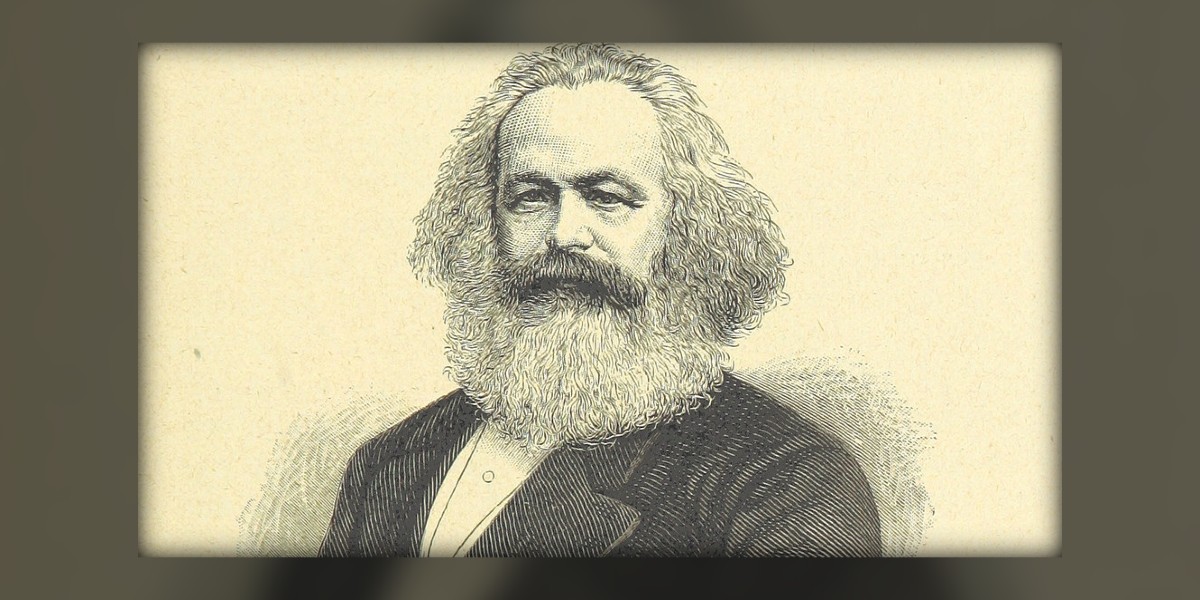
” إن الأفكار المجردة لوحدها لا يمكن أن تغير المجتمع. لقد كانت هذه الحقيقة من أهم الخلاصات التي توصل إليها ماركس “ (كريس هارمن، كيف تعمل الماركسية؟، ص 20).
” كل ما أعرفه هو أنني لست ماركسياً – هذا ما قاله ماركس، إن ما كان في سبعينيات القرن التاسع عشر نكتة جدلية لبقة تحول منذ ذلك الوقت إلى مشكلة سياسية كبرى، فقد شهد القرن الذي مضى على وفاة ماركس ظهور عدد لا يحصى من الماركسيات المختلفة والمتصارعة، وهناك حاجة ماسة الآن لحل هذه الإشكالية وبالتالي الإجابة عن السؤال الشائك: ما هو التراث الماركسي الأصيل؟ “ (جون مولينو، ما هو التراث الماركسي الحقيقي؟، ص 12)
” تدعى الماركسية، على اعتبار أنها نظرية عن العالم، وإذا ما فهمت في أوسع مدلولاتها، تدعى المادية الجدلية. والحقيقة أنها تؤلف وتوحد بين عنصرين صادفهما ماركس منفصلين ومنعزلين في علم عصره وفلسفته: مادية فلسفية، وعلم الطبيعة الذي كان قد أحرز بعض التقدم، علم الواقع الإنساني الذي كانت ملامحه قد بدأت تظهر، جدلية هيجل أي نظرية التناقضات. وإطلاق اسم ” المادية الجدلية ” على هذا المذهب الذي وصفناه، أدق دلالة عليه من كلمة ماركسية الشائعة. والواقع أنها أشد دلالة على العناصر الجوهرية التي يتألف منها هذا التحليل الواسع، دون أن نفصلها عن أثر ماركس ومؤلفاته الخاصة، فتتاح لنا سهولة النظر إلى هذه التعاليم بصفتها تعبيراً عن حقبة من الزمن لا عن فرد معين “ (هنري لوفيفر، الماركسية، ص 18).
يمكن النظر إلى الفلسفة الماركسية، من الوجهة التاريخية، على أنها نتاج مشترك للديالكتيك الهيجلي، والمادية، والتجريبية. غير أن التصنيفات التاريخية يمكن أن تكون مضللة في الفلسفة، كما هي الحال في بقية المجالات، فالعناصر الأصيلة أو الجذابة في تفكير ماركس وإنجلز لا تظهر بوضوح في هذا الوصف، وإنما تضيع منه تماماً تلك الصفة التي جعلت الماركسية رمزاً للإيديولوجية الثورية في العصر الحديث، أعني صفة الخروج القاطع المتعمد على كل التقاليد الاجتماعية الكبرى للحضارة الغربية، حيث شهد ماركس ظروف التصنيع المبكر في أوروبا وما نتج عنه من آثار سلبية على الطبقة العاملة، مما دفعه إلى الاهتمام بسرعة التخطيط لإحداث عملية التحول الاجتماعي، والإقرار بضرورتها، فنكب بجهد لا مثيل على دراسة وتفسير وتحليل ونقد العوامل، التي أدت إلى ظهور الرأسمالية والمبادئ، التي ارتكزت عليها للحفاظ على وجودها واستمرارها، وذلك بهدف القضاء عليها وتجاوزها إلى تشكيلة اقتصادية – اجتماعية ينتفي فيها استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. بهذا نجد أن الفلسفة الماركسية شكلت مدخلاً ثورياً للتغيير الاجتماعي والتقدم الإنساني. إلا أن هذا الوصف لا يوضح الفارق الرئيسي في المنظور بين ماركس والفلاسفة السابقين، فرغم كل ما اقتبسه ماركس منهم، فإنه خالفهم جميعاً على نحو أشد مما خالف به أي منهم الباقين.
إن الخلافات الرئيسة بين المثاليين والوضعيين، كما فسرناها، لا تتعلق بمسائل الواقع، وإنما بمسائل المنهج والقيمة. وقد ظلت هذه الخلافات دائماً منحصرة في حدود معينة، فنحن لا نجد مثلاً أن واحداً من المثاليين كفشته وهيجل، أو الوضعيين مثل كونت، أو أنصار مذهب الحرية مثل جون ستيوارت مل، أو الطبيعيين التطوريين كهربرت سبنسر، لا نجد أن واحدًا من هؤلاء قد عد نفسه ثائراً اجتماعياً أو مرتداً عن التراث الحضاري الكامن الذي ظهرت فيه فلسفاتهم ونمت، وإنما كانوا قادة ومصلحين حاولوا فقط أن يوضحوا التراث وينقوه ويُعدلوه، ولم يكن في نيتهم أبداً أن ينشقوا عليه نهائياً. ولقد كانوا بلا شك مندمجين في أزمة العقل التي اشتدت تدريجياً، والتي بسطت ظلها على جميع الفلسفات منذ كانت. ومع ذلك فما زال من الممكن النظر إلى الخلافات الفلسفية بين المثاليين والوضعيين، على خطورتها، على أنها مراحل لمناقشة برلمانية مستمرة بين فئتين مهذبتين إلى حد غير قليل، إحداهما محافظة والأخرى تناصر مذهب الحرية، في الوقت الذي يلتزم فيه الجميع، بدرجات متفاوتة، النظم المتطورة السائدة في العالم المسيحي البرجوازي.
وفضلاً عن ذلك فقد كانت تلك مناقشة ظلت فيها الخطوط الفاصلة بين الأحزاب واضحة المعالم، وظل النظام الحربي، في المسائل الكبرى على الأقل، محفوظاً إلى حد كبير. أما عندما نأتي إلى ماركس، وإلى نيتشه وكيركجورد، فإننا نجد هذه الخطوط تصبح غامضة، ويبدأ ظهور تقابل فلسفي من نوع أشد وأجرأ، فلم يكن واحد من هؤلاء الفلاسفة ليقنع بتغيير التراث، بل حاول كل منهم، على طريقته الخاصة، أن يهدمه. ولم يكن ما سعوا إليه، من حيث هم فلاسفة، هو مجرد الاعتداء إلى مسلك جديد للأفكار، أو نقد جديد للعقل، وإنما شيء يقرب من خلق نوع جديد من الإنسان. وإن كتاباتهم تختلف، شكلاً وموضوعاً، عن كتابات السابقين عليهم إلى حد جعل كثيراً من المؤرخين المحافظين لا يعترفون بأنهم كانوا فلاسفة على الإطلاق. ومع ذلك فإن مذاهبهم، لا النظريات المحترمة لمعاصريهم الأشد تمسكاً بالتقاليد، هي التي كان لها أكبر الأثر (سواء أكان هذا الأثر مفيداً أم ضاراً) في التفكير الفعلي لعصرنا الحالي.
لقد بدا من الواضح في نظر ماركس ونيتشه وكيركجورد، وعدد آخر قليل من المفكرين، أن من المستحيل إيجاد أي مركب أو توافق حضاري بين المسيحية والعلم الوضعي والمذهب السياسي التحرري. ولم يكن هدفهم هو التمسك بمبادئ المعقولية، وإنما كان هو الخلاص أو النجاح. وهكذا قال ماركس إن المشكلة الفلسفية ليست فهم العالم وإنما تغييره. وكان لفظ ” الحقيقة ” ذاته في نظر نيتشه مدعاةً للسخرية، فحيثما لا تنفع الحقيقة يلجأ نيتشه صراحة إلى الأكذوبة الرفيعة. ومع ذلك فإن رأيه يُساء فهمه عادة، فهو لم يكن يعترض على الحقيقة ذاتها، وإنما على الافتراضات الفلسفية الجريئة المتعلقة بموضوعية المعايير التقليدية للمعقولية وشمولها، فالمعايير من أي نوع، إما أن تُقبل اختياراً من أجل غاية معينة، أو أن يُسلم بها سلبياً نتيجةً لخوف أو تعود، فالأسئلة الفلسفية الهامة ليست، بالنسبة إلى نيتشه، هي تلك التي تماثل أسئلةً من نوع: ” ما هو الحقيقي؟ ” أو ” ما هو المعقول؟ ” أو ” ما هو الخير؟ ” وإنما هي أسئلة من نوع: ” ماذا أريد أن أفعل؟ ” و ” ماذا أريد أن أصبح؟ “.
ويتسم كيركجورد بنفس القدر من العناد، فهو يدير ظهره، بكل بساطة، للمذاهب اللاهوتية (العقلية) في تراث. وفي رأيه أن هذه ليست إلا محاولات متعددةً غير مسيحية لصبغ فكرة المسيح بصبغة عقلية، وبالتالي فهي طرق متعددة، بنفس المقدار، للتوفيق بين معناها الذاتي الباطن وبين مقتضيات العالم الدنيوي الغريبة عن هذه الفكرة. وفي رأيه أن استحالة التوفيق بين فكرة الحياة المسيحية وبين مقتضيات النظم التاريخية التي جعلها هيجل مساويةً ” للروح الموضوعية ” أو ” العقل “، لا تقل عن استحالة مساواة الحرية الروحية بالضرورة التاريخية. ولقد كان خروجه عن المعقولية اللاهوتية في الوقت ذاته خروجاً جريئاً على النظم الراسخة للحياة البرجوازية في القرن التاسع عشر، ولم يكن أقل في جرأته وقطعيته من خروج ماركس أو نيتشه عليها.
ولقد قام الثلاثة جميعاً بمحاولات جريئة للتعبير عن محنة الإنسان المغترب روحياً واجتماعياً في العصر الحديث، ولذلك فإن المهام الفلسفية لماركس ونيتشه وكيركجورد لا تتصف بأنها نظرية إلا عرضاً. ولم يكن هدفهم بأقل من إيضاح معالم أسلوب جديد للحياة يفي بمقتضيات أولئك الذين يرفضون الاعتراف بأن ما أطلق عليه ماثيو أرنولد اسم ” هذا المرض الغريب الحياة الحديثة “، هو فعل إلهي أو قدر محتم على العقل. فهل كان هؤلاء أنبياء أم مجانين؟ هذا سؤال ستظل الإجابة عليه غير مؤكدة.
يعتبر ماركس أكثر الثلاثة معقولية. ويتجلى هذا أولاً في اهتمامه بمشكلة المنهج، غير أن منهج ماركس هو أيضاً مصدر من أكبر الصعوبات التي تمثلها الماركسية في نظر المؤرخ الفكري، فمن بين صفات ماركس، التي لا يمل أنصاره من تكرارها، أنه كان عالماً اجتماعياً جدياً كان لنظريته في التطور التاريخي تأثير لا حد له في النظريات الاجتماعية التالية. وهم يؤكدون أنه لم يكن مجرد مفكر ديالكتيكي، مثل هيجل، ينسج بطريقة أولية قضايا وقضايا مضادة تفرض مقدماً المجرى الذي ينبغي أن يسير فيه التاريخ البشري. وهذا صحيح إلى حد ما، فقد كان من ضمن أهداف ماديته التاريخية إيجاد إطار لنظرية قابلة للتحقيق في الأسباب الفعلية المؤدية إلى التطور الاجتماعي.
ولم يقتصر ماركس وإنجلز على توجيه انتقادهم الشديد إلى هيجل المثالي، بل وجهاه أيضاً إلى فويرباخ المادي، وذلك على أساس أن فلسفتي التاريخ عند هيجل وفويرباخ كانتا مفرطتين في الطموح والغموض، ومفرطتين في عدم اهتمامهما بالأسباب والنتائج الاجتماعية القابلة للملاحظة.
ومع ذلك فإن ماركس كان أكثر من مجرد عالِم ينسج نظريات للتطور التاريخي، بل كان أيضاً مفكراً أخلاقياً ونسبياً، فهو قد استخدم نظريته في التاريخ، ليس فقط لإيضاح ما حدث، ولا حتى للتكهن بما قد يحدث في ظروف تاريخية معينة، بل أيضاً للتنبؤ بالمصير النهائي للبشر في مجموعهم، فالثروة البروليتارية وظهور المجتمع اللا طبقي بمضي الزمن هي بالنسبة إليه نتائج ضرورية للتناقضات الكامنة في الاقتصاد الرأسمالي، وهي نتائج ليست فقط مرجحة الظهور إذا ما توافرت ظروف تجريبية معينة، بل إنها ضرورية الظهور، أو هي – حسب مقصده الحقيقي الباطن – واجبة الظهور. فمن الواجب، في نظر ماركس كما في نظر هيجل، أن يُقرأ التاريخ البشري على أنه تطور ضروري ينتقل فيه كل نظام اجتماعي حتماً إلى ضده. ولقد كانت نظرته الديالكتيكية إلى التغير – كما هي الحال أيضاً لدى هيجل – أقرب إلى القاعدة الصارمة للتحليل الذي يرمي إلى أن يفرض على كل تفكير صحيح أو ” معقول ” عن التاريخ طابعاً ديالكتيكياً واضحاً منها إلى التعميم الاستقرائي. وهكذا يندمج العلم والأخلاق والبحث في المصائر في ذهن ماركس، وربما بطريقة لا شعورية، على نحو يمكن أن يُعد نظيراً حديثاً لما تتصف به العقلية الإنجيلية من مزج قديم بين التاريخ والأخلاقيات والنبوءة. وأية محاولة لإيجاد فصل قاطع بين هذه العناصر كفيلة بحرمان الماركسية من طابعها الصوفي الخاص، ومن جاذبيتها الهائلة من حيث هي إيديولوجية كاملة.
ومن الطبيعي أن ماركس، من الوجهة الشكلية، معارض للدين، وأن فلسفته في التاريخ ترتكز على ميتافيزيقا مضادة للروحية أو مادية. ومع ذلك فإن ماديته تختلف بشدة، في اتجاهها فضلاً عن مذهبها، عن نظريات الماديين والطبيعيين السابقين عليه، فمن الملاحظ أولًا أن أبحاث الماديين الأوليين، مثل ديمقريطس، كانت تهتم إلى حد بعيد بطبيعة العالم المادي، على حين أن الاهتمام الأول عند ماركس كان منصباً على الإنسان والمجتمع، ولقد نظر الأولون إلى التغير على أنه مسألة حركة أو تغيير في المكان فحسب، متجاهلين تلك التغيرات الكيفية التي كانت أساسية في نظرية ماركس في التطور التاريخي، بل إن نظرتهم الآلية، وبالتالي اللا تاريخية (من وجهة نظر ماركس) إلى التغير، قد حالت بينهم وبين إدراك أن التاريخ عملية غير متكررة، تحدث فيها، في مراحل حاسمة معينة، تغيرات أساسية لا نظير لها في الأسس المادية للتنظيم الاجتماعي.
ولعله لم يكن من قبيل المصادفة أن كثيراً من الماديين القدامى، الذين رأوا أنه لا جديد بالفعل تحت الشمس، كانوا من المسالمين الذين دعوا إلى أخلاق شخصية قوامها الاستسلام والتأمل. أما ماركس فكان داعية متطرفاً إلى العمل الإيجابي، لا يستطيع لهذا السبب نفسه أن يقبل أية ميتافيزيقا تبدو قاضية على الأمل في حدوث تحسن أساسي في الظروف المادية لحياة الإنسان. وبعبارة أخرى، فقد كان عليه أن يأخذ التاريخ مأخذ الجد، مدفوعاً بنفس الرغبة الشديدة إلى تملكته في الانفصال الحاسم عنه. وأخيراً فقد قال في المادة اقترنت في أغلب الأحيان – كما في حالة هوبز – بنظرية اجتماعية مماثلة، ترى أن المجتمع مجرد مجموعة من الأفراد لا تتحكم في علاقاتهم بعضهم ببعض إلا قراراتهم أو مصالحهم الفردية. وتبعًا لهذا الرأي تتم جميع التنظيمات الاجتماعية على أساس تعاقدي، بحيث ينطوي أي خرق للعقد الاجتماعي على تحلل عاجل للمجتمع ذاته. أما نظرية ماركس الاجتماعية فتقضي بتفسير السلوك الاجتماعي ” الهام ” للأفراد، لا من خلال القرارات الشخصية المبنية على الاهتمام العقلي بالمصالح الخاصة، وإنما من خلال الأدوار التي يقوم بها هؤلاء الأفراد من حيث هم ينتمون إلى طبقة اقتصادية معينة، وهي أدوار محددة اجتماعيًّا. ولقد كانت الحالة الطبيعية للبشر في نظر هوبز هي حالة ” حرب الكل ضد الكل “، وهي حالة لا يُزيلها إلا تنصيب حاكم كامل السلطة.
أما في نظر ماركس، فإن الصراع هو حقاً قانون الحياة البشرية، غير أن نظرته إلى دراسة المجتمع من خلال نُظمه العامة جعلته يرى أن الصراع الأساسي اجتماعي، وأن الصورة الأساسية للصراع الاجتماعي هي حرب الطبقات، لذلك كان من الضروري ألا ينطوي أي مذهب مادي يكون مقبولاً لديه، على استبعاد لإمكانية النظرة الجدية إلى القضية القائلة إن المجتمع يزيد على مجرد مجموعة من الذرات البشرية، التي لا تربطها سوياً إلا اتفاقات من صنعها هي.
ولقد وجد ماركس في فلسفة التاريخ عند هيجل إطاراً يصلح، ” إذا ما قُلب رأساً على عقب “، لإيجاد جميع الأسس اللازمة في نظره لأية مادية تاريخية أصيلة. على أنه لم يستطع أن يقبل تفسير هيجل للتاريخ، الذي كان في نهاية الأمر تفسيراً مثالياً، يبدو على الأقل أنه يعزو إلى الأفكار والمثل وحدها قوة متحكمة في التغير الاجتماعي. ففي رأي ماركس أن كل تغير اجتماعي هام إنما هو تغير في الطرق المادية للإنتاج الاقتصادي. ومع ذلك فإن تحليل هيجل الفعلي للتطورات الاجتماعية يلتزم دائماً حدود النظم الاجتماعية ذاتها، ونادراً ما كان يرتكب ما يعده ماركس الخطأ الأصيل في الفلسفة الاجتماعية، ألا وهو تفسير دور الفرد في المجتمع على أنه يرتبط فقط بذوقه واختياره الشخصي. فهيجل كان مثالياً، غير أنه كان مثالياً موضوعياً مطلقاً، وقد أتاح له هذا الاحتفاظ بمسحة من الروحية في الوقت الذي استبعد فيه عملياً، وبطريقة منظمة، تأثير الأغراض الشخصية في تحديد مجرى التطور الاجتماعي. غير أن الأمر الذي كان له تأثير بالغ في ذهن ماركس هو إمكانية إعادة تفسير الديالكتيك. ولم يعبأ ماركس بميل هيجل إلى الخلط بين التناقض المنطقي والتضاد أو التعارض المادي، إذ كان ماركس أقل احتفالاً بخصائص المنطق الصوري من هيجل ذاته. وقد لا تكون هناك قيمة للقانون الديالكتيكي الخاص بالقضية ونقيضها، من حيث هو نظرية للاستدلال المنطقي، ولكن هذا القانون أمد ماركس بأداة لا نظير لها لكشف خيوط التطور التاريخي؛ فهو حين فسر هذا القانون ” مادياً ” بدلاً من أن يعده مجرد قانون للفكر، قد كشف لأول مرة عن طريقة عمل الديالكتيك في العالم الواقعي. ولقد كان استخدام هيجل ذاته للديالكتيك يبدو دائماً اعتباطياً، لا لشيء إلا لأنه لم يكن يملك الأساس المادي الغني اللازم للقول بوجود ارتباط عِلّي بين القضية ونقيضها، أو بين النقيض والمركب الناشئ. وهكذا كان ماركس يهدف لأول مرة من إعادة تفسير هذا القانون إلى إعطائه معنى محددا قد ينفع في أغراض التفسير العِلّي الجاد والتنبؤ.
وهكذا سعى ماركس، بجمعه بين الديالكتيك التاريخي عند هيجل وبين المادية، إلى تحويل المادية ذاتها من التفكير الميكانيكي النظري إلى فلسفة للتطور الاجتماعي، وكذلك إلى تحويل الديالكتيك من قانون للفكر يبدو اعتباطياً، إلى قانون فعلي للعلية التاريخية. وربما كان استخدام ماركس للفظ ” الديالكتيك ” قد أفقد اللفظ أي ارتباط باقٍ بينه وبين معناه الأصلي. غير أن هذه في الواقع مسألة ألفاظ. ورغم أن لفظ ” المادة ” في أهم معانيه لم يعد عند ماركس يُستخدم للدلالة على أساس أو جوهر كامن، وإنما على ” المواد ” الملاحظة التي يعمل بها الناس ويبذلون عليها طاقتهم. فإن هذا يعبر مرة أخرى عن تحول في اهتمام ماركس من حيث هو مفكر إيديولوجي. وأهم ما في الأمر هو أن الإيديولوجية المسماة ﺑ ” المادية الديالكتيكية ” – بغض النظر عن صحة التسمية – قد استحوذت على مخيلة الناس إلى حد لم يقدر عليه أي مذهب منذ عهد المسيح.
وطالما ردد ماركس احتجاجه القائل إن استخدامه للديالكتيك كان علمياً فحسب. وينبغي أن ننبه في الوقت ذاته إلى أن الديالكتيك، كما وصفه هيجل، كان يتميز بسمات أُعجب بها ماركس كثيراً. ومن هذه السمات، تلك المعقولية الكامنة التي عزاها هيجل إليه؛ فقد استطاع هيجل – وربما كان في ذلك متلاعباً بمعنيَين للفظ ” المعقول ” – أن يؤكد أن أية عملية معقولية ينبغي أن تكون مفهومةً وصحيحة في الوقت ذاته. ونظراً إلى أن ” المفهومية ” و” الصحة ” متأصلتان في معنى المعقولية ذاتها، فقد استطاع أن يستخدم اللفظ للتعبير عن الإطراء اللا شخصي في نفس عملية تأكيد الطابع المعقول أو الخاضع للقانون في أي تطور اجتماعي. ولقد كان لهذا، من الناحية الإيديولوجية، ميزة كبرى هي إعفاء هيجل من ضرورة التعبير عن موافقته الخاصة على الديالكتيك في صورة حكم قيمة صريح.
وقد استخدم ماركس نفسه، وربما دون أن يدري بالضبط ما فعل، هذا الجانب المعياري في أساسه للديالكتيك الهيجلي في أغراضه الإيديولوجية الخاصة التي كانت مختلفة كل الاختلاف. غير أن هذا الازدواج في معنى كلمة ” المعقول ” هو الذي أتاح له الاحتفاظ بسمة النزاهة العلمية الرفيعة، دون أن يحرم نفسه مزايا لغة المديح اللا شخصي. وبفضله استطاع أن يترك الديالكتيك يشير إلى وجهه الأخلاقي الخاص دون أن يُقحم عليه أي حكم ذاتي، يفترض أنه دخيل، متعلِّق بالخير أو الشر.
وهكذا كانت فكرة التقدم منسوجةً ببراعة في ثنايا الديالكتيك ذاته، وعلى هذا النحو كان تفسير ماركس المادي للتاريخ ينطوي، دون أي تأكيد خاص من ناحيته، على النتيجة الضمنية التي لم يعبِّر عنها، رغم كونها أساسية، وهي أن التطور الثوري للمجتمع هو دائمًا حركة خاضعة للقانون، تتجه إلى الأحسن. غير أن الديالكتيك كان يتسم بصفة أخرى أُعجب بها ماركس، ألا وهي صفة ” الضرورة “، فلعله كان يكفي، في نظر ماركس العالِم، أن يقتصر المرء على إيضاح شروط التغير الاجتماعي. أما من حيث هو مفكر إيديولوجي، فقد كان من الضروري جداً لتحقيق أغراضه أن يتمكن من وصف رقصة التاريخ الكبرى الثلاثية الإيقاع بأنها ” ضرورية ” أو ” حتمية “. ولا جدال في أن من واجب كل من توافرت لهم النية الطيبة أن يقبلوا عن طِيب خاطر أي تطور معقول، ولكن إذا كان هذا التطور حتميًّا أيضًا كما وصف ماركس النصر النهائي للبروليتاريا، فعندئذٍ تصبح مقاومته منعدمة الجدوى. والمسألة العملية الوحيدة، في نظر أنصار ماركس، هي مسألة التوقيت. فلن يستطيع أي شيء أن يؤجِّل تغيراً تاريخياً ضرورياً إلى الأبد. غير أن الديالكتيك لا يشير إلا إلى اتجاه للتغير، لا إلى جدول تقويمي للحوادث المقبلة؛ ولذلك ينبغي أن تفعل المنظمات الثورية كالحزب الشيوعي شيئاً للتعجيل بالغاية المحتومة المنشودة، أي المجتمع اللا طبقي.
بالمقابل يرى نقاد ماركس أن مناداته بالحتمية جعلته لا يترك مجالا للحرية، وبذلك تصبح الدعوة الإيديولوجية ذاتها عديمة الجدوى. ويبدو لي أن نُقاد ماركس لم يدركوا، في هذه المسألة، أن لفظ ” المحتوم “، كما استخدمه ماركس، هو في المحل الأول للفظ يُقصد منه تشجيع البعض وبث اليأس في نفوس البعض الآخر، فهو لا ينتمي إلى لغة الأوصاف العلمية، وإنما إلى لغة الصراع الإيديولوجي. ووظيفته التنبؤية هي أن يوقظ في عمال العالم الشعور برسالتهم التاريخية بوصفهم محرِّري البشر، أو هذا على الأقل هو الرد الذي كان ماركس خليقاً بأن يدلي به عندما يتحدث من وجهة نظر أكثر واقعية.
وما زال أمامنا أن نلاحظ نتيجةً أخرى لتفسير ماركس للتاريخ، فالتطورات في الفكر الديني أو الفلسفي أو السياسي هي في نظر ماركس نواتج عرضية، في الأساس، للتغيرات في أساليب الإنتاج والتنظيم المادي. وهنا كان هدفه الفعلي هو أن يقلب تفسير هيجل المثالي للتاريخ، بحيث يتسنَّى للمرة الأولى فهم ” التركيب الظاهر ” الفكري المثالي على حقيقته، من حيث هو نتيجته للتغيرات الأساسية في النظام الاجتماعي، لا سبب متحكم فيها. وكان من نتيجة هذا القلب أن ماركس نظر إلى التقدم، لا من خلال النمو الذاتي الروحي أو ” الحرية “، وإنما من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية الكامنة للحياة الاجتماعية. وهكذا رأى ماركس أن تحسين أحوال الإنسان يبدأ بحل لمشكلة الفقر حتى لو لم يكن ينتهي بها. وهو يرى أن خلاص الإنسان، وشفاءه من عزلته ومن بؤسه أيضًا، إنما يكمن أساسًا في التصدي الجماعي لهذه المشكلة، ومن هنا قال: إن تشريح المجتمع المدني ينبغي أن يُلتمس في الاقتصاد السياسي. ولعله كان خليقاً بأن يضيف أن الحال كذلك أيضاً في تشريح التقدم البشري.
ولقد كانت نزعة ماركس الجماعية ناتجة، إلى حد بعيد، عن تتلمذه الأول في المدرسة الهيجلية، فهو منذ البداية قد نظر إلى خلاص البشر، مثلما نظر إلى السلوك البشري ذاته، من خلال المجتمع. على أن الإنسان ليس حيواناً اجتماعياً لأن لديه غريزة الإخاء، وإنما لأنه قد كُيف على التفكير والسلوك بوصفه عضواً في طبقة اجتماعية، فتلك الدوافع التي يملكها الفرد والتي تتعلق بالذات أو بالغير، تعبّر عن نفسها دائماً من خلال مسالك تحكمت فيها البيئة الاجتماعية التي يخضع لها. ولقد نسب كارل بوبر في كتابه القيم ” المجتمع المفتوح وأعداؤه ” إلى ماركس فضلاً هو كونه أول من قرر ما يسميه ﺑ ” الاستقلال الذاتي لعلم الاجتماع “. وهذا في رأيي غير صحيح، فرغم أن فلسفة هيجل في التاريخ كانت ذات نزعة روحية، فإنها قد صيغت أيضاً في عبارات كانت في أساسها منتمية إلى مجال علم الاجتماع أكثر مما هي منتمية إلى مجال علم النفس. ومنه تعلم ماركس التفكير في السلوك البشري من خلال أدوار تفرضها النظم الاجتماعية ذاتها. كذلك تخطئ قضية بوبر في ناحية أخرى، إذ إن أوجست كونت، قد أكد قبل ذلك بأوضح العبارات أن قوانين علم الاجتماع لا ترد إلى القوانين النفسية للطبيعة البشرية. ومع ذلك ففي وسعنا أن نتفق مع بوبر إلى حد معين، فنقول إن ماركس قد ساهم بأكثر مما ساهم به أي فيلسوف آخر في القرن التاسع عشر في إشاعة فكرة الاستقلال الذاتي لعلم الاجتماع، وأن تأثيره، لا تأثير كونت أو هيجل، هو الذي كان له أكبر الأثر في محاربة النزعة النفسية الكامنة في معظم النظريات الاجتماعية السابقة. ولنُضف إلى ذلك أن نظرية كنظرية ماركس، لا تتعارض مع نوع من الفردية الأخلاقية. وينبغي أن نقرِّر، إحقاقاً للحق، أن تصور ماركس للمجتمع الفاضل كان، على خلاف هيجل أو كونت، تصوراً فوضوياً، فالمجتمع الفاضل أو اللا طبقي لا يمكن في نظره أن ينشأ دون تدابير جماعية، غير أن الغاية القصوى لهذه التدابير ولكل النظم ليست حفظ كائن عضوي اجتماعي هائل، وإنما سعادة أفراد الناس. وهنا لا يمكن أن يُعَد ماركس، كما هي الحال بالنسبة إلى هيجل، من الممهدين للفاشية.
كذلك ينبغي أن نلاحظ أن فلسفة ماركس المادية لا يمكن أن تعد، بالفعل، منطوية على نظرية أنانية في الطبيعة البشرية، فماركس من أنصار فكرة تأثير البيئة، وهو يرى، من وجهة نظره الخاصة، أنه إذا كان معظم الناس قد عاشوا حتى الآن بحد السيف، فذلك ليس راجعاً إلى نزعة عدوانية غريزية فيهم، وإنما هو راجع إلى أن ظروف البيئة الاجتماعية تحتم عليهم السلوك بطريقة عدوانية. والرأسمالية، لا شهوة القوة، هي التي تولد النزعة الاستعمارية والحرب في نظر ماركس. وبالمثل ليس الفساد الفطري في الإنسان هو سبب جشع الرأسماليين، بل إن السبب هو روح السلب والنهب التي يثيرها نظام الربح. ولقد قال فولتير إن الناس لم يكونوا دائماً ذئاباً، وإنما أصبحوا ذئاباً. أما ماركس فرأى أن مهمته هي إيضاح سبب ذلك، ولكنه رأى أيضاً أن مهمته هي أن ينبئ الناس بالوسائل التي قد تؤدي بهم إلى الكف عن سلوك مسلك الذئاب.
وفي النهاية يمكننا تحديد الماركسية على أنها العلم الذي يقوم بدراسة قوانين تطور الطبيعة والمجتمع. هي نتاج نقد ماركس لمادية فيورباخ الساكنة وجدلية هيجل المثالية. تعتمد الماركسية بشكل عام على المادية كأساس ثابت في دراستها وتحليلها وتفسيرها للظواهر الطبيعية والاجتماعية. في واقع الأمر تنقسم الفلسفة الماركسية عموماً إلى عدة أقسام رئيسية: أولاً، المادية الجدلية: وهي ركن أساسي من أركان الفلسفة الماركسية تعتمد على قوانين الديالكتيك وتتلخص في اعتبار العالم مكون من مادة متحركة وهي في تطور وتجدد دائم ومستمر. وتؤمن بذلك بأسبقية المادة على الفكر. حدد ماركس منهجه بالمنهج الجدلي، وقد استفاد ماركس من هيجل في تطبيق هذا المنهج ذلك أن هيجل قد بدأ بتطبيق المنهج الجدلي على الفكر والتفكير وحدد بناءً على هذا المنهج تطور التفكير عن طريق الفكرة ونقيضها ثم اختفائها بظهور فكرة جديدة بمثابة تأليف بين الفكرة ونقيضها.
حاول ماركس تطبيق هذا المنهج الجدلي على المادة ويفسر ما ينطوي عليها بدلاً من الفكر، وتطور وحركة التاريخ عن طريق الواقعية المادية ونقيضها ثم اختفائها بظهور واقعية مادية جديدة تؤلف بين الاثنين الأولين. ثانياً، المادية التاريخية: هي العلم الذي يبحث عن القوانين العامة والقوى الدافعة لتطور وتغير المجتمع الإنساني. ولا يقتصر موضوع المادية التاريخية على دراسة تاريخ المجتمعات والشعوب وكيفية تطور نظمها الاجتماعية والاقتصادية التي ظهرت خلال فترات تاريخية معينة من تطور المجتمع الإنساني. ولكن أيضاً تشتمل – المادية التاريخية – على دراسة قوانين الحياة المعاصرة لمختلف الدول والنظم سواءً كانت رأسمالية أم اشتراكية أم نامية، ودراسة قوانين الحياة الاجتماعية والبشرية بصورة عامة. وأخيراً، الاشتراكية العلمية: مجموعة أفكار وعقائد ورؤى ثورية تنادي بصورة حتمية بضرورة الإطاحة بالنظام الرأسمالي وإقامة مجتمع المساواة والعدل في إطار أممي مرتكز على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، وخالي من التمييز الطبقي والاجتماعي وذلك بالاستناد إلى التحليل العلمي للحركة الحقيقة للمجتمع الرأسمالي ولتناقضاته الداخلية التي ستقوده نحو حتفه، ولنضال الطبقة العاملة التي وحدها القادرة على تجاوز هذه التناقضات وبناء نظام آخر من العلاقات الاجتماعية وهو النظام الاشتراكي.
_________
– المراجع المعتمدة:
– جورج بوليتزر وآخرون: أصول الفلسفة الماركسية، ترجمة: شعبان بركات، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، الجزء الأول ، بدون تاريخ.
– هنري لوفيفر: المادية الجدلية، ترجمة: إبراهيم فتحي، آفاق للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2018.
– هنري لوفيفر: الماركسية، ترجمة: جورج يونس، المنشورات العربية، بيروت، ط1، 1972.
– هنري د. أيكن: عصر الأيديولوجية، ترجمة: فؤاد زكريا، مراجعة: عبد الرحمن بدوي، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ط2، 2023.
– حسام الدين فياض: المدخل إلى علم الاجتماع (من مرحلة تأصيل المفاهيم إلى مرحلة التأسيس)، مكتبة الأسرة العربية، إسطنبول، سلسلة نحو علم اجتماع تنويري، الكتاب الثاني، الجزء الثاني، ط1، 2021.
– كريس هارمن: كيف تعمل الماركسية؟، ترجمة: مركز الدراسات الاشتراكية، سلسلة الكتاب الاشتراكي، العدد: الرابع، بدون تاريخ.
– جون مولينو: ما هو التراث الماركسي الحقيقي؟، ترجمة: مركز الدراسات الاشتراكية، كراسات اشتراكية، بدون تاريخ.
______
*د. حسام الدين فياض/ الأستاذ المساعد في النظرية الاجتماعية المعاصرة/ قسم علم الاجتماع كلية الآداب في جامعة ماردين- حلب سابقاً.

