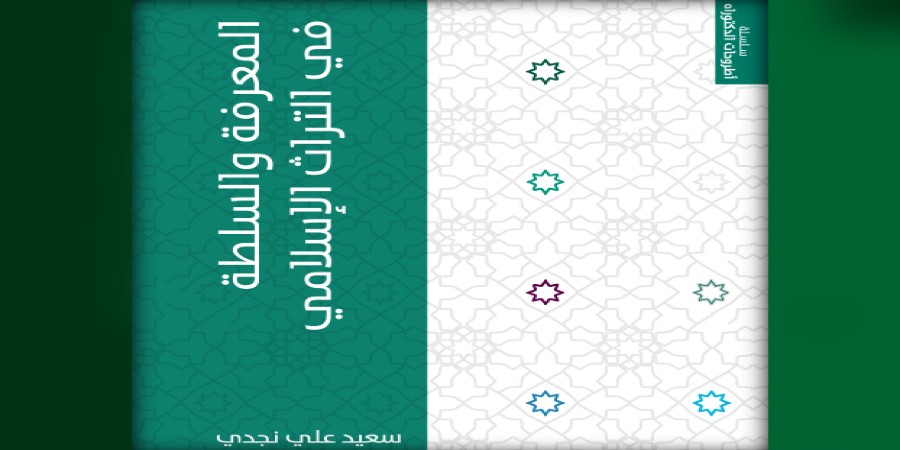
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة “أطروحات الدكتوراه” كتاب المعرفة والسلطة في التراث الإسلامي، وهو من تأليف سعيد علي نجدي. يقع الكتاب في 416 صفحة، شاملةً ببليوغرافيا وفهرسًا عامًّا.
يلقي مؤلِّف هذا الكتاب الضوء على مسألة العلاقة بين المعرفة والسلطة في التاريخ الإسلامي، التي تستبطن كثيرًا من المدارس والاتجاهات الفكرية، مختارًا من بينها للدراسة فكر الفرقة الإسماعيلية، التي تندرج تحت الجناح الشيعي، وجاءت تسميتها نسبةً إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، الإمام السادس لدى الشيعة، ولا يزال لديها أتباع كثيرون في سورية واليمن، إضافة إلى الهند وإيران وغيرهما.
أنشأت هذه الفرقة نظامًا فكريًّا ضخمًا طعّمته بالفلسفتين اليونانية والشرقية، وبالأديان السابقة أيضًا، وقد أدخلت مفهوم “الباطن” و”المرمز” في تأويل النص القرآني، فقامت أيديولوجيتها الدعوية على دعامتين: الظاهر والباطن، والحقيقة لديها تكمن في الباطن. وعلى أنقاض هذه الدعوة شُيدت “الإمبراطورية” الفاطمية ودول أخرى، فهل أفادت الدعوة الإسماعيلية ونظامها الفكريّ في تشكيل الدولة؟ وهل أعادت السلطة بعد إنشائها تشكيل بنى المعرفة؟
هيكلية جماعة الإسماعيليين
تدرّج الكتاب في الحديث عن نشأة الإسماعيلية، ونظامها الفكري، ومراتب الدعوة لديها، والأدوات التي عملت عليها، كالتأويل الباطن والتأويل الظاهر، والمثل والممثول، والستر والكشف، وهي أدوات ساعدت في تبرير ولاداتها المتعددة.
مفهوم الإمام هو المفهوم المحوري عند الإسماعيلية، فهو الدعامة التي لمَّا تزل قائمة ومستمرة، وتختلف بذلك عن الشيعة الاثني عشرية الذين يقولون بتوقف الإمامة مع الإمام الثاني عشر الغائب، المستتر، بينما يعتبر الإسماعيليون أن الإمامة مستمرة، وإن استتر الإمام بحسب الظروف.
دخلت الإسماعيلية في طور جديد مع انتقالها إلى العالم الغربي تميز بتعديل ظاهر الشريعة، وقد تمكن مركز السلطة فيها من التكيف مع الظاهر على نحو يخدم مصالحه، مع إبقاء الباطن الروحاني اللامعلوم ثابتًا، ويسمح بقراءات متعددة بوصفه ظاهرة فكرية. فعلى صعيد التنزيه، أبدت الإسماعيلية عقلانية خارجية قبع خلفها “العرفان”، الذي يُسقط صفات عن الله ويسندها إلى الأئمة، من أجل مد “شريان سلطتهم” بـ “الغذاء الدائم” من خلال الولاية على الناس وضمان طاعتهم، من خلال تصوير “الإمام” طريقًا أوحد لنجاة الغلام “المستجيب” والمرقاة لروحه نحو عوالم أخرى وخلق جديد.
وأوضح مثال للدلالة على التناقض الواضح بين الظاهر والباطن لدى الإسماعيليين ممثلهم في الغرب الآغا خان كريم شاه الحسيني؛ ففي الظاهر هو رجل غربي يعيش حياة غربية ومتزوج بنساء غربيات، وفي الباطن هو بالنسبة إليهم ممثل لمراتب الوجود كلها، ولديه سلطة نسخ الشريعة كالأنبياء والرسل.
استغلال الإسماعيليين معاني اللغة
اللغة رافد مهم في حضارة العرب ومكون رئيس لثقافتهم؛ فقبل نزول القرآن لم يكن للعرب نص مكتوب، وما سمح لهم لاحقًا بتبوُّء مراكز مهمة في التاريخ هو كتابة نصوصهم، ومع الكتابة قامت إشكالية في الصراع على احتكار المعنى. وتحضر الإسماعيلية في هذا المضمار؛ فهي قد أنشأت قالبًا فكريًّا يتمتع بجهاز لغوي ضخم من خلال “العرفان” لاستثماره في تثبيت سلطتهم، والتحكم في أبدان الجماعة وأرواحها، وأهم ما فيه مفهوم الباطن، الذي كلما غاب عن الفهوم سمح بالسيادة أكثر؛ فهو متغير ثابت، ومفهومٌ مفارقٌ لا محايث.
وفي الدول التي حكمها الإسماعيليون كان للإمام على الدوام بعدان سلطويان: روحيّ وتنفيذيّ. أما في الطور الأخير اليوم، مع انعدام دولة خاصة للحكم، فقد بات مفهوم الولاية لدى الإسماعيليين ذا بعد روحيّ فقط، وبات إسماعيليو العالم الغربي يشجعون الناس على الانخراط في أنظمة البلدان وتجنب الصراعات مع الأنظمة والحكام، وخصوصًا لدى إسماعيليي سورية (وهي عيّنة الدراسة)، على الرغم من اختلاف الآغا خان مع سياسة النظام السوري.
ويلقي الكتاب الضوء على إشكالية التسلط التي مثّلت فكرةُ الولاية على الناس، بدلًا من ولايتهم على أنفسهم، جانبًا من جوانبها؛ ولهذا رجع الكتاب إلى منابع الاستبداد في محاولة لفهمه، خصوصًا أن هذا الجيل يعيش اليوم بين أفقين من الماضي والحاضر، وهو أشبه ما يكون في “منزلة بين منزلتين”، يُحيى الحاضر مستحضرًا الماضي على نحو مشوه، فيعيش انشطارًا على مستوى الذات، خوفًا من التعسف.
نعيش اليوم في عالم مفتوح لا مكان فيه للهويات المنغلقة، لأن الانغلاق موتٌ، كما أن الجيل الجديد يتميز بعقلية مغايرة للعقليات المتسلطة، وهو يتشرب أفكاره من العالم كله، فإذا لم تتعامل السلطة معه بمنوال آخر طواها، وهذا ما تنبه له الآغا خان بإرشادات جديدة من خلال مركز الدعوة لئلا تفقد سلطته الروحية سحرها ورمزيتها.
يتناول الفصل الأول انتفاضة الحركات العَلَوية في الشق الحسني، وانتفاضة الإسماعيلية في الشق الحسيني بوصفها أول حركة ثورية بعد ثورة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لكن الفرق بينهما هو أن الزيدية، رغم نجاحها فكريًّا في إنشاء مقولات كلامية متأثرة بالاعتزال، لم تنجح سياسيًّا في بلورة دول واضحة الاتجاه. أما الإسماعيلية، فنجحت فكريًّا وسياسيًّا، من خلال إنشاء الإمبراطورية الفاطمية، وكانت أولى الفرق المنتسبة إلى العَلَوية تنشئ دولة مركزية ضخمة. وفي الوقت الراهن، نشهد أدوارًا أقوى سياسيًّا للاثني عشرية في العراق ولبنان وإيران، في حين تحولت الإسماعيلية إلى جماعة روحية فقط. ويتطرق الفصل إلى مزج الإسماعيلية في فكرها بين علم الكلام والحكمة اليونانية والأديان السابقة، وإلى أن أهمية الإسماعيلية، مقارنةً بالحركات العَلوية الأخرى، تكمن في أنها عملت على السرية وبناء الأدلوجة، وهو ما قصرت فيه الحركات السابقة.
أما الفصل الثاني، فيتعرض لصراع الدعوة الإسماعيلية مع العائلة العباسية المعادية، ولصراعها الداخلي، أولًا مع الفخذ العلوي الذي يمثله أولاد الحسن بن علي – أي بين الحُسينية والحَسَنية – على امتلاك مفاتيح القوة المتمثلة في “الإمامة”، وثانيًا داخل الحسينية نفسها، وهي أشكال من الصراع رسمت لدى الإسماعيلية معالم فكرية ومذهبية عدة، ومكّنتها أكثر من غيرها من إنشاء دول، مستفيدةً من أخطاء السابقين ومعيدة قولبة موروثاتهم المتراكمة لمصلحتها، ومستخدمةً نصوص كبار الفلاسفة (أمثال إخوان الصفا، والرازي، والسجستاني، والكرماني)، كما منحت علماءها سلطة تأويل باطن الشريعة مع الإبقاء على الإمام هدفًا وغاية في رسم أي عمل وحياكته، لأنه في رأيها المركز الذي يشرق على الكون بنوره.
يشرح الفصل الثالث استراتيجية عمل الإسماعيلية على عدة أبنية، ما جعلها صاحبة مشروع. فعلى المستوى السوسيولوجي، بنَت علاقة بين الأبنية الفوقية (عالم الرموز والمعاني) والتحتية (مؤسسات الحكم). وعلى مستوى السلطة، عملت على تهيئة الظروف لظهورها عبر: الستر (الانكفاء والتحضير) والكشف (ممارسة الحكم). وعلى مستوى الدعوة، قامت بجمع الصدقات دعامة أساسية لمشروعها، وتهيئة المناخات الفكرية للتأليب على السلطات المحلية، مستغلةً تناقضات المجتمعات، ومستخدمةً مفردات ذات دلالة مشحونة بالعواطف (مثل العدل، والخير، والتحرر، والمساواة)، وهي جميعًا دعامات ساعدت في ولادة مشروعها وإنضاجه تمهيدًا للكشف عنه.
ويوصّف الفصل الرابع سوسيولوجيًّا كيفية توظيف الفقه الإسماعيلي سياسيًّا أقانيم روحانية لتغليف حقل السلطة بغطاء سميك من القداسة لجعله فوق وعي الناس، وذا جوهر مقدس، وخصوصًا بالنسبة إلى الإمام، فهو ممثلُ عالمِ الجوهر، الذي ينكمش أمامه وعي الإنسان ويستسلم وينقاد إلى الاتباع المطلق، لأن الموجودات كلها لدى الإسماعيلية متمثلة في الإمام؛ بدءًا بالعقل الكلي، ونزولًا إلى الفلك الأعلى، وانتهاءً بعالم الدين والشريعة. وجاء ابتداع فكرة “الترقي الروحي والخلق الآخر” لدى الإسماعيلية، وأن لا خلاص وتطهّر بعد الموت إنْ حادت الروح عن الإمام؛ لإبقاء الأتباع ضمن دائرة الولاء، وإيهامهم بأنه ما من خلاص لأرواحهم من دون تزكية المعلم، فأوّلوا الجنة والنار بأن الإمام ممسك بمصير الروح بعد الموت، فإذا كان ثمة اتِّباع فالخلاص والسعادة، أما إذا لم يكن فسوف تشقى هذه الروح وتبقى حبيسة عالم المادة.
ويبيّن الفصل الخامس قيام الإمامة لدى الإسماعيلية على حبكة الوعد بالنعيم والتطهر الروحي؛ من خلال اتباع الإمام واعتباره مفتاح الانتقال إلى عالم الروح النقي، وهذا البناء الخيالي يوفر رأس المال الرمزي لمدّ بنى السلطة الإسماعيلية المستأنفة على الدوام، وهي اليوم ممثلة بشخص الآغا خان كريم شاه الحسيني، الذي تميل معه جماعته كيفما مال خوفًا على مصيرها، بغض النظر بتحولات ظرفية في “ظاهر” الجماعة تفرضها قرارات للسلطة التي يعيشون في كنفها، إلا أن “الباطن” هو الثابت الوحيد لديهم، فالإمام هو الينبوع الأول وعدم اتباعه يعني تقمّص الروح؛ أي لبسها قميص جسد آخر حتى تتطهر، لتتمكن من العودة إلى عالم الروح.
من ناحية أخرى، يشرح الفصل السادس اهتمام الإسماعيليين بموضوع الإلهيات، وإسنادهم الصفات والأسماء إلى “العقل الكلي” الذي يمثله الإمام في الباطن، وتضخيم كينونة الإمامة الذي يوفر الديمومة السياسية على صعيد الاجتماع، وإبقاء الإمامة من المقدسات التي توفر انضباطًا واندماجًا وتجانسًا هوياتيًّا لدى الأعضاء وارتباطًا بالإمام الحاضر. ويخرج الفصل باستنتاجات متعلقة بسبب إسباغ هذه الصفات على الإمام وربطها بالأقانيم الروحانية، ويتساءل إن كان هذا الأمر على حساب انزياح الإله كليًّا من مدار الوعي، أي استبدال غيابه بحضور الإمام لغايات سياسية، وهي استنتاجات احتمالية؛ فقداسة الإمام مفهوم ذو بعدٍ سياسيٍّ، وهي تؤدي أدوارًا مكشوفة مرةً، وخفيّة مرةً أخرى. ثم إنّ في اتباع الأئمة انتقالًا إلى العوالم العلوية، وفي هذا حبكةٌ لربط الأتباع بإرادة القيادة.
يلقي الفصل السابع الضوء على تأويلات الإسماعيلية للنصوص، والشقة البعيدة التي قطعتها، متسائلًا عن سبب ذلك، ولا سيما إن كان بسبب أن دعوتها كانت ضعيفة بإسماعيل وابنه محمد؛ لأن الإمامة ثابتة – بحسب زعمهم – على محمد بن إسماعيل لقول النبي محمد إن “اسمه اسمي واسم أبيه كاسم أبي”، في مقارنة بين إسماعيل بن إبراهيم ومحمد بن إسماعيل، وأن محمدًا طلب اليمن دارَ هجرة كما فعل جدّه النبي محمد بإقامة دار هجرة في يثرب؛ ومن أجل ذلك، حشدت تأويلات كثيرة متمثلة في إشارات جرى تجنيدها لنصرة مذهبها بسبب ضعف دعواها، فجاءت بفلسفة متأثرة بفيثاغورس، كما هو ماثل بوضوح في رسائل إخوان الصفاء، التي ينسبها الإسماعيليون إلى الإمام الثاني في دور الستر أحمد بن إسماعيل، وفقًا لمصطفى غالب وعارف تامر، أما أبو حيان التوحيدي والقفطي فينسبانها إلى أبي سليمان البستي “المقدسي”، وعلي بن هارون الزنجاني، ومحمد بن أحمد النهرجوري، والعوفي أيضًا، وربما لا تكون كذلك. ويوحي التأويل الإسماعيلي بنزعة عقلية، وهو يذهب صوب غاية عرفانية؛ أي استخدام العقل كـ “ظاهر” من أجل المعنى العرفاني “الباطن”.
يذكر الفصل الثامن الفلسفة العددية الهرمية التي تأتي لمطابقة الدين مع الفلسفة من خلال موروثات الإسماعيليين، ولتكون الممثولات كلها متوجهة صوب عقيدتهم، من أجل مطابقة حدود الدعوة وتسلسلها انتهاءً بالواحد (الإمام) في مرحلة الستر. ومن هنا، يجب الاهتداء إلى العدد الذي تكون صورته في النفوس مطابقة لصور الموجودات في الهيولى، وبمعرفته يتدرج المرتاض إلى سائر الرياضيات والطبيعيات، والعلم به هو جذر العلوم وعنصر الحكمة وأسطقس المعاني، ومن دونه لن نفهم العقائد الإسماعيلية. فكيف تأتّى لمعاصريها فَهْم هذا وقد كانت جمعية سرية لا تأذن للغرباء بحضور مجالسها؟ إضافة إلى ذلك، تقبع في النص الإسماعيلي معانٍ كثيرة ودلالات وإحالات وأقانيم، وكلّها في حاجة إلى تفكيك، وهو نص مثقل بالوزن الميتافيزيقي، والأنطولوجي؛ إذ يذهب الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا إلى أن فيه أكثر من لغة، وكلما دخلنا في أعماقه وجدنا مساحات ولغات، ويذهب كذلك إلى أنه نص لم يمت مع موت المؤلِّف. وكما يقول المفكر الفرنسي رولان بارت، فإن القارئ يكون أمام النصوص الإسماعيلية مثل صفحة بيضاء يكتب النص فيها جسده؛ لأن السلطة المركزية تتسلط فيها الذات على القارئ. وفي موضوع الإدلال يقول بارت: “الإدلال هو المعنى من حيث هو إنتاج حساسية شهوانية، فالنص يخلق رغبات وتشويقًا ويصبح أشبه بنظام من الإشارات والتنبيهات التي تختزن متعةً ونجاةً للذات”، وهو كلام يفيد ما في قراءة النص الإسماعيلي من تحريك للنفوس وتشويقها على نحو لافت للانتباه.
يبقى السؤال الأهم هو: لماذا استخدمت الإسماعيلية “سلاح” التأويل؟ الجواب أنها استخدمت الباطن لتبرير الترميز؛ لأن هذا الترميز أفادها بإسقاط كلّ ما هو موجود في النص القرآني على الدعوة ومراتبها، خصوصًا عندما أوحت أنها مكمّلة للقصص القرآني على خط زمنيّ تعاقبيّ، وصوبت بالتأويل تجاه ربط الأدوار كلها بمسارٍ واحد ينتهي عند الإمامة.
يتوصل الفصل التاسع إلى استنتاجات حول السلطة، أهمها انطلاق سياسة انفتاح الحاكم، أو تشدده، من الواقع، ومن معايير سياسية واقتصادية، وهذا ينطبق على الخلفاء الفاطميين الذين انطلقوا من مقتضيات الواقع في مرحلة القوة والتوسع. ففي بعض الأحيان، تؤثر البنى التحتية (الاجتماع والاقتصاد) في البنية الفوقية (الدين وأيديولوجيا)، ومن ثمّ كانت قرارات أحد حكامهم صارمة تجاه النصارى عندما بدأ الاتجاه السني في التحرك، مثل هدم بعض الكنائس، ولاحقًا تراجع عن تشدده بسبب تأثير التبادل التجاري مع الإمبراطورية البيزنطية، وأعاد بناء الكنائس. وعندما حدثت انشقاقات على مستويَي الدعوة والإنتاج الفكري، حارب الفكر بالفكر، وطلب من الفيلسوف أحمد حميد الدين الكرماني حَشْد عدّته الفكرية للردّ فألف راحة العقل، وهذا ماثل أيضًا طلب المعزّ من القاضي النعمان تصنيفات فقهية؛ إذ عمد إلى تشييد “صرح” فقهي كبير لإظهار نفسه إمام العالم السني في شمال أفريقيا ومصر، ولإظهار أن الفاطميين يؤمنون بالشريعة وبظاهر الدين، وكذلك طلبه من القاضي حوشب تصحيح انحرافات القرامطة، فعمد إلى الكشف وسرائر وأسرار النطقاء، وهذا مماثل أيضًا لطلب الحاكم من الفيلسوف الكرماني الرد على الدعاة الدروز المنشقين عن الإسماعيلية، أو لطلبٍ من الفلاسفة الإيرانيين، مثل الرازي والسجستاني، مفاده تحويل الجماعات إلى الأيديولوجيا الإسماعيلية مع انتشار “المزدكية، الخرمية والبابكية” ذات الطابع الخلاصي في إيران؛ ما مهّد لنشوء دويلة قلعة “ألموت” بزعامة حسن الصباح.
أما الفصل العاشر، وهو الفصل الأخير، فيتساءل بعد عرضٍ التحولات السابقة عن إمكان العودة إلى الحديث عن المسكوت عنه في الدعوة الإسماعيلية. ويعتبر هذا الفصل أن التقية التي كانت في مراحل الستر لم يكن كل العوام على معرفة دقيقة بها وبأقانيمها؛ فالباطن بالنسبة إلى هذه الجماعة حقيقة ثابتة لكنّ الكشف عنها من خلال التأويل مهمّة الإمام، أما الظاهر فهو مسعف يستعان به حتى لا تبدو الإسماعيلية جماعةً متقوقعةً على نفسها. ويشير الفصل إلى أن الإسماعيلية قادرة على الانفتاح على الآخر بغياب التكفير في أدبياتها ونصوصها، وأن النص والدعوة الإسماعيليين مرنان، وأن مخالفيها سكتوا عن هذا واستبعدوه لمصلحة إبراز صفات ونعوتٍ كالغنوصية والهرمسية. وعلى صعيد سوسيولوجيا الثقافة، يؤشر الكتاب إلى عمل الإسماعيلية على التقابل الثقافي على نحو مرنٍ، انطلاقًا من مستلزمات المصلحة؛ لهذا نرى تعايش الإسماعيلية مع كل بيئة ثقافية. وفي ما يخص إسماعيليي سورية، نرى إبراز الفصل الحديث عن التقية لديهم، وأنها لا تعود إلى إرشادات الإمام، الذي يوصي بعدم الدخول في صراع سياسي مع الحكومات؛ ما انعكس في عدم وجود بؤر توتر للجماعة مع أي طرف في مختلف البلدان التي تسكن فيها، على خلاف جماعات عرقية أو إثنية أخرى.
- تأليف: سعيد علي نجدي.
كاتب وباحث لبناني. حاصل على الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية في ميدان علم اجتماع المعرفة والثقافة (2020)، والماجستير في الأنثروبولوجيا من الجامعة اللبنانية. عضو في المجلس العربي للعلوم الاجتماعية. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات، وله العديد من الدراسات والأبحاث والمقالات في عدد من الدوريات والمجلات العلمية والمواقع الإلكترونية.

