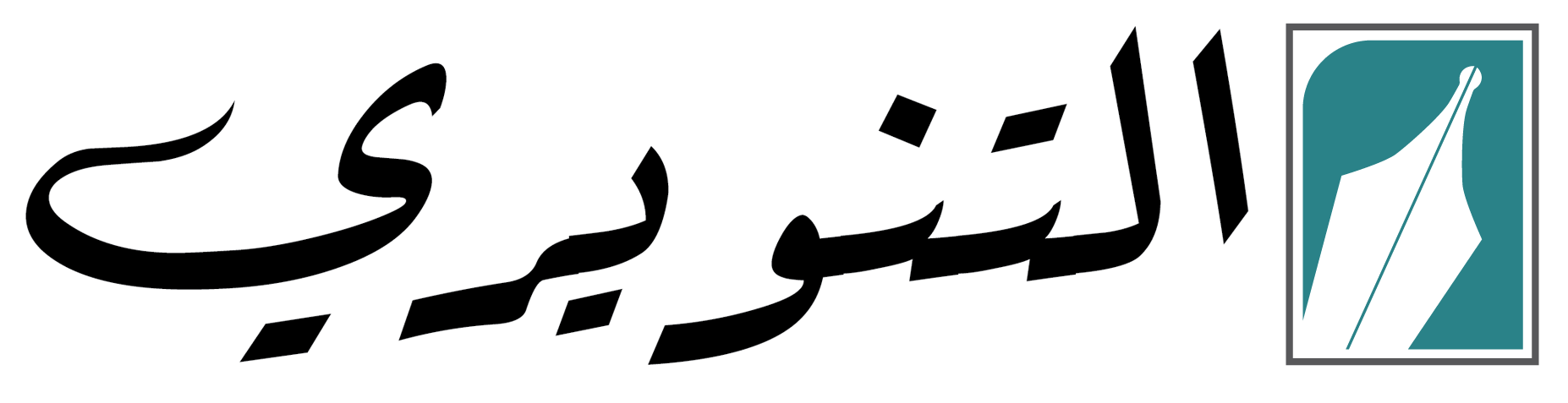يبدو أن علم الاجتماع قد غُيِبَ عن دراسة الحياة الاجتماعية ومشاكلها طيلة العقود الماضية في المجتمعات العربية، وعليه الآن أن يخرج من برجه العاجي وينزل إلى الشارع ويتحول من علم اجتماع العبث إلى علم اجتماع المجتمع النقدي، ويرتبط بواقع الحياة اليومية والتاريخ، فيحاول قراءة همومهم وآمالهم، الظاهرة والباطنة، في لغتهم وثقافتهم وفكرهم وفي حياتهم اليومية، ويحول هذه الهموم إلى قضية ومشروع. هموم الإنسان العربي كثيرة، ويتداخل فيها الموروث الثقافي مع الحاضر، بحيث لا يعرف الإنسان موقعه في الحاضر، ولا في أي زمن يعيش([1]).
إن السؤال المهم الذي ينبغي أن يطرحه علم الاجتماع العربي المعاصر هو حجم البؤس والدمار الذي أصاب الذات العربية نتيجة الفكر الأبوي، الذي جعل الأبوية ظاهرة يومية تتحكم في سائر شؤون حياتنا، في الأسرة والمدرسة والجامعة والدولة. هذه الثقافة التسلطية التي نشب عليها، صارت من مكونات شخصيتنا. وحيثما توجد الشخصية التسلطية يوجد الإذعان المطلق لها وعدم تحمل المسؤولية. لذلك فإن الثقافة الأبوية قد دمرت الذات العربية، وجعلت الخضوع للسلطة سلوكاً يومياً. الأب في الأسرة يتسلط على الأبناء، وكذلك السلطة الأبوية فهذه تتسلط على أفراد المجتمع، وتكوّن شخصية ونظاماً متسلطاً لا شأن للأفراد فيه سوى الخضوع لهذا النظام، ولذلك نلاحظ أن أفراد المجتمع العربي لا يتحملون مسؤولية اجتماعية، لأن السلطة لا تنبع منهم، بل من الأب الحاكم (الاستبداد) ([2]).
يعتقد علماء الإبستمولوجيا (علم المعرفة)، أن الفكر الإنساني يتأثر بأحداث السياق الاجتماعي وتفاعلاته لمجتمع ما، وعلى الرغم من أن للفكر هامشاً من الاستقلال النسبي عن الواقع الذي أنتجه يتجسد في تقدمه على الواقع الاجتماعي أو تخلفه عنه، إلا أنه في نهاية الأمر محكوم عليه بعوامل موضوعية تجعله أحياناً أكثر توضيحاً للواقع من أجل تجاوزه، وأحياناً أخرى أكثر تزييفاً للواقع من أجل الحفاظ عليه([3]). وفي هذا المقال سنتحدث عن واقع علم الاجتماع في البلدان العربية في مرحلتي الاستعمار الأجنبي، وما بعد الاستقلال الوطني.
ففيمرحلة الاستعمار الأجنبي لعب الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، الذي ولد فيه علم الاجتماع في البلدان العربية دوراً أساسياً في توجه أهدافه وأسلوب دراسته للواقع وصياغة هويته الأكاديمية. حيث كان الواقع الذي ولد فيه علم الاجتماع في تلك البلدان هو واقع الاستعمار الأجنبي، الذي سعى إلى تقسيمها إلى مناطق نفوذ ودويلات سياسية استعمارية.
فضلاً عن سعيه الدؤوب إلى تحريك الصراعات وتعميق الانقسامات داخل كل دولة، مستغلاً في ذلك طبيعة أطرها الاجتماعية البنائية وتكويناتها الطائفية والاثنية والقبلية. وما يهمنا في ذلك أن الواقع الذي أنتج العلم والفكر السوسيولوجي في تلك البلدان اتسم بطابع الاستغلال والانتهازية وتغليب المصالح الفئوية الضيقة على حساب السود الأعظم للشعوب حتى في ظل مرحلة ما بعد الاستعمار.
كما استطاعت القوى الاستعمارية وتحالفاتها أن توظف البحوث والدراسات السوسيولوجية والانثروبولوجية لخدمة وتكريس مصالحها، حيث أوكلت تلك المهام للانثروبولوجيين المنضوين تحت لواء سلطتها لدراسة ثقافات الشعوب وكل ما يتعلق بذلك وفق رؤى إيديولوجية بامتياز بذلك أصبح البحث الاجتماعي في خدمة القوى الاستعمارية بشكل لم يسبق له مثيلاً في تاريخ العلوم الاجتماعية في تلك الفترة.
بل حتى الإداريون الذين كانوا يرسلون لإدارة المستعمرات كانوا يقومون بعض البحوث الاجتماعية ويجمعون معلومات دقيقة عن كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية في مستعمراتهم، مستخدمين في ذلك مناهج وطرق بحثية معروفة مثل المسح الاجتماعي، والمقابلة، والملاحظة بالمشاركة، والرصد الدقيق للبيئة، والتنبؤ بمواقف الأمطار والحصاد والآفات الزراعية، وأسعار المحاصيل وغير ذلك. بل لقد أصبحت سياسة راسخة للاستعمار البريطاني والفرنسي ألا يرسل إداري للمستعمرات إلا بعد أن ينال تدريباً وتأهيلاً في العلوم الاجتماعية مثل علم الاجتماع وعلم الانثروبولوجيا، وعلم اجتماع اللغوي، إلى غير ذلك من العلوم ذات الصلة والنتيجة أن هؤلاء الباحثين والإداريين قد أرسوا تقاليد بحثية كانت لها آثارها المهمة على مستقبل البحوث الاجتماعية حتى بعد مرحلة التحرر السياسي لتلك الدول، فأصبحت تلك المعلومات والدراسات مرجعاً أساسياً لا يستطيع باحث تجاهلها، بل وفي كثير من الجامعات والمعاهد شكلت تلك الدراسات والبحوث أهم مكونات المناهج التعليمية التي تدرس فيها، فأصبحت بمثابة ” نماذج إرشادية ” صبغت علم الاجتماع بصبغتها([4]). ومعنى ذلك أن الاستعمار استطاع خلال تلك الفترة تصمم وإخراج الكثير من الأطر التعليم والثقافية في معظم البلدان التي استعمرها من خلال بعض المؤسسات الأكاديمية والتربوية التي أوجدها في شكلها النظامي والحديث.
أما فيمرحلة ما بعد الاستقلال يمكننا القول إن علم الاجتماع المعاصر نشأ مع ولادة الدولة الوطنية في البلدان العربية وذلك بعد معركة طويلة خاضتها ضد الاستعمار الأجنبي- بتعدد أشكاله- طوال القرن التاسع عشر حتى نهاية النصف الأول من القرن العشرين. في هذا السياق انتقل الخطاب عن الواقع العربي من الخطاب النهضوي الذي نشأ أساساً في القرن التاسع عشر مع الرواد الأوائل للنهضة العربية إلى خطاب العلوم الاجتماعية الذي ستتبناه الدولة الوطنية([5]). فمن أسباب تخلف الأمة الإسلامية بشكل عام، أنها على قطيعة بتاريخها وأمجادها وبطولاتها وعظمائها وتراثها الثقافي والعلمي الذي يمتد لعدة قرون.
ومن هذا المنطلق يمكن أن نقول إن البلدان العربية لم تهتم بهذه العلوم على أنها علوم ناقدة ومحللة للمسألة الاجتماعية، وبالتالي يتم على قاعدتها تبني المشروع الاجتماعي الذي سوف ينطلق من الواقع لكي يتأسس عليه نظرة علمية، بل كان المشروع هو عملية إسقاط نماذج اجتماعية أجنبية على الواقع العربي والإسلامي يأتي علم الاجتماع لكي يبرر هذا الإسقاط([6]).
والدليل على ذلك أن الدولة كانت في حاجة إلى إيديولوجية تحدد ذاتها أكثر من علم يحلل ذاتها انطلاقاً من ذاتية المجتمع الذي تأسست عليه. لقد كان علم الاجتماع يدرس المجتمع كما أريد له أن يكون وليس كما ينبغي، فأصبح يدرس ظواهر افتراضية مفروضة عليه وليست عينية تعكس تطور المجتمع في حد ذاته. إنها محنة هذه العلوم التي انطلقت منذ البداية لخدمة خيارات سياسية مسبقة. وبالتالي لا يمكن فهم أزمتها بمعزل عن المتغيرات التي نشأت فيها.
بذلك نجد أن نشأة علم الاجتماع في البلدان العربية عرفت نوع من علاقة القطعية والوصل في الوقت نفسه. فعلاقة القطيعة تتمثل مع الفكر النهضوي الإسلامي الذي كان عليه أن يستأنف إشكاليته لكي يحولها إلى انشغال علمي تعيد طرحه العلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع أساساً وبالتالي يحصل التطور المنطقي في الفكر الذي عبر من خلاله عصر النهضة عن إشكاليته التي لم تكن بدرجة كبيرة من العلمية([7]).
وعلاقة الوصل مع الفكر الغربي الذي كان سائداً سواء من خلال النظريات التي أريد لها أن تكون أدوات لتحليل الواقع العربي والإسلامي لم تكن وليدة هذا الواقع، مع استمرار تأثير السوسيولوجية الاستعمارية التي كانت تدرس الواقع العربي والإسلامي من منظور يخدم غاياتها ومصالحها الدنيئة. فمن المسلم به إن لكل مجتمع خصوصياته السياسية، والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية، ولا يمكن فهم أي واقع اجتماعي إلا من خلال تصور شامل وعميق لهذا الواقع، وهذا ما ينطبق على الواقع الاجتماعي العربي والإسلامي الذي هو بحاجة إلى إنتاج قوالب نظرية تتيح للباحث السوسيولوجي العربي والإسلامي معرفة المشاكل المجتمعية وإيجاد الحلول لها. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسقط نظرية نابعة من واقع اجتماعي يختلف في الخصوصية الثقافية والسياسية والاجتماعية فضلاً عن الاختلاف في مراحل تطور هذا المجتمع، وهذا ما انتهجه الباحثون العرب والإسلاميون حيث اكتفوا بنقل التراث النظري الغربي وحاولوا به فهم واقعهم الاجتماعي والسياسي والثقافي.
فعلى سبيل المثال عندما يدرس الطالب الغربي علم الاجتماع فإنه بكل تأكيد يُعْنَى بالظواهر ذات العلاقة بالتاريخ والمجتمع في كل أشكالها وصورها التي تخص ذاته الجماعية، فيستقي نتاجه الفكري من الأدبيات الفلسفية والفكرية التي نتجت عن عصري النهضة والتنوير الأوروبي بصفة عامة، فالفرنسي والإيطالي والإنجليزي والألماني… يشعر كل واحد منهم أنه ينخرط في الإشكال المعرفية التي أنتجتها مجتمعاتهم في خضم عصر النهضة الذي شاركت فيه كل هذه الثقافات بحكم وحدة الإشكال التاريخية والمعرفية وحتى الدينية. وبالتالي نجد أن علم الاجتماع، الذي تبلور في القرن التاسع عشر- الذي يعتبر استجابة وإجابة لهذه الإشكالات – قد عبر عن الهم التاريخي لهذه المجتمعات في تجاوز أزمتها الثورية والدفع بالأوضاع تحت تأثير فكرة التقدم إلى الأمام.
بالمقابل لهذا الوضع نجد أن الطالب العربي عموماً في مجال العلوم الاجتماعية هو منفصلاً عن الفكر الذي أنتجه عصر النهضة العربية، حيث لا يجد هذا الطالب في أدبيات علم الاجتماع على غرار الفكر الغربي ما يمكن أن نسميه بسؤال النهضة في تكوينه الأكاديمي. إنه الاستلاب الفكري وغربة هذه العلوم ليس بحكم نظرياتها التي قد نستفيد منها إذا وعينا رهانات نهضتنا وثقافتنا، ولكن من حيث غربة المشتغل بهذه العلوم عن أفكار النهضة العربية على عكس ما حاصل في العالم الغربي([8]).
والدليل أن الرواد الأوائل لعلم الاجتماع في البلدان العربية صبوا كل اهتمامهم حول ترجمة أعمال رواد علم الاجتماع الغربي وحاولوا إبراز أهمية وقيمة هذا العلم وضرورة تدريسه لطلاب المعاهد والجامعات في العربية آنذاك. دون التفكير في محاولة جادة لوضع علم اجتماعي عربي إسلامي يبرز خصوصية تلك المجتمعات، ولم يكتفي هؤلاء الرواد بترجمة الفكر الاجتماعي الغربي، بل تأثروا أيضاً بالاتجاهات الفكرية السائدة آنذاك كالماركسية والوضعية.
لتأتي الدراسات السوسيولوجية الأكاديمية في العالم العربي والإسلامي كجزر متناثرة ومشتتة لا وصل بينها أو جسر يربط بعضها البعض، كما أنها تنعدم فيها العلاقة التكاملية والتواصلية، فكل مفكر أو عالم اجتماع يسبح لوحده منقطع عن غيره يدور حول نفسه. كما أن الدراسات الجادة لا تنخرط في عملية جماعية تشكل حقلاً معرفياً يؤدي إلى تراكم معرفي قد تنبثق عنه بناء نظرية سوسيولوجية عربية إسلامية تمثل ثمرة هذا الجهد المتكامل في شكل جماعي كمحاولة جادة للخروج بعلم اجتماع عربي إسلامي يضاهي نظيره الغربي. أما عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات والأصوات المتعالية من داخلها لا تصنع علماً ولا توقظ ضميراً.
ومن الجدير بالذكر أن الفترة التي نالت بها تلك البلدان استقلالها عن الاستعمار الغربي البغيض تبلغ أكثر من خمسين سنة، حيث تعتبر فترة زمنية كافية لكي تخوض فيها تلك البلدان تجربتها في صياغة علم اجتماع عربي، فإذا كان اللوم على الرواد الأوائل الذين لم تكن لديهم أي محاولات لإنتاج نظرية عربية ذات طابع إسلامي، بالإضافة إلى تأثرهم بالفلسفات الوضعية والتوجهات الماركسية التي تتنافى مع خصائصنا الدينية والاجتماعية والثقافية، فإن اللوم الآن مُلقى على جميع المشتغلين بالبحوث والدراسات السوسيولوجية لتقصيرهم في صياغة نظرية اجتماعية نابعة من صميم الواقع الاجتماعي والثقافي لتلك البلدان. لكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا كيف لعلم ولد وترعرع في بيئة غربية بحتة، لها ثقافتها وعاداتها وطرق عيشها وحتى مشاكلها الخاصة أن يطبق بحذافيره على مجتمعاتنا العربية دون تمحيص وتدقيق؟([9])
لذا؛ نرى أن المهمة الأساسية لعلم الاجتماع العربي في وقتنا الراهن هي القيام بعمل حاسم ضمن مساقين: (أول) تفكيك المفاهيم التي ظهرت من المعرفة السوسيولوجية وخطاب أولئك الذين تحدثوا نيابة عن العالم العربي، التي تتسم في الغالب بالإيديولوجيا المركزية – الاثنية – الغربية. (الثاني) نقد المعرفة السوسيولوجية والخطاب حول المجتمعات العربية الذي ينتجه العرب أنفسهم([10]). فيما يتعلق بالمساق الأول من الممكن الاستفادة في ذلك من التراث الأوروبي الذي وإن كان ذلك يتطلب فحصاً للمفاهيم وكشفاً لعلاقاتها الصريحة والضمنية مع إيديولوجيتهم وبالتالي مدى اتساق ذلك مع إيديولوجيتنا السائدة([11]).
بالإضافة إلى ذلك إيجاد حل لإشكالية غياب المداخل المنهجية والنظرية التي سوف نعتمد عليها في دراسة الواقع الاجتماعي للبلدان العربية. وما نقصده نقصد بالمداخل النظرية مجموعة من القضايا الفكرية، التي تتداخل مع بعضها البعض منطقياً، بغية تكوين النسق النظري لها، الذي يتم من خلاله تحليل وتفسير ونقد الواقع الاجتماعي. بمعنى آخر يمكن القول بأنها كيان نظري له مبادئه وقضاياه الرئيسية التي توجب على أي بحث علمي مستنداً إلى هذا الكيان أن يشتق فروضه الرئيسية منه، ثم بعد ذلك استخدم المقولات الرئيسية للكيان النظري في عمليات أخرى: كالوصف والتحليل والتفسير والتنبؤ. ويمكن القول أيضاً إن المداخل النظرية تتشكل من مقولات وقضايا نظرية بناءً عليها يتم إدراك الواقع الاجتماعي من خلال إعطاء تصورات متباينة وتنظيماً محدداً لمتغيراته وطبيعة واتجاه التفاعل بين هذه المتغيرات([12]).
أما مفهوم المداخل المنهجية فيمكن القول بأنها أقل تجريداً من المستوى السابق الذي يتعلق بالمبادئ الأساسية للمداخل النظرية في علم الاجتماع، فالأسس المنهجية تتعلق بطبيعة الحال بالمداخل المنهجية التي تمثل زاوية الاقتراب من قضية البحث موضوع الدراسة، وعليه يمكن القول إن المدخل المنهجي أكثر ارتباطاً ببناء النظرية لأن المقولات النظرية هي التي تفرض هذا المدخل أو ذاك. وبالمقابل فإن المدخل المنهجي بدوره هو الذي يحدد مناهج وطرائق البحث المناسبة في هذا البحث أو تلك القضية([13]).
بناءً على ما تقدم نجد أن معظم دراسات وأبحاث علم الاجتماع في البلدان العربية تتصف بالفقر الابستمولوجي والنظري والمنهجي. صحيح أن المناهج البحثية عالمية بما أنها تستند إلى جوهر خطوات المنهج العلمي، لكن بطبيعة الحالة مضامينها محلية وثقافية واجتماعية. فمن يقرأ دوركايم، ماركس، وفيبر، وغيرهم يقرأ التاريخ الاجتماعي والأوروبي والثقافة الأوروبية لأن علم الاجتماع بنظريات ومناهجه رغم اختلافه جاءت استجابة للواقع الغربي بكل ملامحه وتجلياته. ولهذا لا يتطور الفكر الاجتماعي إلا في سياق تاريخي واجتماعي محدد. وهنا يجب أن نشير أن إنتاج المعرفة لا يتولد إلا داخل فضاء فكري منفتح، أما الفضاء الفكري المنغلق فإنه عقيق لا يتفاعل مع مجتمعه. وهذا يعني أن الثقافة العربية ثقافة مغلقة متخلفة عن زمانها وعصرها، أما الثقافة المنفتحة فهي بنت زمانها. لهذا لم يفرز الفضاء الفكري العربي نظريات ومناهج تعبّر عن واقع مجتمعاتنا وتتوافق مع خصوصيتنا، كما توافقت النظريات والمناهج في علم الاجتماع الغربي مع منطلقات الواقع الأوروبي ومفرزاته([14]).
وفيما يتعلق بإشكالية علماء الاجتماع العرب ومسؤوليتهم الأخلاقية والعلمية، فمن المعلوم أن النظريات والمناهج الاجتماعية طورها علماء وهبوا أنفسهم للعلم، وقد فهم هؤلاء العلم رسالة ومسؤولية، رسالة لفهم الكون وتفسيره والحفاظ عليه، ومن ثم فإن للمناهج بعد قيمي وأخلاقي وإنساني، وهذا تأخذه عن الثقافة. وقيم المفكرون تجسدها مناهجهم، وهذا ما تعبر عنه علاقة المنهج بالإيديولوجيا، وبإنتاج المعرفة والفكر مرتبطتين بطريقة رؤيتنا للكون. فعلى سبيل المثال، فإن المنهج الفيبري، أو المنهج التاريخي الاجتماعي المطبق على دراسته (الأخلاق البروتستانتية والروح الرأسمالية)، يرى أن حركة الإصلاح البروتستانتية، هي التي أسست الحضارة الغربية، فهو يقرأ تقدم المجتمعات وتخلفها من خلال حركة الإصلاح البروتستانتي. كما نجد إيديولوجيا ماركس قائمة في منهجه، وكذلك إيديولوجيا فيبر وبارسونز…. إلخ، والإيديولوجيا فكر وقيم سياسية وثقافية ومعرفية. ولا نجد عالماً ذا مدرسة دون هذا البعد الإيديولوجي، والعلوم الاجتماعية كلها ليست بعيدة عن الإيديولوجيا، والإيديولوجيات هي الرؤى المتعددة للكون، وإن هذه الرؤى المختلفة هي التي تكون النظريات والمدارس، فتبرز المدراس الفكرية بقدر ما يوجد من اتجاهات نظرية([15]).
نستخلص مما سبق أن مدراس علم الاجتماع طورها مفكرون وعلماء أصحاب رؤى اجتماعية. وهذه الرؤية تسعى إلى تطوير الواقع الاجتماعي لأنها قائمة على المنهج والنظرية. فالبعد الإيديولوجي، أو الحكم القيمي هو أساس التنظير ولما غاب التنظير عن علم الاجتماع العربي، فقد غابت عنه المدارس والاتجاهات الفكرية المفسرة للمجتمع، ذلك أن التنظر ليس عملية خارج المجتمع والتاريخ، وإنما يتم في سياق ثقافي ومجتمعي وتاريخي معين. وما سردناه عن النظريات السوسيولوجية ينطبق على المناهج وطرائق البحث الاجتماعي، فهذه تمثل جانب الضعف في علم الاجتماع وهي مرتبطة بالنظريات فلا يقوم التنظير دون منهج، ولذلك نلاحظ أن غياب الاتجاهات والمدارس عندنا، إنما يعود إلى ضعف الانتماء النظري والمنهجي([16]).
يؤكد العرض والتحليل السابق أن أزمة العلوم الاجتماعية في العالم العربي ناتجة عن ظروف مجتمعية وشروط موضوعية أفرزها موقف الدولة السلبي تجاه تلك العلوم، ونظرة المجتمع الدونية إليها، وعدم رغبة معظم الطلبة النابهين في التخصص في مجالاتها المتعددة، لكن هذا الرصيد السلبي المتراكم لا ينفي وجود بعض المحاولات الهادفة لتوطين تلك العلوم الاجتماعية في بيئاتها العربية والإسلامية، ونذكر على سبيل المثال محاولات توطين علم الاجتماع في البيئة العربية، وتجربة أسلمة علم التاريخ باعتبارهما من المحاولات الجديرة بالمراجعة والتقييم في إطار عرضنا للتحديات التي تواجه العلوم الاجتماعية في الوطن العربي والعالم الإسلامي([17]).
بدأت المحاولات لتوطين علم اجتماع عربي بكتابات عالم الاجتماع العراقي علي الوردي التي استند فيها إلى خصوصية البيئة العربية والتراث النظري لابن خلدون، ويذكر الوردي في هذا الاتجاه أننا لو ألقينا نظرة على خارطة الكرة الأرضية، لوجدنا المنطقة العربية، هي المنطقة الوحيدة التي تمتد من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، إنها تتميز عن غيرها من مناطق العالم بكونها أكبر امتداد صحراوي على وجه الكرة الأرضية، ومعنى هذا أنها أكبر منبع للبداوة في العالم كله، لكن النظريات الاجتماعية التي ظهرت في الغرب لا تولي أي اهتمام للبداوة، ولا غرابة في ذلك، لأن علماء الغرب لا يجدون أي أثر للبداوة في مجتمعهم، وهذا هو الذي يدعونا إلى دراسة مجتمعنا في ضوء منهج خاص بنا، يختلف في بعض الوجوه عن علم الاجتماع الغربي. ولتأسيس إطار (نظري للمنهج) الذي ينشده يقول الوردي آن الأوان لكي نرجع إلى الأساس الذي وضعه ابن خلدون لعلم الاجتماع، والذي أهملناه طويلاً، فنزيل عنه تراب الزمن نلقحه بما ظهر مؤخراً من نظريات ومفاهيم اجتماعية جديدة وبهذا نتمكن من بناء علم اجتماع خاص بنا يلائم المجتمع الذي نعيش فيه. وبهذه الكيفية فتح الوردي الباب واسعاً للعديد من الندوات والدراسات التي انتقدت مخرجات البحث الاجتماعي في البلدان العربية، وأرجعت إخفاقات الباحثين الاجتماعيين في تأسيس علم اجتماع عربي إلى أزمة ثلاثية مركبة، قوامها أزمة الإطار النظري الاجتماعي، وأزمة المنهج العلمي وأدواته البحثية، وأزمة العلاقة التبادلية مع المجتمع([18]).
وفي النهاية نقول إن أزمات ومشاكل علم الاجتماع العربي الراهن كثيرة، ولا مجال من حلها ومناقشتها جمعياً، إلا أنه يجب علينا التسليم بكل الأحوال بأهمية هذا العلم الذي يمثل في جوانب مختلفة فكر وفلسفة ونقد اجتماعي، فالمجتمعات المتقدمة، تقدمت بأفكارها ومعرفة أخطأها بالتوازي مع التقدم المادي. وهذا ما يجب أن يحدث في المجتمعات العربية من خلال تفعيل دور لعلم الاجتماع العربي الذي سيكون استجابة حقيقة لواقعنا وخصوصيتنا الثقافية والاجتماعية.
لذا؛ يحتاج الأكاديميون والباحثون السوسيولوجيون في العالم العربي إلى تقديم قراءة نقدية وواعية ومواكبة للمرجعيات النظرية المستخدمة على الصعيد العالمي لدراسة الظواهر الاجتماعية والوقائع التاريخية، وتحديد أسس النظرية والمنهجية التي انبثقت منها، وطبيعة المجتمعات التي نشأت وتطورت فيها، وربما تمكن مثل هذه القراءة الواعية والنقدية في حقل العلوم الاجتماعية من دراسة وتقويم المرجعيات النظرية الناظمة للعلوم الاجتماعية في العالم، لمعرفة مرتكزاتها الثابتة وعناصرها المتغيرة حسب ظروف الزمان والمكان ليبدأ حوار جاد ومثمر من أجل وضع بعض المرجعيات النظرية العربية والمفاهيم المستمدة من واقع المجتمعات العربية وتراثها المعرفي، ثم يجب علينا السعي إلى تغيير النظرة المجتمعية والسياسية السالبة تجاه العلوم الاجتماعية ودورها الفاعل في دراسة وتحليل وتفسير واقع مجتمعاتنا العربية.
إن مستقبل علم الاجتماع، إن كان له مستقبل، سيكون في الثورة على السلطة، أي سلطة، وفي الحد الأدنى إزعاجها بالنقد وكشف آليات الهيمنة التي غالباً ما تلجأ إليها لدوام تسلطها. ومن أنواع السلطة التي يفترض أن نثور عليها تلك المعارف المحافظة التي تأبى التغيير لما صاحبها من أرثوذكسية حولها في رؤوسنا، وقد يصعب الانقلاب عليها دونما سوسيولوجيا ثائرة ومناضلة ضد السائد والمألوف، وما هو متفق عليه، ومن دون ذلك سيطول مكوث هذا السائد فينا وبيننا، الأمر الذي يجعل من الرؤية النقدية لأدواتنا المعرفية أمراً ملحاً، شرط أن نكف عن اعتبار الناقد عدواً، ما دام يمتلك عناصر البرهنة على ما يعتبره نقداً. ولعل أفضل طريقة لتقدير باحث وما أنتجه من بحث هي محاولة البرهنة على ما فيه من تقصير علمي بوضع أسئلة جديدة غير الأسئلة الموضوعة. والأسئلة الجيدة أفضل من الإجابات الجيدة([19]).
وقد يكون المستقبل لهذه السوسيولوجيا التي تستهدف المألوف، فتحرج أهله، في خلق حيوية جديدة، كشفاً للقدرات الداخلية الهادئة للمجتمع وهو يفعل في ذاته، على رأي ألان توران، ليستجيب إلى حاجته في التحول. ولكن هذا مشروط بحياد الباحث الذي، رغم اقترابه من الفاعل الاجتماعي، عليه ألا يتحول هو أيضاً إلى فاعل اجتماعي، وإلا أصبح عمله ضرباً من الالتزام الإيديولوجي، وشكلاً من أشكال الممارسة السياسية. وقد يبدو واقعنا السياسي اليوم أكثر إيثاراً لدور رجل السياسة على مهنة عالم الاجتماع. وهنا يصبح التذكير ضرورياً بأن علم الاجتماع يمثل جهداً دؤوباً ضد كل أشكال التسلط التي تحكم واقع العلاقات الاجتماعية الظاهرة منها والخفية. ولعل هذا مدخل من مداخل المستقبل إلى هذه المعرفة([20]). ونأمل في المستقبل القريب أن يكون لدينا علم اجتماع نقدي فاعل في جامعاتنا العربية يدافع عن وجودنا وحقوقنا ويحل المشكلات التي تعترض تطورنا وتقدمنا نحو مجتمع إنساني أفضل. وفيما يتعلق بوضع الجامعات العربية تبقى مؤسسة الجامعة في سياقها العربي ما يجب أن ننجزه، وليس ما أنجزناه. باعتبارها مشروعاً لم ينجز بعد على حد تعبير هابرماس في مشروع الحداثة، وهذا القول ينطبق أيضاً على معظم جامعاتنا العربية.
([1]) أبو بكر أحمد باقادر، عبد القادر عرابي: آفاق علم اجتماع عربي معاصر، دار الفكر، دمشق، ط1، 2006، ص(181).
([2]) المرجع السابق نفسه، ص(181-182).
([3]) عبد الباسط عبد المعطي: اتجاهات نقدية في علم الاجتماع، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد: 44، شهر أغسطس (آب)، 1981، ص(169).
([4]) مجموعة مؤلفين: ندوة علم الاجتماع من منظور إسلامي، رواق المعرفة، القاهرة، ط1، 2007، ص(13- 14).
([5]) يوسف حنطابلي: إشكالية السؤال السوسيولوجي في الفكر العربي (الواقع العربي بين الماضي وحاضر الأخر – دراسة تحليلية نقدية)، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة يوسف بن خدة، 2007/2008، ص(70).
([6]) المرجع السابق نفسه، ص(70).
([7]) المرجع السابق نفسه، ص(71-72).
([8]) المرجع السابق نفسه، ص(72).
([9]) جميلة شلغوم: واقع السوسيولوجيا في الجزائر في ظل الحداثة وما بعد الحداثة، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم العلوم الاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 2012/2013، ص(69).
([10]) مجموعة مؤلفين: مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، تحرير وتقديم: ساري حنفي ومصطفى مجاهدي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2014، ص(29).
([11]) مجموعة مؤلفين: نحو علم الاجتماع عربي – علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 1989، ص(38).
([12]) حسام الدين فياض: المدخل إلى علم الاجتماع (من مرحلة تأصيل المفاهيم إلى مرحلة التأسيس)، سلسلة نحو علم اجتماع تنويري، الكتاب الثاني، الجزء الأول، مكتبة الأسرة العربية، إسطنبول، ط1، 2021، ص(359).
([13]) المرجع السابق نفسه، ص(359-360).
([14]) أبو بكر أحمد باقادر، عبد القادر عرابي: آفاق علم اجتماع عربي معاصر، مرجع سبق ذكره، ص(157).
([15]) المرجع السابق نفسه، ص(158).
([16]) المرجع السابق نفسه، ص(159).
([17]) أحمد أبو شوك وآخرون: أزمة العلوم الاجتماعية (المظاهر والآفاق)، مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، قطر، ط1، 2021، ص(33).
([18]) المرجع السابق نفسه، ص(34-35).
([19]) مجموعة مؤلفين: مستقبل العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، مرجع سبق ذكره، ص(24).
([20]) المرجع السابق نفسه، ص(24-25).
_______
*د. حسام الدين فياض/ الأستاذ المساعد في النظرية الاجتماعية المعاصرة/قسم علم الاجتماع كلية الآداب في جامعة ماردين- حلب سابقاً.