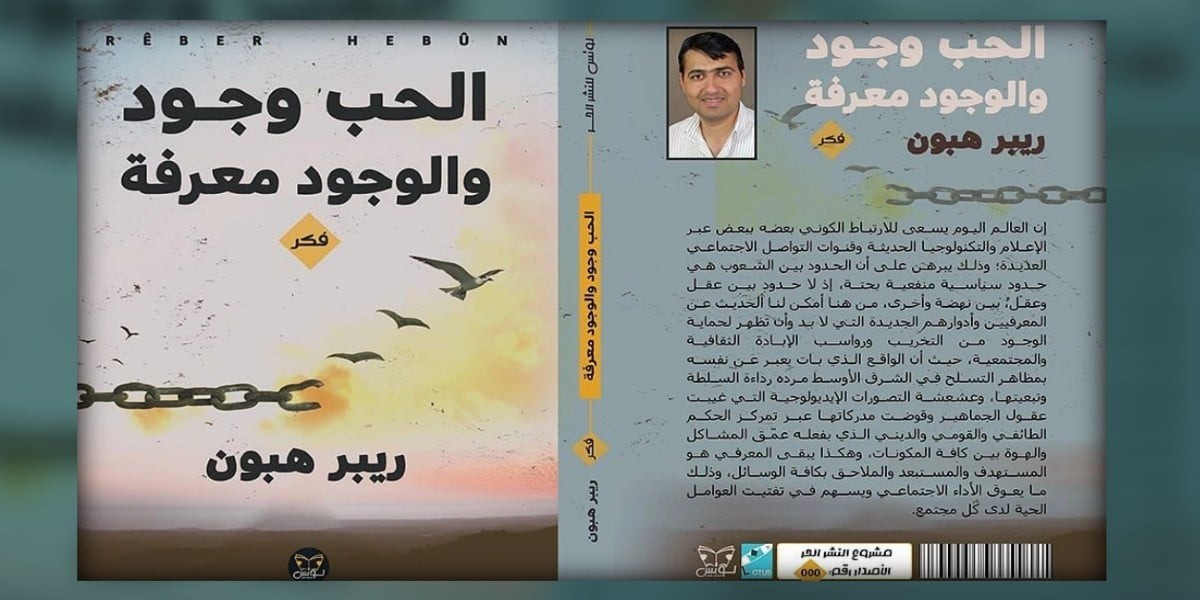النبي إبراهيم وثالوث الوجود الأنطولوجي

انطلاقاً من النص القرآني في وَضع الأُسُس التحليليّة لأُطروحة ]النَبيُّ إبراهيم وثالوث الوجود الانطولوجي[ ومعاينة الآيات التي تتَّخذ من النَبيُّ إبراهيم طرحاً لها، بما يمثِّله هو-النَبيُّ إبراهيم- من تجليات للنفس البشريّة إزاء أبعادها الوجوديّة من السجالات الحاصلة بينه وبين إلاله وبينه وبين قومه، في حيِّز وجوده الزمانيّ والمكانيّ. وبما تمثِّله الذات الإبراهيميّة من اعتلاءٍ انطولوجي إزاء الإنسانيّة والهدف الأسمى الذي تفني حياتها من أجله، والتي تتجلَّى في أسمى آيات خلق الهشاشة الإنسانية “الكَبَد”.
قبل الخوض في السجالات الحاصلة مع النَبي إبراهيم في مستوييّ الوجود البشري الأفقي والعمودي، وبما تمثّله الإله في المستوى العمودي، وفي الإنسان بما يمثّله في المستوى الأفقي والداخلي للذات البشريّة، وبوتقة السجال الحاصلة في زمانيَّته ومكانيَّته بما يمثّله في الكون. فإن هذه السجالات ناتجة عن تمخّض الذات الإبراهيميّة واعتلالاتها إزاء التفكير والتفكّر في وجوده المادِّي والروحي والعقلي، ابتداءً من صُغريات هذا الكون وانتهاءً بكبرياته –الآله- والعلاقات المتشابكة والمحمومة التي يمكن ممارستها في ثنايا الذات الإنسانيّة ناحية الموجودات بتمظهراتها الفيزيقيّة والميتافيزيقيّة والعمل على هدم وبناء هذه الرؤى من وإلى، كلّ حسب شروطه الزمانيَّة والمكانيَّة.
ففي اعتلاله الفردي، فإنه يبحث ويعمل على إيجاد ارتكان لمتعالي ماورائي يعينه على وجوده في البُعدين المادِّي والروحي، ومن المثير للإعجاب الإعمال العقلي المُضني في محاولته لسبر غور طبيعة الوجود المادّيَّة والعبور من خلالها إلى ما هو غير هَوَوي غير مرئي ميتافيزيقي، ابتداءً من سؤال “كيف يتموضع ما هو مادّي معرَّض للتهشُّم أن يتربَّع على عرش الآلهة ويعبد؟” في محاولة لفهم وتخفيف معاناته الأنطولوجيّة وأيضاً في تبيان قصور تلك “الإلهة” على الإعانة من الاعتلالات التي رافقت النَبي إبراهيم، فطبيعة “الإله” المادّيّة –الألوهة الموجبة- كانت تنبئ الذات الإبراهيميّة على دونيتها نظراً لارتباطها الوجودي ضمن حيِّز المادة، وتحتاج إلى من يشكّل هذه “الآلهة” في إطارها المادِّي، ومن ثمّ استحضار المخيِّلة الشعبيَّة وإعطاؤها طابعاً ميثيولوجيا لتوحي لعابديها وتحيط نفسها بهالة من القداسة والرهبة. فالمُكابدة الذاتيَّة التي طالت إبراهيم في رحلته إلى الماورائيات كانت ناتجة عن تحطيم “الوثنية الفكرية” في بنيانها التأسيسيّ ومن ثم محاولة وضع أساسٍ لأفهوم إيمانيّ قابل لعمليَّة موت وبعث ذاتية كلّ حسب زمانيَّته ومكانيَّته ومكوّنه الفكري والتطلّع الروحي الذي تناشده كُلّ ذات باحثة عن أسمى معاني الحياة.
من هنا ومن شرطٍ وجودي لازم، فإنَّ انتقاله إلى إحدى كُبريات السجال الإنسانيّ-الإلهيّ حين قرَّر الاستكانة إلى ما هو أجدر برؤيته الإيمانية، كان كُلاً منهما يُخضع الآخر إلى نوع من المنظومة البُرهانيّة، فالمنظومة البرهانيّة لمفهوم القُدرة كانت من إبراهيم ناحية “الإله”، حين أخرج إبراهيم “الإله” عن صمته بإثبات قدرته على الخلق والتشكيل المادّي وبثّ الروح فيها، أي التحكُّم بكل ما هو مادّي فاني، فالحالة التأمليَّة التي استعرت النَبيُّ إبراهيم في ثنايا هذا الكون هي الأساس الإيماني الفكري وحالة الشك إزاء المُقدّمات الإيمانية التي وجد عليها آباءه يعملون بها، كانت دافِعَهُ للخوض في غمار البحث الإيماني العميق حتى وإن كانت غير مفهومة أو مرغوبة من قارئ الآيات الواردة في المتن القرآني. والمنظومة البرهانيّة لمفهوم الإيمان كانت من “الإله” ناحية إبراهيم، حين اختبر “الإله” إيمانه كما ورد في النصّ القراني من مآلات السجال بين إبراهيم وقومه. في كِلا المَنظومَتين البُرهانِيَّتين دليلٌ على اختبار أحقية كُلٍّ منهما فيما اختاره، فالمنظومة البرهانيّة الأولى –من إبراهيم ناحية “الإله”- كانت نتاج استحقاق إلهي وعدم تبديد الزمن البحثي الذي أمضاه إبراهيم في خُطى بحثه عن متعالٍ كامل ومقتدر يمثِّل الرؤى الإبراهيميّة للذات الإيمانيّة، والمنظومة البرهانيَّة الثانية – من “الإله” ناحية إبراهيم- كانت نتيجة استحقاق إيماني نحو الذات الإبراهيميّة، ولتعينه في دعواه –كما سنرى لاحقاً- على المشاق النفسيّة والجسديّة التي طالت النَبي إبراهيم جراء ما يدعو به قومه.
في خطابيّة النَبيُّ إبراهيم مع بني قومه، اعتمد في بادئ الأمر على قوَّة المنطق العقلي رغم بساطة تركيبها وتنظيمها الحِجاجي كما تُصوّره السرديّة القرآنيّة، إلا أنَّها كانت ذا فعالية في تبيان أي “الألوهة” المُستحقّة للعبادة، “الآلهة” التي تعي لما وما سيكون؟ أم “الآلهة” التي لا تعي لما وما سيكون؟ ومن هذه الانطلاقة المنطقيّة والعقليّة، كان النَبيُّ إبراهيم يؤسِّس لاعتقاد ديني أساسه العقل والوعي من ماديات الوجود الفاني إلى المُبتغى الروحي الخالد، ولعلنا نلتمس في السجاليّة الحاصلة مع قومه ومن اعتلاله الذاتي -كما ذكرته آنفاً- إنّ جمال رحلة العقل والتعقُّل للموجودات والماورائيات هي التي تستحقّ أن يفني المرء الحياة في سبيلها ما استطاع، فالمعول المادِّي الذي بدأ بتحطيم تلك الأوثان – من الجدير بالذكر أنها أوثان فكريّة قبل أن تكون مادية إلهيّة – كانت معول الرشاد الفكري وذروة الاعتلال الانطولوجي في الاتِّصال مع الذاتيّة الإلهيّة.
أثناء خضم خطاب النَبي إبراهيم مع قومه، تتجلَّى لقارئ السيرة الإبراهيميّة كما أوردها النص القرآني صورتين من المِحن التي تعتري الذات الإنسانيّة على المستويين النفسي والجسدي في تكوين الذات الفاعلة عقلياً وروحياً أو حسب رؤية الفيلسوف نيتشه “الإنسان الأعلى ” أو “الإنسان الكامل” حسب رؤية ابن عربي، ففي المحنة النفسيّة، تتَّقد المظالم التي تنشئ عن طرح الأفكار المغايرة لما هو متعارف عليه، والتي تعمل على خروج الشخص من ظلمات العقلية الوثنية إلى نور الإيمان العقلي الرحب، وهو برسم –ههنا- النَبيّ إبراهيم في مبتدأ الأمر ثم الأقوام التي دعاها للإيمان برؤيته “الحقّة” ثم الانتهاء بكل الذوات الكامنة في حالة من السكون الوجودي لتصبح ذوات فاعلة، لما تحدثه من عملية رفض فجة دون العودة إلى الأسس العقلية والمنطقية، وأيضاً إلى الاتّهامات والتشويهات التي توجه إلى الذات الفاعلة، وفي المحنة الجسديّة، يختبر النَبيُّ إبراهيم أنواعاً أخرى من الاعتلالات الجسديّة ولعلَّ أسماها يكون في حادثة “الحرق وهو حي” فتلك الألسُن من النيران الحارقة تحوَّلت بحال من الأحوال إلى “ألسُن” فاعلة في تكوين ونحت وتثبيت “الإيمان” الإبراهيمي للمتعالي، كما أوردتها الميثيولوجيا القرآنية، وفيها صورة من الشقاء الجسدي الذي على المرء اياً كانت زمانيّته ومكانيّته أن يتعرض لها في سبيل الإيمان بفكرة أو بنحت تصوّر جديد من الأفكار. ففي كلا المحنتين النفسيَّة والجسديَّة التي تعرَّض لها إبراهيم من بني قومه هي مناط للانسانيّة بما تحمل على عاتقها من مسيرة البناء الفكري والحضاري في حيز هذا الكون الرحب وليس على الأرض وحدها.
تمثِّل الصيرورة في قصَّة النَبي إبراهيم -رغم افتقارها إلى سرديّة واحدة- دورة حياة الإنسانيّة لما تحدثه من خَلجات ودفقات إزاء المفاهيم الفيزيقيّة والميتافيزيقيّة، وما تُحدثه من مشاجبات قد يكون بعضها إيجابياً قائماً على العقل والتحليل وهي مناط الإنسانيّة البناءة، وبعضها الآخر يقوم على هدم الأفكار بكافة الأساليب المتاحة لتصل إلى حدِّ هدر الأرواح خوفاً من التغيير الذي سوف تحدثه هذه التأمّلات والتبصّرات في البنية الاجتماعيّة والمعرفيّة التي ترافق هذا الصرح العظيم من الذوات البناءة.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.