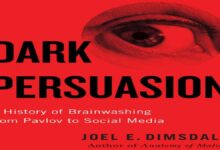قبل الشروع في الحديث عن أزمة علم الاجتماع في البلدان العربية والإسلامية سنحاول أولاً الوقوف على مظاهر ومؤشرات أزمة العلوم الاجتماعية في تلك البلدان، لأنها تشكل مدخلاً أولياً لفهم طبيعة أزمة علم الاجتماع باعتباره الجزء الأهم فيها.
تعتبر أزمة العلوم الاجتماعية في البلدان النامية جزءاً لا يتجزأ من الأزمة الحضارية الكلية التي تعاني منها تلك البلدان قبل أي شيء آخر. فالعلوم الاجتماعية تمثل امتداداً للوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المتدهور على المستوى العام والخاص على حد السواء. فلا يمكن تصور وجود علوم اجتماعية متطورة ومتقدمة، في ظل سيطرة متغيرات وعوامل التخلف الحضاري والمادي على الواقع الاجتماعي. ولكن قبل الحديث عن أزمة العلوم الاجتماعية، سنحاول تقديم تعريف مبسط عن مفهوم العلوم الاجتماعية لإعطاء القارئ فكرة عن ماهية تلك العلوم موضوعها، مجالات تخصصها.
– العلوم الاجتماعية: هي ذلك الحقل المعرفي الذي ” يهتم بدراسة الإنسان في تفاعلاته الاجتماعية على مختلف الأصعدة في علاقته مع إنسان آخر أو جماعة أو مؤسسة أو دولة، أو حتى في تعامله مع موارده المادية لأجل صياغة أطر تفسيرية عامة ومجردة تمكننا من الفهم والتنبؤ والتحكم والتوجيه والتكيف “. وحسب قاموس العلوم الاجتماعية، فإن العلوم الإنسانية والاجتماعية هي ” مجموع العلوم التي تدرس الإنسان داخل المجتمع، بحيث لا يمكن تصور إنساناً لوحده ولا مجتمع من دون بشر “. فالإنسان مدني بطبعه لا بد له من الاجتماع وهو معنى العمران البشري كما يقول العلامة ابن خلدون.
ويرى عاطف غيث أن مصطلح العلوم الاجتماعية يطلق على أي نوع من الدراسة التي تهتم بالإنسان والمجتمع، إلا أن المصطلح يشير بمعناه الدقيق أو الضيق إلى تطبيق المناهج العلمية لدراسة شبكة العلاقات الاجتماعية المعقدة وصور التنظيم التي تمكن الأفراد من العيش معاً في المجتمع.
وفي النهاية يمكننا القول هي فرع من فروع العلم الذي يهتم ويضطلع بدراسة وتحليل وتفسير ونقد كل من المجتمع والسلوك الإنساني بالاعتماد على النظريات السوسيولوجية ( البنائية والتأويلية ) ومناهج وطرائق البحث الاجتماعي.
ويعتبر هذا العلم أحد العلوم التي طورتها الحضارة الإنسانية الحديثة في مطلع القرن العشرين المنصرم. وتهتم هذه العلوم بدراسة العلاقات الإنسانية، حيث تطمح العلوم الاجتماعية إلى فهم العالم الاجتماعي أو (الإنساني) وكشف طبيعة بعض العلاقات الاجتماعية بواسطة الملاحظة والقياس المستمرين. وتنقسم العلوم الاجتماعية بدورها إلى “علم الاجتماع العام والانثروبولوجيا بفروعها المختلفة“.
وفي هذا السياق سنسعى إلى مناقشة أزمة العلوم الاجتماعية والواقع المتردي الذي وصلت إليه بسبب هيمنة حالة التخلف والسكون والجمود على معظم سياقات الدول النامية، مما انعكس سلباً على تكوينها المعرفي وأدائها لدورها الأكاديمي والعملي في تلك الدول، ويتضح لنا ذلك من خلال رصد وتوصيف المؤشرات التالية:
1 – على الصعيد الاقتصادي: لم تنجح الكثير من الدول العربية والإسلامية الغنية مالياً (على سبيل المثال) في بناء قاعدة حقيقية للتنمية الصناعية والتكنولوجية والزراعية. ورغم محاولات البعض منها البدء في ذلك، لكنها ما زالت محاولات محدودة لا تتناسب مع حجم الثروات المالية الموجودة. فاللافت للنظر هنا، أن مسيرة تلك المجتمعات، رغم ادعاء الكثير منها بغير ذلك، كانت ومازالت تتم في كنف الدول الكبرى، ومن خلال توجهاتها، وأطرها المعروضة والمفروضة في الوقت ذاته، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً، وهو الأمر الذي انعكس بدرجة كبيرة على نشأة ونمو وتطور العلوم الاجتماعية في المجتمعات النامية.
2- على الصعيد التنموي: فكما لهثت الحكومات وراء القوى الكبرى، لهثت العلوم الاجتماعية في المجتمعات النامية، وراء ما تلهث وراءه حكوماتها. لذلك جاءت هذه العلوم مصحوبة بأزمة التقليد والمحاكاة لما تُطلقه الجامعات ومراكز البحوث الغربية. وكما استوردت الحكومات أطراً ومشروعات تنموية غير صالحة لطبيعة المجتمعات النامية، استوردت العلوم الاجتماعية، وهذا أشد خطورة مما قامت به تلك الحكومات، أطراً فكرية متعارضة مع طبيعة العقليات والبنيات الاجتماعية في البلدان النامية.
ومما زاد من حجم الكارثة، هو تلك الأخطاء التطبيقية الهائلة التي قامت بها الحكومات في المجتمعات النامية في نقل تجارب التنمية الغربية. فمن خلال عملية النقل السريعة، والرغبة في إيجاد منتج خاص بالعلوم الاجتماعية العربية والإسلامية، أصبحت ملاحقة ما تنتجه العقلية الغربية هي الهدف في حد ذاته، بغض النظر عما يتطلبه الواقع المحلي من ناحية، وبغض النظر عن استيعاب هذه المنتجات الغربية وفهم الأطر الزمنية والاجتماعية والفلسفية التي ظهرت من خلالها من ناحية أخرى.
خلقت هذه المحاولات المرتبطة بالسياق الغربي، سواء من موقف تابع أو من موقف نقدي، محاولات مضادة من أجل البحث عن أطر مجتمعية محلية بما يعرف بأسلمة المعرفة. ورغم صدق نوايا بعض هذه المحاولات إلا أنها لم تقدم ما يُعتد به من ناحية تقديم نظريات ومنهجيات جديدة وجادة لدراسة المجتمعات الإسلامية، بقدر ما تحولت مشروعاتها إلى اقتباسات عديدة وكثيرة للآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة.
3- على الصعيد الثقافي: في حقيقة الأمر لا تساعد بنية الثقافة التقليدية لتلك المجتمعات على عمل وتطور العلوم الاجتماعية، التي تحتاج إلى مناخ مواتي من الحرية والجدل والتسامح. فالثقافة العربية المعاصرة على سبيل المثال تتسم بمجموعة من السمات المُعطلة لعمل العلوم الاجتماعية. فهي ثقافة راكدة ومُتجذرة بنيوياً تستقي عناصر بقائها من طول حالة الاستبداد السياسي وهيمنة دولة ما بعد الاستقلال من ناحية، ومن حالة الضعف الاقتصادي والحضاري التي تشهدها المجتمعات العربية منذ عقود طويلة من ناحية أخرى.
ويمكن إجمال مجموعة من السمات التي تتميز بها الثقافة العربية، والتي تقف بالسلب من عمل العلوم الاجتماعية في عالمنا العربي والإسلامي: استشراء ثقافة الهيمنة والاستبداد، شيوع ثقافة الخوف من العمل الجمعي، الانسحابية والانغلاق على الأسرة، الخوف والتوجس من الآخرين، ضعف ثقافة احترام حقوق الإنسان والتسامح على المستوى الشعبي، وأخيراً تريف الثقافة العربية.
4- على الصعيد التعليمي: كما ترتبط أزمة العلوم الاجتماعية في المجتمعات النامية، بتدني مستوى معظم جامعاتها عموماً، وضعف الأداء التدريسي بها، إضافة إلى الأعداد الهائلة التي تستقبلها هذه الجامعات من المتقدمين لها سنوياً، الأمر الذي لا يتناسب مع إمكانيات هذه الجامعات الاستيعابية والتمويلية. كما تأتي العلوم الاجتماعية في أدني السُلم التراتبي من ناحية تقييم الطلبة لها، والتصور الشعبي لمرتاديها والعاملين بها. وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الأسباب التالية:
أ- هناك تصور على المستوى العام بتدني قيمة العلوم الاجتماعية، وكليات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في العالم العربي. فكليات الآداب هي مأوى الحاصلين على أدني الدرجات في سُلم الثانوية العامة، والذين فاتتهم حظوظ التقدم للكليات العملية مثل الطب والهندسة والعلوم والحاسبات الآلية… إلخ من مثل هذه النوعية من التخصصات ذات الاحترام والتقدير المجتمعي من ناحية، وذات العلاقة المباشرة والقوية بالاحتياجات الإنسانية المجتمعية وبسوق العمل من ناحية أخرى. كما أن هناك تصوراً عاماً بأن هذه الكليات هي مأوى الإناث الذين يبغين مجرد الحصول على شهادة جامعية قد تؤمن لهن وظيفة ما في أي مدرسة حكومية أو خاصة، أو قد ترفع من قيمتهن في سوق الزواج.
ب- في ضوء التوسع في افتتاح الجامعات في الكثير من الدول العربية والإسلامية، وبشكلٍ خاص في المناطق النائية الريفية، إضافة إلى معدلات الهجرة الريفية الهائلة من الريف إلى الحضر في المجتمعات النامية، ظهر ما يمكن أن نُطلق عليه ” تريف الجامعة “، وبالتبعية ” تريف العلوم الاجتماعية “. وهو الأمر الذي نعني به فرض القيم الريفية المحافظة التقليدية على بنية العلم، واختيار الموضوعات التي تبدو فيها الدعاية الأخلاقية أكثر من التحليل العلمي المنهجي الرصين. فالقيم الريفية لا تساعد على خلق حالة التمرد والالتزام، بقدر ما تساعد على تكريس قيم الخضوع والخنوع والانتهازية، وهذه قيم مضادة لبنية العمل وتطويره بشكلٍ أو بآخر. إن تريف العلوم الاجتماعية يقع في المسافة المؤيدة لقيم السلطة السياسية في العالم العربي والمحافظة عليها، فهي قيم ضد التغيير وضد التطور والديمقراطية.
ج- انعكاس تلك الأوضاع المهترئة على طبيعة المنتج العلمي الخاص بالعلوم الاجتماعية فجاء يحمل العديد من السمات المرتبطة باهتراء الواقع المعيش. فلم يشكل هذا المنتج في الكثير من الأحيان إضافة حقيقية لفهم الواقع الاجتماعي المعيش بتجلياته وتحولاته المختلفة. حيث جاء إما استنساخاً كاملاً من بحوث سابقة، أو تقليداً باهتاً لمناهج ونظريات غربية. وعلى ما يبدو أن حالة الضعف الإنتاجي على المستوى المادي، لا تنفصل بدرجة أو بأخرى عن حالة الضعف الفكري، فكلاهما مرتبطان ببعضهما البعض.
د- إضافة إلى ما سبق، لعبت عقلية الموظف، الغالبة على قطاع واسع من المشتغلين بالعلوم الاجتماعية، دوراً كبيراً فيما وصل إليه المنتج الاجتماعي. فالرغبة في الترقي والحصول على الدرجة العلمية، قد أوصلت البعض إلى ما يمكن وصفه ” بسلق البحوث ” بدون القدرة على التعمق والقراءة والفهم والتحليل. كما أن عقلية المجاملات الشائعة في المجتمعات النامية قد ساهمت في ظهور العديد من الكتابات التي لا تليق بكونها تتعلق بفهم الواقع الاجتماعي المعيش في تلك المجتمعات، ولا تليق بظهورها للنشر العام. واللافت للنظر هنا ارتباط عملية النشر، في الكثير من الأحيان، بالعلاقات الاجتماعية وشبكات التدريس وبالمكاسب المادية، حيث أصبحت الجهود المبذولة في العلاقات الاجتماعية أكبر بكثير من الجهود المبذولة في البحوث والدراسات الاجتماعية.
ه – كما يلفت النظر في بنية المشتغلين بالعلوم الاجتماعية، هو إعادة تأسيسهم لجملة أخلاقيات وسلوكيات تأسست من خلال الأطر والتحولات السياسية والفترات الزمنية المختلفة، إضافة إلى ما أنتجوه هم، وراكموا عليه. وإذا كان المشتغلون بالعلوم الاجتماعية لم ينجحوا في إنتاج مدارس نظرية يراكم من خلالها اللاحقون على من سبقوهم، فإنهم قد نجحوا في الحفاظ على خصائص مؤسساتهم المختلفة، على الأخص في جوانبها وملامحها السلبية، ولم ينجحوا في تطويرها والخروج من قيودها الصارمة.
و – وتتمثل أهم سمة من سمات المشتغلين بالعلوم الاجتماعية في حفاظهم على هرمية المؤسسة الأكاديمية، وهو تقليد ينتقل من جيل لآخر، مدعوماً في ذلك ببنية المكانات المتعارف عليها في حقول العلوم الاجتماعية، والتراتبية العلمية. فالبنية الأكاديمية للمشتغلين بالعلوم الاجتماعية تدعم أنماط الاستبداد المتوارثة من جيل لآخر، بحيث لا يستطيع طالب الدراسات العليا أن يخالف أستاذه أو يجادله إلا فيما ندر. وهو نفس ما نجده في قاعات المحاضرات حيث هيمنة الصوت الواحد على جموع الطلاب المحتشدين، بدون القدرة على الجدل أو الاختلاف، على الرغم من أن روح وجوهر العلوم الاجتماعية هو الجدل والاختلاف والتمرد. وفي كلتا الحالتين يلتزم الطلاب الصمت والخضوع والاستكانة رغبة في الحصول على الدرجة العلمية أو النجاح.
وفي النهاية يمكننا القول إن بنية الاستبداد هذه غير ظاهرة للعيان، وليست مكتوبة عبر قواعد محددة للسلوكيات، لكن، يتم استدماجها نفسياً واجتماعياً، بحيث تشكل أطراً محددة للتعامل والسلوكيات والممارسات المختلفة، لا يستطيع أياً كان تجاوزها أو العمل من أجل اختراقها، ناهيك عن إزاحتها والقضاء عليها.
وفي كل الأحوال تصبح هذه البنية امتداداً لبنية السلطة السياسية في المجتمعات النامية، ويصبح المشتغلون بالعلوم الاجتماعية مشاركين من حيث، يعلمون أو لا يعلمون، يعون أو لا يعون، ينتفعون أو لا ينتفعون، في تأييد البني الاستبدادية في العالم العربي. ويصبح أي حديث من قِبلهم عن الإصلاح والديمقراطية والتغيير والشفافية هو حديث مشمول بالشك والسخرية من قبل الآخرين. وخطورة استمرارية هذه البنية أنها تعمق بنية الطاعة والخنوع من قبل من هم في أدنى السلم الأكاديمي لمن هم في قمته. وحتى لو بدت هذه العلاقة تنطوي على نوع من العلاقة الأبوية، فإنها تُولد بين طياتها قدراً كبيراً من الانتهازية والموافقة وتمشية الحال، بدون أن تُنمي قيم التمرد والالتزام الحقيقي. وفي هذا السياق يلعب أستاذ الجامعة دوراً محورياً في تكريس هذه الوضعية المتدنية.
وهكذا نجد أن المجتمعات النامية عموماً تطورت خلال العقود الأخيرة، من حيث الشكل والمظهر وأنماط المعيشة، وقد تمظهر هذا التطور ” الشكلاني ” من خلال تقبل تلك المجتمعات وأخذها لكثير من مظاهر الحضارة الغربية الحديثة، من دون وجود الأخذ بالأسباب والعلل والمناخ الفلسفي والمعرفي الذي صاغها، أي من دون وجود أية معايير أو مضامين فكرية أو فلسفية أو علمية… ولهذا، فقد بقيت تلك المجتمعات حاملة لعدد من موروثات المجتمع القبلي التقليدي العتيق ومن خصائصه، فكراً ومنهجاً وسلوكاً حتى وقتنا المعاصر. أما عن توصيف أزمة علم الاجتماع في البلدان العربية والإسلامية سوف نحاول الوقوف على ملامحها ومظاهرها في الفقرة التالية.
– أزمة علم الاجتماع في البلدان العربية والإسلامية:
ليس صحيحاً أن أزمة علم الاجتماع في بلداننا العربية والإسلامية هي صدى أو امتداد لأزمة علم الاجتماع في العالم الغربي، بل إنها ترجع في حقيقة الأمر إلى شرعية وجود علم الاجتماع والاعتراف به، هذا من جهة. ومن جهة أخرى بسبب اقتصار ممارسة علم الاجتماع على الصعيد النظري فقط وإهمال الجانبين الميداني والتطبيقي لأسباب عديدة سنتحدث عنها بالتفصيل. ويمكننا توصيف أبعاد أزمة علم الاجتماع في البلدان العربية والإسلامية، بما يلي:
1- يقول العالم الفرنسي ريمون آرون عام 1934، إن أشد ما يفتقر إليه علم الاجتماع الفرنسي هم علماء الاجتماع أنفسهم. أما ما نلاحظه اليوم – على الساحة العربية والإسلامية – فهو على العكس تماماً. فأشد ما نفتقر إليه هو علم الاجتماع في حد ذاته.
2- عدم ربط الجامعة ومراكز البحث العلمي بالمجتمع في البلدان العربية والإسلامية لأسباب عديدة أهمها الأسباب السياسية.
3- أما في الجامعات الغربية فإن الحال يختلف كثيراً عما يجري في مجتمعاتنا. حيث يقوم علماء الاجتماع والاثنروبولوجيا بإجراء البحوث والدراسات حول العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية التي تلامس الواقع الغربي كمشكلة البطالة والجريمة وتعاطي المخدرات والأمن الصناعي وتلوث البيئي. فضلاً عن تحليل مظاهرها والمتغيرات الفاعلة فيها بالإضافة إلى اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ليتم بعد ذلك مناقشتها علنياً على نطاق جماهيري واسع.
4- التبعية الثقافية للبلدان العربية والإسلامية للدول الصناعية المتطورة، خصوصاً فيما يتعلق بالسوسيولوجيا التي نشأت أصلاً في أحضان الثورة الصناعية في أوروبا وأمريكا. حيث لم يكن الرواد الأوائل من السوسيولوجيين في تلك البلدان سوى ممثلين لهذه المدرسة أو تلك من المدارس السوسيولوجية الأوروبية. فقد كتب نقولا حداد عام 1924 أول كتاب عربي يحمل اسم ” علم الاجتماع “، وكان واقعاً بصورة خاصة، تحت تأثير هربرت سبنسر، ونظرية التطور الداروينية، وحاول كل من علي عبد الواحد وافي، وعبد العزيز عزت، وحسن سعفان شحادة، إلباس ابن خلدون قبعة أوغست كونت، ولم يكن عبد الكريم اليافي أكثر من ناقل لنظريات دوركايم السوسيولوجية إلى اللغة العربية، وبصورة عامة فإن مؤلفات، وترجمات خريجي جامعات أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت تهيمن على المناخ الأكاديمي العربي والإسلامي، قد جعلت السوسيولوجيا في تلك البلدان، وحتى وقت قريب، أسيرة الوضعية الفرنسية، والامبيريقية الأمريكية، والاتجاه البنائي الوظيفي.
5- وضع معظم السوسيولوجيين في تلك البلدان، إمكانياتهم ومعارفهم العلمية، في خدمة الأنظمة التي يعيشون في ظلها وحولوا السوسيولوجيا إلى علم رسمي تبريري، وأغرقوا طلبتهم في بحوث امبيريقية جزئية بعيداً عن الحاجات الفعلية للجماهير الشعبية التي تحكمها هذه الأنظمة.
6- عدم امتلاك علم الاجتماع في البلدان العربية والإسلامية لنظريات علمية اجتماعية عامة واضحة المعالم، يكون لها أنساق معرفية متكاملة، يمكن اختبارها واقعياً، وتكون لها قدرات تفسيرية، وقدرات تنبؤية، كما هو الحال في علم الاجتماع الغربي، أما معظم الدراسات الاجتماعية العربية فإنها تدور في فلك الدراسات الوصفية. فالنظرية تلعب دوراً أساسياً في تحديد موضوع العلم، والفضاء المعرفي الذي يجب أن يتحرك به مجال البحث، وبالتالي تسهم في تراكم الخبرات العلمية والمعرفية، وتطويرها في اتجاهات محددة.
7- سعى المتخصصون في مجال العلوم الاجتماعية في البلدان العربية والإسلامية إلى إثبات نظريات واتجاهات وشرح مصطلحات وُلدت وترعرعت في مجتمعات أخرى وفي ظروف مغايرة للأوضاع الاجتماعية في تلك البلدان.
8- صحيح أن النظريات والمصطلحات جديرة بالاهتمام والدراسة والعناية للتعرف على ماهية المشكلات التي تتعرض لها تلك المجتمعات، إلا أنه ليس من المعقول استخدامها باسم كونية المعرفة العلمية لأنها لم تأخذ بالحسبان كل الأوضاع الممكنة إنسانياً، ولكن بعضاً منها فقط، أما توظيفها في المجتمعات العربية والإسلامية دون تدقيق وتمحيص فإنها بطبيعة الحال ستكون حجر العثرة في إيجاد وتطوير العلوم الاجتماعية في تلك البلدان.
9- الفشل في تأسيس مناهج سوسيولوجية خاصة، يمكن تطبيقها في دراسة واقعنا الاجتماعي، تراعي فيها طبيعة الإشكاليات الاجتماعية وخصوصيتها في المجتمعات العربية والإسلامية. ولا شك أن المناهج، والمقولات النظرية، بالإضافة إلى الموضوع والوظيفة، والمفاهيم، من أهم شروط تأسيس العلم.
10- إن معظم الأبحاث التي يقدمها الباحثون العرب في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية تقف في أغلب الأحيان عند مرحلة الوصف دون أن تتجاوزها إلى مرحلة التفسير، فأغلب هذه الدراسات تدور في فلك السؤال: كيف حدثت الظاهرة؟ وكيف تتبدى في الطبيعة أو المجتمع؟ دون الانتقال إلى السؤال التفسيري: لماذا حدثت هذه الظاهرة؟ هذا فضلاً عن الوصول إلى سؤال التنبؤ: ماذا سيحدث في المستقبل أو كيف ستحدث الظاهرة؟
11- نحن هنا لا نقلل من أهمية عملية الوصف في الدراسات العلمية بشكل عام، فكثيراً ما يكون الوصف بمنزلة اكتشاف للظاهرة، إلا أن التفسير يتجاوز الوصف، فيستعين به، ويضيف إليه القوانين أو النظريات كي يحقق هدفه، فيمثل التقدم الحقيقي للعلم.
12- ضعف تمويل المشاريع والأبحاث في مجال العلوم الإنسانية عموماً والعلوم الاجتماعية خصوصاً. حيث تعاني الأبحاث السوسيولوجية في تلك البلدان من ضعف كبير في الاهتمام والتمويل ويرجع ذلك بسبب عدم اعتقاد مراكز اتخاذ القرار بفاعليتها ونفعها في تسليط الضوء على المشاكل والقضايا التي تعترض المجتمع بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عدم قدرة الجهات الممولة على قطاف ثمار مردودها مباشرةً كما هو الحال في العلوم الطبيعية.
13- بذلك ينظر للأبحاث في مجال العلوم الإنسانية بشكل عام وعلم الاجتماع بشكل خاص على أنها ضرب من ضروب الترف، الذي يمكن تأجيله أو ليس له مبرر، بل يوجد اليوم في العالم العربي والإسلامي من يطالب بإغلاق أقسام علم الاجتماع في الجامعات، لأنها ليس لها أي دور أو أهمية في الحياة العلمية أو الاجتماعية، على حسب زعمهم.
14- عدم التنسيق بين الدراسات الاجتماعية العربية والإسلامية، وعدم توحيد المفاهيم والمصطلحات، والاستناد إلى مدارس ومرجعيات اجتماعية وافدة من نتاج الشعوب الأخرى، الأمر الذي خلق حالة من الفوضى والتضارب بين المشتغلين في الدراسات الاجتماعية في تلك البلدان، نتج عنها ضياع الجهود، وخلق حالة هدامة، بدلاً من حالة بناءة، فقد يجتمع – على سبيل المثال- في أحد أقسام علم الاجتماع في إحدى الجامعات العربية مجموعة من الأساتذة، ينتمي كل واحد منهم لاتجاه اجتماعي مغاير أو منافس ومضارب للآخر.
15- فهناك الوظيفي، البنيوي، السلوكي، الماركسي، النقدي، الإنشائي، التوفيقي، التنظيمي، الفوضوي … إلخ، حيث يسخر كل منهم طاقاته وجهوده البحثية للانتصار لمذهبه ومدرسته، التي هي بالأساس لا تنتمي للمجتمعات البلدان العربية والإسلامية، فتكون النتيجة أن يساهم في تطوير علم الاجتماع الغربي، وليس علم الاجتماع الإسلامي.
16- المعاناة من إشكالية التعميم والتجزئة، كصفة ملازمة لمعظم الأبحاث السوسيولوجية العربية، فإما أبحاث عامة سطحية تلامس الموضوعات المعالجة من الخارج دون الغوص إلى أعماق المشكلة لتحليلها وفهمها جيداً، وهذا غالباً ما يتمثل بالنزعة المدرسية في التأليف، حتى نجد أن أستاذ علم الاجتماع في تلك البلدان يمكن أن يكتب في أي شيء وفي كل شيء، دون مراعاة ضرورة التعمق في تخصص محدد. أو بالمقابل أبحاث تركز على مشكلات جزئية، ذات طابع امبيريقي، دون مراعاة ضرورة فهم الإطار النظري العام الذي يجب أن تعالج به هذه المشكلات، فنجد هنا نزعة ذات صبغة تبسيطية تميل للتطرف في التجزيئية والتخصصية.
خلاصة القول: يفتقد علم الاجتماع في مجتمعاتنا إلى المقولات النظرية والمنهجية لتفسير تطور هذه المجتمعات وتوقع مسيرتها المستقبلية، وكثير من الأدوات المنهجية المستخدمة اليوم في علم الاجتماع العربي مستعار من تجارب أخرى، وليس في ذلك عيب، ولكن تحتاج تلك الأدوات إلى تطوير ومواءمة من أجل الوصول إلى شبه نظرية تُفسّر وتتوقع صيرورة المجتمع (المجتمعات) العربية في المستقبل، بدايةً من المفاهيم وضرورة ضبطها، وانتهاءً بتفسير تاريخ تطور المجتمعات، وبخاصة أن المجتمع العربي اليوم في حالة انتقال، وأكاد أقول (سيولة اجتماعية)، يتخللها التشكيك في الثوابت القديمة من دون ابتكار أخرى جديدة، مثل: (الدولة المدنية) أو (المجتمع المدني) أو (عقد اجتماعي للحكم)، ونحن اليوم أكثر حاجة لمساهمة ابتكارية لعلماء الاجتماع العرب.
لكننا بهذه الصفحات القليلة لا نستطيع أن نحدد مكانة وخصائص علم الاجتماع في البلدان العربية والإسلامية وملامح الأزمة التي يعاني منها بشكل دقيق لعدم توفر الدراسات الجادة في هذا المجال، مما أدى إلى عدم قدرتنا على تحديد الأسباب الحقيقية التي حالت دون تأسيس علم اجتماع فاعل في تلك البلدان. بالمقابل لا يمكننا فهم المشكلات والقضايا المجتمعية التي نعاني منها دون امتلاك علم الاجتماع العربي والإسلامي لنظريات ومناهج ومفاهيم ومصطلحات خاصة به، التي تمكنه من توظيفها وتطبيقها في بهدف معالجتها.
وفي هذا السياق، نأمل أن نكون قد قدمنا خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح من أجل تسليط الضوء على أوضاع علم الاجتماع في تلك البلدان، التي بدون السعي إلى تغييرها، وبدون تهيئة الأرضية المناسبة لعمل سوسيولوجي جاد، لا يمكن الحديث عن علم اجتماع عربي – إسلامي، ولا علماء اجتماع بالمعنى الحقيقي للكلمة، كما يجب علينا بالمقابل التفاؤل بمستقبل علم الاجتماع في بلداننا على اعتبار أن الحالة الراهنة لعلم الاجتماع ليست لعنة أبدية، وإنما حالة يمكن تجاوزها، وإن كان الطريق إلى ذلك وعراً وطويلاً وشاقاً والسير فيه مجهداً.
– المراجع المعتمدة:
1- محمد أحمد الزعبي: علم الاجتماع – بعض الإشكالات النظرية والتطبيقية، الحوار المتمدن، العدد: 2498، تاريخ 17/12/ 2008.
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=156651
2- حسام الدين فياض: المدخل إلى علم الاجتماع- من مرحلة تأصيل المفاهيم إلى مرحلة التأسيس، مكتبة الأسرة العربية، إسطنبول، ط1، الجزء: الأول، 2021.
3- عبد الحكيم شباط: هل يوجد علم اجتماع عربي؟، مجلة العلوم الاجتماعية، 26-04-2012.
4- جميلة شلغوم: واقع السوسيولوجيا في الجزائر في ظل الحداثة وما بعد الحداثة، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قاصدي رباح، الجزائر، 2014/2013.
5- صالح سليمان عبد العظيم: أزمة العلوم الاجتماعية في العالم العربي، مجلة البيان، 12 يناير 2007. https://www.albayan.ae/opinions/2007-01-12-1.134467
6- أبو بكر أحمد باقادر، عبد القادر عرابي: آفاق علم الاجتماع عربي معاصر، دار الفكر- آفاق معرفة متجددة، دمشق، ط1، 2006.
7- مجموعة مؤلفين: نحو علم اجتماع عربي ( علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة )، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة كتب المستقبل العربي (7)، بيروت، ط2، 1989.
8- محمد الرميحي: علم الاجتماع العربي والواقع، مجلة الفصيل، الرياض، 1 يوليو 2021. https://www.alfaisalmag.com/?p=21180
________
* د. حسام الدين فياض/ الأستاذ المساعد في النظرية الاجتماعية المعاصرة/ قسم علم الاجتماع كلية الآداب في جامعة ماردين- حلب سابقاً.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.