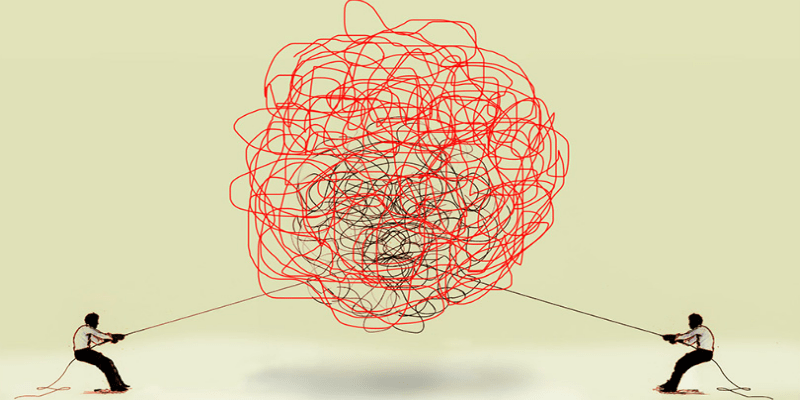
ترجمة: فالح حسن
أمر صعب ومعقّد التعرض لموضوعة الإسلام والحداثة. لا تزعم هذه المقالة تفسير إشكاليَّة كان لها الحظ الوافر من الدراسات، أو الإتيان بإجابات عليها، إنما هي ببساطة تلخِّص المسألة قليلاً، على الرغم من أنها بهذا تخاطر في الانزلاق إلى تسفيهها. بالمعنى المقبول عموماً، تشير كلمة “حديث” ومنها تُشتقّ كلمة “حداثة”، إلى ما يتَّصل بالزمن الحاضر.
وإذاً، فهذا التعبير من أضداد الـ”قديم” أو الـ”ممات”. على أننا إن عدنا إلى التاريخ، لأدركنا بسرعة أن الحداثة تتأرَّخ في العصر القديم، وبالتحديد في عصر الحضارة الإغريقيَّة. فقد كان الإغريق روّاد الحداثة بداعٍ من إرسائهم أول نسق سوسيوـ سياسي في العالم، مُكرَّس لفصل الدين عن الدولة. فصار التنظير عندها في إدارة المدينة وَقفاً على المفكّرين والفلاسفة، على مِنْوال أرسطو وأفلاطون، الذين أطالوا البحث في شأن الجمهوريَّة (res publica)، التي تعني “الأمر العام”. علاوة على ذلك، لعلَّ بوسعنا القول إنَّ الحداثة وُجِدت مُذ صار العقل القيمة الأساسيَّة التي بهداها ينقل الإنسان خطاه. وهذا يعني القول بأن الحداثة تلازم حريَّة الفرد. وكان الفرد في القِدَم ذائب في الحيّز الفئوي الذي تمثله القبيلة أو العشيرة، فكان يشاطر الجماعة المندرج فيها صالحها ويبذل نفسه من أجلها. وعلى الرغم من أن الحياة الروحيَّة لم تكن مقصاة عن ذلك الحيّز، إلا أنها غدت شأناً شخصياً بحصر المعنى. وكان رجال الدين بطبيعة الحال يعنون بذلك الجانب، محاذرين من التدخّل في إدارة المدينة، الذي كان شأناً زمنياً. وطبعاً، جرفت هذا النسق الديمقراطي موجة لَمّ الأنصار التي أشار بها الدينان التوحيديان. وهذا هو سبب ذبول الحداثة على مدى العصر الوسيط الأوربي الذي شهد علو يد إعادة تنشيط الباراديغم(=النموذج) الديني، على جميع مظاهر الحياة الأخرى. وما محاكم التفتيش، التي أعقبت ذلك، إلاّ نتيجة تَعدّي الدين على ميدان حيّز الدولة المؤسَّساتي.
وتوجب انتظار مجيء قرن الأنوار وثورة العام 1789 الفرنسيَّة حتى يتصل الغرب بحداثته مرة أخرى. فكانت العودة إلى نمط التفكير العقلاني، ثمرة “العقل Raison”، هو من صنيع الفلاسفة الذين جدّدوا طرائق التأمّل في العالم، مثل ديدرو وفولتير وروسو. ثم أنّ ولادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حدثت في رحم هذه الحركة الفكريَّة التي لا سابقة لها. بيد أن هذه الصحوة لم تجرِ بين ليلة وضحاها. إذ اندلعت صراعات كبيرة، وحدثت حروب مرعبة دامت قروناً، ضد ظلاميَّة رجال الدين (وهم الذين حرقوا غاليله)، فما كان تحطيم النظام الذي أقامته الكنيسة بالأمر الهين. فقد كانت الكنيسة، كما نعلم، تتولى تدبير شؤون الشعوب الأرضيَّة، وهو ما كان قد فسح المجال لسيادة ما يدعى بالحق الإلهي. وعلى هذا الأساس، جمع الحاكم بين مهام البابا ومهام الملك مؤسساً بذلك الاستبداديَّة عقيدةً للدولة.
وتأسست الشرعيَّة لا على الديمقراطيَّة المباشرة كما كان الحال لدى الإغريق الأقدمين، حيث كان للفرد الحق باختيار ممثلين، إنما على العقيدة الدينيَّة التي رُقيّت إلى دين رسمي حيث يُلزم الفرد بالانصياع لسلطة الإكليروس. وغني عن البيان قول أن الصراعات من أجل نظام أكثر عدلاً لم تكن تُقاد إلاّ على داعي الفصل بين الكنيسة والدولة. واستتباعاً لهذا الفصل، تولت الكنيسة مذ ذاك إدارة شؤون العبادات حصراً وما يتصل بالقيم الروحيَّة، فيما تكرست الدولة لأمور المدينة الدنيويَّة. ولنلحظ أن الحركة التي حملت الحداثة شهدت اتساعاً في أوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين. وأحد أكبر التحولات التي بلغتها الحداثة كانت بلا شك تكريس المساواة بين حقوق الرجال وحقوق النساء. لكن عندما يتعلَّق الأمر ببلدان الإسلام، نُسجّل أن هذه البلدان لم تشهد التطور التاريخي نفسه. فالعقل هنا يقوم بعوامل عدة. ففي البدء، لا وجود في الأرض المسلمة لرجل الدين، الذي يجسد إدارة وتراتبيَّة العبادة، وكذا الحال فيما يخص النسق الإقطاعي، الذي كان أصل تأسيس دول أوروبا.
إذ إن العالم المسلم بعامة، والعالم العربي بخاصة، استغرق في سُبات طويل: من قرون من الانحطاط حتى الصدمة الكولونياليَّة. ومن سوء حظ بلدان الإسلام أنْ كان عليها الولوج في الحداثة كما قسراً، مُذ فُرِضت بالعنف القيم التي نقلها المحتل إليها. فالفردانيَّة، وشفرات السلوك الغربيَّة، واللغة والثقافة الأجنبيتان، هي، كحال مظاهر كثيرة جديدة، أثّرت في أهل تلك البلدان أكثر مما استبطنوها. وكان من آثار الصدمة الكولونياليَّة التي أنتجت في قلب المجتمعات الإسلاميَّة قيماً عديدة، أنْ دفعت بهذه المجتمعات إلى تبني طرائق سلوك تلفيقيَّة. وهكذا، ترى بوسع الرجل المسلم أن يُبدل بذلة الرجل الغربي، التي يرتديها هو في لحظة مضيه إلى عمله، بزِيهِ التقليدي حالما يرجع لبيته الأُسري. ولمّا يناوب المسلم بين الشفرتين الثقافيتين، وإحداهن تقليديَّة والأخرى حديثة، يصير كائناً مُزدوجاً، في المستوى النفساني والثقافي، ممزّق بين ” الذات ” و” الآخر”، أي بمعنى بين أنموذجين ثقافيين يتعارض أحدهما مع الآخر تعارضاً تاماً. ومن هنا يتأتى ذلك القلق الوجودي الذي وصفه المحللون النفسانيون بـ”التيه الهوياتي”.
عليه، فالإسلامويَّة السياسيَّة بوصفها أيديولوجيا مترابطة تستند إلى قيم المجتمع الأبوي، ذلك المجتمع الذي يُفرد مكانةً كبيرة للجنس الذكوري، تُقدِّم للمسلمين الضالين وسيلة في أنْ يتجمعوا حول نواة متحجرة، متكونة من شيفرة الشرف القديمة، والأساطير، وإرث ثقافة الأجداد. إذن، يقوم نجاح هذه الأيديولوجيا على أساس لفظ الثقافة خارجيَّة المنبت، ثقافة أدخلت الريبة تلقاء الهويَّة الأصليَّة المتُوهَمة. وهنا يفهم عدد من المحللين أن المجتمع التقليدي الموجود في كل أصقاع بلدان الإسلام، بوصفه مجتمعا متخطيا للحدود الوطنيَّة، على أنه تعبير عن الأمميَّة الإسلامويَّة. ولم تشذ الجزائر عن هذه الظاهرة. إذ أراد الإسلامويون فيها إعادة تأسيس النسق الأبوي ووضعوا برنامجاً لدعوة النساء العاملات للزم بيوتهن، إنْ هم افلحوا في الاستيلاء على السلطة فيها.
لكن برغم رفض الجزائريون الحداثة الاجتماعيَّة، تجدهم يستهلكون منتجات الغرب وتقنيته، كما حال الشعوب المسلمة الأخرى في العالم العربي والإسلامي. فقد اجتاحت حيّزهم الوطني السيارات، والأجهزة المنزليَّة، وأدوات المعلوماتيَّة والمستلزمات من كل ضرب ونوع. وهكذا يُختَزلون رغماً عنهم في استهلاكهم هذا. فلا تدع الحداثة التي تتناغم اليوم مع العولمة، أي هامش مناورة للشعوب التي تقرر أو تُدّعي أنها تدير ظهرها إليها. ذلك أن التموضع في هامش الحداثة يَعْدِل ترك المرء نفسه لها لتلقفه على غفلةٍ منه. وفوق ذلك، يقع القطع بين قبول استهلاك هذه المنتجات عاليَّة التقنيَّة، وهي من عمل الغرب، وبين رفض مبادئ هذا الغرب نفسه، الفلسفيَّة والثقافيَّة. على هذا، يرجع الأمر للشعوب المسلمة في امتلاك واستبطان المقولات العقليَّة، التي كانت باعث الحداثة الفكريَّة. فما الإسلام بوصفه ديناً بمناوئ للحداثة، إنما الأنساق السوسيو ـ اقتصاديَّة، التي تقوم بها الدول المسلمة، هي التي تُوضع في بؤرة مناصبة الحداثة، وليت هذه البلدان تفيد من أمر فصل المجالين الديني عن السياسي ليغدوا بمستطاعها الأمل ذا يوم بمصير وطني يختص بها.
______
* الراصد التنويري (العدد 2) أيلول/ سبتمبر 2008.

