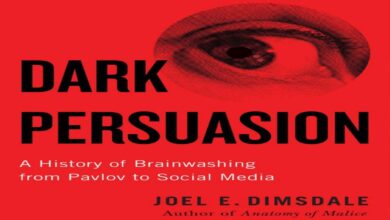إشكالية العنف والمقدّس

في عقيدتي أن السلوك العنيف، مهما كان نوعه، لا يمكن تبريره بحالٍ من الأحوال إلا حين يكون دفاعاً عن حياة الإنسان وحقه في أن يعيش كريماً … أي أن العنف المبرر هو ذلك الذي يكون ردة فعل الذين يمارسون العنف ضدّ الآخر، حيث العنف المبرر ليس سوى ردة الفعل وفي الحالات التي ذكرتها فقط إذ لا يمكن للعنف أن يكون فعلاً أو منهج حياة، بل أن الحياة لا يمكن أن تسير نحو التطور والرقي والعمران إلا وفق مبدأ (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) وبهذا ريادة الأنبياء في إشاعة مبدأ اللاعنف في التعامل مع الآخر المختلف. ولعل في أول نص قرآني أباح للمسلمين اللجوء إلى القوة في مواجهة عنف الآخر، بعد ما يزيد على العقد من الدعوة السلمية وتحمل الظلم والأذى، ما يدعم هذا القول (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ) فسبب الإذن بالقتال (أنهم ظلموا) ومن مظاهر ذلك الظلم أنهم (أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقّ…) ويمكن لنا أن نتصوَّر مقدار ما يشعر به الإنسان من ظلم حين يطرد من موطنه دون وجه حق.
غير أن المفارقة العجيبة في مجمل تاريخنا أنه يتخذ منطق القوة سبيلاً للتعامل مع معظم قضايا الحياة، خصوصا على المستويين الفكري والعقائدي، وهنا خطورة الانقلاب الذي حصل في منظومة القيم والمفاهيم، ولسوء الحظ أن مفاهيم العربي المغرم بالقوة هي التي شكلت العقل العربي والمسلم منذ صادر بنو أمية ومن جاء بعدهم عقول الناس قبل شفاههم وحتى يومنا هذا. فالإنسان في عالمنا محاصر بثالوث مشؤوم من المحرمات بين الدين والسياسة والجنس. فإذا سولت له نفسه الخروج على منظومة الفكر الديني التقليدي رفع في وجهه سيف الردة، وإن تمرد على سياسة الحاكم الفرعون وقع تحت تهمة الخيانة، وإن تحدث عن الجنس بغير طريقة النعامة في التعامل مع الخطر، وجهت له أصابع الاتهام بالانحلال والإباحية والترويج للغرب (الكافر)!
وبعيداً عن جدل
النصوص والتمترس بالمقدس، نجد أن منطق القوة يفتقر للشرعية من الناحية المعرفية
حتى لو دعمته كل ما في الأرض من فتاوى وأحكام، إذ لا شرعية مع القهر والإكراه
وفقدان الشرعية ناتج من انعدام الخيار لدى الطرف الآخر، وكما قال الشاعر:
أمرتني السياط أن لا أقول
ويد السوط حين تأمر طولا
فحين تسود لغة السياط تختفي لغة المنطق والعقل ويصبح المجتمع مجموعة من الكائنات والمرعوبة التي لا تتقن سوى فن الكراهية والنفاق، لهذا رفع القرآن الكريم شعار “لا إكراه في الدين” فالإكراه هو التجلي الأعظم لظاهرة العنف لأنه يتنافى مع إنسانية الإنسان ويصادر قناعته التي هي حالة وجودية تقع خارج دائرة القهر والقوة. إذ يمكنك بالقوة أن تقهرني وتخرس لساني ولكك لن تستطيع أن تقنعني أنك على حق بتلك الطريقة أبدا.
ومشكلة الذين يرون العنف مبدأ كما هو ديدن المتطرفين في كل دين أنهم يعانون من خلل في بنائهم النفسي أصلا، ذلك أنهم أناس مشحونون بالحقد والكراهية للآخر. والسبب الأعمق لذلك الخلل هو حجم الجهل والتخلف في نظرتهم للمعرفة أولا وتصورهم للدين ثانيا.
أما من الناحية المعرفية فمشكلتهم ببساطة أنهم ينظرون للحياة والكون، بكل ما فيهما من سعة وشمولية وتعقيد، بعيون الموتى، وينطلقون من اليقينيات المطلقة في وجود يشي للعقلاء أنه “كل يوم هو في شأن” والدليل الصارخ على ذلك أن الحياة من حولهم تسير بسرعة الضوء، بينما هم يعيشون خارج الزمن، والأدهى من ذلك أنهم فرحون مسرورون! أما نظرتهم للدين فهي ببساطة نظرة في غاية التخلف والهمجية، إذ يحسبون أنهم وكلاء الله في الأرض ووظيفتهم حراسة الحقائق المقدسة والذود عن الله ضد أعدائه، لهذا يكون الله، بهذا المنطق، أكبر سادي عرفه التاريخ. فهم في الحقيقة أكثر من يسيء لله في أرضه.
ومشكلة العنف أنه ليس حلا، بل إلغاء لكل الحلول.. فهو كما يقول الدكتور خالص جلبي “يحمل حزمة من الأمراض اللعينة، فهو لا يحل المشكلات بل يولدها ويزيدها تعقيدا في حلقة شيطانية مفرغة معكوسة تزداد اتساعا وضراوة. والعنف لا يحرر الإنسان بل يأسره لعبودية القوة. والعنف يعتمد الجهاز العضلي ويلغي الجهاز العصبي العقلي.. فحين نحطم الآخر نخرج بنتيجة مرعبة شخصها ابن أبي طالب بعقله الفذ قبل ما يزيد على عشرة قرون حين قال: ” الغالب بالشر مغلوب” إذ يخرج المنتصر والمنهزم في معادلة القوة باختلال نفسي مرضي لا يمكن تخيله، ولن يختفي هذا الاختلال إلا بآليات موازنة جديدة.
أما المنتصر فتنسيه نشوة النصر، بمعناه المتوحش، حجمه الطبيعي فيتصور نفسه آلهة على سنة النمرود التي تقول: “أنا أحيي وأميت” ولهذا يسعى لمصادرة حياة الناس حتى على زلة لسان، وأما المنهزم أو الذي مورس ضده العنف، فيحاول أن يستعيد توازنه ويتخلص من عقدة الشعور بالظلم من خلال التربص وانتظار الفرصة التي تتيح له الانتقام، والتي أن توفرت، يستكمل فايروس العنف والعنف المضاد دورته بنجاح، حيث يغدو “الغالب بالشر مغلوب…” ولعل ما حصل لبعض الحكام العرب في حراك الربيع العربي خير شاهد على ذلك.
وغاية ما نصبو إليه أن تشيع ثقافة التسامح واللاعنف وتتسع، كي تضيق دائرة التطرف والعنف الأعمى الذي أصبح الظاهر الأشد تعقيدا في عالم اليوم، ولن يكون ذلك من خلال الخطب والمقالات فقط بقدر ما يكون من خلال السلوك اليومي الذي يمكنه حين يصبح تيارا بغير المعادلة. وبقدر ما يسود التسامح إلا حين يعيش الإنسان في أجواء من الحرية والعدالة والأمن والطمأنينة والحب، فليس لنا أن نطالب المقهور والمهمش والمقموع أن يكون متسامحا أو معتدلا وكما يقولون: ” لا تطلب الحب ممن فقده”.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.