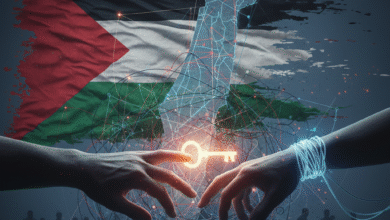دفاعًا عن الفلسفة ضدّ موقف هابرماس من القضيَّة الفلسطينيَّة

قد نتفهم أنَّ السياسة مخادعة ومناورة، فهذا من جوهرها، وقد نتفهَّم أنَّ الاقتصاد هو مصالح ومنافع، فهذا من جوهره، وقد نتفهَّم أنَّ العلم حقائق ونظريَّات، فهذا من جوهره، ولكن ما لا يمكن أن نتفهّمه هو أن يغدو الفكر الفلسفي رهينة للخداع والمصلحة والحقيقة، خصوصًا إذا اعتبرنا الحريَّة من جوهره، فهذا الإنسان الذي يحمل فكرًا لا يكون إنسانا كما يقول الفيلسوف الألماني كارل ياسبيرز إلا بالحرِّيَّة، زيادة على ذلك، فالفلسفة هي منهج طريق، طريقة في مقاومة الاعوجاج والإنكفاس، لذا فلا يمكنها أن تسلك دروب المناورة، كما أنَّها لا تتمحل لبلوغ الحقيقة، ولأنَّها كذلك، فإنَّها لا تحابي السياسة، بل تعرِّي مفاسدها وتكشف خبثها.
والفلسفة كذلك عمل صالح نافع، أي أنَّها تناهض المصالح والمنافع، ولأنَّها كذلك، فإنها لا تنحاز الى الاقتصاد طامعة في التمويل والاغتناء، فغناها في عنادها. والفلسفة كذلك معرفة نسبيَّة لا تنفكّ عن طرح الأسئلة ولا تتشدَّق بالحقيقة، وكل ما فيها نقد وبرهان وحجَّة وموقف وتأمُّل، لذلك تجدها على عكس العلم لا تفتخر بمنجزاتها.
وإذا غلِّفت الفلسفة بالسياسة، ولفَّت بالاقتصاد، واختلطت بالعلم، فإنَّها حتمًا تختنق ويغصُّ المكان عليها بمحدّدات أخرى تتدخَّل في بحثها ومواقفها، هذه المحدّدات تنطوي في الكثير من الأحيان على مكر بلغة هيجل، حين تستغلّ الفلسفة لخدمة مصالح سياسيَّة واقتصاديَّة معيَّنة، والذي يستغلُّ فهو بالضرورة يتريَّد سلَّم القوَّة والسلطة، وبالتالي يصبح متحكّمًا ومسيطرًا، والظاهر أنَّ معادلة الأسبقيَّة قد انقلبت، ففي السابق كان الفكر هو الذي يمهِّد لثورات سياسيَّة واقتصاديَّة، ويشجِّع على إحداث التغيير، ويحفِّز الخيال العامّ على وضع نماذج طوباويَّة يرجى تحقيقها، فكان من نتائج أسبقيَّة الفكر أن شهدت الحضارات التي أولت الأهمِّيَّة له تطوّرًا حاسمًا رسم الخطوط العريضة في تاريخ البشريَّة، ونضرب مثالًا هنا بالحضارة اليونانيَّة والرومانيَّة وبعدها الحضارة الإسلاميَّة، أمَّا اليوم، فالأسبقيَّة للسياسة والاقتصاد على الفكر والفلسفة، وباتت العلاقة بين الاثنين علاقة تطويع وتطوُّع، فالسياسة تطوُّع الفلسفة لخدمة مصالحها، والفلسفة تتطوَّع في تقديم خطط واستراتيجيَّات ملتوية ومتقبضة لتدلِّس ما تبقَّى من الثقة في صلاحيَّة الحقيقة اليوم، وليجف المنبع الأخير الذي نثق فيه من أجل التعرية والفحص والنقد، وماذا يبقى لنا؟
وقد اعتبر فوكو في ذلك أنَّ المعرفة تخضع لشروط قبليَّة تتفشَّى في حقبة معيَّنة، وترتبط هذه الشروط أوّلًا وقبل كل شيء بالسلطة، إذ لا يمكن الفصل بين السلطة والمعرفة، فلا وجود لعلاقات السلطة من دون تأسيس مترابط لحقل المعرفة، ولا لمعرفة لا تشكِّل في الوقت نفسه علاقات السلطة[1]. ونفهم من هذا أنَّ الفلسفة والمعرفة البشريَّة لا تتأسَّس هكذا من خواء وفراغ، ولا تصدر هكذا بدون غاية أو هدف، بل إنَّها تمتلئ بالأهداف وتتكدَّس بالغايات، وقد يحصل أن يحجب الهدف الغاية فيها، فالغاية من الفلسفة هو تنوير العقول، وقد يكون الهدف منها هو طمر الحقائق، بل قد تكون الفلسفة في حدِّ ذاتها هدفًا، وإذا كانت كذلك، فلا يسعنا إلا أن نعتبرها أيديولوجيَّة باعتبارها آليَّة أساسيَّة لخلق ما يعمل كواقع على حدِّ تعبير فوكو، وهذا الواقع ليس إلا كميَّات من القوَّة في علاقة توتُّر كما يقول دولوز، وإنَّ هذا العالم مسكون بالقوى التي تتناحر فيما بينها لتظفر بقسطٍ من هذه الكميَّات، والقوَّة التي تمتلك أكبر قدر من سلطة الواقع تتغلغل الى أعماق المعرفة، لتتجلَّى القوَّة واقعًا عند تطبيق الفكر في الراهن، والمعرفة في الواقع.
لكن يجب أن نحترس هنا قليلًا، لأنَّ روح الفلسفة تنأى عن كل هذه الاعتبارات، ولأنَّ الفلسفة تستقلُّ عن قوَّة، وقوّتها في ذاتها وجوهرها، وإذا حدث أن كانت تلطَّخت الفلسفة بدماء سفكتها القوَّة التي استعانت بها، فالملام هنا، ليس الفلسفة، بل ممثِّل الفلسفة الذي قرَّر أن ينصاع للسلطة، وصحيح أنَّه يوسِّخ صورة الفلسفة النقيَّة بتواطؤه مع المراوغة السياسيَّة والمصالح الاقتصاديَّة، إلا أنَّه بمجرَّد أن يتنكَّر لما يمثِّله، فإنَّه في الحقيقة يشوِّه ذاته، ويغدو التمثيل كذبة اخترعها فيلسوف يدَّعي انتسابه للفلسفة، وما انتسابه هذا إلا تلميع لصورته، والحديث هنا يسري على جميع الفلاسفة الذين تحالفوا مع الظلم والشرّ لمجرَّد انتمائهم السياسي أو انتفاعهم الاقتصادي، وقد سقط القناع عن عددٍ منهم حين أفصحوا عن موقفهم من القضيَّة الفلسطينيَّة، وأعلنوا تضامنهم الوهمي مع إسرائيل لكونها القوَّة المستحوذة على دواليب الاقتصاد العالمي والسياسة الدوليَّة.
ونجترح موقف الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة، وذلك لما أحدثه من زعزعة للضمائر العربيَّة بالخصوص، حيث أبان الكثير من المشتغلين في الحقل الفلسفي عن صدمتهم الغائرة فيما صرح به هذا الفيلسوف لدرجة أنَّ ثقتهم فيه قد تخلخلت، بل هناك منهم من يشكُّ في مصداقيَّة فلسفته وبدأ يستنفر منها، والحقّ أنه في زمن ازدواجيَّة المعايير الذي بدى أن الفكر الغربي يتوسَّم به، لا نندهش من مواقف الغرب الصامتة عن المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حقِّ أطفال ورجال ونساء فلسطين، بالرغم من أن ذلك ينتفي تماما مع مبادئ حقوق الإنسان التي أقرَّها هو نفسه وشرَّعها للعالم، أو هكذا يزعم، وما يجب أن ننتبه إليه، هو أنَّ المعايير والقيم الإنسانيَّة التي نحتها الغرب في جدار هشّ تمليها قوى سياسيَّة واقتصاديَّة متحكِّمة تقود الخطابات الرائجة الى ما ينفع مصالحها، وتهدف الى توحيد العالم على موقف واحد، موقف أنَّ الأقوى هو من يستحقّ، والبقاء له وحده، أمَّا الضعيف فلا قوانين تحميه، ولا حقوق تخوّل له، وأي موقف يتعارض مع موقف الأقوى إلا ويتعرَّض للإقبار والإهمال، وتلعب وسائل الإعلام دورًا مهمًّا من هذا الجانب، إذ إنَّ موقف الفلاسفة من أمثال غارودي وحنَّة آرنت وسارتر قد تمَّ التستُّر عليها وإخفاؤها، في حين أنَّ صوت هابرماس قد وصل الى العالم ككل، وكل من يتشبَّث بفكره ويثق في شخصه لا يسعه إلا أن يقتنع بموقفه من القضيَّة الفلسطينيَّة.
وقد تطفَّل هابرماس على الواقع الفعلي حين صرَّح بأنَّ حركة حماس هي المدانة في هذا الصراع، بدعوى أنَّها هي التي بدأت الهجوم على إسرائيل، ولكلِّ هجوم بالنسبة له ردّة فعل والتي تمثَّلت في دفاع إسرائيل عن نفسها كدولة وعن شعبها كقوم، والأغرب من هذا كله، أنَّ هابرماس قد أُغشيَ عليه في الأوقات التي كانت إسرائيل تتلذَّذ بقتل الاطفال، وتستمتع بإزهاق الأرواح دون أيَّة وصاية حقوقيَّة أو رقابة دوليَّة تفرض عليها، أو أنَّه كان على دراية بما يجري هناك في فلسطين لكنَّه لم يجرؤ على قول الحقيقة خوفًا من اتِّهامه بمعاداة الساميَّة لكونه مواطنًا ألمانيًّا. وإنَّنا لا يمكن أن نقبل الافتراض الثاني، لأنَّ هابرماس فيلسوف، والفيلسوف هو الذي يتجاسر ويتجرَّأ على الإفصاح على الحقيقة، وإن كانت هذه الحقيقة جالبة للتشنيع والتعيير، وحتَّى ولو كانت مهدِّدة للحياة.
وإنَّ موقفنا الذي صرَّحنا به في الأسطر السابقة لا نعدل عليه، فلا نمتنع عن اعتبار هابرماس فيلسوفَا، لكن نمتنع عن اعتباره ناطقًا باسم الفلسفة في مواقفه السياسيَّة، ولا ضير من أنَّه مرجع يحتذى به في المجال الفلسفي، ولا يصدُّنا موقفه السياسي عن إيلاج فضائه الفلسفي الرحب، لكن ميله إلى إسرائيل الطرف الأقوى والأكثر ظلمًا ينزع عنه صفة فيلسوف، وتتبرَّأ الفلسفة منه، لذلك لا يجب أن نقول عنه ونحن نتحدَّث عن موقفه السياسي فيلسوف، وإلَّا ستكون الفلسفة قد وقعت في فخِّ التشخيص، وما هي كذلك، ولن تكون.
[1] Michel Foucault , Surveiller et punir , naissance de la prison , Paris , Gallimard , 1975 , p. 261.
*إبراهيم ماين: طالب باحث في شعبة الفلسفة بسلك الإجازة في المدرسة العليا للأساتذة بجامعة محمد الخامس بالرباط المغرب ، حاصل على شهادة الدراسات العامة في شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة ابن زهر أكادير .
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.