كارل بوبر: جمهوريَّة أفلاطون بوصفها مجتمعًا مغلقًا
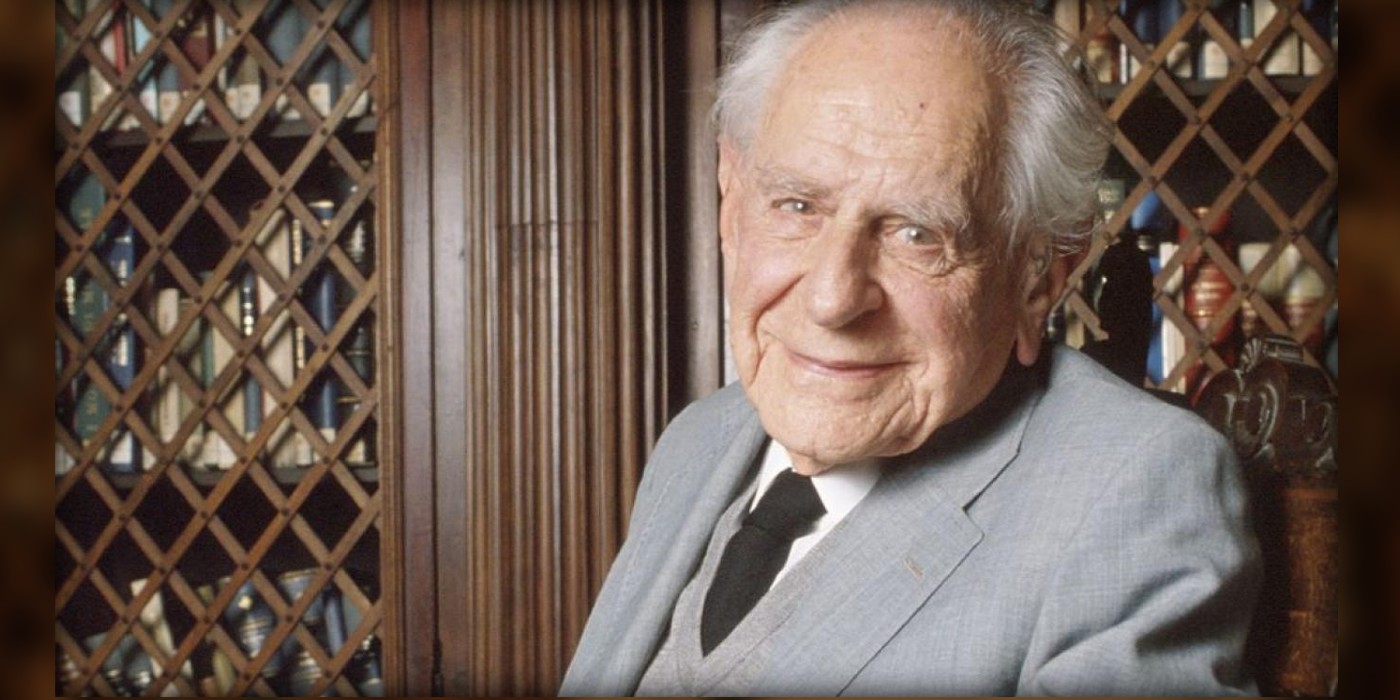
برع كارل بوبر في مجال الابستيمولوجيا وسطع فيها نجمه، إلا أنه لم يبق متسمرا في هذا المجال، فكانت له اهتمامات أخرى تطبعها بالخصوص ميولات سياسية، إذ عالج العديد من القضايا السياسية ذات الراهنية في بعض كتبه، خصوصا كتاب ” المجتمع المفتوح وأعداؤه “، الذي تعرض لمسألة مهمة جدا تتعلق بتقديس السلطة، حين يخنع الإنسان لعبوديته ويركن للخوف، فيصبح بذلك حبيس مجتمع مغلق لا منفذ فيه، مجتمع لا يأبه بالأفراد همه الوحيد أن يحافظ على ذاته، إنه يطمس الفرد ويغيبه، ولا يعترف به كمركز قرار أو كمحور لتحيين التغيير. ويشكل كتاب الجمهورية أول نص صريح يشيع فكرة المجتمع المغلق، القائمة على الشمولية التي تجمد الصيرورة والتغير، بما ينطوي عليه هذا المفهوم الأخير من معاني الثورة والفوران والهيجان والعصيان، وهذه المعاني لا تتناسب مع النظام الثابت المتسم بالكمالية والإطلاقية، لذلك حاول أفلاطون سد أي منبع يصدر منه التغير الكفيل بزعزعة الدولة.
إن نظام الجمهورية عند أفلاطون سرمدي بهذا المعنى، ينحرف عن مسار التاريخ الذي يفرض في ذاته الكثير من الثورات والتقلبات والتغيرات، وهي ديناميات تحكم التاريخ نتيجة مجموعة من المتغيرات كالفساد والانحلال …[1] وإذا قمنا بمحاولة فهم الجمهورية في إطار سياق الثبات والتغير، نلاحظ أن أفلاطون تلافى آفة الثورات التي تنتج أساسا من غليان الطبقة الحاكمة المفككة، والواقع أنه قد تأثر بشكل كبير باسبارطة التي كانت مدينة عسكرية في غاية الصرامة، ولأنها كذلك استطاعت التفوق على أثينا، مدينة الحكمة في الحروب البلوبونيزية، هذا الأمر لم يستصغه أفلاطون، لذلك نجد مدينته الفاضلة تتبنى النموذج الاسبرطي خصوصا في التنظيم الطبقي، الذي يعتمد على الطبقات المغلقة لحلحلة مشكلة الصراع الطبقي الفوضوي، وذلك ليس بإلغاء الطبقات، وإنما بمنح امتيازات تدلي بتفوق الطبقة الحاكمة بشكل لا يمكن معه مقارعتها أو مجابهتها، والمقصود بالطبقة الحاكمة هنا الحكام أولا ثم الجنود ثانيا، مع تغييب تام للطبقة السفلى من الشعب (من مساعدين وعمال وفلاحين وصناع) التي وصفها أفلاطون بالقطيع البشري، تنحصر وظيفتهم في تزويد الطبقة الحاكمة باحتياجاتها المادية فقط، إن أفلاطون قد قدم علامة شنيعة لاستعباد واسترقاق الناس بلغ حده مع الشيوعية التي تقتصر على الطبقة الحاكمة، حيث نالوا تهميشا واستبعاد من الحكم والتصويت، ولا يحق لهم التدخل في شؤون الدولة لكونهم منقادين بالشهوة. وطالما كانت الطبقة الحاكمة متحدة أي كأسرة واحدة، فلن يكون في مقدور أحد أن يتحدى سلطتها، وبالتالي لن يكون ثمة صراع طبقي[2] ، وطالما دس الانشقاق والاختلاف بين فئات الطبقة السفلى كلما كان إحساس الاتحاد والاستقرار قويا لدى الطبقة العليا. هذا القانون هو الذي يشكل أساس تحليل أفلاطون لوسائل إبطال التغير السياسي وخلق توازن واستقرار اجتماعي، وهو القانون الذي أعيد اكتشافه حديثا من قبل منظري النزعة الاستبدادية، وخصوصا منهم باريتو [3]، ويثار الحديث هنا كذلك عن الديموقراطية كنظام تصدى له أفلاطون بوصفه نظاما حربائيا فوضويا متقلبا ولا ثقة فيه، فانتزاع حق التصويت من الشعب وتعيين النخبة الارستقراطية لم يكن محض عبث، بل كانت له دواعي ثاوية، فالديموقراطية تتقوى فقط بالحرية التعسفية والمفرطة، الحرية التي يساء استخدامها ينجم عنها التبذير والشطط والبخل والتغطرس والتمرد على القانون، وفي ظل هذا النظام تنتكس الحكمة والاعتدال وتذيع الدناءة والجلافة [4]، وهذا يعكس بجلاء الارهاصات التي تواجه الحكومات الجمهورية التي تعتمد على الديموقراطية، إنها حكومات في الغالب تجلب السخط وعدم الرضا لأنها تنكث عهودها، ويغدو الناس الذين كانوا يهللون في بادئ الأمر بالحرية والحق في التصويت رازحين تحت نير العبودية، ويتعين عليهم أن يحاربوا من أجلها (أي الحرية) في حرب تلو الأخرى يشعلها قادة جدد ضد القادة المختارين كي يجعلوا الناس يشعرون بالحاجة الى قائد عام، ومن ثمة تنقلب الديموقراطية على عقبيها وتتدهور لتتلحف بزي الاستبداد، إن الدولة في إطار الديموقراطية المفرطة التي لا حدود لها تصل الى قمة الدناءة والرداءة .[5]
هذا الجانب الذي ذكره كارل بوبر مصبغ بالسياسة، أما فيما يخص الجانب التربوي[6] ، فرغم اختراقه وحضوره الوازن في الكتاب لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة لا غاية، نهجا لا نظرية، فأفلاطون لم يكن يهمه تربية وتعليم المجتمع بقدر ما كان همه بلورة نهج تربوي مخصص لفئة محددة منتقاة ، فإن النهج يسري على الخاص، إذ أن المثل التربوية العليا التي تهدف الى تنوير المواطن بوجه عام لابد أن تختلف عن تلك التي تهدف الى تثقيف صفوة مختارة منهم، فالأولى ديموقراطية شاملة، والثانية أرستقراطية انتقائية، ومنه فالتربية ما هي إلا مطية لترقية السياسة، فالتربية البدنية مثلا خصوصا الجمناستيك هو وسيلة لتقوية البدن كضرورة حربية لدى الجنود، والتربية الموسيقية هي وسيلة لخلق الإحساس المرهف والحكيم عند الحكام .
إنَّ قدسية أفلاطون وعظمته، بالنسبة لكارل بوبر، لا تكمن في تأملاته المجردة والمتعالية، بل في كونه تمكن من صياغة أول نظرية تقارب بنيات المجتمع المعقدة، وهي جرأة قل نظيرها قبل أفلاطون، لذا نجد كارل بوبر يسميه بعالم الاجتماع على عكس المؤرخين الذي يعتبرون اوغست كونت المؤسس الفعلي لهذا العلم، إن أفلاطون كان يتسم بنوع من الحذاقة والدقة في الملاحظة، لقد كان محللا اجتماعيا محضا، والدليل على ذلك من الكتاب أن أفلاطون على لسان غلوكون ذكر أصل العدالة وأرجع جذورها الى عقد اجتماعي أبرمه الأفراد فيما بينهم بشكل ودي لتجنب الظلم والتعدي، شعار العقد ” ألا يظلموا ولا يظلموا ” [7].
عادى كارل بوبر نموذج المجتمع المغلق السائد في الجمهورية ساعيا الى تأسيس مجتمعات مفتوحة لا تقبل الانغلاق والانطواء على نفسها، مجتمعات لا تكبح جماح الفرد المبدع بذريعة أنه يسير عكس التيار، فيتحرر بذلك من كل سلطة تكبله ومن كل عبودية يتقفص داخلها ويكسر عتبة الجمود والكساد.
بيبليوغرافيا:
1 ) أفلاطون، الجمهورية، ترجمة حنا خباز، دار المعرفة والثقافة.
2 ) كارل بوبر، المجتمع المفتوح وأعداؤه، ترجمة السيد نقادي، دار التنوير للطباعة والنشر، طبعة 1998 .
كارل بوبر، المجتمع المفتوح وأعداؤه، ترجمة السيد نقادي، دار التنوير للطباعة والنشر، طبعة 1998 ، صفحة 32 [1]
أفلاطون، الجمهورية، ترجمة حنا خباز، دار المعرفة والثقافة، ص 69 [7]
___________
*إبراهيم ماين: طالب باحث في شعبة الفلسفة بسلك الإجازة في المدرسة العليا للأساتذة بجامعة محمد الخامس بالرباط المغرب ، حاصل على شهادة الدراسات العامة في شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب و العلوم الإنسانية في جامعة ابن زهر أكادير .
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.








