جون ديوي:الديمقراطية الخلاقة والمهمة التي تنتظرنا
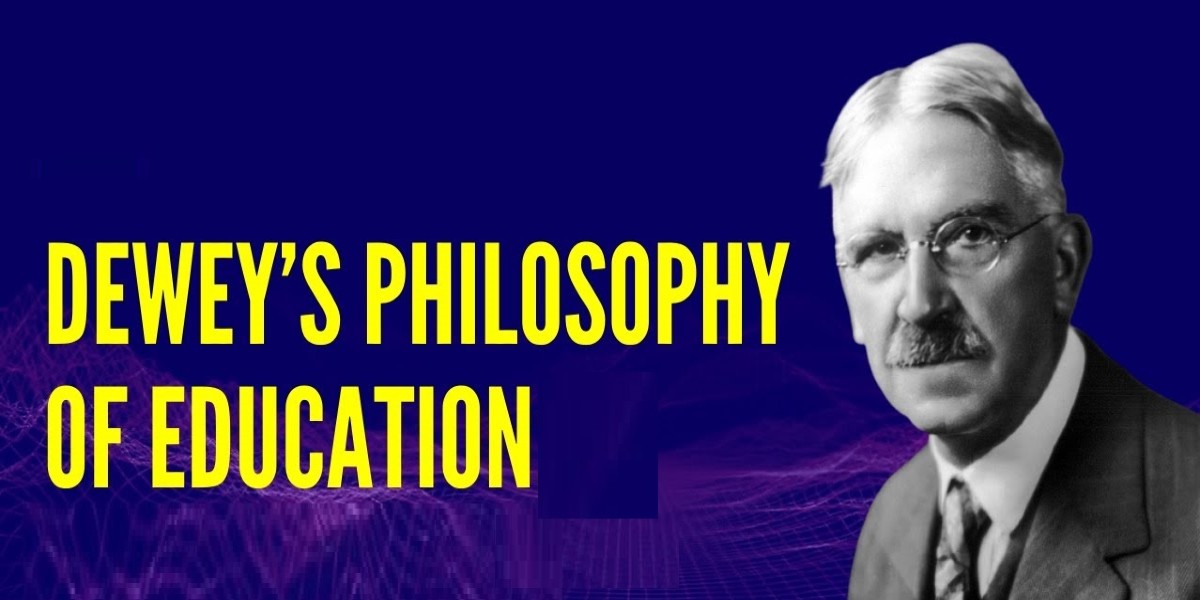
*بقلم: جون ديوي
ترجمة: علي أسعد وطفة
” سمي دستورنا ديمقراطياً لأن الحكم عندنا في أيدي الكثرة لا الأقلية، وتكفل قوانينا المساواة في العدالة للجميع، وإن الرأي العام عندنا ليرحب بكل ذي موهبة في أي نوع من أنواع العمل، وإننا نتيح الحرية للجميع في حياتنا العامة (…) ونتمسك بالقوانين التي تحمي المظلومين، وأبواب مدينتنا مفتوحة على مصراعيها للعالم (…) إننا محبون للجمال في غير إسراف، وللحكمة في غير ضعف، ولا نرى في الفقر عارا”
بيريكليس فيلسوف إغريقي (490 ق.م – 429 ق.م)
مقدمة المترجم:
يعد المفكر والفيلسوف الأمريكي جون ديوي (John Dewey) ( 1859 – 1952)قطبا مركزياً من أقطاب الفكر الإنساني في القرن العشرين، ويعد من أبرز العبقريات الفكرية في مجال الفلسفة والتربية وعلم الاجتماع، ولا يخفى أنه استطاع أن يعبر عن روح أمريكا الصاعدة في القرن العشرين، وهو أحد أبرز مؤسسي الفلسفة البرغماتية، وهي الفلسفة التي تعبر عن روح العصر بسيمائياته الرأسمالية وخصائصه البرجوازية.
وإذا كنا نقوم بترجمة مقالته اليوم (الديمقراطية الخلاقة والمهمة التي تنتظرنا) – وهي ملخص لمحاضرة جامعية ألقاها في عام 1939- فإن ذلك يعود إلى الأهمية الكبيرة لتصور ديوي عن فكرة الديمقراطية، إذ يقدم لنا في هذه المحاضرة تصورا إبداعياً نفتقده اليوم – وما زال كثير من المتخصصين يغفلون عنه – وهو أن الديمقراطية الحقيقة لا تقف عن حدود المظاهر السياسية الشكلية في التصويت والاقتراع والانتخاب، بل هي تعبير سيكولوجي عميق يتأصل في ذهنية الفرد وفي تشكيله الأخلاقي والإنساني. فالديمقراطية عند ديوي تتجلى روحاً متأصلة في عقل الإنسان ووعيه وتضرب جذورها عميقا في أخلاقه وإنسانيته، إنها بالأحرى تشكيل صميمي أصيل يدفع الإنسان إلى ممارسة وجوده الإنساني على نحو تتجلى فيه القيمة الإنسانية للإنسان.
نص المقالة:
يبدأ ديوي محاضرته بالقول: لا أخفي في هذه المناسبة بأنني أتممت الثمانين من عمري[1]، وقد شهدت بلادنا في غضون هذه المرحلة الزمنية التي عشتها أحداثاً جساماً، وإذا كنت أسرد بعض القضايا والأمور التي حدثت في هذه الفترة الزمنية فذلك لأنها ترتبط بالغايات الذي كان مجتمعنا يضحي من أجلها، وذلك عندما بدأت أمتنا تتشكل وتتكون وتسعى إلى بناء مجتمع ديمقراطي. وهذه الغاية ما زالت تحتفظ بأهمية اليوم وزخمها، كما كان حالها في الماضي أي منذ مئة وخمسين عاما، وذلك عندما اجتمع أفضل الرجال وأكثرهم خبرة وحكمة من أجل دراسة الوضع والعمل على بناء مجتمع سياسي ديمقراطي مستقل يتميز بطابع الديمومة والاستمرار.
لقد أفضت موجة التغيرات الحاصلة في السنوات الأخيرة إلى حصاد من النتائج الهامة والتي تقتضي منا أن نبذل جهداً مضاعفاً من أجل السيطرة على أنماط الحياة والوضعيات الناجمة وبصورة طبيعية عن ظروف مناسبة لحدوثها.
منذ ثمانين عاماً لم تكن البلاد قد شهدت ما تعرفه اليوم من حركة عمرانية، وباستثناء بعض المدن الكبرى، فإن شروط الوجود كانت شبيهة إلى حد ما بهذه التي كانت في زمن البناء والتشييد، ولا سيما عندما كانت تقاليد المؤسسين تساهم في بناء أفكار وعقائد متجددة. وعلى الأقل يمكن القول إن البلاد قد انفتحت على دروب جديدة تسعى إليها، ولا سيما الأقاليم التي كانت غنية بالمصادر الخام التي كانت ملكية مشاعية للدولة وكانت جاذبة وغنية بالثروات المادية والطبيعية. ومع ذلك كله يمكن القول إن أمتنا لم تولد من مصادر وظروف مادية خالصة، بل ولدت وتشكلت من أناس مبدعين استطاعوا أن يكتشفوا مؤسسات وأن يبدعوا أفكاراً جديدة مع حالات تفيض بالشروط المادية الجديدة. هؤلاء الناس كانوا دون أدنى شك مبدعين وخلاقين في جوانب الحياة الفكرية والسياسية.
وما يجب علينا أن ندركه جيداً، أن حضارتنا ليست نتاجاً لعطاءات مادية وفيزيائية فحسب بل هي وبالدرجة الأولى عصارة عطاءات أخلاقية وإنسانية. ومع ذلك نقول إن مصادر القوة التي لم توظف وتستثمر اليوم هي مصادر إنسانية بشرية أكثر منها مادية، والأزمة كما تعبر عن نفسها، منذ مائة وخمسين عاماً تكمن في مجال الإبداع الممكن في مادة الحياة الاجتماعية والسياسية، ونحن نعيشها اليوم بصورة تتطلب درجة أكبر من الإبداعية والقدرة على الخلق. ويترتب عليّ في هذا السياق التأكيد بأنه يجب علينا اليوم – أكثر من أي وقت مضى – أن نبذل جهوداً كبيرة وخلاقة ومستمرة من أجل بناء نوع من الديمقراطية المتقدمة، التي نجمت في الأصل – ومنذ مائة وخمسين عاماً في أفضل حالاتها – عن التنظيم الخلاق بين الأحداث والناس وهي الديمقراطية التي ورثناها، ونحن ما زلنا حتى هذه اللحظة نعيش هذا الإرث الديمقراطي.
وفي هذا السياق فإن الوضعية العالمية اليوم لا تذكرنا بضرورة تطوير مختلف أوجه طاقاتنا لكي نثبت الجدارة والأهلية فحسب، بل تضعنا هذه الوضعية الحالية في رهان التحدي الكبير الذي يوجب علينا في ظل هذه الشروط الحرجة والمعقدة، أن نحدد موقعنا في هذا العالم ، وذلك هو الأمر الذي حدده أسلافنا من قبل في شروط أقل صعوبة وتعقيدا.
وأنا في هذا السياق ، أؤكد من جديد بأن هذه المهمة لا يمكن أن تتحقق من غير قدرة على الإبداع والخلق والتجديد، وذلك لأن خطورة الأزمة الحالية تعزى في أغلبها إلى أننا كنا نتصرف، في الماضي القريب ، وكأن ديمقراطيتنا تتجدد بصورة آلية، وكأن أسلافنا قد وضعوا في داخل هذه الديمقراطية جهازاً آلياً يمكنه من اكتشاف المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها، ولاسيما في المجال السياسي. فنحن نتصرف وكأن الديمقراطية هي شيء موجود في واشنطن بصورة رئيسة أو في أية عاصمة لبلد آخر، وذلك تحت تأثير تدافع الرجال والنساء الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع مرة واحدة في العام، لقد اعتدنا أن ننظر إلى الديمقراطية بوصفها آلية تحدث عفوياً وذلك عندما يؤدي الناس وبإخلاص واجباتهم السياسية.
ومنذ عدة سنوات بدأنا نسمع وبصورة متزايدة بأن هذه الديمقراطية ليست كافية، وأن هذه الديمقراطية هي طريقة في الحياة، وهذه الرؤية هي رؤية حقيقة وصحيحة وهي تقودنا إلى ما هو جوهري بصورة مباشرة، ولكنني أتساءل في هذه السياق إلى أي حد بقيت فيه النظرة الخارجية للفكرة القديمة عن الديمقراطية راسخة في الذهنية، وفي كل الأحوال، يجب علينا أن ندرك نظرياً وعملياً بأن الديمقراطية هي طريقة شخصية في الحياة، وهي بالتالي ليست مجرد شيء خارجي يحيط بنا. فالديمقراطية هي: جملة من الاتجاهات والمواقف التي تشكل السمات الشخصية للفرد وتعمل على تحديد ميول وأهدافه في مجال علاقاته الوجودية. وهنا يجب علينا وبدلا من الاعتقاد بأن اتجاهاتنا وعاداتنا تكافئ الأنظمة، يجب علينا أن ندرك بأن المؤسسات والأنظمة هي تعبير وامتداد للاتجاهات الفردية السائدة.
إن الاعتقاد بأن الديمقراطية كطريقة فردية وشخصية في الحياة ليس جديدا، ومع ذلك عندما نضع هذه ا الاعتقاد في محل التجربة فإن ذلك يعطي لهذه العقيدة دلالة جديدة مجسدة قياسا إلى الأفكار القديمة. وهذا يعني أن بناء اتجاهات شخصية جديدة عند الأفراد يساعد في مواجهة القوى المعادية للديمقراطية ويساعد إلى النجاح في هذه المواجهة، وهذا بدوره يتطلب منا أن نعمل على تطويف اتجاهنا في الاعتقاد بأن الوسائل الخارجية العسكرية والمدنية، يمكنها أن تدافع عن الديمقراطية، وأن نؤكد بأن الاتجاهات الديمقراطية المتأصلة في عمق الأفراد، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من شخصيتهم، هي التي تمثل القدرة الحقيقية على حماية العطاء الديمقراطي والمنافحة عن وجوده.
فالديمقراطية طريقة في الحياة تنطلق من الإمكانيات الطبيعية للإنسان، وكذلك فإن الإيمان بأهمية وجود الإنسان الاجتماعي مقولة تتكافأ مع مبدأ ديمقراطي. والديمقراطية طريقة حياة لأنها تأخذ مكانها في داخل الإمكانيات الطبيعية للإنسان، فالإيمان بالإنسان الاجتماعي مقولة تتوافق مع المبدأ الديمقراطي، وهذا الإيمان سيفتقر إلى مغزاه ودلالته إذ لم يأخذ صورة عقيدة جوهرية في طبيعة الإنسان، وهو بالتالي إيمان يقرر بأن هذه الطبيعة الديمقراطية توجد في كل كائن إنساني رغم اختلاف اللون والعرق والجنسية والولادة والغنى المادي أو الثقافي. وحتى عندما تتجسد هذه الديمقراطية في صورة قانونية فإنها مع ذلك تبقى كلمة لا حياة فيها إذا لم تسجل في نسق الاتجاهات السيكولوجية العميقة التي تؤكد إلى أن الإنسان هو صنو الإنسان في مختلف جوانب وعلاقات الوجود والحياة اليومية الإنسانية. إن أدانه النازية لأنها حركة غير متسامحة وحاقدة أمر يؤدي إلى التعصب إذا كان وصفنا لها يقوم على أحكام مسبقة حول العرق واللون والدين والقومية.
فالإيمان بالمساواة هو عقيدة لكل إنسان مهما يكن أمره وله من الحق في أن ينال من عطائها. وبالتالي فإن مفهوم ديمقراطية الحكم مفهوم يشمل الجميع دون استثناء، لأنها تسمح لكل فرد أن على أن يوجه حياته دون الخضوع للإكراه ودون أن يرتهن لإدارة أحد ما مهما يكن أمره.
فالديمقراطية هي طريقة حياة شخصية، وهي طريقة لا توجد بمجرد الإيمان بالطبيعة الإنسانية فحسب، بل أيضا بأهمية الاعتقاد بأنه عندما تتوفر للإنسان الشروط المناسبة فإن الأفراد يستطيعون السلوك والتكيف بذكاء وقدرة أكبر.
لقد اتُّهمت لأكثر من مرة، من جهات معارضة لي، بأنني مسحور بثقة كبيرة وخيالية بأهمية ذكاء الإنسان وطاقاته اللامحدودة، وبأهمية التربية بوصفها علاقة ذكاء ونباهة. مهما يكن الأمر فإنني لست الذي أبدع هذه الرؤية، فقد تعلمت ذلك من الوسط الذي أعيش فيه وذلك بقدر ما كان هذا الوسط خاضعا للروح الديمقراطية. وفي الواقع ومهما يكن حال العقيدة الديمقراطية فإن دورها ينبع في المناقشة والانفتاح وذلك في مستوى الرأي العام، ووفقا لذلك فإن الاعتقاد بالإنسان الاجتماعي يبرهن على الدلالة الاجتماعية للأحداث والآراء. ففكرة الإيمان بالذكاء الإنساني لا حدود لها، وهذا الإيمان راسخ في المنطق الداخلي للديمقراطية، وأنه في اللحظة التي ينكر فيها أحد ما هذه الحقيقة فإنه بالتأكيد يخون انتمائه الديمقراطي.
إنني عندما أتأمل الشروط الصعبة التي يعيشها الناس اليوم في البلدان الأجنبية: الخوف من السجن والمرض والاعتقال، فإن ذلك يدعوني إلى التفكير بأن جوهر الفكرة الديمقراطية وضمانها الداخلي يوجد في إمكانية التوقف وبصورة عفوية في زاوية الشارع من أجل المناقشة حول ما قرأه الفرد هذا اليوم في الصحف، وفي حرية الحديث بحرية داخل قاعة أو حجرة مع بعض الأصدقاء. إن حالة اللاتسامح والقهر التي تنبع من مجرد اختلاف الآراء الدينية أو السياسية أو التجارية أو العرقية، أو لمجرد الاختلاف في اللون، أو في مجال التحصيل الثقافي، هي نوع من الخيانة والغدر تجاه الحياة الديمقراطية. وفي حقيقة الأمر، إن كل إعاقة للاتصال الحر والمتكامل هو عملية وضع الحواجز التي تفصل بين الأفراد في جماعات وطوائف متضاربة وهذا بدوره يشكل اعتراضا على نمط الحياة الديمقراطية.
إن القوانين التي تضمن الحريات المدنية كحرية الاعتقاد، وحرية التعبير، وحرية الإجماع، ليست مهمة في هذا المستوى وذلك إذا كانت حرية الاتصال وتدوير الأفكار مكبوتة وممنوعة، من خلال الشك والخوف والكراهية، وهذه الأشياء تدمر الشرط الأساسي للحياة الديمقراطية بدرجة عالية وذلك لأن هذه المظاهر تغذي الحقد والكراهية وانعدام الثقة واللاتسامح في نفوس الأفراد.
ولا بد لنا في هذا السياق من التأكيد على شرطين للديمقراطية وهي أن الديمقراطية هي طريقة في الحياة وأنها تنطلق من روح عقائدية في الإنسان قوامها التعاون اليومي بين الأفراد. والديمقراطية وفقا للشرط الثاني هي عقيدة قوامها أن حاجات الناس وغاياتهم أمور تختلف من شخص لآخر، وبالتالي فإن مواقف التعاون الودي، التي لا تعطي للتنافس أولوية كما نشاهد ذلك في الرياضة، حالة هامة جدا بالنسبة للحياة الديمقراطية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن تحرير الصراعات ما أمكن ذلك من مبدأ البطش والقوة، وتحويل هذه الصراعات إلى دائرة الحوار والذكاء واحتواء الأشخاص مهما بلغت درجة عدائهم كأشخاص يشكل أيضا جوهرا للحياة الديمقراطية. إن الإيمان الديمقراطي أيضا بأهمية السلام هو منطلق للاعتقاد بإمكانية توجيه التناقضات والصراعات نحو مسافات التعاون والتفاهم، حيث يمكن لكل طرف أن يعبر عن رأيه وذلك بدلا من أن يعمل كل فريق على إلغاء الآخر وإبادته. فالتعاون يجب أن يتم في دائرة الاختلاف، وذلك ينطلق من مبدأ الاعتقاد بأن التعبير عن الاختلاف ليس مجرد حق للآخر بل هو ضرورة ووسيلة لإغناء تجربة الحياة، وأن ذلك يشكل جانبا من جوانب طريقة الحياة الديمقراطية الشخصية.
قد يبدو أن كل ما قلته يمثل سلسلة من الترهات الأخلاقية التي تقال في الأماكن العامة، وأنا أقول في معرض الرد أنني من أجل ذلك قمت بإعداد هذه الأفكار. إن التنازل عن عادة الاعتقاد بأن الديمقراطية أمر مؤسساتي أو خارجي بذاته يقودنا إلى النظر إليها كطريقة للحياة الشخصية، وهذا يعني أن فهم الديمقراطية بوصفها مثالا أخلاقياً ضرورة حيوية، وأن هذا المثال عندما يصبح واقعا حقيقياً فإن ذلك يشكل مسألة أخلاقية، وبالتحليل فإن الديمقراطية هي حقيقة أكيدة إذا كانت ميدان للحياة المشتركة.
وبما أنني قد كرست حياتي في الممارسة الفلسفية فإنني ألتمس منكم أن تكونوا متسامحين، ومن أجل أن ألخص فإنني أعرف العقيدة الديمقراطية باختصار وذلك بالعودة إلى مفردات اللغة الديمقراطية؛ فالديمقراطية هي إيمان بلا حدود بقدرة التجربة الإنسانية على تنظيم الأهداف والمناهج التي تسمح للتجربة اللاحقة أن تكون أكثر غنى وتنظيما، أن كل أشكال العقائد الأخلاقية والاجتماعية تنطلق من فكرة أن التجربة يجب أن تكون في لحظة ما خاضعة لصيغة من الضبط الخارجي أي لسلطة يفترض أنها توجد خارج دائرة التجربة الداخلية، فالديمقراطية هي الاعتقاد بأن آلية التجربة الإنسانية تستفيد بصورة متزايدة من هذه النتيجة أو تلك.
فالنتائج الخاصة تحمل قيمة داخلية بالضرورة، وذلك إذا كانت تهدف إلى إغناء وتنظيم العملية اللاحقة، وذلك لأن أولوية التجربة يمكنها أن تكون تربوية وبالتالي فإن العقيدة الديمقراطية لا يمكنها أن تنفصل عن العقيدة أو التجربة التربوية، وبالتالي فإن كل الغايات والقيم التي تنفصل عن هذه العملية تتحول إلى كوابح وصيغ محددة، وهي بالتالي تعمل على تجميد وتحجيم ما تمّ اكتسابه بدلا من إغنائه وفتح المنافذ الجديدة للتجربة الأفضل، وإذا ما سئلت عما أعنيه بالتجربة في هذا السياق، أجيب بأنها هذا التفاعل الحر للأفراد مع الشروط التي تحيط بهم، ولا سيما في الوسط الإنساني والذي يشمل الحاجة إلى إنماء وتطوير معارف الإنسان عن الأشياء كما هي في الواقع، وهذا يشكل القاعدة الصلبة للاتصال والمشاركة، وبالتالي فإن أي اتصال يدل على نماء الرأي بين الأشخاص. فالحاجة والرغبة مصادر وموجهات للطاقة الإنسانية وهي تدفعنا إلى أبعد ما هو قائم، وإلى أبعد من حدود المعرفة والمعرفة العلمية، وهي توفر لنا الطريق إلى المستقبل الذي لم نستطلع أبعاده بعد، إلى الحدود التي لم نصل إليها حتى هذه اللحظة.
ومهما اختلفت طرق الحياة فالديمقراطية هي الشيء الوحيد الذي يطور التجربة الإنسانية وينميها بوصفها غاية ووسيلة، قادرة على تنظيم العلم والمعرفة والانطلاق بهما إلى الغايات المرجوة ، وهي تمثل القدرة الخلاقة على بناء تجربة المستقبل، وتشكل الأداة الفعالية القادرة على تحرير عواطفنا وحاجاتنا، وذلك من أجل توفير ما لم يكن في الماضي متاحا . إن طرق الحياة التي لا تأخذ طابعا ديمقراطياً كافياً تحدّ من إمكانيات الاتصال والتبادل والتفاعل الاجتماعي والإنساني. وغني عن البيان في نهاية القول إن التفاعل هو التجربة التي تغني وتوسع مدارك الحياة وعطاءات التجربة الإنسانية. وهذا يعني أن حرية الاتصال والقدرة على إحياء التجربة الإنسانية الديمقراطية يشكل مهمة يجب علينا أن نكرسها يوما بعد يوم، فالمهمة الديمقراطية تؤكد في كل يوم على أهمية بناء تجربة الحياة على نحو تتضافر فيه قيم الحرية مع القيم الإنسانية.
أصل المقالة بالفرنسية:
John Dewey: La démocratie créatrice et la tâche qui nous attends, Texte d’une conférence préparée en 1939 par Dewey a l’occasion d’un congrès organisé en l’honneur de ses 80 ans. In: Horizons philosophiques, Vil5. No2, 1997.
مراجع المقالة وهوامشها:
[1] – القول جون ديوي – ألقى ديوي هذه المحاضرة في عام 1939.
جون ديوي (John Dewey) ( 1859 – 1952) فيلسوف وعالم نفس أمريكي، أحد أهم مؤسسي الفلسفة البرغماتية
يعتبر جون ديوي من أشهر أعلام التربية الحديثة على المستوى العالمي. ارتبط اسمه بفلسفة التربية لأنه خاض في تحديد الغرض من التعليم وأفاض في الحديث عن ربط النظريات بالواقع ـ ويعد من آباء التربية البرغماتية، وهو من أوائل الذين أسسوا المدارس التجريبية في جامعة شيكاغو .
[i] – John Dewey: La démocratie créatrice et la tâche qui nous attends, Texte d’une conférence préparée en 1939 par Dewey a l’occasion d’un congrès organisé en l’honneur de ses 80 ans. in: Horizons philosophiques, Vil5. No2, 1997.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.





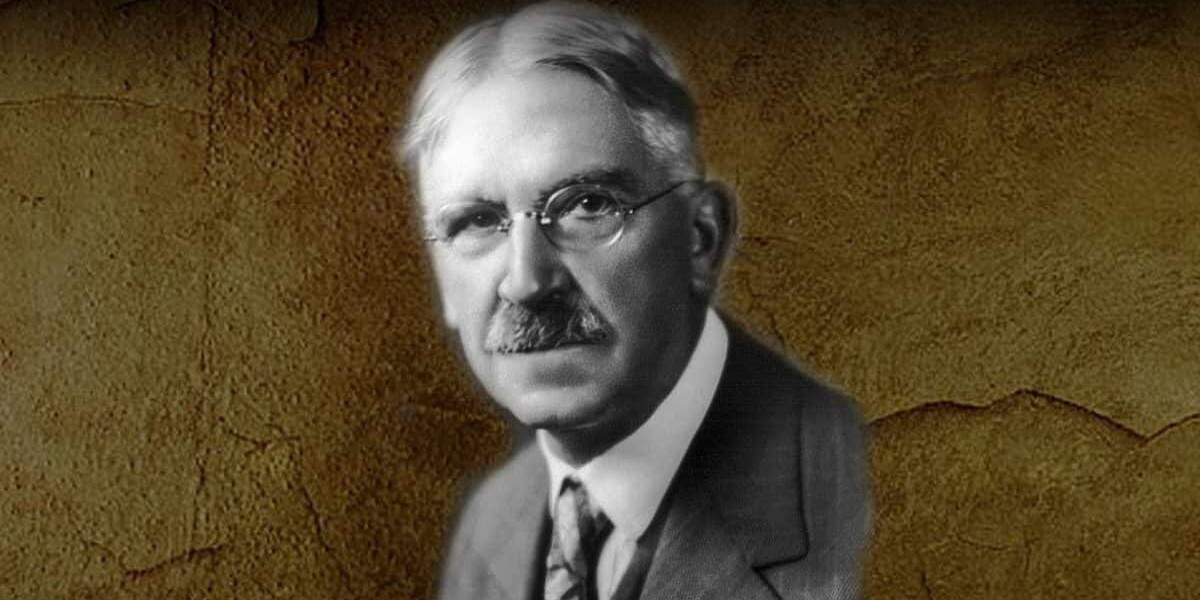
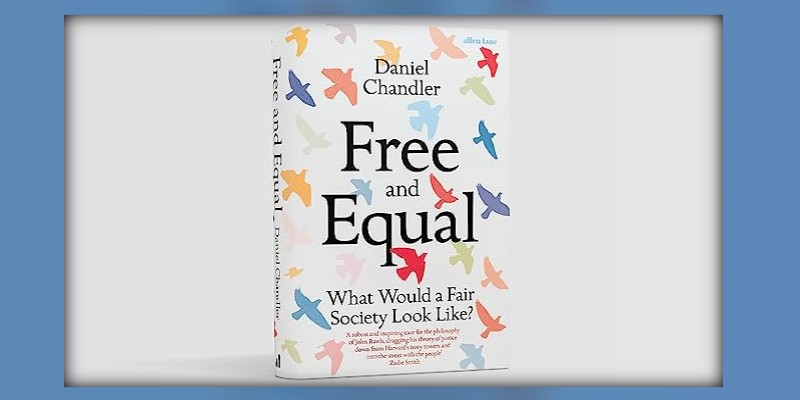
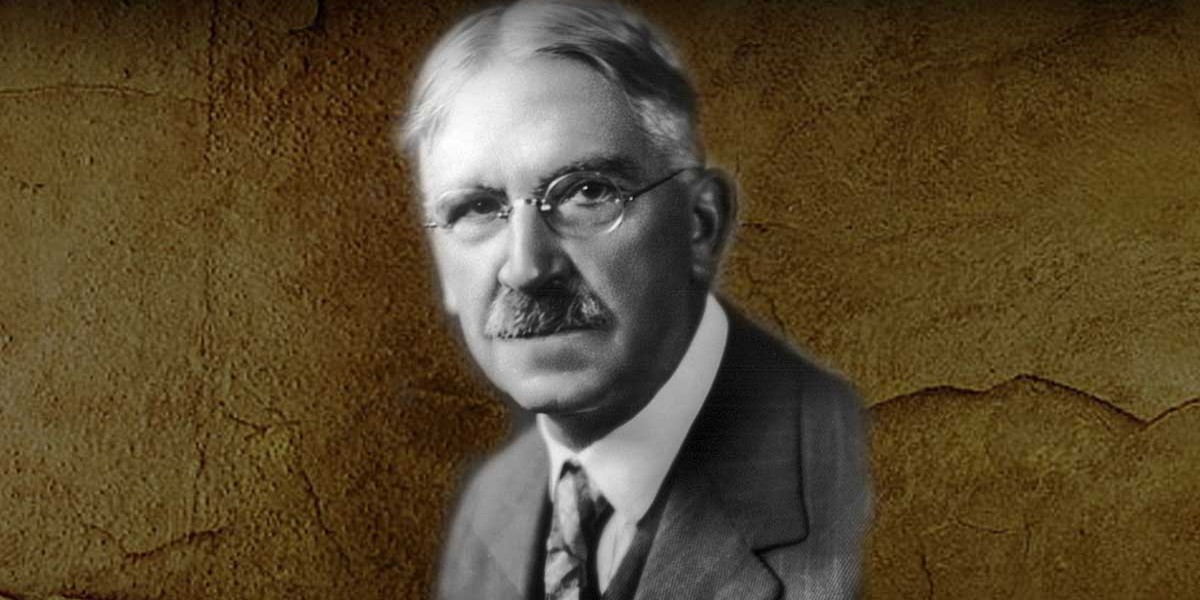

شكر وتقدير لجهودكم ا. د علي أسعد وطفة …مساهماتكم المرموقة في التأليف والترجمة والبحث والعطاء الثقافي …من شأنها إثراء المكتبة العربية، والإرتقاء بالتجربة الفكرية وصولا إلى غرس وممارسة مفاهيم التعاون والتسامح داخل دائرة التنوع وبوتقة التعايش السلمي الكريم.