محمد عناني ترجمان العربية الأمثل .. بحثًا عن التجربة

قضية التواصل بين الثقافات والحضارات قضيةٌ جوهرية لكل أمة حية؛ تسعى نحو الوجود الحقيقي الفاعل، والوعي بما حولها من معطيات مُشكِّلةٍ لواقعها المَعيش، وداخلةٍ في تصوير نموذجها القِيَميّ الحالي والقابل. هذا، وتتمركز قضية الترجمة على رأس هذه الوسائل للتواصل الإرادي من أمة تجاه أخرى. فالمترجم هو عين الأمة على العالم، وهو أداة التواصل الحضاريّ الفرديّ الأبرز. فبتعدُّد لغات الثقافات المختلفة، واستحالة التواصل المباشر للمجموع، حتى على صعيد المجموع الثقافي (فليس مطلوبًا بالضرورة من مُثقفي أيَّة أمة أن يجيدوا لغة أخرى، وإنْ أجادوا فكم من اللغات سيجيدون؟ وهم يحتاجون إلى الاطلاع الدائم والمتجدد على نتاجات غيرهم)؛ تتشخَّصُ في قوانا الواعية قيمةُ الترجمة والقائم عليها في وعي وضمير الأمم.
وفي عالمنا العربي الحديث والمعاصر -رغم ما هو مقرر من أهمية الترجمة الطاغية- تُصارع الترجمة في معارك شتى؛ ما بين عدم الوعي -الشعبيّ والرسميّ- بالأهمية الترجميَّة، وما يُقاسيه المترجم من تجاهل وضعف شديد في المقابل المادي لقاء عملية الترجمة، وعدم وجود خطة عربية واضحة ترسم خارطة الترجمة، وضعف الهيئات المختصة بها؛ وبين أشد العقبات المتمثلة في “النشر التجاري”، وما يستتبعه من اختيارات ترجميَّة شعبيَّة، ومن تأثير على جودة الترجمة، واختيار المترجمين، وتنميط الترجمة بقيود وممارسات هذا النشر. وهذه بعض من المُشكلات الإطاريَّة للترجمة في عالمنا العربي، غير ما في الترجمة داخليًّا من مشكلات جمَّة ينوء بها السياق هنا.
وبناءً على ما سبق، يقل أن يتوفَّر في عالمنا العربي -على أشد احتياجه للترجمة- مترجمٌ بارع مبدع يُكمل الطريق حتى نهايته، مُصارعًا كل هذه العوامل المُثبِّطة. ورغم هذا، بزغ نجم بعض المترجمين الذين لم يكتفوا بالصمود للصعاب؛ بل حازوا الريادة في هذا المجال الترجميّ، وتبدَّت خطاهم هدايةً لغيرهم، بل صاروا مدرسةً في الترجمة. ومتى وُجدت هذا النماذج؛ فقد وجب على المجتمع العلمي والفكري إبرازُها ومعالجتها والتنويه بأمرها؛ لا تمجيدًا لها، بل دراسةً للتجربة في محاولة لتحقيق أقصى إفادة منها، للمترجمين وللوسط الثقافيّ والحضاريّ العربيّ العام.
ومن هؤلاء أصحاب الريادة في مجال الترجمة العربية السيد الدكتور “محمد عناني” (1939 – 2023م)؛ عميد المترجمين العرب -كما يطلق عليه الكثيرون-، والذي استطاع دفع التجربة العربية في الترجمة دفعةً قد تُوصف بالحضاريَّة، عابرًا بها درجات في سُلَّم التحقق والتمظهر حيال غيرها من التجارب الترجمية الأخرى. ولعلَّ هذا العمل الذي أقدم عليه عناني يفرض دراسة أعماله فرضًا على الدرس الترجميّ العربيّ، بل على أدبيات الثقافة العربية. وتسعى هذه المحاولة إلى تجلية جوانب من تجربة عناني الترجمية من حيثيات ثلاث: الاستعدادات والسمات التي أسهمت في إثراء تجربته، والمعالم الكُبرى للتجربة الترجمية عنده، وأهم خصائص الممارسة الترجمية لعناني (أُسسًا وإجراءات). على أن التجربة تلتزم الاستنباط والتأمل المباشر في مشروع عناني لترجمة شيكسبير على وجه الخصوص.
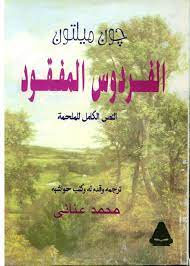
الاستعدادات التي امتلكها محمد عناني
المترجم الحقيقي كاتبٌ متمكن، يستطيع أن يقيم أَوَد النص الذي يبثُّه بثًّا من لغة إلى أخرى، قادرٌ على أن يواجه كامل إمكانات النص المصدر (المترجم عنه) إلى النص المستهدف (المُترجَم)؛ فالمترجم ينبغي أن يكون مُكافئًا -ولو على وجهٍ- لما يترجمه. وتتعاظم هذه الحاجة إلى كاتب حقيقي متمكن حينما يتعرض المترجم إلى النصوص الأعمق والأشد ثراءً ومراوغةً؛ مثل النصوص العلمية، والنصوص الفكرية والفلسفية، وعلى القمَّة النصوص الأدبية (خاصةً الرفيعة منها، وذات البُنى المتشابكة المعقدة).
وإذا كانت هذه الأصول صالحةً للتشخُّص؛ فستكون كامنةً في شخص عناني، الذي امتاز بإجادته التامَّة (بمعنى الإجادة للمستويات اللغوية كافةً الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والبلاغية) لكلا اللغتين اللتين يمارس بهما عملية الترجمة (الإنجليزية والعربية)؛ فضلًا عن إجادته للإنجليزية القديمة[1]. كما امتاز بأنه ناقد؛ والناقد بما تقتضيه الكلمة يمتاز بالرؤية الثاقبة، والتأمل الفكري (الناقد الحقيقي رجل فكر)، والسمت العلمي (الناقد الحقيقي رجل علم)، وسعة الأفق في تقبل الآراء، والهدوء تجاه ما يعالجه، واستهداف النفع العام (الذي قد يكون من معاني الموضوعية الحقيقية)؛ كل هذه السمات جعلت عناني صاحب حق أصيل في أن يمارس ما مارسه من تجارب ترجمية رفيعة.
كما تردف هذه الاستعدادات كونُ عناني أستاذًا جامعيًّا؛ مما يعرِّضه لعديد التجارب من تلامذته؛ على صعيد بناء المَلَكة الترجميَّة عندهم، والتأمل في نسبة الخطأ البشري في التعامل مع النصوص، ومُؤشِّرات التقدم في رهافة الإحساس بالنص. فضلًا عن كونه أديبًا وشاعرًا -والوصف الأخير على وجه الخصوص-؛ وهاتان صفتان ليستا مطلوبتين من المترجم، لتعلُّق الأولى بظروف عناني الوظيفية، ولتعلُّق الأخرى بالموهبة، فهي استعداد فطريّ لا اكتسابيّ، وعلى هذا لا يصلحان معيارين للترجيح في العمل الترجميّ، بل عاملَيْ ترجيح خاصَّيْنِ يردفان تجربة ترجميَّة خاصة. وقد أحسن عناني قياد هذه المنحة الشعرية خاصةً، في صوغ تجربته على أحسن وجه.
السمات النفسية التي تمتع بها محمد عناني
إن خوضَ عناني لهذه التجارب الترجمية التي تتسم بوعورة الطريق في مجرد القراءة لا الترجمة، وإكمالَه مشاريع تتسم بالضخامة من حيث الحجم؛ لَينبئنا بعدد من سماته النفسية الراسخة. من أهمها إخلاصه للعلم، والتفاني في العمل؛ وهاتان صفتان نطالعهما في كم الجهود المبذولة في الترجمات من مراجعات للمعاجم، وكتب النقد القديمة والحديثة، وتكفي نظرة لمَسرد المراجع في أيَّة ترجمة دليلًا كافيًا. وكذا اتسامه بالدقة وهي صفة لازمة لأي مترجم؛ ونراها في نمط معالجته للترجمات، خاصةً الأدبية منها بما تقتضيه من تعدد الوجوه التفسيريَّة، ودقته في حصرها وتحديد المراد الأوفق.
واتسامه بالأمانة الفنية في الترجمة نفسها، والأمانة العلمية التي اقتضته ذِكر كل مَن عاون في أية ترجمة، ولو بإرسال صفحة من كتاب، ولو بمراجعة بعض الكلمات في بعض المعاجم؛ فكان يصرُّ على إيفاء حق الجميع، صغر إسهامهم في العمل أم عظم. كذا كونه ذا إصرار على ما يريد[2]، وكونه حالمًا قد عشق ما يترجمه، لذلك استطاع إيصاله بسهولة ويُسر -على وعورته-. يقول عن مسرحية “طرويلوس وكريسيدا”: “وعاشت في وجداني بمواقفها، بل وببعض أبياتها وصورها”[3].
فقد توفَّرت لعناني من إحاطته نفسه بالكتب والنشاط الثقافيّ المشغوف به حالةٌ من الولع والهيام لما يؤدي؛ ولعلَّ التفاعل بين المثقف أو الباحث وموضوعه من أشد العوامل إيصالًا لدرجة الشعور الولائيّ للعمل. ولم يقس عناني تجربته الترجميَّة بما تُحقق له من نفع خاص؛ صحيح أنه تمتع بقدر معقول من الاستقرار، لكن ما ينتجه من ترجمات لا تدانيه أية مكاسب تحصَّل عليها. كذا لم تتم الموازنة بين جهده ونتاجه الثقافيّ وبين شهرته؛ قياسًا إلى غيره. مما ينبئ بأن جوهر رؤيته المُشكِّلة لمسيرته كانت مُتمحِّضة، لا مُلتبسة -على سبيل الهدف- بغيرها من المآرب.

المعالم الكُبرى للتجربة الترجميَّة عند محمد عناني
تتعدد معالم مشروع عناني الترجميّ، ويبدو من الصعب حصرها -لتنوع مادة ما ترجم، وللدخول تحت لعبة التصنيفات المتعددة لهذه المعالم-؛ لكنْ يمكن استيضاح أهمها في خمسة معالم.
أولًا: المساهمة في التنظير والتطبيق
إن اعتماديَّة مسألة التنظير -في أي مجال- تقع على الموهبة؛ فالخُلُوص من ربقة المواد واشتباكها إلى درجات التنظير هو مَلَكة لا تتأتى بالممارسة وحدها. وإن كان يدخل في حيز الضرورة للمُمارسة التماسُّ مع التنظير بدرجات متفاوتة، تسمح بتشكيل “رؤية المترجم” عن عمله الذي يُسمى “ترجمة”، وما يتعلق بهذا العمل تصورًا كليًّا، وبحثًا في تأثير هذا التصور على مسارات الإجراء الترجميّ.
هذا وتمتاز تجربة عناني بالعناية بهذا الجانب الترجميّ؛ فألَّف كتبًا خالصة للتنظير الترجميّ أثرى بها المكتبة العربية. كان أولها كتاب “فن الترجمة” 1992، الذي حاول فيه وضع التصور لمَن هو المترجم، وناقش فيه قضايا ترجمة الألفاظ والتراكيب والشعر. ثم أتبعه بكتاب “الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق” 1997، الذي تقدم فيه خطوات، مُناقشًا قضايا هامة في الترجمة الأدبية، من ماهيتها، وترجمة الشعر، ومعضلات التركيب البلاغي، وتأثير النغمة على المعاني وكيفياتها. ثم أنهى هذا الجهد بكتاب “نظرية الترجمة الحديثة” 2003، المُركِّز على مجال “دراسات الترجمة”؛ وما أُحدث في تصور ماهية الترجمة، وتشابكها، وذلك النظام العلائقيّ بينها وبين شبكات معرفية وثقافية أخرى.
اعتمد عناني في تجربته التنظيرية على رافدين أساسين: الدراسات الأجنبية في مجال الترجمة، مع متابعة حثيثة لتطور مسار هذه الدراسات، وتفريعاتها. والرافد الآخر هو الممارسة الترجمية المُعمَّقة لعناني؛ التي ساهمت -ابتداءً- بالتعرُّف على تلك الجهود التنظيرية الأجنبية في سني التجربة الممتدة، وبالفهم والتأمل للفعل الترجميّ النابع عن الخبرة، والذي يَفضُلُ ذلك الفهمَ المُتعلَّمَ من قِبَل الآخرين.
ثانيًا: تحويل الفعل الترجمي إلى مشروع ثقافي مُتكامل
هذا من أبرز ما أسهمت به تجربة عناني في مشروع الترجمة العربية الحديثة. فعناني لا يكتفي بترجمة النص -التي هي عهدة المترجم الأساس، وعمله الأصيل-، ولا بالسلوك المعتاد في تدبيج مقدمة تتناول سياقات العمل التاريخية[4]، وقصة العمل، وبعض التحليلات. بل كانت ترجمات عناني -الأدبيَّة خاصةً- موسوعةً ثقافيةً، ومشروعًا نقديًّا، ودرسًا في الترجمة. وهذا التكوُّن للمشروع الثقافيّ الحضاريّ أقامه عنصرانِ: طبيعة المؤلفات المختارة التي تعتورها الكثير من مشكلات الترجمة، وما قبل الترجمة -كإثبات نسبة النص للمؤلف، أو التحقيق في مشروع شيكسبير-، وإصراره على تحقيق الشكل الكامل للنقل؛ بما يقتضيه من مسألة بحث التحقيق -إن كانت مطروحةً-، والتطور النقدي للعمل المترجم من تاريخ تأليفه حتى اللحظة، ومناقشة هذه الأطروحات النقدية التي يطالع بها قارئ الترجمة، وبحث كافة وجوه التفسير في النص للوصول إلى أدق طرح، وذكر السياقات المحيطة بالنص. ولعلَّ هذا ما حوَّلَ كتبه المترجمة إلى كتب ضخمة، لا تتساوى -حجمًا- مع مثيلاتها من ترجمة مترجمين آخرين للعمل نفسه على أية حال؛ كما اضطره إلى هذه المقدمات الطويلة جدًا، وهذه المسارد للمراجع التي يحتوي بعضها على أكثر من مئة كتاب عاد إليها.
ومن طريف هذا الحرص على بحث كل شيء، وإيضاحه وتقديمه للقارئ -ولا أسوقه هنا للتسرِّي، بل مثالًا على سبيل “قياس الأَولى”؛ أيْ إذا كان هذا المثال موجودًا؛ فتصوُّر مدى الدقة في التعامل مع النص نفسه أولى-؛ أنه في السطور الأولى من مقدمة مسرحية “هنري الثامن” راح يفسر قائلًا: “ظهرتْ أول طبعة من هذه المسرحية، في آخر القسم الذي يتضمن المسرحيات التاريخية من طبعة (الفوليو) الأولى لمسرحيات شيكسبير عام 1623. ومعنى (الفوليو) هو القطع الكبير عندنا، أيْ حجم الصفحة الذي يبلغ ضِعف حجم هذا الكتاب الحالي بالعربية. ويدل أصلها على الطيّ مرةً واحدة للصحيفة الكبيرة المُعتادة في طبعات الصحف اليومية محليًّا وعالميًّا”. وهذا النقل الذي حرص فيه على تفسير حجم الطبعة التي ظهر فيها الكتاب الذي يترجمه يدل على ذلك الاستعداد الفطري الدقيق والتنظيميّ لديه؛ فهذه نفس تخاف أن يُفلت منها شيء، وإنْ كان هامشيًّا، وإنْ كان مبدئيًّا.
كما من سبيل تحويله الترجمة إلى مشروع ثقافي متكامل ما أنتجه من مؤلفات متعلقة ومتداخلة بهذه الممارسة الترجمية، منها ما ذُكر من كتب تنظير ترجميّ، ومن كتب أخرى تكمل دائرة الترجمة وتتعاطى معها. منها: فن الكوميديا، المسرح والشعر، المصطلحات الأدبية الحديثة.
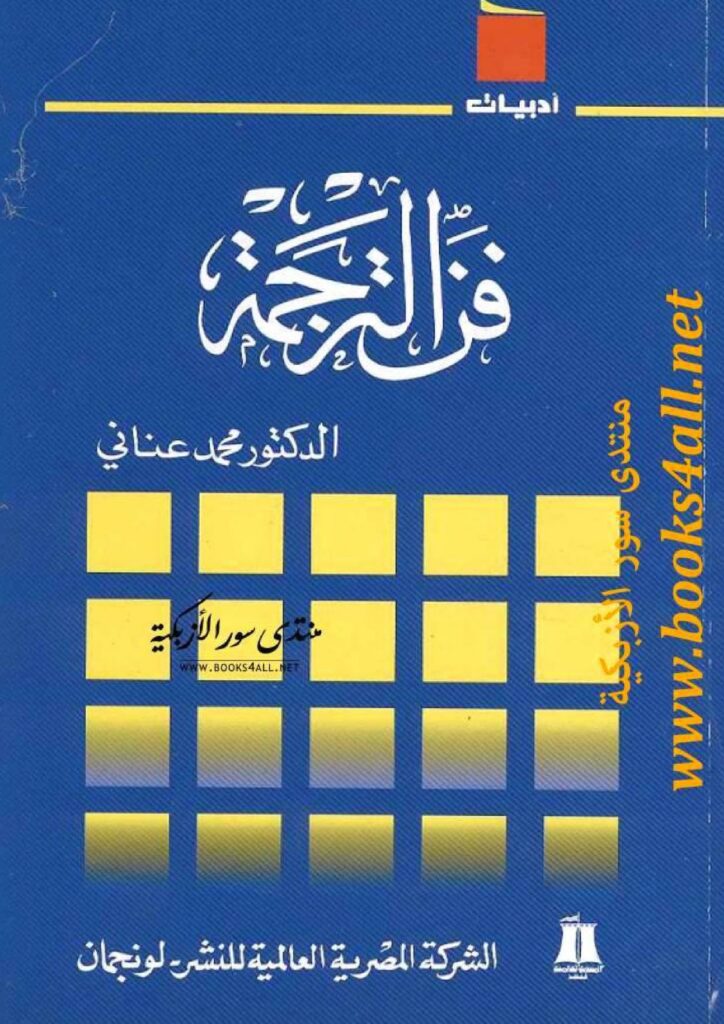
ثالثًا: مركزيَّة ما ترجم في الحضارة المنقول عنها
إذا كان المترجم هو عين الأمة المُبصرة للآخرين وإنتاجهم، التي تُشكِّل -بالتبعة- رؤاه وتصوراته؛ على سبيلَيْ التصوُّر الابتدائي والتصوُّر المُغيِّر؛ إذا كان المترجم هكذا فمن واجبه أن يختار ما يترجمه بدقة، حتى يحقق أعظم إفادة لأمته، وحتى لا يهدر فرصة للترجمة والنشر أهداها لغير الأَولى بالجهد والوقت والمال.
وعلى هذا البناء، فإن عناني من أصحاب الريادة في اختيار مركزيَّة ما يترجمه في الحضارة اللغوية التي ينقل عنها. فليست وحدها مسرحيات شيكسبير (وهي من أعظم المُؤلَّفات في التاريخ) التي نقلها عناني؛ بل هناك أيضًا: ملحمة الفردوس المفقود لملتون، ومختارات من شعر وردزورث، ودون جوان للورد بايرون، والمسرحيات الكُبرى لهارولد بنتر، وسونيتات شيكسبير، وغيرها الكثير من الكتب.
وإذا افتتن عناني بالكتب الكلاسيكية الأصيلة المركزية في الأدب الإنجليزي؛ فلم يغفل مراعاة متطلبات الواقع الآنيّ فيما ترجم. فترجم كتاب إدوارد سعيد المركزي “الاستشراق”، وكتابيه: تغطية الإسلام، والمثقف والسلطة. كما ترجم للمستشرقة والباحثة البارزة كارين آرمسترونج: سيرة النبي محمد، معارك في سبيل الإله (كلاهما بالاشتراك مع د/ فاطمة نصر)، وكذا كتاب “أين الخطأ؟” لأحد عرَّابي الفترة الحالية المستشرق برنارد لويس، وغيرها من الكتب القيِّمة. وهكذا نرى أن تجربة عناني لم تكن فرصة مهدرة من قوى العرب الثقافية، بل كانت تجربة واعية لما يستحق النقل؛ بين ما نبني به ثقافة وفن الترجمة (مترجمات شيكسبير)، وبين ما يحتاجه واقعنا الراهن، وما يتعاطى معه أشدَّ التعاطي.

رابعًا: الترجمة العكسيَّة
حققت تجربة عناني أكمل التصورات التي قد تُرجى من مترجم في أمة من الأمم. فما اكتفى بهذه الترجمات التي قد تكفي مجموع مترجمين، لا واحدًا؛ بل عرف دوره تامًّا، وأكمل دائرة الفائدة التي قد يرجوها مترجمٌ واعٍ، وراح يقيم التجربة الترجميَّة جسرًا للتواصل بين الحضارات. فترجم ما يربو على العشرين كتابًا للإنجليزية ألَّفها عدد من الشخصيات العربية، مثل مصطفى محمود، وفاروق شوشة، وفاروق جويدة، وعز الدين إسماعيل، وصلاح جاهين، وصلاح عبد الصبور، وغيرهم[5]. وتدل هذه الجهود على تلك المسئولية التي تحملها عناني على عاتقه، وإحساسه بواجب المترجم تجاه أمته في تقديم نتاجها للآخرين.
خامسًا: تجربة من ضمير الأمة
من آفات بعض مترجمي العرب أنهم من كثرة التعرض للنماذج الغربية ينتقل ولاؤهم تلقائيًّا، وتتيه بوصلتهم، ويظنون أنهم أجانب؛ فيتخذون الرؤى الغيريَّة، ويتلوَّنون بألوان الثقافات الأخرى. وقد خلت تجربة عناني من هذه الآفات، فنراه يسخر من المتعالمين بثقافات الغير: “وما أكثر مَن يتشدق بأسماء الأجانب بيننا؛ ليبهروا العامة بثقافتهم. تمامًا شأن المتشدقين باليونانية واللاتينية في العصر الفكتوري لكي يوحوا بالثقافة”[6]. ونراه يعرف وجهته وانتماءه ومَن يخاطبه “… ولكنني أختلف عنه في أن وجهة نظري عربية، ونماذجي عربية”[7].
وقد يغير عناني بعض التغييرات النادرة (مع التنويه بالأصل في الهامش؛ فهو دقيق وأمين جدًا لا يعطي لنفسه حق التغيير متى رأى) في سبيل مخاطبة الثقافة العربية؛ مبررًا فعله بهذا السبب. يقول: “منها مثلًا حذف عدد محدود من أسماء الأعلام الأسطوريَّة (وقد نصصتُ على ذلك في الهوامش) التي رأيتها غير مألوفة على الإطلاق للقارئ العربي، ورأيت أنها لا تعينه على إدراك الصورة”[8]. بل نعى على الشعراء العرب استخدامهم لمصطلحات غربية لمحض اتباعهم للغربيين[9].
- أهم خصائص المُمارسة الترجميَّة لمحمد عناني (أُسسًا وإجراءات)
- إنكاره فكرة التعادل المطلق في الترجمة الأدبية بين النصين. يقول: “إن الحديث عن التعادل المطلق بين نص أصلي ونص مترجم محضُ خُرافة؛ فالتعادل يمكن تحقيقه في الترجمة العلمية التي ثبتت حدود مصطلحاتها، وأصبحت أقرب إلى الرموز. وأما في الأدب فالتعادل دائمًا نسبيّ، وهو يرتبط بالمترجم الفرد مثلما يرتبط بالذائقة الاجتماعية في عصره”[10]. ولعل هذا الإنكار هو الذي دفعه ليصف ترجمته بأنها صورة من النص الأصلي. وعلَّل هذا الوصف بأن النص المُترجَم الآن باللغة العربية، وأن النص مُوجَّه إلى جمهور مختلف، وأن النص المترجَم مكتوب في زمن مختلف[11].
- نقل النص معاني وأساليب. وهذه من أصَل خصائص تجربة عناني. فقد استطاع تجاوز هذا السؤال الدائر حول مدى تحقُّق قراءة العربي لكتاب فلان؛ فإذا كان قد قرأ ترجمته فقد قرأ معانيه. لكن المعاني ليست كل النص، فأين الأسلوب؟! هل ما قرأه القارئ هو الكتاب كاملًا بمعانيه وأساليبه، أم أنه نقل لمعاني الكتاب؟ وقد قررت تجربة عناني اجتياز هذه العقبة، وتحقيق هذه المعادلة بنقل النص معاني وأساليب؛ حتى ليستطيع القارئ أن يدعي أنه قرأ لشيكسبير، ولا يقصد بذلك أنه قرأ “قصة وأحداثًا” أو قرأ “معاني وحِكَمًا”؛ بل أنه قرأ شيكسبير سبكًا واحدًا قائمًا. على أن هذا المعنى مُراعًى فيه تلك الضرورة التي تفرضها الترجمة ابتداءً، وضرورة الاختلاف الثقافي -بالمعنى الشامل لهذا التعبير-. لهذا لا تعارُضَ بين هذه الخصيصة وسابقتها من إنكاره التعادُل المطلق؛ بل إنكاره التعادُل المطلق يعني -بمفهوم المخالفة- أنه يتطابق مع النص المترجم في حدود قصوى، وينكر أن يكون النص المترجم نسخة طبق الأصل من النص الأصل. وبالعموم فقد كان عناني يترجم النثر نثرًا، والشعر المُرسل شعرًا مرسلًا، والشعر الموزون المقفى شعرًا موزونًا مقفى، وإذا استخدم شيكسبير لفظة مهجورة استخدم لفظة مهجورة بالعربية، وإذا هبط الأسلوب إلى درجة الكلام العامي هبط بدوره كذلك، حتى إذا شذَّ شيكسبير في كلمة وسط الحوار شذَّ عناني بها. فما أمامنا هو صورة حقيقية لما كتب الكاتب الأصلي، بكل ما تعنيه الكلمة من معاني النص، وأساليبه، ومستويات لغته. وهذه من تفرُّدات هذه التجربة عند عناني.
- نقل النص بالسياقات الكاملة له؛ وهذا يتعلق بمادة ما يترجم من مسرحيات، والمسرحيات تعتمد على عنصر “الحوار”. والحوار عملية اتصال حيَّة، أيْ مرتبطة بجوهر مَن يتحاور، بكل كياناته الثقافية والمعرفية والقِيَمية، وتاريخه وموقفه الراهن. وهنا يُعرِّف عناني الإطار الثقافي للنص: “أعني به الجو العام الذي يسود في عصر ما ويُملي على المتكلمين بلغة ما أنماطًا معينةً من الفكر والإحساس تُرسِّخ بدورها أنماطًا معينةً من الاستجابة للأعمال الفنية”. كما يُعرِّف الدلالات الكاملة للنص بأنها “الدلالات الحضارية التي تقوم على النظرة الشاملة؛ فالشخصيات المسرحية مُستمدة من واقعٍ بادَ وانقضى، ولا بُدَّ للمترجم أن يعيشه مرة ثانية في ذهنه، بعد الاطلاع الواسع على حياة الناس في المجتمع الذي خرجت منه الشخصيات، وبعد تمثل هذه الحياة إلى درجة كافية”[12]. كل هذا غير عنصر المقصود من كلام المتحاورين؛ مما يستدعي عناني إلى استقصاء كافة السياقات التفسيرية التي أوردها الشراح والمفسرون.
- الترجمة برُوح الباحث والناقد. وهذه موازنة أقامها عناني بين رغبته في الإبداع والتحقق وبين الحفاظ على النص المترجَم؛ خاصةً وهو يترجم أدبًا بأدب وشِعرًا بشِعر. وهذا اللون من الترجمة قد يسيطر على المترجم؛ خاصةً إنْ كان أديبًا شاعرًا أصيلًا، فإذا ما تعرَّض لمثل هذه الترجمات لم يستطع إلا أن يمارس شعره، مُبدلًا إرادته محل إرادة الكاتب والنص. لكن عناني استطاع أن يكبح جماح هذه التجربة، ويترجم كأنه يقيس بمقياس البحث الدقيق. ولعلَّ هذا الترشُّد من عناني هو عين الصواب، وهو يترجم الأدب؛ الذي يُخالف غيره من المنتج الثقافي؛ فالأصل في النصوص العامة والنصوص الفكرية الإيضاحُ، ونقل فكرة وتصوير شأن؛ أمَّا الأدب فالغموض والإلغاز قد يكون عنصر الإبانة فيه، وقد يقصد الأديب إلى الإلغاز قصدًا. وهذا ما يلقي على المترجم أعباء جمَّة، تتطلب تسخيرَ كافة الاستعدادات لديه، كما تتطلب ترشُّدًا في ممارسته الترجمية توجسًا من التيه في مسارب الأدب.
- قال الجاحظ عن ترجمة الشِّعر: “فالأشعار لا تستسلم للترجمة، ولا ينبغي أن تُترجم. فعندما تترجم الأشعار تتمزق بنيتها الشِّعريَّة؛ فالوزن الشِّعري ليس سليمًا، والجمال الشِّعريّ يختفي، ولا يبقى شيء من الشِّعر يستحق الإعجاب”[13]. وقد يكفي هذا الرأي في تصوير معضلة ترجمة الأشعار. فالشِّعر هو أكثر المنتجات الثقافية تعقيدًا وتركيبًا بطبيعة تصوُّره، وكيفياته. وقد دعَّمتْ القدرة الفطرية الشِّعرية لعناني اجتيازه جزءًا كبيرًا من هذه العقبة؛ فاستطاع أن يترجم الشِّعر باقتدار ورسوخ. وقد ناقش كثيرًا مسألة أشكال الشِّعر اللائقة بالنقل الترجمي، واستدعاء هذه الأشكال من النص الأصل، وعلاقة التعاطي بينهما، وقدرة الشعر وشكله ونوعه على الإيفاء بالنص المترجم. كما يهتم عناني اهتمامًا بالغًا بالوصول إلى أدق فهم للصورة الفنية في الشعر المترجم، ونقله نقلًا دقيقًا، وفي هذا السياق يناقش غيرَه من المترجمين شعرًا للأعمال التي ترجمها، ويعلق على تأثير الالتزام بالشعر بصورته العمودية على التفاوت بين الترجمة وبين الأصل، وعدم إيفاء الصورة الفنية حقها، أو تغييرها جزئيًّا أو كليًّا[14].
- تبدو إشكالية اللغة التي يستخدمها المترجم هاجسًا مُحيِّرًا. ويبدو النسق المتبع من عناني واضحًا في هذا الشأن -إنْ كانت لفظة الوضوح ملائمةً علميًّا لوصفٍ هنا؛ بما في عملية الترجمة من مزالق-؛ فعناني يحاول مطابقة النص الأصل، ويُدانيه مُداناةً قدر الطاقة الإنسانية. وتبقى لديه معضلة إضافية لا تتعلق بالترجمة، قدر تعلقها بواقع المُترجَم لهم؛ فعناني يترجم المسرح -وهذا عامل متعلق بالنص-، لعرب سيستغلون هذه الترجمة لتمثيل هذه المسرحيات على المسرح العربي للجمهور العربي -وهذا عامل إضافي على الترجمة ليس داخلًا فيها-. وبغضّ النظر عن معضلات التحويل الثقافي -التي نوقشت سابقًا-؛ تبقى معضلة مستويات اللغة التي يترجم بها. وقد حصر عناني المستويات المتعددة في اثنين: مستوى اللغة الرفيعة القديمة (وسمَّاها اللغة العالية)، ومستوى الفصحى المعاصرة -بغضّ النظر عن التجاوز في هذا الحصر-. وقد اختار عناني أن يترجم بمستوى الفصحى المعاصرة، التي تتعلَّق بالحياة، وتكتب بها الصحف، وتتعالَقُ بالعامية أحيانًا كثيرة[15]. هذا من حيث التنظير، ووصف عناني لما مارسه ترجميًّا؛ لكنَّ الترجمة نفسها تنفي ما قد يتبادر إلى الفهم من سُفُول عناني في مستوى اللغة؛ فاللغة العنانيَّة رفيعة عالية، تنساق مع ثقافة عناني المتعاطية مع النصوص الرفيعة -من اللغتين-، ومع مواد البحث التي يتفاعل معها.
- إضافة هوامش وحواشٍ ضخمة بالترجمات. وهذا الإجراء الترجمي لازم لأية ترجمة منضبطة لنص رفيع، فضلًا عن أن يكون قديمًا مضت عليه قرون؛ فلا يبقى أمام المترجم من مَناصٍ إلا أن يشرح ويبرر اختياراته من متعدد، التي اختارها بنفسه؛ وباختياره أعطى لنفسه الحق في ترجيح المعاني أو وجوه المعاني، وفي تفسير النص على وجهٍ. وعناني يدبِّج هوامش وحواشيَ ضخمة قد يتعدى بعضها مئة صفحة[16]. ويكتب عليها: “ثَبَت الحواشي، ويتضمن شروحًا نصيَّة، وتعليقات نقديَّة لم يتسنَّ إدراجُها في المقدمة”[17].
إنَّ تجربة السيد محمد عناني في الترجمة نقلت الترجمة العربية خطوات؛ نحو فهم أعمق لمعنى الترجمة، وللفعل الترجميّ، ولمُمارسة ترجميَّة أوثق في مواجهة نصوص بالغة الوعورة في التعاطي الترجميّ. وقد يبدو من المفيد التوفُّرُ على هذه التجربة دراسةً وتوثيقًا، بل تقنينًا؛ للوصول إلى استفادة عامة للمترجم العربي الحديث من تلك “التجربة العنانيَّة” الثرية الخلَّاقة.
[1] اللغات الأخرى تمتاز بقدر من التغيُّر الملحوظ على مرّ العقود والقرون؛ فهي لا ترتبط بالعنصر الجامع والمرتكز؛ كالقرآن والسنة في لغتنا العربية. وكلاهما يعمل على الحفاظ على تماسك اللغة العربية، أو تنميط حَرَكيَّتها في تشكُّل معيَّن.
[2] انظر مقدمة الطبعة الأولى من يوليوس قيصر بترجمته؛ حيث يعرض لحلمه الذي دام خمسة وثلاثين عامًا في ترجمة المسرحية.
[3] يستعيد هنا ذكرى الستينيات؛ وقد ترجم هذه المسرحية في العام 2010. أيْ بينهما نصف قرن تقريبًا.
[4] انظر مثلًا مسرحية “هنري الثامن” بترجمته صـ35، وما بعدها؛ حيث عقد مدخلًا تاريخيًّا لعصر هنري الثامن. وذلك لأن السياق التاريخيّ هنا سياق تاريخي أساس في تفسير النص.
[5] راجع مثلًا مسرد مؤلفاته ومترجماته في آخر سونيتات شيكسبير.
[6] تاجر البندقية، صـ32.
[7] نظرية الترجمة الحديثة، محمد عناني، صـ2.
[8] تاجر البندقية، صـ32.
[9] راجع السابق.
[11] تاجر البندقية، صـ9.
[12] تاجر البندقية، صـ10.
[13] نقلًا عن المنجز العربي الإسلامي في الترجمة وحوار الثقافات، من بغداد إلى طليطلة، د/ أحمد عتمان، صـ310. والنص المنقول من كتاب الحيوان لعمرو بن بحر الجاحظ.
[14] راجع تاجر البندقية، صـ32. وكذلك يوليوس قيصر المقدمة، وتجربة ترجمة السونيتات الشيكسبيرية، وكتاب الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق.
[15] راجع تاجر البندقية، صـ19، وما بعدها.
[16] مثلًا طرويلوس وكريسيدا.
[17] راجع مثلًا ضجة فارغة، بترجمته، صـ219.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.






