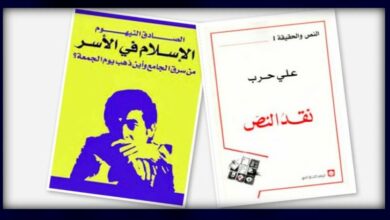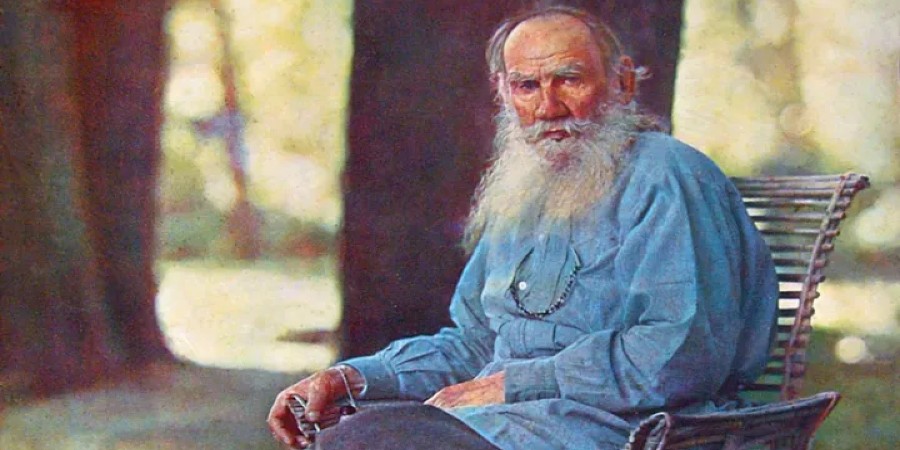( هل للإسلام القدرة على التَّمَدْيُنِ لمواجهة الفكر الغربي؟)
ما موقف الأصُوليّة من حركة الحداثة وما بعد الحداثة؟ سؤال من بين الأسئلة التي طرحها مفكّرون، وهناك من طرح هذه الأسئلة بصيغة أخرى لفهم العلاقة بين الإسلام والغرب إن كانت علاقة ندّيّة عادلة متحضرة، أم هي علاقة هيمنة على الآخر واستعباد له؟ المشكلة أنهم لم يتوصلوا إلى جواب مقنع، بعدما تحول “التعايش” مع الآخر إلى إشكالية حاولت بعض القوى فرض سيطرتها ونموذجها على الآخر بالقوة وتحويل الشعوب إلى تابع مستلب، لأن الفكر الحديث لم يتوصل إلى تعريف دقيق لمفهوم الحداثة وما بعد الحداثة في ظل صراع الأصوليات وظهور إيديولوجيات تولدت عنها قوميات برؤوس متعددة، بل ظهرت مصطلحات جديدة كمفهوم “الحداثة المتأخرة”، كانت النتيجة أن فقدت الشعوب هويتها وقيمتها الإنسانية، في هذه الورقة نرحل مع شخصيات فكرية عديدة اهتمَّت بمسألة الحداثة وما بعد الحداثة من هذه الشخصيات المفكر جان فرانسوا ليونار من رواد حركة ما بعد الحداثة في فرنسا وموقف المودودي من فكرة الحداثة في ردِّه على الأصوليين.
قد يتساءل سائل لماذا هذه الشخصيتان بالذات؟ الجواب لأن جان فرانسوا ليونار عاش في الجزائر في الفترة ما بين 1950 و1952 كانت فيها نيران الحرب مشتعلة بين الجزائر وفرنسا ووقف عن قرب على أساليب القمع الذي كانت تمارسه فرنسا ضد الجزائريين وآثار الاستعمار والتفرقة العرقية، كانت تجربته في الجزائر عاملا مهما في تشكيل “ضميره السياسي”، حسب الكتابات كان ليونار من دعاة الاختلاف والتعدُّد في كل المجالات وفي أنواع الخطاب المختلفة، له آراء في الحياة والثقافة والمجتمع، لقد ناقش ليونار كثير من المسائل المتعلقة بالحداثة وما بعد الحداثة، ومدى تقبل الفكر العالمي لها ولذا يقول عنه النقاد أنه من الصعب أن نفهم كتاباته، يرى ليونار أن العالم يمر بحركة تتميز بما أسماه “الانفجار الاتصالي عن بعد” وأنه يشهد تفكك المذاهب والنظريات والاتجاهات الفكرية الكبرى في المعرفة الأدبية والعلمية ويعاني من غياب أو اختفاء أنساق المعتقدات التي توجه الإنسان في تفكيره وسلوكاته وعلاقاته مع الآخر.
فمصطلح ما بعد الحداثة في نظره هو نتاج الفكر الأمريكي يصف حالة انتقاده في الوقت الراهن، وقد استعار هو هذا المصطلح لدراسة المجتمعات الحديثة التي بدأت في الظهور بعد نهاية العصور الوسطة، كما يفرق بين مجتمعات العصور الوسطى التي ربطت خطاب الصدق والعدالة بالقصص التاريخية، أما مرحلة ما بعد الحداثة يقول إنها فقدت هذه الخطابات ولم تعد تؤمن بالقصص التاريخية التي لم تعد تتماشى مع العصر الحالي وكأنها تريد أن تلغي التاريخ (الماضي) من حياة الإنسان، وتريد له أن يعيش حاضره فقط طالما هي تؤمن بأن الماضي انتهى والمستقبل مجهول، وبالتالي فمرحلة ما بعد الحداثة تفتقر إلى مشروعية ماهو صادق وما هو عادل، ممَّا أدَّى إلى ظهور واستفحال الحركات الإرهابية، هذه الأخيرة أوقفت كل عملية تفكير أو تقدم، يقول ليونار إن الأزمة ليست أزمة ارتفاع في سعر البترول وإنما هي أزمة هذه القصص التاريخية والحكايات الكبرى ذاتها، حيث تميزت بالتناقضات مثلما نقرأه عن مجتمع النبوّة بعد وفاة الرسول ( صلعم) وما وقع من حروب وجرائم قتل استهدفت أهل البيت، انقسم فيها المجتمع المسلم إلى شيعة وسُنّة تقاتلت فيما بينها، وحتى الحروب بين الكنيسة والدولة في المجتمع الغربي.
ما اتفق عليه المفكرون أن حركة ما بعد الحداثة (كحركة فكرية) تقوم على رفض الأسس التي ترتكز عليها الحضارة الغربية الحديثة وترفض المسلمات التي تقوم عليها هذه الحضارة، لعل ليونار هنا يتحدث عن الأصولية الغربية وبلوغ نهايتها ( أي توقف دور الكنيسة)، هي دراسات سلط فيها المفكرون الضوء على العائلات التي تعيش بصورة دينية محددة، حياة تقليدية ومنعزلة، وعائلات أخرى ناشطة دينيا ولكن بطريقة أصولية، وهذا يعني ليس كل ما يراه المرء أصوليا يكون في واقع الأمر كذلك، هو الشيء نفسه ما نراه في الأصوليات الإسلامية التي تعيش الآن صراعات داخلية بينها وبين نفسها فلا هي سارت على النهج ألأصولي ولا هي سايرت الحداثة، وظل الصراع في المجتمع العربي افسلامي قائما بين الأصالة والمعاصرة.
نلاحظ هنا كيف بتلاعب المفكرون والفلاسفة بالمفاهيم والمصطلحات ( الحداثة، ما بعد الحداثة والحداثة المتأخرة)، فالمفكرون يرون أن ما توصلت إلى الحداثة المتأخرة ما هي إلا نماذج، السؤال هل الحداثة المتأخرة تأتي بعد مرحلة ما بعد الحداثة؟ أم أنه لا توجد هناك حداثة أصلا، الأمر وما فيه أن المفكرين والفلاسفة يبتكرون مفاهيم ومصطلحات ويبحثون عن مرادفات لها، كمفهوم العصرنة الذي يقابله مفهوم الحداثة ونقيضها الأصالة، خاصة عندما يدور الحديث عن الإسلام والغرب أو الصراع بين الشرق والغرب إن صح القول، ومثل هذه النقاشات قد تؤدي إلى الفهم الخطأ للدين، فما يطرح هنا وهناك ماهو إلا تلاعب بالألفاظ أو الكلمات، وطرح أسئلة لإثارة مشكلة ولا نقول إشكالية، الحديث هنا يقود إلى الحديث عن الأصوليين الذين يقفون ضد مشروع الحداثة، وهم مجموعة نظمت نفسها في حركات اجتماعية ويتعاملون مع قضايا معينة، لها أهميتها بالنسبة لهم، فهم يجعلون القناعات الدينية مُطْلَقَة وغير قابلة للنقاش، وكما هو معروف فإن الحركات الأصولية لا تؤمن بالحداثة ولا بما يعد الحداثة، فهي تريد إخضاع الحياة الخاصة والعامة لإملاءات قناعاتها الدينية من باب بناء الهوية بل توحيدها والحفاظ عليها ويُقْصَدُ بذلك الهوية الدينية، يكون ذلك بوضع حدود منيعة تفصلهم وتميزهم عن الآحرين.
و كمثال ففي المجتمعات الإسلامية جعلت بعض الجماعات ( في العراق وإيران ومصر والجزائر ..الخ) من الزيّ الإسلامي (اللباس) قيمة دينية، أي على الرجل أن يرتدي القميص ويطلق اللحية والمرأة تضع النقاب أو البرقع وتلبس القفاز والجوارب لكي تتميز عن باقي النساء حتى لو كن مسلمات، ( ياحبيبي ماهذا التعصب؟)، مثال آخر يتمثل في طرح قضية “المهدي المنتظر” لدى كثير من المفكرين وحتى عند المرجعيات الدينية وقضية الروح القدس المذكورة في الإنجيل والقرآن وما طرأ حولهما من خلافات بين المسلمين الذي اختلفوا حول مجيئ المهدي المنتظر، فهذا المهدي عند أهل السنة والجماعة يختلف عن رؤية الشيعة له ( الإمام الغائب) فكل طائفة تصف هوية الأخر (الغريم) وصفا سلبيا، سؤال موجه للأصوليين (المسلمين) أو كما يسمونهم بـ: “مجتمعات الكتاب” طالما الأصولية هي البقاء على النهج القديم أي السلف في تفكيرهم وسلوكاتهم، لماذا إذًا يستهلكون ما يبتكره الغرب؟ للعلم أنه من السّلف ظهر مفهوم “السلفية” كتيار سياسي أعطيت له صبغة دينية وهذه الأخيرة منقسمة إلى طائفتين أيضا: السلفية المعتدلة (المدرسة الباديسية كمثال) والسلفية المتطرفة (الوهّابية).
إن الاختلافات في الرؤى جعلت مصطلح ما بعد الحداثة يحظى باهتمام كبير عند المفكرين بمختلف جنسياتهم ويعتبر المفكر أرنولد توينبي أحد رواد هذا التيار الفكري، ويرجع ذلك إلى موقفه الفكري من الحضارة الغربية في القرن العشرين وما اعتلتها من عوامل التفكك، والسؤال يفرض نفسه: ألم تعتر الحضارة الإسلامية عوامل تفكك هي الآخرى وفي كل مظاهرها الفكرية والثقافية؟ لدرجة أن البعض اعتبر مرحلة ما بعد الحداثة تتمثل في الفجوة التي تفصل الثقافة الراقية الرفيعة في كل مجتمع غربي كان أو عربي، بدليل ظهور بعض الثقافات الدخيلة وإدخالها على الثقافة العربية، مثل ثقافة الـ: pop أو الجاز jaz والبلوز blooz عند الأمريكيين السود وكذلك فن “الراي” Rai الذي وصفه البعض بالوباء السيداوي ( نسبة إلى داء السيدا)، فما هو متفق عليه هو أن هذه الثقافات قرينة العقليات الشاذة، تحركها اليد الخفية الصهيونية الفرنسية فهي لا تعكس موقفا ولا تعبر عن فلسفة، تسعى فقط إلى تشويه الأذواق وتحطيم الفن الأصيل، فكل ما يستهلكه المجتمع العربي هو غربي، لكن هناك تغيير في اللون فقط، والجزائر واحدة من الدول التي أصيب شبابها بهذا الداء، إلا من رحم ربي ذلك باسم التقدم والحداثة، وهذا يعني أن ما بعد الحداثة التصقت بها حالات من التدهور والإنحطاط الإجتماعي والثقافي، وعلى مفكري ما بعد الحداثة أن يطهروا فضاءها من مخلفات الحداثة.
فما حدث للمجتمع البشري هو نفسه ما حدث للغراب الذي جاء يمشي مشية الحمامة فلا هو حافظ على مشيته ولا هو مشى مشية الحمامة، هو مثل ينطبق على المجتمع الإسلامي، فلا هو حافظ على هويته وتراثه وحضارته ولا هو مارس حضارة الآخر ممارسة صحيحة، حتى بعد ظهور الأصوليين الذين فشلوا في جمع الشتات، لأنهم تتبعوا استراتيجيات هيمنة مختلفة باستعمال الخطاب الغير عقلاني وهم الآن يتعايشون مع الآخر باستعمال كل وسائل التكنولوجيا الحديثة، لكننا لا نعلم إن كان هذا التعايش هو لبناء هوية جديدة أو استعادة الهوية المفقودة ومحاولة إقحامها في المجتمع المتطور ( الغربي) ومسايرة “العولمة”، أما عن الثقافات الإسلامية ما تمت الإشارة إليه من بعض الباحثين هو أن الحداثة جاءت في صورة الإستعمار الفرنسي والبريطاني وكانت ساعة ميلادها في الشرق الأوسط عام 1798 في المعركة التي دارت رحاها أمام الأهرامات وارتبط اسمها في بداية الأمر بنابوليون، ثم تطورت بتاثير بريطاني كانت في البداية تحت إدارة نواب الملوك الخديويين في القرن التاسع عشر وبعد معركة التل الكبيرعام 1882 أصبحت تحت السلطة البريطانية المباشرة.
وإذا كان جان فرانسوا ليونار من المفكرين الفرنسيين الذين اثاروا بفكرهم الساحة الغربية بصفة عامة وفرنسا بالخصوص، فهناك من أرخوا للفكر العربي المعاصر وأخذوا انطباعات عن أوروبا، فمالك بن نبي كمفكر تنويري وكذلك محمد أركون وطاهر الجزائري رائد التجديد الشامي والطهطاوي من أمثال هؤلاء، فقد دوّن الطهطاوي رحلته إلى فرنسا ومشاهداته ووقف على الأحداث والإضطرابات التي عاشتها باريس في 1830 ومكنته رحلته من الإطلاع على كتب روسو ومونتسيكيو، ضمها في مذكراته سماها “الرحلة الباريسية” كما نقف مع مفكرين جدد في العراق وفي تركيا وفي لبنان ( مهدي عامل في نقده الفكر اليومي) كانت كل مشاريعهم تنويرية، إلا أن أفكارهم اصطدمت مع الفكر السلفي الذي يرفض التجديد والتغيير، وقد لاحظ المفكرون أن الخلط في الأذهان وراء عودة المجتمعات البشرية إلى الجاهلية بما فيها المجتمعات الإسلامة وهو منح الحق في “الحاكمية” لبعض البشر وجعل منهم “أربابًا” كما نلمسه في المجتمع الإيراني وقضية ولاية الفقيه، حيث ترى إيران أن البنية التاسيسية للمجتمع العربي هي بنية دينية وأن الدين هو المحرك الأول للمجتمع العربي.
من هذا المنطلق كانت هناك دعوات لفصل الدين عن السياسة ومنهم دعوة سيد أحمد خان في الهند، حيث دعا إلى التنوير الأوروبي وفصل الدين عن السياسة، ما دعا بالمودودي إلى تأسيس الجماعة الإسلامية التي تعتبر واحدة من أكبر منظمات الإسلام السياسي ويعتبر المودودي من أكبر منظري الإسلام السياسي، حيث استطاع أن يطور المنشور الحداثي وأن يعيد صياغة التراث الإسلامي، فقد أعاد الإجتهاد في فهم التراث في ضوء متطلبات الحداثة وخرج من هذا المنظور بنموذج الدولة الإسلامية المتفتحة على الحوار، يقول النقاد أن المودودي وجماعته الإسلاميين مبرمجين لكنهم ليسوا أصوليين ويقابله الأفغاني ومحمد عبده الذي قام بعمل إصلاحي في الإسلام لجعله قادرا على الدخول في حوار مع الحداثة، لم يختر الأقغاني النموذج “السلفي” في إعادة تطبيق النصوص الدينية وإنما عن طريق فتح باب الإجتهاد، أي من خلال تفسير حُرّ وتأويل للقرآن والتراث مع الوعي بالبعد التاريخي، إلا أن هذه الإصلاحات حسب النقاد باءت بالفشل .
فشل الإصلاحات وراء تأخر العرب
تؤكد بعض الدراسات أن تقدم الغرب وتأخر الشرق راجع إلى فشل الإصلاحات في العالم العربي الإسلامي فموقف الدول الإسلامية المتحررة إزاء التجديد والتغريب اعتبرت القانون الإسلامي غير صالح للتطبيق في هذه الحياة كثلما حدث في تركيا أيام كمال اتاتورك الذي الغى الإسلام كدين دولة رسمي للبلاد وألغى المحاكم الشرعية والخلافة والحجاب وسارت على هذا النهج إندونيسيا التي قالت أنه لا يشترط الإسلام لأي موظف حكومي أو ضابط في الجيش أو رئيس جمهوربة ولا يلزم عليه أن يقسم بالله والرسول، وكل إنسان حُرٌّ في اعتناق أيّ دين وبفضل هذا التجديد والتغريب كانت أندونيسيا تتقدم نحو الشيوعية بقيادة رئيسها سوكارنو، لولا فطنة الشعب والطلبة، كما نلمس ذلك في تونس أيضا من خلال خطاب الرئيس الحبيب بورقيبة في مؤتمر انعقد في مارس 1974 عندما قال أن المسلمين وصلوا إلى حد تأليه الرسول بتكرارهم الصلاة عليه ونفس الشيئ حدث في الجزائر عندما ساق زعماؤها البلاد نحو مادية اشتراكية علمانية ونحو الحضارة الغربية رغم الأمال التي عقدتها العناصر الإسلامية فقد نشرت جويش أوبسرفر jewish observer وهي صحيفة يهودية في عددها الصادر في 31 أوت 1961 مقالا تحت عنوان: “حكم الإسلام لابد أن يسود” أن علماء الجزائر هاجموا القادة القوميين الذين نادوا بدولة جزارية اشتراكية تعطل فيها الدين عن التدخل في شؤون الدولة.
الصراع إذًا هو صراع الثابت والمتحول، بين المقدس واللامقدس ( ولا نقول المدنس) ليس في الصورة التي عرفتها الجاهلية وإنما في الصورة التي رسمتها الحداثة التي يوجه لها معارضوها انتقادات ويعترفون بأن مبادئ “فلسفة التنوير” هي التي ساعدت على قيام الثورة الديمقراطية في العالم الغربي خاصة في فرنسا وأمريكا، إذ يرى التنويريون أن الزمن تغير وهو بحاجة إلى نظريات ومفاهيم جديدة تتلاءم والإتجاهات الثقافية الجديدة وتنوع المو اقف الفكرية، بل ظهور اتجاهات جديدة في الفن تجاوزت المدارس الحديثة، كما يطرح التنويريون قضايا في شكل أسئلة: ( ماذا أعرف؟.. أعرف “نفسي”، إذن هي فلسفة، ماذا أعرف؟ أعرف “ربي” إذن هو “الدين” فقط، ماذا اعرف؟ أعرف “حاكمي” إذن هي سياسة) هذه العناصر الثلاثة ( الفلسفة، الدين والسياسة) هي التي ترتكز عليها التنويرية.، خلاصة االقول فما ـثبتته الدراسات أن الحداثة في كل الدول وبخاصة الدول الإسلامية لم تكن نتاجا طبيعيا لثورات وإنما نشأت من خلال وجود قوى الإستعمار الغربي وأذرعها الداخلية المتمثلة في النخب العلمانية مما يعطي لهذه الحداثة طابعا خاصا بوصفها مقوما لنشأة الأصولية الدينية أو السلفيين المحافظين مرورا بالإخوان المسلمين وصولا إلى علماء اللاهوت، حتى الوهابية فهي منقسمة جزء منها محافظ والجزء الثاني فهو ثوري مرتبط مع جماعات إرهابية، فوقع الصراع بين جماعتين الأولى تقوم على المعتقد والثانية تقوم على الطقس ز هو تلصراع الذي لا يزال قائما حاليا بين السنة والشيعة، نقف هنا مع مفكر معاصر وهو الباحث المغربي محمد زكاري في دراسته حول مشروعية الإصلاح حملت عنوان: “الإصلاح بوصفه مشروع غير مكتمل” حيث قال: لا بد لنا ونحن نفكر في مشروع إصلاحي حقيقي، أن نعيد الاعتبار لما أسسه وقعّد له جهابذة الإصلاح والمشروع النهضوي، منذ القرن التاسع عشر، في غرب العالم الإسلامي ومشرقه، فلا يصيرُ فعلاً واقعيًّا إلا متى حرَّكتهُ إرادة مجتمعيَّة، يشاركُ فيها الفاعلون السياسيون بالقدر نفسه الذي يشاركُ به أفراد الشعب، متجاوزين الوضع الصوريّ الذي أنتجته الديمقراطيَّات المعطوبة وبه تصيرُ العمليَّة الإصلاحيَّة جزءاً من مشروعٍ شاملٍ، هدفُهُ الوحيد النهوض بالمجتمع من دواليب التَّخلُّف والبحث عن سبُل التَّقدُّم، غير ان محمد زكاري له رؤية خاصة لمفهوم الحداثة، ويبدوا أنه من المدافعين عنها، إذ يقول: فالحداثة هي اللحظة التي تم فيها الوعي (مع التّشديد على معنى الوعي) بما أنتجه العقل الغربي خلال مراحل نهضته، لكن الحداثة على المنوال الغربي ليست معياراً، ولا ينبغي أن يؤخذ هذا الكلام حجة لدى التيارات المحافظة التي تهوي بالغرب إلى مستوى الشيطانية، فما اتصل بعدم قدرة العرب والمسلمين اليوم على مجابهة الإشكاليات الهوياتية الكبرى، وعدم قدرتهم على إعادة الاعتبار للمقومات الحضارية والروحية في ابتعاث وعي جديد يمكنهم من مواكبة واقع يتغير، فنظريته قد تلقةى قبول لدي المفكرين التنويريين والإصلاحيين، فطالما العامل المعياري والقيمي من معادلة الإصلاح غائب او مغيب فالإصلاح بوصفه مشروعا غير مكتمل ولن يكتمل.
___________
*الأستاذة علجية عيش.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.