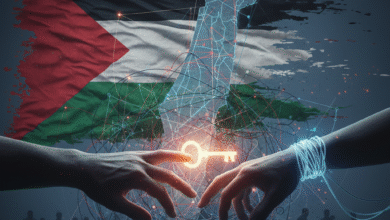السلطة وديعة آن أوان استعادتها

أهمّ تحوّل في مفهوم السياسة الحديثة هو الشرعيَّة Legitimacy. هو مفهوم نقل التفكير بالسلطة من حقٍّ مكتسب أو ممنوح أو طبيعي، مثل القول بالسلطة الأبويَّة أو القيادة الكارزميَّة أو الاصطفاء أو الميزة النبوءاتيَّة أو الحقّ والتنصيب الإلهيين، إلى التفكير بها بصفتها فناً وابتكاراً إنسانيين، جعل السلطة نتاج عقد بين طرفين: محكوم وحاكم، يمنح المحكومُ من خلاله صلاحيَّة الأمر والنفوذ للحاكم، مقابل التزام الحاكم بجملة قوانين وضوابط وقيامه بمهام ومسؤوليات، وفي مقدّمها الحريَّة والرفاه والأمن بجميع وجوهه، بحيث يملك المحكوم حقّ انتزاع السلطة الحاكمة من كل الصلاحيات والمهام في حال أخفقت في القيام بمهامها أو خرقت الضوابط والحدود التي يتعيَّن عليها التقيّد بهما.
وقد وصف جون لوك السلطة الناتجة عن هذا التعاقد، بأنها وديعة أودعها عموم الناس باختيارهم وإرادتهم لدى الممسكين بهذه السلطة، ويحقّ لهم استعادة هذه الوديعة متى شاؤا، بل يجب عليهم استعادتها في حال أخفق أصحاب السلطة في مهامهم. بذلك باتت السلطة مقنَّنة ومشروطة، بمعنى عدم إمكان اعتبارها حقّاً مكتسباً أو حقاًّ شخصياً، وعدم إمكان تأبيدها، وعدم إمكان فرضها بقوّة الغلبة، بل تقوم على قاعدة المشروعيَّة التي يهبها المجتمع للممسكين بها، ويملك هذا المجتمع الحقّ في انتزاعها وإسقاطها ساعة شاء.
لذلك لا يمكن تفسير التمثيل الانتخابي على أنه تفويض لأصحاب السلطة، أي عقدُ تنازلٍ من المحكوم للحاكم، بل هو ائتمان، أي تحميل النائب أو المسؤول أمانة القيام بمهمّته على أكمل صورها. كما أن إنجازات أية جهة أو حزب أو قيادة لا تولد مديونيَّة بذمّة المجتمع، ولا يمنحها سلطة ونفوذ من خارج المشروعيَّة التي يمنحها المجتمع كجسم واحد وإرادة موحَّدة (تكشف عنها الأكثريَّة) للسلطة. فالأصل هو عدم شرعيَّة سلطة أحد على أحد إلا بالاتّفاق العام، أي قبول المحكوم الطوعي الحرّ والمشروط بأن يتولى شخص أو جهة صلاحيَّة الأمر الإكراهي لتنظيم شؤون المجتمع. والقبول هنا لا يعني التنازل أو نقل الملكيَّة أو إسقاط حقّ أو التفويض، بل هو قبول مقرون بحقّ التراجع عنه واسترداده ساعة شاء. ولهذا السبب كان وديعة، ولهذا السبب أيضاً كان مفهوم السلطة المعاصرة متقوم بالحريَّة ومسبوق بها ومُنتج من منتجاتها.
هذا يعني أنَّ العمليَّة الإنتخابيَّة ليست هي التي تمنح المشروعيَّة، بل هي مجرَّد أداة عمليَّة للكشف عن موقف عموم أفراد المجتمع، وعلامة خارجيَّة أو ماديَّة على قبولهم بمن يملك سلطة الأمر بوجهيه: التشريعي والتنفيذي. ما يعني أنَّ التمثيل مقيّد وليس مطلق، مشروط لا بالقانون والبروتوكولات فحسب، بل باستمرار قبول الناس بأهليَّة وبقاء من يمثِّلهم أو يحكمهم.
هذه المقدَّمة، ليست رأياً خاصّاً، بل هي أصلٌ نظري وعقلي لأيَّة سلطة قائمة، وهي مرتكز أيَّة سلطة مشروعة، وهي المرجع في التعامل مع الواقع السياسي الحالي في لبنان الذي أدخلنا في الكارثة ووضع البلد على سكَّة الانهيار الشامل. فالمعضلة لم تعد مجرَّد أزمة علاقة بين قوى وجهات، أو عقدة تأليف وتسمية، أو توازنات طائفيَّة، بل باتت في عمقها سقوط شرعيَّة جميع من في السلطة، سقوط صفة جميع من يشرع ويصدر مراسيم، لا لأن المجتمع سحب قبوله وألغى عقده مع أهل السلطة أو مع من يمثّله فحسب، بل لأن الإخفاق الكارثي الذي أوصلتنا إليه القوى المتنفِّذة والآمرة، هو بذاته السبب الأول لسقوط هذه الشرعيَّة، بحكم أن الإحفاق هو بمثابة الشرط الضمني المسقط والناقض لأيَّة شرعيَّة سياسيَّة أو صلاحيَّة سلطة. بالتالي، لم النقاش حول بقاء شرعيَّة السلطة القائمة وعدمها، بل انتقل إلى التفكير في سبل استعادة السلطة ممَّن هتك قواعد شرعيتها، وإعادة بنائها على أسس مشروعة.
تكمن المشكلة هنا في انسداد أفق البدائل والخيارات، التي تنحصر في خيارين، ولو بنحو الخيارات المحتملة والممكنة: العسكري والمجتمعي.
أمَّا الخيار العسكري، وعلى الرغم من مسوّغه السياسي والدستوري، الذي يعتبر مؤسَّسة الجيش صمَّام أمان الدولة، والموكل إليها حفظ سيادتها ضدّ كل من ينتهكها في الداخل والخارج، والملاذ الأخير بعد استنفاذ السبل السياسيَّة والطرق السلميَّة. إلا أن في هذا الخيار، أنه فضلاً عن مخاطر الانزلاق إلى عسكرة الحياة العامَّة، فإنه خيار ممتنع موضوعياً، بحكم الحساسيات الطائفيَّة في تركيبة المؤسَّسة العسكريَّة، ووجود قوة عسكريَّة وأمنيَّة راكمت قدراتها على هامش مؤسَّسات الدولة ومن خارج أصول الشرعيَّة السياسيَّة أو مبادئ حيازة الإكراه المشروع، وتضاهي الجيش في قدراتها التنظيميَّة والتدميريَّة. ما يعني أن الجيش بات عملياً فاقد القدرة الفعليَّة على المبادرة.
أمَّا الخيار المجتمعي، فيكاد يكون منتفياً أو في غاية الضعف، بحكم عجز المجتمع عن المبادرة، بعد أن ترسَّخت بداخله الولاءات الشخصيَّة، وتربَّى أكثر أفراده على الزبائنيَّة وتكيَّفوا مع الفساد لزمن طويل، حتى صار ذلك سجيَّة وخلقاً عاماً، تخلَّى بموجبهما المجتمع عن مهمّته وحقّه في مراقبة السلطة ومحاسبتها، وعطَّل قوته الذاتيَّة في الحدّ من تغوّل السلطة وتمادي أهل الحكم في خطيئتهم. ما سمح لقوى السلطة في تذرية أفراد المجتمع، أي تحويل المجتمع إلى أفراد مشتَّتة وحائرة ومنشغلة بخصوصياتها ومصالحها الخاصَّة، وفي تحويل التضامن الاجتماعي من رابط مدني يقوم على الهويَّة الطوعيَّة والحرَّة والجامعة، إلى عصبيات عدوانيَّة تتباهى على بعضها بانتصارات ملفَّقة وعناصر قوة وهميَّة وهشَّة، وإلى روابط بدائيَّة تلوذ بالتاريخ والذاكرة وحتى المقدَّس لتعوض على نفسها كدر عيشها. أي بتنا أمام مجتمع لا يعي حقَّه ودوره، وإذا تحصَّل لديه هذا الوعي، فإنَّه عاجز وفاقد القدرة على المبادرة لتصويب مسار الحياة العامَّة.
هذا لا يعني انسداد أفق التغيير، بل يدل على عمق الأزمة التي لم تعد متمثِّلة بشخص أو جهة، بل بمعضلة إعادة بناء الحياة السياسيَّة على أسس شرعيَّة، والتي لن تحصل قبل أن يستعيد المجتمع دوره ويعي حقيقته لا بصفته تجمّع أفراد وجماعات، بل بصفته كائناً سياسياً، منه فقط تصدر الشرعيَّة وإليه فقط تعود.
______
*وجيه قانصو/ فيلسوف ومفكّر لبناني.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.