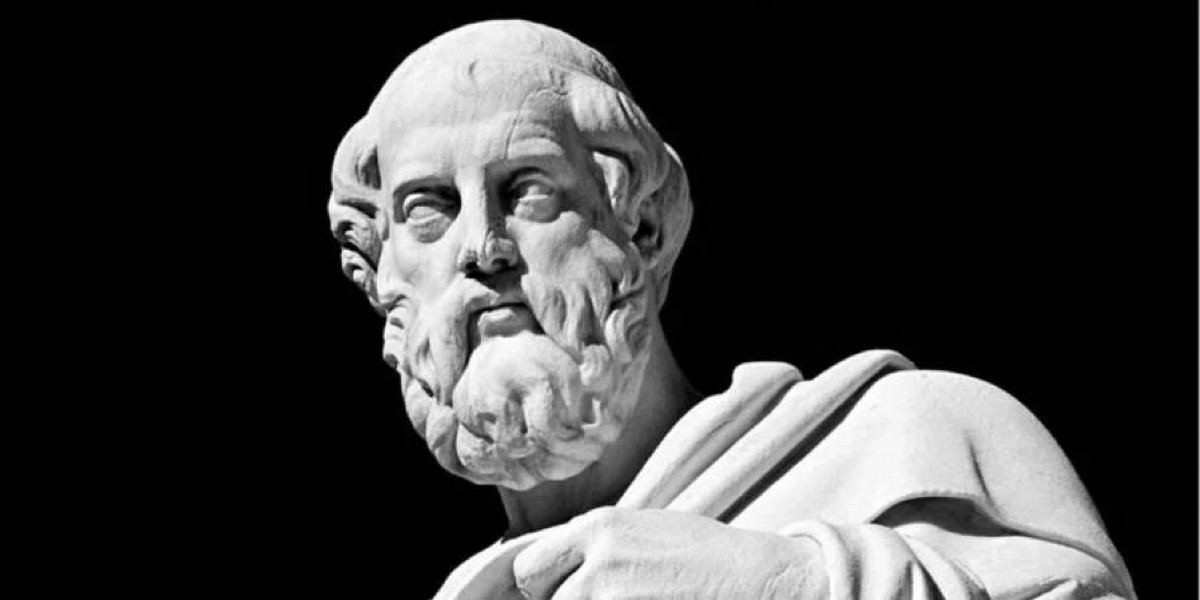عن الإرث الإغريقي في الإسلام

كريستيان جامبي
ترجمة: عبد الرحيم البصريّ
إن تأثير الفلسفة الإغريقيَّة في أرض الإسلام لعظيم. إذ كان عالم الأفكار مصدر إلهامٍ لنشوء تصوّر عن النبيّ يكون بموجبه مرشدَ أرواح.
ليس بناءُ الأنساقِ الفلسفيَّة حكرا على الغرب الإغريقي واللاتيني، وإننا نعلم ذلك منذ الآن علم اليقين. فقد شهدت أرض الإسلام تطوّر نشاط فلسفيّ قويّ، عندما شجّع على ذلك فضولُ علمائها والتأييدُ الذي حظي به من لدن بعض السلطات السياسيَّة. ورغم ذلك، ظلّ هذا النشاط غالبا، في نظرنا، متميزًا جدًّا عن الأنحاء التي تَرسّخ بها حتى في حياة الدين الإسلامي. ولهذا الأمر كثير من الأسباب والمسوغات،أهمها المسوغ التالي: أنّ أعظم الفلاسفة الذين عرفهم العالم المسلم، في اللحظة الفارقة التي مثّلها اسمَا كل من الفارابي وابن سينا، مايوافق القرن العاشر في تقويمنا، كانوا في المقام الأَوّل مَناطقة، وعلماء طبيعة، وميتافيزيقيين تأملوا إرث الفكر الأرسطيّ واجتهدوا في تغييره مع الحفاظ عليه.
ودون الخوض في النقاشات العالِمةِ حول طبيعة هذه اللحظة الفلسفيَّة ومعناها، لنوجه عنايتنا صوب أمر لا يَقلّ أهميَّة عن الإرث الإغريقيّ في أرض الإسلام. وهذا الأمر هو الاشتباك الذي ما فتئ يتقوى بين الدوافع اللاهوتيَّة وموضوع الميتافيزيقا.
مشروع دين فلسفيّ
سبق للمدرسة »الإشراقيَّة « مع رئيسها شهاب الدين يحي السهروردي (توفي سنة 1191) أن شكَّلت توليفة بين الأفلاطونيَّة المحدثة والتأويل القرآني، ويشهدُ ذلك على إرادةِ بناءِ ما يمكن أن نسميه بـ »دين فلسفيّ “. وبعد ذلك، سمح إدماج القضايا الكبرى لفكر ابن عربي، أي ذلك الكم الهائل من التفاسير القرآنيَّة، بضربٍ من التداخل بين الميتافيزيقا الإسلاميَّة والتصوّف التأمّليّ. وأنَّ ازدهار الفلسفات التي وُضعت تحت حماية السلطات الشيعيَّة في إيران، إبّان القرن السابع عشر، يدلُّ على هذا التوحيد المتنامي للمعارف وعلى روح التوفيق التي أتاحت تكوين علم فلسفيّ يسعى إلى الشمول موجَّهٍ بعناية نحو دين باطنيّ.
ينبغي أن ندقِّق بأي معنى اتَّصل توجّه الفلسفة بلاهوت أفلاطونيّ مُحدَث يعتبر نفسه الوجه الباطن للرسالة النبويَّة. وذلك أنّ موضوع الميتافيزيقا الأكثر استقرارًا، وكما هو الشأن عند أرسطو، يمثل ”الموجود من حيث هو موجود”، وهذا بديهي جدا في ميتافيزيقا ابن سينا. والحال أنّنا نرى وجود الموجود، كما تصوّره ابن عربي، يصير محصّلة الماهيَّة الإلهيَّة ومجموع أفعال الوجود التي تشكِّل أسس الموجود المخلوق. إنّ الاتَّحاد الجوهريّ للألوهيَّة وتجلياتها في الكون، والسيادة الكاملة لله على أنحاء فيضه في الدرجات المختلفة للموجود، وأخيرا استكمال النفس البشريَّة أثناء فهمها لهذه الوحدة، تشكل بلا ريب جزءا من القضايا الدائمة للفلسفة الإسلاميَّة، كما رأيناها تنبسط في أوج اكتمالها خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. وقد كانت أعمال كل من المير داماد، والملا صدرا، والقاضي سعيد القمي بمثابة تأمّلات قويَّة حول هذه الوحدة بين الوجود والإلهيّ.
بواعث إلهام متبادل
لا ينبغي أن نتخيَّل نشاط الفلسفة في الإسلام كما لو أنه ضربٌ من المعرفة الخالية من المنفعة والتأمليَّة الخالصة. حتى وإن كانت أهميَّة الأعمال التي أومأنا إليها بالنسبة إلى تاريخ الميتافيزيقا العام عظيمة، وذلك أنّ الأساسيّ يوجد بلا جدال في مكان آخر. فمن جهة، يتعلق الأمر بتهييء نظام لاهوتي، وذلك عبر صياغة مفاهيم موروثة من أرسطو وأفلوطين العربي(أي نصوص أفلوطين التي شرحت خطأ ووُضِعت تحت اسم أرسطو)، تتقاطع فيها منزلة الإنسان في حالِ اكتماله وبلوغه الحكمة الفلسفيَّة مع المنزلة الخاصَّة بالنبي أو بالإمام (حينما يكون أصحاب النظر من الشيعة). إنّ الإنسان الكامل هو المرشد، لأنه اجتمع فيه كونه هو المعلِّم التام، الملهَمُ من الروح القدس، والذي ينبسط فيه العقل الإلهي، وكونه نموذج الحياة والخلاص للإنسان الذي قطع مع العالم الحسيّ، عالم” الدنيا”. تَشَكّل إذًا نموذج الإرشاد النبوي، والتوجيه الروحيّ وفق سمات فلسفيَّة بارزة، تُبايِن كليًّا النموذج اللاهوتي السياسي الذي تبناه أنصار دين متمركز كليا حول الاشتغال بالفروع الفقهيَّة.
لا ينبغي أن نهمل إسهام عديد من الفلاسفة في هذا التمرين الكبير الذي هو التفسير القرآني. لقد كان بلا شك غائبا أو محتشما جدا حضورُه عند أوائل الفلاسفة، أي الفلاسفة الذين وُسموا بطابع هلنستي، لكنه صار ممارسة كاسحة في الأنساق اللاحقة. إنّ الفكرة التي تعتبر أنّ الحرف القرآني له معانٍ محجوبة متعدِّدة قد غذَّت التأويل المجازيّ. بل أكثر من ذلك، أتاحت تأويلَ، ليس القرآن فحسب، وإنما النصوص المقدَّسة كلها، وأدب الحديث (سنن النبي والأئمة أحيانا) ومجموع النصوص أو الأقوال التي تعتبر بمثابة أحاديث تستحق أن تكون محل تقديس. ولذلك نفهم وجود صراعات في التأويل بين القرّاء الذين تمسَّكوا بالمعنى الحرفي، والحسّي، أوالجسماني، للآيات القرآنيَّة، والقرّاء الفلاسفةِ الذين تحمَّسوا لإعطاء معنى آخر فكريّ، وفوق حسِّي للنص القرآنيّ. إنَّ انتقاء الآيات، من خلال استبعاد الجزء اليسير من القرآن المخصَّص للأوامر الشرعيَّة لأجل تفضيل الآيات ذات الطابع الأخروي أو ذات النفح الروحانيّ، يدلّ بوضوح على القطب الذي اتَّجه نحوه التفسير الفلسفيّ: عنينا تجريدَ الوعود النبويَّة والتعاليم الشرعيَّة من كل انغماس لها في هذا العالم، من أجل حملها، إذا جاز التعبير، إلى أفق سبق لأفلاطون أن حدَّد معناه.
التحرير الفلسفيّ للنفس
لا يقل الإلهام الأفلاطونيّ للفلاسفة في الإسلام أهميَّة عن الإلهام الذي أتاحه لهم إدماج الفكر المشائيّ. فقد تجلَّى ذلك عندهم من خلال تأويلٍ لـ”العالم الآخر” ، وللحياة الآخرةِ التي أخبر عنها الأنبياء تحت إمارة عالم العقل، الذي يُعتبرُ عالم النفس بالنسبة إليه بمثابة الفيضِ الذي نشأ عنه ووجوده المتحرك. هكذا تعلن الفلسفة عن نفسها، عند مفكّر مثل الملا صدرا، بصفتها نشاطًا تحرّريا، بعيد جدا عن مجرد الاحترام الأعمى للأوامر الإلهيَّة. إنّ هذا التحرير الفلسفيّ للنفس البشريَّة، لمّا تماهى مع صعود نفسِ العالم لكي تعود إلى موطنها الحقيقيّ، وهو عالم المعقول، يدين بالكثير لوساطة النصوص الأفلوطينيَّة.إذ إنه يثبت ذاته ضدا على السلطة المتنامية لعلماء الفقه ويستند في ذلك على التأويل القرآني. وإنّ التأكيد الذي بموجبه،” يكون الدين شأنا جوانيًّا”، دائما بحسب الملا صدرا، لا يقلِّل من قيمة الأوامر الشرعيَّة في شيء. بل يجعل منها ”شأنا برانيا”، وظاهرا، وبالتالي شيئا غير جوهري. وإذا صح، كما رأي ليوستروس، أنّ الفلسفة في الإسلام كانت غايتها تأسيسُ سلطة سياسيَّة عادلة وقائمة على الحقيقة العقليَّة ، فانّ هذا التوجه اللاهوتيّ السياسيّ قد ارتبط ارتباطا وثيقًا بتوجه جعل الفيلسوف بمثابة ” مرشد للأرواح”، »هادي الأرواح « بامتياز. إنه يقوم بتأويل الإرشاد السياسيّ، لكنَّه يؤسِّس كذلك ضربا من الإرشاد يهدف إلى إقامة صرح الإنسان الجوانيّ.
إيمان ”العامَّة ” وإيمان ”الخاصَّة”
الاستكمال، تلكم هي الكلمة المفتاح التي تتيح ربط الدين بالفلسفة. فإذا كان الخضوع هو الكلمة الرئيسة للدين البرانيّ، الذي يؤسِّس الممارسات التعبّديَّة، فإنّ تحرير النفس هي الكلمة الرئيسة في الدين الجوانيّ الذي ينكشف بالفلسفة. وسواء أتعلَّق الأمر بتأويل الجزاءات والنعم في الدار الآخرة (المعاد) أو بتحديد السبل التي بها يكون التزهّد والتدبّر وتزكيَّة النّفس ممكنة، فإنّ فلاسفتنا ينأون بوضوح عن قراءة الشّرعِ بألفاظ الخضوع المتذلل والأداء الشكليّ. إنّ هذه القسمة البيّنة، التي كانت حاضرة قبلاً لدى ابن سينا، والتي تعزَّزت أكثر لدى نصير الدين الطوسيّ أو لدى الملا صدرا، والقائمةِ بين دين عامَّة المؤمنين في الإسلام ودين خاصَّة الفلاسفة، أصبحت هي ما أتاح النّظر إلى درجات الإيمان نظرة تراتبيَّة. حيث يكون الإيمان الذي يتغذى كليا من اعتقادات ”حسِّيَّة” حتما إيمان ”العامّة”. ويكون الإيمان الذي يقصد دلالات ”معقولة” إيمانَ ”الخاصَّة”.
بديهيّ أن يكون لهذه القسمة ثمن، حيث إنّ ألدّ أعداء الفلسفة الأكثر نباهة أظهروا أنّه يكمن في: خطر يحدق بالمعنى الحرفيّ للشرع، وفي الانفصال بين الحكمة الفلسفيَّة والدين الموحى به،ثم في التشكيك الذي يحدِّق بالوعود الإلهيَّة التي أخبر عنها النبي. وبوجه أكثر واقعيَّة، إنّ دين الفيلسوف يُهدّد الطابع الجمعيّ وبالتالي السياسيّ للدين ”الحق”.
وحتى وإن كان فكر عظيم مثل ابن رشد (ما نسيمه Averroès) قد علم كيف يُقسّم الأدوار بين الحكمة والشريعة الدينيَّة ويصالح بهذا دين العامة مع دين الخاصة، فإنّ ذلك لا يُغيّر في الأمر شيئًا.من جهة أنّ أعداد الفلسفة العلماء لم يفوتوا فرصة للحكم بخطورة ممارسةٍ ليس في سعها أن تنتهي إلا إلى تمجيد حياة المتوحد.
من المذهل جدا أن يكون استكمال الذات، البالغة أعلى مراتب الكشوفات النبويَّة، وغاية الحقائق الإلهيَّة الربانيَّة لدى كاتب أندلسي ألمعي مثل ابن طفيل (1185_1110)، موافقا للأوامر الأخلاقيَّة للملا صدرا. ففي الحالتين كلتيهما، نلاحظ تشكّل مجموعٍ من المنظورات الاستدلاليَّة، ولكن أيضًا قصصًا لتربية الحكيم. فالإنسان، بحكم طبيعته العاقلة جوهريا، أهلٌ لأن يلقى مصيرًا روحانيًّا من حيث إنه »ملاك قريب من العرش الإلهي «، كما كتب الملا صدرا. إنّ النفس البشريَّة الصادرة من معالي العقل، يمكنها أن تعود إليه ومن واجبها فعل ذلك. اتَّصل هذا التفاؤل الفلسفيّ، ولا غرابة في ذلك، بضفاف الروحانيَّة الإسلاميَّة، لكنه أيضا تعرَّض لانمحاء في راهن الشعوب المسلمة. وبلا ريب، فإنّ مصيره يبقى باطنيا، ومجردا من أيَّة فعاليَّة سياسيَّة، ولنا في هذا مرآة حقيقيَّة للتجربة الأفلاطونيَّة. فهل يعني ذلك أنه دون جدوى بقدر ما يكون غير جدير بالثقة؟ سبق لإيمانويل كانط أن قال عن جمهوريَّة أفلاطون إنها غير مسؤولة عن كون الناس عاجزين عن إقامتها، وإنما بالأحرى هم مسئولون، بسبب سوء أخلاقهم، عن إخفاقها. وإنَّ تصريحًا مثل هذا يجوز أن يكون هو نفسه تصريح فلاسفة الإسلام، إذا ما سمحت أخلاق استكمال النفس التي تَصوّروهَا، وهي مختلفة جدا عن أخلاق كانط، أن تدفع بهذه المماثلة إلى ما وراء حدود المعقول.
____
Christian Jambet, de l’héritage grec en islam, le Magazine littéraire,n°571, 2016,pp83-85.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.