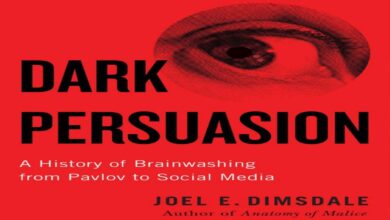الصدفة ومفاتيح الاستشراف

مدخل:
تقترح الأطروحات الفلسفيَّة المعروفة أنَّ الفكرة الأساسيَّة للارتباط الوثيق بين “الصدفة” و”الفرصة” و”الحظ”، وما يخالطها من آليَّات العلل والأسباب، ومترتّبات “الضرورة” و”الحتميَّة”، تتعلَّق بالفرصة المرغوبة، لدرجة أنه قد يبدو، في الواقع، القول إنَّ هذا الشيء حدث بالصدفة يقترب من أن يكون مرادفاً كافياً في اللغة العاديَّة للفرصة المقصودة، أو الحظّ المتوقّع. الأمر الذي يعني أنه يمكننا أن نحاول التنبّؤ بما ستكون عليه النتيجة المرتجاة من أي مشاركة نقصدها، أو أي محفل جديد ننضم إلى دائرته، وإن تزينت اللقاءات فيه دوماً بألق المفاجأة الأخّاذ، التي ألفنا تعريفها بالصدفة.
ورغم وجود أدلَّة وفيرة على حدوث “الصدفة”، واستشعار الحدث لمآل ما يُرَتِّبُه الحظ فيها، فإنَّ العديد من الفلاسفة ينكرون أن “الفرصة” الحقيقيَّة ملازمة لهذا الترتيب، حتى ولو كانت تعني، أي الصدفة، في كتابات بعضهم ما هو متميَّز، أو تلك المفاجأة، التي تحدث بدون سبب محدَّد ومعروف، أو بما يجعلها تتناقض مع كل نظريَّة حتميَّة تقايسها فروض الضرورة. ففي اللغة اليوميَّة، يبدو أن استخدام كلمات مثل “الفرصة”، و”الصدفة”، و”الحظّ”، أو “العشوائيَّة” تتداخل بقوَّة. في الواقع، فإنَّ بعض اللغات، مثل الألمانيَّة، تُعجم وتدغم كل هذه المفردات في كلمة واحدة؛ هي “زُفال-Zufall”. وفي لغات وثقافات أخرى، هناك فصل واضح بين الأحداث المفضية للصدفة، مع دلالات إيجابيَّة موحية لنتائجها، مثل، “الحظّ”، و”الفرصة”، غير أن بعض ممن يعانون من سوء الطالع لا يرون في الصدفة إلا حقيقتها العشوائيَّة، وتنقلب معهم هذه الصدفة إلى مفردات سلبيَّة؛ مثل، “حادث”، و”خطر” جسيم.
في المنهج:
في هذا المقال، نحاول تقديم قراءة مستفسرة نرسم من خلالها الخطوط الرئيسة لتطوّر العديد من هذه المفاهيم؛ من العهد الإغريقي القديم حتى العصر الحديث، أو على نحوٍ أدق، من ديموكريتوس، وأرسطو، إلى محمود أمين العالم، ومحمد باقر الصدر. نبدؤها بتناول ثلاثة عناصر خاصّة؛ أولها، “الفرصة”، و”الحظ”، و”العشوائيَّة”، وما إلى ذلك، التي تُسْتَدعى في بعض الحالات كتفسيرات للأحداث، ولكن في حالات أخرى تُعَيِّن الأحداث، التي تقع دون تفسيرات. ثانيها، يُصْبِح معنى هذه المصطلحات واضحاً فقط عندما يفهم المرء أي البدائل يمكن استبعادها. وأخيراً، فمن الواضح أن نرى كيف أنه، بعد استبعاد صارم لـ”الفرصة”، أو “العشوائيَّة”، من المجال العلمي للشرح في فترة تاريخيَّة مبكرة، تمَّت استعادتها إلى المجد الكامل في القرنين التاسع عشروالعشرين، خاصَّة في علم الأحياء والفيزياء.
لهذا، فإن هذه القراءة المستفسرة عن متعلّقات “الصدفة” تستهدف، باقتضاب، الاطلاع على بعض مظان بحثها في الفكر الإنساني، ولا تحاجج، بأي حال من الأحوال، يقينيات النصّ المقدّس. فالحديث عن وجود الصدفة في حياتنا لا يعني مطلقاً نسبة وجودنا إليها، ولا ترقى محاولات تعريفها لأن تُؤخذ دليلاً على عدم وجود الإرادة والحكمة والقوة والعلم، الذي هو للخالق سبحانه، والذي يعلم ولا نعلم، وهو الذي خَلَقَ كُل شيءٍ بِقَدَر، “وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِيْنٍ”، الأنعام (59). لذا، فقد حَضَّ القرآن الكريم على النظر والتأمّل والتفكّر والتدبّر والاجتهاد في فهم الظواهر؛ ترسيخاً للإيمان، لا نقضاً له.
إن هذا الفهم يُحِيلُنا إلى سؤال تَسْهُل إجابته: هل تُخلق الفرصة، أو تُكتشف؟ إذ إن كل سعي إنساني يستهدف اغتنام ما يتوفّر عليه المرء من فرص، أو يناله من حظ، أو يتطلّع إليه من رجاءات الخير. فمن أجل اكتشاف الفرصة في نظام قائم، ينبغي، أولاً، أن نكون قادرين على التعرّف عليها، والطريق إلى ذلك إما أن يَمُر من خلال التعليم، واستيعاب نمط الظروف، أو الصفات، أو التنبوء، الذي يستصحب النظر والتأمّل والتفكّر والتدبّر والاجتهاد، أو هو في الواقع قيام المرء بإنشاء نمط استشراف يتناسب مع جديَّة سعيه، يبني على تراكم المعرفة وقوة الحدث، بلوغاً للهدف المنشود.
العلل والمعلولات:
الصدفة، أو الضرورة، في بعض تعاريفها، هما متعلقان بفكرة الترابط بين طائفة من أنظمة العلل والمعلولات، التي يتحقَّق كل منها في سلسلتها الخاصَّة مستقلَّة عن الأخرى. ويظهر هنا أن كلمة الصدفة ليست منقطعة عن العلاقة مع الحقيقة الخارجيَّة للضرورة، إنما تعبّر عن مفهوم له تمثّلاته في الظواهر الملاحظة، وله تأثيره وفاعليته، الذي يتّضح في ملكوت الخلق. وقد كان أرسطو أول من خَرَّجَ الصدفة على ثلاث حالات؛ أولها، التقاء عشوائي بين حادثين؛ وثانيها، حضور متزامن لصفتين مستقلّتين في موضوع واحد؛ والثالثة، حالة انتساب صفة ممكن إلى موضوع، دون أن نتبيَّن منها أي دلالة للقصد والتدبير. وربما بدأ أن هذه الأخيرة عكس الصدفة، التي تشترك في صفات الأمر العارض، إلا أن تَحَقُّقِها غير المقصود يدخل في مجال القصد والتدبير، وكل ما هو مخلوق بِقَدَر.
وتبدو “الصدفة”، في الكثير من الأحيان، وكأنها تتحرَّك بسلاسة بين الدعوة لأمر خاضع لحتميَّة الترتيبات الموصوفة والمُقَدَّرَة بعنايَّة، والتحقّق المنشود لمراد “الفرصة” المرغوبة، وبين “المفاجأة” السارة، التي تتجلى عبرها هذه الصدفة بتمثّلات الحظ. وإذا اعترفنا أن بعض الأمور لا تخضع لمنطق الأسباب “الظرفيَّة”، أو “الضرورة”، فنحن يمكن أن نَعْقِلْهَا ونُعَلِّقْهَا بِعلاقةٍ سببيَّة مثاليَّة كافيَّة لتبيان تحقق “الحظ”، دون الحاجة للاعتماد على الشروط الماديَّة الحتميَّة الصارمة. وهذا يعني اعتماد تطوير القدرة الكاملة على التنبؤ الحصيف بالأحداث، التي تُبْقِي على إمكانيَّة قراءة المستقبل بالحدس المفعم بالأمل. رغم أن الحدس والصدفة للبعض هما مجرد حدث بدون سبب، وإن قال بهما المنجمون فقد كذبوا.
ولأن لا شيء، يمكن أن يتقصّده الإنسان، ويُقال له أنه حدث بالصدفة، ولكن هناك دائماً سبب وضرورة لكل شيء توجده هذه الصدفة. رغم أن المفاجأة، التي تتأتَّى منها الفرصة، تؤخذ على أنها حادثة عارضة، وفي حالة تنازع موضوعي مع الحتميَّة السببيَّة. وتُعتبر معاكسة للتقديرات الماديَّة، أو الآليَّة، التي نُعَايرُ بها النسق العام للأحداث. ويمثل هذا بعضاً من فهمنا التقليدي للفرصة، أي أنه إذا تقرر أن هناك حدثاً واحداً وقع عن طريق الصدفة، فإن اللاحتميَّة يمكن أن تصبح صحيحة، وتقوض تماماً إمكانيَّة المعرفة المستهدفة والمعينة على فهم قيمة الفرصة.
منطق الفلسفة:
ومع هذا، فإن استحضار عدد من التصوّرات الفلسفيَّة في فهمنا لكل من الفرصة والعشوائيَّة يفتح إمكانيَّة تَبَصُّر أن ردم الهوَّة بينهما سهلة؛ في الحالتين العاديَّة والعلميَّة. وتزيل طريقة الفهم هذه الالتباس العارض بين الصدفة والحظ، الذي من شأنه أن يُناقض الحقيقة المألوفة للفرصة، والذي هو مضلل تماماً لتوقعاتنا. وقد يكون هذا الاستحضار لهذه التصورات هو مجرَّد محاولة لتوضيح الفروق بين الصدفة والعشوائيَّة، فضلاً عن إدراك السياقات، التي تتداخل في تعريف الفرصة. وربما يهدف أيضاً إلى توضيح العلاقة بين الصدفة والعشوائيَّة؛ ضمن مفاهيم هامة أخرى في العبارات المجاورة للحظ، ولا سيما وأن التوقّع والتنبّؤ، في كثير من الأحيان،يكونان عرضة للالتباس.
لهذا، فإن مفاهيم الضرورة والإمكانيَّة قابلة للتجزئة؛ مثل القول بأن شيئاً ما ضرورياً هو كالقول بأن نفيه غير ممكن، أو كأن أقول إن شيئاً ما ممكن، هو كالقول بأن نفيه ليس ضرورياً؛ أو أن نقول إن الكائن يجب أن تكون له خاصيَّة معينة، هو كالقول إنه لا يمكن أن يفتقر إليها؛ وأن نقول إن الكائن يمكن أن يكون له ملكات معينة، هو كالقول إنه ليس هو الحال، الذي يجب أن يفتقر إليه. وفي حين يقول الكثيرون إن كل إنسان لا يمكن أن يفشل في أن يكون إنسانياً؛ فإنه إذا كان الأمر كذلك، فإن التوصيف الأساسي للمشروط يحسب خاصيَّة كون الإنسانيَّة عنصراً أساسياً لكل إنسان. وأيضاً، يقول آخرون إنه على الرغم من أن أحدهم، مثل زيد، هو في الواقع كان مولعاً بالكلاب. وهذا يعني أن زيد يفتقر إلى تلك الملكات الإنسانيَّة. فإذا كان هذا صحيح، فإن توصيف الخصائص الأساسيَّة للملكات يحسب لكونه مولعاً بالكلاب، وأن إنسانيَّة زيد عرضيَّة، لا أصليَّة.
بين الضرورة والصدفة:
من هنا، يمكن التمييز بين الخصائص الأساسيَّة لـ”الضرورة”، مقابل الخصائص العرضيَّة لـ”الصدفة”، التي جرى تعريفها بطرق مختلفة. ولكن المفهوم الأكثر شيوعاً في المصطلحات المعياريَّة حالياً، هو تلك الخاصيَّة الأساسيَّة للكائن، التي يجب أن تكون له، في حين أن الخاصيَّة العرضيَّة للكائن هي تلك التي كانت له، غير أنه يفتقر إليها الآن. وهذا ما يمكن أن نسميه بالتوصيف الأساسي للمشروط، إذ إن التوصيف المشروط للمفهوم هو الذي يجب أن يفسّر الفكرة من حيث الضرورة/ الاحتمال. ففي التوصيف، الذي عَرَضَ للتمييز بين الخصائص الأساسيَّة والحوادث العرضيَّة، فإن استخدام كلمة “يجب” تعكس حقيقة ضرورة الاحتجاج، في حين أن استخدام كلمة “يمكن” تعكس إمكانيَّة الاحتجاج بهذا الاحتمال.
بيد أن مفهوم الصدفة، وفقاً لـ”أوجستان كورنو”، الذي ولد عام 1801، ويُعتبر أول من صاغ نظريَّة موضوعيَّة خالصة للصدفة في العصر الحديث، أخذ في البروز أكثر، في سياقات الفكر الفلسفي، عندما زادت موضوعيتنا في مواجهة الواقع الخارجي. إذ أصبح من المهم النظر إلى أن الصدفة هي الموضوع، الذي يتجنّبه العلم، لأنها لا تخضع لتحديد القانون، وتخفي قيمتها الموضوعيَّة عنه، عكس الضرورة، التي يمكن أن تصاغ في قانون. وينقلنا هذا الفهم إلى الأطوار، التي مرّت بها الصدفة؛ من المستوى الذاتي الغائي، إلى الذاتي العرفاني، ثم الطور الموضوعي. فهل ما كان قبل هذا الطور الأخير يُمثل تعبيراً عن جهلنا بملابسات الضرورة الموضوعيَّة؟
فلسفة المصادفة:
لقد بيَّنَ “محمود أمين العَالِم”، في كتابه “فلسفة المصادفة”، وبعد انقلابه المادِّي على مثاليته الأولى، أنّ الصدفة تكاد تكون مجهولة تماماً لدى البدائيين، الذين أقاموا نوعاً من الترابط والتماسك بين الوجودين الطبيعي والإنساني. مثلما لا نجد مفهوماً مترابطاً للصدفة في الديانة الأولى للإغريق، ولم نعثر على هذه الكلمة عند “هوميروس”، و”يوربيدس”، بحيث تكون لها دلالة واضحة محددة بعض الشيء كقوة منافسة لقوة الآلهة. فالصدفة عند “العَالِم” ليست إلا علة وهميَّة ابتدعها جهلنا. لذلك، فإن الصدفة تختفي وتتراجع كلما ازدادت واتسعت معرفتنا. فالصدفة، حسب هذا التعريف المادّي، كلمة لا توجد إلا فينا، وهي لا تعدو أن تكون أثراً نفسياً ناتجاً عن جهلنا بالعلل الحقيقيَّة.
من جهته، يقول السيد محمد باقر الصدر أنّه من غير الصحيح أن نعتبر “الصدفة” نقطة في مقابل “الضرورة”، أو “اللزوم”، بدلاً عن الحتميَّة؛ على اعتبار أن فرضيتهما، أي الضرورة واللزوم، ليست هي الفرضيَّة الوحيدة المحتملة في مقابل هذه الصدفة. بل نقول هنا بالفرضيَّة الأخرى المحتملة في مقابل الصدفة، وهي الفرصة، حتى لو لم تكن هناك مسلمات منطقيَّة لوجود علاقة موضوعيَّة بينهما. فالصدفة، كما يعتقد الصدر، تُمثل نقطة في مقابل التفسير المشترك، وليس نقطة في مقابل الضرورة. ونحن نقول، وفقاً للحدث العرفاني، إنها تجليات “الحظ”، الذي يُعادِلُ قيمة “التوفيق”، والذي يحدث فجأة وعلى غير المعتاد، مُحقِقَاً لغنيمة “الفرصة”.
إن اعتماد أي من الأطروحات، التي تقدم ذكرها، كمسلمة أمر قد لا يتوافق عليه كل المعنيون بالبحث الفلسفي، ولكن ربط الصدفة بالفرصة، وجعلهما مسألة مألوفة، يُشكل الأساس لنجاح الحجج، التي قُدمت في كل، أو بعض، هذه الأمثلة. أما إذا افترضنا أن استنتاجات هذه الحجج ضعيفة، أو غير قابلة للتصديق، فإن ذلك سيضع الكثير من الشك على نظريات معتمدة بالفعل في مساقات البحث العلمي المختلفة. رغم أنه يجب علينا أن نُخْضِعُ كل الأمثلة لفحص دقيق يوضح ما إذا كانت الحجج، التي اعتمدت عليها صحيحة أم لا. وبالضبط، فإن هذا ما عنيناه بالقول عن بعض الأحداث، أنها عشوائيَّة، أو ربما في توصيف سيّء الحظ، محفوفة بالمخاطر. ولكنها في كل الأحول دَالَّة على إمكانيَّة الاستشراف.
* دبلوماسي سوداني، الأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي، الأردن
عمان، المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة
السبت 3 فبراير 2018
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.