كيف يحلُّ الإسلام أزمة العالَم؟… قراءة في كتاب “الإسلام بين الشرق والغرب”
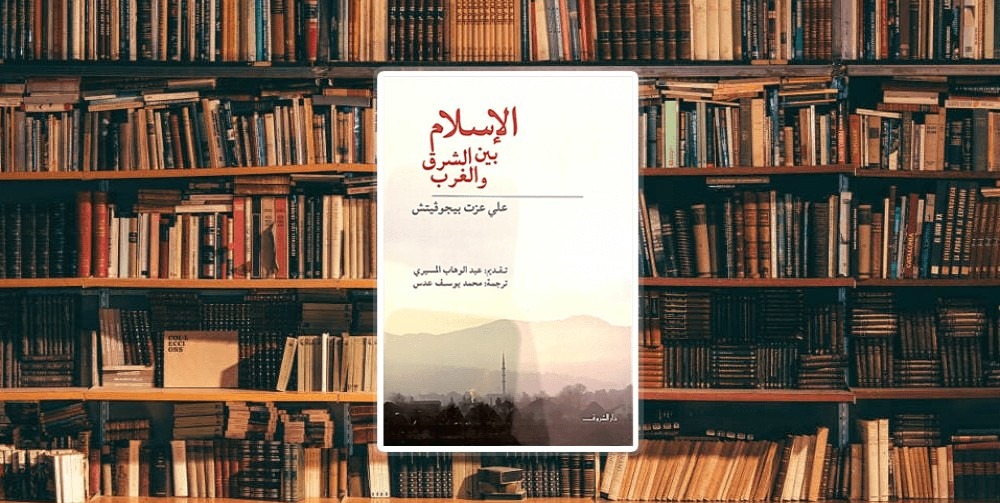
صاحب هذا الكتاب بالغ الأهميَّة في الفكر المُعاصِر هو “عليّ عزت بيجوفيتش”. وُلد في عام 1925م، في مدينة “بوسانا كروبا”. وقد هوى القراءة في الفكر والفلسفة والأدب منذ يُفُوعتِه؛ وقد قرأ قبل وصوله لسن الثامنة عشرة مؤلفات رصينة في الفلسفة مثل “نقد العقل المحض” لـ”إيمانويل كانط”. وقد تعلَّمَ اللغات: الإنجليزيَّة، الفرنسيَّة، الألمانيَّة، وألمَّ باللغة العربيَّة. التحق بجامعة “سراييفو”، وحصل على شهادة “القانون” فيها 1950م. حُكم عليه مرتَيْن من القضاء اليوغوسلافيّ، وناضَلَ طويلاً في الساحة السياسيّة. بجانب عمله مُستشارًا قانونيًّا لمدة خمسة وعشرين عامًا. وكان يكتب مقالاتٍ كثيرة في تلك المراحل، بجانب كتابه “هروبي إلى الحريّة” الذي كتبه في السجن.
كل هذا التاريخ النضاليّ جعل له ثقة وشهرة بين مُواطنِيه. وبعد انهيار “الاتحاد السوفيتيّ” تفككت دولة “يوغوسلافيا” إلى عدد من الدول؛ منها “صربيا وكرواتيا” -المسيحيَّتَيْنِ-، و”البُوسنة والهرسك” -المُسلمة-. ثمّ فُتح النظام الحزبيّ؛ فأسَّسَ حزب “العمل الديمقراطيّ” عام 1990م. ودخل به الانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة فحاز منصب الرئيس في العام نفسه. ودخلت بلاده في الحرب مع “صربيا” بعد اعتداء الأخيرة السافر، وإرادتها ضمّ “البوسنة والهرسك” لأراضيها. وخاض الحرب مع بلاده، إلى أن جاءت المعاهدة الظالمة التي قادتها “الولايات المتحدة الأمريكيَّة” المُسمَّاة بـ”اتفاقية دايتون للسلام”، والتي نجحت في تقسيم “البوسنة والهرسك” إداريًّا. وقد وافق عليها “بيجوفيتش” لينقذ أهله ومواطنيه من شنائع الحرب الصليبيَّة الصربية. وتفرغ عام 2000م من الأعمال جميعًا إلى الكتابة. إلى أن مات عام 2003م في مستشفى “سراييفو” المركزيّ؛ ليموت بين أهله الذين أحبَّهم وناضل من أجلهم. وقد خلَّف عدة مؤلفات فكريَّة وأدبيَّة. أشهرها على الإطلاق كتابه الذي كان له دويّ هائل في الأوساط جميعًا “الإسلام بين الشرق والغرب”. والذي نتناوله بوجه من وجوه التناول هنا.
“الازدواجيَّة الإنسانيَّة” المُسلَّمة الأولى عند “بيجوفيتش”
يكاد يكون فكر “بيجوفيتش” كله مبنيًّا على مُسلَّمة يراها حتميَّة في رؤية الإنسان والحياة؛ هي “مبدأ ازدواجيَّة الإنسان”. وتعني هذه الازدواجيَّة وجود عالَمَيْنِ يعيشهما الإنسان؛ هما المادة، والرُّوح. حيث الإنسان دائمًا يحسُّ وجود “عنصرَينْ، نظامَيْنِ، عالَمَيْنِ من أصليْنِ مُختلفَيْنِ، ومن طبيعتَيْنِ مختلفتَيْنِ، لمْ يصدرْ أحدُهُما عن الآخر”. بل يرى فوق ذلك أنَّ “الازدواجيَّة هي ألصق المشاعر بالإنسان”.
ورغم أنَّ هذا المبدأ لا يراه مُتَّسقًا مع كُلِّ الفلسفات الكُبرى؛ حيث هي واحديَّة النزعة، فإنه لا يعطي كبير اهتمام بتلك الفلسفات لأنَّها -ومن وجهة نظره- مُغايرة للواقع الذي يشعر كلُّ إنسان به ويعيشه؛ ألا وهو ازدواجيَّته من حيث هو مادة تُكوِّن جسده، ورُوْح يعطيه معنى الحياة.
وهذه الازدواجيَّة بدأت عندما أشهد الله-تعالى- بني آدم على أنفسهم. حسب قوله تعالى في سورة الأعراف، آية 172: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ). حيث كان الميثاق الأكبر، ونشأت عنده المعايير الأخلاقيَّة، وهبط الإنسان إلى العالَم. من هذه اللحظة بدأت حريَّة الإنسان تواجه حتميَّة الطبيعة في ازدواجيَّة ستظلُّ قائمة ما قامت الحياة وبقيت.
ويرى “بيجوفيتش” عنصرَيْ الازدواجيَّة جليَّيْنِ في تاريخ الفلسفة، وفي تقدير الفلاسفة واهتمامهم. حيث يمثِّل خطَّ “الرُّوح” في الفلسفة: أفلاطون، الغزاليّ، ديكارت، كانط، هيجل، برجسون. ويمثِّل خطَّ “المادة”: طاليس، هوبز، ديدرو، سبنسر، ماركس. وبذلك يُكيِّفُ “بيجوفيتش” نظرته مع أحد التقسيمات الرئيسة للفلسفة العامة؛ حيث يجعل الفلاسفة ذَوِيْ الاتجاه المثاليّ فلاسفةَ الرُّوح، وذَوِيْ الاتجاه الماديِّ فلاسفةَ المادة.
ولا شكَّ في أنَّ الجُزء الأضخم من فلسفته قد ساقها على ما أمْلَتْهُ عليه تلك المُسلَّمة. فقد كان لهذه المُسلَّمة آثار بعيدة الغور على رؤيته للواقع، ورؤيتِهِ لقضايا هامَّة جدًّا في نظر أيّ مذهب فلسفيّ أو فكريّ يسعى لتحليل ما حوله. وسوف نأتي الآن لنماذج من تأثير هذه المُسلَّمة عليه. تتمثّل في رؤيته لقضايا وتعريفات مثل: الثقافة، الحضارة، التقدم.

مفهوم الثقافة، والحضارة، والتقدُّم عند “بيجوفيتش”
فلنتخيَّلْ الآن أنَّنا ننظر في مِرآة “بيجوفيتش” من وجهة نظر مُسلَّمته .. سنرى على الجانب الآخر انعكاسًا للازدواجيَّة (المادة – الروح) هو (الحضارة – الثقافة). إنَّ “بيجوفيتش” يرى مفهومَيْ الحضارة والثقافة على أساس من الاختلاف والتباين، إنَّه يراهما طرفَيْ تضاد.
الثقافة عنده: هي مجموع العوامل التي تربط الإنسان بالسماء، وبأصله الذي جاء منه. حيث تتكوَّن من الدين، والفنّ، والأخلاق، والفلسفة، والشعر، والأدب. أيْ أنَّ الثقافة هي المُقابل لشقِّ “الرُّوح” في مُسلَّمته. والثقافة عنده هي تأثير هذه المؤثرات التي تُخضع الروح، وتغذيها وتنميها لتجعلها دومًا روحًا لإنسان، لتجعل للإنسان أصلاً سماويًّا، لا مجموعة أمشاج من طين-كما يرى الماديُّون-. يقول: “فكلُّ شيء في إطار الثقافة إما تأكيد، أو رفض، أو شكٌّ، أو تأمل في ذكريات ذلك الأصل السماويّ للإنسان. تتميز الثقافة بهذا اللُّغز، وتستمرُّ هكذا خلال الزمن في نضال مستمرٍّ لحلِّ هذا اللُّغز”.
الحضارة عنده: هي مجموع العوامل التي تربط الإنسان بأصله الماديّ، وتذكره بأصله الحيوانيّ؛ حيث تساعده على أداء مهامِّهِ البيولوجيَّة (الحيويَّة) بكفاءة أكبر؛ من حيث المأكل، المشرب، الملبس، الانتقال…. أيْ أنَّ الحضارة هي المُقابل لشقِّ “المادة” في مُسلَّمته. ونراه يؤكد على ذلك بقوله: “هذا الجانب من الحياة يختلف عن الحيوان فقط في الدرجة والمستوى والتنظيم”. ويقول: “الحضارة تعني فنّ العمل والسيطرة، وصناعة الأشياء صناعة دقيقة…فهي التغيير المستمرّ للعالَم”.
التقدُّم عنده: هو التحسين المستمرُّ في الجانب الحضاريّ فقط، دون التحسين في الجانب الرُّوحيّ الثقافيّ. وهكذا يرى العالَم الحديث فكرة “التقدُّم” لذلك يضفي عليها “بيجوفيتش” صفات السوء. بل يجعل في كتابه عنوان “التقدُّم ضدّ الإنسان” ليسخَرَ فيه من تلك الشطحات الهائلة في مجالات العلم الحديث التي جعلت العالَم يجنُّ بفكرة التقدُّم. ثُمَّ يتساءل: هل كلُّ هذا التقدُّم ساعَدَ في سعادة البشرية؟! .. وعلى مدى عشر صفحات يأتي بعشرات وعشرات من التقارير الدوليَّة والحكوميَّة؛ لنرى أنَّ أشدَّ البلاد تقدُّمًا هي أكثرها شقاءً، وسوء أخلاق، وخوفًا، وإجرامًا.
- المُشكلات الرئيسة في عالَم اليوم عند “بيجوفيتش”
تتمثل المشكلات التي تعصف بعالَمنا اليوم، وكذلك تهدد العالَم الإسلاميّ في:
-الصراع الأيدولوجيّ المسيطر على العالم. حيث يكاد العالم اليوم يتحول إلى كتلة من صراعات فكرية شرسة تحارب بعضها. ولا أدلَّ على ذلك من أنَّه افتتح كتابه بقوله: “يتميز العالَم الحديث بصدام أيدولوجيّ نحن جميعًا مُتورِّطون فيه؛ سواء كمساهمين أم ضحايا”. ولعلَّ الصراع الذي يقصده “بيجوفيتش” تحوَّلَ قليلاً عن يومنا المَعيش؛ حيث كان يقصد جهات هي: الصراع الشيوعيّ -ويمثله الاتحاد السوفيتيّ- من جهة، والصراع الرَّأسماليّ -وتمثله دول الغرب- من جهة، والظهير الفكريّ المسيحيّ من جهة.
-حالة الاستقطاب الشديدة التي تُمارَسُ على الدول والشعوب من قِبَل تلك الأيدولوجيَّات. حيث كلُّ فلسفة تعمل بأسلحتها الكاملة لاستقطاب الشعوب، ولتكوين جبهات داعمة ومؤمنة ومؤيدة لها. وأظنُّ أنَّ التفكير السليم يؤدي إلى أنَّ سلاح الشيوعيَّة كان الحرب والقمع، وسلاح الرأسماليَّة -كان وما زال- السلع الاستهلاكيَّة، وسلاح المسيحيَّة هو الكنيسة والتبشير في العالم. رغم أنَّه لم يرِدْ هذا الكلام في سطور كتابه.
-الإلحاد حيث تغزو العالَمَ مذاهبُ نظرية التطور، والفلسفات الشيوعيَّة، والحركات الاجتماعيّة الهدَّامة -مثل الهيبز- والأفلام الإباحيّة. وكلُّها مذاهب ماديَّة لا تنظر إلى الإنسان إلا باعتباره جسدًا ومادةً فقط، مِمَّا يهدِّد بقاء هُوِيَّة الإنسان الرُّوحيَّة.

وجهات النظر الثلاث المتكاملة في حاضر العالَم المعاصر
يرى الكثير من وجهات النظر في العالَم. لكنَّ ثلاثًا منها فقط تمتلك صفة الرؤية المتكاملة للعالَم.
-وجهة النظر الدينيَّة: ولا يقصد بها الإسلام، بل المسيحيّة. وتبدأ من الرُّوح. وهي عنده تعكس إمكانيَّة الضمير.
-وجهة النظر الماديَّة: وتبدأ من المادة. وهي عنده تعكس إمكانيّة الطبيعة.
-وجهة النظر الإسلاميَّة: وتبدأ من الوجود المُتزامن للرُّوح والمادة معًا. وهي عنده تعكس إمكانيّة الإنسان.
*”الإسلام بمنظوره الحضاريّ” الحلّ لمُشكلات العالَم عند “بيجوفيتش”
إنَّ قضيَّة “الإسلام” تمثّل ذُروة تطبيقه لمُسلَّمة الازدواجيَّة. فقد رأى أنَّ غالب التاريخ والتأثير الدينيّ انصبَّ على اليهوديَّة، والمسيحيَّة، والإسلام. ثُمَّ بدأ بتصنيف الدين اليهوديّ والمسيحيّ باعتبار مُسلَّمته. فقد انصبَّ الدين اليهوديّ على الجانب الماديّ من الإنسان، فكانت تعاليمه وفلسفته مُنحازةً للمادة وحدها. وجاء الدين المسيحيّ ليصلح من هذا الانحياز فصبَّ جهوده، ورؤيته على الجانب الرُّوحيّ فقط. فكانت الدِّيانتان مُفتقدتَيْنِ لشيءٍ هامٍّ ومُكوِّنٍ رئيس. ولكنَّه أشاد بالمسيحيّة ونظامها الرُّوحيّ، مع وصفه بأنَّه نظام ناقص، بل إنَّه يرى أنَّ نجاح “الشيوعيَّة” في العالم المسيحيّ كانت لغياب الجانب الماديّ فيها.
والمَلحوظ هنا في منهج “بيجوفيتش” أنَّه يُعمِل المناهج الحديثة في “علم الاجتماع” على الأديان، فيَذهب مذهب التطوُّر في الأديان -وهذا اتجاه في علم الأديان العامّ-؛ حيث اعتبر المسيحيّة تطورًا لليهوديَّة، والإسلام تطوُّرٌ لهما، وأنَّه تطوَّرَ في تاريخه من الدين الخالص (الذي يشبه المسيحيّة) إلى الدين العالميّ الحضاريّ في شكله الحاليّ، لكن على يد الرسول -صلى الله عليه وسلّم- فقط. وهذا الاعتبار المنهجيّ له ملامحه التأسيسيّة في المنهج والموضوع على حد سواء.
وهو مخالف للتصوُّر الإسلاميّ العامّ للأديان؛ حيث الرسالات لا تتطوَّر؛ فهي ليست بسيطة، أو ذات حال بدائيَّة. وغاية ما في الأمر أنَّ الدين يُحرَّف من أهله، أو أنَّ الرسالة كانت منذ البدء مُوجَّهةً إلى قوم بعينهم (كرسالة المسيح فإنَّها موجهة إلى اليهود فقط). ولعلَّ هذا من إغراقه في المناهج الغربيّة وأتباعها. وقد أحببتُ التنبيه على هذا المِفصل المنهجيّ.
وقد عقد “بيجوفيتش” الكثير من المقارنات بين الأديان الثلاثة. ومن أذكاها وأوضحها هذا المثال الذي أحبّ أن أعطي صاحبه فيه التعبير عن نفسه. يقول: “يكرّس “العهد القديم” فكرة الأذى بالأذى، ويكرّس “العهد الجديد” العفو. فانظرْ إلى القرآن كيف يركّب جُزَيْئًا من هاتَيْنِ الذَّرَّتَيْنِ: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ) -الشورى 40-“. وهكذا يوضّح الفارق بين تناوُل ووِجهة وتصوُّر الإسلام عن الدِّينَيْنِ السابقَيْن.
والإسلام عنده اقترب من اليهوديَّة في ماديَّتها، واقترب من المسيحيّة في رُوحيَّتها. بل تطور على ذلك وجمع بين الاثنَيْنِ في مُركَّب واحد لا ينفصم. فكان النظام الأكمل في العالم، وصار النظام الوحيد الذي يشمل ازدواجيَّة الإنسان.
وقد اعتمد الإسلام في امتيازه عن الأديان السابقة، وعن المذاهب الماديَّة على دعامتَيْنِ:
-الرُّؤية الشاملة؛ حيث يتكامل فيه عُنصرا الإنسان (المادة، الروح).
-المنظور الحضاريّ؛ حيث ينظر إلى الإنسان بصفته خليفةً لله -تعالى- على أرضه. فهو عنده ليس مُجرَّد أمشاج من موادّ -كما الرؤية الماديّة-، وهو عنده مسئول في الكون لا مجرد مِرآة، مُحاسب على مسئوليّته -ليس كما في الدين الخالص-.
سمَّى “بيجوفيتش” مُراعاةَ الإسلام للازدواجيّة بـ”ثُنائيّة القُطب”؛ فكأنَّ الإسلام يمثل وحدةً لها قطبان تشملهما. وراح يتناول كلَّ رُكن من الإسلام ليُطبّق عليه هذه الثنائيّة الجامعة بين المادة والرُّوح. فمثلاً “الصلاة” رُكن الإسلام الأوّل، وهي شعيرة شائعة بين الأديان، وغرضها دائمًا هو التطهر الرُّوحيّ من خلال الاتصال بـ”الإله” -على حسب تصوُّر كلّ دين-. وفي الإسلام الصلاة كذلك لها الغرض نفسه، لكنَّها فوق ذلك تجمع التطهُّر الرُّوحيّ بالطهارة الماديَّة البدنيَّة.
فلا بُدَّ للصلاة من الوضوء، ومن التأكُّد من طهارة المكان والمُصلِّيْ. وكذلك الحركات في الصلاة؛ أيْ اعتمادها على الحركات الجسديَّة. هذان العُنصران (الطهارة الماديَّة، الحركات البدنيَّة) ليسا موجودَيْنِ في مفهوم الصلاة عند الأديان، لكنَّهما في الإسلام بارزان مُؤكَّدان وشرطان لبدء التطهُّر الرُّوحيّ بلقاء الخالق. وهكذا يجمع الإسلام بين المادة والروح في أحد أركانه. وقد تتبع باقي الأركان كذلك. وهو يرى أنَّ الصلاة مِنهاج الكون في توحيد الفكرة والعمل.
هذا، ويتميّز الإسلام بمجموعة من الخصائص؛ تُؤهِّله ليكون دين الحضارة والثقافة معًا، المادة والرُّوح معًا. منها في نظره:
-الجمع بين الفكرة والعمل، كما رأينا في أركان الإسلام.
-الجمع بين الفنّ والتكنولوجيا (الثقافة والحضارة)؛ مثل فنّ العمارة الإسلاميَّة، حيث يجمع بين جمال الفن، مع وظيفة الشيء المُتفنَّن فيه ونفعيَّته.
-أنَّه دين يتَّجه نحو الطبيعة؛ تأمُّلاً، وتفكُّرًا، وإعمارًا.
-دين جمع بين الدين الخالص والعلم (الثقافة والحضارة)؛ حيث المسجد -مثلاً- مدرسة في الوقت نفسه، وهو يسمّيه بـ”المسجدرسة”.
-دين ينظر إلى الإنسان في صفته الفرد الواحد، وفي صفته الجمع (الناس) -حيث يلحظ أنَّ غالب الخطاب في القرآن للناس-. ولا ينظر إليهم بمعيار البطوليَّة، ولا معيار الملائكيَّة.
-دين يجمع بين الدين الخالص والقانون. بل هو قانون في ذاته. وقد لحظَ أنَّ أحدًا لا يستطيع التفريق في الإسلام بين المُؤلَّف الدينيّ، والمؤلَّف القانونيّ، وأنَّ غالب المُفكّرين المسلمين كتبوا في الفقه والمَنظومة القانونيَّة الشاملة للإسلام، ويمثِّل بذلك لكتاب “الخَرَاج” للإمام “أبي يوسف”. حتى في المنظومة العِقابيَّة نرى المُوازنة بين الذنب الشخصيّ وحماية المُجتمع.
-دين يُوحِّد الحياة الاجتماعيَّة الماديَّة مع الرُّوحيَّة. مثال “الزواج” عند المسيحيِّين رباط رُوحيّ، وعند الماديِّين مجرُّد عقد. فانظرْ إلى “بيجوفيتش” إذ يكتب: “جاء الزواج الإسلاميّ فوحَّدَ هذَيْنِ النوعَيْن من الزواج. فالزواج الإسلاميّ -من وجهة النظر الأوربيَّة- هو زواج دينيّ ومَدنيّ. أيْ أنَّه عقد اتفاق يتمُّ في حفل دينيّ في الوقت نفسه. والذي يعقد الزواج رجل دين -هذا التعريف غير صحيح فليس في الإسلام رجال دين بالمعنى المسيحيّ- ومُوظَّف في الدولة .. الاثنان في شخص واحد. ولأنَّ في الزواج الإسلاميّ صفة العقد، لذلك يمكن حلُّهُ عند الضرورة؛ فالطلاق مسموح به لأسباب تقتضيه … وهذا تفكير دينيّ أخلاقيّ معًا”. ومع طول الفقرة لكنِّي أحببت أن نتصل معه فيها.
هذا وغيره من خصائص الإسلام التي تؤهِّله ليكون النظام الحضاريّ الأفضل للعالَم عند المفكّر الكبير “بيوجوفيتش”.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




