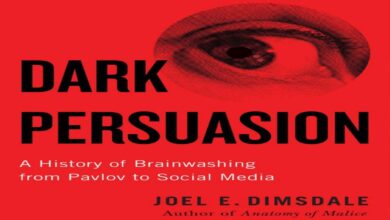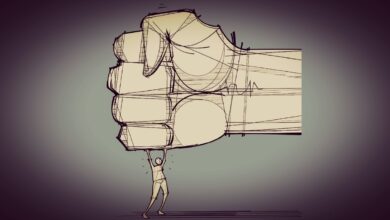السلوك الاجتماعي ليس مجموعة من الأحاسيس المُضطربة، أوْ كَومة من العواطف الساذجة، أوْ منظومة من رُدود الأفعال العبثيَّة، وإنما هو منهج نظري وعملي في آنٍ معًا، يشتمل على تاريخ الأفكار الإنسانيَّة، والوعي الوجودي بهذا التاريخ. وكما أن الوعي لا ينفصل عن التاريخ، كذلك الفكر لا ينفصل عن التطبيق. وهاتان القاعدتان تسيران جَنبًا إلى جَنب في فلسفة الشعور الإنساني، التي تستمدّ شرعيتها من قُوَّة المنطق والاحتكام إلى العقل. وهذا يدفع باتِّجاه توليد تيار فكري نقدي، يقوم على فحصِ المُسلَّمات المُكرَّسة اجتماعيًّا بفِعل الأهواء والمصالح والعادات والتقاليد، واختبارِ حقيقة الوعي الإنساني في عَالَم القَسوة المُتغيِّر. وقَسوةُ العَالَم هي الامتحانُ الحقيقي للإنسان، وُجودًا وفِكْرًا وشُعورًا. وبما أن كُل امتحان يحتاج إلى إجابة، ولا يُمكن التَّهَرُّب مِنها، فإنَّ الإنسان مُطَالَب بالإجابة عن السؤال المصيري الذي يمسُّ شرعيَّة وُجوده، ومشروعيَّة سُلطته الاعتباريَّة على الأنساق الاجتماعيَّة: هل يُحافظ الإنسان على إنسانيته في العَالَم القاسي والبيئة الخشنة أَمْ يتحوَّل إلى وحش كاسر للحِفاظ على وُجوده وسُلطته؟
والتحدِّي المصيري أمام السلوك الاجتماعي ينطلق مِن حقيقة مُفادها أن الإنسانيَّة على المِحَك، والإنسانيَّة هي القلب النابض للسلوك الاجتماعي، وهذا يعني أن الإنسان صارَ في مركز الخطر، ولم يَعُد الخطر مُجرَّد احتمال، وإنَّما صارَ واقعًا ملموسًا ومُعاشًا، ولم يعد الإنسانُ واقفًا على الشاطئ يُراقب دَوَّامات البحر، وإنَّما صار في أعماق الدَّوَّامات، وعليه أن يُنقِذ نَفْسَه بنَفْسه، ويُقَاتل الطاقةَ السلبيَّة بالطاقة الإيجابيَّة، لأنَّ بَر الأمان بعيد، ولن يأتي أحد لإنقاذ أحد، لأن كُل إنسان مشغول بنَفْسه، ولا يُفكِّر إلا بالنجاة الشخصيَّة. وهذا أمرٌ مُتوقَّع في بيئة عالميَّة مُعادية لإنسانيَّة الإنسان، كرَّست الخلاصَ الفردي كَحَل وحيد للنجاة، لذلك صار كُل فرد يُحاول القفزَ مِن السفينة قبل غرقها، ولا يُفكِّر بإنقاذ السفينة. والنجاةُ الجماعيَّة لَيست مُستحيلة، فلا داعي للخوف، ولا وقت للبكاء والاستسلام، والوقتُ الذي يَقضيه الإنسانُ في البكاء على الماضي، يَكفي لبناء الحاضر وإنقاذ المستقبل. والوقتُ الذي يَستهلكه الخَوفُ مِن المَوت، يَكفي لصناعة الحياة.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.