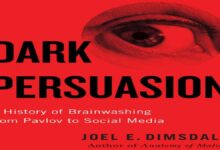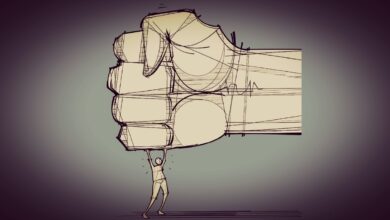الفضيلة الغائبة؛ تراجعات الأخلاق في العلاقات الدوليَّة

مقاربات وتباينات:
تُشير الدلائل الراجحة، من خلال النظر المنهجي، إلى أنَّ مجالي القانون الدولي والعلاقات الدوليَّة يربطهما تداخل الصلات الموضوعيَّة، ما نشأ عنه اهتمامات وتاريخ مشترك، كما أن بينهما تبايناً صارخاً في المهنيَّة والحرفيَّة والشعور بالهدف. ولعقود عديدة، نما الحقلان بشكلٍ منفصل، إلا أنه في الآونة الأخيرة فقط كانت هناك علامات واضحة على التقارب. ومع ذلك، فإننا نشكّ في أن تداخل الاهتمامات الموضوعيَّة سيفوز في سباق التقارب هذا إلى درجة التكامل البنيوي، بسبب الخلافات العميقة بينهما، ليس فقط في الأسلوب، الذي ينجز به أعضاء الحقلين ما يفعلونه، ولكن أكثر من ذلك في الطريقة، التي يبرّرون بها ما يقومون به من أفعال. ولتوضيح دليل هذا التأكيد، لا بد لنا أن نُشير إلى أن العلاقات الدوليَّة قد شهدت نقاشاً جادّاً حول العودة إلى مراجعة الممارسة التقليديَّة لأداء محترفيها، واحتضان فكرة “الانعكاس”، التي عُرِفَت للمرَّة الأولى في علم الاجتماع، إذ بدأ مؤخّراً أن هناك عودة واسعة، ولكنها متفاوتة، إلى مناقشات قضيَّة الأخلاق. وعلى النقيض من ذلك، يبدو لنا أن لا شيء مشابه لهذا قد حدث في النظريَّة القانونيَّة الدوليَّة، المتمِّمة والضابطة لحقل العلاقات الدوليَّة، الأمر الذي جعل هذا التباين بين الحقلين عقبة في سبيل إصلاح الممارسة وضبط بوصلة الهدف.
إنَّ مردّ هذا التباين يرجع إلى حقيقة أن هناك اختلافاً واسعاً بين القانونيين حول تفسير الأخلاق في العمل السياسي عامَّة، وفي العلاقات الدوليَّة على وجه الخصوص. يقول نيكولاس غرينوود أونف في مقال له بعنوان: “التفكير في الأخلاق، التفكير عبر الحقول”، نُشر يوم 22 يونيو 2016، في موقع AEON الإلكتروني، لطالما كانت العلاقات الدوليَّة مرتبطة بتداخلات صعبة مع عالم السياسة، فهي بلا شكّ تتداخل مع فن الحكم. ففي هذا السياق، يعد دور الممارسة مجرد محاولة غير مجديَّة لكسر الفجوة بين النظريَّة والسياسة، ناهيك عن التمييز بين القيمة والحقيقة المُضَمَّنْ في العلوم كَحِرَفٍ مُمَارَسَة. وعلى النقيض من ذلك، فإنَّ القانون يجعل الممارسة حتميَّة مهنيَّة، ويظل الإقناع هو نقطة الحجَّة القانونيَّة. وتعني الدعوة أن القيم تُشَكَّل بنشاط تفسير القانوني للوقائع في أيَّة حال، بما في ذلك وقائع القانون. لهذا، لم يستطع الطرفان أن يتَّفقا حول تعريف واحد لهذه المُعادلة، بحيث يتراوح الفهم للأخلاق السياسيَّة بين من يعتبرها مجموعة القيم، التي تُنظِّم العلاقات بين الجماعات والدول، على قاعدة الاحترام المتبادل، وبين من يُعْلِي المصالح ويجعلها الحاكم لكل فعل سياسي يرتبط بالآخر؛ وفي ذلك لا بأس ولا مناص، من منطلق أصحاب هذا الرأي، أن تبرِّر الغاية كل الوسائل، من مَكرٍ، ودهاء، وخداع، وقوَّة، واعتداء وتدخل، بلوغاً لهذه المصالح.
افتراضات جدليَّة:
إنَّ ما تقدَّم يمثِّل خلافاً قديماً متجدّداً بين المدارس السياسيَّة الغربيَّة، التي تتراوح بين الاعتدال الأخلاقي، الذي يمثِّله المفكِّر الإسباني فرنسيسكو دو فيتوريا، والذي عاش بين عامي 1490 و1546، وبين التطرُّف النفعي في تصوّرات المنظِّر السياسي الإيطالي نيكولو برناردو مكيافيلي، والذي عاش بين عامي 1469 و1527، وأرسى قاعدة “الغاية تُبرِر الوسيلة”. وتماثلهما في العصر الحديث؛ في جانب الاعتدال، نظريَّة القانون الدولي الإنساني، التي ترفض استخدام القوة، وتأبى التجاوزات على حقوق الشعوب والدول، بمنطق القوة؛ وفي الجانب النفعي، النظريَّة البراغماتيَّة، والتي تُبرِّر المخاتلات غير الأخلاقيَّة في العلاقات الخارجيَّة من أجل تحقيق مصلحة الدولة. ولاستجلاء هذا التباين، يجب الإشارة هنا بشكل أوضح إلى أن هذا التفسير لما يفعله القانونيون يعكس اليوم الطريقة الأنجلو – أمريكيَّة للتفكير في القانون باعتباره مهنة؛ بينما يرى العلماء المختصّون في القانون الدولي الأمور بطريقة مختلفة بعض الشيء. وينبغي أن نُشير أيضاً إلى أن للطريقة الأنجلو – أمريكيَّة أثراً حاسماً على أسلوب ممارسة القانون الدولي، الأمر الذي يعني أن هناك انعكاساً لا شك فيه لقرنين من هيمنة هذه الطريقة؛ يسندها منطق القوَّة الصلبة، وعسكرة السياسة الخارجيَّة لدى الطرفين.
لقد أثبت مارتي أنتيرو كوسكينيمي بقوة في كتابه “من الاعتذار إلى اليوتوبيا: هيكل الحجة القانونيَّة الدوليَّة”، الصادر في هيلسنكي عام 1989، عن رابطة القانونيين الفلنديين، أن ممارسة القانون الدولي مليئة بالافتراضات الليبراليَّة. فالقانون الدولي هو بالفعل عنصر رئيس في تصوّر الليبراليَّة كمشروع عالمي، وخاصيَّة لا تتجزّأ من الثقافة السياسيَّة للعالم المعاصر. ولا حاجة إلى الحديث عن الأصول الأنجلو – أمريكيَّة، على وجه التحديد، لهذا المشروع، والطرق العديدة، التي تَشَرَّبتها الليبراليَّة منها، مع الافتراضات النفسيَّة والثقافيَّة لهذه الأصول. ورغم هذا، قد يجوز هنا التأكيد على أن الليبراليَّة هي فعلاً مشروع أخلاقي. ولا شيء يجعل هذا أكثر وضوحاً من مناداتها بأهميَّة حقوق الإنسان، في النظريَّة والممارسات القانونيَّة الدوليَّة المعاصرة. إن ظهور الاهتمام العلمي المذهل بـ”الدستوريَّة العالميَّة” هو دليل إضافي على أن الليبراليَّة كمشروع أخلاقي ما زالت حيَّة؛ حتى في الظروف الراهنة، التي طغت فيها ظواهر الشعوبيَّة العنصريَّة، وتبدت نزعات الهيمنة الإمبرياليَّة من جديد.
وبالطبع، إذا كان ذلك كذلك، فإن لهذه الليبراليَّة؛ رغماً عن ذلك، وجود طويل في النظريَّة السياسيَّة أيضاً، لأنها نزعة أخلاقيَّة ترمي إلى التحرر السياسي والاقتصادي. وإذا وافقنا على هذا المُعطى، فمن الواضح أن الخطاب الغالب اليوم في العلاقات الدوليَّة هو موضوع الأخلاق، الذي تتبناه المدرسة الليبراليَّة، بينما كانت النظريَّة الواقعيَّة، التي تحدِّد العلاقات الدوليَّة بنظرة ضيِّقة لا ترى سوى الدول منفصلة تتصارع على المصالح، في المقابل، قد تبنَّت الردع والأحلاف، هي ما كان سائداً بعد الحرب العالميَّة الثانيَّة؛ بل وأعادت، منذ نهاية الحرب الباردة، تأكيد هيمنتها، بدعاوى كانت معظمها تحت ستار التصوّرات البنيويَّة، التي تمتلك أوسع حدود للاختصاص بتركيزها على وحدة النظام الدولي في كل مستوياته، وتركيزها على نماذج الإنتاج، واعتبارها للعلاقات السياسيَّة بين الدول كظاهرة سطحيَّة، والتي كرَّست الاستغلال والتبعيَّة.
إنَّ كل هذا يطرح مشكلاً اليوم، مثلما كان معضلة بالأمس، فيما يتعلَّق باختيار المفهوم، الذي يعبِّر عن هذه المقاربة بشكل كلي ودقيق؛ قبل أن تشمل النظريات الدياليكتيكيَّة، والماركسيَّة، والطبقة الاجتماعيَّة، والماديَّة التاريخيَّة، وغيرها، ثم اختيار البنيويَّة كمنطلق للممارسة. وهنا، كانت حقوق الإنسان، مرَّة أخرى، مصدر قلق كبير بسببٍ من دكتاتوريَّة الأنظمة الشيوعيَّة آنئذ، بإعلائها للجوانب الأمنيَّة في واقعيتها الدفاعيَّة. فقد انضمَّ حينها عدد كبير من علماء العلاقات الدوليَّة إلى زملائهم في الحركة الدستوريَّة العالميَّة، التي تعمل الآن كخليفة لحركة النظام العالمي القديم، والتي بلغت ذروتها قبل أربعين عاماً خلت.
ومع ذلك، فإنَّ التجربة علّمتنا أنَّ علماء العلاقات الدوليَّة هؤلاء لا يأخذون الليبراليَّة، وعلاقتها بالسلوك الأخلاقي، كأمر مفروغ منه. فقد وضعت الواقعيَّة الصاعدة العديد من الليبراليين في موقف دفاعي، وأجبرت بعضهم على زيادة الاهتمام بالبحث عن موضوعة الأخلاق عند فلاسفة السياسة. وفي هذا المنحى، ظهر في المقدِّمة إيمانويل كانط وأبحاثه الأخلاقيَّة، ثمَّ احتلَّ جون رولز مكانة بارزة بين هؤلاء. وفي حين أن فلاسفة القانون حذوا حذوهم، إلا أن القانونيين الليبراليين الدوليين لم يترسَّموا خطاهم. ويمكن أن يُعزى السبب هنا إلى الزيادة الهائلة في الحاجة إلى ممارسة القانون الدولي. إذ إنه عندما تكون الممارسة ذات أهميَّة قصوى، وعائدٍ ماديٍ مُجْدٍ، وفي حالة تبرير ذاتي عن انشغالاتها، فإنَّ الفقه السياسي الأخلاقي لا يُهْتَمُّ به كثيراً.
التجربة علّمتنا أنَّ علماء العلاقات الدوليَّة هؤلاء لا يأخذون الليبراليَّة، وعلاقتها بالسلوك الأخلاقي، كأمر مفروغ منه. فقد وضعت الواقعيَّة الصاعدة العديد من الليبراليين في موقف دفاعي، وأجبرت بعضهم على زيادة الاهتمام بالبحث عن موضوعة الأخلاق عند فلاسفة السياسة.
التراجع والإحياء:
الآن، وبالعودة إلى سجال العلاقات الدوليَّة مرَّة أخرى، سنجد أنه مما يثير الدهشة إلى حدٍّ كبير، أن تراجع الواقعيَّة الأخير ألهم أيضاً حركة إحياء، وإن كانت متواضعة، لرغبتنا في الاهتمام بالأخلاق. وذلك من خلال النظر إلى ما يسمَّى بالواقعيَّة الكلاسيكيَّة، التي لا ترى إلا الدول، وجدوى ما يمكن أن تقدّمه في هذا السياق. وبالتالي، أنصتنا مجدّداً إلى شخصيات أمريكيَّة مرموقة في هذا الحقل؛ مثل، رينهولد نيبور وهانز يواخيم مورغنثاو. فقد أسهم المفكر عالم اللاهوت البروتستانتي رينهولد نيبور، الذي عاش بين عامي 1971 و1892، في تطوير المنهج الواقعي في السياسة الخارجيَّة، إذ يؤكِّد على ذلك بقوله “إن نزعة الإنسان نحو العدل هو ما يجعل الديمقراطيَّة ممكنة، ونزعة الإنسان نحو الظلم هو ما يجعل الديمقراطيَّة ضروريَّة”. في حين يُعتبر المفكر مورغينثاو، الذي عاش بين عامي 1904 و1980، أحد رواد القرن العشرين في مجال دراسة السياسة الدوليَّة، وكانت له إسهامات بارزة تتعلق بنظريَّة العلاقات الدوليَّة، فضلاً عن دراسة القانون الدولي، إلى جانب تأليفه كتاب السياسة بين الأمم.
كما أعاد بعض الباحثين في بلدان أخرى كثيرة اكتشاف مسألة الأخلاق في العلاقات الدوليَّة، دون أيَّة إشارة إلى الليبراليَّة ومخاوفها المعياريَّة. ومعروف أنه بدلاً من التعبير عن هذه المخاوف بالتضييق الكبير جداً على الواقعيَّة الوضعيَّة، فإن الليبراليَّة تميل إلى الاكتفاء بإظهار الحكمة كمرشد أخلاقي. رغم أنه كان هناك ردّ فعل ضدّ احتضان العلم، والافتتان بنظريَّة الاختيار العقلاني، والافتراض بأن العلوم الاجتماعيَّة الجيِّدة تتطلَّب استخدام الأساليب الكميَّة، خاصَّة في أوروبا، وبشكلٍ أعمّ في مجمل حقل العلاقات الدوليَّة.
إن الواقعيَّة الوضعيَّة تَدَّعِي التمسك بمنهج العلم الوضعي، الذي يفرض بصرامة التمييز بين الواقع والقيمة، ولا يسمح بوضع أي اعتبار للأخلاق. وقد يكون هذا الفهم مناسب للباحثين في الولايات المتَّحدة، الذين يساوون ببساطة بين الهيمنة الأمريكيَّة والقيم الليبراليَّة، وأن الأخلاق العليا تعني بالمنطق البراغماتي المصالح الأمريكيَّة العليا. غير أنه، وفي كل مكان آخر، يُنظر إلى هذا الافتراض الأمريكي المتعجرف، على ما هو عليه من تحيزات، باستياء شديد، لأنه لا يُقدم حافزاً للانتقال إلى تبني الأخلاق في العلاقات الدوليَّة، إلا ما كان متوافقاً منها مع المصالح الأمريكيَّة. ومرَّة أخرى نرى، إذا جاز لنا أن نُكرِّر القول، إنه لا يوجد مثل هذا الدور للواقعيَّة الوضعيَّة، الذي يفرض نفسه على القانونيين الدوليين، لأن القانون الدولي ليبرالي بأصول قواعده، وتنتشر القيم الليبراليَّة بالفعل في افتراضاته.
وممَّا لا شكّ فيه أن الواقعيَّة الأمريكيَّة؛ رغم إدخالها لقضايا حقوق الإنسان والحرّيات الدينيَّة كوسائل ضغط في سياستها الخارجيَّة، إلا أنها لا تُشبِه الأخلاقيات التي نادت بها الليبراليَّة، مثلما لا تتطابق البنيويَّة مع التعدّديَّة، والتي تنظر إلى المجتمع الدولي كشبكة من العلاقات المتداخلة، لأن نظريتها العامَّة ليست منتوجاً أكاديمياً للعلاقات الدوليَّة، وإنما هي مثل الاتّجاه المثالي المحافظ في اعتماد مبدأ الدولة/المركز. وقد رأى البعض في هذا الاتجاه نوعاً من “الواقعيَّة الجديدة”، ولكن عندما ظهرت السلوكيَّة في الخمسينيات، اعتبرت بمثابة الرفض التام للواقعيَّة؛ قديمها وجديدها. وتلا ذلك هجوم على مناهج بحث الواقعيَّة فقط دون أن يتمكَّن الرافضون لها من تعويض نظريتها العامة، ثم أن كل الجهود، التي مارستها المدرسة السلوكيَّة بين الخمسينيات والستينيات في مجال الدراسات الكميَّة، و”المحاكاة”، وبناء النظريَّة، انطلقت كلها من المسلمات الواقعيَّة. ولكن هذه الواقعيَّة لم تشهد منافسة حقيقيَّة وجديَّة إلا في السبعينيات، متزامنة مع ظهور نظريتي التبعيَّة والبنيويَّة، ومن بَعْدِهِمَا منظورات الاعتماد المتبادل والتعدديَّة.
بيد أن رد فعل الواقعيَّة جاءت مع كتاب بي جيه كوهين، الموسوم بـ”مسألة الإمبرياليَّة: الاقتصاد السياسي للهيمنة والاستقلال”، الذي صدر في نيويورك عام 1973، والذي أكد فيه على التحليل السياسي، وليس الاقتصادي للإمبرياليَّة. ولحقت بها مساهمة روبرت تاكر، في كتابه “عدم المساواة بين الأمم”، وصدر بنيويورك عام 1977، الذي رفض فكرة توزيع العدالة، أو تجزئتها. وقد أكد هيدلي بول، في كتابه “التدخُّل في السياسة العالميَّة”، الذي أصدرته مطبعة جامعة أكسفورد عام 1984، على أهميَّة التدخُّل الفعَّال. بينما أعاد ستيفن كراسنر كتابة الاقتصاد السياسي بلون “تجاري- جديد”، في كتابه “الدفاع عن المصلحة الوطنيَّة: استثمارات المواد الخام والسياسة الخارجيَّة للولايات المتَّحدة”، الذي صدر في نيوجيرسي عام 1978. وكذلك فعل روبرت جيلبين، في كتابه “الحرب والتغيير في السياسة العالميَّة”، الذي أصدرته جامعة كامبريدج عام 1984، والذي أكد فيه على دور الحرب كمؤسَّسة للتغيير.
وهذا يُحِيلنا إلى حقيقة أن الواقعيين يشتركون مع المثاليين في منظور “الدولة/المركز state-centric paradigm”، ولكن يختلفون معهم في الحلول المقدّمة كسياقات عامَّة للعلاقات الدوليَّة. ففي الوقت الذي يدعم فيه الواقعيون المذاهب المحافظة، التي تقول إنَّ الدول القويَّة في العالم عليها مسؤوليَّة الحفاظ على النظام الدولي؛ مع كل ما تتضمَّنه هذه المسؤوليَّة من تحدّيات وصعوبات ومخاطر، فإن المثاليين اختاروا المذاهب الليبراليَّة، وما يرافق المسؤوليَّة فيها من مقتضيات أخلاقيَّة، ويرون أن الدولة يمكن أن تُرَوَّضْ، ويمكن للتغيير أن يحدث تدريجيّاً بواسطة آليات؛ مثل نزع التسلُّح، والأمن الجماعي، وتقوية أنظمة القانون، واتِّخاذ إجراءات عقابيَّة ضدّ المعتدين. وكل هذه الأفكار تتقاطع في بعضها مع المبادئ، التي يؤمن بها الواقعيون، خاصَّة موضوع السيادة، والقوَّة، والدبلوماسيَّة، ولكن ظلَّ حُلم المثاليين دائماً ينزع إلى إمكانيَّة تكوين حكومة عالميَّة.
ثقافة الحقوق:
لقد ارتبطت فكرة الحكومة العالميَّة هذه بتصوّرات ومنظومات العدل والمساواة الإنسانيَّة في مستواها الكوني، كمبدأ حداثي. وسبق أن علقنا بالفعل على ظهور ثقافة الحقوق، وشدَّدنا على طابعها الليبرالي الحداثي، إلا أن هناك سمة أخرى من سمات الحداثة، التي نحتاج إلى مراعاتها، وتدخل في منظومة الإصلاح بمعناه الأشمل. وإذا أردنا أن نضع الإدارة والحوكمة وترشيد المجال العام في الإطار، فهنا، بالطبع، سنجد أن عَالِماً عملاقاً؛ مثل ماكس ويبر، يلقي بظلاله الوريفة على موضوع الإصلاح، ونعلم جميعاً أن ويبر كان مهتماً جداً بالآثار الأخلاقيَّة للخدمة العامَّة، ناهيك عن المسعى الرأسمالي والحياة البرجوازيَّة، وإسهاماته النظريَّة المتقدِّمة حول الأخلاق البروتستانتيَّة وربطها بقيمة العمل.
إنَّ القضيَّة المحوريَّة، التي يَنْظُرها العلماء في عالم ما بعد الحرب الباردة، هي بروز مستجدات ملحَّة على مستوى أجندة السياسة العالميَّة، وخاصة صعود البعد الأخلاقي في العلاقات الدوليَّة، وارتفاع الأصوات المناديَّة بتعزيز هذا البعد القيمي. إذ تأسست الليبراليَّة الأولى على أفكار الحريَّة والمساواة، وبينما يُشَدِّد نموذجها الكلاسيكي على قيمة الحريَّة هذه، إلا أن المبدأ الثاني، وهو المساواة، يتجلَّى بشكل أكثر وضوحاً في الليبراليَّة الاجتماعيَّة. ورغم أن التحليل السياسي العامّ لا يستبعد متغير القوة، حتى في الليبراليَّة، إلا أن المقاربات الجديدة ترتكز بالأساس على فهم كيفيَّة نشوء الأفكار والهويّات، وتتفاعل بها مع بعضها البعض، لتشكل الطريقة، التي تنظر بها الدول لمختلف المواقف، وتستجيب لها السياسة الخارجيَّة تبعاً لذلك.
وتعكس مناهج العلوم الاجتماعيَّة المعاصرة، وتدعم إلى حدٍّ كبير، صعود نزاهة الإدارة والحوكمة الرشيدة في العالم الحديث. وهناك، بالطبع، خلفيَّة أخلاقيَّة للإدارة باعتبارها حرفة موجهة إلى بعض القيم الواضحة؛ مثل الكفاءة والتناسب، ومن أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل، وأعطوا الأجير حقّه قبل أن يجفّ عرقه. وتأخذ هذه الخلفيَّة، إلى جانب أنها دينيَّة؛ إسلاميَّة ومسيحيَّة، شكل الأخلاق التتابعيَّة، وهي طريقة تفكير تعود، في جانبها المادي، إلى جيريمي بينثام، الفيلسوف والقانوني الإنجليزي، الذي عاش بين عامي 1748 و1832، والمنظر الرائد في فلسفة القانون الأنجلو – أمريكي، واشتهر بدعوته لمبدأ النفعيَّة المتبادلة. كما أنها أيضاً طريقة تفكير تميل إلى تعزيز النشاط المتمايز وظيفياً في المجتمعات الحديثة المعقّدة.
لقد كان للنظريَّة الوظيفيَّة إسهام صغير نسبيّاً في العلاقات الدوليَّة، ويرجع الفضل في ذلك أساساً إلى كتاب “نظام عمل السلام” لديفيد متراني، الذي صدر في شيكاغو عام 1946، وعندها فقط أُتُخِذَتْ الوظيفيَّة كعامل مساعد للفكر الدولي الليبرالي. بينما اضطر القانونيون الدوليون في الآونة الأخيرة إلى مواجهة انتشار الأنظمة القانونيَّة المحدّدة وظيفياً، التي تضمّ فنيين لا يعملون دائماً في الحكومات، بل ينشطون غالباً في مجالات متعدِّدة. ففجأة أصبحت ممارسة القانون الإداري العالمي جالبة لمصلحة كبرى، لكن يبدو أن أحداً لم يفكِّر في أهميته الأخلاقيَّة. ولا تكاد مناقشة المساءلة الفرديَّة، أو المؤسّساتيَّة، تكون مهمَّة في العلاقات الدوليَّة، وفقاً للمدرسة الليبراليَّة، أو القانون الإداري العالمي، أو في هذا المجال المزدهر لأخلاق العمل.
إن الليبراليَّة الحقيقيَّة تستلهم أشياءها من تراث النظريَّة الكلاسيكيَّة، بما في ذلك الاهتمامات الإنسانيَّة الأولى بقضايا الحقوق، وقدر الإنسان، كما جاءت في فلسفة كانط الأخلاقيَّة، أو مبدئيَّة العدالة الاجتماعيَّة في جدليَّة هيجل، والماديَّة التاريخيَّة لكارل ماركس، وبِشُرُوحَات إنجلز ولينين، وغيرهما من المُنَظِّرِين الإشتراكيين. في حين أن الاستقلال الذاتي الليبرالي أصبح الآن مؤطّراً بشكل روتيني كمشروع كانطيان، الذي تعتمد الإدارة العقلانيَّة فيه على تبعيَّة الدعم الأخلاقي. ويبدو أن لا أحد في العلاقات الدوليَّة يشعر بالانزعاج من التناقضات الواضحة في هذين النظامين الأخلاقيين، وكلاهما يدَّعي أنه يتمتع بتطبيق عالمي.
إنَّ القضيَّة المحوريَّة، التي يَنْظُرها العلماء في عالم ما بعد الحرب الباردة، هي بروز مستجدات ملحَّة على مستوى أجندة السياسة العالميَّة، وخاصة صعود البعد الأخلاقي في العلاقات الدوليَّة، وارتفاع الأصوات المناديَّة بتعزيز هذا البعد القيمي.
آليَّة المنفعة:
في الواقع، كما أشار روب ووكر، في كتابه “الداخل/الخارج: العلاقات الدوليَّة كنظريَّة سياسيَّة”، الصادر عن مطبعة جامعة كامبريدج عام 1993، إلى وصف “المنفعة الليبراليَّة” باعتبارها آليَّة عمل حاضرة في كل الحديث عن النظام العالمي، ودراسة الأنظمة الدوليَّة، إلا أنه يرى أن هذا الاتِّجاه في ربط العلاقات الدوليَّة بهذه النفعيَّة الليبراليَّة يتضمَّن بالضرورة مناقشة حول الدستوريَّة العالميَّة، والقانون الإداري العالمي. ويمكن النظر هنا إلى كتاب فريدريش كراتوشويل المعنون “وضع القانون في المجتمع العالمي: تأملات في دور وسيادة القانون”، الصادر عن مطبعة جامعة كامبريدج عام 2014، للحصول على تقييم حاسم حول هذا الأمر. فإذا كان هناك تقارب متنامٍ بين العلاقات الدوليَّة والقانون الإداري العالمي، فهو في رأينا متَّسق تماماً مع هذا الانصهار السهل للغاية بين الأنظمة الأخلاقيَّة المتنافرة والعالميَّة. ومع النفعيَّة الليبراليَّة غير المنعكسة كأرضيَّة مشتركة، يوفِّر القانون الإداري العالمي والعلاقات الدوليَّة الإطار النظري لمجموعة من الممارسات، التي يمكن التعميم من خلالها.
وبالمراجعة الفاحصة لهذا الإطار النظري، يبدو أن العلماء الناقدين للقانون الإداري العالمي والعلاقات الدوليَّة لم يكونوا قد عانوا من نفس النوع من تعقيدات التقارب الوليد. على الأقل لا نرى أيَّة علامات على ذلك، لأسباب ليس أقلّها أنَّ علماء القانون النقديين أبدوا القليل من الاهتمام بنظرائهم في مجال العلاقات الدوليَّة. وقد يعتقد المرء أنه سيكون خلاف ذلك، إذ بعد كل شيء، فقد وجَّه العلماء الناقدون في العديد من المجالات حماستهم التحرريَّة ضدّ الحداثة الليبراليَّة وافتراضاتها حول الأهميَّة العالميَّة. ويمكن أن يكون كره النفعيَّة الليبراليَّة بمثابة أرضيَّة مشتركة لشن أيَّة حملة من أجل بديل متماسك للأنظمة الأخلاقيَّة الحديثة، وليس فقط ضدّ النفاق الليبرالي مثل “سيادة القانون”. وبدلاً من ذلك، نرى مقاومة حرجة للمطالبات العالميَّة، جنباً إلى جنب مع جاذبيَّة “الآخر”. على الأقل، يكشف النقاش المدروس، الذي أجراه ديفيد كينيدي، في كتابة حول “الجانب المظلم للفضيلة: إعادة تقييم الإنسانيَّة الدوليَّة”، الصادر عن مطبعة جامعة برينستون عام 2005، عن قلق القانوني الناجم عن الإدارة العقلانيَّة في ممارسة التنميَّة الدوليَّة.
لهذا، يجب أن يكون من الواضح للجميع أن الكثيرين من علماء السياسة غير راضين عن حالة الخطاب الأخلاقي في كل من القانون الإداري العالمي والعلاقات الدوليَّة. إن اندماج الحداثة الليبراليَّة بين كانط وبنثام ليس سوى بداية المشكلة، ولا يوجد حّل للنقد العامّ لهذا الخطاب. وإذا كنا سنقوم بتفصيل تداعيات ومتطلّبات النظامين الأخلاقيين في زمن الحداثة، فعلينا أن نتساءل عن سبب إصرارنا على أن الأنظمة الدوليَّة، أو “المجتمع المدني العالمي” يقدمان الحكم الذاتي الفردي، أو يدفعان لإظهار كيف تعمل الدستوريَّة العالميَّة والقانون الإداري العالمي ضد بعضهما البعض. غير أنه لا يزال يتعين علينا مواجهة أوجه القصور في كلا مشروعي النظامين الأخلاقيين الحديثين، حتى يكون الجميع سعداء بالمصادقة عليهما.
ويسود اعتقاد في الأوساط العلميَّة أن الخطوة الوحيدة المعقولة، التي ستأخذنا إلى فضيلة الأخلاق، هي عندما يعيد الفلاسفة والمنظِّرون السياسيون اكتشاف أخلاق الفضيلة. ولطالما ارتبطت هذه الأخلاق ارتباطاً وثيقاً بالحياة اليوميَّة، وادّعاءات الفطرة السليمة في العلاقات الدوليَّة، فقد تحرَّك جان كلابر في هذا الاتجاه، وذلك وفقاً لما جاء في دراسته “القانون، الأخلاقيات، والحوكمة العالميَّة: المساءلة في المنظور”، التي نشرتها مجلة نيوزيلاندا للقانون الدولي والعام، في العدد 11، الصادر عام 2013. ففي رأيه أن أخلاق الفضيلة تسير جنباً إلى جنب مع إحياء النظريَّة السياسيَّة للجمهوريَّة، التي جذبت اهتماماً متواضعاً في العلاقات الخارجيَّة. ويرجع ذلك، إلى حدٍّ كبير، إلى دانييل دودني، في كتابه “حدود القوة: نظريَّة الأمن الجمهوري من البوليس إلى القريَّة العالميَّة”، الصادر عن مطبعة جامعة برينستون عام 2010، وجرى تأكيده في كتاب نيكولاس غرينوود أونوف “التراث الجمهوري في الفكر الدولي”، الصادر عن مطبعة جامعة كامبريدج عام 1998. وقد حاول أونوف مؤخّراً إعادة صياغة “أخلاق الفضيلة” كنظام قيمي قائم بذاته، أي جعله نظاماً يناسب عالم اليوم، ويعمل دون تعميم الذرائع. في الواقع، تم تكييف هذه الأفكار من محاضرة ألقاها أونوف مؤخراً، في معهد الجامعة الأوروبيَّة بسويسرا، ورسم هذا النظام الأخلاقي، وأعلن أنه سيتناوله مفصلاً في كتاب سيصدر قريباً. إذا كانت هذه هي اللحظة المناسبة لمثل هذا المنعطف، أو أي منعطف آخر، فلا يزال يتعيَّن علينا رؤيته بالعين المبصرة.
الخلاصة:
يلزمنا أن نُقرِّر، في الختام، أن المبادئ الليبراليَّة، التي قرَّبت فكرة الأخلاق كقيمة موضوعيَّة في العلاقات الدوليَّة، كانت في بداياتها منحصرة في أفكار الفلاسفة والمفكِّرين والأدباء؛ مثل، روسو ومونتسكيو وفولتير وغيرهم، إلى أن أضفت عليها الثورة الفرنسيَّة صفة المبادئ السياسيَّة، بعد أن ضمَّنتها في إعلان حقوق الإنسان والمواطن، يوم 26 أغسطس 1789. وأصبح بعدها العالم، على نحو متزايد، يتمثل نظريات مفاهيم القانون الأخلاقيَّة، التي تبدو صحيحة من خلال زيادة مجال الحريات الفرديَّة، وزيادة التركيز على الصالح العام؛ المُتَضَمِّن للحقوق المتساوية للمواطنين في كل أنحاء العالم.
ومع ذلك، فإنَّ التقاطعات والإخفاقات في تطبيقات قواعد الأخلاق في العلاقات الدوليَّة تجعل من هذه الأخلاق في حال ما يمكن الإصطلاح عليه بـ”الفضيلة الغائبة”، التي تبقى عالقة دائماً بين النظريَّة والممارسة. فالعلاقات الدوليَّة يُفترض أن ترتكز على مجموعة من قواعد وضع التعايش السلمي بين الأمم والشعوب، وهناك الكثير من الممارسات الدوليَّة، التي ينبغي أن تركِّز على تحويل هذه القواعد إلى اتِّفاقيات وقوانين دوليَّة. لقد تراجع السياسيون كثيراً عن الحجج الفلسفيَّة المتعلقة بمشكلة الالتزام، إلى حدٍّ كبير، ويجري التغافل عن تطبيق أخلاق الفضيلة بشكل منهجي في الممارسة السياسيَّة الدوليَّة. ومن المهم معالجة هذا الموقف، ليس فقط لأن أخلاقيَّات الفضيلة لديها ما تقدّمه للنظريَّة الدوليَّة، ولكن لأن نظام الأخلاق الليبرالي والقانوني الدولي الحالي لدينا لا يفشل فقط في تعزيز الصالح، بل يسبب أيضاً تأثيراً سلبياً على الممارسة السياسيَّة.
رغم توزّع أفكارها، يبدو أن الليبراليَّة تعد بالكثير في مجال تطوير العلاقات الدوليَّة. وبقدر ما يتطوّر النقاش بين المنظورات، فإن هذه المراجعة تفتح المجال أمام إمكانيَّة دراسة الترابطات في مستويات تحليل العوامل، التي تدفع ببعض المجتمعات لأن تكون عدوانيَّة، أو مسالمة، في علاقتها الخارجيَّة، أو كيفيَّة بناء مؤسّسات من شأنها أن تخدم العدالة في المجتمع الدولي بطرق أخرى غير الصراع. وقد جرى عرض الأفكار والأساليب المختلفة، التي يمكن أن تقدم إجابة للأسئلة الأكثر إلحاحاً في السياسة الدوليَّة والأخلاق، وأبرزت الأهميَّة النظريَّة لحساسيَّة السياق في قضايا الإصلاح، وأكَّدت على عدم الفصل بين ممارسات السياسة والأخلاق في العلاقات الدوليَّة.
* دبلوماسي، الأمين العام السابق لمنتدى الفكر العربي، الأردن.
السبت 13 يوليو 2019
أديس أبابا، إثيوبيا
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.