القراءة التنويريَّة للدين: أين تكمن المعركة؟
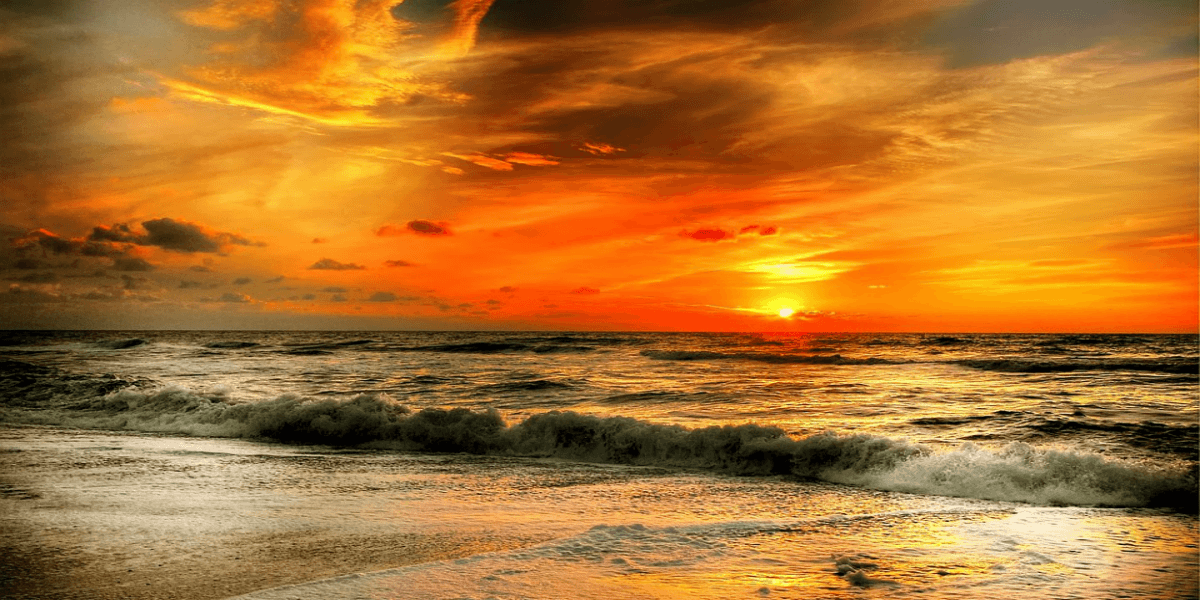
الفكر نِتاج الأسئلة، والأسئلة ابنة وفيَّة لمجتمعاتها. فالسؤال كائن حي، يتحوَّل ويتغيَّر مع صيرورة المجتمع الذي يعيش فيه، وتتبدَّل معانيه ودلالاته كلَّما تغيَّر السياق الاجتماعي المحيط به. ويخطِئ من يعتقد بأنَّ عمليَّة “الفكر” هي عمليَّة عقلانيَّة مجرَّدة تحدُثُ في ذهنِ “المفُكِّر”، دون أن تكون ذات صلة بالمجتمع الذي يحيط بها. وليس بإمكان المفُكِّر – مهما كان متجرّدا – ألا يكون جزءاً من لحظته التاريخيَّة، وعنصراً من عناصر السياق المحيط. صحيح أنَّ الفكر بإمكانه أن يلعب دوراً في تغيير الواقع المحيط، لكن ضمن حدود وليس في فراغٍ مطلق.
سؤال التنوير الأوروبي
ولم يكن سؤال التنوير الأوروبي منفصلاً عن سياقه. فخلال العصور الوسطى، مثَّلت الكنيسة بتعنُّتها الفكري والسياسي عقبةً كبرى أمام تطوُّر أهم ركائز الحداثة الأوروبيَّة المعاصرة: العلم، والدولة؛ وهو ما جعل سؤال التنوير يدور في معظمه حول محاولة التخلُّص من تأثير الدين- ممثَّلا في الكنيسة- على المجتمع، لفتح الطريق أمام تطوُّر العلم التجريبي (بهياكله العقليَّة ومنطق التفكير) والدولة الحديثة (بهياكل السلطة وأنظمة الإدارة).
وبناءً على ذلك، تأسَّس التنوير الأوروبي في القرن الثامن عشر على نقد “الدين” (الذي أصبح رمزاً للعصور الوسطى والظلام الأوروبي)، في مقابل “العلم” الذي كانت انتصاراته حديثة العهد حينها ومن ثم َّكان منتشياً بذاته ورمزاً للمستقبل وتحقُّق إرادة الإنسان. بالأساس، تركَّزت الانتقادات الموجَّهة للدين في تلك الفترة على اعتبارهِ يؤسِّسُ نفسه على “خرافات” في مقابل العلم التجريبي الذي يؤسِّس نفسه على “حقائق” تجريبيَّة. على سبيل المثال، يحكي رفاعة الطهطاوي عن لقائه بأهل باريس قائلا “إنَّ أكثر أهل هذه المدينة إَّنما له من دين النصرانيَّة الاسم فقط، حيث لا يتبع دينه، ولا غيرة له عليه، بل هو من الفرق المحسَّنة والمقبَّحة بالعقل، أو فرقة من الإباحيِّين الذين يقولون إنَّ كل عمل يأذن فيه العقل صواب…وإذا ذكرته له (الدين) في مقابلة العلوم الطبيعيَّة قال: إنَّهُ لا يصدِّق بشيءٍ ممَّا في كتب أهل الكتاب لخروجه عن الأمور الطبيعيَّة“[1]
سؤال التنوير العربي ما قبل الاستعمار: من الثورة الفرنسيَّة وحتى الاستعمار
وأشخاص مثل رفاعة الطهطاوي، كانوا طلائع التنوير التي نقلت إلى الشرق ما رأت وسمعت واختبرت في رحلاتها إلى الغرب، ومنذ ذلك الحين بدأت تتوافد على الجسد الشرقي المتهالك إشعاعات من النهضة الأوروبيَّة، حتى استحثَّت فيه سؤالاً بدا حينها مُباغتاً وحزيناً في الوقت ذاته: لماذا تقدَّمَ الغرب وتأخَّرنا؟ وبرغم صعوبة السؤال على النفس، ومحاولات الإنكار المبدئيَّة والتلقائيَّة، بدأ الوعي يترسَّخ داخل المجال العربي والإسلامي على مدار القرن التاسع عشر تقريبا بالفجوةِ التي اتَّسعت بينه وبين أوروبا الحداثة، “وهذا الوعي وإن انصبَّ في الأوَّل على الشعور بالقوَّة العسكريَّة الغربيَّة فقد تعمَّق وصار شعوراً بالتقدُّم الصناعي والتقني والعلمي والحضاري لدي الأوروبيِّين. وكأنَّ الظاهرة وقد أتت من أقاصي الدنيا باغتت هذه الحضارات الممتلئة بذاتها(الشرق) والشاعرة آنفا بتفوّقها لما لها من عمقٍ تاريخي“[2] لاحظ أنَّ هذا “العمق التاريخي” لمجتمعاتنا والذي يتحدَّث عنه هشام جعيط هو ما جعل سؤال التنوير العربي والإسلامي يعني تقريبا الحلم باستعادة هذا المجد القريب الذي ما زالت أصداؤه حيَّة في الذاكرة، ومن هنا كان “التنوير العربي” مشروعاً “للإحياء” و “النهضة”، بمعنى أنَّهُ كان مشروعاً يريد إعادة بناء الصلة بالماضي القريب (ماضي الخلافة وتراث الإسلام) وإحداث بعض التطويرات النوعيَّة لمواكبة الحداثة، وذلك على عكسِ سؤال التنوير الأوروبي الذي كان يريد القطيعة مع الماضي القريب (ماضي العصور الوسطى)، ومن هنا كانت حدَّته تجاه المسألة الدينيَّة والكنيسة.
وخلال هذه المرحلة الأولى، وتحت ضغط الإحساس بالفجوة، استمرَّت حركات الإصلاح والنهضة في محاولات “تنقية” الإسلام من الشوائب اللاعقلانيَّة التي لحقت به، في محاولة دفاعيَّة وتطويريَّة في آن. لاحظ أنَّ هذا الإصلاح الإسلامي كان يبني نفسه تأسيساً “على” الدين وليس تأسيساً “ضدَّه” كما كان الحال في أوروبا.
فمحاولات الإصلاح الديني في هذه المرحلة، كانت تحاول استيعاب مفهوم “العقل” و”العلم” اللذين صارا محوراً للحداثة، ضمن منظومة الدين والثقافة الدينيَّة، وليس بديلاً عنها، وهو ما كان يتطلَّب القيام بالكثير من الإصلاحات والتغييرات على الثقافة الدينيَّة السائدة. يقول محمد عبده عن التجديد الديني كما يراه أنَّه “تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمَّة قبل ظهور الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى، واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله لتردّ من شططه، وتقل من خلطه وخبطه، لتتمّ حكمة الله في حفظ نظام العالم الإنساني. وإنَّهُ على هذا الوجه يُعَدُّ صديقاً للعلم، باعثاً على البحث في أسرار الكون، داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة، مطالباً بالتعويل عليها في أدب النفس وإصلاح العمل“[3]. لاحظ كذلك أنَّ هذا الإصلاح الجديد – وخلال هذه الفترة الأوَّليَّة- لم يكن يجد حرجاً في الاعتراف بالتخلُّف الذاتي والاحتياج إلى الإصلاح وتغيير الذات[4]، وهو ما يمكنك قراءته في سؤال النهضة ذاته: لماذا تقدَّمَ الغرب وتخلَّفَ المسلمون؟[5]
سؤال التنوير في عصر الاستعمار: نهايات القرن التاسع عشر- منتصف القرن العشرين
غير أنَّ سؤال النهضة العربيَّة والإسلاميَّة لم يبقَ كما هو، منفتحاً ومتسامحا، فبنهاية القرن التاسع عشر، وجدَ العرب والمسلمون أنفسهم فريسةً للطموح الاستعماري لأوروبا المتفجِّرة بالقوَّة، ومن هنا ارتبك سؤال النهضة، إذ اختلط بالرغبة في مقاومة الآخر المغتصب وتأكيد الذات، فقد كانت “الرغبة الجامحة في التغيير تختلط مع رغبة لا تقل عنها هيجاناً في توكيد الذات، ومن هنا أتت معادلة صعبة وجدليَّة مرهقة”[6]. وبهذه الطريقة، أتت أوروبا بدباباتها إلينا لتربك سؤالنا الذاتي – كعربٍ ومسلمين- من بعد أن كانت تلهمنا من بعيد. فبطبيعة الحال، لم يكن يمكن أن تُفهَم في هذه المرحلة أي مطالبة بتغيير الذات سوى على أنَّها “خيانة ثقافيَّة” وتواطؤ مع المستعمر، وهي التهمة التي لاحقت مصلحين كبار من أمثال الإمام محمد عبده على سبيل المثال. و”في أشدِّ لحظات الهيمنة الأوروبيَّة (1880-1919)، كانت تجري الأمور وكأنَّ هناك خطين للبحث يحرِّكان أعماق الإسلام: خطّ إصلاح ذاتي بأوسع معنى الكلمة كان استمرارا للفترة السابقة وكان يزداد اتِّساعا، وخطّ رفض مباشر للآخر، وهذه ظاهرة جديدة ارتدت رداء المجابهة المركَّزة إذ راح كل مجتمع إسلامي يحامي عن حوزته”[7]. فبسبب الاستعمار إذن، أصبحت نداءات الحداثة والتحديث مُتَّهمة بالخيانة والولاء للمستعمر، ومحاصرة ضمن نطاقات ضيِّقة، وهو ما مكَّن الثقافة التقليديَّة في المنطقة من السيطرة بقوَّة على المجتمع، بحكم كونها الرافعة الاجتماعيَّة الأقوى في ذلك الوقت للنضال ضدّ المستعمر، جنباً إلى جنب مع القوميَّة التي كانت قد ازدهرت.
سؤال التنوير ما بعد الاستعمار (منتصف الخمسينات- 2011)
وبعد أن استُهلِكَت المنطقة في حروب التحرير، رحل الاستعمار بعد عقودٍ طويلة، لتستفيق المنطقة على نفسها غارقة في التناقض، كأنَّها أصبحت في عالمٍ غير الذي أمست فيه: تقسيم قطري بحدود سياسيَّة جديدة إمَّا بفعل الانشقاقات التي حدثت تباعاً عن دولة الخلافة، أو بفعل التوازنات والمفاوضات الأخيرة مع المستعمرين، حكومات وزعماء عسكريِّين تولَّوا السلطة بحكم شرعيَّة النضال ضدّ المستعمر، ولا مجال سوى للحديث عن “أنظمة الحكم الحديثة” و “الديمقراطيَّة” و”المواطنة” وما إلى ذلك، للحصول على الاعتراف الدولي وشرعيَّة الوجود “كدولة” في العالم الحديث، دون أن تفهم الكتل البشريَّة التي تحيا ضمن هذه “الدول” ماذا عليها أن تفعل -إذن- في ميراثها الديني والثقافي؟ هذه الازدواجيَّة بين نخب حاكمة تحلم بالتحديث القسري ومجتمعات ما زالت تحلم بمجد الخلافة هي ما خلقت – على المستوى الثقافي- ازدواجيَّة الوعي العامّ بين “الشريعة” من ناحية و”الدولة القطريَّة الحديثة” من ناحية أخرى، وهي الإشكاليَّة التي تحدَّث عنها روسو كثيرا في المجتمعات المسيحيَّة وامتدح غيابها في دولة الخلافة الإسلاميَّة، ولم يكن “روسو” ليتوقَّع أنَّ دخول الاستعمار والحداثة سويّا إلى المنطقة سيعيدان إنتاج مشكلته هنا. فالاستعمار الذي باغت المنطقة لم يمهلها فرصة هادئة لتطوير ذاتها على مهل، ولتحديث ثقافتها بما يتوافق مع متغيّرات الزمن. فقد اضطرَّت حروب التحرير ضدّ المستعمر المجتمع إلى اللجوء إلى أقوى ما لديه من مخزونٍ ثقافي: الدين التقليدي، حتى يتمكَّن من تأكيد ذاته والدفاع عن نفسه ضمن معركة وجود، ومن ثم تأجَّل الحديث عن مسألة الإصلاح الديني إلى أجلٍ غير مسمَّى.
لاحظ أيضا أن هذه المسافة بين المجتمعات الإسلاميَّة والدول التي حكمتها بُعَيْد الاستعمار (دول تحاول قيادة مشاريع تحديث فوقي، ومجتمعات ما زال وعيها يعيش في لحظةٍ سابقة) هو ما خلق عدَّة أزمات تالية؛ أوَّلها الهشاشة الدائمة لشرعيَّة الأنظمة الحاكمة بحكم كونها استمدَّت شرعيتها أساسا من مشاركتها في نضال المستعمرين سابقا، لكنها لم تحصل أبدا – في أغلب الأحوال- على شرعيَّة تعبيرها عن مجتمعاتها ثقافيّاً بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهو ما ألجأها إلى عمل مواءمات وتوازنات مع الثقافة التقليديَّة (وتحديداً التيَّارات والمؤسَّسات الدينيَّة التقليديَّة) لتأييد سلطتها، (عبد الناصر والأزهر على سبيل المثال)، وهو ما أدَّى بدوره إلى أن صار مشروع التحديث الذي كانت تقوده هذه الأنظمة يجري على قدمٍ واحدة؛ فالدولة من ناحية تديُّن التقليد، لكنها تتحالف معه في النهاية من أجل البقاء. ولهذا السبب لم تنجح مشروعات – أو شعارات- التحديث التي قادتها الدولة العربيَّة طيلة الخمسين سنة الأخيرة منذ أن خرج المستعمر وحتَّى مطلع القرن الحادي والعشرين، إلا بحدود ضئيلة وبعض الاستثناءات.
أيضا، لم تُثمِر عن شيءٍ تقريبا مبادرات التنوير التي خاضتها قوى من خارج الدولة، فهذا التحالف بين “الدولة” و”التقليد الديني” وضع قوى التجديد الديني في مفارقة صعبة: “فالدولة” التي (يتطلَّب تحديثها إخضاعها لسلطة الشعب وليس سلطة رجال الدين باختلاف أشكالهم مؤسَّسيّاً وحركيّاً ولا سلطة الشريعة)، بحثت لنفسها عن شرعيَّة عجولة بحكم ولادتها المبتسرة بعد خروج المستعمر، ومن ثم قامت بتأميم الدين وتوظيفه لصالحها، وبالتالي أجهضت “إصلاحه”. وبذلك أصبحت أصوات التجديد الديني أمام خصمين هما الدولة والتقليد الديني (وهي خصومة من الناحية النظريَّة) لكنهما متحالفين في الحقيقة (وذلك كما يتصرفا في الواقع)، وبالتالي وقع مشروع التجديد الديني مجدَّداً في موقفٍ متناقض، وأفسح المجال لتيّارات الإسلام السياسي، التي تطرح الدين التقليدي كبديل سياسي، وبالتالي فهي تتبنَّى نفس المعادلة التحالفيَّة التي تبنَّتها الأنظمة، لكن من موقع “أكثر تديُّنا”، على الأقل في أعين الجماهير. وهذه التيّارات -تيَّارات الإسلام السياسي- قد انضمَّت بذلك لتصبح خصماً ثالثا لمشروع التجديد الديني والمطالبين به، والذين وجدوا أنفسهم بذلك، وعلى مدار خمسين عاماً أو يزيد، يواجهون حلفاً ثلاثيّاً مركّبا: الدولة، المؤسَّسات الدينيَّة التقليديَّة، الإسلام السياسي!
قارن هذا الموقف المربك لتيارات الإصلاح الديني العربيَّة مع نظيرتها الأوروبيَّة، فتحرير الدولة من الارتهان لسلطة الدين/الكنيسة كان أحد الأهداف الأساسيَّة للإصلاح الديني الأوروبي، ويتخيَّل “ول ديورانت” حوارا بين كاثوليكي مؤيِّد للكنيسة وبروتستانتي مؤيِّد للإصلاح الديني، وفي هذا الحوار يتحدَّث البروتستانتي الإصلاحي مدافعاً عن موقف الإصلاح الديني وتأثيره على سلطة الدولة، قائلا “وقد اعترفنا بأنَّ السلطة الزمنيَّة من عند الله…لأنَّ النظام الاجتماعي يتطلَّب حكومة محترمة…ومع أننا أيَّدنا حقّ الملوك الإلهي، فإنّنا أيضا شجَّعنا نموّ الديمقراطيَّة في إنجلترا وأستكلندا وسويسرا وأمريكا، في حين كان قساوستكم في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا يخضعون للملوك، وقد حطَّم تمرّدنا على سلطة كنيستكم تعويذة الحكم المطلق، وهيَّأ أوروبا لمساءلة كل ألوان الاستبداد دينيَّة كانت أو علمانيَّة”[8].ولهذا السبب، وجد المصلحون الدينيُّون الأوروبيّون الأوائل عنتاً شديداً من المؤسَّسة الدينيَّة/ الكنيسة، بينما وجدوا دعماً من كثير من “الأمراء” بحكم كون مشروع التجديد الديني كان يصبُّ أساساً في صالح تأسيس الدولة وتحريرها من كل سلطة خارجة عنها، بينما في السياق الإسلامي والعربي، تعتمد الدولة أساساً على الدين والمؤسَّسة الدينيَّة -بعد تأميمها- في صياغة خطابها الاجتماعي وتأسيس شرعيّتها. وهو ما كان – وما زال – أحد التحدِّيات التي تواجه مشروع التجديد الديني في المنطقة كما أوضحت.
المرحلة الرابعة: ما بعد الربيع العربي
ومع القرن الحادي والعشرين، عبرَ جيلٍ جديد عن نفسه وعن تطلّعاته، فيما عرف بالربيع العربي، وهو موجة تغيير “كانت” واعدة ما لبثت أن اصطدمت مرة أخرى بصخرة الميراث الماضي والتحالف القديم: ثقافة دينيَّة تقليديَّة تحكم قبضتها على العقول وتغذِّي تيَّارات الإسلام السياسي ولو بشكلٍ غير مباشر، وأنظمة استبداديَّة في المقابل -تحالفت مع الدين التقليدي في السابق- واليوم تطرح نفسها كبديلٍ وحيد اضطراري![9]
لكن لا بد من الاعتراف كذلك، أنَّ موجات الربيع العربي أعطت لتيارات الإسلام السياسي فرصة ذهبيَّة للانتحار، فقد مكَّنتها من الظهور علناً للمرَّة الأولى منذ عقود واختبار فرضيّاتها في الواقع، كما أعطت للجماهير كذلك فرصة اختبار شعارات الإسلام السياسي ومقولاتها الأساسيَّة، وهو ما أدَّى في النهاية إلى انكشاف غطائها الشعبي والجماهيري السابق، مع انطلاق شبح التيَّارات المسلَّحة الذي أرعب الجميع، وهو الفزع الذي يقف وراء تشكُّل أغلب سياسات الإصلاح الديني اليوم.
سؤال التجديد الديني اليوم
فاليوم، وبعد الصدمات التي تعرَّض لها العالم والمجتمع الإسلامي من جراء سقوط الإسلام السياسي في اختبار الثورة، أصبح الخطاب موجَّهاً في اتِّجاهين – ليسا هما الأهمّ في تقديري- الاتِّجاه الأوَّل موجَّه نحو الخارج وهو خطاب تجميل الصورة الذي تحاول أن تتبنَّاه المؤسَّسات الدينيَّة الرسميَّة (كالأزهر) والأنظمة السياسيَّة (كالمملكة السعوديَّة)، وهو خطاب دفاعي خاوي من أي مضمون جدي يحاول أن يؤكد على أن للإسلام وجها غير الذي يراه العالم ويلح على تأكيد “الصورة المشرقة” للإسلام “الصحيح”! وليس ثمَّة فائدة من مناقشة هذا التيار – سواء بالاتِّفاق أو الاختلاف- فهو خطاب – كما أسلفت- خاوٍ من أيِّ محاولة جادَّة للتفكير بعمق وصياغة أيَّة رؤية بنَّاءة للذات، فقط يلح على محاولة دفاع عن الذات – وتمجيدها في ذات الوقت- دون طرح أي سؤالٍ حارق.
على الجانب الآخر، تبلور خلال السنوات القليلة الماضية اتِّجاه ثانٍ تتبنَّاه كذلك بعض الحكومات، وهو اتِّجاه امتصاص الطاقة التحريضيَّة للإسلام، والتي تتمثَّل على سبيل المثال في آيات الجهاد والتصنيفات الحادَّة للآخر السائدة ضمن الثقافة الدينيَّة التقليديَّة. يفترض هذا التيار أنه يمكن استخدام التصوُّف كبديلٍ مناسب للخطاب السلفي التقليدي الذي كشف عن بنيته التحريضيَّة العميقة حتى لو اختفى وراء نصوص وأحكام تبدو هادئة ظاهريّا، لكنَّه في نهاية الأمر يعبئ الوعي المسلم بكافة المركّبات اللازمة للتحريض والتي لا ينقصها سوى قدر مناسب من الاحتقان لتتحوَّل إلى أيديولوجيا عدائيَّة نشطة. على سبيل المثال، قام مجلس بيت العائلة المصري – الذي يجمع الهيئات الدينيَّة الإسلاميَّة والمسيحيَّة- بمبادرة لمراجعة المناهج الدراسيَّة المصريَّة من المحتوي الديني التحريضي وهو ما تمثَّل بحذف آيات الجهاد أساساً كما وأي إشارات لتكفير الآخر أو التحريض ضدّه.
وبرغم الفائدة النسبيَّة للاتِّجاه الثاني، وهي الفائدة التي تجعل منه إنجازاً نسبيّاً ومرحليّا، إلا أنَّهُ يطرح علينا سؤالاً مشروعا: ما هي الجدوى الحقيقيَّة من “إخفاء” محتوى ما دون تقديم معالجة جادَّة وشجاعة له تشتمل على الأقل على إعادة تعريفه، خاصَّة إذا كان ما سيتمُّ حذفه من كتاب المدرسة، سيطلُّ برأسه مرَّةً أخرى في خطبة الجمعة أو حتى من اليوتيوب، وذلك ما لم نواجه أنفسنا بالأسئلة الصعبة؟
في مقابل هذا وذاك، انشغلت أغلب القطاعات النخبويَّة الأكاديميَّة المهتمَّة بالدراسة النقديَّة للدين في “تيه” مناقشة “التنوير” كقضيَّة فلسفيَّة وفكريَّة ونظريَّة صرفة، منفصلة تماماً عن الدور الاجتماعي العملي المنتظر من التجديد الديني، بحيث تدور أسئلة هذه النخب حول موضوعات ذات بعدٍ فلسفي صَرِف (كمناقشة مفهوم التنوير) أو تاريخي (مثل نقد التنوير الأوروبي)، أو قضايا ذات بعد هويَّاتي وأيديولوجي في كثير من الأحيان من قبيل “نقد الاستشراق” و”الكولونياليَّة” وما إلى ذلك. بطبيعة الحال، كل هذه الأسئلة مشروعة لكنها لا تلمس الاحتياج الملحّ للمجتمعات العربيَّة والإسلاميَّة اليوم.
نقد وإعادة توجيه لسؤال التنوير اليوم
أولا، أودُّ أن ألفت النظر إلى عديد الاختلافات التي تعرَّضت لها بين سياق التنوير الأوروبي ومثيله الإسلامي الذي هو قيد التشكُّل، وهي الاختلافات التي تشحذ الذهن للتفكير خارج صندوق التجربة الأوروبيَّة الخام، لابتداع وسائل ومقاربات جديدة حقا، لكنها أصيلة ومتجذِّرة في ذات الوقت. مثلا، نحتاج أن نلاحظ أنَّ المفهوم الاختزالي للحقيقة العلميَّة التجريبيَّة قد تجاوزته حتى الثقافة الأوروبيَّة اليوم، ولا يعقل أبدا أن يؤسِّس سؤال التنوير العربي ذاته على سؤال قد تجاوزه العالم منذ قرن! (فقط لأن العالم قد تجاوزه وليس لمجرَّد أنه سؤال نشأ في السياق الغربي، فذلك لا يمكن أن يكون منفرداً سبباً لرفضه من حيث المبدأ). فاليوم، لم يعد مفهوم “التجريب” هو المفهوم المحوري، وإنما مفهوم “الاتِّصال”، ففي عصر الشبكات والتواصل الذي لا حدود له، يمكن نقد “الدين” -طبعا “الدين السائد” لا الدين في أصله كفكرة مجرَّدة- لا باعتباره “خرافة” لا يقبلها “العقل”، ولكن على أساس ما يحدثه من “انفصال” عن حركيَّة الواقع المتسارعة. المقصود هنا نقد الثقافة الدينيَّة بمقدار ما تكون عقبة أمام مسار التعلُّم الذاتي، والنضوج، وذلك في مقابل فضاء الاتِّصال الحديث الذي يشكل العالم اليوم. وبهذا الشكل يمكن لمفهوم “الاتِّصال” أن يكون مرتكزا للتجديد الديني، لا مفهوم “الحقيقة” الدو غمائي[10]. ومفهوم “الاتَّصال” ليس مفهوماً نظريّاً كما هو واضح، ولكنَّهُ مفهوم عملاني، يتجاوز الإشكالات النظريَّة لمفاهيم جدليَّة بطبيعتها (مثل مفهوم “العقل”) ويستدعي تلقائيّاً “التَّواصل”، “التعلُّم المتبادل”، “التثاقف”، “التحوُّل”، “التكيُّف”…إلخ ومن هذه المفاهيم وغيرها تتراكم التغيُّرات.
ثانيا: في تقديري لم يلمس السؤال التنويري كما هو مطروح اليوم أعمق نقاطه، ولم تضغط النخب العربيَّة والإسلاميَّة حتى اللحظة على أشدِّ نقاط السؤال حرقة وأهمّيَّة: سؤال التربية. فإذا كانت الثقافة التقليديَّة استطاعت أن تحافظ على نفسها من جيل إلى جيل عبر وسائط التربية المعروفة والحاضرة في ملايين التفاصيل اليوميَّة، فلا بديل لتطويرها عن اقتحام نفس الميدان؛ ببساطةٍ ساذجة: بماذا سنجيب على أبنائنا عندما يسألوننا عن الله؟ وعن معني الموت؟ وعن تعدد الأديان؟ وعن الجسد والجنس؟ بماذا سنجيب عندما يسألوننا عن الغرض من الحياة؟ وعن معنى الحرب؟ وعن معيار الخير والشر؟ أو حتى عن الوطن؟ هياكل العالم كلها تتغيَّر، ولم تعد من بنيةٍ ثابتة، وكل الإجابات البسيطة التي قبلناها نحن من آبائنا، لم تعد لتقنع طفلاً في الرابعة من عمره.
المطلوب تحديدا- وهو ما يمكن أن نعتبره المعركة الحقيقيَّة للتنوير- هو تقديم معالجة مختلفة ومعاصرة للمسألة الدينيَّة ولما يمكن أن نسميه بأوسع المعاني “التربية الدينيَّة”. ولا تعني التربية الدينيَّة هنا مادَّة “التربيَّة الدينيَّة” في المدرسة، كما لا تعني “التربية الدينيَّة” التعاليم الخاصَّة بالطقوس أو مسابقات حفظ القرآن الكريم، ولكن تعني صياغة إجابات جديدة يمكن تقديمها عن الأسئلة المبدئيَّة والأبسط حول هذا الكون – أسئلة الأطفال -: كيف يمكننا أن نميِّز بين الخير والشرّ؟ ولماذا يجب علينا أن نكون أخيارا؟ ماذا يجب علينا أن نفعل في هذه الحياة؟ ماذا يجب أن نتوقَّع من العالم؟
معركة التنوير اليوم ليست معركة ضدّ الدين، ولا يجب أن تكون كذلك، وإنما هي معركة مع الثقافة -ماكينة فهم الدين وتأويله- وبالتالي مع الذات. معركة التنوير تكمن في إعادة تأسيس الوعي المسلم – وعينا جميعا- من خلال التربية، بشكلٍ يعيد تعريف الذات والآخر والطريقة التي يجب أن ننظر بها إلى العالم، وإلى غاية الحياة، ومعنى العلاقات وأسسها، ومعنى الصواب والخطأ.
قائمة المراجع
الطهطاوي، رفاعة رافع. (2010). الأعمال الكاملة – الجزء الثاني. القاهرة: دار الشروق.
جعيط، هشام. (2011). أزمة الثقافة الإسلاميَّة. بيروت: دار الطليعة.
ديورانت، ول. (2001). قصة الحضارة (Vol. 27/28). القاهرة: هيئة الكتاب والمجموعة الثقافيَّة المصريَّة.
عبده، محمد. (2006). الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده. القاهرة: دار الشروق.
[1] (الطهطاوي، 2010، صفحة 44).
[2] (جعيط، 2011، صفحة 24)
[3] (عبده، 2006، صفحة 312)
[4] على عكس اليوم، ويا لها من مفارقة، حيث يمكننا التأكيد أنَّ الفجوة اليوم قد ازدادت اتّساعا عمَّا كانت عليه في مطلع القرن التاسع عشر، بينما في المقابل نجد تيّارا يهاجم بقوة كل نقد ذاتي موجَّه إلى الثقافة أو أية مطالبات بالتغيير باعتبار أن ذلك يمثِّل نظرة “كولونياليَّة” منبطحة! ولمزيد من المفارقة، فإنَّ أغلب رموز هذا التيار من أبناء التعليم الغربي والثقافة الغربيَّة، وبينما هم – كغربيِّين بالثقافة والتعليم – يمارسون عمليَّة نقد ذاتي للغرب من داخله، يتمّ تصدير كتاباتهم إلى المنطقة العربيَّة ليتمّ استخدامها من قبل التيّارات الأصوليَّة في دعم الجمود والدفاع المتشنِّج عن الماضي ومقاومة التغيير!
[5] ولا يعني ذلك بالضرورة الترحيب الجماهيري بمسألة الإصلاح، بل ربما العكس هو الصحيح.
[6] (جعيط، 2011، صفحة 66)
[7] (جعيط، 2011، صفحة 65)
[8] (ديورانت، 2001، صفحة 258)
[9] في تقديري ليس هذا التحالف هو السبب الوحيد لإخفاق الربيع العربي: أساسا، فقر النخبة وإخفاقها في صياغة بدائل وخطابات ناضجة هو جوهر المشكل بالنسبة لي، وهذا التحالف بين الدولة والتقليد الديني والثقافي الذي أتحدث عنه هو الأمر الواقع، الذي كان يفترض بالنخبة أن تتعامل معه، لكنها لم تفعل لأسباب عديدة.
[10] وبكل أسف، ما يزال بعض المثقّفين في السياق العربي والإسلامي يتبنون مفهوم “الحقيقة العلميَّة” بمعناه الاختزالي الضيق جدا للقرن الثامن عشر، والذي تجاوزته أوروبا ذاتها كما أشرت نحو مفهوم أوسع لنسبيَّة الحقيقة، يشمل العلم والدين معا، فكما أن الدين “حقيقة” رمزيَّة قاصرة، فالحقيقة التجريبيَّة كذلك لها قصورها الذي لا جدال فيه، لا سيما بعد الكشوفات العديدة لميكانيكا الكم والتي تقوم حاليا بتفكيك وإعدادة تركيب نظرة العالم لمعني الوجود ذاته.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




