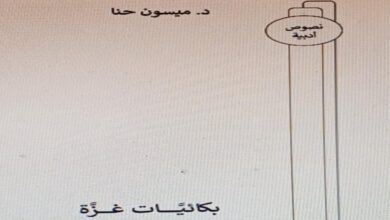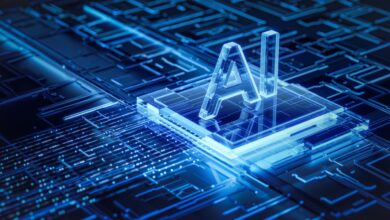الجمعيات الدينيَّة وإسهاماتها في التربية والتعليم في المنطقة العربيَّة

إنَّ النشاط الخارج عن المؤسّسات الحكوميَّة لا يكون مناهضًا في العادة لنظيره الرسمي، ذلك أنّه لا يُتصوّر نشاط تابع لجهة حكوميَّة ليس له مكمّل خارج عنها! وإذا أمعنّا النظر في الوسط الاجتماعيّ نجد اتّفاقاً حاصلًا على نجاعة جهود مؤسّسات المجتمع المدني، وسنقف في هذا المقام عند نشاط الجمعيّات الدينيّة وما تقدّمه من خدمات للمجتمع على اعتبارها جهدًا خارجًا عن مجال السياسة والأرباح.
تعلّق الطالب المتمدرس بمحيط جمعوي له أثره البالغ في تنمية قدراته التعليميّة والتربويّة، إذ هذا الأخير يأخذ بقيَّة وقته الذي إن لم يستثمره في هذا المجال وشبهه ضاع هباءً ولم يستفد منه بشيء، ويزداد الأمر أهمّيّة إذا تعلَّق هذا الطالب بجانب روحيّ لا يتنازع الناس في دوره وأهمّيته وانعكاسه على التربية والتعليم، كيف لا وأوَّل ما نزل من القرآن ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ العلق(1) فكان لهذا المجال قصب السبق في العناية به وتقديمه على غيره من مجالات النشاط.
ولعلّنا نورد مثالًا يكون معيارًا حقيقيًّا لصدق ما ذكرنا، ألا وهو مرور الجزائر بالحقبة الاستدماريَّة التي استهدفت التربية والتعليم كغرضٍ أوَّل، إذ تفطَّن علماؤنا لإقامة ما يسمَّى بالزاوية[1] التي هي بمقابل المدرسة النظاميّة التي قرّرت اللغة الفرنسيَّة لغة إلزاميَّة في التعليم فهدف الزاوية الأوَّل العربيَّة والقرآن فكان تأسيسها ببنايات هشَّة جدًّا، لأنّهم يدركون أن الاستدمار سيدمّرها فور علمهم بها، ومع ذلك تجني ثمارها والأمر كذلك في المغرب وتونس وموريتانيا وليبيا… هذا المثال يؤكِّد حاجة المجتمع لأمثال هذه الفضاءات لتكون دائمًا وأبدًا مكمّلة لنقص بل وعجز المؤسّسات الحكوميَّة عن أداء واجبها في كثير من الأحيان وبالخصوص في تلك الفترة التي كادت أن تُطمس فيها معالم العروبة. ولعلّ التدهور الذي عليه الآن المنظومات التعليميّة العربيّة هو بسبب التبعيّة ولا شكّ إذا لم تستقلّ منظوماتنا التربويّة يومًا موظّفة آراء أسلافها وأمناء أمّتها في العمليّة التعليميّة التي كانت الإشارة لها في القرون الأولى حتى إذا اكتشفها الغرب واستثمرها ننادي: علمناها منذ كذا قرن! وما زاد الطين بَلّة بكثرة كثيرة لا بقلّة؛ ما تمارسه المنظّمات الدوليّة التي فسحت المجال لثلّة من طلاب العرب من أجل احتوائهم واللعب على عواطفهم لاستمالة آرائهم أو كما يسمّي البعض هذه السياسة بـ”القوّة الناعمة”؛ إذ طرحت المنظّمات الدوليّة القوّة الصلبة المتمثِّلة في السلاح والغزو راجعة إلى القوّة الناعمة كوسيلة للعولمة الثقافيَّة.
ثم إنه من أبرز الذين أشاروا للعمليّة التعليميّة تأصيلاً وتفصيلاً من علماء الأمَّة الإسلاميَّة العلّامة ابن خلدون في كتابه “المقدّمة” تحت عنوان:
- وجه الصواب في تعليم العلوم وطرق إفادته.
- تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار الإسلاميّة في طرقه… وغيرها من العناوين.
المتأمّل لهذا الإسهام منه رحمه الله، يجد أن ما هو سارٍ الآن من محاولات لترسيخ استراتيجيّات العمليّة التعليميّة سواء: المقاربة بالتقويم، أو المقاربة بالمضامين، أو المقاربة بالكفاءات، أو المقاربة بالوجدان، ما هي إلا أسماء كانت الإشارة لها من ابن خلدون وغيره.
إنَّ تجاهل المنطقة العربيّة لإشارات عظمائها هو ولا شكّ سبب في تراجع المستوى العلمي المنشود الذي تطمح تحقيقة من خلال الإصلاحات التربويّة المتجدِّدة، ولعل الحلّ هو الوقوف عند ما كتبه علماؤنا في تأسيس التعليم وكفى.
إنَّ الإسهامات العلميَّة والتربويَّة التي يقدّمها المجتمع المدنيّ في مجال العلم الشرعيّ والأخلاق الإسلاميَّة هو ولا شك في خطٍّ متوازٍ مع خدمات المؤسَّسات الحكوميّة، إلا أن المجتمع المدني أكثر حرّيّة؛ إذ ما تقدمه الجمعيات من معارف وبرامج تكوين مهاري وقيمي وكذا برامج عمليَّة تستهدف الاتّجاهات وتنمِّي جوانب يصعب على المدرسة تنميتها[2] لاعتبارات عدّة قد يكون الطالب لها فاقدًا إيّاها في المؤسّسات الحكوميّة التي قد تكون تمنع تعليمها لأيّ غرضٍ كان، ولعل من بين الأمثلة هو حفظ القرآن الكريم إذ في أغلب المدارس النظاميّة لا نجد جداول لمتابعة الطلّاب في حفظ القرآن الكريم هذا إذا كان القرآن الكريم مادّة مقرّرة على غرار المجال المرخّص المتاح من جمعيّة أو غيرها وعلى سبيل المثال “الكتاب” أو ما يسمى بالدارجة: “المحضرة أو العربيّة”[3] التي قدّمت للمجتمع العربي ما يعجز اللسان عن وصفه من علم وأخلاق؛ إذ الحريّة التعليميّة في المجتمع المدني أكثر منها في المؤسّسات الحكوميّة التعليميّة. وقولنا هذا لا يعني الانتقاص أو تجاهل المدرسة الحكوميَّة إذ بدونها لا رسميّة لأي علم تتعلّمه فالشهادة الحكوميّة تمكِّن المتعلّم من بذل ونشر علمه ولا شكّ. ولا نقصد بقولنا هذا تهميش الذين حرموا التعليم النظامي، كما أنه لا تكون فرص علميَّة لمن أفرد التعلّم في الجانب المدني إذ رأينا الكثير منهم من أصحاب العلم والفضل لا يحملون شهادات مكنتهم من الانخراط في منظّمات أو جمعيّات أو حتى نشاطات اجتماعيَّة.
وإذا كانت جودة التربية من جودة التعليم حتمًا كان لزامًا علينا أن ننظر إلى جهود مؤسّسات المجتمع بعين التقدير والاحترام، ولعلّي أجد نفسي مجبرًا على ذكر ما قدّمته “جمعية العلماء المسلمين الجزائريّين”[4] من خدمات للعربيّة، والإسلام، والوطن برئاسة العلامة عبد الحميد بن باديس ومن بعده البشير الإبراهيمي وغيرهما وأكبر الأدِّلة على ذلك أنها إعادة الأمل وأيقظت العوام فضلا عن المثقّفين من الفرنسة التي تقبّلوها بل ورجوها رجاء المواطن المخلص! وفروع هذه الجمعيّة المباركة التي هي الآن على ما كانت عليه من خدمات لا تزال ماضية قدمًا ترسّخ ما طمح مؤسّسوها والحمد لله رب العالمين، وهذا المجهود وغيره من مجهودات في مختلف الأمصار العربيّة يؤكِّد الشرعيّة التي يسير عليها أمثال هؤلاء، بل ومساهمتهم في بناء البيئة العلميّة في الوطن العربي. إلا أنني في هذا المقام أودّ الإشارة إلى أمر مهمّ؛ وهو ضرورة اعتماد النشاط الجمعوي من طرف الحكومة وبعده حقيقة على أيّ توجّه سياسيّ أو دينيّ ليكون على مسمّاه الاصطلاحيّ الطامح للإصلاح بعيدًا عن أوهام التطرّف الدينيّ أو تحقيق أغراض سلبيّة.
ممّا يجدر بنا التنبيه عليه هو ضرورة التفات الحكومات العربيّة لأمثال هذه النشاطات وإمدادهم بالمساعدة وتثمين مجهوداتهم، أو على الأقل تسهيل الطريق أمامهم فحسب من أجل تنوير طريق الشباب الطموح لخدمة أمّته والذود عن مقدّساتها وتوفير الفضاءات اللازمة لهم.
____________
[1] مكان يوفّر التفرّغ التام من أجل تلقي العلوم بأنواعها: الفقه، العقيدة، النحو والصرف، الحساب، الفلك… وسمّيت كذلك كون الطالب الواحد يخصّص زاوية خاصّة به، أو هي من الانزواء.
[2] كبرامج تقوية الذات وتنميتها والقدرة على الحوار والتواصل وكذا العمل الميداني الذي ليس من اهتمامات المنظومات العربيّة وأيضا اكتساب الطاقة القياديّة …
[3] سميت “المحضرة” كذلك لأنها تجبر الطلبة على الحضور وسمّيت بـ”العربيّة” لأنها كانت تعلّم العربيّة في مقابل المدرسة الفرنسيّة إبان الاستدمار الفرنسي في الجزائر.
[4] هي جمعيّة إسلاميّة جزائريّة أسّسها مجموعة من العلماء الجزائريّين خلال النصف الأول من القرن العشرين، أسمى أهدافها: الأخلاق الإسلاميّة والمحافظة على الهويّة الوطنيّة وشعارها: الإسلام ديننا، والعربيّة لغتنا، والجزائر وطننا. وهي ماضية إلى الآن على ما أراده مؤسّسوها.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.