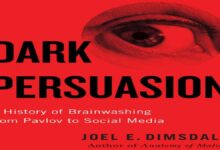ماذا ينبغي على أهل الفكر؟

*وجيهة البحارنة
السياسة عالمٌ متقلّب، لها حيثيّاتها وألاعيبها وقواعدها وأهدافها، صلحت أم فسدت، ولها مؤسَّساتها وأدواتها ورجالاتها وقراراتها، أصابت أم أخطأت، فقد تذهب للسلم وقد تذهب للحرب بين عشيٍّة وضحاها، لحيثيّات أو نوايا لا حصر لها معلنة أو مطويّة، نعلمها أو نجهلها.
فمهما كانت نداءاتنا وأمنياتنا الثقافيَّة كمفكّرين بأنّ السياسة العامّة للأوطان ينبغي أن تتقيَّد بمحاور الرشد، والصلاح، وحاكميَّة القيَم، ورضا الشعوب، إلا أنّ هذا يتعسَّر على صخرة الواقع، نتيجة ظروف كثيرة أملتها طبيعة الجغرافيا والتاريخ والإرث المعقَّد الذي نحن فيه، بل ولكثرة انهيال الزيف والدجل والتضليل وارتباك وضبابيَّة كلّ شيء.
فماذا تمتلك الشعوب أن تفعل وهي التي تدفع الثمن عادة؟ وكيف تصون قيمها، ومصائرها، وحاضرها ومستقبلها، عبر مؤسّساتها الثقافيَّة والدينيَّة، إذا اهتاجت السياسة وسارت في اتّجاه التدمير أو القطيعة والخُسران؟!
نحن نعلم كشعوب أنّ مصير أمّتنا واحد، وأنه على المحكّ، وأنّ أوطاننا نُهزة كلّ طامع فإذا حدث خلاف بين قُطرين عربيّين أو مسلمين، أو مجموعة أقطار، فهذا أوان (إذا ظهرت الفتنُ فعلى العالِم أن يُظهر علمه)، ومفكّرو الأمّة هم علماؤها، وعلمهم هو علمهم بأصيل قيَم الأمّة، وبخطير ووحدة مصيرها، وبجوامع كلمات وحدتها وعزّتها، فينبغي لهم فرادى ومؤسّساتيّين الدفع باتّجاه ترطيب الأجواء وإزالة الخلاف وتبديد المخاوف، مهما علت أبواق السياسة بالنفير تجاه الخصومة.
فإذا كان الطرفان متفقين على الخصومة والسلبيَّة كوسيلةٍ للحل، وهي أبشعُ الوسائل، فلماذا لا يندفعان نحو أحبّ الوسائل لله والناس، بخطوةٍ إيجابيَّة نحو طريق الحلّ وهي “التواصل” ؟ (وخيرهما من يبدأ السلام)، فهي خطوةٌ صغيرة، لكنها بداية لانطلاقةٍ بخطواتٍ كبيرة وقفزات واسعة نحو مستقبلٍ أكثر إشراقًا ورضا ومحبَّة.
والحوار من أنجع وسائل التواصل لحلّ الخلافات، والأكثر ملاءمة وتوافقًا مع روح العصر، بشرط أن يكون لتبادل المفاهيم بغية تقدير مضمونها الفكري وليس لتبادلِ قذائف الاتّهامات- ولتبديد الشكوك والمخاوف وأسبابها لا لحصد ثمارها.
السلم، الحوار، الأخوّة، التعاون.. هي قيم الأمّة التي لا حياد عنها، وهي ضمان بقاء وجودنا كأوطان وثباتنا كإنسان، لا يمكن للمفكّر أن يتّخذ دونها بدلا، وإلاّ سقطت عنه قيمة الفكر وقيمة الإنسان، بل قيمة الدين بشكلٍ أولي؛ إذ ربُّ الدين سبحانه أمر “فأصلحوا بين أخويكم”، ونبيُّه الأمين أوجب “إصلاح ذات البيْن أفضلُ من عامّة الصلاة والصيام”.
فكما في حريق الغابة الذي يمكن أن يأتي بأواره على المسكونة بأناسها ومنجزاتها، فإذ لم نملك قرار الإطفاء فلا أقلّ نحاول مجتهدين في تحجيم الأضرار ومنع استشراء النار.. وذلك عبر إعادة ضخّ ماء المشتركات، والتذكير بالقيم، والأهمّ كمثقّفين هو عدم السقوط في النار بالاشتغال بالتحريض وتبادل الاتّهامات وتبرير الخصومة، عوض الاشتغال بالتهدئة ونزع فتائل الأزمة وعدم تبرير الخصومة.
وإنّ من أقوى وقودات نار السياسة الواجبِ إبعادُها، هشيم الدين وزيت الثقافة، فلو حصرنا مسألة الخلاف في الدائرة السياسيَّة لتُحلّ هناك عبر مطارحاتها السياسيَّة وقنواتها وأدواتها وقوانينها وقِواها، دون أن نحشر الشعوب وعواطفها فيها، ودون أن نشحذ أقلام المفكّرين للنفخ فيها، ودون أن نستجدي الدين للنفير به في تشريعها وتقديس نارها.. نكون قد أدّينا واجبنا في الفتن، و”أظهرنا علمنا” الإطفائي.
إن دور المثقَّف باعتباره حالة وعي في الوطن والأمَّة، أن يكون شاهدًا ونذيرًا، فلا ينساق ويذوب ويُعبَّأ ويُوظَّف، بل يقول بصدقٍ وشفقةٍ ما فيه المصلحة لوطنه وأمّته، لكن يقولها بعقلٍ لا بخلاف وشقاق، وبمنطق حبٍّ لا برعونة واستعلاء فساد، فيدعو دائمًا للمصالحة بين الأشقّاء، وللتحقيق النزيه في أيّ خلاف، ولتغليب السلم والأمن كونه قيمة جوهريّة ثابتة، القيمة التي ينبغي الجنوح لها دائمًا مع أيّ استعداد، ومع فرض عدم وجوده ينبغي خلقه وتهيئته، وإلى الحوار لتذليل كل المسائل العالقة بتحضّر واحترام، وإلى حصر الأمور في دائرتها الخاصَّة دون ضرر أو إضرار بالشعوب وبمستقبل المنطقة، وإلى عدم الخصومة أو الفجور فيها بإسقاط كل علائق الودّ وشريف القيَم كأن لم يكن بيننا مودّة، وإلى عدم اجترار الماضي الخاطئ وويلاته وإهالته، بل باستشراف المستقبل الزاهي الممكن للذهاب إليه، وإلى عدم توظيف الفكر والمفكّرين والإعلام إلا في التذكير بقيم الأخوة والعروبة والسلام بين الأشقاء واستحضار الماضي فقط الناصع الحفيّ بالتعاون والتجاوز وتذليل الصعاب.
كل هذا بغية الحفاظ على حرَم أوطاننا، ومنجزاتها، وأنظمتها، ورجالاتها، وعقولها، ودينها، وأخلاقها، وسلمها، وحسن جوارها، وطيب علاقاتها، واستجرارًا لتلاحمها وتعاونها وتكاملها، وسلامة مستقبلها ومستقبل أبنائها.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.