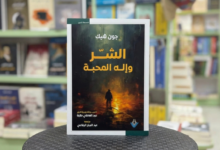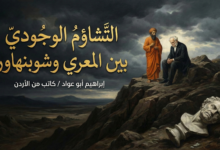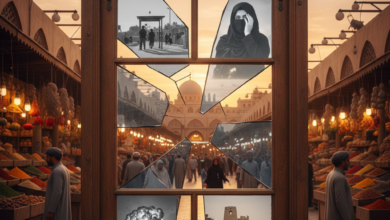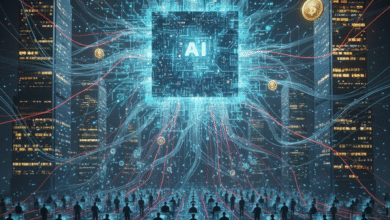ميتافيزيقا العلم الذكيّ
الفيزياء الكوانتية، الفلسفة، والعقل الفائق: هل يعود المطلق ليحكم العلم؟

عُدَّ التساؤلُ عن إمكان وجود صلة بين القوانين الحاكمة على الطبيعة وعوالم ما بعد الطبيعة، أحد أبرز العلامات الدالَّة على المعضلات التي سعى العقل الفلسفيُّ للوقوف عليها، واستخراج المبادئ المنطقيَّة المناسبة لها. وإذا كان هذا التساؤل لا يني يقضُّ سكينة المفاهيم منذ الحقبة الإغريقيَّة إلى أزمنة الحداثة، فقد جاء العلم الذكيُّ بحادثاته وانعطافاته الكبرى، ليقارب الإجابة من محلٍ غير معهود. فلقد بدا بما لا يقبل الرَّيب، كما لو أنَّ هذا العلم هو الذي سيفترض على الفلسفة القيام بمهمَّة الكشف عن تلك الصِّلة الغائمة بين الفيزياء والميتافيزياء. تلقاء هذا، نرانا بإزاء استفهام داهم عمَّا سيؤول إليه الحال، حين يسائلُ العلم الذكيُّ الفلسفةَ ماذا صنعت، فيما هو فخورٌ بما صار إليه اليوم من عظيم الذكاء وعلياء الفطنة؟
ربَّما تأَتَّى الجوابُ أدنى إلى خطبٍ جليلٍ لم يكن وقوعه محسوبًا في تفكيرنا المعاصر. منطقيٌّ أن تنشأ مساءلةٌ تبادليَّةٌ بين الفلسفة والعلم. لكن منسوب المساءلة قد يزيد متى عرفنا أنَّ للعلم حجَّةً على الفلسفة لكونه الواسطة البَدئيَّة في تأسيس معرفتها بالكون. لهذا المعتبر رأينا كيف قامت المقالة الفلسفيَّة الأولى على العناصر الأربعة (النار والماء والأرض والهواء)، ثم ليتشكَّل منها الجذرَ الكوزمولوجي لـ«ميتافيزيقا» الإغريق. نظير ذلك، سنلاحظ كيف احتجَّت الفلسفة على العلم ـ وإن على استحياء ـ من بعد أن تمكَّنت غزواته من إقصاء التأمُّل الميتافيزيقيِّ، واستنزال التفلسف من متعاليات التجريد إلى أرض الفينومينولوجيا الفسيحة؟
لكنَّ المسألة لا تتوقَّف لدى هذه الحدود. فسيظهر بصورة لا لَبس فيها، كيف انبرى منظِّرو الحداثة إلى الإمساك بناصية الفلسفة قصْدَ تطويعها، وتحويلها إلى علم كسائر العلوم الإنسانيَّة. فلمَّا أن أفلح هؤلاء بما انبروا إليه – وفي طليعتهم إيمانويل كانط – وجدنا كيف انحصرت مهمَّة الفلسفة الحديثة بمعاينة البنية الشكليَّة للعقل، والنظر- إلى هذه البنية – باعتبارها المرجع الوحيد الذي ينبغي الاستناد إليه لفهم الأساس الحقيقيِّ للمعرفة اليقينيَّة بالعالم.
العلم الذكيُّ وتحدّيِ «معرفة الشيء في ذاته»
بظهور العلم الفائق الذكاء، سيكشف الديالكتيك الداخليُّ لهذا العلم حقائق غابت عن العقل الفلسفيِّ من نسخته الإغريقيَّة إلى وقائعه المستحدثة. هذه الحقائق التي أطلقتها الفيزياء الكوانتية سوف تجعل الفلسفةَ أمام حرجٍ عظيم، قوامه الخشية من تقويض أحد أمتن أركانها الأنطولوجيَّة، وهواستحالة التعرُّف على «الشيء في ذاته».
هنا لست أخفي الذي استشعِرهُ بين حين وحين، أنَّ الفيزياء الحديثة ربَّما جاوزت نباهة التقليد الفلسفيِّ لمَّا أخرجت هذا البعض اليسير عن صلته الوثيقة بحقيقة ذلك المكنون الأصيل الذي يُسمَّى «الشيء في ذاته». ولكن حين أحكمت الفيزياء الحديثة دربتها، وفقًا لوحدة مكوِّنات الكون، راحت تتعامل مع تعدُّد مكوِّناته وتنوُّع أجناسها كنفسٍ واحدة. ثمَّ طفقت ترسم خطوط سيرها على واحديَّة لا انفصام لها بين الشيء المحتجب بذاته والأشياء البادية للعيان. ثمَّ لتقرِّر من بعد التجربة والملاحظة أنَّ كلَّ شيء من أشياء الكون يسري بلا انقطاع او انفصال، من نفسه الباطنة إلى نفسه الظاهرة وبالعكس. ثم ماذا كذلك؟..لو نظرنا من داخل حقول الفيزياء المستحدثة، سوف تطلُّ علينا فرضيات تقول بوجود قوانين غير مرئية للأذهان، بل هي ذات وجود مستقلٍّ بمعنى من المعاني. من الأسئلة التي سُئلت حيال تلك الفرضيات: ما شكل وطبيعة ذلك الوجود الذي يحملنا على أن ننسب إلى شيء مجرَّد جدًّا، وسديميٍّ جدًّا، بأنَّه من قوانين الطبيعة؟. بعض فيزيائيّي الكَمِّ المُحدَثين وجدوا أنَّ ثمَّة ما يفيد بأن ليس جميع الأشياء التي يُقال عنها إنَّها موجودة هي ملموسة مثل الإسمنت. الذرَّات مثلًا، صغيرة جدًّا، ولا يمكن رؤيتُها أو لَمْسُها، أو الإحساس بها مباشرة بأيِّ شكل من الأشكال. اما معرفتنا بها فتأتي بشكل غير مباشر، وعبر معدَّات وسيطة. كما أنَّ البيانات التي تأتي منها يجب أن تُعالج وتفسَّر. لدى ما تعدِ به ميكانيك الكوانتم ما يجعل الأمر أكثر سوءًا. إذ ليس ممكنًا – مثلًا – أن ننسب مكانًا محدَّدًا أو حركة محدَّدة إلى ذرَّةٍ ما في الوقت ذاته. فالذرَّات، والجزيئات ما دون الذرّيَّة تسكن عالمًا ظِلِّيًّا ذا نصف وجود. [بول ديفز ـ التدبير الإلهي ـ الأساس العلميّ لعالم منطقي ـ ترجمة: محمد الجورا ـ مراجعة: جهاد العلم ـ دار الحصاد، دمشق ـ ط1 2009 ـ ص90].
خلاصة ما يذهب إليه هؤلاء يتمثَّل في تساؤلهم الحائر عمَّا إذا كان لقوانين الفيزياء وجودٌ متعالٍ. فيزيائيّون كثيرون يعتقدون أنَّ الأمر هو كذلك. بل إنَّهم يتحدَّثون عن اكتشاف قوانين الفيزياء وكأنَّما هذه القوانين كانت موجودة هناك في مكان ما. في حين أنَّ ما نسمّيه اليوم قوانين الفيزياء، هي فقط مقاربة تجريبيَّة لمجموعة فريدة من قوانين حقيقيَّة.
بالطَّبع، قد لا يشعر أكثر الفيزيائيين – بل جلُّ فلاسفة العقل الأدنى – بالارتياح تجاه فكرة قوانين متعالية. وما ذاك إلَّا لارتيابهم من الإقرار بالجنبة الَّلاهوتيَّة لتلك القوانين. بعض هؤلاء يشيرون إلى أنَّ علماء، مثل علماء الرياضيَّات، ينطلقون من فرضيَّة تقول إنَّ لحقائق موضوعاتهم وجودًا مستقلًّا… أو كأنَّ ثمَّة مجموعة واحدة من القوانين يسير الكون وفقها بكلِّ واقعيَّة وبمعزل عن هذا العالم الذي تحكمه. ولو استقرأنا تاريخ العلم لألفيناه حافلًا بالشواهد عمَّا كان يُعدُّ ذات يوم حقائق أساسيَّة لا يمكن الاستغناء عنها، ثمَّ اتَّضح من بعد ذلك أنَّها كانت محدودة، ويمكن الاستغناء عنها. والمثل واضحٌ لنا لمَّا عُدَّت الأرض مركز الكون، وبقيت كذلك قرونًا حتى اكتشف العلماء عكس ذلك.
سوف يصل الجدل بين علماء الفيزياء الحديثة إلى درجة تستثير الدهشة. قد يكون الأبرز والأكثر إثارة فيه، الإقرار بوجود صِلاتٍ وثيقةٍ بين الفيزياء والميتافيزياء. اللاّفت في إقرار كهذا، هو أنَّ القوانين بذاتها لا تصف العالم تمامًا، فالهدف الكلّيُّ من صياغتهم للقوانين هو ربط أحداث فيزيائيَّة مختلفة في ما بينها. ولأجل أن تكتمل اجراءات الربط، لا مناص من التناغم بين القوانين الكلّيَّة والشروط البَدئيَّة المناسبة لوضعيَّة وخصوصيَّة كلِّ حالة. فالقوانين –كما يقررون- هي ضربٌ من أقوال حول نوع من الظواهر، والشروط البَدئيَّة ضربٌ من أقوال حول أنظمة محدَّدة لكلِّ ظاهرة. ولكي يقوم عالم الفيزياء بتجربةٍ ما، فإنَّه يختار – غالبًا – أو يفترض شروطًا بدئيَّة محدَّدة. على سبيل المثال، في تجربته الشهيرة على سقوط الأجسام، حرَّر غاليليو كتلتين غير متساويتين حجمًا في وقت واحد، لكي يبرهن على أنَّهما سوف تصدمان الأرض في الوقت ذاته. بالمقابل لا يستطيع العالم أن يختار القوانين (لأنَّها معطى إلهيّ)، وهذه الحقيقة تضع تلك القوانين في مكان أعلى بكثير من الشروط البدئيَّة التي تُعدُّ عرضيَّة، وقابلة للتعديل، بينما القوانين أساسيَّة وأبديَّة ومطلقة. وعليه، ينظر معظم الفيزيائيّين إلى الشروط الأوَّليَّة الكونيَّة على أنَّها واقعة خارج مدى العالم تمامًا، ويجب قبولها مثل القوانين كحقائق صرفة. بل حتى تلك التي لها إطار عقليٌّ دينيٌّ فإنَّها تتوجَّه إلى الله لتفسيرها.
من المغري – كما يعرب هؤلاء – أن نفترض أنَّ الشروط البدئيَّة لم تكن عشوائيَّة، بل إنَّها ملتزمة بمبدأ ما أساسيّ. في نهاية المطاف، يتمُّ قبول فكرة أنَّ قوانين الفيزياء ليست عشوائيَّة، بل بالإمكان توضيبها في علاقات رياضيَّة ذكيَّة. ومن الأهميَّة بمكان أن ندرك أنَّ قانون الشروط البدئيَّة لا يمكن البرهنة على صحَّته أو خطأه، أو أن نستمدَّه من قوانين فيزيائيَّة موجودة. ذلك أنَّ جدوى أيِّ قانون كهذا تكمن في قدرته على التنبُّوء بنتائج قابلة للملاحظة والاختبار، كما هو الحال مع جميع المقترحات العلميَّة. والاعتقاد الغالب هو أنَّ المقترحات حول قوانين الشروط البدئيَّة تدعم بقوَّة الفكرة الأفلاطونيَّة القائلة: إنَّ القوانين متعالية على الكون الفيزيائيّ، وإنَّ قوانين الفيزياء أتت إلى الوجود مع الكون، وأنَّها في الآن عينه لا تستطيع أن تفسِّر أصل الكون،لأنَّها لم تكن موجودة إلَّا حين وُجد الكون. وهذا واضحٌ جدًّا عندما يتعلَّق الأمر بقانون الشروط البدئيَّة، لأنَّ قانونًا كهذا يسعى ليفسِّر بكلِّ دقَّة كيف أتى الكون إلى الوجود، وبالشكل الذي أتى به. من أجل ذلك، يقرِّر الفيزيائيّون أنَّ احتمال التشكُّل العشوائيِّ لمادَّة الكون ضعيفٌ جدًّا. ولقد توصَّلوا بنتيجة بحوث كثيرة إلى استنتاج أنَّ: الكون الماديَّ، والفراغ، والزمن، والحياة، والكائنات العاقلة على الأرض، والكواكب الأخرى.. كلَّها من صنع عقلٍ فائقٍ التدبير. ما يعني ـ بحسب توصُّلات الفيزياء الحديثة ـ أنَّها مجتمعة على نظام حركة وحياة واحدة، وأنَّ الكون مبرمجٌ قبل نشوئه لكي تظهر فيه موادُّ حيَّة، وكائناتٌ عاقلة. فالتقصّيات العمليَّة والنظريَّة الجديدة للعلماء توفِّر الأسس التي ستقوم عليها الرواية العلميَّة التالية لخلق العالم. يؤكِّد العلماء أيضًا وجود نظريَّة فيزيائيَّة جديدة، وضعت نتيجة لتطوُّر تصوُّرات أ. آينشتاين، وقد ظهر فيها مستوى معيَّن من الحقيقة وتمتلك كلَّ علامات الألوهيَّة، وهي النظريَّة التي يُطلق عليها عبارة «العدم المطلق». والعدم المطلق الذي يرومونه قد يكون هو نفسه «الشيء في ذاته»، والذي منه يبدأ كلُّ شيء… هذا «العدم» لا يكتفي بخلق المادَّة –كما يقرر العلماء- وإنَّما يضع لها مخطَّطات ومقاصد وغايات». ولقد ألمح آينشتاين – ذات يوم – إلى فكرة أكثر أهميَّة، لخَّصها في التساؤل عمَّا إذا كان لدى الله أيُّ خيار في خلق العالم على غير ما هو عليه. قد لا يكون صاحب نظريَّة النسبيَّة متديِّنًا بالمعنى التقليديِّ للكلمة، إلَّا أنَّه غالبًا ما استطاب استخدام كلمة الله للتعبير عن أسئلة وجوديَّة عميقة. ومع أنَّ هذا التساؤل أغضب في حينه أجيالًا من العلماء والفلاسفة والَّلاهوتيّين، إلَّا أنَّه استولد أسئلة مستأنَفة ليس بمقدور أحد من هؤلاء الإعراض عنها أو تجاهل الإجابة عليها. أبرز هذه الأسئلة وأكثرها تحدّيًا للفلسفة والفيزياء معًا، تلك المتعلِّقة بالعقل الفائق ومكانته التدبيريَّة في إرجاع مظاهر الأشياء إلى اصول ذواتها الخفيَّة. لم يكن التفكير بحاضريَّة العقل الفائق التدبير مجرَّد مقترح لاهوتيٍّ شاع أمرُه في مجادلات القرون الوسطى، بل هو حصيلة اختبارات شاقَّة ومديدة في محراب الفيزياء الدقيقة. مع الأسئلة التي خرجت بها الفيزياء الحديثة، سوف يتضاعف منسوب التحدّي في أوساط العلماء والفلاسفة سواءً بسواء. لم يعد التفكير على سيرته الأولى حيال الفرضيَّة التقليديَّة التي ترى أنَّ الأشياء، كما هي عليه، هي نتيجة لضرورة منطقيَّة أو حتميَّة. كذلك ما عاد أمرًا هيِّناً -بالنسبة إلى هؤلاء- إقصاء المشيئة والإرادة الإلهيَّتين من أصل القضيَّة، كما فعلت ميتافيزيقا الإغريق ورهطٌ وازنٌ من فلاسفة الحداثة. لكن لو افترضنا أنَّ هؤلاء كانوا على صواب في ما زعموا، فذاك يعني أنَّ العالم بات نظامًا مغلقًا، وكلُّ شيء فيه جرى تفسيره ولا بقي منه سرٌّ مستتر. يعني ذلك أيضًا، أن لاحاجة بنا – فعليًّا- لأن نراقب العالم كي نكون قادرين على فهم شكله ومحتواه. ذلك لأنَّ كلَّ شيء يُستتبعُ من ضرورة منطقيَّة، هو من منتوج العقل وحده ولا شيء سواه.
غير أنَّ الفلسفة الإقصائيَّة للألوهيَّة، التي ميَّزت عصور الحداثة في الغرب، ستجد نفسها أمام تحدّيات حاسمة أطلقها العلم الذكيُّ والتحوُّلات الكبرى في الفيزياء الحديثة. فعندما تحدَّثوا عن مطلق يُعدُّ مصدرًا لكلِّ شيء موجود، فقد رموا بذلك إلى أنَّه في قلب أيِّ جسيمة من المادَّة وُضِعَ الأساس الحيُّ لـ «قطعة» خاصَّة من المطلق، تُعدُّ رفيعة التطوُّر، وواعية، ومصدرًا للمعلومات، وقادرة على إدراك ذاتها بذاتها. ويُطلق على هذه «القطعة» أحيانًا شرارة الإله. فالوعي موجود في كلِّ جسيمة أوليَّة، وفي كلِّ كمٍّ (كوانتي)، وفي كلِّ ذرَّة. زيادة على ذلك، كل ما يمكن أن يكون ـ وأيًّا تكُن صفته – يصبح متميّزًا وله وعيُه الخاصّ. ثمَّ إنَّ وجود مثل هذه المواضيع، كالفكرة، وشكل الفكرة، والخطَّة التي تنطوي عليها، فضلًا عن الانفعالات التي تصاحبها، هي أيضًا لها وعيُها الخاصّ، بل إنَّها غير ممكنة من دون مصادقة المطلق، الذي يعطي الحياة لهذه الوقائع على شكل وعي. تأسيسًا على هذه الفرضيَّة، تصير الفكرة المترافقة بالوعي، هي الروح. والروح هي روح صرفة، غير مرتبطة بأيِّ كائن حيّ. ولا تقوم بشيء ولا تسعى إلى شيء. إنَّها بكلمة: موجودة ببساطة. وإذا كان الكثير من الفلاسفة القدماء يقولون إنَّ عالم الأفكار موجود، فإنَّ علماء الفيزياء النظريَّة والتطبيقيَّة يعتقدون أنَّ: «عالم الأفكار – هو حقيقةٌ ما، وهذه الحقيقة بالنسبة إلى المادَّة، هي الأكثر استقرارًا، وتشكِّل عالم الحقيقة الأعلى، وأساس كلِّ شيء. وقد أثبتوا أنَّ طبيعة هذه الحقيقة المفارقة (مادّيَّة ولا مادّيَّة) في الآن نفسه. لقد نشأت من فعل فاعلٍ شاءها بعقلٍ مدبِّر، ثمَّ من بعد ذلك أخذت المادَّة الفظة المألوفة لدينا بالظهور والتحيُّز في الزمان والمكان. فعلى سبيل المثال، يقرِّر القائلون بواقعيَّة عالم الأفكار، أنَّ الَّلفظ والتدوين وفاعليَّة الفكرة في حقل التأثير، هي العناصر إياها التي تمنح هذه الحقيقة المفارقة صورتها المادّيَّة.
II
الأساس الكوزمولوجيّ للميتافيزيقا الأولى
وصلاً بما ذكرناه، بسبب من مساواته بين الذكاء والروح من جهة، والانتظام الرياضيِّ للكون من الجهة المقابلة، كان أفلاطون يسبق سواه من فلاسفة العلم إلى طرح المشكلة، وكان الأحدَّ إحساسًا بمفارقة الحركات الكوكبيَّة. لهذا سيمضي بثقة لافتة، إلى إبداء فرضيَّة تفيد بأنَّ الكواكب تتحرَّك وهي على تناقض بيِّن مع الأدلَّة التجريبيَّة. إنَّها تسلك بالفعل في مدارات منفردة متَّسقة ولكنّها ذات انتظام كامل. ورغم عدم وجود شيء ذي شأن يدلُّ على صواب هذه العقيدة في زمانه سوى إيمانه بالرياضيَّات وألوهيَّة السماوات، فقد نجح في إلزام فلاسفة المستقبل بالاشتباك مع البيانات الكوكبيَّة والاهتداء إلى ماهيَّة الحركات المتَّسقة والمنظَّمة التي يمكن تفسير الحركات الظاهرة بالاستناد الى افتراضاتها. [ريتشارد تارناس – آلام العقل الغربي – ترجمة: فاضل جتكر- مكتبة العبيكان – الرياض – السعوديَّة – 2001- ص 82].
ربطًا بما توصَّل إليه أفلاطون لجهة الوصل بين الروح والذكاء البشريِّ والانتظام الرياضيِّ للكون، تتبدَّى لنا سلسلة متَّسقة تستظهر أكثر عناصر الفلسفة الأفلاطونيَّة تميُّزًا: الإيمان بالمطلق والأحاديِّ بدلًا من النسبيِّ والمتعدِّد ـ تقديس النظام ونبذ الفوضى ـ صلات الوصل بين الملاحظة التجريبيَّة والأشكال المثاليَّة ـ الجمع بين الآلهة البدائيَّة الأسطوريَّة والأشكال أو الصِّيغ الرياضيَّة والعقليَّة ـ الجمع بين الآلهة المتعدِّدة (آلهة السماء) والإله الواحد الأحد (خالق الذكاء الأعلى). وأخيرًا، جملة العواقب المعقَّدة، بل وحتى المتناقضة التي كان من شأن فكر أفلاطون أن ينطوي عليها ويكون لها أثرها الوازن على التطوُّرات العلميَّة والفلسفيَّة الَّلاحقة في الثقافة الغربيَّة.
لقد شكَّلت الأفكار المتعالية – بما هي المبادئ المسيّرة لعقل السماء – أساس الفلسفة الأفلاطونيَّة. غير أنَّ المقالة الأرسطيَّة ما لبثت أن انقلبت عليها، حتى بدت الصورة وكأنَّ أفلاطون نُزِّل إلى أدنى الأرض. جرَّاء ذلك، سيظهر على نحو صريح، أنَّ فهم الإيقاع الأساسيِّ لفلسفة أرسطو وكوزمولوجيَّته، هو الشرط المسبق لاستيعاب التطوُّر الَّلاحق للفكر الغربيّ.
في تأسيساته للعقل العلميِّ، دَرَجَ أرسطو على رؤية العالم التجريبيِّ بوصفه واقعًا، وأنَّ الواقع الحقيقيَّ هو عالم الأشياء الملموسة القابلة للإدراك بالحواسّ، لا عالم أفكار سرمديَّة استعصى أمرها على الإدراك. ولأنَّ نظريَّة الأفكار والمُثُل الأفلاطونيَّة بدت في نظره غير قابلة للإثبات من ناحية، ومثقلة بحشد من الصعوبات المنطقيَّة من ناحية ثانية، طفق يبادر إلى نحت المقولات العشر، ليبيّن أنَّ أشياء الكون واقعيَّة، وأنَّها موجودة على نحو التعدُّد الَّلامتناهي من الأشكال والأنواع. لقد رأى أنَّ هذه الأنماط المختلفة من الوجود ليست متكافئة من حيث المكانة الوجوديَّة. فالجواهر هي أسس وفواعل كلِّ الأشياء الأخرى. ولولا وجود هذه الجواهر لم يكن لشيء أن يكون موجودًا. لذا لم يكن عالم الواقع، في نظر أرسطو إلَّا عالم جواهر منفردة متمايزة ومنفصلة بعضها عن البعض الآخر.
لم يكتفِ أرسطو بما أسَّس له من فهمٍ لهندسة العالم المرئيِّ عن طريق المقولات العشر، بل هو سيمضي في رحلته التحليليَّة العقليَّة للعالم، إلى استحداث حكاية أكثر تعقيدًا، وأغنى تركيبًا حيال حركة الأشياء وصيرورتها. هذه الحكاية هي التي ستجعل فلسفته أقرب روحيًّا إلى فلسفة أفلاطون مع احتفاظها بخصائصها في الوقت نفسه. لقد استنتج أنَّ الجوهر ليس وحدة من وحدات المادَّة، بل هو بنيانٌ أو شكلٌ قابل للإدراك ومتجسِّد في المادَّة. ورغم أنَّ الشكل حلوليٌّ متأصِّل كليًّا، ولا وجود له على نحو مستقلٍّ عن تجسُّده الماديِّ، فإنَّ هذا الشكل هو الذي يضفي على الجوهر جوهريَّته المميَّزة. ولأنَّ الشكل، في رأي أرسطو يضفي على أيِّ جوهر، لا فقط بنيته الأساسيَّة، بل آليَّته التطوُّرية أيضًا، لذلك كانت علوم الحياة (البيولوجيا) العضويَّة، لا الرياضيَّات المجرَّدة، هي علومه المميَّزة. وعِوضاً من واقع أفلاطون السكونيِّ المثاليِّ، عَمَدَ أرسطو إلى استحداث اعترافٍ أكثر وضوحًا بعمليَّات الطبيعة القائمة على النموِّ والتطوُّر، مع سعي كلِّ عضويَّة للانتقال من النقصان إلى الكمال، ومن حالة الاحتمال إلى حالة الفعل. وفيما شدَّد أفلاطون على «لا كماليَّة» جميع الأشياء الطبيعيَّة، مقارنة بالأشكال التي تقلّدها، دأب أرسطو على التصريح بأنَّ أيَّ عضويَّة تنتقل من حالة غير كاملة باتِّجاه بلوغ نضج كامل، فمنتهاها أن يتحقَّق شكلها المتأصِّل تحقُّقًا فعليًّا: البذرة تتحوَّل إلى نبتة، والجنين إلى طفل، والطفل إلى راشد، وهكذا. أمَّا الشكل فيبقى مبدأ فعل متأصِّل كامن في العضويَّة منذ نشوئها. من ذلك، يتَّضح المقصد الأرسطيُّ القائل بأنَّ جوهرَ شيءٍ ما، ليس إلَّا الشكل الذي آل إليه. وما طبيعة أيِّ شيء إلَّا لتحقيق شكله المتجذِّر وترجمته إلى لغة الواقع. ومع ذلك، فإنَّ عبارتي «الشكل» و«المادَّة» هما عبارتان نسبيَّتان: لأنَّ من شأن تحقُّق أيِّ شكل، أن يقود بدوره، إلى أن يكون المادَّة التي يمكن لشكل أرقى أن يخرج من رحمها. فالمادَّة هي القوام غير الموصوف للوجود. وإمكانيَّة الشكل هي التي يقولبها الشكل، ثم يفرضها وينقلها من الاحتمال إلى الواقع الفعليّ. وعليه، لا تتحقَّق المادَّة إلَّا بفعل تزاوجها مع الشكل، ذلك بأنَّ الشكل هو واقع المادَّة الفعليِّ، الذي يشكِّله الهدف المكتمل. ومع أنَّ أيَّ شكل ليس هو نفسه جوهرًا، كما في نظرة أفلاطون، فإنَّ لكلِّ جوهر شكلًا، وبنيانًا قابلًا للإدراك، أي بنيانًا يُلبس الجوهر ثوبه. يضاف إلى ذلك أنَّ كلَّ جوهر لا يكتفي بامتلاك شكلٍ ما، ويمكن للمرء أن يقول: إنَّ الشكل يملك الجوهر أيضًا، لأن الجوهر يسعى طبيعيًّا لتحقيق شكله الأصليِّ المتجذِّر. كما يسعى ليصبح صنفًا كاملًا من نوعه، وما من جوهر إلَّا ويتطلَّع إلى تحقيق ما هو بالقوَّة أساسًا.[ر. تارناس – المصدر نفسه – ص 89].
III
فيزيائيَّة الفلسفة الحديثة
ليس من باب «حكم القيمة» أن يُقال، إنَّ الفلسفة الحديثة استلهمت جلّ عناصر حداثتها العلميَّة من كونيَّات الإغريق ومبانيهم الفلسفيَّة. ربَّما لهذا الداعي وجدنا كيف أنَّ الغرب الحديث لم يُدَع لحظة تمرُّ إلَّا وأعرب فيها عن إعجابه بالحيويَّة الاستثنائيَّة للعقل اليونانيِّ. ومن المؤكَّد أنَّ الغرب اليوم يواصل العودة بشغفٍ محمومٍ إلى أجداده القدماء، وعلى نحوٍ يشبه عودة المرء إلى منابع البصيرة الخالدة. من أجل ذلك رأينا كيف شقَّ العقل الإغريقيُّ سبيله ببساطة شديدة إلى فكر الحداثة لتتخذ من مفاهيمه دربةً لها. ومع أفول القرون الوسطى سوف يبتدئ عهدٌ آخر، يوجِّه خلاله العلمُ الغربيُّ جلَّ قوَّته وطاقته نحو دراسة العالم الفيزيائيِّ.
وهكذا راحت العقيدة العلميَّة لحضارة الغرب الحديث تأتلف على تصورات رباعيَّة الأبعاد: اشتقاق الوعي من المادَّة- استقلال المادَّة عن الوعي- الإمكانيَّة الاستثنائيَّة للإدراك العقليِّ للكون. ومقدرة العقل الذكيِّ على حلِّ معضلات الوجود أنَّى بلغت تعقيداتها. والّلافت ان هذه التصوُّرات اتخذت صيرورتها نحو التحول إلى يقين معرفيٍّ، وستمهِّد إلى ظهور الشكل التقانيِّ للحضارة الحديثة، حيث كلُّ شيء حالئذٍ سيفقد قيمته ما لم يكن مُدرجاً في قائمة المقتضيات المادّيَّة.
بسبب من الثورة العلميَّة تعرَّضت مهمَّة الفيلسوف لمحنة معرفيَّة؛ لم يعد قادرًا معها على تحديد تصوُّر ميتافيزيقيٍّ للعالم بالمعنى التقليديّ. بات ملزمًا بالمبادرة بدلًا من ذلك، إلى تحليل طبيعة عقل الإنسان وحدوده. فالعقل، رغم عجزه عن الحسم في قضايا متعالية على التجربة، ظلَّ قادرًا على تحديد جملة العوامل المعرفيَّة الجوهريَّة بالنسبة إلى التجربة البشريَّة، وعلى إغناء التجربة كلِّها بنظامه. وبسببٍ من ذلك، باتت مهمَّة الفلسفة الحقيقيَّة متمثِّلة، إذًا بمعاينة البنية الشكليَّة للعقل، ذلك إلى الحدِّ الذي صار فيه العقل الأدنى حاكمًا مطلقًا على فهم حقيقة الكون.
تخلص ميتافيزيقا الحداثة إلى الاعتقاد بأنَّ العلم يُنجز وفق الشروط الخاصَّة به، ولا يعتمدُ على أيِّ شيءٍ خارج ذاته. هذا المعتقد هو في الواقع تظهيرٌ شديد الكثافة لميراث عصر التنوير الذي نظر إلى العالَم كآليّةٍ ماديّةٍ مستقلَّة. تبعًا لهذه النظرة عُدَّت كلّ إشارةٍ إلى الدين والأمر الغيبي شأناً فائضًا عن الحاجة، أو نزوعًا إلى الَّلاعقلانيَّة. مردُّ ذلك كلّه إلى تسليم الحركة التنويريَّة، المطلق بقوَّة العقل البشريِّ وقدرته على تذليل الاستعصاءات التي تعترض اكتشاف الكون وفهم أسراره. لذا، غالبًا ما جرى التعامل مع العقلانيَّة كحقيقةٍ قُصوى. حتى لقد أوشك كبار فلاسفة الحداثة وعلمائها على «تأليهها» لمَّا رأوا كيف حُوِّلت الكنائس بعد الثورة الفرنسيَّة إلى «معابد للعقل». يومذاك بدت العقلانيَّة – وهي في غلواء توتُّرها – أدنى إلى عقيدةٍ مرادفةٍ للإلحاد ومنتجةٍ له في الآن عينه. لهذا يميل المفكِّر العقلانيُّ إلى الاعتقاد الصَّارم بأنَّ المعقول هو الطبيعيُّ، ولا وجود لشيءٍ خارقٍ للطبيعة، وأقصى ما يُعرف به هو المجهول الذي قد يصبح يومًا ما معلومًا ولا مكان في مخطَّطه الفكريِّ لقوى خارقة. وتبعًا لهذه الميول تنزع العقلانيَّة إلى عدم الإقرار بكلِّ ما هو غيبيّ، ثمَّ لتكتفي بالطبيعيِّ، الذي يؤمن المفكِّر العقلانيُّ بأنَّه قابلٌ للفهم، وأنَّ السبيل إلى فهمه في الغالب الأعمِّ يتمُّ عبر ما سُمِّي بـ «مناهج ووسائل البحث العلميّ»…
بسبب من غلواء الاندهاش بثورة العلم، دأبت العقلانيَّة الجائرة على الاكتفاء بخطابها الأحاديِّ، وأعرضت في الغالب الأعمِّ عن الإصغاء لنداء الإيمان. وما كان هذا المسلك ليكون إلَّا لداعي الاختلال المنهجي بين منطق عمل العلم ومنطق عمل العقلانيَّة معًا. وللنُّظَّار في هذا المضمار حجَّةٌ مؤدّاها التالي: بينما تدخل أسئلة الوجود الكبرى في اهتمامات العقلانيِّ، تتوارى هذه الأسئلة، أو قد تصل حدَّ التبدُّد لدى علماء الرياضيَّات وفيزياء الطبيعة. هذا هو الفارق الجوهريُّ بين كلٍّ من هذين الحقلين. فإذا أخذنا العلم بمعنى نسق المعارف العلميَّة المتراكمة (أي المنهج العلميّ)، فلن نجد له رابطة اعتناءٍ بالميتافيزيقا أو بـعلم «ما بعد الطبيعة». وما ذاك إلَّا لأنَّ العلم من حيث هو علم، لا يقدِّم لنا مذهبًا في الكونيَّات (كوزمولوجيا)، أو في الوجود في ذاته (الأنطولوجيا)، فضلًا عن معرفة الغاية من وجود الموجودات. وعليه، فإنَّ العلم بما هو علم لا يسعى إلى الإجابة، ولا حتى التساؤل، عن القضايا الكبرى المتعلِّقة بمصير الإنسان في الحياة والموت، أو الخير والشرّ. حتى أنَّ كثرةً من العلماء لا تجد عندهم أيَّ فضولٍ ميتافيزيقيّ. شأنُهم في هذا شأن كثيرين من البشر، ولكن ما إن يُسأل أحدٌ منهم أيًّا من الأسئلة الكبرى ويحاول الإجابة عنها، حتَّى يكفَّ بهذا السلوك عن أن يكون عالمًا، بل إنَّه بذلك يفعل شيئًا آخر مغايرًا لطبيعة عمله كعالِم. أمَّا المفكِّر العقلانيُّ فلديه مجموعةٌ كاملةٌ من الإجابات عن القضايا الكبرى، زاعمًا أنَّ الزمن والدأب كفيلان، إذا ما لازم الإنسان صواب التفكير، بتقديم الإجابات الصحيحة. وعليه، عُدَّت النزعة العقلانيَّة بالصورة التي ظهرت فيها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في الغرب نسقًا ميتافيزيقيًّا كاملًا. بل وأكثر من هذا، عوملت في كثير من الأحيان كدينٍ أو كبديل من الدين.
IV
العِلموية بوصفها مذهباً ميتافيزيقياً بلا روح
تبيَّن في ما مرَّ معنا كيف استولت الحركة العقلانيَّة على حضارة الغرب الحديث، ووضعت كلَّ منجزاته في الفكر والمعرفة والتقانة تحت سطوة أحكامها الأرضانية الصارمة. ولقد كان من الطبيعيِّ والحالة هذه، أن تسفر هذه الديناميَّة الاستيلائيَّة عن فرضيّتين أطلقهما التقدُّم الاستثنائيُّ للعلوم، ثمَّ لتشكِّلا معًا أساسًا لـ«نظريَّة معرفة» لعِلمويةٍ تامَّة القوام:
الفرضيَّة الأولى: مبنيَّة على الاعتقاد بأنَّ العلم والتفكير العلميَّ قادران لوحدهما على أن يحدِّدا ما علينا أن نتقبَّله على أنَّه حقيقيٌّ، وأنَّ كلَّ شيءٍ يجب أن يخضع لقوانين الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا أو أيِّ فرعٍ آخر من فروع العلم، أمَّا أمورٌ مثل النزعة الروحيَّة، بل وحتى الشعور بالجمال والحدس والعاطفة والأخلاقيَّات، فقد اختزلتها النظرة العقلانيَّة إلى مجرَّد متغيّراتٍ في كيمياء الدماغ الذي يتفاعل مع مجموعةٍ من القوانين الميكرو ـ بيولوجيَّة المرتبطة بتطوُّر الإنسان.
الفرضيَّة الثانية: تجد أنَّ الهدف من تحصيل المعارف هو التحكُّم بالعالم الخارجيِّ، والهيمنة على الطبيعة.
بحلول القرن السابع عشر، سنلاحظ السيرورة التي سيتولّد منها نسقاً معرفياً جديداً في أوروبا متمثلاً بسيادة العلم وكشوفاته. سيظهر ذلك بقوَّةٍ مع كتاب «تقدُّم التعلم» (1605) لفرانسيس بيكون (1561 – 1626) الذي سيؤكِّد أنَّ كلَّ حقيقةٍ يجب إخضاعها للنَّقد الصارم عبر العلم التجريبيِّ حتى تلك المتعلِّقة بأكثر الاعتقادات الدينيَّة قداسة. وتلك كانت لحظةً مفصليَّةً في التنظير الغربيِّ للعِلمويَّة سوف تؤسِّس لما يمكن اعتباره فصلًا وظيفيًّا بين الله والعالم. وكان ذلك في الحقيقة ضربًا من علمنةٍ تعترف بالخالق من جهة، وتعطِّل في الوقت نفسه تدبيراته للتاريخ البشريّ. وعلى هذه الدربة من الاعتقاد بدت العِلمويَّة كنزعة مسيطرة على الحضارة الحديثة أدنى إلى مذهب ميتافيزيقيٍّ، إلَّا أنَّه منزوع من أيَّة نزعةٍ روحانيَّة.
أمَّا الخلاصة التي انتهت إليها العِلمويَّة الكلاسيكيَّة الحديثة، فتقوم على استحالة بلوغ المعرفة الإنسانيَّة الحقيقيَّة إلَّا عبر الاستخدام الفاعل لعقل الإنسان والملاحظة التجريبيَّة. كما تقوم على الاعتقاد بأنَّ أسباب الظواهر الطبيعيَّة لا هي شخصيَّة ولا مادّيَّة ولا متعالية، بل يجب التماسها داخل ملكوت الطبيعة القابلة للرَّصد والملاحظة. أمَّا سائر العناصر الأسطوريَّة والمنتمية إلى ما وراء الطبيعة فيبغي استبعادها من التفسيرات السببيَّة، بوصفها إسقاطات شبه إنسانيَّة. وشيئًا فشيئًا أصبحت أيُّ إشارةٍ إلى الله في التفسير العلميِّ للعالم بعيدةً وعرَضيَّةً بشكلٍ متزايد. ومع الوقت، أصبح الإله خارجًا عن الموضوع حتى حين يجري الحديث عن مصدر النظام الشمسيِّ وصيانته.
في الأحقاب المتأخِّرة للحداثة (القرنان التاسع عشر والعشرين) سيأخذ الانفصال القطعيُّ بين العلم والدين مداه الفعليّ. ومع هذا الانفصال توسَّعت البيئات المتأثِّرة بالنظرة الكونيَّة العلميَّة الجديدة على نحوٍ لم تعد تقبل فيه الإيمان الدينيّ. ذلك بأنَّ المنهجيَّة الإلحاديَّة للنظرة العلميَّة المعاصرة قامت ببساطةٍ على إقصاء السؤال عن وجود الله. تلقاء ذلك، ولَّدت إطارًا ذهنيًّا يميل نحو تعميم لامبالاتها المنهجيَّة تجاه ما هو إلهيٌّ وتحويله إلى نزعةٍ إنسانيَّةٍ علميَّةٍ مُطلقة.
لم تستمد «العِلمويَّة» شرعيَّتها فقط من العقلانيَّة التي أخرجها عصر التنوير العلمانيُّ، بل هي وجدت الحاضنة الدينيَّة لنموِّها، حيث استغلَّت الندوب العميقة التي تركها الأثر العميق للحداثة على بنية الكنيسة. وتدلُّ اختبارات الإصلاح البروتستانتيِّ في القرن الخامس عشر على رسوخ قاعدةٍ لاهوتيَّةٍ قوامُها الجمع بين الإيمان بالله والإيمان بالعلم مع إسقاط العصمة عن سلطة الكنيسة. تبلورت هذه النظريَّة مع مارتن لوثر (1483 – 1546)، وجون كالفن (1509-1564)، وهولدريش زفينغلي (1484 – 1531م)، الذين عادوا إلى منابع التراث المسيحيِّ لتدعيم محاجَّاتهم الَّلاهوتيّة في وجه الكنيسة الكاثوليكيَّة. شدَّد لوثر على أهميَّة الإيمان، لكنَّه رفض العقل بشدَّةٍ لأنَّه يؤدّي إلى الإلحاد. حسب تأويليَّته أنَّ معرفة الله عن طريق التفكير في نظام الكون العجيب – كما فعل الَّلاهوتيّون المدرسيّون ـ لم يكن أمرًا مسموحًا. وفي مؤلَّفاته كان الإيمان بالله قد بدأ ينسحب من العالم الماديِّ الذي لم يعد له أهميَّة إطلاقًا. وهذا ما دفعه إلى علمنة السياسة. أمّا كالفن وزفينغلي فذهبا أبعد ممَّا ذهب إليه «المعلِّم» في التأسيس الَّلاهوتيِّ للدنيويَّة العلميَّة. حيث آمنا بضرورة الجمع بين وحيانيَّة الكتاب المقدَّس وواقعيَّة الحياة البشريَّة. لقد وجدا أنَّ على المسيحيين أن يعبِّروا عن إيمانهم بالمشاركة في الحياة الاجتماعيَّة والسياسيَّة بدلًا من الانسحاب إلى داخل الدير. وأنَّ عليهم أن يقدِّسوا العمل من خلال تعميد أخلاق رأس المال الصاعد. ذلك بأنَّ العمل هو سعيٌ مقدَّسٌ نحو الألوهة وليس عقابًا إلهيًّا على الخطيئة الآدميَّة الأولى. لقد اعتقد كالفن أنَّ رؤية الله في خلقه أمرٌ ممكن، فلم يرَ تعارضًا بين العلم والكتاب المقدَّس. فالإنجيل لم يقدِّم معلومات حرفيَّة حول الجغرافيا ونشأة الكون، بل إنَّه عبَّر عن حقيقةٍ عصِيّةٍ على الوصف من خلال كلمات ليس في وسع البشر المحدودين فهمها وإدراك أسرارها الخفيَّة.
تضيء لنا هذه المقدِّمات على حقيقة أنَّ النزعة العلميَّة، كانت تنمو بقوَّةٍ في أوروبا ولم يكن نموُّها خارج المسيحيَّة. في مثل هذه الحال، بدت الصورة وكأنَّ البروتستانتيَّة المحتجَّة لاهوتيًّا على إكراهات الكنيسة الكاثوليكيَّة الرومانيَّة، هي التي شرَّعت الباب لنظريَّة العلمنة ولثورتها العلميَّة الشاملة فيما بعد. وسيأتي من روّاد حركة الحداثة -ممن تأثروا بالتأويل البروتستانتي- ليُضفي على هذه الصورة مشروعيّتها العلميّة:
عند مستهلِّ الحداثة سيشارك العالم الفلكيُّ الهولنديُّ كوبر نيكوس (1473 – 1543م) كالفن رؤيته الَّلاهوتيَّة المعلمَنة، لمَّا قال إنَّ ما أنجزتُه حول مركزيَّة الشمس، هو أكثر إلهيَّةً ممَّا هو بشريّ. أمَّا غاليلي الذي اختبر فرضيَّة كوبرنيكوس عمليًّا فقد كان مقتنعًا بأنَّ ما أنجزه كان نعمةً إلهيَّة. كذلك سيحذو إسحاق نيوتن (1642 – 1727) حذو نظيريه حين تحدَّث عن فكرة الجاذبيَّة كقوَّةٍ كونيَّةٍ تجعل الكون كلَّه متماسكًا وتمنع الأجرام السماويَّة من الاصطدام بعضها ببعض. فقد أعرب يومها عن اعتقاده بأنَّ ما توصَّل إليه يثبت وجود الله العظيم ميكانيكيًّا. على النحو إيَّاه سنستمع إلى آينشتاين (1879-1955) وهو يعلن في خريف عمره أنَّ الله لم يكن يمارس لعبة الحظّ وهو يهندس الكون الأعظم.
V
من الفيزياء إلى الميتافيزياء
لم يكن الفيلسوف والفيزيائيُّ الألمانيُّ فيلهلم ليبنتز (1646-1716) يجادل الديكارتيين في موقفهم الميتافيزيقيِّ من مسألة الخلق فحسب، بل مضى إلى التبصُّر في مصدر الاعتبارات التي أسَّست تلك المواقف الميتافيزيقيَّة، المعبَّر عنها بفلسفة الطبيعة، أو بالتصوُّر الفيزيائيِّ للطبيعة. ولتقرير حجَّته، سينبري إلى مجاوزة التقليد «العقلانوي» الذي رسخ في أرض الحداثة مع منظِّرها الأول رينيه ديكارت. ربما لهذا سيرفض ليبنتز الموقف الديكارتيَّ العامَّ القائل بالفصل بين حقائق الميتافيزيقا التي ينتجها العقل، وحقائق الَّلاهوت التي تصدر عن الإيمان الديني. فالفصل بين حقائق تعتبر «فوق العقل» وأخرى في متناوله، لا يمكن أن يؤدّي إلا الى شيوع الآراء الاعتباطيَّة. كما أنَّ القول بوجود حقائق دينيَّة «تعارض» العقل يمكن أن يفضي إلى شتَّى أشكال الَّلاأدرية والإلحاد.
كان من أبرز أهداف لايبتتز في «المقالة في الميتافيزيقا» بيان الترابط العضويِّ بين القضايا الفيزيائيَّة والمسائل الميتافيزيقيَّة الدينيَّة. مؤدى رؤيته في هذا المنفسح التنظيري، استحالة فصل تصوُّراتنا عن الله عن تلك التي نطوِّرها عن العلم الفيزيائيِّ والرياضيِّ، كما لا يمكن معارضة العقل للعقيدة. لذلك يندرج النقد العميق للفكر الديكارتيِّ وخصوصًا لأطروحته القائلة بوجود جوهرين مختلفين، جوهرٍ مادّيٍّ وجوهرٍ روحيٍّ، ضمن التوجُّه نفسه الذي دعا الفيلسوف الألمانيُّ إلى التوفيق بين العلل الفاعلة والعلل الغائيَّة. ولكي نفهم موقف كلا الفيلسوفين [ديكارت وليبنتز] من علاقة الفيزياء بالميتافيزيقا، لا بدَّ من أن نُذكِّر بأنَّ تفسير الطبيعة بات منذ قيام الثورة الكوبرنيكيَّة منوطًا بالفيزياء الرياضيَّة التي تضفي على العالَم المادّيَّ وصفًا يقوم على التجريد الرياضيّ. وذلك هو على التعيين، المعنى الذي ميَّز عصر الحداثة من جهة اعتباره الطبيعة عالمًا لا متناهيًا وليس كونًا مغلقًا.
وما من ريب في أنَّ مثل هذا التحوُّل الانعطافيِّ ما كان ليكون لولا الدور الذي أدَّاه غاليله واعرب عنه بقوله: «إن كتاب الفلسفة هو ذاك الكتاب المفتوح أمام أعيننا باستمرار، إلَّا أنَّه لمَّا كان مكتوبًا بحروف مختلفة عن حروفنا الهجائيَّة، فإنَّ قراءته ليست في متناول الجميع. ثم سيؤكِّد أنَّ حروف هذا الكتاب هي المثلَّثات والمربَّعات والدوائر والكرات والمخروطات وأشكال رياضيَّة أخرى، صالحة تمامًا لمثل هذه القراءة.
ينطلق موقفُ ديكارت العلميُّ من هذه المقدِّمات الغاليليَّة. فلقد تبيَّن من بعد استقراء متأنٍّ ان نظريته الفيزيائيَّة لا تكتسب معناها ودلالاتها إلَّا في نطاق القول بوحدة الطبيعة المحطِّمة لنظريَّة الكوسموس الإغريقيَّة. وعليه، فلا تكمن طرافة ديكارت في الاهتمام العلميِّ البعيد عن القواعد والمبادئ الأرسطيَّة فحسب، بل كذلك في ربطه بين المسائل الفيزيائيَّة والمسائل الرياضيَّة تمامًا كما نبّه إلى ذلك غاليله. والبيِّن أنَّ قوانين الحركة لدى ديكارت هي تلك القوانين التي يُعبِّر عنها بقواعد سببيَّة تبادل الحركة كما تتمُّ في تصادم الأجسام. لذا تندرج هذه العمليَّة الفيزيائيَّة ضمن ميتافيزيقا السبب، الأمر الذي أدَّى به إلى إقصاء الصور الجوهريَّة باعتبارها غير ملائمة لفعل الجسم الذي لا يمكن أن يكون إلَّا من خلال الملامسة. وتأسيسًا على يقينه الرياضيِّ، راح ديكارت يعرِّف الطبيعة ويقول مخاطبًا مناظريه: «لتكونوا على علم أنَّني لا أقصد أولًا من خلال عبارة الطبيعة بعض الآلهة، أو بعض القوى الخياليَّة الأخرى، بل أستعمل هذه الكلمة للتعبير عن المادَّة نفسها التي أعتبرها بجميع الصفات التي نسبتها إليها، لكن شريطة أن يواصل الله محافظته عليها بالصورة نفسها التي خلقها بها. فبمجرَّد أن يواصل الله المحافظة على المادَّة، سوف يترتَّب على ذلك بالضرورة أن تحدث تغيُّرات في أجزائها، ما دام لا يمكن، على ما يبدو، إسنادها إلى فعل الله، لأنَّها لا تتغيَّر البتَّة، فإنّي أنسبها إلى الطبيعة، وأسمّي القواعد التي تُسيِّر تلك التغُّيرات، قوانين الطبيعة».
ربَّما علينا هنا، أن نستعيد أيضًا ما ذهب إليه لايبنتز في كتابه «مقالة في الميتافيزيقا» من أنَّ تعريفه لله يختلف جوهريًّا عن تعريف الفلاسفة المحدثين أمثال ديكارت وسبينوزا. فقد صرَّح بأنَّه أبعد ما يكون عن رأي مَن يزعمون أنَّه ليس ثمَّة قواعد خير وكمال طبيعة الأشياء أو في أفكار الله عنها، وأنَّ أعمال الله ليست خيِّرة إلَّا من جهة العلَّة الصوريَّة [المتمثِّلة] في أنَّ الله قد قام بها». فالله ـ كما يقول ـ كائنٌ ضروريٌّ، وملكة فهمه مصدر الجواهر، وإرادته أصل الموجودات، وهو التناغم الأسمى وعلَّة الأشياء القصوى»…فلو كانت قواعد الميكانيكا تابعة للهندسة فقط من دون الميتافيزيقا لكانت الظواهر على غير ما هي عليه كلّيًا كما يقول لايبنتز. أمَّا مؤدَّى ما ذهب إليه، فهو التأسيس لأطروحة تدعو إلى وجوب العودة إلى الميتافيزيقا لتفسير حقيقة الفيزياء. وهذه الأطروحة تعني في المقام الأول وعي أنَّ الوجود الفيزيائيَّ يعود في منشأه وأصله إلى إرادة ميتافيزيقيَّة أخرجته إلى الوجود. وهنا على وجه الضَّبط يقع التمييز الأنطولوجيُّ بين ماهيَّة الواجد وهوّيَّة الموجود، واستطرادًا بين المصنوع وصانعه. هكذا، وطالما قد اعترفنا بحكمة الله في جزئيَّات بنية بعض الأجسام الخاصَّة والميكانيكيَّة، فقد أصبح من الَّلازم أن تظهر تلك الحكمة أيضًا في هيئة العالم العامَّة، وفي تكوين قوانين الطبيعة. لكن، ثمَّة خلافٌ من هذه الوجهة بين الرؤية السقراطيَّة حول العلَّة الغائيَّة ورؤية لايبنتز المستندة إلى التطوُّرات الجوهريَّة للعلوم الفيزيائيَّة. والبيِّن أنَّ مهمَّة الفيزيائيِّ، بحسب سقراط، تكمن في البحث في كلِّ شيء عن العلَّة الغائيَّة التي تكون بموجبها العلَّة الفاعلة ثانويَّة الدور والمقام. وإذا كان من الجائز القيام بمقارنات بين نظريَّة سقراط ونظريَّة لايبنتز في الغائيَّة فلا بدَّ من أن نفهم أنَّهما تختلفان، فإذا كان سقراط يستعمل الأطروحة الغائيَّة لتفسير جزئيَّات الظواهر، فلايبنتز لا يذكر مبدئيًّا الفكرة الغائيَّة إلَّا حين يتعلَّق الأمر بفعل الخلق وفهم كنه العالم في كلّيَّته. ولبيان التوفيق الضروريِّ بين العلَّة الفاعلة والعلَّة الغائيَّة، يضيف لايبنتز في رسالة إلى دي بييات (Des Billettes): «أعتقد أنَّ كلَّ شيء يسير ميكانيكيًّا في الطبيعة»، وأنَّه يمكن تفسيرها عن طريق العلل الفاعلة، لكن كلّ شيء يمكن في الوقت نفسه كذلك أن يُفسَّر عن طريق العلل الغائيَّة»، إذ «يمكن كلّ ما هو طبيعيٌّ أن يفسَّر في جزئيَّاته من دون أن نفكِّر في الله»، لكن فهم كليَّته لا يدرك من دونه. [أنظر: p. 203. Malebranche et Leibniz, relations personnelles Robinet, èd,]
VI
ميتافيزيقا الحركة الجوهريَّة
لم تكن الفلسفة الإسلاميَّة بمنأى عن علم الطبيعة كفضاء مكوِّن لنظامها الميتافيزيقيّ. وإذا كان الفلاسفة المسلمون الأوائل كالفارابي وابن سينا قد اتَّخذوا سيريَّتهم نحو فهم الطبيعة على طريقة المشَّاء برجاء الوصول إلى «الماوراء»، فسيتخذ ملَّا صدرا الشيرازيُّ دربة مفارقة ليرسم نظرًا مجاوزًا لمنطق عمل الطبيعة عبر أطروحته في الحركة الجوهريَّة. ففي سياق استجلاء الصِّلة بين الطبيعة وما بعد الطبيعة، دأبت الحكمة المتعالية على تظهير هذا المفهوم انطلاقًا من وجهة نظر جديدة ومفارقة في عالم الميتافيزيقا قوامُها حدوث التغيُّر في مقولة الجوهر. وبهذا الفتح المعرفيِّ سوف يجاوز صدر الدين الشيرازيُ (ملَّا صدرا) الفهم الأرسطيَّ في تفسير حركة الكون، حيث يتحوَّل الجوهر في نظامه الفلسفيِّ إلى بنية للأحداث والحركة وإلى عمليَّة للتغيُّر. ينظر ملَّا صدرا إلى الطبيعة بوصفها مبدأً للتغيُّر والثبات. وعلى أساس هذه الفرضيَّة منح مقولة الحركة استقلالًا نسبيًّا باعتبار كونها حقيقة قائمة بذاتها. إلَّا أنَّ ما يكمن وراء اعتبارات صاحب الحكمة المتعالية للتغيُّر والطبيعة هو تصوُّره للوجود ومسوِّغاته، لمَّا رأى إلى التغيُّر بوصفه نمطًا للوجود يفكِّك العالم المادّيَّ ويتجاوز الحركة الناقلة والموضعيَّة، ويؤكِّد ديناميَّة صورة العالم تبعًا لهرم الوجود وتراتبيَّته.
يفتتح ملَّا صدرا نقاشه للحركة باتِّباع مشروع الطبيعة الأرسطيَّة، فيفسِّر معنى كلمة القوَّة بطرق عدَّة. والمعنى الأكثر شيوعًا هو أنَّ القوَّة هي القدرة على إجراء أفعال بعينها، وهي في هذا المعنى إمكان يرادف القدرة، التي تجعل حركة أو فعل الأجسام الطبيعيَّة ممكنًا. وهكذا تستعمل كلُّ الموجودات التي تخضع للتغيُّر الكمّيِّ والموضعيِّ قدرة القوَّة؛ لأنَّ الأجسام الهيولانيَّة تحتاج إلى مبدأ فاعل لتحقّق قوَّتها الكامنة، وهذا يبرهن حسب ملَّا صدرا أنَّ الشيء ذاته لا يمكن أن يكون مصدرًا للتغيًّر، بل ثمَّة بالضرورة فاعل من خارجه يحثُّه على التغيُّر. قد يتَّفق صدرا مع أرسطو وابن سينا على أنَّ هذا يعنى «أنَّ الشيء ليس له مبدأ للتغيُّر في ذاته» و«كلُّ جسم متحرِّك له محرِّك من خارج ذاته». وعليه، تقــدِّم العلاقــة بيـن المحـرِّك والجسم المتحرِّك تتابعًا عِلّيًّا فـي هــذا المحرِّك الـذي يحــرِّك الأشيــاء الأخرى بحركــة لا سببيَّة فحسب، بــل يتمتـَّـع بحال أنطولوجيّ. وفي هذا المجال، يستشهد صدرا بستة أنواع مختلفة من الفواعل في ما يتعلَّق بحركة الأشياء، وهي القصد والنيَّة والرضا والطبيعة والقصر والتشكُّر. وباصطلاح صدرا، كلُّ ما له قبليَّة وتزداد كثافته في التحقُّق الوجوديِّ يرجَّح أن يكون علَّة لا أثرًا، والله وحده بهذا المعنى هو ما يطلق عليه حقًّا «علة» كلِّ شيء. وعلى الشاكلة ذاتها، فإنَّ المادَّة الأولى أو الهيولى لديها على الأقلِّ قوَّة لوجود علَّة لأنَّها أضعف في التكوين الوجوديِّ بنزوع قوى نحو عدم الوجود. [الأسفار – الجزء الثالث – ص 10-13].
الجسم الطبيعيُّ في الفلسفة الصدرائيَّة مزيج مركَّب محكوم بقانون التحوُّل والتغيير المستمرِّ. كذلك الأمر في الذرَّات الكوانتوميَّة الدائمة التحوُّل والحركة على أساس الفيزياء الكوانتوميَّة. إلَّا أنَّ التغيير في الفلسفة يعني خروج الشيء من القوَّة إلى الفعل، حيث يحصل إمَّا على نحو دفعيٍّ (الكون والفساد)، وإمَّا على نحو تدريجيٍّ (الحركة). وقد عرض صدر المتألّهين نظريَّة الحركة الجوهريَّة ورفض نظريَّة الكون والفساد الأرسطيَّة؛ ليبيّن أنَّ التحوُّل في الجسم الطبيعيِّ يجري في قالب الحركة الذاتيَّة والتغيير التدريجيِّ الدائم. وهكذا يمكن توضيح تحوُّل وتغيير الذرَّات الكوانتوميَّة في فيزياء الكوانتوم، وكذلك خلق وفناء الذرَّات في نظريَّة المدارات الكوانتوميَّة على أساس «أصل عدم القاطعيَّة»، وكذلك حركة الأشياء الذاتيَّة في الحكمة المتعالية الصدرائيَّة على أساس الحركة الجوهريَّة والتغيير الدائم، لكنَّ المسألة الجديرة بالذكر هنا أنَّ هذا التغيير يترافق في الحالتين مع توارد الصور؛ وليس مع تحقُّق الوجود الفلسفيِّ وفقده، فالذرَّة في المدار الكوانتوميِّ تخضع للخلق ثمَّ الفناء. وهذا ما شرحته الحكمة المشَّائيَّة وفق مبدأ الخلع والّلبس، انطلاقًا من فكرة الكون والفساد، بينما شرحته الحكمة المتعالية على قاعدة الّلبس بعد الّلبس، وانطلاقًا من فكرة الحركة الجوهريَّة. ممَّا لا شكَّ فيه، أنَّ الذرَّة وبعد فنائها، يجب أن ترد عليها صورة أخرى (الذرَّة الجديدة المخلوقة في المدار)؛ وإلَّا لزم أن تتحقِّق فعليَّة المادَّة من دون صورة، وهذا محال. والمسلَّم به، أنَّ توارد الصور هذا على الذرَّات، سواء كان على شاكلة الخلع والّلبس أم الّلبس بعد الّلبس، لا يحمل معنى تحقُّق الوجود وفقده بالمعنى الفلسفيّ. كما يمكن القول أنَّ أصل عدم القاطعيَّة عند هايزنبرك، هو شكل من أشكال التحوُّل والمرونة الدائمة، وبالذات لعالم الذرَّات الكوانتوميَّة.
كان ملَّا صدرا يعتقد أنَّ «الزمان» هو مقدار الحركة في الجوهر؛ أي أنَّ عالم الطبيعة في حالة تحرُّك وتجدُّد مستمرَّين، وأنَّ الزمان هو مقدار هذا التجدُّد والتغيُّر في الطبيعة، إلَّا أنَّ من جملة الإشكالات والتحدّيات المطروحة في الحكمتين المشّائيَّة والمتعالية في خصوص الحركة في الجوهر، والتي قدَّم صدر المتألّهين إجابات متعدِّدة لها، هو بحث ثبات الموضوع، والذي على أساسه رفض المشَّاؤون الحركة في الجوهر، حيث اعتبروا أنَّ ثبات الموضوع واحد من ضرورات الحركة وهو يتنافى مع الحركة الجوهريَّة. أمَّا في الفيزياء الجديدة، فعندما تفنى الذرَّة في ميدان خاصٍّ (مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ في أحدث النظريَّات الكوانتوميَّة؛ أي نظريَّة المدارات الكوانتوميَّة، تكون الأصالة للمدار والذرَّات هي مظاهر أو تجلّيات الحالات الصادرة عن المدار، والتي هي في حالة تحوُّل وتغيير دائم من دون أن تتعرَّض للزوال)، وعندما تخلق الذرَّة [نوع الذرَّة عينها]، فهذا يشير إلى ثبات الموضوع، وهذا الذي ادَّعته الفلسفة الصدرائيَّة وأيّدته انطلاقًا من اعتبار الحركة نوع من الوجود، ومن العينيَّة بين الحركة والتحرُّك. وفي هذا الأمر، يمكن ملاحظات التطابق بين الأمرين. [ابراهيم قالين – بين الفيزياء والميتافيزياء – فصليَّة «علم المبدأ» – العدد الثاني – صيف 2022].
ثمَّة مسألة أخرى تجب الإشارة إليها، وهي أنَّ الجسم الطبيعيَّ في الفلسفة الصدرائيَّة مركَّب من القوَّة والفعل وتدلُّ القوَّة على المادَّة والفعل على الصورة؛ ولذلك، فالقوّة مرتبطة بالجسم الطبيعيّ. وفي ما يتعلّق بالذرّة الأساسيَّة، فهناك ما يشير إلى وجود ما هو بالقوَّة، كما يقول هايزنبرك: “هناك إمكان للموجوديّة أو ميل نحو الموجوديَّة، وتدلُّ هذه الجملة على أنَّ الذرّات الأساسيَّة هي حالة المادَّة التي هي بالقوَّة وليست المادَّة بالفعل، وتحصل المادَّة بالفعل من خلال اتِّصال هذه الذرَّات بعضها ببعض. كما تجدر الإشارة إلى أنَّ الحركة في الحكمة المتعالية هي عبارة عن الخروج التدريجيِّ من القوَّة إلى الفعل، ومن النقص إلى الكمال. ذاك يعني أنَّ النقص والكمال هما صفتان للشيء المتحرِّك في طول الحركة؛ أي أنَّ الحركة الجوهريّة في الفلسفة الصدرائيّة تتحقّق على أساس استكمال مادَّة الصورة، أمَّا في نظريَّة خلق وفناء الذرَّات الأساسيَّة، والتي يبدو في الظاهر أنَّها تتطابق مع نظريَّة الكون والفساد المشَّائيَّة، فمن غير الممكن الحديث بوضوح عن هذا البُعد الاستكماليّ، علمًا أنَّ المدار يتعرَّض باستمرار لحال هبوط وصعود وتحوُّل دائم، وبهذا يمكن الحديث عن هذه المقارنة الاستكماليَّة. ومن البائن أنَّ توارد الصور المتقدِّم الذكر في خصوص الذرَّات الأساسيَّة، هو ضربٌ من التكامل، وهذا ما يجعل من المقارنة بينها وبين الحكمة المتعالية أكثر وضوحًا. ومع التدقيق والتعمُّق، ندرك أنَّ نظريَّة الحركة الذاتيّة والتكامليَّة للجسم الطبيعيِّ، تتّضح من خلال فرض وجود مادَّة أولى هي بالقوَّة المحضة ولا فعليَّة لها سوى كونها بالقوَّة؛ وإذا نظرنا إلى المادَّة الأولى للذرَّات الأساسيَّة من ناحية كونها عين المدارات الكوانتوميَّة، فللمدارات هذه فعليّة، وبالتالي هي ذات صور. وعليه، وَجَب البحث عن الجسم الطبيعيِّ ومادَّته الأولى في أمر آخر في عالم الذرَّات الكوانتوميَّة. يبدو أنَّ المفيد هنا هو التأمُّل الميتافيزيقيُّ لا الاكتفاء بالاختبارات التجريبيَّة، إذ ليس ثمَّة أيُّ مختبر بإمكانه إثبات وجود مادَّة لا أثر لها على الإطلاق.
* * *
لنا ـ في الختام ـ أن نتساءل مجدَّدًا حول جدوى ومشروعية ما نحا إليه العقل الفلسفي الحديث مع هيوم وكانط نحو حجب الثّقة عن الشرعيَّة العقليَّة للمعرفة الميتافيزيقيَّة. ثمَّ ليمتدَّ التساؤل عمَّا إذا كان العلم الذكيُّ هو الباب الذي سينفتح معه أفق التأسيس المتجدِّد لتفلسُف ينعطف فيه العقل إلى طوره الامتدادي، ويرى إلى الفيزياء الذكيّة كتمهيد ضروريٍّ لاستبصار ما وراءها من حقائق ميتافيزيقية.
ولأنَّ العلم الفائق الذكاء هو سليلُ السيرورة المنطقيَّة لما سُمِّي «الحقيقة العلميَّة»، فإنَّه – في ماهيَّته وهوّيَّته وظهوره، وتبعًا للامتداد الَّلامتناهي لنشاط العقل الإنسانيِّ – يُعدُّ طفرة طبيعيَّة. بالتالي فهو يترجم بعضًا يسيرًا ممَّا يمكن أن يفلح به العقل حين تتوسَّع آفاقه ويمضي بعيدًا في استكشاف الكون واستكناه حقائقه ومجهولاته.
لا دهشة إذن، في ما يرسلُه به العلم الذكي من علامات مبهرة. ربما يكون الإندهاش الأعظم من ذاك الذي ينطوي عليه العقل البشري من امتدادات هائلة، وفي قدرته على الكشف عن أسرار الكينونة وسبر غور مجهولاتها. هنالك، على وجه الحقيقة، يكمن السرُّ الذي منه سيبلغ العلم الذكيُّ مكانة لا قِبَل له بها، وفقًا لمبدأٍ واعٍ لكلِّ موجود حظٌّ منه أنَّى كان جنسه أو نوعه أو فصيلته.
د. محمود حيدر
مفكّر وباحث في الفلسفة والميتافيزيقا ـ لبنان
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.