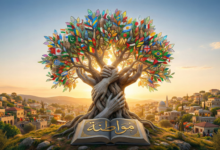من ترييض الطبيعة إلى فلسفة الاختلاف
منصرة: كيف نشأت فلسفة الاختلاف من قلب العقل العلمي الحديث
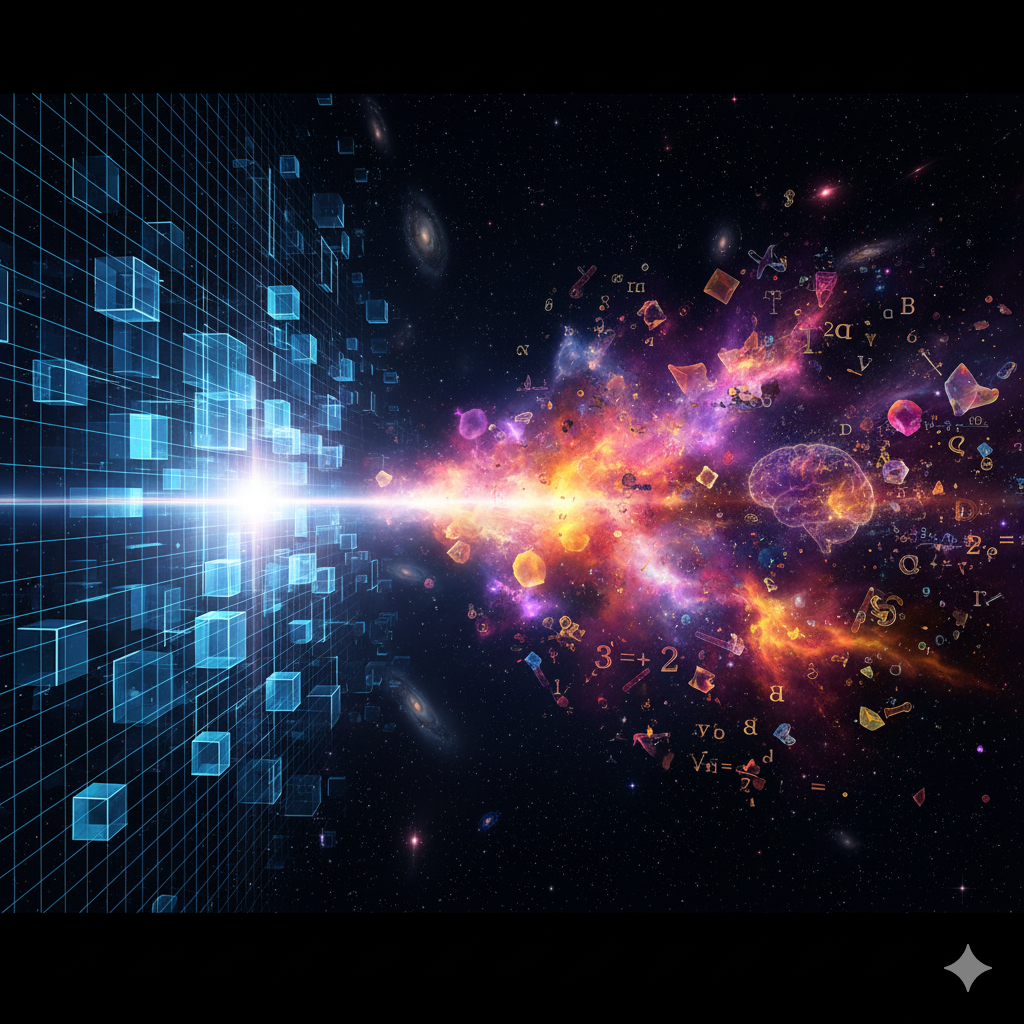
يمكن النظر إلى فلسفة الاختلاف بوصفها لحظة نقد داخلي في تاريخ الفكر الغربي الحديث، لا بوصفها قطيعة معه أو تجاوزًا خارج حدوده. فهي لا تأتي من خارج المنظومة التي أقامها العقل العلمي، بل تنبثق من صميمها، من داخل بنيتها ذاتها، حين بلغت هذه المنظومة ذروة اتساقها مع نيوتن وكانط. الفرضية التي ينطلق منها هذا المقال هي أن الجذر العميق لفلسفة الاختلاف ليس أدبيًا ولا سياسيًا ولا حتى ميتافيزيقيًا بمعناه التقليدي، بل هو جذر علمي في الأساس. إنّ ما أفرز لاحقًا التفكير في التعدد، والتأويل، والاختلاف، إنما هو الأثر البعيد لذلك المشروع العلمي الحديث الذي أراد أن يجعل من العالم نظامًا واحدًا منسجمًا يمكن تمثيله رياضيًا.
حين أعلن غاليلي أن “كتاب الطبيعة مكتوب بلغة الرياضيات”، كان يؤسس، دون أن يدري، لنمط جديد من العلاقة بين الفكر والوجود، علاقة قوامها القياس والتماثل. الطبيعة لم تعد تُدرك إلا بما يمكن صياغته عددًا وشكلًا، أي بما يدخل في نظام الكمّ. هذا التحول لم يكن مجرد تقدم في أدوات المعرفة، بل كان انتقالًا في بنية الفكر ذاتها من الكيفي إلى الكمي، من التعدد إلى الوحدة، من الغموض إلى الشفافية. ثم جاء ديكارت ليعمّم هذا النمط الرياضي على مجمل حقول الفكر، جاعلًا من المنهج الهندسي النموذج الأعلى للعقل والمعرفة. ومن هنا تأسست الميتافيزيقا الحديثة على مبدأ الهوية والحضور: الحقيقة واحدة لأنها مطابقة للعقل، والعقل واحد لأنه يقيس الأشياء بمقياس واحد.
غير أنّ هذا التماثل الصارم الذي أرساه المشروع العلمي لم يمر دون أن يترك أثرًا معاكسًا في العمق. فكلّ محاولة لردّ التعدد إلى الوحدة، ولإخضاع العالم إلى نظام واحد من المعنى، كانت تخلق في الوقت نفسه توتّرًا خفيًا بين ما يُقال وما يُقصى، بين ما يُقاس وبين ما ينفلت من كل القياس. ومن هذا التوتر بالذات، لا من خارجه، وُلدت فلسفة الاختلاف. فهي لم تأت لتعارض العلم، بل لتفكك منطقه حين يُحوّله إلى نسق مغلق لا يرى إلا ما يمكن ضبطه. إنّ نيتشه، وهايدغر، ودولوز، ودريدا، لم يفعلوا سوى استئناف المشروع العلمي في أقصى صرامته، لكن من زاوية ما يستبعده، من زاوية المختلف والمهمّش والمستبعد باسم الحقيقة الواحدة.
بهذا المعنى، فإن فلسفة الاختلاف ليست قطيعة مع العقلانية الحديثة بقدر ما هي وعي بحدودها. إنها تفكير في ما لم يفكر فيه هذا العقل حين جعل الرياضيات نموذجًا للمعرفة والوجود. لذلك فإن فهم فلسفة الاختلاف يستلزم العودة إلى أصل من أوصلوها -أصلها العلمي-، إلى تلك اللحظة التي حوّل فيها غاليلي وديكارت العالم إلى بنية هندسية محكمة وموحدة، لأن من هناك بالضبط بدأ مسار النقد، وبدأت الإمكانية الجديدة للتفكير في اللامقاس، في المختلف، في ما يفلت من النظام. إنّ هذا البحث ينطلق من هذا التصور: فلسفة الاختلاف ليست ردّ فعل ثقافيًا أو أخلاقيًا، بل هي ارتداد داخلي للعلم على ذاته، وانعكاس لمطلب الدقة والتماثل حين يبلغ أقصاه، فيتحول إلى نقيضه، أي إلى الاعتراف بما لا يمكن قياسه ولا تمثيله.
إن الجذر العميق لفلسفة الاختلاف لا يمكن فهمه إلا في ضوء التحول الكبير الذي عرفه الفكر الغربي مع المشروع العلمي الحديث، وبالخصوص مع غاليلي وديكارت. فهناك، في ذلك المنعطف الذي دشّن ما سيعرف لاحقًا بالعقل الحديث، تم تأسيس علاقة جديدة بين الإنسان والعالم، بين الفكر والوجود، بين المعنى والحقيقة. لقد تحوّلت الطبيعة من كونها مجالًا للغموض والتعدد والاختلاف إلى موضوع للقياس والتماثل واليقين. إنها لحظة تَرييُض الطبيعة، حيث لم يعد العالم يُقرأ بعين التجربة المباشرة ولا بحسّ المشاركة، بل بلغة رياضية صارمة، لغة خالية من الكيف والالتباس، كما قال غاليلي: كتاب الطبيعة مكتوب بلغة الرياضيات. منذ تلك اللحظة أصبح ما لا يُقاس لا يُعترف به، وما لا يدخل في نظام العدد لا مكان له في نظام الحقيقة.
بهذا المعنى، فإن مشروع ترييض الطبيعة لم يكن مجرّد تحوّل في أدوات المعرفة، بل كان انقلابًا في بنية الفكر نفسه. فحين تُكتب الطبيعة بلغة واحدة، بلغة الكمية والقياس، فإنها تفقد تعددها، وتُختزل إلى ما يمكن تمثيله هندسيًا. إن المشروع العلمي الحديث أقام العالم على أساس التماثل والوحدة، وحوّل الاختلاف إلى خطأ، والكيف إلى غموض يجب تبديده. والنتيجة أن الوجود لم يعد فضاء مفتوحًا للدهشة، بل صار معادلة يمكن حلّها.
ثم جاء ديكارت ليمنح هذا التوجّه شكله الميتافيزيقي. فإذا كان غاليلي قد ريّض الطبيعة، فإن ديكارت سيُريّض الفكر ذاته. المنهج الهندسي عنده لم يعد طريقة للبرهان الرياضي فقط، بل أصبح نموذجًا للمعرفة برمتها. العقل، في تصوره، لا يبلغ الحقيقة إلا حين يسير وفق خطوات المنهج الهندسي: البداهة، التحليل، التركيب، والإحصاء. وبهذا تم نقل مبدأ التماثل من مجال الأشياء إلى مجال الفكر، وأصبحت الحقيقة واحدة لأنها مطابقة للعقل، والعقل واحد لأنه يعقل على نمط واحد. ومن هنا بدأ ما يسميه فوكو ودريدا وديدييه دوبرميه لاحقًا ميتافيزيقا الهوية أو ميتافيزيقا الحضور، حيث يُنظر إلى الحقيقة كحضور دائم للمعنى في ذاته، وإلى الوجود كتماثل مع أصله، وإلى الفكر كمرآة صافية للعالم.
غير أن هذا التماثل الذي صنع مجد العقل الحديث، هو ذاته الذي سيفتح الباب أمام نقده. لأن الفكر، حين يدفع منطقه إلى أقصاه، يكشف حدوده. وهكذا فإن فلسفة الاختلاف لم تنشأ خارج هذا المشروع، بل من داخله، من صميم منطقه الذي استنفد ذاته. فكلّ محاولة لفرض الوحدة المطلقة تُنتج، في نهاية الأمر، وعيًا بالاختلاف الذي أُقصي. إن الاختلاف، بهذا المعنى، ليس نقيضًا للعقل الحديث، بل هو ناتج عنه. لقد وُلد من رحم النسق الذي حاول نفيه، ومن بين شقوق صرامته الهندسية خرج سؤال التعدد والتفرد واللامحدّد.
حين تأمل نيتشه العقل الغربي، رأى فيه نزعة إلى قتل الحياة باسم الحقيقة، ورأى في ميتافيزيقا الهوية سجناً للفكر. الحقيقة عنده ليست تطابقًا مع واقع ثابت، بل هي تأويل، صيرورة، صراع قوى. ومن هنا انطلقت فلسفة الاختلاف بوصفها قطيعة مع فكرة الأصل، مع ذلك الميل الذي رسّخه الفكر الديكارتي إلى ردّ الكثرة إلى الوحدة. لقد فضح نيتشه ذلك المبدأ الخفي الذي يجعل الفكر الغربي يطلب دائماً الواحد وراء المتعدد، والجوهر وراء الظاهر، والمعنى وراء اللفظ. وفي هذا الكشف، تحوّل نيتشه إلى نقطة انعطاف: فبدل أن يكون الاختلاف خطأ في الطريق إلى الحقيقة، صار هو الطريق نفسه.
أما هايدغر، فسيكشف البعد الأنطولوجي لهذه القطيعة. في نظره، الرياضيات ليست مجرد علم للأعداد، بل هي طريقة في النظر إلى الوجود، طريقة تجعل الكائن موضوعًا للسيطرة والحساب. هذا هو مبدأ التقنية الذي يتغذى من الروح الرياضية ذاتها. ولذلك فإن ترييض العالم لم يكن بريئًا، بل كان إعلانًا عن نزعة إرادية إلى السيطرة على الوجود. في مواجهة هذا، دعا هايدغر إلى العودة إلى سؤال الوجود، إلى الإنصات لما يتخفّى، لما لا يُقاس ولا يُحسب، أي إلى الاختلاف الذي سبق كل تحديد.
ثم يأتي دولوز ليمنح الاختلاف مكانته الفلسفية الكاملة. فبينما كان الفكر القديم والحديث معًا يعتبران الهوية شرط الاختلاف، سيقلب دولوز المعادلة: الاختلاف هو الأصل، والهوية ليست سوى أثر، تكرار بلا نموذج، تشابه بلا أصل. بهذا التصور يصبح الوجود نفسه اختلافًا في صيرورة، لا وحدة ثابتة، وتصبح الفلسفة ليست بحثًا عن ما هو واحد، بل عن ما يتوالد من تعدد.
إن ما يجمع نيتشه وهايدغر ودولوز ودريدا، على اختلاف مقارباتهم، هو هذا الموقف النقدي من المشروع العلمي-الميتافيزيقي الذي بدأ مع غاليلي وديكارت. كلهم رأوا في ذلك المشروع لحظة التأسيس لما يسميه فوكو نظام الحقيقة الحديث، نظام يقوم على التماثل والشفافية والقياس، ويرفض ما لا يمكن إخضاعه لمعياره. لكن هذا النظام، في صرامته، كشف عن مفارقته الداخلية: كلّ محاولة لتأسيس الحقيقة على مبدأ الوحدة، تُظهر أن الوحدة نفسها تحتاج إلى ما يختلف عنها كي تُعرّف. ومن هنا، فالميتافيزيقا التي أقصت الاختلاف كانت تحمله في جوفها، كما يحمل النظام العلمي الحديث نقيضه في بنيته ذاتها
من هذا المنظور، لا تكون فلسفة الاختلاف مجرد رد فعل على العقل العلمي، بل هي استئناف له من موقع آخر. لقد استكملت منطقه إلى نهايته كي تكشف أن ما يسعى إلى الإلغاء لا يُلغى، وأن ما يُقصى في البداية يعود في النهاية بوصفه أساسًا جديدًا للفكر. فحين أقصى المشروع العلمي الغموض والكيفي والاحتمالي باسم الدقة واليقين، كان يزرع بذور نقده. وحين حوّل العالم إلى معادلة، فتح الباب أمام السؤال عن ما يفلت من كل معادلة.
إننا، إذن، أمام نقلة فلسفية نوعية تؤكد قولة هابرماس (الحداثة مشروع لم يكتمل بعد) : الاختلاف لم يولد ضد العلم، بل من داخل العلم الحديث حين بلغ أقصى درجات صرامته. لم يولد من رفض العقل، بل من عقل أدرك حدوده. ومن هنا يمكن القول إن فلسفة الاختلاف ليست ثورة على العقل، بل هي عودة إلى العقل وقد تطهّر من وهم التماثل. هي نقد من الداخل، تفكيك لا هدم، إعادة فتح لما أُغلق باسم الحقيقة الواحدة.
بهذا المعنى، فإن فلسفة الاختلاف ليست فقط لحظة جديدة في تاريخ الفكر، بل هي استعادة للوجود نفسه كصيرورة مفتوحة لا تُختزل في مبدأ أو أصل. إنها إعلان عن أن الحقيقة ليست وحدة بل تعدد، وليست حضورًا بل أثرًا، وليست تماثلًا بل اختلافًا. ومن هنا، يعود الفكر الحديث إلى بدايته ليجد في قلب مشروعه العلمي الصارم ما يقوده إلى تجاوزه: فالتاريخ الفكري للغرب لم يخرج من دائرة العقل إلا لكي يكتشف، متأخرًا، أن العقل الذي نادى بالتماثل هو الذي ولّد الاختلاف.
يونس نحيب
لائحة المصادر:
- Gilles Deleuze, Différence et répétition. Presses universitaires de France (PUF), Paris, 1968.
- Martin Heidegger. Essais et conférences. Trd André Préau. Ed Gallimard Paris, 1980.
- Michel Foucault, L’Archéologie du savoir. Ed Gallimard, Paris, 1969.
- Friedrich Nietzsche, Par delà bien et le mal, Trd Cornélius Heim, Gallimard, Paris, 1971.
- عبد السلام بنعبد العالي. أسس الفكر الفلسفي المعاصر: مجاوزة الميتافيزيقا. منشورات المتوسط، الطبعة الثالثة، إيطاليا، 2023.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.