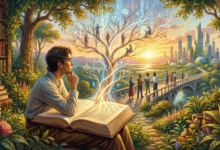بكائيَّات غزَّة؛ ما بين المقاومة والإبادة

سررت حين وصلني كتابان هدية من الكاتبة الأردنية د. ميسون حنا: كتاب أنين الأرواح، ويضم عدة مسرحيات بقلمها، وكتاب بكائيات غزة. قرأت الكتابين، فاستوقفتني نصوص بكائيات غزة وأثارت روحي، خاصة ونحن نعيش منذ قرابة العامين حرب الإبادة على غزة بقلوب مفطورة ممزقة، في ظل صمت وخنوع عربي وإسلامي، وتواطؤ غربي، ودعم أمريكي مطلق. الكتاب يقع في 82 صفحة من القطع المتوسط، وطُبع في الأردن عام 2024م، وصُمّم غلافه باللون الأبيض دون لوحة كما في باقي كتب الكاتبة. وقد جاء العنوان مرتبطًا بالحرب الشرسة على غزة، وبما يتخللها من صور الإبادة، في ظل صمود أسطوري لشعبنا هناك، فكان العنوان “بكائيات غزة” تعبيرًا عن شيء من بكاء الروح، في ظل العجز عن الفعل. قدم للكتاب الروائي السوري محمد فتحي المقداد بمقدمة جميلة، لكنه وقع في خطأ تاريخي، إذ ذكر: “في العام 1948 أُعلن قيام دولة إسرائيل، وبعد الحرب الخاسرة التي خاضتها الجيوش العربية (النكبة)، وإقرار الهدنة، تمخضت الأمور والمحادثات العلنية والسرية عن قرار (181) لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية”، بينما الصحيح أن قرار التقسيم رقم 181 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني 1947، أي قبل النكبة وليس بعدها.
بكائيات غزة مجموعة من النصوص الأدبية العابرة للتجنيس، تتكوّن من اثنين وثلاثين نصًا، وهو العنوان ذاته الذي صدر به ديوان شعر في عام 2025، ما يجعل هذا الكتاب أسبق في الصدور بعام. افتتحت الكاتبة كتابها بعبارة: “نصوص أدبية تعكس واقع الحال في غزة أثناء ملحمة طوفان الأقصى”، واضعةً القارئ من البداية في إطار محدد لا يتجاوزه خيالًا أو تأويلًا. ثم قدمت تنويهًا اعتذرت فيه لأهل غزة والمنكوبين في العالم، إذ لا يمكن للكلمة، كما تقول، أن تبلغ عمق المأساة، وأضافت: “الكلمة سلاح، قيل إنها سلاح العاجز الأعزل، ولكني على يقين أنها سلاح الواعي الذي يسعى للتوثيق، ولرسم صورة قد تتآكل بفعل الزمن”. الكاتبة تعيش، بخيالها وإحساسها، بعضًا من معاناة أهل غزة تحت نار الحرب والقتل والتجويع والعطش، وجاءت نصوصها تدور حول عدة محاور لا يمكن فصلها عن بعضها، من أبرزها:
محور الشهداء: في نص “عطش”، نجد امرأة في ظل الحرب تحمل سطلًا بحثًا عن ماء لأطفالها، وحين تعود لا تجد سوى منزل مدمر وأشلاء أطفالها. تقول: “جمعت بعض أشلائهم وسكبت الماء فوقهم، لعلهم يرتوون”. يتجلى الإيمان في النص حين تقول: “نظرت إلى أشلاء أبنائي بذهول.. بكيت، صرخت، لطمت، وأيقنت أخيرًا أن لا راد لقضاء الله”، وهو الإيمان ذاته الذي يمنح أهل غزة سرّ صمودهم. وفي “وحيدة”، تُصاب امرأة تحت القصف، ولا تستطيع الزحف نحو والدها الشهيد. أما في “صمت”، فالصمت يملأ المشهد بعد استشهاد الأم وبقاء الابنة وحيدة. ذات الفكرة تتكرر في “دموع” و”إفطار غزي” حيث يستشهد طفل بلحظة الإفطار.
الكاتبة تنقل صورًا متكررة لاستشهاد العائلات، كما في “ضياع”، حيث الأم تفقد أطفالها الخمسة في أماكن متفرقة، وتبقى الرضيعة شهيدة على صدرها، فتقول: “لماذا أبقيتني أيها الموت أتجرع مرارة الفقد؟”. في “نزوح” (المشهد الرابع)، ينقل الشهيد لحظة إصابته بعد محاولة اسعاف الجرحى: “اخترقت رصاصة صدري، فتكومت بينهم”، وفي المشهد التاسع: “أطلقوا النار على طاقم السيارة، سقط شهداء من المسعفين، واستشهد الطبيب كذلك”. في “صورة 1″، تستشهد صحفية أثناء تغطية قصف مشفى والجرحى بداخله، وفي “صورة 2″، تنقل لنا الكاتبة مشاعر أم استُشهد ابنها الصحفي.
محور المعاناة: المعاناة هي السقف الذي يحتمي تحته كل ما يتعرض له شعب غزة. منذ نكبة 1948 وحتى الاحتلال عام 1967، ومن ثم الحصار والقتل والتجويع المتواصل. في نص “براءة”، يستشهد الأب، ويفقد الطفل ساقيه، ويسأل الطبيب ببراءة: “متى ستنبت قدمي يا عمو؟”. في “آذان”، تُقصف المساجد ويُرفع الأذان بلا مآذن. في “وداع”، يخرج الأب بحثًا عن طعام مودعا أسرته ويقول: “ومن يدري، قد لا أعود…”، وفي “كابوس”، تسأل الطفلة من تحت الركام: “هل هذا حلم مزعج أم حقيقة؟”.
في “روح متشظية”، يستيقظ ربّ الأسرة جريحًا بعد القصف، وقد فقد عائلته، فيقول: “إصاباتي بسيطة، لكن روحي متشظية… من يدرك عمق إصاباتي إذن؟”. وفي “جوع” المكون من أربع شذرات قصيرة يكون الكلام عن الجوع، لا طعام حتى في القمامة. في “خداع”، يدخل الاحتلال شاحنات غذاء ثم يقصف الناس حين يتجمعون حولها. في “صدمة”، تُقصف المخابز، فتسأل: “ماذا بقي لنا غير الجوع والحرمان؟”، وفي “وهم”، يرى الطفل قطعة جبن في مصيدة فئران، فيقول لأمه: “انظري، قطعة جبن! وأنا جائع”.
تتواصل الصور الإنسانية الموجعة: في “حرقة”، يتمثل ذلّ اليُتم بعد فقد الأسرة “حين شعر بالذل وبحرقة الفقد”؛ وفي “حلم صغيرة”، تقول الطفلة: “أشتاق لقضمة خبز أبيض يا ماما”، فتجيبها: “أغمضي عينيك وتخيليها”. في “عذاب”، تبقى الأم تحت الركام ولا تُنقذ بسبب غياب المعدات.ويبقى الطفل يعاني، في نص “؟”، يبقى رضيع وحده يلتقم ثدي أمه الشهيدة. في “طقس”، يدفن أب كسرة خبز مخضبة بدم ابنه. وفي “ألم”، أم تُخاطب أطفالها بعد فقدان زوجها بسبب الجوع.
في “الحج”، رجل كهل يفقد حلمه بالحج بسبب الحرب. أما “العيد في غزة”، فيتكوّن من ثماني لوحات نازفة دمًا ودموعًا، تصور كيف أتى العيد على غزة في اللوحة الثانية تقول الطفلة حين تلقي النقود: “ماذا أصنع بها، ولا بائع بالونات في المخيم، ولا حلوى، ولا دكان.. ولا حتى طعام..”، وفي اللوحة الخامسة رجل يجلس في خيمة مع أهل المخيم صباح العيد، وكل أهله وأسرته استشهدوا، “يتلفت حوله بأسى، لا أحد من أقاربه”، في “أحلام العيد”، ست لوحات أخرى دامية تنقل واقع العيد الموجع، من طفل فقد أمه، إلى حلم بكسرة خبز وكأس ماء. وتجعلنا نصرخ: “يا وحدنا” فلا غير الله نتوجه إليه بالدعاء، فكل الإخوة والأشقاء بالدم والعقيدة لا نسمع لهم صوتا ولا نرى فعلا، ففي النص الأول الطفل قيل له أن أمه استشهدت لكنه يقول: “دماء أمي ساخنة على فراشها الممزق، ولم أرها”، وفي النص الثاني حلم الطفلة بكسرة خبز وكأس ماء بارد و”حذاء يقيني لسعة الحر عندما تطأ قدماي الأرض”، وهكذا تتواصل اللوحات النازفة دما وقهرا حتى النص السادس.
في نص “نزوح” المكوّن من أحد عشر مشهدًا، تصوّر الكاتبة النزوح من منطقة إلى أخرى، حيث “المناطق الآمنة” تصبح ميادين للمجزرة. في المشهد الأول، يرفض شيخ مسنّ النزوح قائلًا: “أتركوني على أنقاض بيتي أُصلي”، في الثاني، رجل فقد أسرته يقول: “سأبقى هنا أحرس أشلاءهم.. أرواحهم تحوم من حولي، كيف أتخلى عنهم وأرحل؟!”،. في الثالث، صديق يدفن صديقه: “ما أقسى الموت في العراء، وحيدًا مع الذئاب والغربان والكلاب الضالة”. ، وفي العاشر، تُقصف المستشفيات ويُطلق النار على الجرحى، في “مشهد 1″، تُدفن بجرافات الاحتلال جثث الشهداء والجرحى معًا: “وأد الأحياء النازفين.. فعل غير مسبوق في تاريخ الحروب”. والمأساة تتصاعد في “مشهد 2”. محور الشهادة والخلود: في نص “شهداء”، تنقل الكاتبة مشاعر ذوي الشهداء: أم، أب، أخ، أخت، زوجة، ابن، ابنة، وصديق. وفي نص “الشهيد”، تكتب رسالة شهيد مدني إلى الأحياء. تختم الكاتبة بنص “أيها الغزي، من أنت؟”، وتفتتحه بسؤال: “أيها الغزي: من أي طينة جُبلت؟”، لتُجيب بلسان الغزي: “نحن الحقيقة التي سوف تُدرّس في كتب التاريخ، عندما يكتبها الأحرار”.
ثم يأتي نص “خاتمة”، عبارة عن تساؤلات وأمنيات الكاتبة، تُختتم بجملة: “على أمل النصر، سنبقى نكتب، ونكتب، ونكتب.”.
وخاتمة القراءة : أبدعت الكاتبة في وصف مشاهد الإبادة في غزة، ليس بالشعارات والخطابة، بل بمشاعر إنسانية حقيقية. فالمقاتلون يحملون السلاح، لكن خلفهم شعبٌ كامل من المدنيين يدفع الثمن: نساء، أطفال، شيوخ، مدنيون، وهم عماد الصمود. فلو انتهت المقاومة، لن يتوقف القتل، بل سيُستكمل بالتهجير. المقاومة إذًا ليست فقط فعلًا عسكريًا، بل أملاً في البقاء.
اعتمدت الكاتبة على أسلوب الممازجة النصية، بين الخاطرة، والشذرة، والترنيمة، وبعض النصوص القصيرة جدًا، ما يضعها خارج إطار النقد المنهجي الصارم. فهي نصوص تنتمي إلى ما يُعرف بالأدب العابر للتجنيس، وهو مجال تعبيري حديث نسبيًا في العربية، لا تحكمه قواعد صارمة، بل يترك للمشاعر والانفعالات الحرة أن تكتب نفسها، ويجدر الإشارة إلى ملاحظة أخيرة تتعلق بورود كلمة “الذئاب” في نص “نزوح” (المشهد الثالث)، فبيئيًا، الذئاب لا تعيش في قطاع غزة، بل تتواجد بأعداد محدودة في محميات طبيعية في النقب ووادي عربة فقط، وتقدر بين 100 و150 ذئبًا.
في النهاية، فإن بكائيات غزة ليست مجرد نصوص أدبية، بل هي نواحٍ إنسانيّ عميق، ومرآة تنعكس فيها مآسي غزة وشعبها الصامد، الذي يواجه الموت اليوميّ بجوعه، بدمه، وبدموعه، دون أن تنكسر إرادته. لقد استطاعت د. ميسون حنا أن تكتب، لا عن غزة فقط، بل عنها وعنّا جميعًا، عن الوجع العربي الصامت، والموقف الإنساني المرتبك، عن شهداء بلا قبور، وأطفال بلا طفولة، وأعياد بلا بهجة. كتبت بدمعٍ ساخن على ورق، فكان الحبر شهادة، وكانت الكلمة جدارًا من صمود، في وجه الإبادة والنسيان.. غزة، كما وصفتها الكاتبة، ليست مجرد مدينة تحت النار، بل هي اختبار حيّ للضمير الإنساني. ومن خلال هذه النصوص، يتأكد لنا أن الأدب يمكن أن يكون وثيقة وشاهدًا، وأن البكاء حين يخطه القلبُ على الورق، يتحول إلى مقاومةٍ لا تقل شأنًا عن السلاح.“
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.