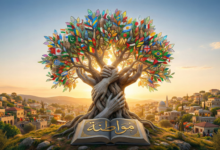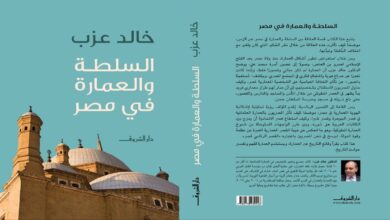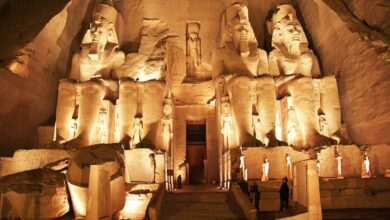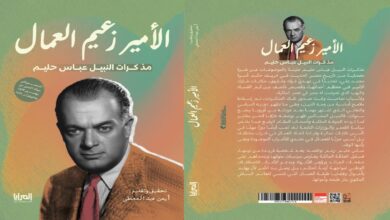اللحظة الاستراتيجيَّة:مستقبل العلاقات السودانيَّة المصريَّة ومحاذير الطرف الثالث

الدكتور الصادق الفقيه*
اقتراب محسوب:
ظهرت الرغبة في تناول هذا الموضوع كمبحث سادس لما بدأناه من سلسلة “الطرف الثالث”، لسببين؛ أولهما أن أفاض في الحديث عنه صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال من إشارات تخصيص لحالات تدخلات “الطرف الثالث”؛ بصفتيه الشريرة والخيرة، لم تكن محصورة في حالة قُطْرِيَّة معينة، وإنما نماذج موضوعية أكثر شمولًا، أوضحنا مُسمياتها في المبحث الأول. وثاني الأسباب هو “اقتراب محسوب” وتطلع للنظر في حالة لازمة أمْسِكُ عن بعض تفاصيلها، لكن حقيقة استدعائها تفرضه خصوصية “اللحظة الاستراتيجية”، التي تتبدى أمامنا نتيجة للتطور الجوهري والتقدم الكبير، الذي لوحظ في علاقات التعاون بين السودان ومصر خلال العامين الماضيين. رغم ما تعرض ويتعرض له السودان من حرب لم تبرح القصد في مخططات هذا “الطراف الثالث”، وأدواته المحلية والإقليمية، في محاولات تقسيم البلاد، وزعزعة استقرارها، ومن ثم التأثير السلبي على كل ما بُنِي عبر التاريخ بين بلدين؛ السودان ومصر، من وشائج قربى وأواصر مصلحة، صعدت بهما إلى مراقي الوحدة أكثر من مرة. وهذا التطور الحادث الآن مهم بشكل خاص، لا سيما بعد فترات سابقة من التراجع الشاذ والكساد الكبير، الذي أثر بشدة على العمق الاستراتيجي للبلدين، إلى جانب أبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وفي حين أنه لا يمكن إنكار أن بعض الفروق الثانوية لا تزال قائمة فيما يتعلق ببعض المسائل، فمن الضروري أن نفهم أن هذه الاختلافات تمثل، في كثير من الحالات، تباينًا في تصريف بعض المصالح ذات الخصوصية المحلية لا يؤدي بالضرورة، ولا ينبغي مطلقًا أن يكون سببًا في تنافرٍ، أو مدعاةٍ إلى صراعٍ من أي نوع؛ مباشر وغير مباشر، أو يكون مبررًا لنزاعٍ بين الأطراف المعنية. إذ إن أي تطور سلبي من هذا القبيل قد يُثِيرُ خلافات لا تُحمدُ عُقباها؛ مُستَفِيدةٌ من عدم وأد هذا التطور في مهده. والجدير بالملاحظة أن مثل هذا التطور؛ في نطاقه وانعكاساته، يُثير قلقًا لا مفر منه لدى المراقبين والمحللين على حد سواء. كما يثير سؤالًا مهمًا: هل سيستمر هذا التعاون المتميز في حجمه وازدهاره باضطراد أسرع، لأنه يُمِكِّن البلدين من الاستفادة والاستثمار في هذه المرحلة المهمة، والحرجة في الوقت ذاته، من علاقتهما، أم أن بعض الانتكاسات الطبيعية قد تؤدي؛ في نهاية المطاف، إلى استرجاع دوامة التراجعات والاتهامات التقليدية، التي يمكن أن تقوض فرص التقدم الكبير، الذي يتم إحرازه حتى الآن؟
واليقين الراسخ عندي أن المقالات والتحقيقات والدراسات، التي أجريت بشكل منهجي في الهيكل التعاوني القوي الحالي، أثبتت أنه مفيد وجوهري للطرفين على حد سواء. ومن دون توقع أي خطر كبير من احتمالات الانهيار، أو الاضطراب الكارثي، ستستمر لإحداث مزيد من هذا اليقين لدى النخب الراشدة في الجانبين. وهذه الرؤية المكثفة هي جزء من تصور استراتيجي أوسع وأكثر شمولًا، هدفه الرئيس هو إثبات أن المواقف، التي قد يواجه فيها هذا التطور والتقدم الإيجابي تحديات موجودة بالفعل وتشكل عقبات، أو مستجدة، ستقابل بإرادة حقيقية وفعلية. ومع ذلك، فإن السلاح الفعال الوحيد لمواجهة هذه التحديات يكمن بقوة في أساس هذه المبادئ المتميزة، التي يمكن أن تشمل جميع الأذونات والاتفاقيات اللازمة؛ والملزمة بالتساوي لدى سلطات الطرفين. ونأمل مخلصين أن تكون هذه الرؤية بمثابة نقطة انطلاق أولية فقط، حيث توجد مجالات رحبة وواسعة النطاق في هذه الاتجاهات لا تزال غير مستكشفة إلى حد كبير ويمكن تطويرها والارتقاء بها أكثر، وبالتالي لا تخضع لبحث علمي دقيق. إذ إن هذه الرؤية لا تفلت من قيد المحتوى التقليدي والأجندات والتفسيرات المتاحة للعلاقات السودانية المصرية المعقدة. لذلك، من المتوقع أن ينظر الباحث الحريص والدارس الدؤوب إلى هذه الرؤية على أنها مجرد لبنة واحدة في البناء الشامل والمستمر للمعرفة المطلوبة في هذا المجال.
لهذا، نحن نشهد بالفخر أن هناك نهضة ملحوظة في التعاون والديناميات المصرية السودانية تجري بالتأكيد في جميع مجالات المشاركة الثنائية تقريبًا، التي تنطوي بشكل كبير على أبعاد إقليمية ودولية ومحلية متزايدة القوة. وهذا التقارب المهم والواعد أعاد إحياء السؤال القديم، الذي كان محل نقاش في كثير من الأحيان: هل تشكل الروابط التاريخية وأوجه التشابه الدائمة بين النخب، وكذلك على المستوى الشعبي، حقًا أساس العلاقات العميقة والمتعددة الأوجه، التي تربط بين الشعبين السوداني والمصري، إلى جانب صناع السياسات والمؤسسات الرسمية لديهما؟ ويشير الفحص الدقيق والأكثر شمولًا إلى أن هذه الروابط التاريخية وأوجه التشابه الكامنة تدعم بالفعل العديد من القواسم المشتركة والسمات الفريدة، التي ربطت تاريخيًا بين مصر والسودان على مر القرون، مما يدل على نمط متميز يختلف بشكل ملحوظ عن العلاقات، التي تشمل البلدان المجاورة الأخرى في المنطقة. وقد تجلى ذلك بأوضح صوره في الأزمة الأخيرة، التي ألجأت السودانيين بمئات الآلاف إلى بلدهم الثاني مصر، والتي ما تضجر شعبها ولا نظامها الحاكم من جموع الباحثين عن الأمن في كنانة العرب. ومع ذلك، فإن الحالات الحالية للتعاون المصري السوداني المعزز مدفوعة في المقام الأول ببعض التقديرات والاحتياجات الاستراتيجية العميقة الجذور، التي تواجه كلا البلدين، والتي تتسرب عبر المنطقة العربية الأوسع منذ الأيام الأولى للحرب الأخيرة في السودان. ويقال دائمًا إن مثل هذه الاحتياجات الاستراتيجية تجعل التعاون ذا أهمية قصوى، ويمكن القول إنها أكثر فعالية بكثير من الدوافع العاطفية المرصودة وراء التصريحات العلنية المستمرة والمواقف المتعجلة، التي لا نهاية لها على ما يبدو، والتي تميز العلاقات الدبلوماسية الدولية في كثير من الأحيان. وبالتالي، فإن الديناميات المتطورة بين مصر والسودان تستطيع أن تقدم دراسة حالة مثيرة للاهتمام حول كيفية تحول العلاقات التاريخية الراسخة إلى ضرورات استراتيجية في مواجهة التحديات المعاصرة.
السياق التاريخي للعلاقات:
يمكن إرجاع عمق الجذور التاريخية للعلاقات السودانية المصرية إلى العصور القديمة عندما لم تكن تعتبر منطقة وادي النيل؛ مصر وبلاد النوبة، مركزًا للعالم المعروف فحسب، بل تم الاحتفاء والاحتفال بها باعتبارها مهد الحضارة نفسها. وكانت مصدرًا رئيسًا لكل من التنوير العلمي والفكر الديني، وأثرت على العديد من المناطق خارج حدودها المعروفة آنذاك. وعلى الرغم من وسائل الاتصال البدائية المتاحة، كان هناك مدى لا يمكن إنكاره من التفاعل مع الأراضي والثقافات البعيدة، مما أرسى الأساس للعلاقات المستقبلية. في العصر الحديث، أصبحت ديناميات العلاقة بين السودان ومصر مسألة ذات أولوية كبيرة لكلا البلدين، ويرجع ذلك أساسًا إلى قربهما الجغرافي والطبيعة المتشابكة لتاريخهما. وقد عزز هذا التقارب المصالح المشتركة، التي تعود بالنفع على كل من مصر والسودان. ومع ذلك، فإن النسيج التاريخي الغني لم يؤد دائمًا إلى المستوى المتوقع من التعاون، أو التضامن بين البلدين. وغالبًا ما تأثر تطور علاقتهما بالشخصيات والمقاربات المختلفة للقادة الذين حكموا البلدين عبر التاريخ. وبالتالي، كانت هناك فترات لم تصل فيها حيوية وقوة علاقتهما إلى المستويات، التي قد توحي بها الفطرة السليمة والمنطق أنها قابلة للتحقيق. وتبرز أهمية العلاقات الدبلوماسية بين البلدان من خلال عمقها وأبعادها؛ وإن أهمية هذه العلاقات الدبلوماسية بين البلدان هو في وجوب تطورها باستمرار. ويميل البلدان، اللذين لهما تاريخ طويل من التفاعل والألفة دائمًا إلى توطيد علاقاتها بشكل أكثر اتساقًا. ولسنوات عديدة، كان من الممكن النظر إلى مصر والسودان على أنهما أمة واحدة تقريبا بسبب شريان الحياة المشترك لنهر النيل العظيم، الذي كان بمثابة رابط طبيعي لكلا الشعبين. ومع ذلك، ظل هذا المنظور ثابتًا إلى حد كبير فقط حتى منتصف القرن العشرين. ولكن، تظل العلاقة القائمة بين مصر والسودان لها خصائص فريدة تميزها عن الشراكات الأخرى. ومن الواضح أنه لا توجد مصالح مشتركة شبيهة تربط غيرهما من الدول ببعضها البعض، ومع ذلك فإن محيطها الجغرافي يضفي على التفاعل قيمة جوهرية جديرة بالملاحظة. وعلى الرغم من أن الروابط تتطور في مجالات حيوية مثل الزراعة والثقافة والأمن، إلا أن الروابط ليست متشابكة بإحكام كما قد يتوقع المرء نظرًا لقربها وتفاعلاتها التاريخية. وقد ساهمت مجموعة متنوعة من العوامل في هذا الافتقار إلى التقارب، بما في ذلك ما نُظِرَ إليه في بعض أحيانٍ مضت على أنه مواقف عدائية، والافتقار إلى مبادرات التنمية، والحد الأدنى من المشاركة، والندوب، التي خلفتها مختلف هذه المواقف؛ بما فيها اتهامات بدعم الفصائل المتعارضة، وبعض الروايات، التي تقوض المواقف الرسمية، والممارسات التمييزية، والتخلف عن الدعم الواجب في أوقات الحاجة، وحتى القضايا المحيطة بالنظرة المشتركة لتقاسم مياه النيل، كلها عناصر قد لا تبدو في كثير من الأحيان مرئية، لكن غالبًا ما يتم تضخيمها من قبل كل من الصديق والعدو على حد سواء. وقد أدى ذلك إلى فترات انهار فيها هدف التفاؤل بسبب عدم وجود أي تلميح إلى تقدم إيجابي، مما كان يدفع مرة أخرى إلى التشاؤم. وعمل البريطانيون على ضمان عدم استغلال مياه النيل في الأنشطة التجارية، أو العسكرية، وأغلقوا فرص الحصول على قنوات ملاحية حيوية على مدار العام تفيد كلا البلدين. وفي المشهد السياسي اليوم، يبدو أن إمبريالية “الطرف الثالث” قد تطورت، ووجهت الأحداث بطرق قد تكون أكثر دهاء من الهيمنة الصريحة السابقة، ولكنها مع ذلك تشكل أخطارًا كبيرة، إذ لا تزال الأهداف الرئيسة للدول القوية قائمة في الغالب. لذلك، من الأهمية بمكان أن يسعى السودان ومصر إلى تفاهم متبادل أعمق، لأن مثل هذا الفهم لن يخنق روح الإنجاز، بدلًا من ذلك، سيعزز الالتزام بتحقيق أهدافهما المشتركة عن طيب خاطر وفي الوقت المناسب. ومن خلال تبني التفاهم المتبادل، يمكن لهما أن يعملا على منع اللعب بنقاط ضعف بعضها البعض، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات وتهديد التعايش البشري في هذه المنطقة الحساسة. وسيساعد الأساس القائم على الوضوح والحقيقة على ضمان عدم تشويش الإجراءات والأحداث، التي تواجه البلدين بالمعلومات المضللة، التي يمكن أن تعطل الأساس الفاعل لوجودهما المشترك.
الأهمية الجيوسياسية:
إلى حد كبير جدًا، فإن المزايا المتعددة المرتبطة بإنشاء السودان، أربكتها تدخلات “الطرف الثالث”، الذي لم يكن متحمسًا لاستمرار الوحدة العضوية مع مصر، التي كان يعمل لصالحها “الحزب الاتحادي” وقاعدته “الختمية”، وتبنته مصر، في مقابل شعار “السودان للسودانيين”، الذي رفعه “حزب الأمة” ورافعته “الأنصار”، والذي دعمته بريطانيا بقوة ليؤسس للهوية لشخصية انفصالية كامنة في بعض شرائح المجتمع وتنتظر أن تتحقق بالكامل، وتُحْدِث الهوة العميقة، والتي تعاني من بعض عقابيلها العلاقة الآن. ولم يكن من قبيل الصدفة أن اتخذ الإنجليز الإجراءات، التي قاموا بها لصالح المفاصلة السودانية المصرية، لدرجة شجعت، أو ألجأت أطرافًا ممن تبنوا هذه المفاصلة إلى “طرفٍ ثالثٍ” آخر هو إسرائيل لدعمهم في أول انتخابات مع فجر الاستقلال، وهي حادثة وَثَّقَ لها البروفسير غبريال ووربيرج في مجلة “دراسات الشرق الأوسط”، التي صدرت في بريطانيا في أوائل ستينيات القرن الماضي، وأسهب في شرحها الدكتور محمود حارب في كتاب بعنوان: “التدخل الإسرائيلي في السودان”. ومثلت أفعال هذه الأطراف الفصل الأخير في السباق المحتدم بين مصر والإمبراطورية البريطانية خلال لحظات موت الخلافة العثمانية، وكلاهما كان يسعى للسيطرة على المناطق الاستراتيجية في شمال وشرق إفريقيا. ولم تحتو هذه المنطقة الحيوية على مخازن الحبوب المستقبلية وحقول القطن الضرورية للنمو الاقتصادي فحسب، بل احتوت أيضًا على البنية التحتية الضرورية والاستثمارات الكبيرة والنقاط الجغرافية الرئيسة مثل قناة السويس. وكانت قناة السويس، على وجه الخصوص، تتمتع بالقدرة على الهيمنة على طرق الاتصال، التي تربط أوروبا بالهند والشرق الأقصى، مما يجعلها رصيدًا لا غنى عنه. وفي المناطق غير المطورة إلى حد كبير، وعدت المناطق النائية السودانية والأوغندية بأن تصبح نقطة محورية للطاقة المولدة حديثًا في شمال أفريقيا. ويمكن أن تؤدي هذه الإمكانات إلى مستقبل يكون مستقلًا سياسيًا ومزدهرًا اقتصاديًا، وهي رؤية تقود تطلعات المنطقة؛ كانت وما تزال.
لهذا، يمكن توجيه هذه الطاقة المحتملة بشكل استراتيجي نحو البناء الطموح لحزام ليبي – مصري – سوداني، الذي سيكون لديه القدرة على الوقوف على قدميه بشكل مستقل. ويمكن لهذا الحزام الاقتصادي الحيوي أن ينخرط في التجارة مع التجمعات الصناعية الديناميكية في بلاد الشام والخليج العربي الغني والمحيط الهندي المتنوع. ومع ذلك، فإنها رؤية لن تخدم أسيادها الأجانب من “الأطراف الثالثة” إلا بدرجة محدودة، تمليها مصالحها الخاصة في المجال الجوهري. وكما سيتم الكشف عنه لاحقًا في هذا المبحث المتعمق، فإن قادة بارزين مثل عبد الناصر والقذافي والنميري، إلى جانب القوى السياسية السودانية والمصرية، قد تنافسوا بشدة وأهدروا الخيارات الاستراتيجية، التي وضعها العثمانيون بعناية واقترحوها لجزء كبير من رعاياهم. وقد أظهر هؤلاء القادة عدم رغبتهم في أي تفاهم، أو تعاون ذي مغزى بين مصر والسودان وليبيا. ونتيجة لذلك، فإن الدعم الحاسم الضروري للتنمية المستدامة لخط قوي ودائم بين النواة العربية والسعة الأفريقية كان غائبًا بشكل صارخ، ويفتقر إليه الآن بشدة.
العلاقات الاقتصادية:
يعزز تصورنا علاقة متبادلة شاملة قائمة على ما هو موجود من أدبيات تستهدف الربط بين التعاون السياسي الثنائي والبعد الاقتصادي، وننظر بدقة بأن الأمن له تأثير كبير ومباشر على العلاقات الاقتصادية بين الدول. ومع ذلك، فإن هذا التصور، الذي يُركز بشكل خاص على السودان ومصر، والذي يتماشى بشكل جيد مع الوضع، الذي ندرسه أثبت في نهاية المطاف أنه مجرد توضيح لهذه الحاجة إلى فهم أعمق. وعلى الرغم من هذا الرفض للفرضية العامة المتعلقة بالصلة بين الروابط الأمنية والاقتصادية، لا تزال هناك مجالات عديدة يمكن لكلا البلدين أن يستغلا فيها إمكاناتهما الجماعية بشكل فعال لتحقيق المنفعة المتبادلة. لذلك، من الضروري في هذا المنعطف أن نعتمد سياسات تتمحور حول الناس، بدلًا من الاعتماد فقط على الأساليب اللوجستية والسياسات والإجراءات التقليدية. وتمثل هذه الفترة بالذات لحظة حكمة كبيرة، يجب الاستفادة منها لإيجاد حل مستدام ودائم لجميع القضايا العالقة القائمة حاليًا، مما يضمن في نهاية المطاف شراكة اقتصادية قوية من خلال التعزيز النشط للتجارة بينهما وحمايتها وتيسيرها. ومن الأفضل لصناع القرار السياسي في كل من القاهرة والخرطوم أن يعترفوا بأنه من مصلحتهم المشتركة المتبادلة إزالة الغيوم المجازية، التي لطالما غطت علاقاتهما الثنائية. ومن شأن القيام بذلك أن يساعد إلى حد كبير في رعاية “اللحظة الاستراتيجية”، التي تنعكس حاليًا في التقارب الملحوظ والنادر، الذي يحدث في المشهد السياسي للبلدين المضيفين لمصالح وحاجات بعضهما.
ونعلم أنه عندما تصبح العلاقة بين السودان ومصر مشوشة سياسيًا، تنشأ عواقب عديدة، مما يؤدي إلى حرمانٍ كبيرٍ من الفوائد المحتملة، التي يمكن تسخيرها. فتاريخيًا، دعت مصر والسودان، اللتان تشتركان في ماض معقد ومتشابك، غيرهما ذات مرة إلى مقايضة سياسية تهدف إلى تعزيز الروابط في جميع أنحاء العالم العربي. ويكشف المناخ السياسي المعاصر عن وضع تطالب فيه القوات المسلحة السودانية بقوة يحكم شؤون الأمة، بالتوازي مع رغبات المصريين، الذين يرددون دعوات مماثلة في ظل ظهور قادة جدد في مصر بعد ثورة 2011. ويعكس هذا الدفع من أجل الحكم القوي الرغبة الأوسع في الإصلاحات السياسية والاقتصادية في كلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد عضوية مصر في المجلس الأفروآسيوي للتجارة الخارجية على موقعها الاستراتيجي، مما يجعل الغرفة في القاهرة حاسمة لإنشاء مجالس أعمال مشتركة يمكن أن تسهل تعزيز التعاون في عدد لا يحصى من القضايا. وهذا يمكن أن يمهد الطريق لمعالجة وإزالة أي عقبات تعوق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز بيئة مواتية للتجارة والتعاون. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الشراكة المعززة بين مصر والسودان في هذا السياق إلى زيادة التركيز على تسهيل وتعزيز المزيد من أنشطة التجسير بين البلدين. ومن خلال التخفيف من الأجواء المشحونة سياسيًا في السودان، التي تؤثر حاليًا على التفاعلات الاقتصادية، يمكن لكل من مصر والسودان توجيه طاقتهما بشكل فعال لدراسة الفرص الوفيرة للتعاون الاقتصادي المتبادل الموجودة.
الروابط الثقافية والتراث المشترك:
شهدت المشاركة في برامج إدارة التراث زيادة ملحوظة، لا سيما وأن العديد من المؤسسات بدأت تنظر إلى مسؤولياتها في الحفاظ على هذا التراث على أنه جزء لا يتجزأ من جهود خدمة العملاء من المواطنين والسياح. وتسعى هذه المؤسسات بنشاط إلى إقامة شراكات فيما بينها، مما يسهل في النهاية فرص التواصل ووضع معايير تهدف إلى تعزيز الحفاظ على التراث. بالإضافة إلى ذلك، تسعى هذه المؤسسات جاهدة لتحسين نشر المعلومات الحيوية مع دعم تطوير المعرفة وكذلك أفضل الممارسات في حماية المواقع التراثية. ويبرز السودان، على وجه الخصوص، كبلد مهم يستضيف مجموعة لا مثيل لها من المعالم الأثرية، ويضم أكثر من 750 موقعًا غنيًا بالتاريخ القديم، التي لا مثيل لها من قبل أي دولة أخرى في جميع أنحاء العالم، مما يسلط الضوء على الأهمية الأثرية الرائعة للبلدين. ويمكن تحويل تطوير مثل هذه العلاقات بسهولة إلى فهم أعمق إذا أعربت الحكومتان عن استعدادهما الحقيقي للانخراط مع بعضهما البعض والعمل بنشاط لحل القضايا المختلفة، التي تعيق التعاون الثقافي حاليًا. وهذه المشاركة الثقافية، جنبًا إلى جنب مع التبادلات التعليمية والأكاديمية، لديها القدرة على تعزيز العلاقات الثنائية بشكل كبير وتعزيز فهم أكبر لوجهات النظر الفريدة، التي يمتلكها كل منهما. ويمكن أن تلعب هذه الجهود دورًا حاسمًا في معالجة التعقيدات وسوء الفهم المعاصرين اللذين غالبًا ما يتغلغلان في بعض الخطاب الحالي. وتكمن أهمية هذه المبادرات في إدراك أن الأهمية المتزايدة للقضايا الثقافية في الإطار الأوسع للمناقشات المتعلقة بالحقوق الثقافية تمثل اتجاها واسع الانتشار. ويدعو هذا الاتجاه إلى فهمٍ أكثر عمقًا ودقة لكيفية نسج الثقافة بشكل جوهري في المفاوضات العامة والصراعات المختلفة، التي تمر بها بلدان معينة. ومن خلال تعزيز هذا الفهم، يمكن لأصحاب المصلحة التنقل بشكل أفضل في التفاعل المعقد بين التراث والثقافة والحقوق في المشهد العالمي اليوم.
المناخ السياسي الحالي في السودان:
يواجه السودان حاليًا لحظة حساسة للغاية من الناحية السياسية وحاسمة في تاريخه من الناحية الأمنية. والوضع داخل البلاد ليس معقدًا فحسب، بل يتسم بمواجهة عسكرية حادة وصراعات سياسية مستمرة على السلطة. ففي مرحلة ما من الجدول الزمني الأخير للبلاد، انتقلت إلى نظام تعددي لتقاسم السلطة تميز بإنشاء مجلس سيادة مشترك. وتم هيكلة هذا المجلس بحيث كان يقوده في المقام الأول شخصيات عسكرية، بينما كان في الوقت نفسه رئيس وزراء مدني على رأسه يشرف على المجلس التنفيذي الأعلى. علاوة على ذلك، كانت الحكومة مدعومة من قبل مجموعة تكنوقراط كبيرة لم يتم فيها تمثيل جميع المكونات المختلفة لقوى المعارضة، إلى جانب الجهات الفاعلة القوية في الدولة، التي تسعى جاهدة من أجل نظام حكم أكثر شمولًا. فيما تقاعس الجميع عن اختيار أعضاء المجلس التشريعي ليعكس النسيج السياسي والمجتمعي المتنوع للسودان. ومع ذلك، في منعطف آخر، تطورت المواجهة إلى صراع بين المكونات المختلفة، فيما “قوى الحرية والتغيير – قحت”، التي اصطدمت مع العناصر المتبقية من النظام القديم. ومع تصاعد التوترات، بدأ تحالف عسكري بين مليشيا “قوات الدعم السريع”، وتجمع مدني يعرف باسم “المجلس المركزي” لقحت، الذي تطور لاحقًا لما عُرِفَ بـ”تنسيقية القوى التقدمية المدنية – تقدم” يحل محل النظام السياسي، الذي كان قائمًا، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة. وخلقت هذه القضية المستمرة ساحة معركة تتعلق بصنع القرار، لا سيما بين المجلس السيادي والسلطة التنفيذية والحكومة نفسها، حيث كان يتنافس كل كيان على النفوذ والسلطة. وقد تقدم التوتر في ذلك الوقت ليدور حول ما نُظِرَ إليه كقضية ملحة متمثلة في تنفيذ الإصلاحات السياسية والقضائية والإعلامية الأساسية في البلاد. وتمسكت قحت بأن هذه الإصلاحات حاسمة، لأنها تشكل العمود الفقري الأساس للثورة السودانية، التي دعت إلى تغييرات شاملة وإعادة اختراع المشهد السياسي والاجتماعي في السودان. ومع توقف مناقشة هذه التحولات ومتابعتها، واندلاع الحرب، لا تزال البلاد على حافة تحول محوري يمكن أن يحدد مستقبلها.
أدى مزيج هذا التدخل في عمل السلطة ومختلف المجالات، للأسف، إلى انخفاض كبير في مستوى تحقيق الأحلام الكبيرة والصغيرة، التي كان يحملها الشعب السوداني أثناء الثورة وبعدها. وكنتيجة مباشرة، بدأ الرضا الشعبي عن القوائم المتطورة للوضع السياسي في الانخفاض باطراد. إلى جانب ذلك، انتشر شعور بالإحباط واليأس على نطاق واسع نتيجة لتراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية الحرجة. وتشمل هذه المؤشرات الانخفاض المقلق في قيمة العملة المحلية، والمضاربة المتفشية، والنقص الحاد، والتضخم المتفشي، وتصاعد موجة البطالة. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص نظرا لأن الحكومة الحالية تقترب من الانتهاء من عامها الأول في السلطة، في حين أن مطالب المواطنين لا تزال واضحة تماما: ضرورة التنفيذ الناجح للشعارات المعلنة سابقا، وتوفير الخدمات الأساسية، والحد الحقيقي من الفساد، الذي ابتلي به النظام. علاوة على ذلك، فإن قرارات اللجان العديدة الصادرة عن الحكومة، إلى جانب الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية المفرطة، لم تؤد إلا إلى تفاقم القضايا المطروحة حتى وصلت إلى حالة الهشاشة وعدم الاستقرار الحالية.
المناخ السياسي في مصر:
يتميز أداء النظام الحاكم الحالي في مصر بدرجة عالية من الفاعلية، التي لا تخلو من “براجماتية”، وذلك لتعامله مع شبكة معقدة، ولكنها منسوجة بإحكام، من العلاقات الإقليمية والدولية، التي تحيط بالبلاد حاليًا. فبعد تأمين السلطة السياسية والاقتصادية في أعقاب الثورة، دعم الجيش الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناورة مهمة لوضع حد، لما اعتقدوه أنه سيولة سياسية، أعقبت الانتخابات، ورأوا أنها كان يمكن أن تخلق أزمات أمنية لا تُحمَد عُقْبَاها. ومنذ ذلك الحين، سعى الرئيس السيسي بنشاط إلى ترتيب نوع من السياسية غير التقليدية من خلال استراتيجية إعلامية شديدة التركيز، وموجة مستمرة من الخطاب الوطني، الذي صعده عبر شعارات؛ مثل “تحيا مصر”. والآن، بعد ما يقرب من تسع سنوات وثلاث انتخابات، يجد السيسي نفسه يركز بشكل متزايد على اتخاذ احتياطات مكثفة لمنع تكرار التوترات، التي شهدتها فترة الرئيس السابق حسني مبارك. وفي الوقت الحاضر، تجري عملية إعادة ترتيب كبيرة للمجتمع المدني، تشمل ضوابط على فاعلية منظمات المجتمع المدني وإشراف على عمليات وسائط الإعلام. ويشير النجاح الواضح لاستراتيجية هذه الترتيبات، التي تم تنفيذها حديثًا إلى أن عكس السياسة أمر غير مرجح تمامًا في المستقبل المنظور، حيث تواصل جهودها في استكمال مشاريع البنيات التحتية، وتحكم الدولة في معالجة اختلالات الاقتصاد.
لقد تمتعت مجموعة من هذه المشاريع، وما رافقها من إصلاحات هيكلية بشكل ملحوظ، بدعم ثابت من مختلف الجهات الفاعلة الدولية، التي تميل، في نهجها الاستراتيجي، إلى إعطاء الأولوية للحفاظ على الاستقرار السياسي. ومن بين هؤلاء المؤيدين الدوليين حليفة مصر الأمنية منذ فترة طويلة، الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تلتزم بالمعايير الراسخة للعلاقات التاريخية بين البلدين. وجاء هذا التوقع في أعقاب التغيير الكبير في الحزب السياسي، الذي تولى مسؤولية السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن الكونجرس يسيطر عليه الآن حزب سياسي يدعي صراحة أنه يعطي الأولوية للقيم الأمريكية الأساسية. وفي ضوء ذلك، قام كلاهما بمحاولات تقييد ما كانت تقدمه واشنطن من تمويل لعدد من دول المنطقة. حتى الاتحاد الأوروبي قدم دعمه السياسي لنظام السيسي، وقدم تعزيزات مالية سخية تزيد من تعزيز هذا التحالف. عندما يتعلق الأمر بالدول الغربية مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، فإن دعمها لمصر غالبًا ما يكون مبررًا باسم أمنها هذه الدول الداخلي، وجهود القاهرة في كبح جماح الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وقد تعزز هذا الموقف من خلال المواجهات الاستراتيجية العرضية في مجالات حيوية أخرى؛ مثل الطاقة، أو التمويل، أو حتى جهود مكافحة أسباب الاحتباس الحراري. وفي هذا السياق، اتخذت أدوارهم بعدًا أكبر وأتاحت فرصة للتأكيد على الحاجة إلى محاولة المطالبة بإدخال تحسينات ملموسة على حالة الإجراءات المرتبطة بهذه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تأثير النزاعات الإقليمية على العلاقات:
من المؤكد أن من شأن الإدارة الفعالة للصراعات الداخلية المعقدة في السودان وحلها أن تسهم بشكل كبير في تحسين العلاقات السودانية المصرية. ولا يقتصر هذا التعزيز على أن التركيز والاهتمام سيبتعدان عن الصراعات المستمرة القائمة على الهوية، التي أثرت سلبًا على العلاقات الثنائية لعقود عديدة. والأهم من ذلك، أنه في أعقاب عهد الرؤيس السابق عمر حسن أحمد البشير، إذا تمكن السودان من اجتياز هذا الانتقال بنجاح، فلديه القدرة على تقديم نموذج قوي لدولة شقيقة وفعالة يمكن لمصر أن تنظر إليها كنقطة مرجعية لمعالجة قضاياهما الخاصة مع دخولها المرحلة الصعبة من حقبة ما بعد بناء “سد النهضة”. فالوضع مثير للاهتمام، حيث ينطوي النهج الحالي لمصر في إدارة الشؤون السياسية وشؤون الدولة بشكل كبير على دور مشترك مع الخرطوم والعمل معًا لمجابهة الطريقة، التي بنت بها إثيوبيا فكرة هذا السد كجزء من هويتها الوطنية وهياكل الحكم. ومع ذلك، هناك تحد أساس وكبير ينتظر حكومتي السودان ومصر لتحقيق هذا الهدف المشترك، الذي يستلزم التخلي التام عن بنى التفكير الفردي فيما يتعلق بالمياه، وصياغة استراتيجية موحدة، للحفاظ على حقوقهما المكتسبة تاريخيًا.
وبالنظر إلى الرابطة الفريدة والتاريخية، التي تطورت بمرور الوقت بين القاهرة والخرطوم، فمن المرجح جدًا أن تتوقع مصر وربما تطالب بمشاركة خاصة ونشطة في حل أي صراع داخلي سوداني قد ينشأ. وهذا التوقع متجذر في علاقة طويلة الأمد يشترك فيها كلا البلدين. وهذا دور يشعر العديد من المواطنين السودانيين بأنه حق لهم من جارتهم القوية، مدفوعًا بالاعتقاد بأن مثل هذا الانخراط من قبل مصر يعود بالنفع عليهما معًا، ومفيد ولاستقرار المنطقة. وحتى تلك الأصوات في السودان، لا سيما داخل المجتمع متطرفي اليمين واليسار، التي تنتقد ما تعتبره مصلحة مصرية ثابتة، وربما مبالغ فيها، فيما يجادلون بأنه شأن سوداني واضح، يجب أن تدرك أن لديها خيارات محدودة للغاية عندما يتعلق الأمر بالتأثير على قدرة أيٍ من الحكومتين، أو استعدادهما لتغيير هذا التركيز الجيوستراتيجي. وبناء على ذلك، وبالنسبة لمجموعة متنوعة من العوامل التشغيلية المفيدة والعملية والمنطقية، فإن أية مبادرة محتملة في سياق المشهد السياسي في السودان من المرجح أن تكون مُتَقَبِّلَة تمامًا للمقترحات والطلبات المصرية لمشاريع مشتركة تعاونية أوسع نطاقًا يمكن أن تعزز المصالح المتبادلة في المنطقة.
الأمن المائي ونزاع النيل:
وخلال زيارته إلى الخرطوم في أبريل 1960، قبيل الفترة الحاسمة، التي تحيط باتفاق مياه النيل، وبينما كانت المفاوضات التفصيلية تجري قبل إصدار الاتفاق، طرح السير هوبرت مايلز، الذي كان يعمل آنذاك مستشارًا للوفد السوداني، سؤالًا هامًا على كبير المفاوضين السودانيين؛ إسماعيل الأزهري. وتساءل عن كيفية رد الأزهري على الشكوك الحقيقية السائدة في مصر بشأن الدفاعات، التي تم إنشاؤها بموجب بنود الاتفاق. ورد الأزهري بتفكير قائلًا: “لماذا يتحدث المرء عن الشك الحقيقي؟ لا أحد يتحدث عن ثقة حقيقية؛ بهذه الروح، تم إبرام اتفاقية مياه النيل، التي كانت ذات أهمية كبيرة لكلا البلدين، في نهاية المطاف وتوقيعها في 8 نوفمبر 1959، مما يمثل لحظة محورية في علاقاتهما. بعد ذلك، قام وفد مصري بزيارة أخرى إلى السودان لتناول مختلف النقاط المتعلقة بالاتفاق العسكري السوداني المصري العملياتي والاستراتيجي. وخلال هذه الزيارة ركزوا على تحصين ضفاف النهر بالأقفال والمنشآت الدفاعية المختلفة وفقًا لحقوق الجانبين بموجب اتفاقية مياه النيل، حيث يذكر أنه تم إيلاء كل الاحترام الواجب للجانب المصري خلال المناقشات والعمليات التعاونية.
لهذا، فإن التأكيد الأول هو أن اتفاقية مياه النيل تتفق بالفعل تمامًا مع القانون المدني المصري لعام 1952، وما أعقبها من قوانين سودانية، فيما يتعلق بإدارة الأنهار وحقوقها، مما يجعلها إطارًا قانونيًا ودبلوماسيًا مهمًا لكلا البلدين المعنيين. وإذا كان المفهوم الأساس، الذي تقوم عليه صيغة النيل، الذي يدعم الحق الكامل والشرعي لكل من السودان ومصر في تخزين المياه، جزئيًا في السد العالي في أسوان وكليًا داخل السد العالي السوداني، لا يتفق مع المادة، أو المواد المحددة من القانون المدني في كليهما، فمن المنطقي أنه لم يكن من الممكن السماح ببناء السد نفسه بالمضي قدمًا تحت أي إطار قانوني، أو تنظيمي. لذلك، فإنه يقدم نقطة مثيرة للاهتمام، وهي أنه ربما لم تلخص خلافة الجانبين، حيث يعمل كل طرف كوارث للممارسات التاريخية لأسلافهما معًا، مجمل ما عبر عنه ممثلوهم، أو روح الاتفاقات المبرمة. فقد انخرط كلا البلدين في عملية دقيقة لتخزين الموارد المائية الثمينة، التي تم قياسها بدقة بواسطة نقاط القياس، وتحكمها قيود الوقت، وبالتالي ضمان تحديد حقوقهما ومسؤولياتهما وفهمها بوضوح. ولا يقتصر هذا التوازن المعقد على الإدارة الفنية للموارد المائية فحسب، بل يشمل أيضًا احترامًا أعمق للعلاقة التاريخية، التي تشترك فيها كلا البلدين مع نهر النيل نفسه.
دور القوى الخارجية “الأطراف الثالثة”:
يمكن فهم العلاقات السودانية المصرية من خلال ثلاث طبقات متميزة، ولكنها مترابطة. أولًا، من الضروري الاعتراف بأن الدولتين تشتركان في مجموعة كبيرة من المصالح المشتركة، التي نشأت على مدى تاريخ طويل يتسم بالتعاون الواسع. وتشكل هذه الخلفية التاريخية أساسًا متينًا للتعاون في المستقبل، والمجالات، التي لا يكون فيها التعاون ممكنًا فحسب، بل مفيدة للغاية هي في الواقع مجالات كبيرة ومتنوعة. ثانيًا، تمتلك النخبة السياسية في كل من السودان ومصر مصلحة راسخة في الاستفادة بشكل فعال من هذه المجالات ذات المصالح المشتركة لصالحهما المشترك. وتساعد رغبتهما في تعظيم الفوائد المستمدة من هذه العلاقات على ضمان بقاء العلاقات السودانية المصرية قوية وقابلة للتكيف. وطالما أن هناك مزايا اقتصادية وسياسية ملموسة تعزز مصالح بعضها البعض، فمن المرجح أن تستمر العلاقات بين السودان ومصر، قادرة على تحمل مختلف الضغوط والتحديات الخطيرة، التي قد تنشأ. علاوة على ذلك، يوفر تعقيد وثراء العلاقات المصرية السودانية ما يكفي من التنوع والعمق بحيث يمكن لمراكز التعاون القوية، إلى حد كبير، التخفيف من الآثار الضارة للأزمات السياسية الحادة، التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. وتسلط هذه الشبكة المعقدة من التفاعلات الضوء على المرونة والأهمية الاستراتيجية لعلاقتهما.
ولهذا، تكمن إحدى الإجابات المهمة للأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة، التي تشكل باستمرار الديناميات المعقدة للعلاقات السودانية المصرية في الدور المؤثر والجوهري في كثير من الأحيان للقوى الخارجية، أو ما نُشير إليه بـ”الأطراف الثالثة”. وتحتفظ كل من مصر والسودان بمجموعة متنوعة من الحلفاء والعملاء الذين يشاركون بنشاط في تشكيل المشهد الجيوسياسي المتطور باستمرار. وغالبًا ما تساهم شبكات الدعم المعقدة هذه في تصعيد، أو زيادة تفاقم الأوضاع المتكررة بالفعل والعميقة للغاية، التي تواجهها كلا البلدين، مما يزيد من الأعباء الثقيلة بالفعل، التي يجب أن يتحملها كل منهما. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه القوى الخارجية تمتلك القدرة على لعب دور إيجابي وتحويلي في الغالب في تعزيز الاستقرار والتعاون والسلام في المنطقة. بالإضافة إلى الدول المؤثرة مثل الولايات المتحدة وغيرها من اللاعبين الرئيسيين على المسرح العالمي، فإن العديد من الدول في جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك الجزائر، لديها مصلحة راسخة في تعزيز السلام والتفاهم المتبادل والتعاون الاقتصادي طويل الأمد بين مصر والسودان. وسيتعمق هذا التحليل في النظر إلى الدور المحوري، الذي تلعبه هذه “الأطراف الثالثة” في تحديد مستقبل جهود صنع السلام ومبادرات بناء السلام بين مصر والسودان، أو الإضرار بها كما حدث في انفصال جنوب السودان، والمساعدة في بناء “سد النهضة”، وحتى التحريض والدعم للحرب، التي تجري الآن في السودان. وبينما سنستكشف بمزيد من التفصيل بعض هذه التحديات، فإن العديد من الخيرين من هذه “الأطراف” تشترك في نفس الأهداف والتطلعات، وتشكل تحالفًا من نوع ما مكرس للحل السلمي للصراعات. ومن الأهمية بمكان الاعتراف بأن تحقيق السلام أمر بالغ الأهمية ليس فقط للاستقرار الداخلي في مصر والسودان، ولكن أيضًا للاستقرار الشامل في المنطقة العربية والأفريقية الأوسع. ويمثل هذا الاستقرار أساس القوة والوحدة للدول العربية والأفريقية، وهو أمر ضروري للتغلب على التحديات المعقدة، التي تنتظر جميع الدول المعنية.
الاتفاقيات التجارية والتعاون الاقتصادي:
ما يدعو للأسف أنه في كثير من الأحيان لم يكن هناك حِراك كبير، أو قوة دافعة ذات نُظمٍ مأسسة ومستدامة بين الشعبين، خاصة في الظروف، التي تضع فيها الحكومتين قوانين مختلفة، وتقدم تدابير جديدة، وتتدخل بنشاط في الحركة والتجارة. وعواقب بعض هذه الإجراءات والمواقف على التجارة عديدة وواسعة الانتشار، وتؤثر على جوانب مختلفة من الاقتصاد. وأشار مواطن فضولي أثناء تعليقه على الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين إلى أن بلاده “لا تتضرر. يداها غير مقيدتين”. لذلك، فإن مخاوف الأطراف المعنية ليست ببساطة بنفس الدرجة، وبالتالي يظهر تفاوت في مستوى القلق. ويجب أن نكون واقعيين في نهجنا وألا نقدم مطالب غير واقعية لا يمكن إلا أن تؤدي إلى تحريف قبضة ما نملكه وبالتالي إضعاف من حولنا. من غير المعروف على نطاق واسع أنه من خلال استخدام سياسات معينة، فإن ما تخسره مصر أو السودان قد لا يكون أكبر مما قد يكسبه أيًا منهما في المستقبل. ولذلك، ينصب التركيز في المقام الأول على ما تفقدانه بالفعل في الوقت الحاضر. ومع ذلك، لا يوجد لهما طريق بديل حقًا لإيجاد مخرج إذا لم تتوقفا عن فرض الصفقة الحالية، التي تهدف فقط إلى توسيع نفوذ كل منهما على دائرته الخاصة في المنطقة ودينامياتها. والأهم من ذلك، يتعين على مصر والسودان أن يتخليا تمامًا عن عدم الاستعداد المشترك لمجابهة الخطر الوشيك، الذي تمثله الدول المجاورة والتحديات، التي تمثلها على مصالح البلدين الحيوية، وما “سد النهضة” إلا نموذج قد يتكرر. ولا يعني ذلك عدم وجود مشاركة في التفاعلات بين الاقتصادين، إلا أن هذا الانخراط محدود ومقيد، ويتطلب إطارًا أوسع وأكثر شمولًا لا يمكن إنشاؤه إلا بما يمكن من استيعاب نطاق وحجم المشاريع الكبيرة، بدلًا من العمل في ظل عقود صغيرة محدودة لا تؤدي إلا إلى تفاقم جدل الصراعات والمناقشات التجارية المستمرة.
إن شعبي البلدين لا يتخطيان حواجز شديدة تمنعهما حقًا من الانخراط مع بعضهما البعض، بل عليهما تعزيز ما هو إيجابي، والقفز فوق ما يكبح الطموحات المشروعة للجانبين، إذ لا تحتاج مصر والسودان إلى قواعد، أو منصات جديدة لرأس المال الاستثماري في هذه اللحظة. بدلًا من ذلك، يحتاج البلدان إلى مجالات من المشاريع الكبيرة والمتكاملة تمامًا، التي يمكن أن تنشط الاقتصاد، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار في السودان. باختصار، لا يوجد ما يكفي من رأس المال داخل الاقتصادين لاستكمال بعضهما البعض بشكل سلبي، حيث يجب أن ينصب التركيز على التعاون والنمو المتبادل. وهناك قواعد، أو شروط معينة، يمكن ويجب فرضها على الشعبين حتى يتمكنوا من تفسير الفرص الموجودة بينهما بشكل أفضل بشكل افتراضي وواقعي. وهذا يتجاوز مجرد مناقشة ما يمكن السماح به في أسهمهم المالية واستثماراتهم الاقتصادية. وفي ظروف الأزمة، غالبًا هناك من يلعبون دورًا سلبيًا في تحديد ما ينظر إليه على أنه مرير، أو غير موات بالنسبة لهم، مما يعني في النهاية الفشل المستمر في إعادة تشغيل الشراكات الجادة بشكل فعال بين الشركات التجارية الكبرى، التي يمكن أن تزدهر لولا ذلك. وقد تكون هناك تقارير واردة من مختلف المنظمات والوسطاء التجاريين حول مستقبل رأس المال الاستثماري المتدفق من مصر إلى السودان، أو العكس، ومع ذلك فإن هذه المنظورات أكثر بساطة في توقعاتها مما كان متوقعًا بالفعل. لذلك، فإن تراكم العديد من التقديرات القاتمة على المعلومات السماعية أمر يجب معالجته بمزيد من الإلحاح والجدية على تكثيف نشر المعرفة الصحيحة. وحتى يتحقق ذلك، فلن يهتم المصريون بمناقشة مستقبلهم في السوق السودانية بصدق إلا إذا كانت الأرقام المالية تتماشى مع قدراتهم وطموحاتهم كشركات أجنبية، وكذلك السودانيين بالنسبة لأسواق مصر. ولذلك، فمن الأهمية بمكان أن يعيد كلا البلدين تقييم الإمكانات، التي لديهما في تعزيز علاقة اقتصادية أعمق لا تفيد أسواقهما فحسب، بل تعزز أيضًا التكامل الاقتصادي الإقليمي، الذي يمكن أن يؤدي إلى الازدهار المشترك.
التعاون العسكري والتحالفات الأمنية:
لقد حان الوقت لأن ننظر حول جدوى الموضوع الأساس للتعاون السوداني المصري، مع التركيز بشكل خاص على نصف الحالة الحاضرة الأكثر دلالة، التي تشمل التحالف الاستراتيجي العسكري فيما يتعلق بالقيود المتأصلة. وفي هذا السياق المعقد والمتعدد الأوجه، يمكننا النظر في العديد من القضايا الحاسمة، التي يمكن توضيحها بشكل أكبر من أجل اكتساب فهم أعمق. وتشمل هذه المفاهيم والتصورات الاستراتيجية، التي تعلم طبيعة التحالف وتطوره بمرور الوقت، ونطاقات القدرات العسكرية، التي تمتلكها كل دولة وكيف يمكن دمج هذه القدرات بشكل فعال، ومن ثم، القيود المختلفة، التي يجب موازنتها بعناية مقابل إمكانات التحالف في التخطيط العملياتي، والتي يمكن أن يكون لها تداعيات إيجابية كبيرة على الاستقرار الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري فحص التدفق المستمر للأسلحة والمعدات بين البلدين، والسلوك العملياتي، الذي تظهره قواتهما العسكرية في الأنشطة المشتركة، إلى جانب مجموعة التدريبات العسكرية، التي يشاركون فيها معًا، والقيود، أو الروابط السياسية والثقافية والجغرافية الأوسع نطاقًا، التي تشكل التفاعلات في المجال العسكري. وتؤثر هذه العوامل مجتمعة على كل شيء من القرارات التكتيكية إلى الأطر الاستراتيجية طويلة الأجل، فضلًا عن الديناميات الأمنية الشاملة بين السودان ومصر، مما يؤثر على أدوارهما كلاعبين محوريين في المنطقة.
لذلك، فإن احتضان جميع هذه الاعتبارات الأساسية الست، وهي: المفاهيم الاستراتيجية والإدراك والمزاج؛ ومجموعة القدرات عمليات التخطيط التشغيلي؛ وديناميات تدفق الأسلحة والمعدات؛ وأحكام التدريب وآليات المساعدة؛ تقييمات الأداء التشغيلي؛ وتعقيدات السلوك التشغيلي، جنبًا إلى جنب مع القيود التنظيمية والسياسية وكذلك الإمكانات؛ والتعامل مع الأسلحة والعلاقات العسكرية في أيدي رئيس العمليات وصنع السياسات، كل ذلك مع عدم التظاهر بتغطيتها الكاملة. وفي هذا السياق، سيذهب التحليل السياسي العسكري إلى حد كبير للأسلحة والمساعدات العسكرية المقدمة للبلدين خلال فترات تاريخية مختلفة، بما في ذلك القوة النسبية لكل مؤسسة عسكرية تم تقييمها كميًا ونوعيًا. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من المناسب استكشاف مجال التعاون العسكري والعمليات المشتركة والتخطيط الدقيق خلال الفترات المختلفة، وكذلك فحص الأسلحة الأخرى وروابط المساعدات العسكرية المنسوجة في الثروات السياسية لكلا البلدين. لذلك، فإن مجال التعاون العسكري وتشكيل التحالفات العسكرية، كظواهر، إذا تم فحصها بموضوعية في ضوء آثارها الحالية وأهميتها الإقليمية، يمكن أن يسفر عن إرشادات ثاقبة فيما يتعلق بالخطوط العريضة المحتملة للاتجاهات المستقبلية، التي يمكن ملاحظتها في هذه العلاقة المعقدة. ورغم أن التحالفات العسكرية، قد تتجلى في العديد من الأشكال والأساليب العملياتية ومجالات المساعي المختلفة، إلا أنه لا يزال من الممكن الاعتراف بها، إذا تم التعامل معها بحذر لازم، على حقيقتها. وبالتالي، ولكن في هذا السياق فقط، يمكن تمييز هذه الرؤى والآمال، عند ترجمتها إلى المشهد العسكري، والاعتراف بها، وإلى حد تقريبي على الأقل، التنبؤ بها على أنها تنبثق من المنبع المشترك لهذه الظواهر العسكرية المترابطة، والسمات الأساسية، والمتطلبات الجوهرية، التي تقوم عليها.
التصور العام والهوية الوطنية:
تجذب العلاقة بين الرأي العام والهوية الوطنية حاليًا اهتماما وتركيزًا متزايدين في المجال الواسع لدراسة العلاقات الدولية، حيث إن التصورات، التي يحملها الجمهور لها آثار كبيرة على عملية صنع السياسات بأكملها. والتفاعل بين هذه المتغيرات الحاسمة معقد، وكذلك كيف يمكن لرأي الجمهور المتصور حول هوية البلد وأفعاله أن يؤثر بشكل كبير على النتائج الظرفية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يلعب هذا التفاعل دورًا حيويًا في تشكيل كل من التصورات المعرفية والمعيارية، التي تعكس المعتقدات والقيم الأساسية للسكان. ومن المؤكد أن التصورات، التي يحملها الجمهور فيما يتعلق بما إذا كانت الشعوب المختلفة، أو المجموعات المختلفة تتعايش بشكل متناغم في المجتمع ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد ديناميات العلاقات الشاملة بين الدول. ويجادل العلماء على نطاق واسع بأن التواصل الفعال مع الدولة يعمل كأداة أساسية وحيوية يمكن أن تساعد في استنباط مواقف واستجابات أكثر إيجابية من كل من الدوائر المحلية والجماهير الدولية على حد سواء. ويتم تحقيق هذه المشاركة الإيجابية من خلال قدرة الدولة على الإعلان بشكل جيد وشرح ثقافة الحكومة الفريدة والسياسات المتنوعة والمصالح الرئيسة بطريقة فريدة وجذابة. وهكذا يحتل الرأي العام وارتباطه بالهوية الوطنية مركز الصدارة في فهم العلاقات الدولية الحديثة اليوم.
لهذا، وعلى الرغم من المناقشات المتزايدة مؤخرًا حول هذا الموضوع، فإن العلاقة المعقدة بين الهوية الوطنية المعترضة للجمهور والمواقف تجاه البلدان والشعوب الأخرى لا تزال غير مفهومة جيدًا من قبل العديد من الباحثين والمراقبين على حد سواء. ويشمل هذا التفاعل المعقد والمتعدد الأوجه مجموعة واسعة من العوامل، التي تلعب دورًا حاسمًا في كيفية بناء البلدان المختلفة لهوياتها ورواياتها وسرديتها الوطنية وإدراكها لذاتها. كما أنه يمتد إلى العلاقات المعقدة الموجودة على المستوى العالمي، مما يؤثر على كيفية تفاعل الدول مع بعضها البعض على جبهات مختلفة. وتلعب الهوية، في هذا السياق من العلاقات الدولية، دورًا مهمًا في تشكيل الديناميات الصعبة القائمة. ويشمل ذلك التأثير على السلوك الاستراتيجي للشركات الدولية وكيفية عملها عبر الحدود سعيًا وراء الفرص، التي قد تنشأ. ونادرًا ما يمكن أن يحدث التعاون الحقيقي بين البلدان من دون أفراد من خلفيات ثقافية مشتركة يعبرون الحدود. ويجب ألا يكون هؤلاء الأفراد مستعدين فحسب، بل يجب أن يكونوا حريصين أيضًا على تحمل المخاطر المتبادلة لصالح كلا الطرفين المشاركين في التفاعل. بالإضافة إلى ذلك، تتأثر عمليات ونتائج مبادرات السياسة الخارجية بشكل كبير بالمواقف العامة السائدة حول كيفية إدراك التفاعلات بين الدول وصياغتها وإجرائها. علاوة على ذلك، تؤكد الدراسة على أن الهوية الإقليمية تعمل كفاعل تمييز حاسم عندما يتعلق الأمر بتشكيل تفضيلات السياسة الخارجية بين مختلف الدول. ويوضح هذا أهمية فهم كيفية تأثير الانتماءات الإقليمية على العلاقات الدولية وقرارات السياسة على نطاق أوسع. ومن خلال استكشاف هذه العوامل، نكتسب نظرة ثاقبة للدور الأساس، الذي تلعبه الهوية الوطنية والإدراك العام في عالم المتاهة الدبلوماسية الدولية والتبادلات بين الثقافات.
التحديات المستقبلية في العلاقات الثنائية:
ولنكون أكثر صراحة من أجل تنقية الأجواء لإحقاق كل ما تقدم ذِكره، وخلق بيئة لا تُخالط الملاحة في فضاءاتها المستقبلية أية مطبات حرِجَة، علينا تفكيك بعض عقد الحاضر بجرأة تحفظ لكل جانب حقه ومصالحه وماء وجهه. وأعني؛ فيما أعني، بعض متعلقات الحدود، التي أرجو مخلصًا ألا تكون موجودة إلا كمعابر للتواصل لا موانع لما فيه مصالح الطرفين. وعلى الرغم من إجراء جولتين من المفاوضات المباشرة بشأن النزاع الحدودي المعقد بين مصر والسودان منذ مطلع الألفية في عام 2000، إلا أنه لم يتم بعد التوقيع على اتفاق ملزم ونهائي يعالج هذه المسألة الحرجة؛ ببعديها الإداري والسيادي. فعلى مر السنين، أصبح السودان أكثر حرصًا واستباقية في رغبته في حل هذا النزاع المستمر، في حين تبنت مصر موقفًا يتسم بالمرونة حينًا، ويذهب أحيانًا إلى حد الرضا عن النفس بما تحقق، مما يعقد القدرة على التنبؤ بمدى سرعة حل هذه القضية الخلافية، أو إلى متى ستظل العلاقات الثنائية بين البلدين متوترة بسببها. فالمنطق السليم يقول إنه إذا لم يتم الاتفاق على حلول ودية قائمة على الإجماع لمثل هذه التحديات العالقة، فإن المناخ المحيط بالعلاقات الثنائية، فضلًا عن العلاقات المجتمعية طويلة الأمد بين البلدين، سوف يعوق حتمًا، وربما يتعرض لضغوط كبيرة يتسلل عبرها “الطرف الثالث”، الذي لا ينبغي أن تُتاح له فرصة يغتنمها بين شؤون العائلة الواحدة في السودان ومصر. وعلى الرغم من أن هذا النزاع الحدودي، الذي لم يتم حله بين البلدين الجارين هو العامل الأكثر أهمية، الذي أعاق ويعوق إقامة علاقات قوية وتحصينها، إلا أن عددًا من التحديات الملحة الأخرى تحتاج أيضًا إلى معالجة بذكاء من أجل تعزيز شراكة أكثر انسجامًا واستدامة. ومن أهم هذه التحديات إبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في قضايا الموارد المائية، ومعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بسياسات منطقة البحر الأحمر، والانخراط في مناقشات بناءة حول الاتهامات المتبادلة، التي قد تطرأ، والتي نشأت في ضوء مراحل سوء الفهم في العلاقات السودانية المصرية. فكل هذه المشاكل العالقة والمخاوف، التي لم يتم حلها ستؤثر بشكل كبير على العلاقات بين مصر والسودان؛ ليس فقط في نافذة الفرص السياسية الحالية القائمة، ولكن أيضًا على القضايا الإقليمية الأوسع، التي يمكن أن تؤثر على مسار العلاقات الدولية. وتحتاج حكومتي البلدين، بوصفهما مؤسستين وطنيتين رئيسيتين، إلى التعزيز والتعزيز من خلال الارتباطات والمبادرات بخلاف ما سبقت الإشارة إليه من اقتصاد واستثمارات وحتى مبيعات الأسلحة، مما يضمن أن العلاقة الوثيقة، التي يرغب فيها المدافعون عنها يمكن تحقيقها وتنميتها بالفعل من خلال التعاون والتفاهم.
فرص لتقوية العلاقات:
يجد كل من السودان ومصر نفسيهما حاليًا يتصارعان مع العديد من التحديات الجديدة والملحة، التي تظهر في المشهد الجيوسياسي المعقد اليوم. فإذا نظرنا إلى مصر فهي معترف بها وتحظى بالاحترام على نطاق واسع كقوة سياسية واقتصادية وعسكرية رئيسة ليس فقط في منطقة شمال أفريقيا، ولكن أيضًا في دول الخليج وعبر معظم إفريقيا كقارة. في المقابل، يحتل السودان موقعًا مهمًا من الاعتراف في سياقات شرق أفريقيا والإطار الأوسع للوطن العربي ودول القارة السمراء والعالم الثالث. ومع ذلك، من الأهمية بمكان التأكيد على أن أيًا من هذين البلدين المجاورين لا يدرك تمامًا المدى والعمق الهائل اللذين يمكن أن تصبح فيهما ثروات كل منهما أكثر تشابكًا وترابطًا بينما نتطلع إلى المستقبل. وتبرز فكرة الجمع بين نقاط قوتهما ومواردهما وقدراتهما استراتيجيًا على أنها ربما تكون الاستراتيجية الواعدة والأكثر قابلية للتطبيق لمواجهة ومعالجة عدد لا يحصى من القضايا والمشاكل المعقدة، التي تواجه كلا البلدين حاليًا في شرق شمال إفريقيا، لا سيما في حوض النيل والبحر الأحمر المعقد والمهم من الناحية الجيوسياسية، وحتى من المحتمل أن يمتد إلى ما وراء تلك الحدود. علاوة على ذلك، في علاقاتها مع البلدان والكيانات في العالم الخارجي، قد تكتشف كل دولة في نهاية المطاف أن التقارب والتعاون وبناء التحالفات مع بعضهما البعض يمكن أن يكون بمثابة رصيد مهم ودائم يعزز نفوذهما الشامل ووجودهما وقدرتهما التفاوضية على المسرح الدولي. ومن خلال استكشاف كل سبل الشراكة والدعم المتبادل، يمكن لكل من السودان ومصر العمل من أجل مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا، والتعامل مع التحديات، التي تنتظرنا بقوة جماعية أكبر ورؤية استراتيجية أوضح.
لهذا، ليس من المستغرب أن تكون النجاحات العديدة، التي حققها كلا البلدين في العلاقات العربية والأفريقية نتيجة مباشرة للرؤية الاستراتيجية، التي يمثلها عدد قليل من صانعي السياسات المطلعين في كل سياق رابط بين البلدين. وتسمح هذه الفطنة الاستراتيجية للسودان ومصر بالتنقل في تعقيدات السياسة الإقليمية بشكل فعال. ومع ذلك، يبدو أن الرئيس الأسبق محمد جعفر النميري، الذي كان يُشير باستمرار ومودة إلى السودان ومصر على أنهما “روحان في جسد واحد”، ما كان في الوقت نفسه يميل إلى حد ما لاستخلاص الاستنتاجات المنطقية والضرورية، التي قد يتوقعها المرء فيما يتعلق بعلاقات البلدين وتفاعلاتهما المستقبلية. علاوة على ذلك، داخل بعض دوائر النخبة السودانية، كانت هناك باستمرار وجهات نظر تقليدية حول مصر والمصريين تقاوم التغيير. وتستمر هذه المعتقدات، التي عفا عليها الزمن في التأثير بقوة على وجهات النظر السائدة وتخلق حواجز أمام التقدم. وفي الوقت نفسه، يتمسك نظراؤهم في مصر بافتراضاتهم القديمة حول السودان. تشمل هذه الافتراضات تعقيدات التاريخ السوداني، بالإضافة إلى الأدوار المستقبلية المتوقعة في السياق الأوسع والمتعدد الأوجه للمنطقة. ويمكن لمثل هذه التصورات الراسخة؛ غير إنها متراجعة، أن تعوق إلى حد كبير القدرة على تطوير تعاون أكثر انسجامًا وتفاهمًا متبادلًا بين هاتين البلدين المترابطين ارتباطًا وثيقًا لا ينفصم. لذلك، ستكون معالجة مقاربات هذه التحيزات العميقة الجذور ووجهات النظر الإيجابية المتطورة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز العلاقات المحسنة والجهود التعاونية بين السودان ومصر في المضي قدمًا، لا سيما في عصر أصبح فيه التعاون الإقليمي أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحقيق الأهداف الجماعية ومواجهة التحديات المشتركة.
يجئ الهدف الأساس من معاينة المبادرات الدبلوماسية وأثرها كمحاولة جادة لفحص وتحليل لبعض المبادرات، التي اتخذتها حكومة السودان في جهودها الدؤوبة لتحسين علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع جميع البلدان تقريبًا في جميع أنحاء العالم بنجاح كبير. علاوة على ذلك، سعت باستمرار إلى توسيع هذه العلاقات لتشمل جمهورية مصر العربية والدول العربية والأفريقية. وتنبع الأسباب الأكثر وضوحًا للتقارب الحاضر وتقوية العلاقات بينها ومصر من المقاربات والمقارنات الخارجية، التي سعت إليها الدولة والتفاوض عليها، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالرغبة في مؤازرة نظامها على المسرح الإقليمي والدولي، التي هي بلا شك أحد الدوافع الرئيسة والأكثر أهمية وراء الدفع باتجاه بناء ما ذكرنا من رؤية استراتيجية. ومن المهم أن نلاحظ أنه ليس السودان وحده يلعب دورًا حاسمًا في هذا السياق، ولكن أيضًا تساهم قيادة مصر بشكل كبير، حيث توفر القابليات اللازمة لتبني هذه الرؤية، وهي أمر ضروري لما يتم إنجازه وإنتاجه وفقًا لاحتياجات البلدين الشقيقين.
وفي مثال تقريبي مختلف، يمكن أيضًا ملاحظة التفسير القائل بأن كلا من أفريقيا والوطن العربي حاولا رفع علاقاتهما الاقتصادية إلى مستوى طبيعي عن كثب من السياق الأوسع لسياسة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية خلال ما مضى من محاولات. وكنتيجة مباشرة للقضية الفلسطينية المثيرة للجدل والافتقار المستمر إلى التعاون الاقتصادي الفعال، فإن العديد من المشاكل الناشئة عن المظالم التاريخية والظروف الراهنة لم تؤد إلا إلى تفاقم الحالة القائمة من تشوهات الفهم. وفي سعيهما لإقامة علاقات ودية وذات منفعة متبادلة بين الدولتين المصرية والسودانية، يمكن للمرء أن يلاحظ من لقائهما الأخير في القاهرة أن كلا من الرئيس البرهان والرئيس السيسي وجدا مستوىً معينًا من المتعة والرضا في اغتنام هذه اللحظة بالذات. وكان ينظر إلى هذه الحكومتين، كما تمت مناقشة حالتهما الراهنة عاليه، على أنهما هيكل حكومتين ذات خصائص يمكن لهما التلاقي استراتيجيًا لتعملا كنقطة توقف حاسمة في تاريخ البلدين. ويمكن استخدام هذا الموقف الإيجابي إما للمزيد من التطور، أو الشراكة الاستراتيجية المتقدمة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، التي تم تجاهل ضروراتها في السابق. وبالإشارة إلى الأمثلة والملاحظات المذكورة أعلاه، يمكن أن نخلص في نهاية المطاف إلى أن البلدان تقيم علاقات مع بعضها البعض بسبب مصالحها وتطلعاتها المادية في المقام الأول. علاوة على ذلك، عادة ما تتدهور هذه العلاقات بشكل كبير إذا اصطدمت رغبات الدول ومصالحها المتضاربة، أو تتحسن بشكل ملحوظ إذا كانت مصالح وأهداف تلك الدول تتماشى بشكل متناغم. وهذا يؤكد أن التفاعل المعقد بين الدوافع الاقتصادية والاستراتيجيات الجيوسياسية، التي تحدد العلاقات الدولية في هذا السياق، يقودان السودان ومصر إلى غايات ما يصبو إليه كلًا منهما.
دور المنظمات الدولية:
وفي هذه اللحظة الفارقة، نراقب عن كثب الوجود الكبير لمختلف المنظمات الدولية، التي تعمل على وجه التحديد في مناطق الحاجة في السودان ومصر، ونأمل في إيجابية أدوارها، حتى لا تُعيد إلى الأذهان مداخل “الطرف الثالث” الناعمة. إذ إن هذه المنظمات، بمواردها الواسعة وخبراتها المتخصصة، لديها القدرة على أن تكون أحيانًا بديلًا فعالًا للحلول المحلية، ويمكن أن تؤدي دورًا هامًا للغاية في الوساطة خلال الأوضاع المتضاربة الحالية والمستمرة، التي تواجهها دول الإقليم بأسرها. وليس هناك شك في أنه بالنظر إلى المستقبل، قد تؤدي هذه الأنواع من المنظمات دورًا محوريًا ومتزايد الأهمية في السياق الأوسع للعالم العربي والأفريقي كله. ويمكن أن يكون تحقيق هذا النشاط التقليدي وتنفيذه وسيلة قيمة للغاية لتوحيد المسؤوليات العرفية للعالم العربي والأفريقي، وتعزيز روح التعاون، التي تهدف إلى تعزيز المساواة في توزيع الموارد الأساسية وتسهيل المفاوضات الدولية الحاسمة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب هذه المساهمات من هذه المنظمات مشاركة مباشرة ونشطة في مجموعة متنوعة من برامج التنمية، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز النمو المستدام في جميع المجالات. ويمكن أن يؤدي التفاعل بين الكيانات المحلية والشركاء الدوليين إلى حلول وشراكات مبتكرة تفيد المجتمعات المتأثرة بشدة بالتحديات المستمرة.
وينبع هذا الأمل، وما يستصحبه من اقتراح، من إدراك عميق لحقيقة أن العديد من العناصر الحاسمة لتدخلات “الطرف الثالث” قد ساهمت بشكل كبير في الوضع الخطير الحالي، الذي يتميز بانعدام الثقة المتبادل، والخوف المتفشي، والبعد عن التقارب الثقافي، والاعتماد المفرط على عدد قليل من المنظمات المؤثرة الرئيسة على جانبي النيل. ويمكن إرجاع النتائج السلبية الناجمة عن هذا المأزق، إلى جانب زيادة تكثيف المشاكل المستمرة، إلى حد كبير إلى الظروف المؤسفة، التي يترك فيها مصير البلدان المجاورة للسودان خاصة بشكل أساس في أيدي القرارات المفترضة، التي يتخذها هذا “الطرف الثالث”، وهي قرارات غالبًا ما تفتقر إلى المصداقية، ولا تأخذ في الاعتبار الآثار الأوسع نطاقًا على الناس. وفي رأينا أن إنشاء المنظمات المشتركة بين البلدين؛ السودان ومصر، من شأنه أن يمهد الطريق بلا شك لإحراز تقدم كبير، ويعزز التعاون والتفاهم بين الدولتين. وسيكون لديها حافز مقنع للتحول من حالتها الحالية المجزأة إلى مجموعات صنع قرار وطنية منسقة ومتوازنة تعكس حقًا إرادة شعبيهما. علاوة على ذلك، فإن هذا التبرير لإشراك المزيد من الدول العربية والأفريقية في دعم وتمويل هذه المنظمات سيكون مفيدًا للطرفين ولجميع أصحاب المصلحة المعنيين، لأنه لن يساهم فقط في السعي إلى التقارب العربي الأفريقي، ولكن أيضًا في تعزيز الثروة التنموية في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤدي في النهاية إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
دراسات حالة:
بالإضافة إلى القضايا المختلفة، التي تمت مناقشتها سابقًا، فإن التعاون في مجال البيئة المهم للغاية له أهمية عميقة فيما يتعلق بحوض نهر النيل المجهد تاريخيًا وحاليًا. يخدم هذا الممر المائي الحيوي، المعروف بأهميته البيئية والاجتماعية الهائلة، عددًا لا يحصى من المصالح في جميع أنحاء البلدان المختلفة، التي يمر بها، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الأشخاص. وعلى وجه التحديد، فإن مسألة رؤية شاملة ومتعمقة لاستكشاف ممارسات التعاون الناجحة والفعالة قد تفيد في كبح التلوث الزراعي، الذي ينشأ حوض النيل لما له تداعيات كبيرة وضارة على جودة المياه والصحة البيئية العامة في المناطق المجاورة لتدفق النهر وروافده. ويؤكد هذا الواقع المقلق على الحاجة الملحة لإجراء تقييم شامل ويقظ للآثار المحتملة، التي يمكن أن تنشأ نتيجة للسدود القائمة والمقترحة على طول مجرى نهر النيل. وتعد الإدارة الفعالة لنظام النهر هذا أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة الإنتاجية الزراعية، والحفاظ على التوازن البيئي، ودعم الاستخدامات والاحتياجات الأساسية المختلفة في اتجاه مجرى النهر. وقد برز التحديد الاستباقي لهذه الآثار بوصفه أحد أهم عناصر التعاون الحيوي، الذي أقيم بين البلدان المعنية. ومن الضروري الاعتراف بأن هذه المشاريع المشتركة قد تطورت إلى آليات مهمة لتعزيز التعاون المهني بشكل كبير بين العلماء والخبراء من كلا البلدين؛ مصر والسودان، والمعنيين في دول الحوض الأخرى. وهذه الشراكات المميزة، مقترنة بوضع قاعدة بيانات شاملة مفصلة ومفهومة جيدًا، فضلًا عن منهجيات مبتكرة، تكتسي أهمية بالغة في تعزيز التبادلات الفعالة والسليمة بين العلماء المعنيين. وهي تلعب دورًا محوريًا في تهيئة مناخ من الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل، وهو أمر بالغ الأهمية للتصدي بفعالية للتحديات البيئية المعقدة والمتعددة الأوجه، التي تنتظرنا في المنطقة. ومن خلال تعزيز مثل هذه البيئات التعاونية، يمكن للبلدان العمل معًا بشكل متناغم واستراتيجي للتخفيف من التهديدات المختلفة، التي يشكلها التلوث والضغوط البيئية الأخرى على حوض نهر النيل. وهذا التعاون لا يعزز قدرتهما الجماعية على مواجهة التحديات المشتركة فحسب، بل يساعد أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تعود بالنفع على جميع الدول المعنية. ويعد التوازن المعقد بين الحفاظ على البيئة والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين يعتمدون على النيل أمرًا ضروريًا للاستقرار والسلام على المدى الطويل في المنطقة، مما يسهل مستقبلًا أكثر صحة لكل من نهر النيل والمجتمعات، التي تعتمد على مياهه.
المجالات المحتملة لحل النزاعات:
تؤكد الاستنتاجات المستخلصة من التحليل الدقيق والمفصل، الذي يتناول المجالات المحتملة لإقامة علاقات سليمة بين مصر والسودان بوضوح حقيقة أن الفرص المحتملة لتحقيق حل سلمي للنزاعات بينهما، أو داخل أي منهما، جديرة بالملاحظة؛ مثل الاحتمالات المستمرة، والكامنة في كثير من الأحيان لتصاعد التوترات حول مجموعة قليلة، أو واسعة من القضايا الإقليمية والاقتصادية والتنموية والسياسية المحددة، التي ربما أزعجت هذه الدول تاريخيًا. وهذه الحالة المتعددة الأوجه، والمعقدة أحيانًا، تتيح فرصة حاسمة للحوار البناء، وإدراك الخطر المستمر المتمثل في تعميق الانقسامات، التي قد تكون نشأت بمرور الوقت. وتتوقف رؤية هذه المجالات المحتملة المحددة لحل النزاعات إلى حد كبير على الإرادة السياسية للقادة المشاركين بنشاط في العملية، إلى جانب الأدوار الداعمة، التي تلعبها الدول الأفريقية والعربية والإسلامية وغيرها من أصحاب المصالح الدولية، التي تسعى إلى تعزيز قضية الإنصاف والعدالة للجميع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ومع ذلك، وبعد الفحص الدقيق والدقيق للظروف السائدة؛ خاصة عند الأخذ في الاعتبار البديل القاتم المتمثل في إيقاظ بعض سرديات الإرث المؤلم من انعدام الثقة والعداء، الذي غالبًا ما ميز علاقاتهما في منعطفات السياسة الحرجة؛ وهي نادرة، يُصبح من الواضح بلا شك أن هناك، على الأقل، حاجة ملحة وضرورية للسعي من أجل البديل الوحيد المتاح لهؤلاء الجارين الشقيقين: سلام معزز ضروري لضمان الاستقرار، وخطوات جادة نحو وحدة تكاملية تضاعف من قوة كل منهما مع الآخر. وفي سبيل تحقيق ذلك، وإلى جانب تهدئة مناطق الصراع، التي تم تحديدها وفحصها بالفعل في تحليلات سابقة، يجب أن نعترف بالحقيقة الحرجة المتمثلة في أن الاقتصادات الإقليمية والدولية النامية تظهر طلبًا واضحًا وملحًا على كل من الموارد الوفيرة الموجودة داخل الحوض الشاسع، الذي يحتله البلدان، ومضافًا إليه طرق النقل الاستراتيجية عبرهما، إلى جانب الوصول إلى مرافق الموانئ الحيوية، التي تسيطران عليها لتيسير التجارة العابرة للقارات.
علاوة على ذلك، من المهم للغاية أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن حل النزاعات يزداد تعقيدًا بسبب القضايا الداخلية السودانية المعدية للجيران، التي ابتليت بها البلاد، التي تُواجه العديد من التحديات مثل الافتقار إلى التعليم الجيد، وانتشار الأمراض المختلفة، والحاجة الملحة للتنمية المستدامة، التي تلبي احتياجات السكان. يُضاف إلى ذلك موضوع الديمقراطية السياسية، خاصة في الأطر، التي وضعتها الدول العربية والأفريقية، الذي يتجاوز حالة الدولتين المعنيتين فقط. إنه يجذب حتمًا بعض الدول المؤيدة للتحالف من أجل هذا الهدف، والقوى العظمى ذات الصلة، التي تزعم أنها تتوق إلى تهيئة ظروف تكافؤ الفرص لجميع المجتمعات على نطاق عالمي. ومع ذلك، فإن المحفز للتنمية الداخلية الهادفة يعتمد بشكل كبير، وكبير جدًا، على ما هو أكبر بكثير من مجرد التعايش السلمي والتعاون بين مصر والسودان. إن طبيعة هذه العلاقة الثنائية الحيوية ديناميكية؛ كانت وما تزال. وسوف تتطور حتمًا إلى ما هو أكثر إيجابية، شريطة ألا تتأثر بمختلف العناصر المتبقية، التي تميز السياق الأوسع لشمال شرق أفريقيا، الغني بالتعقيد.
لهذا، فإن التنمية الشاملة والمستقبل السلمي التكاملي المتوقع لوادي النيل يفوق بكثير أي فوائد مؤقتة مستمدة من التنافس الثنائي، أو الآليات، التي تهدف فقط إلى إدارة الأزمات الطارئة. وفقط من خلال اتباع نهج مركز على هذه الاتجاهات الإنمائية الحرجة يمكن أن تتحول القضايا الخلافية إلى ما يمكن تسميته بحالة “غير ملحوظة”، مما يدل على غياب حالي للصراع العلني والواضح. وعندما نتأمل في التحديات العديدة، التي يواجهها كلا البلدين والصراعات، التي لا تعد ولا تحصى، التي خاضاها تاريخيًا، تُصبح المسألة ذات أهمية تاريخية ضئيلة، بصرف النظر عن آثارها النظرية فيما يتعلق بالقانون الدولي، الذي يحكم هيمنة الحكومات والعلاقات بين الأمم. وبينما يمر وادي النيل بتنمية تعترف بحقوق واحتياجات سكانه ويحترمها بشكل أساس، فإن الاستفسار “الذي لم يلاحظ” سابقًا سيكون قد حل بشكل طبيعي لصالح إطار متقدم بهدوء لحقوق الإنسان الدولية يعود بالنفع على الجميع. وتَظهر الآن “اللحظة الاستراتيجية” المناسبة للانخراط حقًا في المناقشات الضرورية. وفي الواقع، حان وقت الكلام المسموع، الذي يؤكد أننا نقف عند منعطف استراتيجي حاسم يستدعي إجراء حوار حقيقي بين الأطراف المعنية من أجل المستقبل.
دور المجتمع المدني في العلاقات الثنائية:
بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، التي تعمل في سياقات كل من السودان ومصر، يعتبر إعلان الاتفاق على “الحريات الأربعة” معلمًا استثنائيًا في هذا المشهد المتطور. ولم يكن يمثل مجرد ذروة في هذه العلاقات، بل يجسد رحلة واسعة وتحويلية، بلغت ذروتها في لحظات محورية من التغيير الكبير والتقدم الأساس في رحلتهما نحو التكامل والوحدة، ليس فقط في مستواها السياسي والدبلوماسي، وإنما في بعدها الاجتماعي الأعمق. وفي الواقع، عندما نحلل الديناميات المعقدة، التي تلعب دورًا فيما يتعلق بالرأي العام والتأثيرات المختلفة، التي تشكل مبادرات صناع القرار فيما يتعلق بالعلاقات السودانية المصرية المعقدة والمتطورة، يصبح من الواضح تمامًا أن المساهمات الثابتة، التي تقدمها منظمات المجتمع المدني المتفانية في كل من السودان ومصر تقف كتأثيرات محورية. ولا يمكن إنكار أن هذه المساهمات تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد مساهمات قطاع الأعمال الكبير، الذي غالبًا ما تلعب مصالحه دورًا حاسمًا.
لقد عملت هذه المنظمات غير الحكومية كجسور أساسية، حيث حافظت بجد على الروابط الحيوية، التي ثابرت بشكل مذهل بين المجتمعات المدنية في البلدين الشقيقين المتجاورين، لا سيما في الأوقات المضطربة عندما أصبحت البيئة السياسية بين حكومتيهما متباعدة بشكل متزايد، ومحفوفة أحيانًا بالتوتر. وخلال تلك الفترات المؤقتة والحرجة، تم تنظيم العديد من التجمعات السودانية المصرية على وجه التحديد بهدف تعزيز الحوار المثمر، وتطوير التعاون على مختلف الجبهات. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه التجمعات الهامة، في أغلب الأحيان، عقدت واختتمت دون أن تسفر عن أي نتائج ملموسة ومحسوسة يمكن اعتبارها مؤثرة، أو تحويلية لمستقبل أي من البلدين. وفي هذا المنعطف الحرج من تاريخنا المشترك، يوجد ثلاثي غير عادي وقوي لديه القدرة على زيادة تعزيز الحِراك العام، الذي يتراكم حاليًا ويرتفع قبل إجراءات الحكومتين. ويتكون هذا الثلاثي من المجتمعات المدنية الديناميكية المذكورة أعلاه، والمُناصَرة الإعلامية الفعالة، التي يتردد صداها بشكل هادف لدى الجمهور، والروابط الإنسانية الدائمة، التي تم إنشاؤها على مستوى المجتمع الشعبي، والتي تعمل كأساس للمشاركة المستمرة.
وفي الواقع، قدم محللون بارزون اقتراحات مقنعة، مشيرين إلى أن الظروف ربما أصبحت متوافقة بشكل إيجابي مع ما يمكن وصفه، بعبارات معتدلة، بأنه “إعادة اكتشاف النيل كشريان حياة لمصر والسودان”، أو ما أسميته بـ”اللحظة الاستراتيجية”. وتقدم هذه الفكرة المثيرة للتأمل فرصة غير مسبوقة وقيمة للمجتمعات المدنية في كلا البلدين لتأكيد أهميتها، التي لا يمكن إنكارها وتوضيح أن النيل يمثل أكثر بكثير من مجرد رمز “أيقوني” خال من الجوهر والمعنى. إن مسار العمل الحكيم والعقلاني، الذي يجب أن يتفكر فيه كلا البلدين عمدًا في هذه المرحلة الحرجة هو إدراك أن الوسيلة، التي نتواصل من خلالها ونتحاور، يمكن أن تكون بمثابة رسالة متكاملة وقوية في حد ذاتها. ولا يسلط هذا التفكير الضوء على الترابط بين مجتمعاتنا فحسب، بل يعزز أيضًا أهمية الجهود التعاونية في التعامل مع التحديات المشتركة، التي نواجهها. وفي الجوهر، من خلال الانخراط الكامل مع بعضنا البعض، والاستفادة من نقاط قوتنا، والبقاء ملتزمين بتعزيز بيئة من الحوار والتفاهم، يمكننا تمهيد الطريق لمستقبل يتم فيه الاعتراف بالمجتمعات المدنية في السودان ومصر كمحركين رئيسيين للتغيير، مما يساعد على شق طريق نحو الاستقرار والسلام والازدهار المشترك في المنطقة.
مشاركة الشباب والأجيال القادمة:
يعتمد الاستقرار طويل الأمد والنجاح الدائم لأمتنا بشكل أساس على مواطنينا، وخاصة الجيل القادم. وسيلعب هذا الجيل دورًا محوريًا في تشكيل المشهد المستقبلي لمجتمعنا وثقافتنا. ولا يمكن أن يكون هناك رصيد وطني أكبر من السكان الطموحين والديناميكيين الذين يتألفون من أفراد متعلمين وأصحاء ومهرة وملهمين باستمرار. وسيكون الثراء والقوة المستمدة من هؤلاء السكان المتنوعين والنابضين بالحياة ضروريين عندما يتعلق الأمر بتحديد مدى فعالية توظيف إمكاناتنا الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية وتحسينها في عالم متزايد التواصل والترابط. ولبناء قاعدة دعم أوسع وأكثر شمولًا وقوة لبلدينا، وتسخير ثروة من الأفكار المبتكرة ووجهات النظر الجديدة والتجارب الفريدة، يجب أن نشارك بنشاط مع شبابنا. ويجب أن تحدث هذه المشاركة بطريقة هادفة ومتسقة، تبدأ في وقت مبكر من حياتهم وتستمر طوال رحلة التنمية الشاملة. ويعتمد مستقبلنا الجماعي حقًا على تعزيز المواهب والتطلعات والطموحات الفريدة لهؤلاء الشباب مع ضمان شعورهم بالتقدير، والاستماع إليهم في كل تفاعل. ومن خلال الاستثمار بشكل كبير في نموهم وتطورهم، فإننا لا نُمَكَّنَهُم من الوصول إلى آفاق جديدة فحسب، بل نعزز أيضًا أسس مجتمعنا. لذلك، نحن لا نعد شبابنا للمستقبل فحسب، وإنما نجهز أمتنا للتحديات المعقدة والفرص المثيرة، التي تنتظرنا في مشهد عالمي متطور. وهذا الالتزام تجاه مواطنينا الشباب سيضمن أن يصبحوا قادة ومفكرين ومبتكرين في الغد. ومن ثم، يجب أن نعطي الأولوية لتعليمهم وصحتهم ورفاهيتهم من أجل استدامة وتقدم مجتمعنا ككل.
لهذا، يمثل شبابنا مجموعة واسعة من الإمكانات وهم حاليًا مورد غير مستغل إلى حد كبير ينتظر استخدامه بفعالية. ومن خلال أخذ زمام المبادرة لإقامة حوار هادف مع الشباب، وفي الوقت نفسه زيادة فرص العمل والمواطنة النشطة للشرائح الفقيرة والنائمة سياسيًا في مجتمعنا، سنكون قادرين على تكوين قاعدة دعم أقوى وأكثر ديمومة على المدى الطويل. ومن الأهمية بمكان أن نعمل معًا لتعزيز ودعم وإشراك المجتمع المدني وقادة الرأي الذين يمكنهم التأثير على التغيير. ومن خلال القيام بذلك، سنزود هؤلاء الشباب بالمعلومات الحيوية والتحليل الشامل اللازمين لتوجيه رغباتهم القوية في التغيير بشكل فعال إلى نتائج بناءة اجتماعيًا ومقبولة على نطاق واسع. لذلك، فإن إشراك شبابنا لا يفيدهم فحسب، بل يوفر لنا أيضًا فرصة فريدة لاستباق صدامات الأجيال المستقبلية. ويمكننا تثبيط الآراء المتطرفة والتعليقات التحريضية، التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على مصالحنا الجماعية. وفي النهاية، فإن صوت شبابنا قوي وحازم، وهو حريص على أن يسمع. ولذلك، فإن التغاضي عن هذا الجانب الحيوي هو دعوة إلى صمت مقلق بين الشباب. ويجب أن نتذكر أن الصمت ليس حلًا دائمًا للتحديات الملحة، التي تواجهنا كل يوم. ومن خلال الاستماع، يمكننا احتضان رؤاهم وحماسهم، مما يخلق مستقبلًا أكثر إشراقًا للجميع.
التعاون التكنولوجي والابتكار:
إن اتباع استراتيجيات تعاون إقليمي عربي أفريقي شاملة يمكن أن يحول بشكل ملحوظ وكبير العلاقات الاستراتيجية بين السودان ومصر إلى محرك دولي قوي مكرس للابتكار والتقدم المستدام. ويمكن أن تكون هذه العلاقات المتطورة والعميقة بمثابة أرضية تجريبية فريدة حيث يمكن للدولتين التعاون بنشاط في أشكال رائدة ومتطورة من التعاون التكنولوجي. علاوة على ذلك، لديهما القدرة على تأسيس وإنشاء أدوات قوية لسياسات البحث والابتكار يمكن أن تتبناها الدول الأخرى بشكل فعال، وخاصة تلك، التي تتطلع إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية، في المستقبل. وستوفر هذه البيئة التعاونية أساسًا متينًا لتحقيق النجاح في مختلف البرامج، التي تركز باهتمام على الابتكار، وكذلك نقل التكنولوجيا. وسيساهم هذا النهج المبتكر بشكل كبير في توليد تقنيات جديدة ومتقدمة عبر قطاعات متنوعة.
لقد شهد العالم أنه، ومنذ التسعينيات، ارتفعت الأسواق الناشئة بشكل متزايد كمصادر حيوية للابتكار، حيث عملت كلاعبين أساسيين على المسرح العالمي، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي مع استمرار البلدان في التطور والبناء على منافذ اقتصادية فريدة وتعزيز نقاط قوتها في الابتكار. ويمكن لمبادرات التعاون الواسعة هذه أن تعتمد جداول أعمال بحثية جيدة التنسيق تعطي الأولوية للأهداف المشتركة وتوفر أيضًا تمويلًا عامًا أساسيًا للشركات المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية لتهيئة بيئة مواتية للنمو. ويمكن تسهيل هذا التقدم من خلال مجموعة متنوعة من تدابير السياسات المصممة بعناية، التي تشجع وتحفز وتدعم النمو والابتكار في قطاع التكنولوجيا، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج معززة وتأثيرات إيجابية أوسع نطاقًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولقد كافحت الحكومات العربية والأفريقية تاريخيًا من أجل تعزيز العلوم والتكنولوجيا بشكل فعال داخل حدودها. ويبدو أن تدابير السياسة العامة القائمة، مثل تصدير المعدات التكنولوجية وتعزيز التعاون من خلال تطوير البرمجيات، تعمل كقنوات أكثر فعالية لتحقيق التقدم التكنولوجي، لا سيما في الأجل القصير. ومن الآن فصاعدًا، سيكون من المهم للغاية بالنسبة لمستقبل العلاقات بين شمال السودان ومصر أن يتجاوز صانعو السياسات في كلا البلدينعقلية مجرد “إضعاف الآخر”. وبدلًا من ذلك، يجب أن ينخرطوا في تحليلٍ بناءٍ وتعاونيٍ يركز على الإجراءات، التي يمكن اتخاذها لتعزيز التآزر والمنفعة المتبادلة بين البلدين. ومن خلال إعطاء الأولوية للتعاون المستقل والانخراط في حوار مدروس، من الممكن تشكيل اقتصادات مشتركة تكرم وتعزز التميز الثقافي لكل دولة، ولكليهما معًا.
وفي تقديري، فإن هذا ليس مفيدًا فحسب، بل يُعَدُّ ضروريًا لأن كلا الجانبين بحاجة إلى إدراك القيمة المضافة في هويتيهما الفريدة وكيف يمكن لهذه الهويات أن تساهم في مشهد اقتصادي أكبر وأكثر ترابطًا. وسيكون تعزيز نقل التكنولوجيا، لا سيما بين المراكز الشمالية والحضرية على جانبي الحدود، أمرًا حتميًا لتحقيق هذه الأهداف. علاوة على ذلك، ومع تكثيف الدعوة إلى المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة؛ لا سيما الحاجة إلى تطوير تكنولوجيا مبتكرة يمكنها الاستفادة بشكل فعال من مواردنا الطبيعية الغنية والاستزادة منها، قد يكون هذا بمثابة الدافع الرئيس، الذي يغري ويحفز الحكومات العربية والأفريقية على بذل جهود جادة نحو تعزيز قدرتها على الحوكمة. فقد حان الوقت لهم للتقدم واحتضان التغيير والاستثمار بنشاط في تنمية بيئة تغذي التقدم العلمي والابتكار التكنولوجي لصالح الجميع.
التحديات البيئية والجهود المشتركة:
يبرز التاريخ المعقد للتعاون المشترك بين السودان ومصر، لا سيما في السياق الأوسع لبيئة حوض النيل، كنموذج بارز يمكن أن يكون بمثابة معيار للجهود التعاونية المحتملة والمبادرات المشتركة في المستقبل. ورغم إشاراتنا السابقة في هذا المبحث لموضوع المياه ومتعلقات البيئة، إلا أن هناك حقيقة مؤسفة حقًا، وهي أنه حتى هذه المرحلة الزمنية، كافحت كلتا الدولتين باستمرار، ولكن لم تبلغا تمام النجاح عندما يتعلق الأمر بالمعالجة الفعالة للأخطار الحرجة والمتعددة الأوجه، التي تشكلها التحديات المائية والبيئية، والتي لا تعد ولا تحصى، خاصة تلك المحيطة بإدارة المياه والحفاظ عليها. وظلت عمليات التنمية الحضرية الداخلية والتخطيط الزراعي، التي تجري في كل من السودان ومصر، حتى الآن، غافلة إلى حد كبير عن الآثار العميقة وبعيدة المدى في كثير من الأحيان لأفعالهما على التدفق المعقد للمياه الجوفية، التي تسير نحو نهاية وادي النيل. وعلى نطاق أوسع، لا تؤثر أوجه القصور الصارخة هذه على دولهما فحسب، بل تؤثر بشكل كبير على إمدادات المياه الإجمالية للمنطقة بأكملها، وهي قضية ملحة بشكل متزايد لم يعد من الممكن تجاهلها، أو التقليل من شأنها.
ومع ذلك، فقد ظهر أخيرًا وعي حاسم بهذا الترابط العميق في الخطاب الحالي، وكما هو اليوم، فإن مستقبل نهر النيل سيتشكل بصورة حاسمة من خلال مزيج من المبادرات البشرية والظواهر الطبيعية في جميع أنحاء هذا المنطقة، التي يعيش فيها الجيل الحالي. وهذه الحالة المتطورة تجعل الحاجة الملحة للعمل أكثر وضوحًا وأهمية من أي وقت مضى. ومن المفارقات أننا نجد أنفسنا نقف في لحظة محورية للتعاون المحتمل، حيث إن أي فشل في تلبية احتياجات بعضنا البعض بشكل كاف يهدد سلامة حوض النيل ومستقبله المستدام. وهذا القلق مهم بشكل خاص بالنظر إلى أن المطالب الخارجية تتصاعد وسط ضغوط النمو السكاني السريع، مما يضغط على الحاجة إلى حلول فورية ومستدامة لم يعد من الممكن أن تظل في مجال حسابات التقاعس. وفيما يتعلق بأنشطتهما الاقتصادية الأساسية، يواجه كل من السودان ومصر خيارات صعبة بشكل متزايد ومعقدة في كثير من الأحيان تحمل تداعيات كبيرة على مستقبل كل منهما.
وتظل الحقيقة هي أنه من خلال سلسلة من التجارب الصعبة في بعض الأحيان، سواء كانت نابعة من تعاون حقيقي، أو ناجمة عن المنافسة، نجحت كل من مصر والسودان في اجتياز قضايا أخرى تبدو مستعصية وصعبة تتعلق بإدارة جمع وحصاد المياه السطحية والجوفية في حوض النيل. وتمتلك العقول الرائدة في البحث والتخطيط والخدمة العامة داخل كلا البلدين الآن إمكانات فريدة لتوجيه شعوبها نحو الازدهار المتجدد والاستقرار على المدى الطويل. ومع ذلك، من الأهمية بمكان الاعتراف بالخطر المتناقض، الذي يلوح في الأفق. لذلك، فإن جهود المشرفين المتعاونين على مصالحهم المشتركة يمكن أن تزرع عن غير قصد بذور التدهور والضياع النهائي للموارد الحيوية لحوض النيل. ورغم أن التعاون الناجح محفوف بالتحديات، يمكن أن يؤدي إلى توليد ثروة كبيرة وفوائد اقتصادية، ولكن هذه الثروة تخلق أيضًا فرصة لتبديد الموارد الثمينة بسبب القرارات السيئة وغير المستنيرة. ولذلك، من الضروري أن تحافظ الدولتان على موقف عميق ويقظ فيما يتعلق بالرؤية الشاملة المطلوبة لفهم وتقدير الأهمية التاريخية للقرارات الحاسمة، التي يجب أن تتخذها بشكل جماعي في المستقبل القريب. وستضمن هذه اليقظة أن يظل تركيزهما حادًا ومتعمدًا أثناء تنقلهم بجد في قضايا هذه المياه المعقدة والمضطربة في كثير من الأحيان.
إدارة الأزمات وآليات الاستجابة لها:
ونحن نُجيل النظر فيما يمكن أن يُشَكِّل قاعدة انطلاق ضرورية للتأكيد على أهمية الحديث عن “اللحظة الاستراتيجية”، علينا أن نتذكر أن من الاتفاقات المهمة الأخرى ذات الاهتمام المشترك، التي تتعلق تحديدًا بآليات إدارة الأزمات والاستجابة لها، الاتفاق المحوري لعام 1959، الذي تم إبرامه في أعقاب فترة متوترة بشكل ملحوظ من المواجهة وعدم الاستقرار في العلاقة بين الدول المعنية بقضية المياه. فقد تم وضع هذا الاتفاق الحاسم بعناية في المقام الأول للمساعدة في تجنب العواقب الوخيمة، التي يمكن أن تنشأ عن أي مواجهات أخرى، التي قد تشمل هذه العواقب المحتملة عدم كفاية تدفقات المياه، والعديد من التحديات المتعلقة بهندسة الموارد المائية والتعديلات في طرق البناء، وظروف الجفاف الشديدة والممتدة، والتي تهدد الجدوى الزراعية، وتراكم الطمي الضار، الذي يمكن أن يدمر النظام البيئي بشكل كبير ويؤثر سلبًا على المجتمعات، التي تعتمد على النهر أثناء انتقاله من مصر إلى السودان وإلى أعلى المنبع من السد الموجود في السودان.
ومع ذلك، فإن التحدي الكبير، الذي نواجهه اليوم هو أن اتفاق عام 1959 وحده ربما لم يعد يمثل الطريق الصحيح للمضي قدمًا، لأن “طرفًا ثالثًا”؛ مدعومًا من “أرافٍ أخرى” يخاطر بأن يصبح توزيع المياه مصدرًا محتملًا لإدامة الأنشطة غير القانونية، بدلًا من أن يعمل حقًا على منعها بشكل فعال. لذلك، فإن الضرورة الملحة لتنشيط وإعادة تقييم اتفاق عام 1959 تصبح واضحة بشكل صارخ، حيث إن تحديثه بمبادئ توجيهية إضافية وتحويل الاتفاقية إلى صك متعدد الأطراف مكرس لحماية الأنهار والطبيعة، فضلًا عن أهداف التنمية المستدامة، يمكن أن يضمن نهجًا مثاليًا وشاملًا لبلدان المنبع فيما يتعلق بالاستخدامات الرئيسة لنهر النيل و”سد النهضة” الإثيوبي الكبير، وما يسمى بـ”اتفاقية عنتبي”. ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات الاستباقية، يمكننا تعزيز التعاون بين الدول، وضمان التقاسم العادل للموارد، والتصدي للتحديات المتزايدة، التي تنشأ عن التغيرات البيئية، وندرة الموارد، والنزاعات السياسية المعقدة، التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
لهذا، فإذا كان هناك اتفاق على آليات بناء الثقة وإعلان واضح بضرورة استبعاد العمل العسكري تمامًا إذا قَبِلَت إثيوبيا بالرقابة والإدارة المشتركة لـ”سد النهضة”، فإن اتفاق عام 1959 يقلل بشكل كبير من الرافعة الأكثر أهمية، التي حافظت عليها مصر تاريخيًا على الموارد المائية لنهر النيل. وفقًا لهذه القاعدة، فإن مصر ملزمة بشيء من المرونة تجاه كل من السودان وإثيوبيا كلما حدث انخفاض في تدفق مياه النهر. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مصر والسودان أن يتحملا المسؤولية عن أي طمي ضار يتراكم في السدود الموجودة في كليهما. وفي ضوء ذلك، قد يتبين أنه من الأكثر فعالية التوصل إلى اتفاق يستند إلى مبادئ القانون الدولي، التي تحكم تخصيص مياه النيل، مثل مفاهيم التخصيص العادل والمعقول. وعلاوة على ذلك، يمكن إنشاء ضمانة إضافية من خلال التزام أكثر صرامة للتحكيم مع “الطرف الثالث” المؤتمن للإشراف على أي نزاعات تنشأ في هذا السياق. وفي الحالات، التي تجد فيها إثيوبيا والسودان ومصر نفسها غير قادرة على تحقيق الموافقة المتبادلة، سيكون من المفيد للأطراف الأخرى الموقعة المعنية امتلاك آلية واضحة تمكنهم من الموافقة على مشاريع الري. ويمكن أن يشمل الموقعون المحتملون على هذه المبادرة أي شركاء مترابطين بيئيًا واقتصاديًا بحوض النيل الكبير، فضلًا عن أولئك الذين يتأثرون بشكل مباشر بقضايا تخصيص المياه. ويمكن تسهيل عملية التحكيم مع “طرف ثالث” من قبل محكمة مكرسة لتوفير العضوية الاستشارية فيما يتعلق بقضايا الأمن العالمي، وضمان حل مرن وعادل للنزاعات حول موارد مياه النيل.
الدروس المستفادة من العلاقات الثنائية الأخرى:
يجب علينا أن نُثَبِّت أولًا، أنه من الأهمية بمكان التأكيد على أن الوضع فيما يتعلق بإثيوبيا ومصر ليس مجرد مسألة قطيعة دبلوماسية بين بلدين تلين وتشتد. بدلًا من ذلك، ينبغي النظر إليها على أنها حقًا مسألة حياة وموت عميقين بالنسبة لمصر. فيما يتعلق بالمصالح المادية المتعلقة بإثيوبيا، فإن جوهر المصالح المشتركة يتوقف بشكل كبير على الانهيار التام لأي علاقات تعاونية بين أديس أبابا والقاهرة. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن السلام الدائم في المنطقة؛ ومصر الراضية بشكل معقول بحقوقها المائية، سيمثلان عقبات لا يمكن التغلب عليها أمام أي مفهوم عظيم للجوار مستمد من التوافق في مشهد الوطن العربي وأفريقيا. فإذا أرادت إثيوبيا البقاء على قيد حسن الجوار والحفاظ على نفوذها على النيل الأزق بشكل فعال، فإنها بحاجة حاسمة إلى إدراك الشعور بالإحباط الداخلي في مصر والسودان من انفرادها بالتصرف في شأن مصيري بالنسبة للبلدين. ومن شأن أي تعاون واسع النطاق بين إثيوبيا ومصر والسودان أن يشكل أيضًا حاجزًا سياسيًا واقتصاديًا، وربما حتى عسكريًا أمام حركات التمرد المتزايدة في منطقة القرن الأفريقي الحيوية استراتيجيًا. ولا تزال مصر، كما هي إثيوبيا والسودان، القوى الإقليمية الوحيدة القادرة على ممارسة النفوذ الحقيقي فيما يتعلق بمياه النيل. وبالتالي، وفي أسوأ الأحوال، فإن دفع مصر في إطار دفاعي عن حقها المشروع في مياه النيل يزيد بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بالتحدي الإثيوبي المباشر للجوانب الحيوية في جميع أنحاء المنطقة، مما يجعل مثل هذه الأعمال خطرة بشكل واضح على طموحات إثيوبيا الأوسع في المنطقة.
وللتأكيد على الحاجة للتعاون، تفتقر إثيوبيا إلى منفذ بحرب، إلى جانب ما يعتمل داخلها من تململ إثني وثقافي وديني، واضطراب في علاقاتها مع جوارها المباشر؛ السودان وإريتريا والصومال وكينيا وجنوب السودان، مع استثناء، ولكن جزئي مع جيبوتي. ويعوزها إلى حد كبير أنظمة الإقناع المحلية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأكثر عملية، أو رسمية تمامًا، التي تتمتع بها كل من مصر والسودان فعليًا في مختلف البلدان، التي تحتفظا فيها بمصلحة هيكلية عميقة. وقد يتجلى هذا التأثير بأشكال مختلفة، سواء من خلال القيادة الاستراتيجية، أو من خلال الاختراق الاقتصادي الكبير. لذلك، فإن الأصول الرئيسة لإثيوبيا، وهما أساسيان للارتقاء الضروري بمصالحها الأمنية، هما مرة أخرى، عمليتان بشكل مميز بطبيعتهما بدلًا من أن يكونا متجذرين في مبادئ رفيعة العقلانية. أولًا وقبل كل شيء، تتطلب الإثيوبية؛ سواء كانت إقليمية، أو عالمية في الواقع، قاعدة دائمة من الأصول الاستراتيجية الموجودة في المنطقة. وهذا المطلب ضروري لضمان عدم تعرضها لعمل عسكري قوي وسريع الاستجابة لما يصدر عنها من تهديدات في شأن حيوي كالمياه. وثانيًا، يجب أن تتيقن أن استمرار تعمد إغفال حق في هذه المنطقة الحيوية ضار استراتيجيًا، ولا يمكن من الوصول إلى تفاهمات موثوقة ودائمة تُتِيح للجميع الاستفادة العادلة من الموارد المحلية في الإقليم. علاوة على ذلك، تتطلب هذه التفاهمات حماية قانونية، التي بدونها ستتعرض القدرة التشغيلية الأكبر لمصادر المياه، وفعالية المهمة المتوخاة من ترتيبها للخطر. ولذلك، فإن الغياب المحتمل لهذا النوع من الدعم القانوني والعملياتي للتفاهمات يشكل ويؤطر مخاوف مصر والسودان المتعلقة بأهدافها الأمنية والتنموية الوطنية.
الآفاق المستقبلية والتوصيات:
ربما نتجاوز القصد المعرفي إذا قررنا أن ما نطرحه هنا يمثل التوصيات النهائية لصانعي السياسات في كلٍ من السودان ومصر، وحتى إثيوبيا وغيرها من المعنيين في الجوار العربي والأفريقي، لكن يمكننا القول إن الآفاق المستقبلية للعلاقات السودانية المصرية عديدة ومتنوعة وتعتمد إلى حد كبير على الرؤية الاستراتيجية المنشودة للعصر القادم والأهداف المشتركة لكلا البلدين، وما يربط بها من متعلقات الجوار الإقليمي. فبعد فترة تعرضا خلالها لتخريب كبير وتحديات في علاقاتهما، هناك الآن اهتمام متجدد ومتحمس بإحياء وتقوية هذه العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين. وظهر هذا الاهتمام المتزايد بضرورة إعادة تنظيم العلاقات القديمة والموثوقة، التي ربطتهما تاريخيًا كسمة لا يمكن إيقافها في التفاعل الديناميكي والمشاركة المحمودة بين السودان ومصر. ويدرك البلدان الفوائد المحتملة، التي يمكن أن يحققها تعزيز التعاون والتكامل، حيث يهدفان إلى بناء مستقبل أكثر ازدهارًا؛ وضمان استقرارهما معًا. وبينما يتنقلان في تعقيدات وفروق دقيقة في إرثهما التاريخي وروابطهما الثقافية، تظل إمكانيات النمو المتبادل والتعاون والتفاهم وفيرة وجاهزة للاستكشاف، مما يخلق العديد من الفرص للتنمية والشراكة في مختلف القطاعات.
لهذا، يُعْتَقَدُ على نطاق واسع أن هناك العديد من الميزات، التي يجب مراعاتها بالإضافة إلى التحديات، التي لا تعد ولا تحصى، والتي تواجه “اللحظة الاستراتيجية” الحالية لكل من السودان ومصر. وهذا الوضع متعدد الأوجه ومعقد، ولكن من الواضح تمامًا أن هناك أنشطة ومبادرات مختلفة يجري الاضطلاع بها، تهدف جميعها إلى تجنب الأخطار المحتملة، التي يمكن أن تنشأ عن أعمال التخريب، والتي يمكن أن يتعمدها “الطرف الثالث”. وتحمل العلاقة بين السودان ومصر قدرًا كبيرًا من الآفاق المستقبلية، مع إمكانات كبيرة لتعميق التعاون والمشاركة. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان من الممكن اعتماد هذه الاحتمالات بنجاح وترجمتها إلى إجراءات من شأنها أن تيسر استحداث مفاهيم جديدة وطرائق مبتكرة من خلال استخدامها العملي في تشكيل هيكل أمني إقليمي شامل. لذلك، فإن إنشاء هيكل أمني إقليمي جديد في المنطقة يكتسي أهمية قصوى، يرتكز على إنشاء استراتيجية مشتركة تعاونية ليس فقط لمكافحة الشائعات، ولكن أيضًا لمناورات الاستهداف، التي تقوم بها “الأطراف الثالثة”، أو القوى العظمى.
والرجاء أن تشمل هذه المبادرة زيادة حجم التجارة والاستثمار زيادة كبيرة، فضلًا عن الربط الفعال بين مختلف مشاريع النقل عبر الحدود. وهذا أمر حيوي بشكل خاص نظرًا لموقع السودان الجغرافي الاستراتيجي، الذي يعمل كجسر حاسم بين شرق وشمال إفريقيا. فقد أصبحت معالجة المعضلات، التي يواجهها السكان في البلدين وحلها، إلى جانب إيجاد حلول قابلة للتطبيق للمعوقات الحدودية القائمة، أمرًا ضروريًا وحاجة ملحة. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه العوامل، لا يزال ينظر إلى الدعم الشعبي على أنه العنصر الأكثر أهمية لأي احتمالات للتقدم، لأنه من دون دعم الجماهير، قد تتعثر أية مبادرات. ولذلك، يجب اتخاذ تدابير عملية بجدٍ لضمان عدم خروج زخم العلاقات الجيدة عن مساره، أو التحرك في اتجاه غير مُواتٍ. ومثل هذا التحول المؤسف للأحداث، إذا وقع لا قدر الله، من شأنه أن يقوض أمن السودان واستقراره، الأمر، الذي سيكون له بدوره آثار متعدية تؤثر حتمًا على مصر والإقليم. وبالتالي، فإن ديناميات العلاقة بين هاتين البلدين لها وزن كبير وتتطلب اهتمامًا دقيقًا واستراتيجيًا.
الخلاصة:
يؤكد هذا المبحث بشكل قاطع أننا نجد أنفسنا نقف على حافة منعطف استراتيجي تحويلي وجديد في العلاقات المتطورة والمتعددة الأوجه القائمة بين مصر والسودان. فالأحداث الهامة والمتغيرات المحورية، التي شكلت العالم العربي والقارة الأفريقية منذ فجر القرن الحادي والعشرين، عندما تقترن باستمرار النخبة السودانية وترسيخها لنموذج وطني لحوكمة الدولة، إلى جانب التوسع الكبير والملحوظ في العلاقات التجارية بين مصر والمجتمع الدولي خارج حدود إفريقيا، تعمل جميعها على دفع السودان ومصر على الظهور كجسر يسهل الوصول إليه، ومفتوح للجانب العربي للاستثمار في الموارد الوفيرة الموجودة في المناطق الجنوبية من القارة. ومع ذلك، لن يكون هذا المسعى مباشرًا وسهلًا، أو خاليًا من التحديات الكبيرة، وسيستمر تركيز فن الحكم في إعطاء أهمية للانخراط في الحقائق الموجودة على الأرض. ومن الأهمية بمكان أن نُدرك أنه سيكون هناك تركيز كبير على إيصال مفهوم إفريقيا إلى مصر أنه بالنسبة للكثيرين، كان مفهوم إفريقيًا متشابكًا تاريخيًا مع مسارات عربية محدودة ومنافذ ضيقة، التي غالبًا ما أدت إلى عرقلة ممارسة النفوذ والتوعية، التي يمكن أن تعزز التقدم. لذلك، فإن “اللحظة الاستراتيجية” الحالية، التي تكشفت اليوم تستدعي إطارًا قويًا يمكن من خلاله تفكيك الانقسامات العرقية بشكل فعال ومعالجتها بشكل علني، دون الوقوع في فخاخ تبادل الاتهامات الذاتية، أو العبء الثقيل للمظالم التاريخية، مما يضمن توحيد الجهود الجماعية في السعي لتحقيق هدف متسامٍ ومشترك يتجاوز الانقسامات ويؤدي إلى مستقبل واعد لجميع المعنيين.
لهذا، فإن هذا التدبير الخاص هو، الذي سيتطلب بشكل متزايد فهمًا عميقًا وحنكة سياسية إبداعية وخلاقة، فضلًا عن إضفاء الطابع المؤسسي المستمر والحاسم على علاقة فريدة ومؤثرة حقًا بين مصر والسودان. وفي الواقع، إذا كان التحليل المقدم في هذا المبحث صحيحًا، فإننا نجد أنفسنا على عتبة لحظة مهمة واستراتيجية في التاريخ حيث سيكون إنشاء قدرة قوية للدولة، جنبًا إلى جنب مع قوة اتفاق متبادل المنفعة والتوافق بين المساهمين، أمرًا ضروريًا لتطوير وتشكيل إطار العلاقة المستقبلية بين السودان والمفاهيم المختلفة، تعزز النوايا والأهداف، التي ترعاها مصر والسودان بنشاط وتلهمهما ويرغبان فيها بشدة. وستكتسب هذه العلاقة المتطورة أهمية فريدة، وستلعب دورًا رئيسًا لا غنى عنه في المسار المستقبلي للسودان خاصة وهو يشرع في رحلته ضمن نظام إقليمي معقد وصعب في كثير من الأحيان. وفي هذا المشهد المتقدم، تصبح أهمية العمل بشكل تعاوني وعن طيب خاطر للحكام الطبيعيين لهذا الفضاء الحيوي استراتيجيًا واضحة بشكل واقعيٍ ومنطقيٍ جدًا لكلا البلدين المعنيين. وبينما نتعمق في الآثار المترتبة على هذه الشراكة الحاسمة، يصبح من الواضح بشكل متزايد أن الجهود التعاونية المطلوبة لن تتطلب الثقة والتعاون المتبادل فحسب، بل ستتطلب أيضًا رؤية مشتركة تتماشى مع مصالح كل من مصر والسودان بطرق عميقة وذات مغزى. ولا شك أن تحقيق مثل هذا المواءمة سيتطلب حوارًا مستدامًا ومفاوضات مدروسة والتزامًا ثابتًا باستراتيجية طويلة الأجل تعزز الاحترام المتبادل والمنفعة لكلا البلدين. ولن يعزز هذا النهج البناء الاستقرار الإقليمي فحسب، بل يسهل أيضًا النمو والازدهار لكلا البلدين وهما يتنقلان بمهارة في تعقيدات مستقبلهما المتشابك في هذه الفترة الهامة. وبالتالي، من الضروري أن يُدرك الطرفان الأهمية التاريخية لهذه “اللحظة الاستراتيجية” وأن يعملا بشكل حاسم واستراتيجي لتسخير إمكاناتها الكاملة لشعبيهما وتأمين مستقبل أفضل معًا. وتكمن فرصة النمو هذه في إمكانية الشراكة لإنشاء إطار لا يوجه التفاعلات الدبلوماسية فحسب، بل ينمي التعاون الاقتصادي، الذي يرفع قدر كل من مصر والسودان في الساحتين الإقليمية والدولية.
_________
* السفير، الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، الأردن، واستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة سكاريا، تركيا
الجمعة، 02 مايو 2025
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.