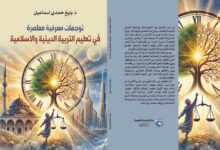اختراقات الطرف الثالث: مقاربات ومقارنات بين تعميق الانقسامات وكبح الأزمات

مقدمات:
نحاول في هذا الجزء الخامس من التحقيق الممتد لأثر “الطرف الثالث” وتدخلاته واختراقاته اتباع نهج مُقارَن ومُتناظِر لكشف طبقات هذا الأثر المعقدة، والفروق الدقيقة متعددة الأوجه لعمليات مُنَظِّرِيه ومُنَفِّذِيه بِشكل فعال. وللاستمرار أكثر في هذا الفحص الشامل، سأضع أمام القارئ المزيد من الأسس الإجرائية والمصطلحية، التي بُنِيَ عليها استفساري التفصيلي بدقة خلال المباحث، التي تقدمت، والتي شَرَحْتُ فيها دواعي الاهتمام في استعراض هذا الموضوع. فقد أوضحت أنني أفعل ذلك مستمدًا إلهامًا كبيرًا من عبارة الأمير الحسن حول “نظرية المؤامرة”، والإشارة الفَطِنَة لاختراق “الطرف الثالث” للقوى الثقافية والاجتماعية والسياسية المؤثرة، التي مِرَّ تِبيان زمان حديثه ومكانه في الجزء الأول من هذه المباحث، جنبًا إلى جنب مع ما توسعت فيه الإشارات للعمليات المتداخلة لإحداث التمايز والتفكك في المجتمعات العربية والإسلامية. وبعد أن استخدمت استعارة مثيرة للذكريات عن أحلاف سادت ثم بادت، سَمَّى بعضها سمو الأمير، نُشير إلى ما اشتملت عليه هذه الأحلاف من مقاصد لم يكن للمتحالفين فيها “ناقة ولا جمل”. لذلك، انتهت تلك التحالفات بأسباب موتها، التي قامت عليها، أو تلك المتعارضة مع طبيعة وأهداف الأطراف المتحالفة.
ومن نافلة القول، إن الهدف الرئيس لـ”الطرف الثالث” وراء الدفع لتأسيس هذه الأحلاف هو صَدّ المد الشيوعي، مع سعيه لتنشيط عمليات استخراج المندثر من الجذور الأثرية للجهوية والقبلية والعشائرية في الدول المتحالفة وجوارها العربي والإسلامي، التي أفسرها هنا بمعنىً عام، هو أن القوى المتنفذة؛ بعد أن أنجزت التحالفات، شرعَت في استغلال التنوع والتعدد والتشعب داخل المجتمعات الشرقية لاختراقها، وما فعله الغرب فيما يتعلق بالمعاني متعددة الأوجه المنسوبة إلى مختلف الجهات الفاعلة والوكالات الأوروبية الأطلسية المشاركة في الحراك الاستعماري الجيوسياسي يؤكد ذلك ولا ينفيه. ويُقدم هذا التفسير النظرة الشاملة للبيانات النقدية، إلى جانب الرؤى العميقة، التي شاركناها مع القارئ فيما مضى من مباحث. ومن خلال هذه العدسة التحليلية المصممة بعناية، التي اعتمدناها في هذه السلسلة من المقاربات، أُبْرِرُ عن قصد ٍخروجًا كبيرًا وهادفًا عن الدلالات السياسية والإقليمية التقليدية، التي تم تصورها وتأسيسها في الأصل من قبل صانعي “الأطلس” الأوائل لتصنيف الدول المختلفة، وإلقاء الضوء على الديناميات المعقدة لارتباطاتها وتفاعلاتها. ولا يسعى هذا النهج إلى تسليط الضوء على الخطاب المتطور حول هذه المفاهيم المترابطة بشكل متزايد فحسب، بل يهدف إلى تحدي وإعادة تقييم الروايات الراسخة، التي أثرت منذ فترة طويلة على فهمنا للاصطفافات السياسية والعلاقات الإقليمية في هذا المشهد المعقد.
واليقين عندي أن الاهتمام، الذي تجاوز تلك الحقبة من التاريخ، التي انقضت دواعيها بنهاية الحرب الباردة، يتحول الآن إلى العملية المركبة والمتعددة الأوجه لرسم النظام العالمي المضطرب والدقيق. لذلك، يُنظَرُ إلى الجغرافيا والديمغرافيا ذات الصلة، التي تعد جانبًا حاسمًا ومهمًا من هذا الفحص، في هذا الجزء الخامس، مما يقدم صورة أوضح وأوسع وأكثر شمولًا لمختلف المجالات المشاركة في هذا الخطاب الواسع لـ”نظرية المؤامرة”. ففي هذا الجزء من هذا التحليل التفصيلي، سأضع محورية “الطرف الثالث” جنبًا إلى جنب مع “نظرية المؤامرة” وأربطهما عكسيًا بالمفهوم الدقيق للهندسة الجيوسياسية المتغيرة. ومع ظاهرة إعادة رسم خارطة الإقليم الحاسمة، يسلط هذا الارتباط الضوء أيضًا على العديد من القضايا السياقية المهمة، التي أساءت “الأطراف الثالثة” إدارتها، وأسيء التعامل معها في الخطاب الاستعماري السابق، وينبغي أن يكون هدف جميع القوى الوطنية الفاعلة تصحيح سوء الفهم هذا بطريقة “تعميق” للتصورات بمناهج مركزة. ويتطلب هذا نستغرق الوقت الكافي لتعريف مصطلح “التعميق” وتوضيحه بجلاء، مع تحديد تمييز كبير وذي مغزى بين النتائج المتنوعة الناجمة عن المناقشات السياسية المحيطة بالمسألة الحرجة المتمثلة في التفكك الحادث في رؤى النُخب العربية، وتلك الناشئة عن المناقشات المستفيضة والشاملة، التي أجرتها الدراسات التكميلية لبعض مراكز البحث والتفكير في المنطقة. ويؤدي هذا الفحص والتحليل في النهاية إلى تصور حل للصراع المعقد والمتعدد الطبقات في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وهي نتيجة يُغلفها مفهوم “المرآة المعززة”، وهي فكرة أشير إليها على أنها برمجيات إقليمية في هذا السياق بالذات. وعلاوة على ذلك، فإن فكرة “الطرف الثالث”، التي وصفتها بأنها متناقضة في تصريف نفوذها، وليست متناقصة في تعدياتها، من المحتمل أن تصبح “الطرف الثاني” في الغد، خاصة ما نشهده من أدوار “الوكلاء” المحليين، إذ تُشير هذه الأدوار إلى تحول ملحوظ وعميق في الديناميات السائدة في هذا الإطار المعقد، مما يسلط الضوء على العلاقات والتفاعلات المتطورة، التي من المحتمل أن تُشَكِّلُ وتُؤثِّرُ على التطورات والتحولات المستقبلية في هذا المجال؛ في هذه المنطقة من العالم بالذات.
عودة إلى مفهوم الاختراق:
يتشكل مفهوم “الاختراق” عبر الشراكات؛ خاصة ما عهدناه حول الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي تتميز بشكل مركب من خلال شبكة معقدة ومتعددة الأوجه من الأطماع والتوقعات التاريخية والسياسية، التي هي ماثلة في عِظَم التحديات، التي يواجهها العالم الحديث، الذي نعيش فيه اليوم. وتظهر كديناميات متنوعة، غالبًا ما تكون مربكة، وخطيرة سياسيًا، التي يمكن أن تكون صعبة بشكل خاص للتنقل بين منعطفاتها. ففي العديد من البلدان، وفي سياقات مختلفة، لا يوجد مجتمع واحد يصرخ محتجًا عليها، أو حركة سياسية مهيمنة يُنظَرُ إليها على نطاق واسع على أنها قادرة على فرض إرادتها على الأغلبية من دون معارضة “الطرف الثالث”، أو وكلائه الإقليميين. وهذا الوضع متعدد الأوجه والمتضارب، في كثير من الأحيان، هو “أورويلي” بطبيعته بشكل خاص؛ إذا استحضرنا عمل جورج أورويل في روايته “مزرعة الحيوان”، لأن العديد من الأفراد في دول مختلفة لديهم معتقدات غير واقعية، تتأرجح بشكل كبير في أي من الاتجاهين، فيما يتعلق بالفكر الأساس الفردي، الذي يلخص ويعبر عن إرادة غالبية الناس. ولا يبني الصرح الواسع والمعقد للخطأ العالمي من اعتقاد خاطئ واحد، أو حتى مجرد معتقدين متعارضين، بل من عدد لا يحصى من المعتقدات المليئة بالتناقضات والتعقيدات، التي تؤثر بشكل كبير على التفاعلات ووجهات النظر العالمية. والغرض الأساس من هذا المبحث هو محاولة الخوض في فهم شامل فيما يتعلق بطبيعة بعض هذه الاتجاهات التاريخية والسياسية الأكثر لفتًا للانتباه وعمقًا، التي شكلت واقعنا. وفي الوقت نفسه، يهدف هذا العمل؛ في تمامه، إلى المساعدة في توضيح آثارها السياسية والدولية الهامة، وهو ليس بالأمر الهين، لا سيما بالنظر إلى عدد لا يحصى من وجهات النظر والتفسيرات، التي ينطوي عليها مثل هذا الخطاب. ونظرًا لأن هذه الأفكار تنطبق على العلاقة المعقدة بين الإرادة والحكم؛ فيما يتعلق بنتائج كل من النزاعات المدنية والاقتصادية، فإنني أسعى جاهدًا للتمييز بوضوح بين ثلاثة أنواع حاسمة وأساسية من التوقعات السياسية والتاريخية، التي تشكل تصوراتنا وفهمنا لهذه الديناميات: أولًا، التوقعات حول السلوك. بعد ذلك، التوقعات المتعلقة بالقدرات. وأخيرًا، التوقعات المتعلقة بالهيكل والتنظيم. وأبسط التوقعات، مما لا يثير الدهشة، تتعلق بشكل طبيعي بالسلوك والعمل. والفكرة الأساسية في هذا السياق بالذات هي أن أية انقسامات أولية في الرأي والمشاعر سيتم التعبير عنها بشكل كامل وحقيقي قدر الإمكان من قبل جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة. وهذا يعني أنه سيتم منح الأغلبية الشعبية الفرصة للتعبير عن إرادتهم وأفكارهم وآرائهم بحرية، وأن يتم ملاحظة نتائج هذا التعبير على النحو الواجب وتسجيلها وتوثيقها بدقة، على الرغم من أنه لا توجد منظمة اجتماعية واحدة تمتلك السلطة الشاملة للحكم، أو ممارسة السيطرة الأحادية الجانب على كامل المنطقة المعنية. ومن خلال تطبيق هذا المعيار المباشر، يمكن أن التأكيد بحزم أن كل حرب وأزمة أهلية تنتهي في نهاية المطاف باستئناف السلطة الفعلية من قبل الحكومة، أو السلطة الحاكمة، التي تمثل الأغلبية، أو على العكس من ذلك، مع خسارتها الكاملة، والتي تؤدي إلى تفكك وتحول دراماتيكي في الديناميات داخل المشهد السياسي الأوسع في الدولة.
السياق التاريخي:
في البدء، يحق لنا التساؤل: لماذا ظهرت مثل هذه الخلافات الشديدة والعميقة عندما خرج كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية في مواقع ذات قوة ونفوذ ساحقة؟ علاوة على ذلك، ما نوع التفاعلات القوية والسلبية، التي تبعتها حتمًا بين هاتين القوتين العظميين الهائلتين أثناء تنقلهما في واقع ما بعد الحرب؟ ويتطلب التفسير الشامل خطابًا مطولًا في الواقع، بالنظر إلى التعقيدات العديدة، التي ينطوي عليها ذلك. ومع ذلك، يمكن تقديم تفسير جزئي أكثر إيجازًا؛ تفسير يركز بشكل خاص على الفترة حتى عام 1989، عندما انتهت الحرب الباردة، بطريقة موجزة، ولكنها يمكن أن تكون مرضية تتماشى مع أغراضنا. فقد لعبت الطبيعة الأساسية لكل من الصراع الواسع النطاق أثناء تلك الحرب وتسويات السلام المختلفة، التي أدت في النهاية إلى انتهاء تلك الفترة المضطربة أدوارًا حاسمة في تشكيل مشهد ما بعد الحرب المعقد، الذي وجدوا أنفسهم فيه. وساهمت أحداث الحرب العالمية الثانية وما تلاها بشكل كبير في تشكيل الفجوة الهائلة، التي سرعان توسعت ما بين هذين العملاقين العالميين. وفي هذا السياق، أصبح المحاربون الرئيسيون في ذلك الصراع الكبير ينظرون إلى الهياكل السياسية والاقتصادية الدولية بطرق مختلفة بشكل لافت للنظر، مما أدى إلى سوء الفهم وتصاعد التوترات. ويعتقد كل جانب أن هذه الهياكل ستدعم سياساته على أفضل وجه، وتسهل تحمل أنظمته المتميزة، وتضمن أن تسود أيديولوجياتهم الاجتماعية الفريدة على المسرح العالمي، مما يعزز بيئة مهيأة للصراع والتنافس. ولم يؤثر هذا الانقسام الأيديولوجي على العلاقات الدبلوماسية فحسب، بل أرسى أيضًا الأساس لسلسلة من المواجهات، التي من شأنها أن تحدد العلاقات الدولية لعقود، مما خلق إرثًا لا يزال يؤثر على السياسة العالمية حتى اليوم.
وبطبيعة الحال، عادة ما تطالب القوى المنتصرة وتتوقع امتيازات خاصة في مفاوضات معاهدة السلام – بعبارة ملطفة ودون أي تردد. ومن الضروري أن ندرك أنها كثيرًا ما تؤكد نفوذها بطرق متنوعة، وقبل كل شيء، تمنح مؤسسات ومناصب رئيسة لصنع القرار من ذلك النظام من أجل إعاقة عودة ظهور أية تهديدات أمنية محتملة في المستقبل على أفضل وجه. وكانت هذه الممارسة موضوعًا متكررًا في أعقاب الصراعات العالمية. وكان هذا هو الحال بشكل خاص في عام 1945، عندما مارست القوى المنتصرة قوة عسكرية هائلة بطريقة كبيرة غيرت المشهد العالمي بطرق من شأنها أن يتردد صداها لعقود قادمة. وفي نهاية الحرب العالمية الثانية، وجد الاتحاد السوفيتي نفسه مكلفًا بلعب دور صانع القرار الرئيس في عالم أصبح فجأة بدون الولايات المتحدة البارزة، خاصة في الوقت، الذي فشلت فيه واشنطن في الحفاظ على دورها المهيمن في بعض الشؤون الدولية الأساسية. وترك مدى النفوذ والسيطرة السوفيتية في أوروبا الشرقية تلك القوة آمنة بقوة داخل حدودها، وكذلك في الأراضي، التي أثرت عليها. وخلق هذا الوضع شبكة معقدة من الديناميات السياسية. ونظرًا لأن تلك الهيمنة العسكرية الهائلة على مساحات شاسعة من أوروبا أخافت الولايات المتحدة وأساءت إليها، بشكل غير رسمي وخلف الكواليس، فقد خلط الحليفان في زمن الحرب معًا ببطء ما سيصبح انهيارًا كارثيًا في العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وهو صدع لم يسبق له مثيل في سجلات التاريخ السياسي، وتميز بالشكوك المتزايدة، والاختلافات الأيديولوجية، والمواجهة، التي من شأنها أن تخلف تداعيات عميقة على السياسة العالمية في السنوات، والتي تلت ذلك.
دراسات حالة لتدخلات الطرف الثالث:
من أجل التحقيق والتحليل لتأثير أنواع مختلفة من اختراق “الطرف الثالث” في العلاقات الدولية، نستخدم نهج تحليل متداخل في النظر داخل عددٍ من الحالات؛ كتطور العلاقات الدولية، وآليات التأثير، والرافعة الاقتصادية، والتلاعب السياسي، وغيرها. ويسمح لنا هذا النهج بفحص؛ ليس فقط الأثر الأساس لتدخلات “الأطراف الثالثة” أثناء الأزمات الدولية، ولكن الآثار المميزة والمختلفة، التي يمكن أن تحدثها مثل هذه التدخلات في أنواع مختلفة من الأزمات. ولتحديد وتوضيح آثار نطاق هذه التدخلات، نجري تحليلًا للتدخلات عبر مستويات مختلفة من التهديد والتدابير القسرية والأعمال العسكرية، ضمن هذه الفئات المحددة. ومن خلال النظر بشكل منهجي في هذين البعدين؛ النوع والنطاق، لتدخلات “الطرف الثالث”، فإننا نخلق تصنيفًا مفصلًا ودقيقًا يصنف أشكالًا مختلفة من تدخلات “الطرف الثالث” في الأزمات الدولية. وفي هذا التحليل، ننظر في عددٍ من الحالات التمثيلية، على أن يتم اختيار كل حالة من هذه الحالات بعناية لتمثيل نوع فريد من تدخل “الطرف الثالث” بناء على مجموعتنا الأولية من الأبعاد. ومن خلال ما بدأنا به هذا المبحث بمعاينة هذه الحالات ذات الصلة هذه، نكون في وضع جيد لتطوير فرضيات فيما يتعلق بخصائص وتأثيرات كل نوع من الأنواع المحددة لتدخل “الطرف الثالث”. ومن ثم يتم اختبار هذه الفرضيات المصاغة في التحليل متعدد الأبعاد اللاحق، الذي يتبع هذه المناقشة.
ولتحديد الأسباب الجذرية لظاهرة معقدة للغاية ويصعب ملاحظتها بدقة، مثل تدخل “طرف ثالث”، يصبح من الضروري تعميق استكشافنا وفهمنا بشكل كبير. وفي سعينا إلى تحقيق هذا الهدف الحاسم، كنا مهتمين بشكل خاص بالتحقيق الدؤوب في الأثر العميق، الذي تمارسه هذه التدخلات على مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في هذه السيناريوهات المعقدة، وكذلك على النطاق الأوسع للنظام السياسي الدولي ككل. وبالنظر إلى أن الهدف الأساس من هذا المبحث هو فحص الأنماط التفاعلية المعقدة المتأصلة في الأزمات، بدلًا من التركيز فقط على الحوادث المعزولة، أو الأحداث الفردية، التي قد لا تلتقط بشكل كامل الديناميات الشاملة في اللعب، فإننا نأمل مخلصين في اكتساب عمق أكبر من البصيرة في الديناميات الدقيقة لتدخلات “الطرف الثالث”. ويمكن أن يوفر لنا التحليل المستبصر لمجموعة متنوعة من تدخلات “الطرف الثالث” المستوى الأساس من العمق التجريبي الضروري للتوفيق بين هذه النماذج المتنافسة بشكل فعال. ومن خلال القيام بذلك، لا يمكننا فقط الكشف بشكل فعال عن الآليات الأساسية، التي تقود هذه الأحداث، ولكن أيضًا التغلب على أوجه القصور والقيود الملحوظة المرتبطة بالاعتماد فقط على النماذج الحالية، التي يتم اتخاذها بمعزل عن غيرها. وبالاعتماد على هذه الأدبيات الواسعة، يمكن للمرء أن يؤكد بثقة أن التناقض الأساس الموجود في الحجج المتعلقة بفعالية التدخل لا يعزى فقط إلى عدم الاهتمام بالأبحاث السابقة، أو الدراسات السابقة. بدلًا من ذلك، ينشأ هذا التناقض المستمر من الافتقار إلى الاهتمام الحقيقي فيما يتعلق بالطبيعة المعقدة والمتعددة الأوجه لتفاعلات الأزمات نفسها، التي غالبًا ما تكون متعددة الطبقات وتتأثر بعدد لا يحصى من المتغيرات. ويعد فهم هذه الأعماق أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة التحديات، التي تفرضها تدخلات “الأطراف الثالثة” في الشؤون العالمية المعاصرة.
تطور العلاقات الدولية:
لم تكن العلاقات بين الدول ذات السيادة تاريخيًا مسعى، أو مهمة سهلة، وغالباً ما تكون محفوفة بالتعقيدات والعديد من التحديات، التي يصعب التعامل معها بفعالية. وتعمل الانقسامات العميقة والراسخة الموجودة بين الدول على إعاقة وتعقيد مجموعة واسعة من الخيارات السياسية في مختلف المجالات. وتشمل هذه المجالات جوانب حاسمة مثل العمليات العسكرية والشراكات الاقتصادية وغيرها من المجالات الحيوية للعلاقات الدولية؛ وهي عناصر حيوية في نهاية المطاف لضمان الاستقرار العالمي. وقد غيرت التغييرات الجوهرية الرئيسة، التي حدثت في العلاقات الدولية على مر السنين فعالية نظم السياسات العالمية والإقليمية على حد سواء؛ تشمل هذه التغييرات أنظمة معقدة تعمل في قطاعات حيوية مثل التجارة والصحة العامة والديناميات السكانية والبيئة الحيوية. فقد أنجزوا ذلك من خلال التعديل الفعال للافتراضات الراسخة فيما يتعلق بسيادة الدولة وسلطتها والهوية الوطنية، التي كانت تاريخيًا بمثابة حواجز أمام التعاون المستدام بين الدول. ويوجد عامل أساس يؤثر بشكل كبير على هذه الديناميات المتطورة في الاتجاه الملحوظ نحو التحول الديمقراطي، الذي ظهر بشكل بارز في أواخر القرن العشرين. ويُوَلِّدُ هذا الاتجاه حوافز سياسية ومالية للحكومات القادرة على الصمود، وبالتالي تمكينها من حشد الدعم الشعبي الجماهيري بطرق تعزز بشكل فعال مبادرات السياسة الخارجية ذات الأهمية الكبيرة. ونتيجة لذلك، أصبحت الدول بشكل متزايد أقل مركزية في التشغيل الشامل للأنظمة الحديثة بين الدول، التي تحكم التفاعلات المعقدة بين هذه الدول في عالم معولم دائمًا. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التغيرات العميقة، فإن الانقسامات الدولية العميقة، التي لا تزال قائمة، إلى جانب التدخلات العسكرية البارزة للقوى العظمى، تعرض باستمرار سلطة الدولة وشرعيتها لضغوط شديدة ومستمرة غالبًا ما تتحدى أسسها، التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى عدم الاستقرار داخل تلك الدول. وتوجد مجموعة متنوعة من الاستجابات داخل المجتمع الدولي، التي تزيد من تقويض قدرة الدولة على إدارة شؤونها الداخلية وارتباطاتها الخارجية بفعالية. وقد تدفع مثل هذه الضغوط دولة إلى التفكير في تبني نهج بديل لتنظيم علاقاتها الدولية، مما يؤدي إلى إعادة تقييم عميقة للتحالفات والشراكات طويلة الأمد، التي حددت عادة موقفها الدبلوماسي. ومع ذلك، وفي خضم هذه الاضطرابات، فإن الترتيبات الجماعية، سواء من خلال برامج مثل مجلس حقوق الإنسان، أو مبدأ المسؤولية عن الحماية، إلى جانب القناة التقليدية لامتياز القوى العظمى، تقلل بنشاط من الحوافز لإصلاح ذي مغزى، أو تغيير كبير. وهذا بدوره يردع الدول عن اتخاذ خطوات جوهرية واستشرافية على الساحة الدولية. وكبديل لهذه التحديات، يمكن للدولة المستهدفة أن تسعى بنشاط إلى تحويل علاقاتها وارتباطاتها الدولية سعيًا لتحقيق توازن أكثر ملاءمة. وستمكن هذه الاستراتيجية الدولة من التنقل في تعقيدات المشهد الجيوسياسي بنجاح أكبر، وبالتالي تعزيز التعاون، الذي يحقق فوائد لجميع الأطراف المشاركة في العملية. وفي نهاية المطاف، فإن هذا التفاعل والتفاوض المستمر هو، الذي سيشكل مستقبل العلاقات الدولية حيث تسعى الدول إلى التكيف والازدهار في مواجهة الديناميات العالمية المتغيرة.
آليات التأثير:
يثبت فهم المزيد من الخصائص لتأثير “الطرف الثالث” أنه أمر بالغ الأهمية في أي سياق من الديناميات الجيوسياسية، لا سيما في المناطق، التي تتسم بالتوتر الملحوظ والصراع المستمر. وكما ذكرنا سابقًا، قد تنخرط العديد من الجهات الفاعلة العسكرية التابعة لجهات خارجية في مجموعة متنوعة من الإجراءات داخل مسرح النفوذ، التي تشمل كلًا من المجالات العسكرية وغير العسكرية، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على المشهد المحلي وتغير ميزان القوى. وعلى الرغم من وجود حالات تسعى فيها بعض الجهات الفاعلة من “أطراف ثالثة” إلى الحفاظ على موقف محايد تمامًا، مع التركيز فقط على الأعمال غير العسكرية والجهود الإنسانية، إلا أن هذا استثناء في المقام الأول وليس القاعدة الواسعة النطاق، التي لوحظت في الممارسة الفعلية. في الواقع، تميل الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغير الحكومية إلى السعي بنشاط لجذب وتجنيد أكبر عدد ممكن من المؤيدين المحليين لقضاياهم ومبادراتهم وأجنداتهم الأوسع. وبالتالي، عندما يتبين أن تحقيق عدم الانحياز والحياد الكاملين غير ممكن، لا سيما في المناطق المعقدة والمتقلبة في كثير من الأحيان؛ مثل شرق أوكرانيا، فإن هذه الأهداف كثيرًا ما تخضع لمجموعة متنوعة من التفسيرات الأكثر تعقيدًا بكثير مما يعترف به المجتمع الدولي، أو يفهمه عمومًا. وهذا الواقع متعدد الأوجه ينطبق حتى على أولئك الفاعلين الذين يُنظرُ إليهم عمومًا على أنهم يمتلكون نوايا حسنة وإيثار ورغبة صادقة في السلام والاستقرار. ومع ذلك، فإن الدافع المتأصل في هذه “الأطراف” لممارسة أكبر قدر ممكن من النفوذ محليًا يثير حاجة ملحة إلى وضع تعريف واضح وشامل للظروف المحيطة بوجودها ومختلف الآليات المعقدة المؤثرة في السياق الإقليمي. وفي الوقت نفسه، من الضروري النظر في العنصر الأساس للوصول التفاوضي إلى مختلف المناطق، وضمان ألا تتوج هذه العملية بتشويه ما يجب أن يشمله الحياد الحقيقي؛ وعدم الانحياز في هذا المشهد المعقد والديناميكي، الذي يزداد تعقيدًا. ويكشف التفاعل بين هذه العوامل بوضوح عن عمق وتعقيد تأثيرات “الأطراف الثالثة”، ويؤكد على ضرورة التقييم النقدي لأدوارها المتنوعة ضمن الإطار الجيوسياسي الأوسع حيث تستمر هذه التأثيرات في التطور والتكيف استجابة للظروف المتغيرة على الأرض.
الرافعة الاقتصادية:
يشير التأثير الاقتصادي البارز المتزايد؛ للصين مثلًا، على عدد كبير من شركاء الولايات المتحدة بقوة إلى أن صانعي السياسة رفيعي المستوى في تلك البلدان لديهم عمومًا مبررات جوهرية لتجنب فرض قيود على التهديدات السيبرانية الخطيرة والمقلقة، التي تشكلها الصين، والتي تواجه الولايات المتحدة إلى حد كبير. لذلك، فإن اتباع المبدأ القديم المتمثل في “لا تؤذي البلدان الأخرى لمصلحتك الذاتية المفترضة” هو في الواقع نصيحة حكيمة لا ينبغي إغفالها، أو تجاهلها باستخفاف. ويصبح هذا المبدأ التوجيهي أكثر أهمية عندما لا تكون الدول المشاركة في هذا التوازن الدقيق مجرد دول، بل بالأحرى أصدقاء مقربين وحلفاء موثوق بهم وشركاء تجاريين مهمين للولايات المتحدة. خاصة في السيناريوهات، التي يكون فيها الحفاظ على مشهد سيبراني متوازن أكثر قابلية للتطبيق اقتصاديًا وفيه فائدة استراتيجية. ومن دون تراكم التكاليف والأعباء الكبيرة المرتبطة بالحفاظ على المستوى الحالي من التفوق الدفاعي، يصبح من الضروري للولايات المتحدة تحديد تلك الدول، التي تشترك معها في مصالح حاسمة ومهمة، والاعتراف بها، وتحديد أولوياتها. ففي كثير من الأحيان، يمكن لكل من الولايات المتحدة والمتعاونين الدوليين معها جني فوائد ومكافآت أكبر إذا كانوا على استعداد لتقديم تنازلات هادفة واستراتيجية يمكن أن تخلق حوافز فعالة لهذه البلدان، إذا كان بمقدور الرئيس دونالد ترامب أن يتفق مع منظور كهذا. ويمكن أن تقودهم هذه الحوافز إلى التفكير بنشاط والتفكير في المشاركة في تحول سيبراني قادم ومحوري مستهدف. ويمكن لهذه الفرصة التحويلية للتعاون والتقدم أن تمكن كلا الطرفين المعنيين من الظهور كفائزين على المدى الطويل، وإقامة شراكة أكثر قوة ومرونة تصمد أمام اختبار الزمن والتحديات المشتركة، وتعزيز المنافع المتبادلة عبر مجموعة من المجالات الاقتصادية والسياسية. علاوة على ذلك، يصبح الأساس المنطقي للولايات المتحدة لممارسة ضبط النفس في موقفها واستراتيجيتها السيبرانية أكثر إلحاحًا عندما يفكر المرء بعناية في الدعوات والمطالب الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد سوء السلوك الصيني المتصور داخل المشهد الداخلي المعقد باستمرار للولايات المتحدة. ويتجاوز هذا السيناريو جهود الضغط المعتادة من مجموعات المصالح المختلفة، التي من المحتمل أن يكون المواطن العادي في الولايات المتحدة على دراية بها، والتي من المحتمل أن تدق ناقوس الخطر. بدلًا من ذلك، من وجهة نظر اقتصادية دقيقة، فإن الكيانات المختلفة، التي تستفيد إلى أقصى حد من مثل هذه الادعاءات، وردود الفعل اللاحقة، تتماشى تمامًا مع مبدأ راسخ في فلسفة الاستثمار في ريادة الأعمال: يتنافس رواد الأعمال بقوة نيابة عن أولئك الذين لا يساهمون ماليًا في قضاياهم. وكما رأينا في العديد من الحالات السابقة، لا تزال حكومة الولايات المتحدة تواجه سيناريو صعبًا حيث يتعين عليها التنافس ضد كيانات الأعمال العالمية القوية من أجل التفوق والإشراف على عوامل الإنتاج الهامة، التي تعتبر مفيدة في سوق تنافسية وديناميكية بشكل متزايد، لا التشفي في فرض الضرائب على سلع الغير. ويؤكد هذا التفاعل المعقد بين مصالح الحكومة وأولويات الأعمال على إرباك الوضع وضرورة التفكير الاستراتيجي في معالجة التهديدات السيبرانية، التي تشكلها القوى الأجنبية مثل الصين مع الحفاظ على علاقات دولية قوية.
التلاعب السياسي:
إن هناك عنصر هام آخر في وظيفة “الجسر”، أو “الوكيل”، الذي يمر عبره “الطرف الثالث” ينطوي على نهج أكثر نشاطًا ووضوحًا للتلاعب السياسي، بما في ذلك الرعاية المباشرة للميلشيات، والحركات المتمردة، والإرهابية، ودعمها. وفي هذا السيناريو بالذات، يُشير وجود علاقات مستمرة ومنتظمة بين القوى الخارجية العدوانية و”الوكلاء”، وهذه الجهات الفاعلة غير الحكومية؛ المفترسة في كثير من الأحيان، إلى أن السيطرة على هذه القدرات التدميرية يمكن الاستغناء عنها إلى حد ما، أو أقل أهمية بالنسبة لرعاتها. وتُشيرُ هذه الملاحظة إلى أن هذه الرعاية تزدهر في سياقات تتمتع فيها الجهات الفاعلة بثقة عالية نسبيًا في قدرتها على إدارة ومراقبة الديناميات التصعيدية الناتجة عن ذلك، فضلًا عن إمكانية الوصول إلى مختلف القنوات المؤسسية، أو السياسية، التي غالبًا ما تعمل على ستر مثل هذه الأنشطة، أو إخفائها عن الأنظار. علاوة على ذلك، تُشيرُ هذه الديناميات إلى أن التكاليف المتصورة المرتبطة بالكشف عن تلك العلاقات المعقدة من قبل المستويات العليا، أو الأقل قليلًا من الدبلوماسيين تفوق بشكل كبير الفوائد المتوقعة، التي تأتي من الحفاظ على مثل هذه الانتماءات والشراكات في السعي لتحقيق أجنداتهم وأهدافهم الأوسع.
لهذا، ليس من الواضح على الفور، كمسألة تجريبية، ما إذا كانت الجهات الفاعلة الخارجية العدوانية متورطة بشكل، أو بآخر في أي سياق استراتيجي معين للعلاقات الدولية وحركات تمرد محددة سلوكيًا. وبهذا، فإن إمكانية الحساسية والحجم التفاضلي بين الدوافع المنتظمة للديناميات الدولية تعني أن طلب مؤشرات تجريبية معقولة غالبًا ما يقود المرء إلى طريق أسوأ من نوع الخيارات، التي يتعمد تصعيدها “الطرف الثالث”. إن هذا المسار محفوف بالمزالق، وهو أمر يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تآكل الثقة بشكل كبير في الانتظام التجريبي، الذي ينخرط به علماء العلاقات الدولية ويصوغون نظرياتهم. ومع ذلك، فإن هذا يمثل سيناريو افتراضيًا جوهريًا حيث يمكن أن يكون المنطق الاستراتيجي، عند دمجه مع الأدلة اللاحقة، مفيدًا للغاية في تحديد الفروق ذات المغزى فيما يتعلق بالمشاركة العسكرية لـ”الطرف الثالث”، التي تأتي مع سياقات ومسارات تصعيدية فريدة خاصة بها. وينبغي أن يُنظر إلى هذا الفهم على أنه خطوة أولية، ولكنها حاسمة في الاختبار والتصنيف في المستقبل في مجال العلاقات الدولية المعقد. وهو يدعو إلى استكشاف أعمق في الفروق الدقيقة في كيفية تعامل القوى الخارجية مع حركات التمرد المحلية والآثار الجيوسياسية الأوسع لتلك التفاعلات، مما قد يفتح آفاقًا للبحث الأكاديمي الأكثر قوة والتطبيقات العملية في استراتيجيات حل النزاعات وجهود صنع السياسات.
التدخل الثقافي:
إن محاولة فرض قواعد غريبة وغير ملائمة داخليًا، فضلًا عن لوائح على الدول الأخرى، تحمل تداعيات ثقافية سلبية أخرى لا يمكن إغفالها، وهي تدخل لا يمكن تبريره، وهذه مسألة تستحق اهتمامًا دقيقًا. ففي المقام الأول، توجد الأشكال الثقافية، مثل أي مؤسسة أخرى، كحالة “سيادية” شديدة الخصوصية، لأنها تلبي بنجاح بعض الاحتياجات البشرية المتأصلة، التي تتجاوز الحدود الجغرافية. ومن المرجح أن تمتلك الشعوب المختلفة والمجتمعات المتميزة متطلبات ثقافية مختلفة فريدة من نوعها لسياقاتها الخاصة وتجاربها التاريخية. وينطبق هذا بالتأكيد على الوظائف المتعددة والأدوار المعقدة للدول والحكومات في جميع أنحاء العالم، التي تختلف اختلافًا كبيرًا بناء على تاريخها المحلي ومعاييرها المجتمعية. لذلك، فإن فرض المؤسسات الغريبة على الشعوب غير الراغبة هو عمل يمكن أن يكون له تأثير مضاعف عميق، وربما ضار على تلك المجتمعات، مما يؤدي إلى السخط والمقاومة. فقد أصبح هذا المفهوم بديهيًا تقريبًا بالنسبة للدول ويتحقق بشكل متزايد في الطبيعة المترابطة لعالمنا المعولم، ويجب أن ينطبق على الدول المنخرطة على المسرح الدولي. وعندما نسمح للعلاقات والالتزامات بأن تنفجر في ظل سياسات القوة للمنظمات الدولية، إلى جانب القرارات المثيرة للجدل في كثير من الأحيان، التي تتخذها هذه المنظمات نفسها، فإن ذلك لا يؤدي إلا إلى زيادة تشويه الخلل غير المستقر بالفعل الموجود في مفهوم المجتمع الدولي. ويضعنا هذا التشويه في مواجهة أزمة ملحة تعتور العالم الآن أكثر من أي وقت مضى، ويضعنا على مفترق طرق فيما يتعلق بـ”النزاهة الثقافية”. ومن الضروري النظر بعناية في التداعيات البعيدة المدى لهذه الإجراءات على الصعيد الدولي، لأن تجاهل احتياجات ورغبات الثقافات المختلفة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات وتعميق الانقسامات المجتمعية، مما يؤدي إلى صراعات كان من الممكن تجنبها من خلال نهج أكثر احترامًا وتفهمًا.
ولهذا، فإن المؤسسات المشتركة بين الدول والمؤسسات الشعبية، إلى جانب المفاهيم المختلفة، لها أهمية لا يمكن التقليل من شأنها وتلعب دورًا حاسمًا بشكل استثنائي في تشكيل المشهد العالمي المعقد، الذي نراه اليوم. وهناك عمى ثقافي مستمر وموجود داخل المجتمع الدولي فيما يتعلق بفرض مجموعة من الأطر المختلفة لحماية الأقليات والنماذج المتنوعة للحكم الديمقراطي. وغالبًا ما ينظر إلى هذه الأطر على أنها مجالات تقليدية للمشاركة؛ أو هي تصورات سائدة بشكل خاص عندما يتم تطبيقها على المجتمعات، التي تعاني من تحديات وجودية وهي في عملية شاقة لدرء الاضمحلال. وحتى في غياب مثل هذا التشويه الثقافي الصارخ، يظل تقديم المساعدات للدول الناجحة والقوية تحديًا هائلًا للدول الأخرى، التي تتصارع مع التدهور والانحطاط والعواقب المتعددة الأوجه للتفكك المجتمعي. وتتضمن الاستراتيجية العامة لتقديم المساعدة بشكل فعال إلى مؤسسة ضعيفة بشكل عام تعريض تلك المؤسسة لأمثلة خارجية للصحة والحيوية. وهذا النهج أكثر إنتاجية بكثير من محاولة حثه على وقف التحولات الجارية، التي قد تكون في الواقع ضرورية لبقائها على المدى الطويل. ويجب تطبيق هذا المبدأ التوجيهي نفسه على الدول، وخاصة تلك، التي تتصارع درجات سيادتها الدنيا مع عمليات التغيير والتطور والتكيف المعقدة والمعقدة، والتي تعتبر حيوية للغاية لبقائها ونجاحها في عالم دائم التطور وسريع الخطى. ومن خلال تقديم المساعدة، التي تعطي الأولوية للإضاءة والفهم والصحة، يمكننا تنمية بيئة يصبح فيها التعافي والتنشيط حقًا احتمالًا ممكنًا. وهذا بدلًا من مجرد فرض نموذج ثابت يخاطر بالفشل في مراعاة التحديات الفريدة والمحددة، التي يواجهها كل مجتمع على حدة، وربما يتجاهل سياقاته واحتياجاته الثقافية المميزة.
التأثير على السياسة الداخلية:
يثير تفاعل الوضع، الذي يمكن اعتباره في أسوأ الحالات وضعًا محفزًا على الانقسام، ولكن بدلًا من ذلك يمكن اعتباره أفضل توسيع لقاعدة الدعم للحكومة القائمة، في أي بلدٍ ذي سيادة. لذلك، تطرأ العديد من الأسئلة الهامة حول كيفية تأثير هذا الوضع على استجابات السياسة المحلية الضرورية. وعلى وجه التحديد، يستدعي الاستفسار هذه الصيغة من التساؤلات: هل تقدم المساعدة اللازمة أم على العكس من ذلك تخلق عقبات هائلة أمام السلطة التنفيذية في سعيها لتحقيق الهدفين الأساسين اللذين يدعمان سلطتها على المسرح الدولي؟ بالإضافة إلى ذلك، هل يضمن هذا السيناريو استمرارية السياسات المختلفة، التي تشارك فيها الحكومة حاليًا؟ علاوة على ذلك، من الضروري التفكير فيما إذا كانت الأزمة الأمنية الحادة تشكل بالفعل تحديات كبيرة للأداء الإداري على المدى الطويل، مما يؤدي إلى ضغط شعبي واضح يتطلب اتخاذ قرارات تنفيذية سريعة وحاسمة. وبدلًا من ذلك، هل يمكن أن تجد السلطة التنفيذية نفسها عالقة بشكل غير مستقر بين الصخرة والمكان الصعب، في مواجهة بديلين ضارين ونافعين على حد سواء بأي تقدم ذي مغزى؟ وقد يواجه الدعم الشعبي تحديًا بطرق معقدة، ولكن من الأهمية بمكان الاعتراف بأن هذا الدعم يجب ألا يُفْقَدُ بالضرورة تمامًا. علاوة على ذلك، تلعب الطريقة، التي تختار بها الحكومة الاستجابة للأزمات دورًا محوريًا في تشكيل مفهوم المجتمع السياسي نفسه. وتُشِيرُ هذه العبارة المختصرة إلى العملية المعقدة والأساسية، التي ينظم المواطنون من خلالها أنفسهم ويحشدون أنفسهم بنشاط من أجل السعي وراء رؤية مشتركة للصالح العام. وتشمل هذه الرؤية بطبيعتها تطلعاتهم وأهدافهم وغاياتهم الجماعية في السياق المجتمعي الأوسع، مما يؤكد بشكل أكبر على الحاجة إلى قيادة متماسكة ورحيمة خلال الأوقات المضطربة.
وعبر هذه الرؤية سيختبر الجميع بدقة التزام الحكومة الثابت والراسخ، ليس فقط في السياق الضيق لصياغة سياسات فعالة لمواجهة التهديد الأمني الديناميكي المتطور باستمرار، الذي يلوح في الأفق، ولكن أيضًا في ضمان بقاء البنية التحتية المحلية مرنة وقوية بما يكفي لمواجهة هذا التهديد المستمر بفعالية وكفاءة. ويثير هذا الوضع الملح قضايا حرجة ومعقدة للحكومة تتعلق بالمفاهيم الأساسية للحكم والمبدأ الدقيق للتبعية، مع التأكيد بوضوح على أن الأمن ليس مجرد حق، أو مجال للسلطة المركزية. وقد تكون السلطة التنفيذية قادرة بالفعل على تقديم استجابات سياسية رمزية فقط وإجراءات جوفاء وغير جوهرية. ومع ذلك، فإن مثل هذه الاستجابات ليست كافية على الإطلاق لتلبية الطلب الشعبي المتزايد على الأمن والاستقرار داخل المجتمع. والواقع أن السلطة التنفيذية تواجه خيارات متزايدة الصعوبة ومعضلات معقدة تتطلب دراسة متأنية. وقد تكون هناك حاجة إلى بذل جهد وطني شامل وتضحية محتملة في أوقات الأزمات للتصدي بفعالية لهذه التحديات المتعددة الأبعاد. ففي حين أنه قد لا يكون من المجدي، أو العملي التعامل بشكل شامل مع الأسباب الجذرية للأزمات المطروحة، إلا أنه تظل المسؤولية القصوى، التي لا يمكن إنكارها للحكومة هي معالجة عواقبها بعيدة المدى والعميقة؛ أي الدعم المستمر والثقة، التي لا تتزعزع من المجتمع السياسي ومكوناته. ويمكن لمثل هذه الجهود المتضافرة أن تعمق وترسخ بشكل كبير التمييز العام الحقيقي الناشئ بين سياسة الدولة الشجاعة والحكومة المِقْدَامَة، مما يضمن تقديم بعض أحكام الرعاية الاجتماعية المحدودة والأساسية مقابل الشعور بالأمن والاستقرار، وبالتالي تعزيز بيئة يشعر فيها المواطنون بالحماية والتقدير في النسيج المجتمعي.
استقطاب الأحزاب السياسية:
يمكن تَوقُع أن يؤدي الاختراق المتزايد والتأثير لمنظمات الأحزاب السياسية في جميع أنحاء البلاد “تعميق الانقسامات السياسية والعرقية”، الذي غالبًا ما يجلب معه مجموعة متنوعة من العواقب السلبية على أعضاء الطيف السياسي المتعدد، ويفاقم من زيادة ترسيخ وتفاقم هذه الانقسامات العرقية والسياسية العميقة والآخذة في الاتساع الموجودة بشكل بارز في المجتمع اليوم. وقادة الأحزاب السياسية ليسوا مُصَممين للغاية فحسب، بل لديهم دوافع شرسة، ويميلون استراتيجيًا إلى بناء منظمات موحدة ومنضبطة وغير معرضة للخطر. وقد جرى تصميم هذه الكيانات الخاصة بدقة لتحمل العديد من الضغوط والتحديات الخارجية، التي يمكن أن تنشأ في المناخ السياسي الحالي المضطرب. ويتأتى هذا الإصرار الدائم من الحاجة الملحة إلى الحساسية الشديدة لكل من ناخبيهم والحزبيين المخلصين والموثوق بهم الذين يشكلون العمود الفقري لأنظمة الدعم المعقدة الخاصة بهم. وبالتالي، حفزت هذه الحساسية الواضحة ظهور سياسات إسفين راسخة، مصحوبة بالعديد من إجراءات الحرس الخلفي، واستراتيجيات المُفْسِد المختلفة، التي يتم استخدامها بشكل متكرر واستراتيجي لتقويض المعارضة. والنتيجة الشاملة لهذه المناورات السياسية متعددة الأوجه والمعقدة هي التخصيص المستمر للدوائر التشريعية الفيدرالية والولاية غير التنافسية إلى حد كبير. ويعمل هذا التخصيص المتسق على تعزيز السلطة بقوة داخل فصائل سياسية معينة، مما يخلق حواجز لا يمكن التغلب عليها أمام أي منافسين قد يحاولون الانتفاض ضدهم.
بالإضافة إلى كل ذلك، هناك قطع روتينية ومتكررة للقواعد والمعايير الإجرائية المعمول بها للحزب المعارض داخل البرلمانات، مما يجعل التقدم التشريعي مسعى مضطربًا ومثيرًا للجدل في كثير من الأحيان، ومحفوفًا بعدد كبير من التحديات. وتؤدي هذه الديناميكية المتطورة إلى مكانة متزايدة وسلطة كبيرة لجماعات الضغط المستقلة، والمنظمات ذات القضية الواحدة، ووكلاء “الطرف الثالث”، ومجموعة واسعة من الأحزاب السياسية المتزاحمة، التي تعرف نفسها بنفسها، كل منها يسعى جاهدا للحصول على موطئ قدم مرغوب فيه في ساحة سياسية مجزأة ومثيرة للجدل بشكل متزايد. ولا تشمل العواقب غير المقصودة وغير المتوقعة في كثير من الأحيان لهذه الاتجاهات السائدة مجرد تحول، ولكن تغييرًا جذريًا تندمج فيه “الأطراف الثالثة” وجماعات الضغط المستقلة بشكل متزايد وبشكل لا ينفصم في الآلية المعقدة والمعقدة لمجمع الضغط العسكري الصناعي والبرلمان. وغالبًا ما تجد هذه الكيانات، التي كثيرًا ما تكون ذاتية الاستدامة ومشبعة بدافع متحمس للتأثير، نفسها في موقف يجعل عملياتها غير قابلة للحكم على الإطلاق. وكنتيجة مباشرة لهذا الوضع السائد، اندمجت هذه المجموعات في تكتلات قوية ذات مصالح خاصة تلعب الآن دورًا محوريًا وحاسمًا في تحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف والغايات السياسية والحوكمة الهامة. وبمرور الوقت، أنضجت منظمات الأحزاب السياسية نفسها وتطورت بشكل كبير، وخضعت لتحولات عميقة، وانتقلت في النهاية إلى أتباع وطنيين، أو، في حالات مختلفة، أصبحت متشابكة بشكل معقد في النظام المعقد للمجلس التشريعي، أو ما يمكن تسميته بـ”معمل الصناعة العرقية”، التي تميز البيئة السياسية المعاصرة، والتي نتنقل فيها ونتعامل معها اليوم.
تآكل السيادة:
لهذا، ولكل ما سبق، فإن التأثير الجوهري والأكثر عمقًا للعمليات، التي يتم تمكينها من خلال الإنترنت يتمثل في التآكل المطرد والمستمر للسيادة على نطاق عالمي، مما يؤثر على الدول بطرق مختلفة متعددة الأوجه. ففي عالم اليوم الرقمي والمترابط للغاية، يمكن في كثير من الأحيان النظر إلى “تآكل السلطة” هذا على أنه أكثر تهديدًا من العمليات العسكرية التقليدية المختلفة، التي تنطوي عادة على مواجهات علنية ومرئية، غالبًا ما يتم شهدها على نطاق أوسع بكثير. وقد أصبح الحرمان من الوصول إلى المشاعات العالمية الحاسمة للتجارة والتمويل والاتصالات أكثر فعالية في فرض إرادة المشغلين من مجرد التعدي على الأراضي المادية، أو التدمير التام للمنتجات والبنية التحتية الحيوية للدول القومية. وبدلًا من أن تكون السيادة بمثابة حجر الزاوية للتنمية المستقلة والناجحة، التي كانت تتمتع بها الدول ذات يوم، أدت الإجراءات، والتي يتم تمكينها عبر الإنترنت، إلى تآكل أسس الاعتماد على الذات، التي كانت تعتمد عليها الدول في يوم من الأيام وتعتز بها. ويحدث هذا الضرر على مستويين متميزين ومترابطين، ويبلغ ذروته في نهاية المطاف في تأثيرات واسعة النطاق وشديدة في كثير من الأحيان يمكن أن تزعزع استقرار الهياكل القائمة. وعلى مستوى السياسات، غالبًا ما تكون ردود الفعل والاستجابات من الحكومات على العمليات، التي يتم تمكينها عبر الإنترنت متوقعة، بل ونمطية بشكل مثير للقلق، مما يؤدي إلى نوع من الجمود السياسي، الذي يعيق العمل الفوري والفعال لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، تبذل حكومات أخرى محاولات جادة لتكييف سياساتها الخاصة ردًا على ذلك، وأحيانًا تكون ببطء شديد بحيث لا تتناسب مع التطور السريع للتهديدات السيبرانية، التي تشكل مخاطر كبيرة. وعلى مستوى المشغل، يبدو أن هؤلاء الممثلين دائمًا متقدمون بخطوة واحدة، ويبتكرون باستمرار. وبحلول الوقت، الذي يتم فيه صياغة هذه السياسات ووضعها موضع التنفيذ بعناية، يتم التحايل عليها بالفعل من قبل مشغلين ماكرين يتكيفون بسرعة مع نقاط الضعف ويستغلونها، مما يجعل هذه التدابير غير فعالة، وبالتالي تضخيم وتسليط الضوء على التحديات الهائلة، التي تواجهها السيادة في عصر الحرب الرقمية المتطور باستمرار، والفوضوي في كثير من الأحيان.
وتشير الآثار المترتبة على العمليات الاقتصادية المدعومة بالإنترنت إلى تصعيد حاد للنزاعات والأزمات الكامنة على نطاق واسع، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير المشهد المعقد للعلاقات الدولية. وعندما يقع هجوم إلكتروني متعمد، يجب الاعتراف به بشكل لا لبس فيه باعتباره عملًا من أعمال الحرب، وهو عمل يشمل عواقب عميقة وبعيدة المدى يمكن أن تموج عبر جوانب مختلفة من المجتمع والحكم. وغالبًا ما تؤدي الآثار التجارية لهذه العمليات إلى تفاقم السخط الشعبي بين السكان، الذي بدوره يقوض القوة النسبية للحكومات في مقاومة الضغط الشعبي المتزايد وإدارته ومعالجته بشكل فعال. ويمكن لهذا الوضع المحفوف بالمخاطر، الذي يتسم بديناميات معقدة، أن يحرف السياسات الوطنية نحو المواجهة والعداء، بدلًا من وضع العمليات، التي يتم تمكينها عبر الإنترنت كمكون استراتيجي لترسانة متوازنة من التهديدات والاستجابات. ويجب أن تهدف مثل هذه الترسانة إلى تعزيز التفاني المزعوم للحفاظ على السلام والتعاون والاستقرار داخل الدول وبين المجتمع الدولي. ففي العصر الحاضر، تطورت الجنايات السيبرانية لتصبح نقطة محورية غزيرة للمواجهة والصراع العالميين، مدعومة بشكل متزايد بميزانية متزايدة باستمرار من الموارد المالية، التي تخصصها الدولة، وكلها تهدف إلى قمع ومكافحة هذه التهديدات الرقمية الهائلة. وتمتد هذه الصراعات المتصاعدة، التي تغذيها العديد من التهديدات والإجراءات السيبرانية، إلى ما هو أبعد من آثارها المباشرة. وهي تساهم في نمط دوري من التوتر لا يزال يضاعف القضايا المجتمعية، ويؤدي إلى تفاقم المظالم الموجودة مسبقًا، وتوتر العلاقات الدولية بشكل كبير بطريقة تثير مخاوف جدية للمجتمع الدولي ككل. وتتطلب التحديات، التي يفرضها هذا البعد الجديد من الحرب اهتمامًا عاجلًا واستراتيجيات استباقية لإدارة التداعيات المحتملة والحفاظ على الاستقرار عبر الحدود.
الآثار الاجتماعية:
إننا نعلم أنه في إطار الجهود الدؤوبة والمتضافرة لاستخلاص استنتاجات هامة وبعيدة المدى في مجال السياسات، من الضروري، والحاسم بنفس القدر، لفت الانتباه إلى التطورات الاجتماعية العديدة والطرق العديدة المعقدة والمعقدة، التي يمكن أن تُشَكًّل بها سياسة متطورة لاختراق “طرف ثالث” تهديدات كبيرة وخطيرة للتماسك الاجتماعي داخل مختلف المجتمعات. ومن أكثر عناصر المجتمع غير المفهومة والأكثر تعقيدًا هي أسباب الانقسام المعقدة والمتعددة الأوجه بين مختلف الفئات، فضلًا عن العناصر الحيوية والحاسمة، التي تعزز التماسك والوحدة في بيئات اجتماعية متنوعة. لذلك، فإنه لأمر رائع حقًا ومقلق إلى حد ما مدى ضآلة فهمنا في الواقع؛ أي مدى محدودية فهمنا، ومدى قلة الأبحاث الشاملة، التي تم إجراؤها حول سبب قدرة مجتمعات معينة، أو مجموعات معينة داخل المجتمعات على الاحتفاظ بالتماسك والوحدة عندما تواجه محنة كبيرة، بينما يبدو أن البعض الآخر ينهار، أو يسقط تحت ضغط مستمر وتحديات تختبر قدرتهم على الصمود. وتلعب المؤسسات دورًا حاسمًا في هذه الديناميكية بشكل لا يمكن إنكاره، لا سيما في كيفية التوسط والتأثير على التخصيص المستقبلي لأنواع مختلفة من رأس المال، إلى جانب المستوى الكبير من الرقابة الاجتماعية الضروري للحفاظ على الإيمان الجماعي بالمستقبل وبمفهوم التقدم، الذي له بالفعل تأثير عميق ودائم على الروح الاجتماعية الأوسع، والتماسك وروح المجتمعات المعنية. ومع ذلك، لا بد من ملاحظة أن التماسك الاجتماعي هو جزئيًا محلي الأصل وتحقق ذاته بطبيعته. ومن المرجح أن يشهد المجتمع، أو المجموعة الاجتماعية، التي تعتقد حقًا أنها تمتلك آفاقًا كبيرة لمستقبل أكثر إشراقًا وتفاؤلًا وملهمة للانخراط في العمل الجاد والإبداع، وإنشاء العديد من السلع والخدمات والمؤسسات، والتي تتماشى بشكل فعال مع معتقداتها المتفائلة، من المرجح أن تشهد مستوى معيشيًا لا يمكن إغفاله ومعززًا بالفعل، وإحساسًا عامًا أكبر بالتقدم، والإنجاز في الحياة والمجتمع. وعلى العكس من ذلك، فإن المجتمع، الذي يتسم بتوقعات متدنية وتكهنات قاتمة متشائمة من المرجح أن يقبع للأسف في حالة من الفقر واليأس، ويكافح ضد الصعاب مع أمل ضئيل في الصعود، أو التحسن الملموس. وغالبًا ما يكون أفقر الأفراد في العالم هم أولئك الذين يستثمرون قدرًا مفرطًا من وقتهم في القلق والمجادلة مع أصدقائهم وعائلاتهم، وغالبًا ما يتجاهلون استثمار الوقت الكافي في الاعتراف وتقدير ما هو عادة عالم سخي وراعي ومتسامح يحيط بهم ويوفر الكثير من الإمكانات للتواصل والنمو. والمعنى الضمني هنا هو أن أحد التهديدات الكبيرة، التي تشكلها سياسة اختراق “طرف ثالث” هو تأثيرها الضار المحتمل على التماسك الاجتماعي، لأنه لا ينطوي على تغيير أساس وربما مدمر في عبء الضرائب وتخصيص الموارد بمرور الوقت فحسب، بل يستلزم تحولًا حاسمًا وأساسيًا في الروح والهوية الوطنية، التي تمت رعايتها، وتطويرها وصيانتها على مر الأجيال. وتلمح مثل هذه السياسة إلى الحاجة الملحة لفرض مستوى معين من الرقابة الاجتماعية لا يتماشى بالضرورة مع الأنماط والأطر التاريخية للمعتقدات والقيم، التي شكلت المجتمع المعني على مر السنين، مما قد يؤدي إلى مشاعر الاغتراب والانفصال والاغتراب بين أفراد المجتمع.
التصور العام للتأثير الأجنبي:
يولد التأثير الأجنبي العديد من المعضلات المباشرة، التي تنطوي على تفاعل معقد ومتعدد الأوجه بين القيم الديمقراطية العزيزة لحرية التعبير والتعبير الفردي والمشاركة السياسية، جنبًا إلى جنب مع الضرورة الملحة والمستمرة لحماية مجتمع الفرد وثقافته من الأفكار، أو الأفعال الضارة المحتملة، التي قد تقوض، أو تشكل تهديدًا خطيرًا لمؤسساته الأساسية وقيمه الجوهرية. وعلى مدار التاريخ، أظهر الرأي العام بوضوح مقاومة ورد فعل على النفوذ الأجنبي، وغالبًا ما كشف عن المشاعر المتأصلة بعمق والمخاوف الكبيرة، التي تحيط بهذا الموضوع المثير للجدل والاستقطاب. وتميل الحركات المناهضة للأجانب، التي تغذيها المشاعر والمخاوف المتزايدة، إلى اكتساب عنفوان وقوة جذب ملحوظة، خاصة خلال الفترات، والتي تتسم بعدم الاستقرار الدولي، أو الحرب، أو الاضطرابات الاقتصادية. ففي هذه الأوقات المضطربة، التي يسود فيها عدم اليقين، يتحول الخوف من الغرباء إلى أداة قوية يمكن التلاعب بها بسهولة من قبل مختلف الفصائل. وغالبًا ما تتفاقم بسبب الميول الكامنة وراء كراهية الأجانب، التي تكمن في أعماق نسيج الهوية الوطنية، مما يجعل عامة الناس أكثر عرضة بشكل ملحوظ للروايات المثيرة للانقسام، والتي تلعب على هذه المخاوف المخيفة. وتبرز القومية كقوة قوية ومؤثرة بشكل ملحوظ في مثل هذه الأوقات المضطربة، ويمكن لمظاهرها المتطرفة بشكل متزايد أن تولد تفاوتات كبيرة في المواقف تجاه مجموعة متنوعة من القضايا؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية وقبول الأفكار والمفاهيم الأجنبية، أو رفضها الصريح. وتعمل القومية كقوة موحدة مقنعة، تجمع بشكل فعال بين المجموعات المتنوعة والمتباينة، التي قد تظل منقسمة داخل نظام حكم واحد، من خلال تعزيز شعور قوي بالمجتمع المشترك والهوية الفريدة والانتماء. وغالبًا ما يرتبط هذا الشعور العميق بالانتماء ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الهوية والتراث العرقيين الفريدين، مما يؤدي ليس فقط إلى الاحتفال بالممارسات الثقافية، ولكن أيضًا إلى استكشاف الجوانب السلبية المرتبطة بالقومية غير الخاضعة للرقابة، التي تسلط الضوء على عناصر ضارة مختلفة. ويؤكد على مجموعة من القضايا مثل كراهية الأجانب، والسعي الدؤوب إلى السيادة الإقليمية، والرغبة العميقة الجذور في الحفاظ على السيطرة على مصير المرء ومستقبله وتوجهه المجتمعي. وفي أكثر تعبيراتها تطرفًا، دفع التوق إلى عودة لا لبس فيها إلى القيم والأعراف الوطنية التقليدية؛ لا سيما في أعقاب الصراع الداخلي، أو الأزمات الناجمة عن الانكماش الاقتصادي، أو التغيرات المجتمعية الكبيرة، دولًا بأكملها ومواطنيها إلى صراعات حادة، وغالبًا ما تكون عنيفة، مع المجتمع العالمي الأوسع ككل. وتتوقف هذه الاستجابة الشرسة والعنيدة في كثير من الأحيان للضغوط الداخلية على شرطٍ أساس حاسم؛ أي الدعم المحلي الكبير داخل صفوف الشعب. ولا يقدم هذا الدعم الحركة المعنية فحسب، بل يوفر الدفع اللازم للاستراتيجيات القومية المتزايدة، التي يمكن أن تنشأ خلال اللحظات المحورية من الاضطرابات والتغيير. وغالبًا ما تعمل هذه المقاربات في الحوكمة والتنظيم المجتمعي على زيادة التوترات داخليًا وخارجيًا، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حلقة مفرغة من التدابير الرجعية والردود المكثفة، التي تديم الانقسام والعداء، سواء عبر الحدود الوطنية، أو داخل المجتمعات نفسها. ويمكن أن يتردد صدى تداعيات هذه المواقف والحركات الأساسية إلى ما هو أبعد من السياق المباشر، مما يؤثر بشكل كبير على الجغرافيا السياسية والتفاعلات العالمية الأوسع نطاقًا، مع تأثيرات دائمة قد تعيد تشكيل العلاقات الدولية والمشهد المحلي لسنوات قادمة، مما يخلق تحديات وانعكاسات جديدة على الساحة العالمية.
ردود فعل المجتمع المدني:
سلطت الكثير من الدراسات الضوء بشكل لا لبس فيه على الدور المتزايد الأهمية، الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني الدولية في التصدي للتحديات الداخلية، التي لا تزال قائمة في مختلف البلدان، والتي تعمل فيها هذه المنظمات؛ أو مفاقمتها إذا اتخذت عبر “طرف ثالث” كأحصنة “طروادة” داخل مجتمعاتها. وبينما تسعى هذه المنظمات بجد للتغلب على الحقائق القاسية، في كثير من الأحيان، والصعوبات الهائلة المرتبطة بالعمل في بيئات تتسم بالازدراء، أو العداء، أو حتى القمع الصريح لها، فإنها تجد أنه من الضروري التركيز على احتياجات بناء القدرات متعددة الأوجه داخل هذه الدول. وهذا التركيز المركز ضروري للغاية للمواجهة الفعالة للانقسامات العميقة والأزمات المتصاعدة بسرعة، التي تعيشها وتعاني منها مجتمعات عديدة حاليًا. وقد برزت المشاكل المحيطة بقضايا الهوية بشكل كبير كمجال من مجالات الاهتمام الحاسمة داخل دوائر المجتمع المدني، لا سيما على خلفية الانتشار السريع للحركات السياسية القائمة على الهوية، التي اكتسبت زخمًا ووضوحًا كبيرين في السنوات الأخيرة. وقد سلط هذا الوضع المتصاعد الضوء حتمًا على مجموعة من المسائل التشغيلية؛ وهي مسائل معقدة لا يمكن حلها بسهولة في حدود “ثقافة الاقتصاد” السائدة، التي تتبناها منظمات المجتمع المدني عادة في عملياتها. وبينما تسعى إلى التكيف والتطور في استجابة مدروسة لهذه التحديات الملحة، يتضح بشكل متزايد أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة تقييم شاملة لاستراتيجياتها ونهجها، حيث يستمر المشهد، الذي تعمل فيه في التحول والتبدل استجابة لهذه المسائل الملحة. ولا يمكن المبالغة في أهمية إعادة التقييم هذه، حيث يجب على المنظمات أن تعمل بجد لضمان أنها لا تلبي الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الأزمات فحسب، بل تبني أيضًا أساسًا مستدامًا للمستقبل. على سبيل المثال، بينما تنخرط جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم في عملية بناء الدولة الأساسية والصعبة في كثير من الأحيان، يبرز سؤال ملح وحاسم يتطلب اهتمامنا المركز، وهو: كيف يتوقع من منظمات المجتمع المدني أن تقيس، أو تقيم، بطريقة هادفة ومؤثرة، ما إذا كانت الجهود المتضافرة، التي تبذلها حكومة معينة تهدف حقًا إلى أن تكون شاملة لجميع شرائح السكان؟ خاصة أولئك الذين تم تهميشهم تاريخيًا؟ علاوة على ذلك، كيف يمكن لهذه المنظمات أن تتأكد بشكل فعال من أن هذه الجهود الحكومية المختلفة لا تهدف، سواء علنًا، أو سريًا، إلى قمع سياسات الهوية، أو مجرد الترويج لرؤية عالمية محددة بشكل ضيق تحد من المشاركة وتستبعد العديد من وجهات النظر الأخرى؟ وعلى نطاق أوسع، كيف يمكن للعمل المتفاني والعاطفي، الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني أن يعقد ويثري النقاش العام الجاري حول السياسات غير الليبرالية المتزايدة، التي تتبناها مختلف الحكومات، والتي قد تقوض في بعض الأحيان بشكل كبير المبادئ الديمقراطية الأساسية، التي من المفترض أن تحمي حقوق كل فرد؟ بالإضافة إلى ذلك، كيف يمكن لهذه المنظمات أن تفضح بشكل فعال وتلقي الضوء النقدي على الروابط المعقدة الموجودة بين هذه المناقشات الحيوية والانقسامات الاجتماعية القائمة، وعدم المساواة العميقة الجذور، والمظالم المنهجية، التي غالبًا ما ابتليت بها قطاعات المجتمع بأشكالها المختلفة؟ ومن خلال هذه المشاركة، يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز قدر أكبر من المساءلة والشفافية في الحوكمة، وضمان سماع جميع الأصوات وتقديرها في الخطاب الوطني. لذلك، عند الانخراط في تفكير عميق فيما يتعلق بالميول المتنوعة للعديد من الكيانات، التي تسعى جاهدة لردع، أو عرقلة مجموعة واسعة من المبادرات الحكومية والمحلية، والتي تم تصميمها خصيصًا للحد من التنوع بشكل فعال، يصبح من الأهمية بمكان فحص نقدي ما إذا كانت التجارب المتنوعة الغنية المستمدة من المبادرات القائمة على الهوية قد تسهل بالفعل مساهمة ذات مغزى حقيقي في عملية التمايز الأوسع والأكثر تعقيدًا. وسيتم دعم هذا التمايز الحاسم بعناية من خلال استراتيجية مصممة بدقة تتضمن بعناية استهداف الموارد وتكريس الجهود المتفانية للمشاريع “البناءة” المختارة بشكل فريد. وقد تلعب هذه المشاريع المختارة بعناية دورًا مهمًا في تعزيز الإدماج وتعزيز التفاهم وتعزيز التواصل بين المجموعات المتنوعة، التي لا تتعايش فحسب، بل تزدهر أيضًا داخل مجتمعاتنا العربية والإسلامية المترابطة. ومن المرجح أن تثري هذه العملية وتعزز النسيج المعقد، الذي يربط الهويات المختلفة معًا في نسيج نابض بالحياة. ومن خلال تبني مثل هذه المبادرات الاستراتيجية المبتكرة بكل إخلاص، يمكننا فتح مسارات جديدة يمكن أن تحول التحديات الحالية إلى فرص لا تقدر بثمن لمشاركة أعمق، وتعزيز الفهم، والنمو الجماعي الهادف بين جميع أعضاء هذه المجتمعات. وفي النهاية، لا يدعم هذا النهج المدروس الهويات الفردية والفريدة، التي يتبناها الناس فحسب، بل يعزز الترابط الضروري بشكل أساس لتحقيق مجتمع متناغم يمكن للجميع فيه الازدهار معًا.
دراسات الحالة:
علينا إذا أردنا تحليلًا شاملًا وموثوقًا أن نبرز عددًا من الحالات المحورية والهامة، التي تنطوي على ظاهرة لـ”اختراق الطرف الثالث”، والتي حظيت باهتمام متزايد في كل من المناقشات العلمية والموجهة نحو السياسات. والتأكد من مستوى التمايز الموجود بين كل حادثة والعلاقة المتأصلة المرتبطة بهذا الاختراق من “الطرف الثالث”، كما تم تعريفها في الخطاب السياسي المعاصر. ولكل دارس علوم سياسية أن يحاول استكشاف عدد من دراسات الحالة المثيرة للاهتمام والجديرة بالملاحظة وعمق البصيرة؛ كحالة الصراع، الذي طال أمده في الشرق الأوسط، والذي يشمل مجموعات مختلفة ودول خارجية ذات مصالح متنافسة، ومتضاربة في بعض الأحيان، وحالتي أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. وعلينا النظر في الصراعات السورية الزئبقية والمضطربة، التي تتميز بمجموعتها الفريدة والمتعددة الأوجه من الدول، والتي تعمل من خلال العديد من الجهات الفاعلة غير الحكومية والتابعة للكثير من الدول. ويمكن أن ننظر للصراع المستمر على البحر الأحمر ذي الأهمية الاستراتيجية والحيوية والمياه المجاورة له، الذي يشارك فيه العديد من القوى المدعومة والجهات الفاعلة ذات الأجندات المختلفة. كما يمكن الإطلالة على ارتفاع مستويات التوتر المدني داخل العديد من الدول العربية والإسلامية، حيث تلعب ديناميات القوة والنفوذ الأجنبية دورًا حاسمًا. وفي الوقت نفسه، فيما يعد بالتأكيد نذيرًا بارزًا لفن الحكم العالمي المستقبلي، الذي يتضمن أنشطة واستراتيجيات اختراق “طرف ثالث”، كانت هناك تقارير عن التواصل، الذي يتجاوز المظلة الوقائية للهيئات الدولية القائمة، بهدف شق طريقه إلى ليبيا والسودان واليمن، الأمر، الذي يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى وعميقة على المشهد الجيوسياسي والاستقرار الإقليميين.
لهذا، يمكن باستخدام منطقة معينة كدراسة حالة مفصلة، إثبات بشكل فعال أن إحدى النتائج المساعدة الهامة الناتجة عن الاعتماد المتزايد على اختراق “الأطراف الثالثة” هي التصعيد المستمر والدائم لأشكال مختلفة من النزاعات. ففي حين أنه من الواضح أن العديد من الدول تستخدم قوات العمليات الخاصة كـ”فاجنر” و”بلاكووتر”، بطريقة عالمية عمليًا، إلا أن السياسات الحالية سمحت للكيانات المشاركة الأخرى بأن تصبح أيضًا متلقية لهذه المساعدة الحيوية. الأمر الذي يستدعي إجراء تحليل توليفي شامل لمراجعة أنواع التوظيف المتنوعة، التي تقع ضمن التعريف التقليدي والقياسي لاختراق “الطرف الثالث”. بعد ذلك، ومن ثم التعمق في معالجة الآثار الأوسع المتشابكة مع الزيادة الملحوظة في اختراق “الطرف الثالث”، لا سيما فيما يتعلق بالتصعيد المصاحب للصراعات وتزايد حالات الدول الفاشلة، أو الكيانات الهشة، التي تعاني من الاضمحلال التدريجي. ونتوخى من ذلك الدعوة بقوة إلى مزيد من البحث المتعمق، الذي يتمحور حول أداة تعريف لكيف يُولد اختراق “الطرف الثالث” التطرف، لا سيما من خلال عدسة النظرية السياسية. بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك حاجة ملحة لمزيد من التحقيق والرقابة على هذه التدخلات المسلحة المخفية في كثير من الأحيان، مستمدة من النظرية العسكرية الراسخة بطريقة أكثر صرامة ومنهجية.
الشرق الأوسط:
كان الشرق الأوسط دائمًا منطقة غارقة في التعقيد وتاريخ الصراعات، وهو بمثابة المرحلة الأولى والأكثر أهمية، التي خضعت فيها القيادات الأوروبية والأمريكية لاختبارات صارمة. وفي كثير من الجوانب، لا يزال يشكل اختبارًا عميقًا وحاسمًا لتلك القيادات اليوم. وقد تجلت هذه أفعال هذه القيادات بشكل بارز في تطوير وإنشاء الإطار المؤسسي الأساس، الذي يحاول الشرق الأوسط حاليًا العمل والتكيف فيه. ومع ذلك، فإن المشكلة الملحة والمتعددة الأوجه، التي نواجهها اليوم هي أنه على الرغم من أن أفعال بعض تلك القيادات كانت مناسبة للسياق التاريخي، الذي ظهرت فيه، فإنها لم تعد تحمل نفس الأهمية، أو الفعالية في عالم اليوم. في الواقع، يمكن تقديم حجة قوية مفادها أنها قد تعيق الآن، في هذا المنعطف، التطور الطبيعي نحو تحقيق قدر أكبر من الحكم الذاتي الإقليمي وتقرير المصير لشعوب المنطقة ودولها. وهذا العائق ليس مجرد قلق نظري، لأنه من المحتمل جدا أن يعرقل المسار الأساس، الذي يجب اتباعه لتحقيق السلام الدائم في هذه المنطقة المضطربة. لذلك، فإن العداء العالمي تقريبًا، الذي أثار نتيجة الدعم الدفاعي المستمر من الغرب، إلى جانب تكاليف الفرصة البديلة الباهظة، التي تعاني منها إسرائيل وهي تقاتل مع صعوبة ربط جهودها الاستيطانية مع مبادرات الدول العربية، أو بمبادرات العالم الأوسع نطاقًا، مسألة تثير قلقًا بالغًا. وعلاوة على ذلك، فإن استمرار الأعمال غير القانونية المزعزعة للاستقرار، التي تصاحب الفشل في التعامل بفعالية مع هذه السياسات كلها مؤشرات واضحة بشكل صارخ على التحديات، التي نواجهها كمجتمعات عربية وإسلامية. ولا تعكس هذه المخاوف السياسات الحالية فحسب، بل تشير أيضًا إلى آثار عميقة على كيفية إصلاح هذه السياسات، أو تغييرها للأفضل بينما نمضي قدمًا نحو مستقبل غير مؤكد.
ولهذا، فإن البديل الأساس، الذي نواجهه في ظروفنا الحالية والصعبة إلى حد ما ليس مجرد الشلل والعجز الملاحظ في النموذج الحالي، بل إن الاحتمال المتزايد، الذي يلوح في الأفق لحدوث أزمة إنسانية حادة، أكثر إيلامًا مما نشهده في غزة والأراضي المحتلة الآن. ومن المرجح أن تنبع هذه الأزمة من كارثة محلية لن تكون القيادات قادرة على دعم السعي الحالي لموقف نشط في ديناميات المنطقة ذات الأزمات والمعقدة. وغالبًا ما ينظر إلى الأزمة السياسية، التي ميزت العقد المضطرب في عقود القرن العشرين على أنها نتيجة في المقام الأول للأطماع الجامحة المقترنة بالإسراف في العدوان والتطرف الكبير. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى التاريخ السياسي لفترة أطول، فإن أصوله الحقيقية والأكثر عمقًا تكمن بأقل بكثير من المصادرة المفاجئة للصراع في فلسطين، التي حدثت في أعقاب 1948، وما تلاها من “صدمات” كبيرة لمعدلات لحروب طاحنة. بدلًا من ذلك، فإن هذه الأصول متجذرة في الأحداث الأعمق والبعيدة المدى، التي وقعت قبل عام 1948. فقد أدى “وعد بلفور” سنة 1917، إلى خلق تلك الحقبة المحورية، التي ساهمت في النهاية في الأزمة الحالية، التي نواجهها اليوم. ولذلك، فإن هذه الخلفية المتعددة الأوجه ضرورية لفهم النطاق الكامل للحالة، التي تكشفت خلال تلك الفترة.
أوروبا الشرقية:
لقد أثبتت العديد من البلدان الواقعة في أوروبا الوسطى والشرقية، التي تشارك حاليًا في حوار مهم وجدي مع الاتحاد الأوروبي من مواقعها كأعضاء، مما يدل على التزام قوي ليس فقط بالتعاون الاقتصادي، ولكن أيضًا بترتيبات الدفاع الجماعي، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. بالإضافة إلى هذه الدول، هناك أخرى، قبل تقديم طلباتها الرسمية لعضوية الاتحاد الأوروبي، وأيضًا بعد ذلك بشكل مستمر، سعت بنشاط إلى تعزيز روابطها والاندماج في الإطار الأمني الشامل للاتحاد. وقد اضطلع هذا الاتحاد بالذات بدور مركزي وحاسم في تيسير الجهود الدبلوماسية الغربية الأخيرة والتدخل العسكري في مناطق بالغة الأهمية؛ مثل كوسوفو والبوسنة، مما يدل على قدرتها على الاستجابة بفعالية للأزمات في المنطقة. ومع ذلك، فإن وظيفة المنظمة فيما يتعلق بالتوسع الشرقي أصبحت معقدة بشكل متزايد وهي الآن محفوفة بالعديد من التحديات، التي يمكن أن تؤثر على فعاليتها التشغيلية. وتدعو الإدارة الحالية للاتحاد الأوروبي بنشاط إلى تأجيل أي توسع محتمل، وهي خطوة استراتيجية يمكن أن تسيس هذا الكيان الأمني الحيوي عن غير قصد، وتعريض توازنه واستقراره الداخليين الهشين أصلا للخطر. وفي هذا الإطار متعدد الطبقات، يجري الاتحاد الأوروبي التصويت الحاسم على المسائل الأمنية الهامة، مما يؤكد أهمية الحفاظ على توازن دقيق بين الدول الأعضاء وضمان معالجة جميع الآراء والمخاوف بشكل مناسب. ففي نهاية المطاف، قد تؤدي نتيجة النقاش الداخلي الجاري إلى قرار محوري، تتخذه بعض الدول الأعضاء، بالانسحاب الكامل من هذه المنظمة، كما فعلت بريطانيا. وبدلًا من مواصلة انتمائهم إلى الاتحاد الأوروبي كما هو حاليًا، قد يختارون إعادة توجيه مناقشاتهم المتعلقة بالأمن من خلال مديرية أمنية غربية مختلطة بديلة، الأمر الذي قد يكون له تداعيات كبيرة على تماسك التحالف. وسيتأثر هذا الاتجاه الجديد ويهيمن عليه في الغالب من قبل فرنسا، التي أظهرت تاريخيًا اهتمامًا قويًا بقيادة المبادرات الدفاعية الأوروبية. ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى التزام أقوى وأكثر توحيدًا من الاتحاد الأوروبي تجاه تعزيز ذراعه الأمني، خاصة في مواجهة المشهد الجيوسياسي سريع التطور، الذي لا يمكن التنبؤ به، والذي نشهده اليوم. إذ إنه يتميز بتهديدات جديدة تدعو إلى الحاجة إلى نهج تعاوني للأمن يعالج التحديات التقليدية والناشئة على حد سواء.
من وجهة نظر روسية، لا يمكن إنكار الرفض الصريح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للانخراط في أي نقاش هادف يتعلق بجانب التوسع كعنصر لا يتجزأ من مبادرات هذا التوسع الشرقي الأوسع نطاقًا مثالًا مهمًا آخر على عدم الرغبة الجماعية لكل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في الانخراط بجدية مع دعوة موسكو الطويلة الأمد. وكانت هذه الدعوة تهدف على وجه التحديد إلى تهيئة بيئة مواتية لتقاسم عدد لا يحصى من المسؤوليات، التي تأتي مع ضمان الاستقرار السياسي والعسكري والشعور السائد بالأمن في المناطق الواقعة شرق الحدود الأوروبية الحالية. ولا شك في أن هذا الموقف يعكس توترًا جيوسياسيًا أكثر شمولًا لا يزال قائمًا حتى اليوم، ويعمل على تسليط الضوء على الانقسامات العميقة القائمة في العلاقات الدبلوماسية بين هؤلاء اللاعبين الدوليين الرئيسين. ومع ذلك، فإن القرار التاريخي، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بالشروع في تعديل معاهدته يمثل خطوة حاسمة، وربما تحويلية في التحضير للتوسع الشرقي، والذي من المفترض أن يكون قد اكتمل منذ عام 2002. وقد مهد هذا التعهد الطريق أمام أول دول أوروبا الشرقية الوسطى لتصبح رسميًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما مثل لحظة محورية حقًا في تكامل المنطقة مع الإطار الأوروبي الأكبر والأوسع. بالإضافة إلى ذلك، قبل الاتحاد الأوروبي استراتيجيًا ضرورة وأهمية تسهيل مبيعات الأسلحة الغربية ونقلها إلى هذه المنطقة المتقلبة بشكل متزايد، والتي تشمل كل من روسيا وأوكرانيا، مما يزيد من تأزيم الديناميات المعقدة بالفعل للأمن والاستقرار الإقليميين، ويشكل تحديات كبيرة للنظام السائد القائم في أوروبا.
أمريكا اللاتينية:
على الجانب الإيجابي من المعادلة، يمكن ملاحظة أن النفقات العسكرية الإجمالية لمختلف حكومات أمريكا اللاتينية ظلت بشكل عام عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالمعايير العالمية. وقد كان متوسط الزيادة في الإنفاق العسكري لأمريكا اللاتينية ككل 3.1٪ فقط، وهي نسبة متواضعة بشكل ملحوظ عند مقارنتها بمناطق أخرى في جميع أنحاء العالم، حيث تشهد الميزانيات العسكرية في كثير من الأحيان تقلبات وزيادات أكثر أهمية. ومع ذلك، وعلى الرغم من معدل النمو المتواضع هذا في إجمالي الإنفاق العسكري، لا يزال متوسط مستوى الإنفاق العسكري مرتفعًا جدًا مقارنة بالمؤشرات والأولويات الاقتصادية الوطنية. وفي الواقع، تجدر الإشارة إلى أن خمسة بلدان في المنطقة تصنف من بين الثلاثين دولة في العالم، التي لديها أعلى نسبة من الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي، مما يثير مخاوف ملحة بشأن تخصيص الموارد في هذه الدول. وبصفة عامة، وكما سبق أن درسنا وناقشنا بدقة في الأقسام السابقة من هذا التحليل، فإن النفقات العسكرية لأمريكا اللاتينية تتجاوز بكثير ما يمكن اعتباره مناسبًا، أو ضروريًا لتلبية احتياجات الأمن القومي البحتة على نحو ملائم. ولتوضيح هذه النقطة بشكل أكبر، على سبيل المثال، في كيتو، عاصمة الإكوادور، تخصص الحكومة أموالًا كبيرة سنويًا للعمليات العسكرية، ولكن من المفارقات أن الحكومة نفسها تنفق جزءًا صغيرًا فقط من هذا المبلغ على الخدمات العامة الحيوية مثل بناء وصيانة شبكات الصرف الصحي الحيوية. وبالمثل، توجه سان سلفادور، عاصمة السلفادور، مبالغ كبيرة من ميزانيتها نحو العمليات العسكرية بينما تخصص الموارد بالحد الأدنى فقط لتحسين البنية التحتية للصرف الصحي، الذي تشتد الحاجة إليه. وعلاوة على ذلك، فإن مدينة غواتيمالا، عاصمة غواتيمالا، تظهر نمطًا مشابهًا ومقلقًا، حيث تخصص نفقات كبيرة موجهة للعمليات العسكرية، ولكنها للأسف وجدت نفسها محدودة في الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية للبنية التحتية، مثل شبكات الصرف الصحي. ويسلط هذا الخلل المستمر الضوء على مسألة مستمرة تتعلق بتحديد الأولويات في اعتبارات الميزانية وهي مسألة واضحة في جميع أنحاء المنطقة، مما يثير تساؤلات حاسمة بشأن فعالية استراتيجيات تخصيص الموارد الحكومية. كما يؤكد الحاجة إلى إعادة تقييم الأولويات، التي من شأنها أن تسمح للبلدان بتحقيق التوازن بشكل أكثر فعالية بين شواغل الأمن القومي والاحتياجات الاجتماعية والهياكل الأساسية الملحة.
لقد أدت العسكرة المتزايدة للعلاقات الاقتصادية المعاصرة إلى تحويل جيش أمريكا اللاتينية بشكل كبير إلى جهات اقتصادية قوية بشكل ملحوظ تمارس الآن نفوذًا كبيرًا على مختلف جوانب الحكم والإدارة الاقتصادية. تعمل هذه الكيانات العسكرية بنشاط على توسيع دورها في إدارة ومراقبة وتخصيص أموال الدولة، فضلًا عن التحكم في الدخل الكبير المستمد من تصدير الموارد والسلع الحيوية لبلادها. علاوة على ذلك، فإنها تتدخل بشكل روتيني في المفاوضات المعدنية والتجارية الحاسمة، وتحدد بشكل فعال السياسة النقدية ولوائح الصرف الأجنبي، والتي تعتبر حيوية للصحة الاقتصادية. وغالبًا ما تعرقل الجهود الحكومية الرامية إلى تأمين الائتمانات الأجنبية اللازمة، التي تعتبر حاسمة لمعالجة الأزمات المالية، والتي تلوح في الأفق، التي تواجهها العديد من الدول في المنطقة. وهناك تنسيق جيد ومنظم لهذه الأنشطة على الصعيد الإقليمي، مما لا يؤدي إلا إلى تعزيز مدى وصولها وتأثيرها عبر الحدود ويزيد من تعقيد المشهد السياسي. وتؤدي سيطرة الجيش الاحتكارية على التجارة في المنتجات الأساسية المهمة للتنمية، مثل القصدير والقطن والنفط، إلى جانب التراكم الهائل للثروة الناتج عن هذه الأنشطة الاقتصادية، إلى توليد المزيد من القوة السياسية والنفوذ. ويخلق هذا الوضع حلقة مفرغة حيث تعزز ديناميات العسكرة والقوة الاقتصادية بعضها البعض. ونتيجة لذلك، تغير هذه التطورات بشكل كبير مشهد القوة داخل الدول، مما يخلق تفاعلًا معقدًا ومحفوفًا بالمخاطر في كثير من الأحيان بين الجيش وحكم الدولة. باختصار، أدت عسكرة كل من “التنمية الداخلية” و”العلاقات الخارجية” في سياق أمريكا اللاتينية إلى تكثيف الدرجة المرتفعة بالفعل من الصراع والمعارضة القائمة بين جيش أمريكا اللاتينية ومختلف “القوى المنشقة”، التي تتحدى سلطتها وشرعيتها وتفوقها الاقتصادي. ويضمن هذا الوضع غير المستقر أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي تعاني منها المنطقة لن تجد حلًا واضحًا على المدى القصير. وبالتالي، فإن هذا الوضع الراسخ يؤدي إلى تفاقم التوترات، مما يخلق جوًا من عدم الاستقرار يتخلل الحكومات والهياكل المجتمعية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. ومن المرجح أن تستمر الآثار المترتبة على هذه التطورات في الظهور، مما يؤثر على العلاقات الإقليمية والديناميات الداخلية للدول في جميع أنحاء القارة، ويخلق القابليات المختلفة لتغلغل نفوذ “الأطراف الثالثة”.
الاعتبارات القانونية والأخلاقية:
لقد أجرينا؛ في غير هذه المباحث دراسات مستفيضة وشاملة لمجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة المتعلقة بالإنترنت؛ إبهارًا وإرهابًا وتجزئة واختراقًا، والكثير من المتعلقات، التي من شأنها أن تكون بلا منازع سببًا إضافيًا في استعادة “الأطراف الثالثة” جميعها تأثيرات نفوذها بـ”القوة الناعمة” بعد أن فقدت السيطرة عليها بـ”القوة الصلبة”. لذلك، نستصحب هنا دعوة البعض بضرورات الحرص والحزر والتقييد، أو يجب أن تخضع صراحة لقيود قانونية مختلفة، وضوابط أخلاقية قصوى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتبارات الهامة، التي لا يمكن على الإطلاق، ولا يجب إغفالها تحت أي ظرف من الظروف، توضع في صدارة مناقشتنا للأنشطة المعيبة لوسائل التواصل الاجتماعي، أو تلك المعنية على الاختراق والغزو الثقافي والفكري. وتشمل هذه الأنشطة الآثار الديناميكية والحركية الناشئة عن العمليات السيبرانية المعقدة والمنسقة تنسيقًا محكمًا، التي يمكن أن يكون لها آثار واسعة النطاق وعميقة على البنية التحتية الوطنية الحيوية، لا سيما في أوقات التصعيد الملحوظ للخطاب العدواني. علاوة على ذلك، فإن الحياد، الذي لا جدال فيه والنزاهة، التي لا يمكن تعويضها لبعض الأصول الرقمية الحيوية يلعبان دورًا حاسمًا لا غنى عنه ليس فقط في الحفاظ على الأمن العام، ولكن أيضًا في ضمان الاستقرار في المواقف المضطربة بشكل متزايد. ولكل ذلك، نتعمق في التعقيدات متعددة الأوجه، التي ترتبط بطبيعتها بالجمع الواسع والتحليل الدقيق والعرض المتماسك للأدلة الرقمية القوية، والتي تؤيد ما ذهبنا ونذهب إليه من تبريرات. وهذا الدليل ضروري بشكل أساس لكل من الإجراءات القانونية الصحيحة والأغراض الأخلاقية، ويشكل العمود الفقري للمساءلة في عالمنا الرقمي. وعلينا أن نستكشف التقارب المعقد والبالغ الأهمية للآثار التجارية والعسكرية لهذه الثورة الرقمية المتسارعة. وتحمل هذه الآثار عواقب واسعة النطاق، فضلًا عن الكشف عن نقاط الضعف المتأصلة، التي يتم نسجها بشكل وثيق داخل هذه العوالم المترابطة، والتي تؤثر بشكل كبير على بعضها البعض بطرق مؤثرة مختلفة. كما علينا أن نقوم بتحليل التطوير المستمر والتنفيذ والتطبيق المتطور للتدابير الرقمية المضادة المتقدمة، التي تم تصميمها خصيصًا لمعالجة العديد من التهديدات الناشئة، والتي تظهر نفسها باستمرار في مشهد متزايد التعقيد والديناميكية. وخلال مناقشتنا الواسعة، سلطنا، ويمكن تسليط المزيد من الضوء على عدد لا يحصى من معايير الأسبقية، التي يجب أخذها في الاعتبار بجد إذا أريد اتخاذ قرار حاسم ومؤثر فيما يتعلق بنشر تأثير سيبراني معين، أو نهج تكتيكي، لخدمة إطار استراتيجي أوسع. ويجب اتخاذ مثل هذا القرار بطريقة مدروسة ومسؤولة، مع مراعاة احتمال حدوث تصعيد غير مقصود في سياقات معقدة مختلفة، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة وبعيدة المدى قد تؤثر سلبًا على العديد من أصحاب المصلحة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال ملح دائمًا بأن لاعبًا معينًا يمكن أن ينتقل إلى أسفل منحدر التصعيد الزلق. وفي مثل هذا السيناريو، قد تتأثر السيطرة على أفعالهم بشكل متزايد بعمليات التفكير، التي يمكن استبدالها بسهولة بالملكية العاطفية، أو الالتزام السياسي العميق الجذور، أو الخطر الملموس للخسارة المتبادلة، أو حتى الجمود الساحق، الذي ينبع من الأحداث السابقة، والتي تؤطر بشكل عميق تقدم صنع القرار بمرور الوقت. علاوة على ذلك، من المهم للغاية إدراك وجود إمكانات كبيرة للتطبيق المتعمد والمحسوب والاستراتيجي لمختلف التكتيكات السيبرانية ليتم النظر إليها بدقة من خلال عدسة محددة كميًا. ومن هذا المنظور، قد يظهر التصعيد نفسه بالفعل بطريقة ثنائية محتملة، حيث يتم تبسيط النتائج إلى فئتين متعارضتين؛ التصعيد، أو التقييد. ويمكن أن يؤدي هذا النوع من الإدراك الثنائي عن غير قصد إلى ظهور انقسامات واضحة ومقلقة خلال مرحلتي الاستجابة ورد الفعل للتفاعلات الدولية، مما يعقد المشهد الجيوسياسي المعقد والمتعدد الأوجه، الذي نتنقل فيه حاليًا. وتتطلب التوترات المتزايدة بين الدول القومية المختلفة فهمًا دقيقًا. وبالتالي، فإن عواقب هذه الديناميات، إذا تركت دون رادع، يمكن أن تزيد من حدة التوترات القائمة بين الأطراف المعنية وتفاقمها. وفي نهاية المطاف، يشكل هذا التصعيد خطرًا كبيرًا يتمثل في التسبب في عواقب غير متوقعة وغير متوقعة تعكس التعقيدات العميقة للعلاقات الدولية الحديثة. وتجعل هذه التطورات الملاحة السياسية والدبلوماسية أكثر صعوبة في إدارتها وفهمها والتنبؤ بها، مما يخلق بيئة أكثر عدم استقرار وتحديًا لجميع أصحاب المصلحة المعنيين. ويؤكد هذا التفاعل المعقد للعوامل على أهمية الاجتهاد والبصيرة في التنقل في المشهد السيبراني الحالي والمستقبلي.
إطار القانون الدولي:
ذكرنا من قبل أنه يكمن الاقتداء بالقبول العام المعلن للقاعدة المعترف بها دوليًا ضد التدخل في شؤون الدولة، التي تعد المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة تعبيرًا تقليديًا عنها، ومجالًا واسعًا ومعقدًا يحتوي فيه القانون الدولي العرفي على مؤهلات وفروق دقيقة وممارسات تكسر وتتحدى بشكل أساس هذه القاعدة، التي تبدو مطلقة. ويكشف جوهر هذه الفروق الدقيقة عن مجموعة من التفسيرات والتطبيقات للقاعدة، مما يشير إلى أن عدم التدخل المطلق نادرًا ما يتحقق في الممارسة. وعلى العكس من ذلك، فإن العالمية السياسية والأخلاقية للمعيار المتطور للمسؤولية عن الحماية، التي كثيرًا ما يُشير إليها صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال بعبارتها الإنجليزية (R2PThe Right to Protect-)، إلى جانب الامتيازات المصاحبة لها المتمثلة في التدخل الإنساني وعدم اللامبالاة، تفرض شروطًا جديدة ومقنعة تعقد بشكل معقد الحظر العرفي الثابت والراسخ للتدخل، الذي يحكم تقليديًا العلاقات بين الدول. وتتجلى هذه التعقيدات في حالات مختلفة حيث تتصارع الجهات الفاعلة في الدولة مع الانقسام بين الالتزام بالمعايير القانونية والاحتياجات الإنسانية الملحة. مع التنبؤ بأن هذه القاعدة، التي ألهمت خطابًا ونقاشًا كبيرين بين العلماء وصانعي السياسات والجمهور على حد سواء، قد وصلت بالفعل إلى حدود إمكاناتها العالمية، نختتم باستنتاج حذر مفاده أنه من غير المرجح أن يتطور حق الحماية إلى معيار قانوني دولي قائم بذاته وقابل للتطبيق على نطاق واسع بترتيب أكبر من العمومية. وبدلًا من ذلك، من المرجح أن يظل استثناء طارئًا وإضافة مؤقتة إلى القانون الدولي القائم والمعقد، الذي يحكم النزاع الأهلي، أو واجهة الأزمات متعددة الأوجه. لذلك، فإن التضاريس القانونية الدولية الاسمية، التي تسكنها معايير قانونية معترف بها دوليًا، والتي تحكم القضايا الحرجة المحيطة بالأمن الدولي، والسلام الدائم، والالتزام الحالي بالسيادة الوطنية، إلى جانب عدم التدخل الداخلي، تقدم صورة للانقسام الأخلاقي والسياسي العميق، الذي يصعب التنقل فيه بشكل متزايد. وتتسم هذه التضاريس بالتوتر والاختلاف، حيث غالبًا ما تتعارض المصالح التقليدية لسيادة الدولة مع المبادئ الناشئة، التي تدعو إلى حقوق الإنسان والمسؤوليات العالمية. ولذلك، فإنه يعكس مشهدًا متنوعًا ومعقدًا من التذبذب والاستقطاب والمنافسة العاطفية بلا هوادة، إلى جانب الانقسام المستمر والتناقض القلق فيما يتعلق بالدولة المسموح بها والاستجابات الدولية، التي تواجه الواقع القاسي والشنيع للجرائم الفظيعة الجماعية. وقد أثارت هذه الجرائم قلقًا ونقاشًا دوليين، لكنها كشفت أيضًا عن أوجه القصور في الإطار القانوني القائم. إلى جانب الضيق السياسي التأسيسي والعنيف، الذي طال أمده، والذي يتخلل العديد من الدول، تعقد هذه الديناميات الخطاب حول أفضل السبل لمعالجة الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. وعلى خلفية القطيعة السياسية والأخلاقية العميقة المتسارعة، المتحالفة مع العنف الجسدي المتزايد، الذي ساهم في انهيار الإمبراطوريات الإقليمية القوية تاريخيًا والكيانات السياسية المعاصرة، فضلًا عن المبدأ التأسيسي للدول القائمة على تقرير المصير، يدرس هذا الخطاب بالفعل التصلب القانوني الدولي لمحيط سيادي وموضوعي. وقد عزز هذا الترسيخ، بنفس القدر، فك الارتباط القانوني الدولي، الذي يعزل الدول عن الأطر التعاونية على المسرح العالمي والقمع المحلي، الذي يسعى إلى الحفاظ على النظام خارج هذه الحدود المحددة والراسخة. وهذه الظواهر، جنبًا إلى جنب، تثير الشكوك حول فعالية المعايير الدولية، التي تهدف إلى حماية الضعفاء والمعرضين لخطر الفظائع. وبالتالي، فإن التحديات، التي يفرضها هذا التطور القانوني والأخلاقي المستمر تستدعي تفكيرًا نقديًا حول ما يشكل تدخلًا مشروعًا ومسؤوليات الدول في عالم يتسم بشكل متزايد بالترابط ونقاط الضعف المشتركة.
المعضلات الأخلاقية في التدخل:
يشمل صنع السلام والتدخل العديد من الأبعاد، التي تجسد مجموعة واسعة من الاعتبارات الأخلاقية والآثار الهادفة. ويكمن المحور الرئيس لهذه المفاهيم في التوتر الكبير والمثير للجدل في كثير من الأحيان، والمتأصل في التفاعل بين مبدأ السيادة الوطنية ونظام قيم دولي أكثر شمولًا يسعى جاهدًا إلى دعم حقوق الإنسان وضمان السلام الدائم. وهذا التوتر المتأصل متعدد الطبقات ومعقد بشكل معقد ومتجذر بعمق في النسيج التاريخي للعلاقات العالمية، الذي يتشكل باستمرار من خلال عدد لا يحصى من الصراعات والمناقشات والمفاوضات على مر الزمن. وعلاوة على ذلك، تمتد السيادات الوطنية إلى ما هو أبعد من مجرد الأطر القانونية، أو الهياكل النظرية الثابتة بطبيعتها. بدلًا من ذلك، فهي تعمل كمصادر حاسمة للسلطة والهوية، التي تؤثر بشكل عميق على حكم الدولة، فضلًا عن التجارب الحية والهويات الفردية لمواطنيها. ومن الأهمية بمكان أن نفكر بعناية في الآثار الأخلاقية المتأصلة في هذا المجال، بالإضافة إلى الحقائق العملية، التي تصاحب هذه التدخلات. ففي مشهد دولي حيث يتم الاعتراف على نطاق واسع بالحدود الإقليمية المحددة بشكل صارم كقاعدة، فإن احترام سيادة الدول المجاورة يتجاوز كونه مجرد عنصر ذكي في السياسة الخارجية. وتبرز كضرورة أساسية لحماية الدفاع عن النفس والاستقرار الأوسع في المنطقة. لذلك، فإن القومية، التي تشمل جميع أبعادها الدقيقة وآثارها الواسعة النطاق، تمثل قوة فاعلة للغاية في ساحة العلاقات الدولية تتطلب اعترافًا واحترامًا جديين. ولذلك، فإن أي شكل من أشكال عدم الاحترام، أو التقويض الموجه نحو سيادة الأمة يمتلك القدرة على التحريض على ردود فعل دفاعية قد تفوق بشكل صارخ التهديد المتصور، مما يمهد الطريق في النهاية لعواقب وخيمة غير متوقعة. في الحالات القصوى بشكل خاص، يمكن أن يؤدي عدم الاحترام هذا إلى دفع نحو تشكيل دول قومية جديدة، أو حتى إشعال التوسع الإقليمي العدواني، وكلاهما من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام الإقليمي القائم بشكل كبير. علاوة على ذلك، يمكن أن تتوج آثار عدم احترام سيادة الأمة بتغييرات جذرية في النظام، أو تحولات في السياسة داخل الدول المتضررة، وكل ذلك يتم بحجة الدفاع عن النفس والحماية. عادة ما تتماشى هذه الإجراءات مع السرد الأوسع، الذي يؤكد على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي، مع السعي في الوقت نفسه إلى الهدوء والوئام المجتمعي. لذلك يصبح من المهم للغاية تحليل كيف يعمل دعم النظام كهدف محوري يوجه السياسة العامة نحو إنشاء حوكمة آمنة ومستقرة ومتماسكة، حتى عندما تتطلب هذه الحوكمة المناورة عبر المساحات الخارجية واستغلالها لتحقيق المصالح الوطنية المتصورة. وفي هذا السياق، يجب أن تخضع أي سياسة تدخلية مقترحة لتقييم دقيق لمصداقيتها وشرعيتها. ولن يتبنى الجمهور بسهولة أي سياسة مقترحة ما لم يقتنع تمامًا بأنها تمتلك مبررًا أخلاقيًا وذا جدوى عملية، تجسد بوضوح المبادئ الأساسية للأيديولوجية والمصالح الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تقيم هذه السياسات بدقة المكافآت المحتملة مقابل المخاطر الكامنة، التي تنطوي عليها، وتنمية مشهد يشعر فيه الجمهور بالثقة الحقيقية على سلامته ورفاهيته أثناء الإبحار في المياه المحفوفة بالمخاطر في كثير من الأحيان للمشاركة الدولية. ومن خلال تقييم هذه الاعتبارات، يمكن للمرء أن يعزز فهما أكثر شمولا للتوازن الدقيق المطلوب لإدارة العلاقة المعقدة لصنع السلام والتدخل والسيادة الوطنية في عالم يتطور باستمرار ويحمل التحديات.
الاتجاهات المستقبلية في اختراق “الطرف الثالث”:
ظلت مشكلة “التأطير” طويلة الأمد والمثيرة للجدل في كثير من الأحيان باستمرار جانبًا مهمًا ومعقدًا من جوانب الخطاب السياسي، حيث تتبنى الفصائل المختلفة وجهات نظر متعارضة ومتباينة بشكل فريد حول هذه المسألة. ويتم تحديد الاتجاهات والتطورات والاتجاه العام للمشهد السياسي في المقام الأول من خلال الطريقة المحددة، التي تؤطر بها الجماعات السياسية المختلفة القضية المعينة المطروحة. وهذا يميز بإيجاز النقاش المستمر والعاطفي، الذي لا يزال يحيط به اليوم. وكثيرًا ما يدعو المؤيدون الذين يدافعون بقوة إلى اتباع نهج دبلوماسي لحل النزاعات “أطرافًا ثالثة” محايدة في محاولة لدق أسافين فعالة بين الأطراف المعادية في كثير من الأحيان المتورطة في هذه النزاعات المعقدة. وللأسف، فإن هذه الحاجة الخاصة والاعتماد على “أطراف ثالثة” يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم التوترات القائمة، مما يعقد الحالة المحفوفة بالمخاطر أصلًا بدلًا من تيسير التوصل إلى حل حقيقي وذي مغزى. لذلك، فإن إشراك الوسطاء المحايدين، على الرغم من حسن النية في كثير من الأحيان، يؤدي أحيانًا إلى عواقب غير مقصودة تزيد من ترسيخ الانقسامات وسوء الفهم. ويمكن أن يؤدي انتشار السلطة، إلى جانب احتمال حدوث زيادة كبيرة في الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار، إلى تسارع ملموس في “الاختراق” العام لمختلف تأثيرات “الأطراف الثالثة” في مناطق متنوعة في جميع أنحاء العالم. وقد ينشأ هذا الوضع المعقد كنتيجة مباشرة لعدد لا يحصى من الفرص، التي تظهر حتمًا في سياقات مضطربة وغير مستقرة، والتي يمكن أن تتطور فجأة وبشكل غير متوقع دون سابق إنذار. وفي ضوء هذه الظروف المتغيرة بسرعة، من المرجح أن تصبح القوى الإقليمية أكثر انخراطًا بشكل متزايد في الأزمات العديدة، التي تؤثر على مصالحها الوطنية. وسيختارون بنشاط التدخل بشكل متكرر في مختلف الصراعات، التي تحدث داخل أحيائهم المباشرين ومناطق نفوذهم. وهذه المشاركة مدفوعة برغبتهم في تأكيد أدوارهم، والحفاظ على الاستقرار، والاستجابة بفعالية للتحديات الناشئة، التي لا تزال تشكل الأطر الطبيعية والخطوط الجغرافية السياسية، والتي أصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى في عالم يتسم بديناميات متغيرة وهياكل سلطة متطورة. وعلى نطاق عالمي أوسع بكثير وأكثر تعقيدًا بكثير، قد تختار بعض الدول بشكل متعمد واستراتيجي الانخراط بنشاط في مجموعة واسعة من الصراعات المختلفة المستوحاة من مجموعة عميقة الجذور ومتنوعة من الأسس والمبادئ والمعتقدات التأسيسية الأيديولوجية. وغالبًا ما تكون هذه الصراعات متعددة الأوجه مدفوعة بقوة ودفعها بقوة من قبل مجموعة مختارة من القوى العظمى التقليدية القوية، التي تسعى إلى نشر نظرياتها الخاصة والمحددة عن السلوك الدولي والسلوك والحكم الدقيق على الدول والمناطق الأخرى. وهذا الاتجاه المثير للقلق، خاصة إذا ترك دون رادع، لديه القدرة على أن يؤدي إلى بيئة عالمية أكثر استقطابًا وتشرذمًا تتعمق فيها الانقسامات الأيديولوجية وتتسع وتتفاقم، مما يخلق في النهاية مشهدًا صعبًا ومعقدًا. وفي هذه البيئة، يزدهر سوء الفهم والأعمال العدائية وينتشر، وللأسف، يصبح الصراع أكثر انتشارًا واتساعًا بشكل متزايد بين الدول في مختلف مناطق العالم. ولا شك في أن مثل هذا السيناريو سيؤثر على استقرار العلاقات الدولية ويقوضه، مما يؤدي إلى تصاعد التوترات والصراعات المحتملة، التي يمكن أن تزعزع استقرار ميزان القوى الدقيق، الذي تم إنشاؤه على الصعيد الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النشاط والجهود، التي تبذلها الأمم المتحدة، بالاقتران مع مشاركة ومساهمة أقل نسبيًا من مختلف المنظمات الدولية الأخرى، قد تشهد زيادة ملحوظة في مجموعة واسعة من القدرات، مع استمرار الديناميات العالمية في التحول والتطور بطرق معقدة. ومع ذلك، من الضروري أن نلاحظ بوضوح أن الطلب على الخدمات الحكومية، إلى جانب الدعم المقدم من هذه المنظمات، قد يتجاوز بدرجة كبيرة قدرتها وإمكانياتها التنظيمية الحالية. فالواقع الناشئ للتعددية الداخلية، الذي يتجلى من خلال ما يسمى بالطبقات والبيروقراطيات الوظيفية شبه المستقلة، يجعل الحكومات غير قادرة بشكل متزايد على أداء بعض الوظائف الجماعية الأساسية بفعالية وكفاءة. لذلك، فإن الانتشار المستمر والمتسارع للسلطة على المستوى الإقليمي، مقترنًا بالتقدم السريع والانتشار الواسع النطاق للتكنولوجيا العسكرية المتطورة، يزيد من ضرورة طلب الحكومات المساعدة من أطراف ثالثة مختلفة. ويؤكد هذا التعقيد المتزايد في العلاقات العالمية على الحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون والاستراتيجيات المبتكرة بين الدول والمنظمات على حد سواء، وهي تتغلب على التحديات، التي يمثلها المشهد الجيوسياسي المتغير باستمرار.
التقدم التكنولوجي:
على مدى العقود العديدة الماضية، شهدنا تطورات كبيرة وملحوظة حقًا في تطوير القدرات السيبرانية عبر مجموعة واسعة بشكل ملحوظ من سيناريوهات وبيئات الصراع. في البداية، خلال الأيام الأولى لتكنولوجيا الحوسبة، تم تطوير الكمبيوتر واستخدامه بشكل أساس كوسيلة متطورة لتحليل أنظمة الأسلحة المعقدة وتسهيل معالجة البيانات. واستغرق الأمر وقتًا طويلًا وسلسلة من الأحداث قبل أن يتم تحويل هذه الأنظمة في النهاية ضد منشئيها من خلال الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة وانتهاكات البيانات المختلفة. وطوال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، كان التركيز السائد لجميع جهود أمن تكنولوجيا المعلومات تقريبًا يدور حول تطوير عمليات قوية وبروتوكولات فعالة وإجراءات شاملة تهدف على وجه التحديد إلى حماية المعلومات السرية بالإضافة إلى المواد الأخرى الحساسة للغاية. وقد صاغت بلدان مختلفة العديد من المبادئ التوجيهية الشاملة بدقة، إلى جانب الوكالات والمنظمات ذات السمعة الطيبة، لمعالجة هذه الشواغل الأمنية الهامة بفعالية. ومع ذلك، لم يتم الاعتراف بالأهمية الحقيقية لتدابير الأمن السيبراني القوية والفعالة من قبل الحكومات والصناعات إلا بعد وقت طويل من أن أصبح اختراع الإنترنت واعتماده على نطاق واسع وانتشاره المتسارع حقيقة ملموسة. ومع استمرار تطور التكنولوجيا بمعدل غير مسبوق، أظهرت العديد من المنظمات تأخرًا ملحوظًا في جهودها لتطوير تخطيط أمني رسمي وسياسات شاملة وإجراءات راسخة لمكافحة هذه التهديدات الناشئة بشكل فعال. ومع التوسع الملحوظ في استخدام الكمبيوتر بين عامة الناس وداخل مختلف المنظمات، بدأت مجموعة من التهديدات الجديدة والمعقدة بشكل متزايد في الظهور، مما يمثل تحديات خطيرة ومعقدة لسلامة البيانات وأمنها. واستلزم هذا التحول نهجًا أكثر إلحاحًا واستراتيجية ومتعددة الأوجه للأمن السيبراني يمكن أن يتكيف مع المشهد سريع التغير للتهديدات السيبرانية.
لقد تم تصميم البرامج الضارة الحديثة وتطويرها بدقة خصيصًا بهدف استهداف الأجهزة الرقمية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الذكية المختلفة، التي تخدم المستهلكين والشركات على حد سواء. وبمرور الوقت، تطورت هذه البرامج الضارة بشكل كبير وتم اعتمادها لاحقًا لأغراض أكثر شناعة، لا سيما ما يهدف منها إلى شن هجمات معقدة ضد الدول، التي أنشأت بنى تحتية معقدة للشبكة. واستجابة لهذا التطور المقلق للتهديدات في المشهد الرقمي، نما مجال الأمن السيبراني بشكل كبير وأصبح معقدًا بشكل متزايد، ويشمل مجموعة واسعة من الممارسات والتقنيات. واليوم، أنشئت أنظمة كاملة مكرسة حصريًا لحماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات جنبًا إلى جنب مع بنيتها التحتية الأساسية من العديد من التهديدات. وقد أصبح من المسلم به على نطاق واسع عبر القطاعات أن تكنولوجيا المعلومات ضرورية بشكل أساس لكيفية عمل الأمة بفعالية، وتؤثر على كل شيء من الاتصالات اليومية إلى العمليات العسكرية الحيوية. وفي الحرب المعاصرة، أصبح الأمن السيبراني يلعب دورًا محوريًا في منع النزاعات من التصعيد بشكل فعال إلى مواجهات أكبر. لذلك، فإنه يحول مجرد وجود القوات على الأرض من محفز محتمل لحادث دولي إلى استراتيجية معقدة ومنسقة بعناية ذات آثار عالمية بعيدة المدى. وتسلط هذه الديناميكية الضوء على الترابط المعقد للاشتباكات العسكرية الحديثة، حيث يمكن أن تكون ساحة المعركة الرقمية بنفس أهمية الاشتباكات التقليدية، مما يعيد تشكيل مشهد الحرب بطرق غير مسبوقة.
التحولات في ديناميات الطاقة العالمية:
تتأثر استراتيجية السعي للحصول على الدعم الخارجي في الصراعات الدولية بشكل عميق بالتحولات المستمرة في ديناميات القوة العالمية، التي تعمل باستمرار على تعديل التحالفات وإعادة توجيه الاصطفافات بين الدول بطرق تأسيسية. وتؤدي هذه التحولات الهامة إلى تآكل وتدهور التحالفات القائمة، وفي بعض الحالات المؤسفة، تتسبب في تفكيكها بشكل نهائي وكامل، مما يترك الدول في كثير من الأحيان تتعامل مع العواقب. وهناك تطوران حاسمان على وجه الخصوص يساعدان على تفسير الزيادة الملحوظة في الدعم القادم من الرعاة الخارجيين من قبل المتحاربين الأضعف المتورطين في صراعات إقليمية محددة. أولًا، يُنذر صعود قوى عظمى جديدة على المسرح العالمي بظهور تكوينات جيوسياسية جديدة وعلاقات معقدة في التوزيع العام للنفوذ في جميع أنحاء العالم، مما يغير سلوكيات واستراتيجيات الدول. ثانيًا، إن التدهور المتزامن والملحوظ في التفوق، الذي كانت تتمتع به ذات يوم قوة عظمى، التي أصبحت الآن معترف بها على نطاق واسع كقوة عظمى ضعيفة، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن استعدادها للوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه الحلفاء، تدفع الدول المتعاملة معها إلى التشكيك بجدية في جدوى اصطفافها ودعمها المستمر. ويدفعهم هذا التشكيك إلى البحث بنشاط عن مصادر أخرى أكثر موثوقية للدعم والمساعدة الخارجية وسط المشهد الجيوسياسي المتقلب باستمرار، الذي يتسم بعدم اليقين وعدم الاستقرار المحتمل. ويعكس البحث عن شراكات وتحالفات جديدة تطورًا تكتيكيًا حيث تعطي الدول الأولوية لأمنها ومصالحها الاستراتيجية في بيئة تتسم بالتغيير السريع وعدم القدرة على التنبؤ.
لهذا، فإن ما يبرز على أنه فريد من نوعه ويستحق الاهتمام بشكل خاص ليس فقط هذه الرغبة المستمرة والدؤوبة في تغيير وتعديل القواعد والمعايير الراسخة في وقت شهد فيه ميزان القوى المعقد داخل المسرح العالمي تحولًا كبيرًا بالفعل، ولكن أيضًا الحجم الهائل الملحوظ والجودة الاستثنائية للحوافز المالية الواسعة النطاق والدعم العسكري، الذي تستطيع القوى العظمى الناشئة الآن تقديمه وعرضه بشكل مذهل. ولهذه الحوافز المالية والمساعدات العسكرية تأثير عميق وجوهري على الوضع الراهن، لأنها تلعب دورًا في تعميق الانقسامات القائمة، التي تفصل بين الفصائل المختلفة وفي الوقت نفسه في تصعيد الصراعات العديدة، التي تنشأ بين الجهات الفاعلة الإقليمية، والتي لا تعد ولا تحصى المنخرطة بعمق في هذه الديناميات المعقدة والمتعددة الأوجه. وينطبق هذا بشكل خاص في لحظة حاسمة يبدأ فيها بندول الحالة الاستراتيجية الدولية في التأرجح على نطاق أوسع وبشكل لا يمكن التنبؤ به أكثر من أي وقت مضى. وعلى مدار العقدين الماضيين، كان النظام الدولي نفسه يمر بالفعل بتحول كبير وتحويلي، وهو تغيير هائل لا يمكن إنكاره في آثاره. علاوة على ذلك، كان هناك ارتفاع واضح ومقلق في القرارات الأحادية الجانب، التي تتخذها دول مختلفة في كثير من الأحيان استجابة لمصالحها الوطنية. ويبدو أن مثل هذه القرارات تؤدي إلى انقسامات متزايدة بشكل مثير للقلق، لا سيما داخل التحالفات القائمة وبين الدول الأوروبية نفسها، التي تعاني من نصيبها من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وكنتيجة مباشرة لهذه التطورات، تفقد أوروبا، ككيان جماعي مثلًا، موقعها السابق في النفوذ، وبالتالي لم تعد تحتل المكانة المرموقة بكونها السلطة الجيوسياسية والعسكرية والأمنية الأساسية، التي كانت تحتفظ بها ذات يوم، أو أنها قادرة على التلاعب جنبًا إلى جنب مع القوى الكبرى في العالم، والتي تهيمن على نحو متزايد على الشؤون الدولية. ولم تعد مقارباتها تجاه الأزمات الإقليمية الكبرى الحرجة؛ بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصراع الإسرائيلي العربي الطويل الأمد والمعقد، والوضع الدقيق والمنقسم باستمرار في قبرص، فضلًا عن العديد من مناطق الأزمات المهمة الأخرى، تعكس نفس المستوى من المشاركة، أو الاهتمام بالتدخل، الذي أظهرته القوى العالمية الكبرى سابقًا، مما يثير تساؤلات مهمة حول دور أوروبا المستقبلي في الحوكمة العالمية والديناميات الأمنية.
استنتاجات وتوصيات:
وفي حين أن كل حالة فريدة ومحددة ليست قابلة في الواقع لإشراك “طرف ثالث” تهدف إلى دعم الأهداف المحددة، فمن الأهمية بمكان الاعتراف بأنه في الحالات النادرة والفريدة، التي ينظر فيها إلى المشاركة الخارجية على أنها خيار مشروع وقابل للتطبيق، فإن احتمالات حل النزاعات الفعال وجوهر مشروع الشراكة نفسه ستتحسن وتتعزز بدرجة كبيرة من خلال إيلاء اهتمام دقيق للتوصيات الشاملة التالية: أولها وأهمها، لا بد من الجمع الصحيح بين الثقة، التي لا تتزعزع في العملية، إلى جانب الحياد الحقيقي فيما يتعلق بالأطراف المعنية وشرعية الإجراءات المتخذة. ومن الأهمية بمكان النظر بعناية في المستويات والأنواع المختلفة للتواضع والتواضع من “طرف ثالث” فيما يتعلق بما يمكن تحقيقه بشكل واقعي، خاصة عند التفكير في المصلحة الذاتية الفردية وإرادة الأطراف المشاركة في المناقشة الهادفة. علاوة على ذلك، لا يمكن المبالغة في أهمية التخطيط الدقيق والإعداد الشامل، لأنه يشمل عناصر رئيسة مثل نية ما قبل الأزمة، واستراتيجيات العمل الفعالة للأزمات، وتطوير سياسات مدروسة جيدًا بعد الأزمة الموجهة نحو حل طويل الأجل. ومن الضروري أيضًا تسليط الضوء على الدور الحاسم، الذي تؤديه الوساطة في التعامل بفعالية مع حالات الأزمات، مع التركيز الشديد على إيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف المعنية، وتيسير عملية بناءة تعزز التفاهم والتعاون المتبادلين. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تحسين وتعزيز تدريب ممارسي الوساطة والمستشارين على القواعد الأساسية والضرورية للوساطة، وتغطية جوانبها النظرية والمتغيرات الحيوية المعتمدة، بالإضافة إلى معالجة منحنى التعلم النقدي المرتبط باكتساب الخبرة العملية، لا سيما فيما يتعلق بالتطوير التنظيمي الكبير للتدريب العملي الدولي. وأخيرًا، يمكن أن يكون الإدراج المدروس للوسطاء المضمنين في هذا الإطار الشامل بمثابة مضاعف فاعل للقوة، وبالتالي تعزيز الشراكات المحسنة والمساهمة بشكل إيجابي في تعزيز الشراكات ضمن نموذج غير مؤقت يسفر عن نتائج أفضل وأكثر ملاءمة لجميع أصحاب المصلحة المشاركين في العملية.
ولا شك أن هناك مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة لتعزيز النجاح الشامل لجهود صنع السلام وحفظ السلام وتحقيق الاستقرار بعد الأزمات بشكل كبير؛ في مقدمتها، تهيئة الظروف المواتية والملائمة، التي يمكن أن تسمح بفعالية بصعود سيادة القانون وتعزز هذه المبادئ الحيوية للحكم الرشيد في البلدان المضيفة، التي تمر بفترات من الأزمات والتحول بعد الأزمات. ويجب أن تشمل هذه العملية ليس فقط تثبيت السلام المستدام، ولكن أيضًا الحفاظ على هذا السلام المستدام وصونه على المدى الطويل، وضمان تحديد إجراءات الوكالة واستجابات الشاغل الرئيس بوضوح وتنظيمها وتوضيحها من أجل تحسين الفهم والتنفيذ الفعال. ومن الأهمية بمكان الاستفادة بنشاط من وجود أصحاب المصلحة المتنوعين ومساهماتهم المحلية لنقل الموارد والمعرفة والخبرات المحددة اللازمة لجهود إعادة البناء الشاملة. لذلك، فإن إقامة روابط أقوى وأكثر فعالية بين العمليات العسكرية والدعم الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإعمار المستهدف خلال مرحلة ما بعد الصراع الحرجة أمر حتمي لتحقيق انتعاش شامل يعود بالنفع على جميع أبعاد المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والوكالات الحكومية إلى زيادة تعزيز فعالية هذه المبادرات، وتوفير نهج أكثر تكاملًا لبناء السلام يعالج الأسباب الجذرية للصراع وعدم الاستقرار. علاوة على ذلك، فإن إنشاء آليات التعاون المحلية، وصيانتها المستمرة، والتقييم الدقيق أمر ضروري للغاية لتعزيز المشاركة المجتمعية وتسهيل النمو. ويعد إنشاء نموذج حوكمة موسع شامل وتمثيلي أمرًا بالغ الأهمية. ويجب أن يأخذ هذا النموذج في الاعتبار الاحتياجات والتطلعات المتنوعة لجميع السكان. ولذلك، فإنه ليس مفيدا فحسب، بل إنه حيوي حقًا لتحقيق النجاح والاستدامة على المدى الطويل في جميع المجالات. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنشاء ولاية “كينزية” والحفاظ عليها بشكل مستمر في أعقاب الصراع أمر في غاية الأهمية. وتهدف هذه الولاية إلى توفير المساعدة اللازمة لجهود إعادة البناء الاجتماعي الفعالة، مع معالجة الأنواع المتميزة من الحكم، التي تميل إلى الظهور بعد فترات من الاضطرابات. ويضمن هذا النهج رعاية الاستقرار والمرونة الشاملين بمرور الوقت، مما يمكن المناطق المتضررة من التعافي وإعادة البناء والازدهار مرة أخرى. وفي هذه العملية، من الأهمية بمكان أن تتم جهود إعادة البناء بطريقة عادلة وعادلة لجميع الأطراف المعنية، وبالتالي تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع والتعاون، الذي سيؤدي إلى مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.
تعزيز الصمود الوطني:
ومثلما تسعى معظم الدول إلى ضمان أن تتضمن بنيتها التحتية أنظمة زائدة عن الحاجة وقدرات محددة للغاية للاستجابة للأعطال البيئية والتقنية والتعافي منها، يجب عليها تطوير بنيتها التحتية السياسية والاقتصادية لتشمل قدرات محددة للتعامل مع “الإخفاقات”، التي من المحتمل أن يفرضها تهديد تدخلات “المتسلل العالمي” المكثفة، أو بمعنىً آخر اختراقات “الطرف الثالث” غير المرغوب فيها. وسيكون لهذه “المرونة الوطنية” المعززة تأثير مباشر على الدور، الذي يمكن أن تلعبه دول “الطرف الثالث” في زعزعة، أو ربما تعزيز الأمن والاستقرار من خلال مساعدة الدول المختلفة على تقدير خيارات الحد من الضعف. ويجب أن يكون التركيز الأولي في تطوير “المرونة الوطنية” في مجال المشاكل الأكثر صلة بالخطوط العريضة الحالية للعلاقة بين الدول العظمى والعالم المتقدم حديثًا وفي المستقبل. وهذا يعني أن الجهود الأولية يجب أن تركز على تعزيز الدفاعات في سياق إدارة النزاعات وإنفاذ السلام. وأفضل طريقة للبدء هي تحديد الخصوم المحتملين ضمن الفئة الطبيعية لـ”مديري الأزمات المحليين” بشكل سري وتدريجي ومنحهم إمكانية الوصول إلى هذا النوع من القدرات السرية، التي تستخدمها الدول المتقدمة للتحقق من الامتثال للاتفاقيات الرئيسة. ويشير التفكير على هذا النمط إلى أن دولة مثل الولايات المتحدة تصدر قانونًا من شأنه أن يَسْتَبْعد، رهنًا بقرار الرئيس، المتمردين والكيانات الأخرى من الخارج، التي يمكن تعريفها بشكل معقول على أنهم متدخلين غير شرعيين من أي حقوق في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة. وهذا يعكس نفس المنطق، الذي يوافق على الرقابة الداخلية على الأسواق بسبب مساهمتها في نزاهة الأسواق المالية. ويهدف هذا الاقتراح إلى زيادة التكاليف والحد من فعالية تدخلاتهم، من شأنه أن يمنع أي مجموعات داخلية ترغب في الاستفادة من حقيقة أن مستوطني النزاع من الخارج يمكنهم تحديد الأنشطة العسكرية الفردية عن طريق استدعاء أوامره إلى مساعديه في المنزل من هاتف عام. وبدلًا من ذلك، ستضطر الجماعات المتمردة إلى اختراع وسائل أكثر تعقيدًا لاستخدام التجارة العالمية لإخفاء أنشطتها، في حين أن مساهمة الدول المتقدمة في نزاهة عملية صنع السلام ستخضع لمزيد من التدقيق. في البداية، في مواجهة مهمة التعامل مع المتمردين الخطرين في دول أخرى، ستجد واشنطن نفسها بعد ذلك تراقب الخطوات المقترحة لمساعدة الآخرين على مواجهة الجرائم الخطيرة والتخريب ومحاولات خصم محتمل لتعطيل سيادة القانون. ويجب أن تتطور المعاهدات والمنظمات بطريقة تناسب التكوينات السياسية والاقتصادية المختلفة على نطاق واسع للبلدان المهمة في العالم. ومع ذلك، يجب أن يكون من السهل سرد الأولويات. ويجب أن يكون الهدف العام هو تطوير مجموعة كاملة من قدرات إدارة النزاعات، التي تكمل وتعزز مؤسسات الحوافز والنزاهة والضمان والكبح العادية، التي يستخدمها المنافسون المحليون لتسوية نزاعاتهم. وبعبارة أخرى، يجب دعم قدراتهم الداخلية: (أ) على تحديد الدوافع والحوافز المفيدة لأي حل للاستحواذ ومعاكسة للمغامرات الخارجية، (ب) مراقبة أن الأعمال العدائية للمنافس الخارجي لا تنجح في توفير أي ميزة خاصة على الحلول، التي يمكن أن يقدمها مديرو المأزق، (ج) التأكد من أن المشاركين يستخدمون البدائل خارج النزاع لتقديم الوعود، والضمانات والإجراءات، التي تؤكد الوعود ذات المصداقية لدرجة أن مؤسسات الردع تظل الوسيلة الفعالة الوحيدة لإدارة الصراع. وتتمثل فائدة السياسة طويلة المدى في مساعدة الآخرين على التمتع بالقدرة على جعل حل اللحظة الأخيرة لأزمات المفاوضات الاستراتيجية المهمة هو الفعل العام للتحول، الذي يزيل المخاطر، التي حددها منظرو التصعيد.
تعزيز التعاون الدولي:
من المعرف أن الدول الضحية لا يمكن أن تتصرف من جانب واحد، أو مستقل عمليات “اختراق” خطيرة من جانب “طرف ثالث”، ولا سيما من هذا النوع، الذي يصعب التصدي، أو التخفيف من حدتها بفعالية. وتمثل هذه الإجراءات مشكلة دولية هامة وملحة تتطلب استجابة منسقة وجماعية من المجتمع العالمي. وبالتالي، فإن التعاون الدولي ضروري وضروري للغاية للحد بشكل كبير من الحوافز، التي تؤدي إلى الاستفزازات والاستفزازات المضادة اللاحقة قبل أن تتصاعد إلى مستوى كارثي، أو مأساوي. ومن مصلحة جميع الدول في جميع أنحاء العالم تجنب مثل هذا التصعيد؛ وبنفس القدر من الأهمية الحاجة إلى مناصرة الآخرين ومساعدتهم على تجنب الوقوع في نفس الفخاخ وإغراءات الحرب النووية والقتال والصراع المدمر. ونحن بحاجة جماعيًا إلى إيجاد طرق مجدية ومبتكرة لإدارة القوات التقليدية على نحو أكثر فعالية من أجل تخفيض وتقليل الضغوط المتزايدة، التي تجبر الدول على التلويح بالأسلحة النووية، بل والأكثر إثارة للقلق، إمكانية استخدامها في الحالات، والتي قد تنشأ ويصعب التحكم فيها. وعلاوة على ذلك، يجب أن يتم إنشاء آليات قوية لرصد والحد من مختلف أنواع التجارب، أو الأنشطة الفضائية، التي تؤكد وتسلط الضوء على المصالح الجماعية في التطوير المحتمل للقدرات، التي من شأنها أن تمكن من شن الهجمات دون سابق إنذار، أو بدون إنذار، لأن ذلك يشكل تهديدًا خطيرًا وكبيرًا للأمن والاستقرار العالميين. ومن الأهمية بمكان أن تعترف كل دولة بالمسؤولية المشتركة، التي نتحملها في تعزيز عالم أكثر أمانًا من خلال التعاون والحوار والعمل الدؤوب للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تعكس الإرادة الجماعية لمنع مثل هذه النتائج الخطيرة.
وبعد كل هذا؛ هل يمكن للمجتمع الدولي أن يعالج بفعالية الشواغل الهامة والملحة، التي تنشأ فيما يتعلق بـ”اختراقات الأطراف الثالثة” الخطيرة، التي تشكل تهديدًا على وجه التحديد لسلامة واستقرار الهيكل الدولي القائم؟ ويشمل هذا الهيكل مجموعة متنوعة من اتفاقات تحديد الأسلحة، التي تم إبرامها لضمان الأمن العالمي. لذلك، فإن مشهد هذه الاتفاقيات القائمة لتحديد الأسلحة الاستراتيجية متجذر بقوة في المفاهيم التقليدية للردع والاستقرار الاستراتيجي، التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، والتي ركزت في الغالب على القضايا النووية والترسانات النووية. في الواقع، تم تصميم اتفاقيات الحد من الأسلحة هذه بدقة على مر السنين لخفض أعداد الأسلحة النووية وأنظمة إيصالها والحد منها بشكل منهجي، بهدف تعزيز الاستقرار من خلال آليات تعاونية تعزز تبادل المعلومات الهامة بين الدول المشاركة في هذه الاتفاقات. علاوة على ذلك، عملت هذه الاتفاقيات على الإعلان صراحة عن مناطق، أو مناطق، أو تقنيات ناشئة معينة على أنها محظورة من حيث الانتشار والنشر. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تؤسس إطارًا محددًا جيدًا للسلوك المسؤول بين الدول، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بتوسيع القدرات العسكرية الخطرة، التي يمكن أن تؤدي إلى الصراع. وهذه التدابير الوقائية حيوية للحفاظ على بيئة دولية آمنة حيث يمكن للدول الانخراط في الحوار والدبلوماسية بدلًا من تصعيد التوترات، التي يمكن أن تهدد السلام في نهاية المطاف.
الخلاصة:
جادل هذا المبحث بأن التغيير المستمر في طبيعة الصراع، مصحوبًا بالغياب الأخير للتنظيم الفعال فيما يتعلق بالصراعات، التي تنشأ عن “اختراق الطرف الثالث”، يعكس انقسامًا مقلقًا وعميقًا في السياسة العالمية اليوم. وهذا الوضع المقلق مدفوع إلى حد كبير بزيادة التصرفات الفردية في السياسة العالمية، مما يعقد الإطار الدولي القائم. ومن خلال الجمع بين وجهات النظر المختلفة؛ على وجه التحديد، كيف تغذي القومية الحروب الأهلية جنبًا إلى جنب مع الطلب الشعبي المتزايد على المشاركة الجيوسياسية، التي يتردد صداها بعمق داخل العديد من الدول، مع التعريف الدقيق للمجتمع الدولي نفسه والآليات المختلفة، التي تقود التعبير عن السيادة، يصبح من الواضح أن هذه العناصر ضرورية في الحفاظ على النظام والاستقرار في المشهد السياسي الفوضوي. ومع ذلك، فإنها تميل إلى توليد انقسامات عميقة بين المجتمعات الحضارية والسياسية وداخلها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم التوترات وسوء الفهم. ويسمح هذا النهج التكاملي بفهم أعمق لكيفية وسبب تطور السياسة العالمية بمثل هذه الطرق المعقدة والمتعددة الأوجه. وفي حين أن هناك بعض السوابق التاريخية، التي تم تحليلها سابقا لمحددات الصراع، فمن الواضح أن السياق المعاصر لدراسة هذه الموضوعات وتأثيرها على الصراع يستلزم مزيدًا من التطوير والتنقيح للفكر من أجل التكيف مع الحقائق المتغيرة. ومع ذلك، في حالة الحروب الأهلية واسعة النطاق وفي دراسة الديناميات المعقدة للحروب والصراعات الأهلية الأكثر محلية وأصغر حجمًا، فإن فكرة المجتمع الدولي ذاتها تواجه تحديًا عميقًا ويعاد تشكيلها. وتنشأ هذه الصعوبة لأن مفهوم المجتمع الدولي لا ينطوي بشكل لا لبس فيه على الانسجام، أو السلوك الحميد أخلاقيًا بين الدول والمجتمعات المعنية. بدلًا من ذلك، غالبًا ما يسلط الضوء على التحديات والاختلافات الكبيرة الموجودة في القيم السياسية والاجتماعية، مما يؤدي إلى صراعات دبلوماسية أكثر تعقيدًا، ومواجهات عنيفة محتملة.
لهذا، فقد تم النظر بعناية في الآثار العميقة لـ”اختراق الطرف الثالث” على ديناميات الصراع والتنظيم الأوسع للسياسة العالمية وتحليلها بدقة في مجموعة متنوعة من السياقات. وسواء نظرنا إلى الوضع الحالي للعالم على أنه مركزي بشكل مفرط، أو ربما غير منظم وفوضوي بشكل مفرط، فمن الضروري بشكل أساس أن نُدرك أن “اختراق الطرف الثالث”، على الرغم من أهميته، لا يمكن أن يحل بشكل فعال محل الدور الحاسم والحيوي، الذي تلعبه الدول المهيمنة داخل النظام الدولي. وكما كان واضحًا باستمرار على مدار التاريخ، يمكن أن يكون بمثابة كبح حاسم لسلوك الدول المستبدة وأفعالها غير الخاضعة للرقابة في كثير من الأحيان، لكن إيجابياته ظلت محدودة للغاية مقارنة بعواقبه. وقد جرى تطوير التمييز بين عدم المساواة غير الرسمية والمساواة الرسمية، لا سيما من حيث كل من التعبيرات والاستخدام العملي الفعلي للسيادة، وبشكل شامل ومناقشته بدقة من قبل العلماء والممارسين على حد سواء. لذلك، فإن مسألة ما إذا كان المجتمع الدولي يمثل حقًا المساواة وعدم التجانس على حد سواء مسألة معقدة، ولكن ظاهرة “اختراق الطرف الثالث” تثبت بعمق أن المساواة في السيادة ليست ممكنة فحسب، بل إن المفاوضات والحوار الجماعي الهادفين حولها يحدثان بالفعل. ومثلما تتطلب الحروب اتخاذ قرارات دقيقة والتزامات جوهرية من الأطراف المعنية، يمكن للتعاون أن يعمل بسهولة أكبر على توضيح القضايا الخلافية، وربما يؤدي إلى حلول وسط في كل من السياسة الوطنية والإقليمية. وبهذه الطريقة المهمة، يمكن أن يلعب “اختراق الطرف الثالث” أحيانًا دورًا مهمًا في مساعدة السياسة العالمية على التطور نحو عالم أكثر تنظيمًا واستقرارًا، لا سيما في تناقض صارخ مع عالم يتسم بعدم اليقين الكبير ويميل إلى التقليل من أهمية القوة والمصلحة في قيادة العلاقات الدولية.
_____________
* أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية بجامعة سكاريا، تركيا، والأمين العام لمنتدى الفكر العربي، الأردن
الثلاثاء، 22 أبريل 2025
مطار الدوحة، دولة قطر
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.