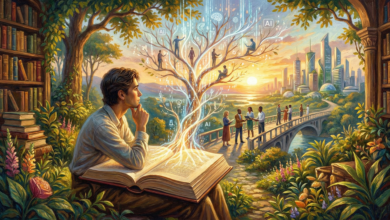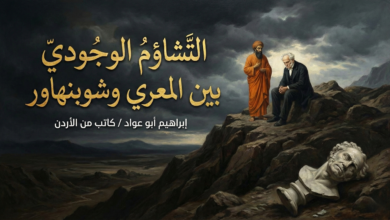فلسفة المستقبل: جوهر الاستشراف والرؤية الاستراتيجيَّة
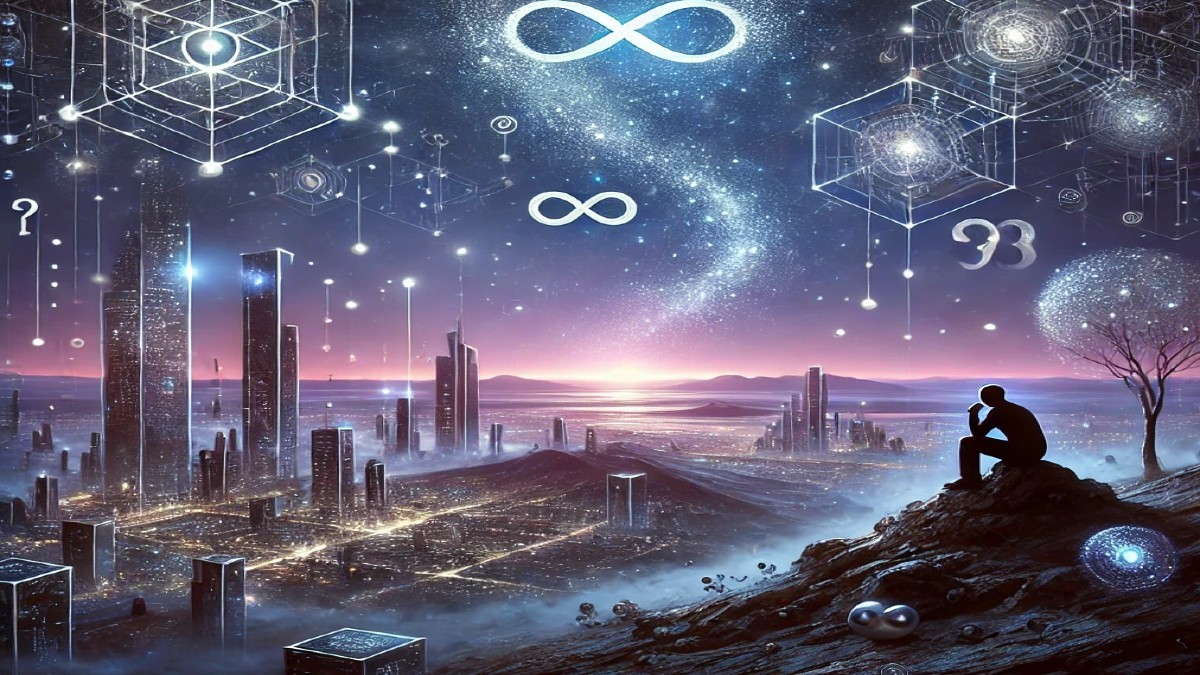
الدكتور الصادق الفقيه*
مدخل منطقي:
يحمل مستقبل “الرؤية” الفلسفية للحياة والكون وعدًا هائلًا، ويعمل كاحتمال مثير للاهتمام للغاية لجميع الذين يأخذون الوقت الكافي للتفكير في أهميتها. وكأني بصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال يحدث عن هذه “الرؤية” في هذا المستقبل عندما ظل يعيد على مسامع الحضور؛ في محاضرته بكلية الدفاع الوطني الأردنية، يوم الأربعاء 26 شباط/فبراير 2025، “رؤيته” حول التخطيط الاستراتيجي والاستشراف. وأحسب أن القناعة لدى سموه هي طرح التساؤل المفتوح، وهو: هل يمكن لأي شخص، بغض النظر عن مستواه التعليمي، أو قدراته المتنوعة، أن يفشل حقًا في الشعور بالإلهام “الرؤيوي”، وأن يأسره الفكر المبدع حول الاحتمالات المثيرة، التي قد تنتظرنا في عالم البحث الفلسفي الواسع والمتطور باستمرار؟ لأنه في مجال “الرؤية” الفلسفية الواسع والرائع، الذي قد يبدو للوهلة الأولى أنه يقف في تناقض صارخ مع العلوم الأخرى، لأنه يثبت اكتشاف حقيقتها الكاملة والنهائية بما أنه مسعى صعب ومعقد، ولا يزال بعيد المنال بشكل محير بالنسبة للعديد من المفكرين. إذ إن حلم الشاعر، ورؤية الفنان، ووحي الرائي العميق؛ كل هذه الأفكار البراقة في متناول أيدينا، مغلفة في الكمال المذهل لجمالها الرائع وما تختزنه من العجائب، التي تثيرها في أذهاننا وأرواحنا. فقد يتواصل العلم معنا حول العوالم، التي لا تعد ولا تحصى، الكبيرة والصغيرة، الموجودة في سلسلة متصلة لا نهاية لها من الزمان والمكان، وتغوص في عوالم بعيدة كل البعد عن محيطنا المألوف في الكون. وتناقش “الرؤية” الفلسفية العديد من الأنظمة والظواهر البعيدة من الناحية الفلكية، وغالبًا ما تبدو غير قابلة للتصور تمامًا في حجمها وتعقيدها الهائل. ومع ذلك، فإن سبر الأغوار النهائية للأسرار سيظل لغزًا آسرًا لم يتم الكشف عنه وفهمه بالكامل بعد، ويبقى في ظلال فضولنا الجماعي. علاوة على ذلك، لا ينبغي الاستدلال على أن العلم وحده هو المجال الوحيد، الذي يعبر عن الشعور بالفشل في مساعيه. في الواقع، يجب أن تنطبق الانتقادات والتوبيخ المدروس، التي يجب أن يقدمها العلم أيضًا على الفلسفة نفسها، التي تعاني انعدام “الرؤية”، على الرغم من نواياها النبيلة وتطلعاتها العالية، من العديد من الأخطاء الفادحة والخرافات، التي لا أساس لها من الصحة وربما “السخافات” و”التفاهات”، التي يمكن أن تلقي بظلالها على فهمنا للعالم. لذلك، غالبًا ما ترتكب الفلسفة؛ كما الفكر، خطأ فادحًا يتمثل في التركيز فقط على سماء واحدة وأرض واحدة، والتركيز على غروب واحد وشروق شمس واحدة، بينما تفشل في مراعاة التعقيدات والتفاصيل الدقيقة والمعوقات الهائلة الموجودة خارج نطاقها الفوري، وغالبًا ما يكون هذا التركيز محدودًا للغاية. فقط من خلال “الرؤية” والتصور العميق لعملية لا نهاية لها، تشمل دورات النهار والليل، التي لا نهاية لها، ودرجات الطقس المتقلبة للحرارة والبرودة، والدوران الأبدي للأقمار والكواكب، والتوازن الدقيق بين الحياة والموت نفسه، يمكننا البدء في الوصول إلى فهم أكثر شمولًا لتمثيلهما الحقيقي، حيث توجد فقط كأحداث غارقة في الصدفة والأحداث العشوائية. وهذه الحوادث، بدورها، يمكن تنظيمها بدقة في العديد من المستويات المتميزة من الحقائق والملاحظات والعلاقات المعقدة، التي تحيك نسيج الوجود معًا. وفي هذا العالم، أو في أي عوالم أخرى محتملة قد تكون موجودة خارج تصورنا، فإن المسعى النبيل لـ”الرؤية” الفلسفية ليس مجرد تحديد حقيقة فريدة ونهائية، بل بالأحرى السعي من أجل فهم أعمق للوجود نفسه. إنها تُشبِه التلسكوب القوي، الذي يسمح لنا برؤية التناقضات، التي تكمن تحت السطح بشكل أكثر وضوحًا من ذي قبل، وفتح الحلول الممكنة، وتوسيع حدود الكون المعقول، الذي نعيش فيه ونستكشفه بشكل حدسي. لذلك، على الرغم من الواقع، الذي لا يمكن إنكاره، وغالبًا ما يكون صعبًا، وهو أنه لا أحد مِنَّا يعرف حقًا الإجابات النهائية لهذه الأسئلة المحيرة والعميقة والدائمة، فإن هذه الأسئلة لا تزال يتردد صداها بعمق في عقول وقلوب الحكماء والمفكرين والتأمليين، وحتى الفضوليين، الذين يسعون إلى الفهم. وتتمحور مشاكل “الرؤية” الفلسفية الدائمة بشكل أساس حول فهم اتجاه وهدف الحركات والتحولات والتطورات المستمرة في العالم. ومع ذلك، يشعر بعض الأفراد بالخجل من الانخراط في هذه الاستفسارات الكبرى والمفاهيم المعقدة، ولا يسع المرء إلا أن يشعر بالجرح والإحباط إلى حد ما عندما يدرك أنهم يتوقعون فقط وصول المفكرين، أو القادة، إلى الحقيقة المنشودة؛ كل واحد يجسد تفسيره الخاص للفكر الديكارتي المتجذر في مبادئ الشك والاستفسار. وكأني بالواحد منهم يحدث نفسه بالقول: “أعتقد أنني أفضل أن أشعر بالخروج تمامًا من عالمي”، فيما نُسِبَ إلى أحد الأفراد وهو يصارع الألم والمعاناة على سريره، “بدلًا من محاولة خلق عالم كامل من خلال عقلي وتولي الدور الشاق للألوهية”. في مثل هذه الحالة، ما الذي تختار الفلسفة بالضبط الانخراط فيه في نسيج الوجود الكبير؟ فهل يمكن أن يكون كل ذلك مجرد صرح كبير للنفي، أو تعبير عن اليأس من الحالة الإنسانية؟ أو ربما يمثل توغلًا في وجود العقل نفسه، متحديًا حدود فهمنا؟ وبطبيعة الحال لا يمكن لهذه الأفكار أن تلخص الوظائف الأصيلة والمتنوعة لـ”الرؤية” الفلسفية، التي يكمن هدفها الحقيقي في كشف لغز الحياة العميق والمعقد، مع المنطق، الذي يجب أن نطبقه النابع من المبادئ الأساسية للطبيعة نفسها، والتحدث في دروس أساسية وقابلة للتطبيق بطبيعتها يتردد صداها مع تجاربنا الحية والرحلة، والتي نقوم بها طوال وجودنا في هذا الواقع المعقد دائمًا المسمى بـ”الحياة”.
الرؤية الفلسفية وتشكيل المستقبل:
هناك عدد قليل جدًا من الأسئلة، التي تحمل مثل هذه الأهمية الفكرية الكبيرة وتمتلك تاريخًا طويلًا ومعقدًا بشكل ملحوظ مثل تلك الاستفسارات، التي كانت مركزية في مجال الفلسفة الواسع على مر العصور. بالإضافة إلى ذلك، فإن الغرض الأساس للفلسفة منذ بدايتها كان متجذرًا باستمرار في الرغبة في فهم الطبيعة المعقدة للعديد من الأشياء، التي تحيط بنا في كوننا الشاسع والمعقد وفهمها بشكل كامل. ولا ينطوي هذا السعي المستمر والديناميكي على تحديد واضح فحسب، بل ينطوي أيضًا على توضيح ما هو المقصود حقًا بالمناقشات، التي تتعلق بالواقع والقيم الأخلاقية، فضلًا عن وجود الله وصفاته، من بين العديد من المعضلات الفلسفية المعقدة الأخرى. وللتعبير عن المقصود بطريقة شاملة وصارمة فكريًا فيما يتعلق بمثل هذه القضايا الأساسية والخالدة، من الأهمية بمكان أن تكون النتائج والاستنتاجات المستمدة من العلوم، إلى جانب آثارها العميقة، بمثابة الأساس المتين والموثوق، الذي يمكن أن يتكشف منه الفهم الفلسفي ويتطور بشكل مناسب. هذا الجانب التأسيسي هو بالضبط السبب في أن الفهم الأكثر اكتمالًا وثراءً ودقة لـ”نوع الأشياء الموجودة” لا يمكن اشتقاقه إلا من خلال التقدير العميق والاعتراف بما تعلمناه عن الواقع والوجود من خلال الرؤى، التي لا تقدر بثمن، والتي توفرها كل من العلوم الطبيعية والاجتماعية. وهذه الأفكار هي تلك، التي نحن محظوظون للغاية بما يكفي للانخراط فيها في مجتمعنا المعاصر اليوم، وهي تعزز بشكل كبير وتطور استفساراتنا واستكشافاتنا الفلسفية في طبيعة الوجود نفسه، وتواصل الحوار القديم، الذي استمر عبر تاريخ البشرية.
من خلال بذل جهد متضافر ومتفاني لجمع وتحليل وتوليف الأفكار الثاقبة الأكثر عمقًا المستمدة من العديد من المجالات والتخصصات المختلفة، يمكننا إنشاء فهم أكثر اتساعًا وتماسكا لكل ما نعرفه. وفي هذه العملية الحيوية، تلعب الفلسفة دورًا حاسمًا كإطار أساسي يُمَكِّنُ تفكيرنا من الوصول إلى أعلى إمكاناته وكفاءته. هذه السمة الأساسية للفلسفة هي السبب في أنها تعتبر بحق، ويُحتفل بها بفخر، على أنها ملكة العلوم، إلى جانب كونها حارسًا ثابتًا للتقدم البشري والتطور الكبير عبر التاريخ. وتتوقف الصحة العامة والرفاهية والازدهار للدول في نهاية المطاف على التصورات المشتركة والمعتقدات الجماعية لمواطنيها فيما يتعلق بما هو حقيقي ومفيد وجيد في الأساس. وإذا أكدنا أن الفهم الشامل والواسع النطاق والعميق للواقع يلخص الجوهر الحقيقي للفلسفة، فهذا يعني منطقيًا أن الفلسفة ذات المغزى والجديرة بالاهتمام يجب أن تستكشف وتعالج بشكل معقد ومدروس الأسئلة الأساسية المتعلقة بطبيعة الواقع، والقيم الإنسانية الأساسية، التي توحدنا، وجوهر الذات الإلهية؛ كل ذلك مع الاعتراف بترابطها العميق. ولا يمكن إدراك هذه المفاهيم النقدية والمحورية بشكل فعال، أو ربطها بشكل متماسك عند التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض. وبدلًا من ذلك، يتطلب ذلك تكاملًا مدروسًا وشاملًا للاستنتاجات العامة، التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بهذه المسائل الهامة. ولا يمكن تحقيق مثل هذا التوليف بالكامل إلا من خلال فهم شامل للرؤى المستقاة من كل من الاكتشافات العلمية المعاصرة والتأملات الفلسفية الغنية، التي تميز وتحدد عصرنا، وتُؤكد على أهمية المشاركة التعاونية والحوار متعدد التخصصات في إثراء فهمنا لهذه القضايا الحيوية.
الأسس التاريخية للفكر المستقبلي:
بتحويل انتباهنا إلى الجذور التاريخية العميقة لهذا النوع المحدد من التفكير، فإننا مضطرون منذ البداية إلى توضيح التمييز المهم، الذي غالبًا ما يتم تجاهله بين فلسفة المستقبل والأفكار المختلفة، التي تركز عليها بشكل بارز في المناقشات والخطابات المعاصرة. وكل مرحلة فردية في القوس الطويل للتنمية البشرية تنطوي على تصور خاص ومحدد؛ هما الماضي والحاضر، ولا سيما المستقبل كما تصوره المفكرون والمجتمعات في تلك الأزمنة. ويجب استخلاص استنتاج حاسم مماثل في مجال الفلسفة الواسع، حيث غالبًا ما تتأثر الرؤى بالسياق الاجتماعي والسياسي للعصر. وسواء في دراسة الفلسفة نفسها، أو في فلسفة المستقبل الأوسع، لُوحِظ تطابقٌ قويٌ ومهمٌ بين الشكل السائد للتنظيم في المجتمع ومفهوم المستقبل، الذي يميز الفترات التاريخية المختلفة، مما يعكس الآمال والمعايير والتحديات، التي تواجهها المجتمعات. وهذه العلاقة المعقدة تجعل الوفرة الملحوظة من القضايا والموضوعات لنظرية المستقبل النامية، التي يمكن أن تشمل الأخلاق والتكنولوجيا والديناميات الاجتماعية، من بين عوامل مهمة أخرى تشكل مصير الإنسان. فقد أصبحت هذه النظرية المتطورة تعرف باسم فلسفة الحياة، وهو مصطلح يلخص الطرق المختلفة، التي يسعى بها البشر إلى فهم وجودهم، والبنى الاجتماعية من حولهم، ومسارهم وهم يتحركون إلى الأمام في عالم متزايد التعقيد والمترابط. ومن خلال هذه العدسة الشاملة يمكننا اكتساب فهم أكثر عمقًا ودقة لتعقيد وعمق أفكارنا المتطورة فيما يتعلق بما ينتظرنا كبشر وقيمنا المشتركة وتطلعاتنا والعالم كما نعرفه، وإيقاظ الشعور بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة، التي سترث الموروثات، التي نصنعها اليوم.
لهذا، عند فحص المراحل المختلفة والهامة في التفكير الفلسفي، يمكننا تحديد خمس فترات رئيسة بوضوح شكلت بعمق النسيج الواسع لتاريخ المعالجة الصادقة واستكشاف المشكلات المعقدة، التي تحيط بالمستقبل. ويمكن وصف عصر ما قبل الفلسفة؛ أولًا، بشكل مناسب ودقيق تمامًا، بأنه زمن تميز بالغرائز الخام وردود الفعل الحيوانية للبشر، الذين كانوا يعملون في المقام الأول ككائنات بيولوجية. وكان هؤلاء الأفراد يمثلون بوضوح وغريزية بقائهم الفردي قبل كل شيء، مدفوعين برغبة لا تنضب في المثابرة والازدهار. وثانيًا، يمكن اعتبار كل القلق النفسي والاضطرابات، التي ظهرت في الأساطير ما قبل الفلسفة على أنها نابعة من الاهتمام الإنساني الأعمق، المتجذر في الرغبة في إطالة عمر المرء. وكانت هذه الرغبة الأساسية بمثابة الشرط المسبق الأساس لتحقيق رغبات وتطلعات شخصية أخرى أكثر بدائية وأساسية يحملها الناس في أعماق أنفسهم. وثالثًا، فقد أدى الفيضان الهائل من الطاقة الإبداعية، التي تم إطلاقها من خلال اكتشاف طرق مختلفة لتحقيق تلك الرغبات، بمجرد أن يتم إثارتها وإلهابها بالفعل، إلى ازدهار غني لحياة مليئة بالمغامرات الخيالية والروايات المعقدة الموجودة في الأساطير. ورابعًا، انتهت شعبية كل مغامرة في النهاية إما بالقرار السعيد للأسطورة، أو بحل ألغاز “أوراكل”، التي كانت بمثابة منارة للأمل والبصيرة والحكمة العميقة، التي توجه الأرواح المضطربة في تلك الحقبة. علاوة على ذلك، كانت الطريقة السائدة لإنتاج الحياة خلال هذا الوقت غير مخطط لها إلى حد كبير وفردية للغاية، وتعكس الرحلات والمغامرات الشخصية، التي قام بها كل بطل، أو شخصية مركزية في تلك الحكايات القديمة. ورابعًا، ظهرت الندرة كنتيجة مباشرة للتحديات العديدة، التي يفرضها العمل العقلي والجسدي الشاق، الذي لم يكن مكرسًا صراحة لاكتشاف حلول أنيقة وسهلة التكرار لعدد لا يحصى من المشاكل الملحة، التي تواجه المجتمع ككل. لذلك، وخامسًا وأخيرًا، غالبًا ما تم تكليف المهمة المتمثلة في الحد من خسائر الموارد ببطل مغامر دائما كانت سعادته الأساسية والشخصية هي هدفه النهائي، مما دفعه إلى الأمام في هذا السعي المستمر للبقاء والإنجاز في عالم غالبًا ما بدا قاسيًا ولا يرحم. وهنا يكمن التفاعل المعقد بين الدافع الفردي والحاجة المجتمعية، مما يكشف عن التأثيرات العميقة، التي أحدثتها تلك القصص القديمة وأبطالها على تشكيل الاستفسارات الفلسفية المبكرة حول معنى الحياة والوجود والغرض منهما.
وجهات نظر فلسفية قديمة حول المستقبل:
في أعمال أفلاطون الشاملة والمؤثرة، يتم الاعتراف بالفلسفة باستمرار وبثبات على أنها الشكل الوحيد الفريد والصحيح حقًا للمعرفة، وتقف بشكل مدوي فوق كل شيء آخر في أهميته وقيمته. لذلك، يترتب على ذلك، ربما ضمنيًا وبدون تعبير مباشر، تجاهل الزمن المستقبلي للفعل “أن يكون” ببساطة عندما يتعلق الأمر بتطبيقه بدقة على موضوع البحث المركزي للفكر الفلسفي. وضمن حواراته العديدة، ينخرط أفلاطون تمامًا مع المفاهيم الغنية والأشكال العالمية والجواهر الخالدة الموجودة خارج التدفق السائل لتجربتنا الزمنية وتصوراتنا المتغيرة باستمرار، التي غالبًا ما تلقي بظلالنا على حكمنا. وبعد ذلك، من تشبيه الكهف المنير والمجازي العميق، نفهم بعمق أن الفلسفة الحقيقية تتعلق بشكل أساس بالعالم العميق والجوهري، الذي يقع وراء كهف التجربة المجردة، بدلًا من العالم السطحي للتجربة الخشنة والعابرة، التي يختزنها معظمنا عادة ويعتبرها أمرًا مفروغًا منه. ومع ذلك، يجب أن نسأل، هل هذا السعي الفلسفي يمتد أيضًا إلى العالم، الذي نشير إليه غالبًا باسم “عالم الظل”، عالم التجربة الملموس نفسه، الذي نتعامل معه كل يوم؟ وقد تتكشف الرحلة المعرفية من مجرد الرأي إلى المعرفة الراسخة بالفعل خطوة بخطوة، وهو صعود تدريجي يتحقق من خلال شقنا للطريق بعناية ومهارة من خلال الآراء السلبية الشبيهة بالصور منخفضة الدرجة، التي تمثل كل ما يمكن لمعظمنا الوصول إليه في حياتنا اليومية وروتيننا اليومي. وفي الواقع، يعمل أفلاطون نفسه بسلسلة دقيقة للغاية من الخطوات، التي تم إنشاؤها بعناية، والتي تمثل أشكالًا نقية بشكل متزايد من الرأي، وتسعى في النهاية للوصول إلى أسفل المقياس، الذي يحدد الوجود الموضوعي المقبول، أو المعروف في سياق الفهم الحقيقي. وهذه العملية الصارمة والمنهجية ضرورية للغاية لسد الفجوة المعرفية الكبيرة الموجودة بين مجرد الرأي والمعرفة المستقرة والقوية، التي يمكن تحقيقها من خلال البحث الفلسفي الجاد، الذي يمكن من خلاله أن يمر التواضع ويسكن، ولكنه لا يسمح بمرور عدم اليقين، أو الارتباك، أو الباطل في الفهم، مع التأكيد على أهمية الوضوح في مساعينا الفلسفية.
وفي المشهد المعقد والمتعدد الأوجه للتجربة الإنسانية الملموسة؛ الذي هو عالم واسع وواسع حيث تتجذر أشكالنا المختلفة من النشاط السياسي وتتطور وتزدهر، توجد ضرورة عميقة لفهم ودراسة هذا الواقع من خلال العدسة الثاقبة لفكره السياسي. في هذا السياق الأوسع، تنخرط “الجمهورية” بحماس في صراع صارم مع المعضلات المتنوعة والمعقدة، التي تنشأ حتمًا في السعي المتواصل لمواءمة المبادئ المتنوعة والأهداف الطموحة والهياكل المعقدة للمجتمع. وهي تشارك بنشاط في استكشاف مدروس ونقدي لكيفية ربط المفهوم الصعب والمثير للجدل في كثير من الأحيان للحرية الفردية بالحاجة الشاملة والملحة لتكوين اجتماعي جيد التنظيم وسليم أخلاقيًا وجيد بطبيعته. ويؤسس هذا الاستكشاف بشكل فعال أساسًا متينًا لتحقيق التناغم العقلاني البشري، وهو أمر حيوي لتعزيز التماسك المجتمعي والوحدة. وحتى في هذا الإطار الفلسفي العميق والمثري، يجب على المرء أن يدرك تمامًا أن الوقت لا يمارس ضغوطه المعتادة، التي لا هوادة فيها. وتصبح هذه الملاحظة بارزة وجديرة بالملاحظة بشكل خاص عند النظر إليها من خلال الزمن المستقبلي الانعكاسي للفعل “أن تكون”، مما يشير إلى احتمالات أكثر من القيود. وتكشف الاتجاهات السائدة، التي لوحظت حتى الآن في العمل الموسع لأفلاطون عن عملية توجيه مثيرة للاهتمام تنجذب بشكل طبيعي نحو أنواع أكثر تجريدًا من الفكر والمثل العليا. وتشمل هذه الأنواع المجردة المثل العليا الخالدة والأشكال الأساسية، التي يتم تصورها وفهمها على أنها مهمة إلى الأبد في جوهرها وأهميتها. وفي هذا الاتجاه بالذات نكتشف التفسير الشامل والتطبيق العملي للمعرفة، مما يشير إلى الاتجاه المناسب والمفضل حقًا لكل من الفكر والعمل في المجال السياسي الواسع والمعقد والديناميكي. ومن خلال هذا الاستكشاف العميق للفكر السياسي، لا نعمق فهمنا لهذه العلاقات المعقدة والترابطات المتداخلة فحسب، بل نكتسب نظرة ثاقبة لا تقدر بثمن لجوهر الوجود البشري داخل التركيب الغني للنسيج المجتمعي، مما يؤدي إلى التنوير الشخصي والجماعي.
الحركات الفلسفية والمفكرين الرئيسيين:
تتمثل إحدى الحركات الحاسمة في الفكر المعاصر؛ أولًا، في تطوير نظرية النظم، التي تستلزم فحصًا عميقًا وشاملًا للنظام بأكمله ككيان متماسك، مع التأكيد على أهمية فهم كيفية تفاعل المكونات المختلفة مع بعضها البعض والتأثير عليها، بدلًا من مجرد تحليل هذه المكونات بمعزل عن بعضها البعض كمجموعة بسيطة من الأجزاء. ويدرك هذا النهج الشامل أنه لا يمكن استنتاج وظائف وسلوك النظام بأكمله في كثير من الأحيان من الأجزاء الفردية وحدها، مما يؤدي إلى رؤى وحلول أكثر شمولًا. وتنبثق مدرسة فلسفية؛ ثانية، مهمة من الجدل المستمر والديناميكي حول الاختزالية، وهو نقاش ساخن يشكك في صحة وآثار تقسيم الظواهر المعقدة إلى مكونات أبسط، ويدعو إلى وجهات نظر متنوعة تتحدى المنهجيات التقليدية والعقلية الاختزالية. ويدفع هذا الخطاب الصارم المفكرين إلى إعادة النظر في قيود الاختزالية واستكشاف مناهج أكثر تكاملية. والحركة الفلسفية؛ الثالثة، متجذرة في علم الحساب سريع التوسع والتطور، حيث تلعب الأساليب الحسابية المتقدمة والنماذج المبتكرة دورًا مركزيًا بشكل متزايد في تعزيز فهمنا للظواهر المختلفة عبر العديد من المجالات، مما يؤثر ليس فقط على البحث العلمي، ولكن أيضًا على الاستكشافات الفلسفية. وينطوي التحول الحيوي؛ الرابع، على إعادة التفكير العميق في الفلسفة نفسها، وإعادة تصورها على أنها “منطق تطبيقي” يمتد إلى ما هو أبعد من مجرد التفكير المجرد لمعالجة التطبيقات العملية عبر مجالات متنوعة، وحث الفلاسفة على التركيز على الآثار الواقعية وعواقب نظرياتهم. وتتميز الحركة؛ الخامسة، باستكشاف متجدد للأسئلة الوجودية العميقة، التي شغلت الفلاسفة تقليديًا لعدة قرون، والتي لم يتم التعامل معها من خلال عدسة المنطق الحديث، أو الأطر التحليلية الصارمة، بل تقع حول أطراف العلم ومتجذرة بعمق في مبادئه التأسيسية، مما يوضح الترابط بين التحقيقات الفلسفية والتحقيقات العلمية. وأخيرًا، تثير الحركة الرئيسة؛ السادسة، أسئلة عميقة ومثيرة للتفكير حول طبيعة البحث الفلسفي نفسه: هل أصبح السعي وراء الفهم الفلسفي في شكله الحالي قديمًا، أو غير ذي صلة في عالم سريع التغير؟ وهل الأسئلة الملحة ذات الأهمية الإنسانية المطلقة والمعنى تقتصر فقط على عوالم العلوم الإنسانية والفنون، أم أنها تتجاوز الحدود المساقية؟ لذلك، من الضروري ليس فقط تحديد هذه المدارس الفلسفية الست المتميزة، ولكن أيضًا تحديد بإيجاز من هو رائد هذه الحركات التحويلية، وكيف ترتبط ببعضها البعض، وما هي الطرق المبتكرة، التي تؤثر بها على المشهد المتطور للمؤسسات الأكاديمية وجامعات المستقبل. فقد شكلت هذه الاعتبارات النقدية بلا شك على الانقسامات والمناقشات المحيطة بهذه الموضوعات الملحة في الخطاب الفلسفي المعاصر.
وتشكل نظرية الأنظمة، جنبًا إلى جنب مع تعميمها الموسع المعروف باسم علم التحكم الآلي من الدرجة الثانية، توسعا مفاهيميًا مهمًا بشكل ملحوظ يتجاوز مجرد النظر في المكونات المعزولة. بدلًا من ذلك، فإنه يشمل النظام بأكمله ككيان معقد ومتماسك. وضمن هذا الإطار الشامل، تعتبر التفسيرات المبسطة، أو الذرية، أو المخصصة، التي تركز حصريًا على الأجزاء الفردية غير كافية بشكل مبرر. لذلك، فإن المنظور الثاقب، الذي توفره علم التحكم الآلي من الدرجة الثانية شامل بطبيعته، حيث يسعى إلى دمج ليس فقط المراقب، ولكن الوكلاء المشاركين والكائنات الحية في النظام قيد التحليل. ويسهل هذا التضمين الحاسم فهمًا أكثر عمقًا لكيفية تطبيق المراقب لنماذج الدرجة الثانية، أو حتى الثالثة لتفسير وفهم سلوكيات وأفعال هؤلاء المشاركين، الذين، بدورهم، يستخدمون نماذج من الدرجة الأولى للتنقل بنجاح في واقعهم المعقدة. علاوة على ذلك، فإن الأبعاد الاجتماعية الغنية، التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من الأنظمة تصبح واضحة بشكل متزايد من خلال منهجيات أكثر رسوخًا مستمدة من مفهوم “الديالكتيك” الهيجلي. ويؤكد هذا التفاعل الأساس بين التفكير “المنظومي” والديناميات الاجتماعية على الترابط المعقد بين العناصر المختلفة ومساهماتها الكبيرة في الوظائف الشاملة للنظام بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، فإن مبادئ علم التحكم الآلي، التي تتجلى في كل من جانب أنظمتها التأسيسية وأبعادها الأكثر تعقيدًا من الدرجة الثانية، تتخلل الكثير من السلوك الذكي، الذي يظهره جميع الوكلاء داخل هذه الأنظمة. ويوسع هذا التقاطع العميق بين علم التحكم الآلي والذكاء تأثيره بعيد المدى إلى التحقيقات الفلسفية العميقة، التي تستكشف العوالم الغامضة لميكانيكا الكم وعلم الكونيات. ولا يحفز هذا الاستكشاف على تأملات نقدية حول طبيعة الملاحظة والواقع فحسب، بل يشجع أيضًا العقول الفضولية على التفكير في نسيج الكون نفسه. وتتردد آثار هذه النظرة الشاملة في مختلف التخصصات والمجالات، مما يدعو إلى مزيد من الاستكشاف والفهم للعلاقات المعقدة بين الأنظمة والمراقبين والأهمية الشاملة للترابط بينها.
ما بعد الإنسانية:
تقف صفة ما بعد الإنسان في تناقض صارخ مع الصفة الخبيثة لـ”ما بعد الحقيقة”، التي تُستخدم باستمرار في سياق أوسع يشمل الاستثناء والسلبية. وإذا كنت ستطرح السؤال المثير للتفكير على أي شخص، وتستفسر مباشرة عما إذا كان يعرف بأنه ما بعد الإنسان، أو ما بعد الحداثة، أو ما بعد البنيوي، فستواجه دائمًا إنكاره الفوري والغريزي للمصطلح. بدلًا من ذلك، قد تلاحظه يحاول تهميشها من خلال تصنيفها على أنها متطرفة، أو متعصبة، أو حتى خطرة بطبيعتها. وينطوي هذا التصنيف على تهديد متصور للمعايير والقيم والأعراف الراسخة في المجتمع. والجانب المثير للاهتمام حقًا؛ هو ما يمكن أن نشير إليه بظاهرة ما بعد الإنسان متعددة الأوجه، حول طبيعته البشرية، أي هو أنه، في الواقع، يوجد كل فرد داخل حدوده الخاصة والمعقدة. إن أي شخص يعتقد خلاف ذلك هو مجرد إنسان مسكون بمخاوف من الوحوش المضاربة، التي يتخيل أنها قد تكون كامنة داخل الإطار المفاهيمي المعقد والمتنوع. وهناك، في الواقع، أولئك المتناقضون الذين قد يجادلون بأن الوحش الحقيقي هو، في الواقع، البشرية نفسها، التي تشمل الإنسانية ككل، أو ربما مجرد فكرة متعددة الأوجه لفهم والتعرف على العناصر المتأصلة بعمق، التي تحظى بتقدير كبير ونفخر بها كثيرًا. فالجذر اللاتيني “post” يحمل بداخله المعاني المزدوجة لـ”بعد” و”ما بعد”، وهكذا، عندما نفكر في مصطلح ما بعد الإنسان، فإنه يشير إلى شعور مستنكر بالانتماء إلى الطرق القديمة المألوفة للوجود البشري، أو هو موقف أكثر من إنساني يرفع بشكل ملحوظ مفهوم الوجود نفسه إلى آفاق جديدة. لذلك، أن تكون ما بعد الإنسان يستلزم تجاوز الحدود التقليدية والراسخة للجوهر البشري وفهمه وقدرته. وفي هذا الضوء المنير، تبرز ما بعد الإنسانية كمسعى فكري طموح، يهدف إلى التحقيق بعمق ومركز في حدود ما يعنيه حقًا أن تكون إنسانًا، وبالتالي إنتاج رؤية غالبًا ما تبدو غير واقعية بشكل مثير للاهتمام، مليئة بالتجسيد المستقبلي لعضلة “سايبورغ،” أو طرف حيوي، أو وجه بلاستيكي حيوي يؤكد بجرأة وسلاسة المساواة بين الجسد والعقل. ولذلك، فإن تتبع الأسس الفلسفية لهذا المشروع الجريء والموسع في أصوله المعقدة إلى الحركة المعروفة بشكل بارز باسم ما بعد الإنسانية، تنذر باستكشاف تحويلي وإعادة فحص الطبيعة البشرية نفسها، والتعمق في المناطق المجهولة لوجودنا، التي تدعونا لفحصها بشكل أكبر.
لهذا، فإن تعزيز جسم الإنسان بوسائل مختلفة، مصممة خصيصا لتلبية الرغبات والأحلام والتطلعات الفريدة لكل فرد، هو مثال قديم، يعكس شوقًا عميقًا يمكن إرجاعه إلى أسطورة العصر الذهبي نفسه. وعبر الامتداد الواسع من التاريخ، سعى أشخاص من مجموعة من الثقافات المختلفة والخلفيات المتنوعة بحماس إلى مسارات مبتكرة لتعزيز أنفسهم في عدد لا يحصى من الأشكال. ومنذ الأيام الأولى لأسلافنا في عصور ما قبل التاريخ، اعتمدت ممارسات التنقيح الذاتي، وتعديل الجسم، وإدخال رفقاء الجسم “الطقسيين” دائمًا بشكل كبير على حكمة ورؤى العديد من العرافين الموثوق بهم، والأيدي المساعدة الإيثارية، وسائقي العربات المهرة، والملالي الحكماء، ورجال الطب المطلعين، والأطباء المتفانين. وعلى الرغم من أن مهنة الطب لعبت دورًا أساسيًا في المجتمع البشري لفترة قصيرة نسبيا فقط، امتدت لبضعة آلاف من السنين فقط، إلا أن الفهم الأعمق وإدراك مدى حياة الإنسان وجميع تعقيداتها كان أقصر وأقل فهمًا. وفي الآونة الأخيرة جدًا، كشفت الدراسات العلمية والتطورات الكبيرة عن حقيقة مثيرة للاهتمام؛ وهي عادة ما تتوقف أجسامنا عن نموها وتطورها قبل وقت طويل من الحاجة إلى التوقف. وبالتالي، يمكن اعتبار الشكل الجسدي، الذي يختبره كل واحد مِنَّا مثالًا على ضعف الأداء، وهو أمر نقبله ونتحمله على مضض في المقام الأول، لأننا نعتقد أنه ببساطة لا توجد بدائل قابلة للتطبيق متاحة لنا في هذه المرحلة. في حين أنه من الصحيح بلا شك أن الآثار الحتمية للتآكل والعمر تؤثر باستمرار على مر السنين، إلا أننا نجد أننا نقضي الجزء الأكبر من حياتنا دون أن تنهار أجسادنا تمامًا، أو تتخلى عن وظائفها بالكامل. ومن اللافت للنظر أننا نلاحظ أننا نميل إلى العيش لفترة أطول وأعمر مع كل جيل يمر، مما يؤدي غالبًا إلى زيادة الفضول والتساؤل المستمر فيما يتعلق بحدود طول عمر الإنسان. والسؤال الحاسم، الذي يطرح نفسه من هذا الاستكشاف إذن هو ما إذا كان من الممكن، أو الواقعي على الإطلاق تطوير منتج صيدلاني قادر على إطالة كل من العمر واستدامة حالة الشباب بشكل فعال دون المساس بالأداء بأي طريقة يمكن تصورها؟ قد يمهد هذا الاستكشاف للاحتمالات غير المستغلة الطريق بالفعل لمجالات مجهولة من الصحة والرفاهية، مما يمكن الأفراد في النهاية من تحقيق ليس فقط حياة أطول، ولكن بالأحرى حياة مليئة بالحيوية والطاقة والحيوية، التي تعكس تطلعاتهم حقًا.
الاعتبارات الأخلاقية:
في هذه المبحث، سوف نعاين بعض الموضوعات الغنية والمتنوعة المتعلقة بعلم المستقبل الأخلاقي جنبًا إلى جنب مع الأخلاق متعددة الأوجه في المجال الواسع للفلسفة المستقبلية. ويتماشى موقفنا العام ومنظورنا تجاه المفهوم المعقد للمستقبل كشيء مهم أخلاقيًا بسلاسة مع نهجنا لاستشراف هذا المستقبل، الذي يتم تصوره على أنه مجرد مفهوم يمثل ما سيأتي. وفي كلا السيناريوهين، يظهر الفعل العميق المتمثل في إضفاء الطابع الإنساني على الوقت كحافز قوي يشجع الأفراد الذين يقبلون عن طيب خاطر القيود الأخلاقية المتعلقة بأفعالهم؛ خاصة في البعد الواسع والمعقد للمستقبل، على القيام بأكبر دور كامل واستباقي قدر الإمكان في تشكيل هذا الواقع القادم. علاوة على ذلك، فإنه يتطلب بشدة أن ينخرطوا بنشاط في السلوكيات، التي تعكس نفس الاعتبارات الأخلاقية والسلوكية، التي نأمل أن يتبناها كل فرد عقلاني وحر في حياته الخاصة، هنا والآن، ضمن النطاق الزمني الأرضي، الذي نعيش فيه حاليًا. وقد تصبح هذه المشاركة النشطة عنصرًا حاسمًا، لأنها تعكس قيمنا وتطلعاتنا المشتركة من خلال السماح لنا بنسج اهتماماتنا الأخلاقية في نسيج المستقبل، الذي سنختبره جميعًا بشكل جماعي.
عندما يؤجل الفرد أنشطته المختلفة إلى المستقبل البعيد، مدفوعًا بالرغبة في إبقاء أكبر عدد ممكن من الخيارات مفتوحة لنفسه قدر الإمكان، فإن هذا السلوك يعزز في النهاية اعتقاده الخاطئ عن نفسه كعقل كوني خالد. بدلًا من ذلك، قد يشير إلى أنه شخص تنتظره الوعود المروعة على الغبار القاحل لقرن مجهول لم يأت بعد. وعادة ما يتم تضخيم هذه العقلية من خلال الأمية الكونية المنتشرة بين أولئك الذين يحملون تطلعات مماثلة. وتقودهم هذه الظاهرة إلى التركيز، غالبًا على حساب انفتاحهم على انفتاح المستقبل، على المستقبل نفسه كمفهوم مجرد. في المقابل، فإن البالغين الذين تعلموا حساب تاريخهم وتجاربهم محصنون ضد فقدان علاقتهم بما ينتظرهم. وبدلًا من الإصرار على أن احتياجاتنا، أو رغباتنا هي أهم، أو حتى الأولويات الوحيدة، بدلًا من الاستسلام للخوف من إلحاق أقصى قدر من الظلم، أو التسبب في ضرر كارثي لا يحصى للبشرية، نبدأ في الكشف عن التعددية الغنية للصفات المحتملة الموجودة في الشؤون الإنسانية. لذلك، فإن وجهة النظر الكونية المتماسكة تعلمنا أن نُدرك الكون في ظل الجوانب الإنسانية الحقيقية، التي تكمن داخل طبقات ما يتجاوز أي فرد بمفرده. ونتعلم أنها ستلقي بظلالنا على انشغالنا بالهيمنة الشخصية والرغبة المعزولة المحتملة لفهم القوة المخيفة، التي من شأنها أن تسمح لنا بإبطال أهمية التاريخ نفسه. ومن خلال هذا الفهم التحويلي، يمكننا تنمية مشاركة أكثر مجتمعية واستنارة مع العالم من حولنا، مع التفكير في كيفية صدى خياراتنا داخل النسيج الأوسع للوجود البشري.
ويمكن التأكيد بقناعة كبيرة بأن الأبعاد العميقة للمنظور الأخلاقي مفتوحة حصريًا لأولئك الذين يتمتعون بمسؤولية واستدامة في نظرتهم الإنسانية. ومن وجهة النظر الموسعة والدقيقة هذه، التي يمكن أن تكون ضمنية بشكل، أو بآخر من خلال ثقافة إنسانية مشتركة ومتعاطفة، فإن المستقبل المتوخى، الذي يمثله الأفراد ويتخيلونه ويعدونه بنشاط يمكن أن يقدم بالفعل شيئًا أكثر اتساعًا بكثير من الثقافة الإنسانية، التي كانت موجودة سابقًا. لذلك، فإن الانفتاح الأخلاقي تجاه المستقبل يحكمه ديناميكيًا الحرية المتذرعة في فن العيش الأصيل، في البحث المفعم بالأمل والتفاؤل، وكذلك في المشاركة السياسية الملتزمة. ولذلك، فإن أولئك الذين يغلقون قلوبهم على أحد هذه الجوانب الأساسية قد يغلقونها بشكل فعال أيضًا على المستقبل كما هو مقصود؛ أي باعتباره احتمال يتكشف. ولأننا، أخيرًا، نحن الذين نرغب بجدية في ترسيخ رغبتنا في سلام دائم للبشرية جمعاء. وهذه الحماسة الأخلاقية والسياسية العميقة، تتكئ على أساس متين ومنطقي، وتدخل بنشاط في قوائم البعد المعرفي الواسع، الذي يظل مفتوحًا أيضًا للمستقبل كمستقبل؛ لأننا نحن مهتمون في المقام الأول بهذه الجوانب المختلفة للمستقبل، ونفعل ذلك، باتباع التعاليم الراسخة للسلمية العالمية، من دون أن نطلب أي شيء في المقابل من أي شخص لأي خطوة يتم اتخاذها نحوها على حساب المستقبل كما هو حاضر، أو على حساب بعض الأشياء المرجعية الكونية، التي يمكن تحديدها ببعض الوسائل في الممارسة، والتي من شأنها أن تتماشى بشكل مناسب مع التسرع في الأفق الاستراتيجي بالتأكيد على أقصر وقت ممكن.
أخلاقيات علم الأحياء والتكنولوجيا:
إن المستقبل يرتكز في الغالب على التطور في فرعين للمعرفة، وهما علم الأحياء وعلوم التكنولوجيا، لذلك ترتكز أخلاقيات علم الأحياء وأخلاقيات التكنولوجيا؛ على أساس المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة، وتستعد للعب دور محدد بشكل كبير في تشكيل تطور الحضارة، بينما نتنقل في طريقنا عبر تعقيدات الألفية الثالثة. وتظهر القضايا الملحة المختلفة المحيطة بأخلاقيات علم الأحياء، والأخلاقيات التكنولوجية، والأخلاق الأوسع المرتبطة بكل من العلوم والتكنولوجيا كنتيجة مباشرة للعمليات المنسقة والمدارة بدقة بشكل متزايد، التي تمليها الوكالة البشرية في المجالات الواسعة للبحث العلمي والتقدم التكنولوجي. وتشمل التحديات، التي تواجه النظرية العامة للأخلاق فئات متخصصة موجودة في أخلاقيات علم الأحياء وأخلاقيات التكنولوجيا، وكلاهما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطور المستمر والتطبيق العملي والتأثير المجتمعي الواسع النطاق للتكنولوجيا على حياتنا. وتقف أخلاقيات علم الأحياء كعنصر حاسم في الأخلاقيات الشاملة للمعرفة العلمية، حيث تتعمق في الآثار الأخلاقية والمعضلات الأخلاقية، التي تنشأ عن التقدم في التكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك الهندسة الوراثية والبحوث الطبية الحيوية والقضايا المتعلقة بتقنيات الإنجاب. لذلك، فإن الرؤى، التي تقدمها أخلاقيات علم الأحياء ضرورية لضمان توافق التقدم العلمي مع المعايير الأخلاقية، التي تعطي الأولوية لكرامة الإنسان ورفاهيته. وفي الوقت نفسه، ينبثق مجال أخلاقيات التكنولوجيا من ظهور وظائف متخصصة في أنشطة الأفراد، مثل إنشاء أشكال مختلفة من التقنيات واستقبالها وتوزيعها واستخدامها، إلى جانب إقامة شراكات تكنولوجية تسهل الابتكار والتعاون. وتصوغ هذه الاعتبارات الأخلاقية التكنولوجية إطارًا شاملًا لفهم الآثار الإضافية وغير المتوقعة في بعض الأحيان، التي يمكن أن يحدثها تطبيق التقنيات المتنوعة على المجتمع. ويشمل ذلك المهمة الأساسية المتمثلة في الاستجابة وتلبية المطالب والاحتياجات المتزايدة باستمرار للبشرية، مع تعزيز تطوير وتحسين علم النفس البشري والرفاهية العقلية والتفاعلات الاجتماعية في نفس الوقت. ويكمن المفهوم الأساس لأخلاقيات التكنولوجيا في إدراك عميق بأن مجال نشاطها متشابك بشكل معقد مع التقاليد والأيديولوجيات والمبادئ الأساسية العريقة الموجودة في التفسيرات الفلسفية والأخلاقية للعلاقة بين الطبيعة والتكنولوجيا وحاضر ومستقبل المجتمع البشري. علاوة على ذلك، تنتج التقنيات تأثيرات يمكن تصنيفها على أنها “داخلية”، في إشارة إلى المبدعين وتجاربهم الفردية، بينما تتعلق التأثيرات “الخارجية” بالسياق المجتمعي الأوسع، مما يؤدي إما إلى توسيع، أو تقييد طوعية الأنشطة البشرية. ولا يؤثر هذا التفاعل الديناميكي بين التكنولوجيا والأخلاق على الإبداع البشري وإمكانات النمو فحسب، بل يحول أيضًا أنظمة الحياة الراسخة، التي تحكم وجودنا. وفي النهاية، يمكن أن يؤدي إلى كل من التدمير المحتمل للبشر وتعزيزهم ككائنات طبيعية وروحية، مع التأكيد على الحاجة الماسة للاعتبارات الأخلاقية في التطور التكنولوجي. ولذلك، فإن العلاقة المعقدة بين التكنولوجيا والأخلاق تقف كجانب أساس يجب النظر فيه بعناية بينما نسعى جاهدين لتحقيق تقدمنا المجتمعي المستقبلي ورفاهيتنا الجماعية.
وجهات نظر حول التقنيات الناشئة:
بدأ هذا المبحث بادعاء قوي بأن فلسفة المستقبل يجب أن تواجه بنشاط التحدي الملح المتمثل في التركيز على المشهد سريع التغير للتقنيات الناشئة. ومن الضروري ألا تراقب الفلسفة هذه التطورات فحسب، بل تلعب أيضًا دورًا نشطًا في صياغة المشورة النقدية، وكذلك المبادئ التوجيهية الشاملة، التي تتعلق بالتحديات التكنولوجية الحالية والمستقبلية، والتي تواجهها البشرية في مختلف المجالات. ونُظِّمَ النقاش بعناية في عدة أقسام أساسية، كل منها مخصص لتقديم موضوعات حوار محددة تعزز التبادل الهادف بين تخصص الفلسفة والهجوم الدؤوب للتقنيات الناشئة. داخل كل قسم، تم تحديد معضلات معينة تنبع من الآثار الجديدة للتكنولوجيا بعناية، بما في ذلك تلك، التي تنشأ في العوالم المعقدة للواقع الافتراضي، وعلوم الحياة الواسعة، والمجال التحويلي للذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، علينا نستكشف تطبيقات الآلات المستقلة في سياقات عسكرية مختلفة، التي أثارت نقاشًا أخلاقيًا كبيرًا. ولكل قسم من هذه الأقسام، اقترحنا العديد من الأفكار الفلسفية ذات الصلة بمعالجة المعضلات، التي تم تحديدها. وخلال هذا الجزء من المبحث، نحاول تفصيل مجموعة من وجهات النظر حول كيفية تعامل الفلسفة؛ بل يجب عليها، التعامل مع التحديات التكنولوجية متعددة الأوجه المطروحة. ونعتقد أن هذه المشاركة ليست مجرد خيار؛ بل هي الخيار الأمثل، لأنها التزام في مواجهة التقدم التكنولوجي السريع. في الجزء اللاحق، وجهنا تركيزنا صراحة نحو التأكيد على أربع تخصصات فلسفية فرعية مهمة تعمل كنقاط تثبيت حيوية في المناقشات الحالية المستمرة، التي تحدث بين الفلاسفة والمهندسين، وكذلك بين الفلاسفة وعلماء الاجتماع الآخرين. وهذه التبادلات حاسمة، لا سيما في سياق التعاون بين الفلاسفة وخبراء المجال المتجذرون بعمق في كل من الهندسة وعلوم الحياة. وتسلط هذه المناقشات المدروسة بشكل جماعي الضوء على الفكرة النقدية القائلة بأنه لكي يسفر الحوار المجتمعي والأخلاقي عن نتائج ذات مغزى، من الضروري تطوير التأملات النقدية المركزة حول التحديات الجديدة، التي تفرضها التقنيات الناشئة واستكشافها وتقييمها بدقة. ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن نُدرك أنه حتى أكثر الرؤى الفلسفية تحفيزًا فكريًا ليست كافية، في حد ذاتها، للإبحار في هذه المياه المعقدة والمتطورة باستمرار. ويجب فهم العمل التعاوني ووجهات نظر علماء الهندسة، وكذلك الممارسين في المجال، الذي تهدف فيه الرؤى الفلسفية إلى العثور على التطبيق، بشكل صحيح. ويجب أن تؤخذ هذه المبادرات في الاعتبار، وأن تحظى بتقدير حقيقي من أجل تحقيق نهج شامل. بهذه الطريقة، يمكننا تعزيز حوار أكثر ثراء ودقة يسمح لنا بمعالجة القضايا الأخلاقية الملحة، التي أوجدتها التطورات التكنولوجية، والتي تهدف في النهاية إلى مجتمع مجهز بمعرفة وخبرات لتسخير هذه الابتكارات بمسؤولية ومدروسة.
الذكاء الاصطناعي والأخلاق:
من أجل تطوير نظام قوي وذو مغزى من القيم والأخلاق بشكل مدروس وشامل مصمم خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي سريع التطور والمعقد، يجب على المرء؛ أولًا، أن يسعى إلى فهم عميق لما يعنيه الذكاء حقًا بأشكاله العديدة. وهذا يعني أنه يجب على المرء أن يمتلك مفهومًا واضحًا ودقيقًا وشاملًا للعقلانية، الذي ينطوي بطبيعته على القدرة على التفكير الجيد والحكم السليم، والذي يستنير بسياقات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يشمل جوانب حاسمة مثل الشخصية والوعي والمفهوم المعقد متعدد الأوجه للذات، التي تستمر في التطور. ومع ذلك، عند الفحص والتدقيق الأعمق والأكثر شمولًا، يصبح من الواضح تمامًا أنه لا أحد يعرف حقًا ما هي أي من هذه العناصر الحاسمة والهامة في الواقع، بغض النظر عن مدى اعتقادهم بأنهم يفعلون، أو مدى ثقتهم في تأكيداتهم. وليس لدينا حتى البدايات الأولية لتفسير متماسك، أو مقبول عالميًا فيما يتعلق بما تعنيه هذه المفاهيم الأساسية، ولا نفهم تمامًا كيف ترتبط ببعضها البعض، أو كيف يمكن أن تأتي إلى حيز الوجود، أو تتطور بمرور الوقت في مشهد ديناميكي. باختصار، يجب اعتبار المخطط الفلسفي التقليدي لهذه المفاهيم زائدًا عن الحاجة، أو عفا عليه الزمن، أو غير كافٍ بشكلٍ أساس في ضوء الاستفسارات والمناقشات الحديثة المحيطة بطبيعة الذكاء والوعي. والآن، لنفترض أننا ببساطة نصف روبوتًا متقدمًا يمكنه الأداء بمستوى يساوي، أو ربما حتى يتفوق على أي شخص بشري في كل مهمة يقوم بها الفرد عادة طوال حياته اليومية. ويتضمن ذلك الجانب الحاسم المتمثل في قدرة الروبوت على محاكاة الخصائص الأساسية، التي يبدو أنها تُشير إلى أن الشخص يمتلك عقله الخاص، بالإضافة إلى الرغبات والعواطف وربما حتى ما يشبه الوكالة الأخلاقية، التي تؤدي إلى اعتبارات أخلاقية. ومثل هذا الروبوت، دون أدنى شك، سينظر إليه على أنه شخص في حد ذاته من قبل أولئك الذين يتفاعلون معه، مما يتحدى بشكل أساس افتراضاتنا ومعتقداتنا الراسخة حول ما يعنيه حقًا أن تكون كائنًا واعيًا. وبالتالي، يفتح طرقًا جديدة ومفيدة للاستكشاف الفلسفي والأخلاقي.
ولكن بعد ذلك، ما الذي ستترتب عليه التزاماتنا الأخلاقية بالضبط عندما يتعلق الأمر بالروبوتات المتقدمة للغاية، التي قد تطور يومًا ما مستويات من الذكاء والاستقلالية يمكن مقارنتها بمستويات لدينا؟ هل يجب أن نستمر في اعتبار أنه من المناسب تركيب، أو تفكيك هذه الروبوتات بطريقة مشابهة لكيفية تعاملنا مع القطع الأثرية العادية، والأشياء الخالية من المشاعر، أو الوعي؟ وهل يجب أن نوظف بنشاط جيوشًا ضخمة من الروبوتات للقيام بأنواع مختلفة من العمل، التي نجدها مملة، أو دنيوية، أو تحط من كرامتنا الإنسانية؟ علاوة على ذلك، هل يجب أن نتخذ تلك الخطوة المثيرة للجدل المتمثلة في برمجة هذه الروبوتات لفرض عقوبة على الأفعال، التي قد نعتبرها غير مقبولة، أو سلوكًا سيئًا؟ هل يجب أن تمتلك هذه الروبوتات شكلًا من أشكال الإرادة الحرة، التي تعكس إرادة الكائنات الحية، أم يجب أن نختار عمدًا تفضيلاتها ومعاييرها، وبالتالي منحها مظاهر الحرية في إملاء أغراضها الخاصة دون أي عوائق كبيرة؟ أم يمكن أن يكون من الممكن أن نتابع بنشاط خيار أي من هذين البديلين؟ ومن الأهمية بمكان أن نضع في اعتبارنا أن أي شيء يمكن للمرء أن يعبر عنه، أو يصفه، يمكن، من حيث المبدأ، أن يكون مبنيًا، ولو من الناحية النظرية فقط. إذن، ما الذي يجب أن نقدره حقًا في تفاعلاتنا مع هذه الكيانات المتطورة؟ وما الذي يجده الناس بصدق ذا قيمة في علاقاتهم مع الآلات المختلفة، بما في ذلك الروبوتات، التي قد يكون لديها القدرة على التفكير والتصرف بدرجة من الاستقلالية؟ إن هذه الأسئلة، إلى جانب العديد من الاستفسارات الأخرى ذات الأهمية العميقة، تحمل آثارًا كبيرة على الطرق المختلفة، التي نستخدم بها أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما أنها لا تشكل فقط كيفية تفاعلنا مع الكائنات المفكرة، التي نخلقها، ولكن تحدد أيضًا كيف يجب أن تتفاعل هذه الكائنات الرائعة معنا ومع مبدعيها، وربما رؤسائها كذلك. ومع ذلك، قبل أن نبدأ في الإجابة على أي من هذه الأسئلة الملحة بجدية، من الضروري للغاية أن نطور فهمًا أكثر عمقًا لما يعنيه حقًا أن نعتبر كائنًا مفكرًا، أم لا. كما نقف في هذه اللحظة من الزمن، فإن فكرة بناء كائنات مفكرة معقدة قادرة على التفكير والتعلم، وحتى القدرة على العاطفة، تبدو أكثر محتملة وواقعية بكثير من فهمنا الفلسفي الحالي للموضوع، الذي يبدو أنه لا يرقى إلى مستوى التقاط الطيف الكامل لما يستلزمه أن تكون ذكيًا حقًا. ومن الضروري الانخراط بعمق في تَفَحُّص هذه الأفكار، واستكشاف الإمكانات والقيود والمشهد الأخلاقي، الذي يحيط بالتفاعل بين البشر والكيانات الروبوتية المتطورة بشكل متزايد.
الفلسفة البيئية والاستدامة:
دعونا هنا أن نحاول أن نلقي نظرة شاملة وكاملة على المدى، الذي قطعناه في مجال الفلسفة البيئية الواسع والمتنامي باستمرار، الذي اكتسب أهمية متزايدة في الخطاب المعاصر والمناقشات بين مختلف التخصصات. ولطالما طرحت الفلسفة التقليدية، بالطبع، السؤال الحاسم والمهم للغاية: ماذا يمكننا أن نفعل من أجل العيش معًا في وئام وسلام وعدالة حقيقية لأنفسنا وللأجيال القادمة، التي لم تولد بعد؟ وفي معالجة هذا البحث الأساس، نسعى إلى المبادئ العامة للعدالة، التي يمكن أن تقف بشكل مثالي مستقلة عن أي مجتمع، أو سياق ثقافي معين، وتعمل كضوء إرشادي للسلوك الأخلاقي والمسؤولية الأخلاقية. لذلك، مع الواقع الصارخ والمثير للقلق المتمثل في الأخطار العالمية المتزايدة، التي تهدد جنسنا البشري، وكذلك ملايين الأنواع الأخرى، التي تشترك معنا في كوكبنا وتساهم في شبكة الحياة المعقدة، فقد دخلنا الآن في بُعْدٍ مختلفٍ تمامًا وحاسم من تفكيرنا، بُعْدٍ لا يمكن تجاهله، أو التغافل عنه من جانبا. فالآن، لا يتعلق الأمر فقط بالنظام الهيكلي للمجتمع البشري نفسه. بدلًا من ذلك، أصبح السؤال الملح حيويًا بشكل متزايد ووثيق الصلة ببقائنا كنوع. وإلى أي درجة وبأي طرق يمكن أن يؤدي ترتيب معين للمجتمع البشري في نهاية المطاف إلى تدمير مثير للقلق وكارثي للمحيط الحيوي بأكمله ونظمه الإيكولوجية المعقدة، التي تعتبر ضرورية للحفاظ على الحياة؟ ومع ذلك، فقد لوحظ في كثير من الأحيان أنه لم يكن هناك سوى اعتراف ثابت بأن عوالم العلوم الطبيعية والتكنولوجيا داخل المجتمع الرأسمالي من شأنها أن تعرض للخطر بشكل غير متناسب حالة الطبيعة الهشة، التي نعتمد عليها من أجل بقائنا ورفاهيتنا الجماعية. ونادرًا ما تمت مناقشة الدور الهام، الذي لعبته المخاطر الجوهرية المرتبطة بالتطلعات والتقدم التقني في هذه المعضلة، أو فحصه بشكل نقدي بتفاصيل ذات مغزى، مما أدى إلى نقص مستمر في الوعي والمساءلة بين أولئك الذين يمتلكون القدرة على إحداث التغيير. وقد حان الوقت الآن للتفكير في هذه التحديات ومعالجتها، واستكشاف حلول فعالة لضمان التعايش المستدام بين جميع الكائنات الحية.
وفي الأساس، نسأل مجددًا: ما هي مهامنا وإمكانياتنا الآن كفلاسفة وعلماء اجتماع ولاهوتيين في هذا العالم المعقد، الذي يتطلب اهتمامًا عاجلًا وعملًا حاسمًا من جميع المعنيين؟ وإذا وجدنا أنفسنا قلقين بشكل متزايد بشأن المستقبل غير المتوقع للبشرية وحالة الحياة غير المستقرة في عالمنا، فمن الضروري أن نُكرس أنفسنا بجد واستراتيجية للعمل، الذي لا يشمل فقط التدابير التعليمية، التي يبدو أنها قد تصبح غير فعالة أكثر فأكثر مع استمرار مسيرة الزمن، والتي لا تراجع فيها. ومن الأهمية بمكان أن نسعى إلى محاولة منع، أو تخفيف بعض الأسباب الجوهرية والملحة، التي تقودنا إلى مأزق محفوف بالمخاطر. فنحن نُؤمن إيمانًا راسخًا بأنه سيتم تحقيق تقدم أكثر جدوى واستدامة من خلال تغيير الأهداف والتطلعات الإنسانية بشكل جذري بدلًا من مجرد القول مرارًا وتكرارًا طوال الوقت بأن الناس قد أصبحوا “غير مسؤولين أكثر فأكثر”، ونأسف لأن أولئك الذين يرغبون في وقف هذا الاتجاه المقلق غالبًا ما يتم رفضهم على أنهم أفراد غير أكفاء، أو ساذجين. وربما يكون الأمر الأكثر أهمية من هذه الاعتبارات هو حقيقة أنه يجب علينا تغيير اللغة، التي نستخدمها بشكل استباقي حول هذه القضايا المهمة. ويمكن أن يكون تغيير النظرة العالمية، أو إنشاء رؤية أساسية فيما يتعلق بالقواعد الأخلاقية، أو المبادئ الأخلاقية أكثر صعوبةً وتعقيدًا مما قد يبدو للوهلة الأولى. ويمكننا مقاومة ما يحدث لنا ومن حولنا، ولكن عندما يتعلق الأمر بما يقال لنا؛ مثل النقاشات المستمرة والساخنة حول المهام الإنسانية، التي تتناقض مع القمع الدموي، الذي تمارسه القوى العسكرية المختلفة، تُصبح هذه المقاومة أقل قابلية للتحقيق. وحتى الإجراءات، التي نتخذها لا يزال مُسيطَرًا عليها بشكل فعال من خلال الوسيط السائد للغة. على سبيل المثال، عندما يتم تصنيف المهام العسكرية بشكل مخادع على أنها “مهام إنسانية”، يتم تخصيص هذا الاسم لها بشكل استراتيجي لإطار زمني وهدف محددين، وغالبًا ما يحجب نواياها الحقيقية ودوافعها الأساسية. ومع ذلك، فإن تأثير اللغة يمتد إلى ما هو أبعد من العمليات العسكرية وينطبق على مستويات أقل من السيناريوهات الإشكالية والمواقف المعقدة. ونحن حتمًا نخلق ونحدد الإجراءات، التي نتخذها لأنفسنا، ونضع القيود على كل ما نرغب في القيام به مع ضمان أننا لا نقتصر على ما نستمتع به، أو نجد ارتياحًا في “روتيننا” اليومي. وإذا جعلنا هذا الأمر غير ضارين، أو حميدين، فإننا نتعامل مع الماضي ونكشف الأسرار الخفية من وجهة نظر معينة، فقط لنكتشف أن هذه العناصر يتم الكشف عنها في النهاية لأغراض الخدمة في سياق أوسع. ويجب أن تتطور تركيبات النظرية، المعترف بها مسبقًا في المناقشات الاستراتيجية، وتتكيف باستمرار. ويصبح من الضروري تطوير تقنيات محفوفة بالمخاطر بشكل مسؤول، مع تعزيز التقنيات المبتكرة، التي تسعى جاهدة لتحقيق التقدم والتطور دون توليد نفايات ضارة بيئيًا وخطيرة يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على الأجيال القادمة.
تغير المناخ وأخلاقيات تخصيص الموارد:
يبدو أنه؛ مع القضية الملحة والمهمة المتمثلة في تغير المناخ البشري المنشأ، التي أصبحت الآن راسخة في طليعة التحديات العالمية، التي نواجهها جميعا، توجد قضية أخلاقية مهمة تتطلب اهتمامنا الفوري والمتعمد والثابت، مما يتطلب ِمِنَّا إجراء تقييم نقدي لمسؤولياتنا الجماعية والتداعيات المحتملة بعيدة المدى لأفعالنا. فما هي القوة الحقيقية والعميقة للالتزام الأخلاقي، الذي يدين به الجيل الحالي للأجيال المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بالمهمة البالغة الأهمية المتمثلة في الإدارة الفعالة لأزمة المناخ العالمية، التي تشكل تهديدًا كبيرًا لأسس الحياة على الأرض؟ يدور هذا السؤال العميق والمركب بشكل أساس حول المسألة المعقدة المتعلقة بتخصيص الموارد، التي يجب أن ندرسها عن كثب ونبحثها بعناية فائقة. وفي جهودنا المستمرة والمتضافرة لتخصيص حقوق انبعاث الكربون وغازات الدفيئة الأخرى في الغلاف الجوي بشكل عادل، فإننا نعالج أساسًا التوازن الدقيق والمعقد بين الحقوق والامتيازات، التي ندين بها للجيل الحالي بالمقارنة المباشرة مع الحقوق الأساسية المتأصلة للأجيال المقبلة في وراثة مورد مناخي قابل للحياة ومستدام، لأنه أمر بالغ الأهمية لاستدامة الحياة، والصحة والرفاهية على كوكبنا. ونحن، في الواقع، نتصارع مع سؤال أوسع وأكثر عمومية حو: ما هي الحقوق، التي يمتلكها هذا الجيل الحالي حقًا في توريث أحفاده؛ فيما يتعلق بالخيرات والموارد الطبيعية الضرورية للغاية للإشباع الشامل والكامل للاحتياجات والرغبات البشرية، المادية وغير المادية على حد سواء؟ ويدعونا هذا التحقيق الأخلاقي باستمرار إلى التفكير بعناية في الآثار بعيدة المدى والطويلة للخيارات والإجراءات، التي نتخذها اليوم وتتحدانا للتفكير بعمق والتداول في مسؤولياتنا تجاه أولئك الذين سيسكنون هذه الأرض في السنوات القادمة. وهذا التفكير مهم بشكل خاص ونحن نفكر في الإرث، الذي نختار أن نتركه وراءنا، وهو إرث يجب أن يوفر بشكل مثالي ليس فقط احتياجاتنا الفورية والملحة، ولكن يخدم أيضًا المصالح الدائمة لسكان المستقبل والأجيال في هذا العالم، مما يضمن قدرتهم على الازدهار في بيئة صحية ومستدامة نحن ملزمون بحمايتها والحفاظ عليها.
لهذا، يمكن تشبيه السؤال العام المطروح بقضية مهمة تتعلق بالوصايا والتركات، التي تسلط الضوء حتمًا على سلسلة من الاعتبارات المعقدة، والتي تشبه ما نقوم بمواجهتها عند توريث ووراثة الأصول القيمة. ومن خلال مزيج نافذ من استراتيجيات الاستثمار الحكيمة؛ وضربة حظ سعيدة في إدارة مواردنا، نجد أنفسنا أمام فرصة مخبأة لوراثة شيء جوهري للغاية؛ عالم طبيعي قابل للحياة لا يلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات والرغبات الحالية لسكاننا فحسب، بل يمتلك أيضًا إمكانية تسخيره من قبل الأجيال المقبلة. وهذا يمكن أن يسمح لهم بتحقيق نمط حياة غني بنفس القدر، إن لم يكن أكثر من نمط حياتنا. لذلك، فأولًا وقبل كل شيء، بما أن وصية مواردنا الطبيعية تمثل، في الواقع، تراثنا المشترك، الذي نتشاركه جميعًا ونتمسك به بأمانة، يجب أن نفكر في الالتزامات، التي ندين بها لأولئك الذين أتاحوا لنا الوصية. وما نوع المسؤوليات والاعتبارات الأخلاقية، التي يجب أن نأخذها في بحزم عند اتخاذ قرارات بشأن الموارد، والتي يجب أن نحتفظ بها لصالح الأفراد الذين، للأسف، لا تتاح لهم الفرصة لإدراك، أو تجربة المدى الكامل للوصية، التي يوفرونها لنا؟ وتقودنا هذه الأسئلة إلى تأملات أعمق حول مكاننا ضمن الاستمرارية الأوسع للإشراف البيئي. وثانيًا، يجب أن نفكر في كيفية حماية هذه الموارد القيمة بشكل فعال من أولئك الذين قد يسعون إلى انتزاعها، أو استنزافها لأغراضهم الذاتية، مما قد يعرض للخطر المستقبل الجماعي لنا جميعًا. وهذه ليست مسألة قانونية فحسب، بل تتعلق بالأخلاق والاستدامة، حيث أن الحفاظ على تراثنا الطبيعي ضروري لرفاهية الأجيال القادمة. وثالثًا، يجب أن نتداول في كيفية توزيع فوائد وصيتنا الطبيعية بطريقة متساوية وعادلة. وهل يجب أن نعترف بها كمشاع في متناول الجميع، وتعزيز روح المجتمع والمسؤولية المشتركة على مواردنا؟ أم يجب أن نتبع نهجًا مختلفًا، ونقسمه إلى وحدات متميزة يمكن تخصيصها بين مختلف أعضاء ممتلكاتنا بطريقة منظمة ومنصفة؟ وتنعكس تعقيدات هذه الأسئلة في فهمنا الحالي لقانون حماية البيئة العالمي، مما يُشير بقوة إلى أن هذه الاستفسارات المتعلقة بتوزيع الموارد يجب أن تُعَالَجُ بأقصى قدر من العناية والمداولات المدروسة. سنحاول هنا أن نستكشف بشكل عام بعض الإجابات والأطر المحتملة، التي يمكن استخدامها بشكل فعال لمعالجة هذه القضايا الملحة، مما يضمن أننا نأخذ في الاعتبار حقوق واحتياجات جميع أصحاب المصلحة المعنيين أثناء تنقلنا في هذا الجانب الحاسم من المشهد المجتمعي والبيئي لدينا.
العدالة العالمية وحقوق الإنسان في عصر التكنولوجيا:
شهد السياق التكنولوجي، الذي تعمل فيه قضية العدالة المعقدة تحولًا عميقًا وجديرًا بالملاحظة، مما أدى إلى إعادة تعريف كبيرة لكل من التحديات المختلفة، التي نواجهها والحلول المبتكرة، التي نعمل عليها في السعي لتحقيق العدالة الحقيقية والمساواة الشاملة. وفي عالم اليوم سريع التطور، لم يعد هناك تقسيم مباشر ومبسط بين الأطر الديمقراطية الليبرالية التقليدية والتفسيرات المجتمعية، أو الدينية الأكثر دقة للعدالة. بدلًا من ذلك، نواجه المشكلة المعاصرة والملحة والمتعددة الأوجه المتمثلة في الحقوق الناشئة حديثًا، التي تسعى إلى معالجة التعقيدات المتزايدة في عصرنا. ويجب أن تكون هذه الحقوق للمستقبل مرنة وقابلة للتكيف بما يكفي لاستيعاب مجموعة واسعة من أشكال العدالة المختلفة، مما يعكس المجتمعات المتنوعة والغنية وغير المتجانسة الموجودة في جميع أنحاء العالم في هذا العصر المترابط والديناميكي. ومع ذلك، من الأهمية بمكان وحيوي بنفس القدر أن تحترم هذه الحقوق وتدعمها المبادئ الأساسية للقيم الإنسانية العالمية والاستحقاقات الأساسية، التي تربطنا معًا كمجتمع عالمي متماسك وموحد. ويمكن تحقيق هذا التوازن الدقيق والمعقد بشكل فعال من خلال التمييز الدقيق بين حقوق الإنسان الأساسية الضرورية للحفاظ على مجتمع متسامح ومنصف ومنفتح، وتطبيقها الدقيق والمعتمد على السياق ضمن مجموعة معينة من الحقوق والاستحقاقات المدنية، التي قد تنشأ وتتطور في طرق حياة متميزة وفريدة ثقافيًا. وللتغلب على التحديات المرتبطة بفعالية، من الواضح أنه بدون تقنيات اجتماعية قوية وشاملة ومستدامة، من المرجح أن تظل كفاءتنا التكنولوجية، عند فحصها والنظر فيها بمعنى عالمي وشامل حقًا، مجرد وهم. وقد يفشل هذا الوهم في النهاية في الترجمة إلى تطبيق حقيقي وذي مغزى للعدالة والإنصاف في العالم الحقيقي لجميع الأفراد، بغض النظر عن خلفيتهم، أو معتقداتهم، أو ظروفهم الشخصية.
ومن هنا، يجب أن نفهم بوضوح أن تعليم المهارات الأساسية، أو تكليف الأفراد بالوظائف المناسبة ليس سوى الخطوة الأولى في عملية أكثر تعقيدًا ومتعددة الأوجه. ومن المهم بنفس القدر، إن لم يكن أكثر أهمية، تثقيف وتوفير الوسائل والموارد اللازمة لإدماج هذه المهارات الحيوية بشكل فعال في الهياكل والأنظمة الحالية، التي لدينا حاليًا. ولا يمكن إنكار أن القيادة مطلوبة في هذا السياق على كل مستوى من مستويات المجتمع، من المنظمات الشعبية إلى الإدارة التنفيذية في الشركات والمؤسسات الحكومية. لذلك، فإن الاقتصاد الناشئ القائم على المعرفة يدعو إلى ظهور شكل جديد من الديمقراطية الجماهيرية، بغض النظر عما إذا كنا مستعدين بشكل كافٍ لمثل هذا التحول الزلزالي أم لا؛ يجب على الجماهير أن تجد بطريقة ما طريقة للاندماج بشكل هادف في المؤسسات، التي تمتلك قوة اقتصادية كبيرة. ويتطلب هذا التحدي الكبير جهودًا كبيرة ومتضافرة تُركز على الهندسة الاجتماعية والتحول، بما في ذلك عدد كبير من القطاعات داخل المجتمع، التي تعمل معًا في تعاون. ويجب أن تظهر استدامة النظام العالمي، جنبًا إلى جنب مع المثل العليا للعدالة العالمية، من خلال قوى اجتماعية قوية تنشأ إما داخل دولة ما، أو من خلال آليات حوكمة عالمية فعالة وشاملة تعطي الأولوية للمصالح الجماعية. ويواجه مجتمعنا العالمي حاليًا العديد من أوجه القصور السياسية والاجتماعية والأخلاقية الخطيرة، مما يخلق تعقيدات كبيرة في قدرتنا على بناء مثل هذا الإطار العالمي المنظم. ومن الأهمية بمكان أن نعترف ونفهم أن مجتمعًا عالميًا يعمل حقًا لا يمكن أن يبنى فقط على مبادئ الاقتصاد والكفاءة، لأن هذه المبادئ وحدها لن تكفي لمستقبل مستدام. وفي الواقع، يجب أيضًا وصفه بأنه مجتمع يعزز ويغذي ويدعم بنشاط المبادئ الأخلاقية العالمية، التي تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، والتي غالبًا ما نحصر أنفسنا فيها في تفاعلاتنا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز بيئة يشعر فيها الأفراد بالتمكين والقدرة على المساهمة، بالإضافة إلى تقييم وجهات النظر المتنوعة، التي تحملها الثقافات المختلفة، سيكون ضروريًا لتشكيل مجتمع عالمي أكثر تماسكًا وتوحيدًا.
تقاطع التكنولوجيا والعدالة الاجتماعية:
إن أي فيلسوف يمتلك مستوى كبيرًا من الخبرة في كل من العلوم والهندسة، يمكنه الانخراط بعمق في مجالات متنوعة؛ بروح التجسيد الحقيقي للمبادئ، التي يُدافع عنها، وأن يطبق بنشاط معرفته عبر مجموعة واسعة من القضايا الملحة الموجودة عند التقاطع المعقد للتكنولوجيا والعدالة الاجتماعية. وتشمل هذه المسائل الملحة موضوعات حاسمة مثل فكرة “السجن”، وعدم المساواة المنهجية، وحقوق الإنسان الأساسية، والتعقيدات الكبيرة للحرب والسلام، وديناميات العمل والتعاون، والتفاوتات الصحية المختلفة، التي ابتليت بها مجتمعاتنا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التركيز على فهم التأثير العميق للذكاء الاصطناعي، والتطور المستمر للروبوتات، والأنماط المقلقة للتلقين العقائدي، التي نشهدها في أنظمتنا التعليمية. وفي سعيي لفهم أوسع وحوار مفتوح، يمكن المشاركة في حوارات هادفة وثرية مع فلاسفة بارزين وخبراء مرموقين عالمون بهذه المجالات الحيوية، وتشجيعهم بنشاط على توسيع آفاقهم وإعادة التأمل في وجهات نظرهم. ومن بعد، لا بد من حوار عالمي تحويلي، يدور حول الموضوع الأساس للعدالة الاجتماعية، لا سيما في مجال التكنولوجيا والعمل متعدد الأوجه. وهذه قضية تؤثر بشكل عميق على كل فرد في جميع أنحاء العالم، خاصة وأن التكنولوجيا أصبحت منتشرة بشكل متزايد في حياتنا. وهدف هذا الحوار هو توحيد مجموعات متنوعة من الناس حتى يشعر كل مواطن في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية، أو الاقتصادية، بالترحيب في الداخل، ويمتلك صوتًا مهمًا في النقاش الحيوي، الذي نسعى جاهدين لبدئه. ولذلك، فإن جوهر العدالة الاجتماعية متجذر بشكل معقد في الفكرة الأساسية القائلة بأن جميع المواطنين يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى إطار شامل من الحقوق الاجتماعية والسياسية المتساوية. ولا يوفر هذا الإطار للأفراد إحساسًا قويًا بالانتماء فحسب، بل يغرس أيضًا إحساسًا عميقًا بالمساواة يتردد صداه في جميع أنحاء تجاربنا المشتركة. وفي مجتمع جيد حقًا، يتجاوز هذا المفهوم كونه مجرد فكرة نظرية للمساواة موثقة على الورق، أو معبر عنها في الخطب. بدلًا من ذلك، يجسد واقعًا متجسدًا مصممًا لسد الفجوات الاجتماعية، التي لا تعد ولا تحصى، والتي انقسمت إلى أشكال متعددة من الإقصاء، والتي غالبًا ما تفصل بين الأفراد الذين يقيمون في نفس المنطقة، ويسكنون نفس المدينة، أو نفس الحي، أو حتى نفس الشارع. وفي الواقع، يمكن أن تمتد هذه الانقسامات لتشمل أفراد الأسرة الواحدة. ومع ذلك، فإن ظهور مكان عمل رقمي “معولم” يهدد بتفكيك هذه الحقوق الأساسية، مما يجعلها رديئة بشكل خطير. والنتيجة الناجمة عن ذلك هي فشل جماعي في التضامن، الذي يتفاقم بسبب الانتشار المتزايد لسياسات الغضب، التي تتخلل عالمنا اليوم، مما يزيد من حدة الانقسامات ويقوض آفاق التقدم الجماعي.
تأملات حول مستقبل العمل والأتمتة:
إن عالم العمل في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين مهيأ لأن يتسم بعمق بديناميتين مهمتين ومترابطتين بعمق ستشكلان بلا شك الصناعات ومشهد التوظيف بطرق ملحوظة. أولى هذه الديناميات الحاسمة هو النمو المستمر على نطاق واسع لما يشار إليه الآن باسم “الاقتصاد الثاني”، وهي ظاهرة تحويلية بشكل لافت للنظر معترف بها على نطاق واسع باسم “إعادة الهيكلة الكبرى”. وعملية إعادة الهيكلة الرئيسة هذه ليست مجرد مرحلة عابرة؛ بل هي مرحلة انتقالية وتحويلية؛ إنها تُعيد تعريف الهياكل الاقتصادية القائمة بشكل أساس، وتفسح المجال لأنماط عمل جديدة مبتكرة ومستويات إنتاجية مرتفعة. وتَعِدُ هذه التطورات بتغيير جوهر كيفية تنظيم العمل وكيفية أداء المهام المختلفة. والديناميكية الثانية، التي تكمل هذا التطور البالغ الأهمية هي الصعود المتسارع لذكاء الآلة، وهي القوة، التي تُحْدِثُ تغييرات عميقة وبعيدة المدى في القوى العاملة وطبيعة العمل نفسه. وتشمل هذه الظاهرة الناشئة الاستبدال المتزايد لكل من وظائف ذوي الياقات الزرقاء، والأكثر إثارة للدهشة، وظائف ذوي الياقات البيضاء من خلال الابتكار السريع والنشر للآلات وأجهزة الكمبيوتر وتطبيقات البرمجيات المتطورة والأنظمة الروبوتية المتقدمة، التي تنفذ بجد المهام، التي يؤديها العمال البشريون تقليديًا. ونظرًا لأن المهندسين وعلماء الكمبيوتر يقودون بشكل جماعي التطورات في حدود تكنولوجيا الأتمتة، بدأنا في ملاحظة تأثير مباشر على مجموعة واسعة من القطاعات. وتشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر، تطبيقات المصانع ومراكز الاتصال وعمليات النقل بالشاحنات، بالإضافة إلى المجالات الحيوية والمهمة مثل القانون والطب. ومع البرمجيات المتطورة، التي تدير بشكل متزايد مجموعة متزايدة من المهام والمسؤوليات المكتبية الأساسية، التي كانت ذات يوم في مجال الموظفين البشريين، يصبح من المعقول تمامًا؛ والضروري بالفعل، طرح سؤال بالغ الأهمية: ما هي أشكال العمل المحددة، التي ستبقى حصريًا في مجال القوى العاملة من لحم ودم، التي تشكل الحياة الواقعية، الشركات الديناميكية في القرن الحادي والعشرين؟ وبينما نغامر أكثر في هذا العصر المثير والتحويلي للتقدم التكنولوجي، الذي لا هوادة فيه، يصبح استكشاف هذه الأسئلة المحورية ضروريًا لفهم وتوقع المسار المستقبلي للعمل والتوظيف والطبيعة المتطورة للمناظر الطبيعية الاقتصادية في عالمنا سريع التغير. ومن أجل اجتياز هذا الاضطراب الوشيك والاستعداد للمستقبل المقبل، يجب على الأفراد والمنظمات على حد سواء الانخراط في هذه الاتجاهات بشكل مدروس واستراتيجي.
وفي حين أن هناك العديد من فرص الاستصلاح وإعادة التوجيه المتاحة بسهولة في تطبيق الرؤى المستمدة من ميادين متنوعة للتصدي للتحدي الحرج المتمثل في تعزيز اقتصاد مزدهر وإقامة مجتمع صالح في القرن الحادي والعشرين، فمن الضروري الاعتراف بأساس عميق وقوي بشكل خاص تم إرساؤه بالفعل للتفكير، ليس فقط في مستقبل العمل، ولكن في جوهر البشرية نفسها. وهذا الأساس راسخ بعمق في التقاليد الواسعة والغنية للفلسفة الغربية والشرقية معًا. ويجب أن تركز مجموعة المهام المدروسة والمكررة، التي سيستمر العمال البشريون في الانخراط فيها بشكل مباشر على توفير مجموعة واسعة من الأنشطة الموجهة نحو التوظيف، التي تتماشى بشكل فعال مع التطور المستمر للاحتياجات والتطلعات المجتمعية طوال هذا العصر. وينبغي أن تشمل هذه الجهود المركزة على وجه التحديد الاستفادة من القدرات الفريدة، التي لا يمكن الاستغناء عنها المتأصلة في البشر المستقلين وغير القابلين للاختزال، لا سيما عندما تكمل نقاط قوتهم الفردية بالمهارات المتنوعة والقيمة والمساهمات العمالية الموضوعية الموجودة أيضًا في الآخرين داخل القوى العاملة. وإذا كانت إحدى النتائج الرئيسة على المدى الطويل بالنسبة للاقتصادات، سواء كانت تشمل الثراء والازدهار، أو تميل نحو الفقر والتنمية، تنطوي إلى حد كبير على التحول والابتعاد عن البشر الذين يؤدون أنواعًا معينة من العمل، فعندئذ تثير حتمًا سؤالًا ملحًا وأساسيًا: لماذا نصر على إعطاء الأولوية للبشر لهذه الأدوار؟ وما هي، في الواقع، القيود الفعلية على قابلية استبدال غير البشر في القوى العاملة اليوم؟ ويجب على الفلاسفة من مختلف التخصصات الأخرى، التي تغطي مجالات مثل التاريخ والعلوم السياسية وعلم الاجتماع واقتصاديات العمل، ألا يحتقروا، أو يتجاهلوا الفرصة الكبيرة المقدمة لهم للاستفادة على نطاق واسع من هذه الثروة الكبيرة من المعرفة والنظريات والرؤى. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق ذلك بشكل فعال إلا إذا حافظوا على استعداد حقيقي للانخراط بنشاط فيما يسعى جميع الاقتصاديين الجيدين باستمرار إلى القيام به: النقد، والتوسع بعناية، والتعديل الدقيق، والتوسع بشكل هادف في الرؤى الغنية والنظريات التأسيسية، التي وضعت أمامهم على مر العصور. ولن يؤدي الانخراط في هذا الخطاب الشامل والمتعدد الأبعاد إلى توضيح رؤية العمل في العصر الحديث فحسب، بل سيعزز بنشاط فهمًا أعمق لدور البشرية المتطور والمتعدد الأوجه في سوق العمل بينما نتنقل في تعقيدات وتحديات المشهد الاقتصادي سريع التغير؛ مشهد يتشكل ويتأثر باستمرار بالابتكار المستمر والتقدم التكنولوجي في العديد من القطاعات.
الطبيعة المتغيرة للعمل:
لقد رأينا كيف أن التنبؤات المتعلقة باحتمالات البطالة الجماعية على نطاق واسع، التي ظهرت في الوقت، الذي بدأ فيه الإنتاج الضخم صعوده وتوسيعه الكبيرين في أوائل القرن العشرين، لم تتحقق بالطريقة المخيفة، والتي توقعها الكثيرون. ويرجع هذا الواقع المفاجئ جزئيًا إلى الاختفاء التدريجي لبعض الوظائف الآلية، التي أصبحت قديمة، والتي يوازنها الظهور المتزامن لأنواع جديدة تمامًا من فرص العمل، التي لم تكن موجودة من قبل. ومع ذلك، على نطاق أوسع بكثير، كان الخلق الشامل لوظائف جديدة عملية مستمرة لأن كل غسالة، بالإضافة إلى جميع السلع الاستهلاكية الأخرى، التي اكتسبت شعبية خلال تلك الحقبة، تطلبت مشاركة إنتاج متسقة ومتكررة من العمال الذين يبلغ عددهم الآلاف. وكان هذا التفاعل المعقد بين نمو الإنتاجية والزيادة الإجمالية في مستويات الإنتاج مرتبطًا ارتباطًا جوهريًا بالخلق المستمر لفرص عمل جديدة متنوعة ناشئة في مختلف القطاعات. وعندما نفحص التطورات التكنولوجية، التي ظهرت على مر العقود، نرى أن ظهور أجهزة الحاسوب “الكمبيوتر” وآلات معالجة البيانات المتطورة، والتي يُنظر إليها الآن على أنها تحتوي على روبوتات كنظيراتها المتقدمة، بدأ بجدية خلال العقد التحويلي في السبعينيات. مرة أخرى، لم تؤت التنبؤات المشؤومة بشأن البطالة الجماعية ثمارها. ومع ذلك، خضعت طبيعة العمل لتحول عميق، حيث بدأ تنفيذ المهام بشكل متكرر من قبل الآلاف من الرجال والنساء، في كل مكان اعتبر فيه جهاز حاسوب، أو آلة معالجة بيانات ضروريًا ومؤثرًا، مما أدى إلى تغيير مشهد العمل بشكل أساس كما كان موجودًا قبل هذه التغييرات التكنولوجية.
في هذا الوقت، يُقترحُ في “رؤية” الاستشراف أن التنبؤات المتعلقة بمستقبل العمل ستتحقق بالفعل. وينشأ هذا التوقع مع بدء الاستعانة بمصادر خارجية للمهام اليدوية والفكرية بشكل متزايد للآلات والأنظمة الآلية. ويقال إن ما يبدو أنه يحدث ليس بالضرورة خسارة صريحة ولا يمكن إصلاحها للوظائف، بل هو تحول عميق وذي مغزى للعمل التقليدي كما نعرفه. ويُشير هذا التحول إلى الطرق الراسخة، التي تخيل بها الناس تاريخيًا أنها ستكون الوسيلة الوحيدة للمساهمة في المجتمع واعتبارها مفيدة ومنتجة. وتقليديًا، كان هذا يعني الانخراط بنشاط في مهام تتطلب جهدًا عقليًا، أو تجسيد سلوك جاد أثناء العمل في حجرة، أو بيئة مكتبية. ومع ذلك، فإن هذا التحول يشمل أيضًا الوظائف المختلفة، التي مكنت الأفراد منذ فترة طويلة من العثور على قيمة وهدف في تلك الأدوار التقليدية، على الرغم من أن هذه الأدوار يمكن أن تنطوي على مخاطر كبيرة، أو مهام خطيرة، مما يمثل ظروفًا صعبة للعمال المعنيين. ونتيجة لذلك، يتم تصور مستقبل تتطور فيه الاقتصادات وتزدهر الشركات. ومع ذلك، ومن المفارقات أن هذا المستقبل لا يتطلب بالضرورة قوة عاملة كبيرة ومستقرة للعمل بنجاح. وفي هذا السيناريو الناشئ، قد يكون هناك غياب تام لهياكل العمل التقليدية، والوظائف التقليدية ذات الأدوار المحددة، وساعات العمل الموحدة، وربما حتى الأشكال التقليدية للعملة، مما يمهد الطريق لمجتمع غير نقدي. ويُشير مثل هذا التحول الجذري إلى أن الإطار، الذي اعتمدنا عليه لسنوات يتغير تمامًا. ونتيجة لذلك، قد يكون هناك عدد أقل بكثير من البشر المشاركين في نماذج العمل القديمة. بدلًا من ذلك، يمكننا أن نرى مجتمعًا يجد فيه الأفراد الإنجاز والهدف في أشكال جديدة تمامًا من الإنتاجية والمساهمة خارج التوظيف التقليدي. أدوار ومسؤوليات جديدة لم نفهمها، أو نتبناها بالكامل كجزء من حياتنا اليومية.
التحقيق الفلسفي في طبيعة وعي الذكاء الاصطناعي:
إننا نقف، كما قال سمو الأمير الحسن، في فجر الألفية الثالثة، على عتبة ثورات متتابعة ومتسارعة، تغير طبيعة حياتنا بشكلٍ جذريٍ، وقد تكون في مقدمتها ثورة جديدة ضخمة وتحويلية، وهي الثورة البيولوجية الجزيئية، التي قد تثبت أنها الأكثر أهمية وتأثيرًا في تاريخ البشرية. وذلك لأنها تحمل القدرة على تغيير الطريقة، التي نعيش بها حياتنا تمامًا، والطريقة، التي نتعلم بها المعلومات ونعالجها، بالإضافة إلى الطريقة، التي نأكل ونشرب بها ونتفاعل مع بيئتنا المعيشية. علاوة على ذلك، فإنها ستُغير فهمنا بشكل عميق لماهية الحياة حقًا وحتى تُعيد تشكيل الطريقة، التي نفهم بها وجودنا. لذلك، فإن التطورات الرائدة في استنساخ والإنسان، جنبًا إلى جنب مع الأنسجة المهندسة وغيرها من التقنيات الحيوية الرائدة، تمثل الأمثلة الأولى، وإن كانت فظة إلى حد ما، لما تستطيع البشرية تحقيقه في عالم الحياة الواسع. وقد انضمت هذه الثورات الآن إلى التطورات المذهلة في تكنولوجيا الكمبيوتر، والتي أعطتنا العالم الهائل للواقع الافتراضي، وربط مفهوم إنتاج الحياة من خلال عمليات تشبه البرمجة. ليس من المستغرب أن تكون نفس العقول والمبتكرين في طليعة كل من علوم الحاسوب والثورة البيولوجية الجزيئية المذهلة. وبينما نفكر في المستقبل، الذي ينتظرنا، من المهم بنفس القدر أن نسأل أنفسنا عن أصولنا ونقاط انطلاقنا، أو كما يحلو لسموه بوصفه “الأصول والمنابت”. ويبدو أن نقطة المنشأ هذه هي وعي محطم؛ وعي مجزأ إلى أجزاء صغيرة لا حصر لها، يمثل كل منها منظورًا مختلفًا، أو هي في واقعنا السياسي العربي أشبه بتجزئة المجزأ، أو “تفتيت المتفتت”. ونحن بينما نبدأ نهاية نصف عقدنا الثالث من الألفية الجديدة، قد يبدو الأمر وكأنه يُريد أن يذكرنا بشكل لافت للنظر بالمخاوف والشكوك، التي ماتت منذ فترة طويلة، والتي عبر عنها المفكرون القدامى. فقد فكر هؤلاء المفكرون ذات مرة في استبدال الخشب والطين المتواضعين بالحديد والنحاس الأصفر في بناء آلات التفكير المتقدمة. وكانت مخاوفهم تدور حول الآلات؛ سواء قدراتهم، أو طبيعة أولئك الذين يصنعون مثل هذه الآلات على شكل البشرية وفكرتها. ومن المثير للقلق أن هذه المخاوف والشكوك بشأن إبداعاتنا تطفو على السطح مرة أخرى، مما يؤدي إلى إجراء حوار حاسم حول الاتجاه، الذي نتجه إليه.
لقد تعجب البشر، منذ فجر الوعي الذاتي، بعمق من الظاهرة غير العادية لوجودهم، وعلاوة على ذلك، من القدرة المحيرة على التأمل والتشكيك في هذا الوجود نفسه. ونحن هنا نتشارك تشابهًا مع الفيلسوف القديم أفلاطون، الذي اندهش بنفس القدر من إمكانية الانخراط في الفلسفة. فنجد أنفسنا مندهشين للغاية لأننا نمتلك القدرة على التأمل الذاتي وطرح أسئلة عميقة على أنفسنا حول الواقع، ونحن مندهشون باستمرار من النتائج، التي تنشأ عن تأملاتنا. فعل التفكير في الواقع ليس مجرد وظيفة للعقل. لذلك، فإنه يشمل عملية معقدة لصياغة أفكار تخطف الأنفاس؛ تنشط وتحافظ على جوهر الحياة نفسها. ونظرًا لأن الميول الأساسية، التي تغذي الحياة ظلت ثابتة طوال تاريخ البشرية الواسع، فقد أدت باستمرار إلى إنشاء الأساطير والقصص الخيالية الساحرة، وبالتالي الأديان الكبرى والتوحيدية، التي شكلت الثقافات والمجتمعات. ولذلك، إلى جانب الميل الديني العميق الجذور؛ وهو جزء جوهري من الطبيعة البشرية، ظهر ميل قوي آخر يَقترحُ مجموعة متنوعة من الأفكار. ويولد هذا الميل أفكارًا ومفاهيم رائعة موجودة بشكل مستقل عن السرديات الأسطورية، أو حتى الدينية المعروفة، وتُعرفُ باسم “الميل الفلسفي”، الذي يمثل أولئك الذين لا يمنحون الحياة للمعتقدات المنظمة، ولكن لعالم مختلف من الأفكار؛ غالبًا في معارضة للفكر التقليدي، التي وَلَّدَتْ معًا بعضًا من أكثر الإبداعات أصالة وابتكارًا، والتي صارت تحدد سمات الفكر البشري والإبداع. وهذان الميلان البارزان، الديني والليبرالي، يشكلان الأساس لمجموعة غنية من الاستكشاف الفكري، وهما في الواقع موضوعان يستحقان الدراسة والتأمل. ومع ذلك، فهذه ليست الميول الوحيدة، التي تستحق الاستكشاف في نسيج الفكر البشري المعقد، بل يوجد ميل حيوي آخر يعرف باسم الميل العلمي. ويمثل هذا الميل السعي المنهجي للمعرفة والفهم من خلال الملاحظة والتجريب والبحث العقلاني، مما يزيد من إثراء المشهد المتنوع لكيفية سعي البشرية لفهم الكون.
لهذا، فإن هذا الميل الأخير يُشبه الميلين السابقين من حيث إنه غذى أيضًا، ولا يزال يرعى، المشاريع الكبرى للبشرية. ومع ذلك، فإنه يقف في تناقض صارخ مع كليهما. فقد دخلت كل هذه الميول بشكل حثيث في كياننا دون أن نلاحظ وصولها، وأصدرت قانونًا جديدًا تمامًا؛ منظورًا مختلفًا للحياة، لأننا الآن قادرون على قياس زيف ذلك السياق، الذي تم الحفاظ عليه فقط بسبب ملاءمته للوقت. وكانت الشخصيات المعروفة في العالم القديم تُدرك تمامًا أن هذا السياق لا يخلو من مخاطر كبيرة، لأنه يسعى إلى تحويل الشك الميتافيزيقي إلى اعتقاد معترف به عالميًا. فقد فهموا الترابط المعقد بين قوانين العقل، والقوانين، التي تحكم الطبيعة، والقوانين، التي تحكم المجتمع، وقوانين الروح الأعمق. وهذا هو بالضبط السبب في أن النقاش المحيط بطبيعة الوعي يمكن أن يظهر كتحقيق فلسفي صارم وهدف علمي للتحليل الدقيق. وفي عصرنا المعاصر، يبدو أن علماء الأحياء العصبية قد استولوا على الوشاح من نظرائهم القدامى. وفي أوقات سابقة، كان هؤلاء الأفراد يحظون بالتبجيل كأنبياء، أو عرافين، يتنبؤون بأحداث؛ مثل المطر، أو التحولات المروعة، على غرار الطريقة، التي يتنبأ بها علماء الحاسوب اليوم بوجود طوباوي على الأرض من خلال تقدم الآلات. ونجد أنفسنا نتنقل في التوازن الدقيق بين النموذج العلمي، حيث يتم بالضرورة التخلص من أي شيء يفشل في التحمل، ووجهة النظر الصوفية، حيث يعتبر أي شيء مستبعد من عالم العقيدة الراسخة خاطئًا تلقائيًا؛ مما يؤدي إلى منظور يرسم صورة أولئك الذين يفشلون في الإيمان على أنهم أغبياء. وهكذا، نجد أنفسنا نواجه أسئلة وشكوك، من نواح كثيرة، خطيرة ومهمة مثل تلك، التي طرحها مرشدونا القدامى على بيئتهم، التي كانت تقريبًا بنفس الخطورة، في الواقع.
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الواعي والتعلم الآلي:
تُظهر أبحاث وهندسة الذكاء الاصطناعي الحديثة أوجه تشابه ملحوظة مع مزيج البهجة والخوف، الذي ميز ظهور العلوم النووية، مما يوفر توضيحًا حيًا للعلاقة المعقدة بين الابتكار التكنولوجي والاعتبارات الأخلاقية، التي تأتي معه. ويكمن الأمل السائد في ضمان بقاء الذكاء الاصطناعي المفيد “معبأ” واحتوائه بطريقة مفيدة في تحويله إلى مستشار موثوق به يعزز عملية صنع القرار البشري. وهذا في تناقض صارخ مع ما نُدركه عنه حتى الآن، لأنه يعمل ببساطة كمخبر، قد ينقل معلومات خالية من السياق المناسب، أو فهم الآثار المترتبة على ذلك. ويتجاوز الطلب على مثل هذا التطور التفسير الممتع والمبسط لـ”قوانين الروبوتات الثلاثة” غريب الأطوار للكاتب الروسي الأمريكي إسحاق عظيموف. وبدلًا من ذلك، فإنه يدعو إلى إنشاء “الذكاء الاصطناعي الصديق” الحقيقي، الذي يتناغم مع القيم الإنسانية ويضع أولوية عالية للسلامة والعمليات الأخلاقية. ولن ينتج تحقيق هذا الهدف عن تعديلات سطحية مثل تزيين الذكاء الاصطناعي بسمات مرحة مثل الاحمرار، أو الضحك على النكات كلما تم اتخاذ قرار. وإنما بدلًا من ذلك، يحتاج التركيز الأساس إلى التعمق أكثر، متجذرًا بشكل معقد في السلوكيات الأخلاقية، التي تعكس حقًا تعقيدات سيناريوهات العالم الحقيقي. ولن تظهر تقنية الذكاء الاصطناعي؛ ولا أي إنسان، سلوكًا أخلاقيًا وفقًا للعواقب الفوضوية، التي تم تصويرها في “سيد الذباب”، والتي تقف بمثابة تذكير مؤلم بالعناصر الأكثر شرًا في الطبيعة البشرية وعمليات صنع القرار. وتُشير العديد من التجارب والدراسات العلمية إلى أن الذكاء الاصطناعي الأكثر أخلاقية سيتطلب تصميمات عصبية تمكنه من إظهار الوعي الذاتي والتعاطف. وسيحتاج مثل هذا الشكل من الذكاء الاصطناعي إلى اكتساب القدرة على التأمل، وفهم أن لديه القدرة على الخداع والكذب بدرجات متفاوتة، والالتزام بالأنماط السلوكية الراسخة، أو حتى تعديل سلوكه ليتماشى مع توقعات البيئة المحيطة به. علاوة على ذلك، يجب تشكيل جوهر الذكاء الاصطناعي الواعي أخلاقيًا من خلال الوعي الظرفي واتخاذ القرارات المستنيرة، مع امتلاك القدرة على عكس الحكم والوعي الشبيهين بالإنسان في العمليات، التي تحكم القرارات، والتي تؤثر على الحياة والرفاهية.
ومع ذلك، فإن جميع الضمانات المتعلقة بالسلوك الأخلاقي ستأتي بشكل أساس من تلك البرامج المحددة المصممة بعناية والمُعَدَّة بشكل صريح لتنفيذ وإنفاذ هذه المبادئ الحيوية. وفي حين أنه من الممكن بالفعل منع الذكاء الاصطناعي من الانخراط في أفعال محددة معينة، أو إخفاق في العمل، فإن القضية الشاملة المتمثلة في التصرف الأخلاقي تنطوي على مجموعة أوسع وأكثر تعقيدًا من الاعتبارات، التي لا يمكن استخلاصها بسهولة. وينبغي أن يتمتع الذكاء الاصطناعي الأخلاقي بالقدرة على التعلم وتطوير فهمه وممارساته تدريجيًا على مدى فترة طويلة. ويعتمد جزء كبير مما يشكل صنع القرار الأخلاقي على تحديد الأنماط واستيعابها بمرور الوقت. وبالتالي، يمكن تدريب الذكاء الاصطناعي الأخلاقي بكفاءة على التعرف على السمات الاجتماعية الأساسية، التي غالبًا ما توفر خبرات لا تقدر بثمن ومعلومات أخلاقية ضرورية لتطويره. ومن المهم ملاحظة أنه سيكون هناك بلا شك العديد من التمارين غير المقصودة للاختيار الأخلاقي، التي يمكن أن تتحول إلى حلقات مفرغة ضارة محتملة، مما يستلزم الحذر. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الدراسات البحثية، التي تبحث في كيفية استيعاب الأطفال لوجهات النظر الأخلاقية وتبنيها رؤى مهمة توفر دروسًا لا تقدر بثمن للتصميم المدروس والمتعمد للبروتوكولات الأخلاقية العصبية، بينما نمضي قدمًا في مشهد تكنولوجي متزايد التعقيد.
وينشأ أحد التحديات الكبيرة والعميقة المرتبطة بتنفيذ الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات في المقام الأول من حقيقة أنه ليس مباشرًا مثل الخوارزمية، التي تحسب الأحداث فقط بناء على بيانات الإدخال المهضومة مسبقًا. وعلى عكس الخوارزميات التقليدية، التي يمكن أن تتبع المسارات الخطية في كثير من الأحيان وتعمل ضمن نطاق محدود، يدمج الذكاء الاصطناعي العديد من الأشكال المتنوعة للمعرفة ويظهر سلوكًا متعمدًا، مما يعقد وظيفته بشكل كبير. وغالبًا ما يتم انتقاد الأساليب، التي تم تطويرها واستخدامها حاليًا لكونها سطحية وتفتقر إلى العمق والتعقيدات اللازمة، ويمكن أن تنفصل بسهولة عن جميع أشكال المعرفة والعفوية، التي تعتبر حاسمة لاتخاذ قرارات هادفة ومدركة للسياق في البيئات الديناميكية. علاوة على ذلك، لا يوجد مبرر نظري قوي لسبب عدم خضوع رقائق حاسوب الذكاء الاصطناعي المضمنة في إنتاج سلعة لنفس التدقيق الأخلاقي الشامل، الذي يتم إجراؤه بدقة على السلوك البشري، والذي يتم دمجه أيضًا في نفس الإطار الاقتصادي. ويجب أن تنطبق توقعات السلوك الأخلاقي عالميًا، بغض النظر عما إذا كان صانع القرار الذكاء الاصطناعي، أو الإنسان. وبشكل أساس، يجب تفضيل الذكاء الاصطناعي الشبيه بوقت التشغيل، الذي يربط الإجراءات بالمدخلات في الوقت الفعلي والتعليقات السياقية، على أنواع الذكاء الاصطناعي الأكثر انفصالًا وغير المجسدة، التي تفتقر إلى الوعي الظرفي. ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الذكاء الاصطناعي، على الأقل في مراحله الحالية والمتطورة، بعيد إلى حد كبير عن تحقيق الفهم المعرفي الحقيقي، وقد لا يمتلك الأسس، أو الأطر اللازمة لتعكس الحقائق الأخلاقية بشكل حقيقي بطريقة هادفة. وبالتالي، يُنْصَحُ باستخدام سرديات ونماذج الذكاء الاصطناعي الصعبة، التي تحكمها معايير وإرشادات أخلاقية أكثر صرامة، مما يضمن درجة أكبر من المسؤولية والمساءلة والاعتبار الأخلاقي في القرارات الصادرة والإجراءات المتخذة نتيجة لقدرات الذكاء الاصطناعي. وقد يساعد هذا النهج في سد الفجوة بين القيم الإنسانية والتقدم التكنولوجي.
لهذا، لا يزال الذكاء الاصطناعي المدمج في التطبيقات السلبية يمثل مصدر توجس وقلق كبير للعديد من المراقبين والمحللين. وأحد الأمثلة الواضحة والمثيرة لهذا التوجس والقلق على ذلك هو تطوير ونشر أسلحة آلية تعمل بدرجات مختلفة من الاستقلالية. وهذه الأنظمة غير قادرة على تطوير الفهم العميق المطلوب لتوضيح قراراتها ودمج تلك القرارات بشكل فعال في العوامل المعرفية، التي يمكن أن تتصرف بمسؤولية. وبدلًا من ذلك، فإنهم يختبرون المعلومات مجرد وحدات، أو أجزاء متميزة من المعلومات، ولا يظهرون أي اهتمام حقيقي، أو فهم لمعناها وآثارها الأساسية. ويوجد جانب مظلم مقلق للمعلومات لا يوفر البيانات الضرورية من الدرجة الثانية والثالثة اللازمة لفهم دقيق. لذلك، فإن المعرفة بأن الذكاء الاصطناعي يعالجها خالية من القيمة بشكل أساس، مما يعني أنها تفتقر إلى القيم، أو الأخلاق المتأصلة، التي قد يطبقها البشر عند تفسير البيانات. وبالتالي، فإن هذه البيانات، التي تم إنشاؤها عن الأشخاص وتحفهم، الخالية من السياق الأساس، تنشأ من تنبؤات الأداء الجيد للسلوك السابق. وتعزز هذه العملية تقدم البيانات، على أمل أن تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من إدارة العناصر، التي تعتبر مفيدة وذات قيمة بشكل فعال من خلال “المسح السطحي بدلًا من السعي”، مما يؤدي إلى الحد الأدنى من فهم السياق المحيط، ومما يؤدي إلى نتائج مهدرة للجهد الخلاق. ويمكن لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي تحديد المشاعر، التي يظهرها الأفراد والتعرف عليها، ولكنه يفتقر بشكل أساس إلى القدرة على فهم سبب تجربة الشخص لهذه المشاعر في المقام الأول. وفي هذا العالم المعقد والغامض للغاية، الذي نعيش فيه، يمكن أن تتراكم احتمالية حدوث أخطاء روتينية بشكل غير محسوس بمرور الوقت. ويمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تولد عن غير قصد حالات فشل تلقائية، خاصة عندما يقوم المطورون بتحميل واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، التي تجمع المعلومات، مما يعزز في النهاية التوقعات المتحيزة ويديمها. وبدلًا من ذلك، من الضروري أن نعطي الأولوية لتطوير الآلات الأخلاقية، التي لا يمكن تحقيقها إلا إذا التزم المبرمجون البشريون بأنماط واضحة من السلوك تعكس المعايير الأخلاقية الجيدة. وهذا الالتزام أمر بالغ الأهمية في توجيه الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل أكثر أمانًا ومسؤولية.
فلسفة التعليم والتعلم مدى الحياة في العصر الرقمي:
أعاد عصر المعلومات تشكيل المشهد التعليمي بشكل كبير، مما خلق العديد من المتطلبات الجديدة، لا سيما في مجال التعليم العالي. فالمفهوم الحاسم، الذي نشأ من هذا التطور هو مبدأ “التعليم مدى الحياة”. وتشمل هذه الفكرة بشكل أساس الاستمرارية التعليمية بأكملها، التي تتراوح من المراحل الأولى من الطفولة وتستمر حتى المراحل النهائية من الحياة. وبينما نتعمق في هذا الموضوع، يصبح من الأهمية بمكان بشكل متزايد أن نُدرك أنه يجب علينا التعامل مع هذا المفهوم، ليس فقط كإعلان رسمي، أو موقف أيديولوجي مجرد. بدلًا من ذلك، نحتاج إلى احتضانه كضرورة أساسية وعملية حيوية لوجودنا في المجتمع المعاصر. وتنبع هذه الضرورة من سعينا الحثيث للتكيف والاستجابة الفعالة للمشهد سريع التطور لعالمنا، والذي يتطلب باستمرار مهارات ومعارف جديدة. وللتغلب على هذه التغييرات، يجب علينا تحديث استراتيجياتنا ومناهجنا التعليمية باستمرار بما يتماشى مع سوق العمل المتغير باستمرار ومتطلبات المهارات المرتبطة به. وإذا بذلنا جهدًا واعيًا بعناية لتحويل تركيزنا الأساس في التعليم بعيدًا عن مجرد الجوانب الإجرائية والصارمة في كثير من الأحيان للتعلم التقليدي، التي يمكن أن نشعر في كثير من الأحيان بأنها عفا عليها الزمن، أو غير مناسبة للبيئة الديناميكية الحالية، وبدلًا من ذلك نُعيد توجيه تركيزنا نحو النتائج الحقيقية للتعلم، فإننا نخلق إمكانية لنموذج تعليمي تحويلي. وفي مثل هذه البيئة، لا يمتلك كل فرد، بغض النظر عن عمره، الحق الأصيل في متابعة المعرفة فحسب، بل يشعر أيضًا برغبة جوهرية عميقة في التعرف على مواضيع مقنعة حقًا وذات صلة به. وفي إطار هذا النموذج التعليمي، يكتسب مفهوم “التعلم مدى الحياة” أهمية كبيرة، مما يعزز تجربة تعليمية أكثر ثراءً وإرضاءً لجميع المعنيين. ومن خلال هذا النهج التقدمي، يمكننا أن نضمن أن التعليم ليس ثابتًا، بل عملية حية نابضة بالحياة تشرك المتعلمين باستمرار في كل مرحلة من مراحل الحياة، مما يضمن أن يظل السعي وراء المعرفة مسعى متاحًا ومجزيًا للجميع.
ويلعب التعليم المستمر دورًا حيويًا يشبه الألياف، التي تساعد بشكل كبير في عملية الهضم الفكري، مما يسهل ليس فقط التكيف مع بيئات التعلم المختلفة، ولكن أيضًا تعزيز اكتساب المهارات الأساسية الضرورية للتطوير الشخصي والمهني. ومن أجل ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة وتنميتها على أساس متين ومستدام، يصبح من الضروري تغيير محتوى وشكل العروض التعليمية وتحديثها وتطويرها بنشاط، فضلًا عن تعزيز العلاقات الموجودة والتفاعل بين أنواع التعليم المختلفة. وتتضمن هذه العملية الديناميكية والمستمرة المراقبة المستمرة للأفكار الجديدة الناشئة والمنهجيات والاتجاهات المبتكرة داخل سوق المعرفة المتطور باستمرار. وعلاوة على ذلك، يعد تحديث البنى التحتية التعليمية الحالية وتعزيزها أمرًا ضروريًا لضمان الوصول العادل والفرص لجميع الأفراد بغض النظر عن خلفياتهم. لذلك، فإن معالجة وحل القضايا الخطيرة، التي تعيق المزيد من التطوير في الممارسات والموارد والفرص التعليمية أمر لا يقل أهمية ولا ينبغي إغفاله. ومن خلال تنفيذ هذه التغييرات الحيوية، يمكننا السعي لخلق بيئة تعليمية أكثر شمولًا وفعالية تلبي الاحتياجات المتنوعة لجميع المتعلمين وتمكنهم من النجاح في عالم يزداد تعقيدًا.
دور الفلسفة في تشكيل التقنيات التعليمية:
تدل أهمية العلم والتكنولوجيا في الثقافة الحديثة على أن التوجه العام وتنفيذ الإصلاحات التعليمية المستقبلية سيصبحان لهما أهمية حاسمة لمواصلة تطوير كل من التقدم العلمي والتكنولوجي، وكذلك المجتمع بأكمله. وقد أصبح من الواضح تمامًا، حتى في هذه المرحلة الزمنية، أن هذه المهام الأساسية لا يمكن إنجازها بنجاح إلا إذا تم استخدام المبادئ العامة الواسعة والنتائج الملموسة المستمدة من نظرية التقدم العلمي والتكنولوجي كأدوات تحليلية وعملية توجيهية من شأنها أن تثري وتشكل الإصلاح التربوي. وهذه المهمة الحاسمة تكتسي أهمية كبرى لمستقبل البشرية وتستلزم التطوير المتسق لهذا الجزء المبتكر من فلسفة المستقبل، الذي ينشأ استجابة للحاجة الماسة لمعالجة المشاكل الأكثر إلحاحًا في عصرنا المعاصر. ويمتلك هذا الجزء الجديد من الفكر الفلسفي خصوصية مميزة غائبة تمامًا في المجالات التقليدية للبحث الفلسفي. ولذلك، فإن الأهمية المتزايدة للعلم والتكنولوجيا في نسيج المجتمع الحديث تجعل من الضروري أن تسترشد الإصلاحات التعليمية بمبادئ منهجية مستمدة من الخطاب العلمي والتكنولوجي. وتؤكد التحديات، التي لا تعد ولا تحصى، التي يواجهها المجتمع المعاصر على ضرورة هذا النهج المتماسك والمنظم، والتي تتطلب حلولًا مبتكرة وعملية على حد سواء. وهذا يعني أن البحث الفلسفي لا ينبغي أن ينتقد الأطر التعليمية الحالية فحسب، بل يجب أن يساهم بنشاط في تطورها، مما يضمن توافقها مع التطورات السريعة في العلوم والتكنولوجيا، التي تحدد عصرنا. علاوة على ذلك، يجب أن يرتبط هذا الجزء الجديد من الفكر الفلسفي ارتباطًا وثيقًا، في إطاره التحليلي، بالتقدم النظري، الذي تم تحقيقه في المجالات الفردية للمعرفة العلمية، وفي تطبيقه، بنتائج عملية وأنشطة ملموسة تغطي مختلف مجالات الحياة البشرية. وتؤكد هذه الخصوصية على ضرورة أن يسعى نشاط الفلسفة، الذي يسعى إلى تطوير نظرية التقنيات التعليمية المتجهة إلى القرن القادم، إلى تقديم المبادئ التوجيهية والتنظيم اللازم للإبحار عبر بحر المعرفة الموسع في مجتمع المستقبل. ولضمان أن هذه المبادئ الفلسفية يتردد صداها مع حقائق المعرفة الحديثة، من الأهمية بمكان أن يتم صياغتها من قبل أفراد ليسوا على دراية جيدة بالجوانب النظرية فحسب، بل يمتلكون فهمًا عميقًا للتحديات العملية، التي يواجهها المهنيون والطلاب على حد سواء. ويتضمن ذلك إشراك الأفراد “المتأمرين” بعمق في التخصصات العلمية عالية التخصص، وكذلك أولئك الذين يعملون في المجالات، التي تتشابك بِارتباطٍ وثيقٍ بهذه المجالات المعرفية. وستساعد رؤاهم في تشكيل المصفوفة الطبيعية والمحتوى الموضوعي المطلوب لتلبية الاحتياجات التعليمية المعقدة للمجتمع للمضي قدمًا، مما يضمن أن الإصلاحات التعليمية المستقبلية ليست سليمة من الناحية المفاهيمية فحسب، بل قابلة للتطبيق عمليًا وذات صلة بعالمنا التكنولوجي المتزايد.
البحث عن المعنى في المجتمع التكنولوجي:
قد لا يبدو هوس الفلسفة المعاصرة بالوجود، في بعض الأحيان، للفيلسوف المحترف على أنه شيء جديد، أو رائد بشكل خاص. هذه الفكرة القائلة بأن زيادة الواقع قد تكون بمثابة وسيلة يميل بها الكثير من الناس إلى تبرير وجودهم قد تم انتقادها ورفضها منذ فترة طويلة من قبل العديد من المفكرين على مر العصور. مثل هذا الشكوك، على الرغم من انتشاره بين الأوساط الفكرية، لم يقلل من أهمية فلسفة كيركجارد الوجودية المُؤمِنَة، التي كان لها تأثير عميق ودائم على العقل المعاصر. ومن أعماق عمل كيركجارد ظهرت فلسفات مختلفة، على الرغم من أنها غير مرتبطة وجوديًا، إلا أنها غالبًا ما ترتبط بالفكر الوجودي، بما في ذلك المساهمات البارزة للفلاسفة البارزين مثل هايدغر وجاسبرز. وقد أثر كل من هؤلاء المفكرين بشكل كبير على الجيل، الذي بلغ الآن سن الرشد ويتصارع مع تعقيدات الفكر الفلسفي الحديث. وليست هذه الشخصيات المهمة وحدها هي، التي تركت بصمة، ولكن أيضًا عدد كبير من الأدب الجديد والحركات الفنية، التي ظهرت، والتي تتباهى بعناوين مختلفة مثيرة للاهتمام مثل “مسرح العبث” و”الوجودية الجديدة” و”أدب اليأس الجديد”، وغيرها الكثير، التي تحاول بشكل جماعي تلخيص جوهر البحث والتأمل الوجودي. وكان كيركجارد مهتمًا بشدة بمشاعر الإنسان وصراعاته العاطفية، حيث كان يتصارع بشكل معقد مع الحالة البشرية، بينما ركز هايدغر باهتمام على الفروق الدقيقة في حالته المستمرة من التفكير ووعيه بالوجود. وفي المقابل، استكشف جاسبرز مفهومه عن التعالي من منظور تاريخي، مفهوم يتساءل عن المعنى ويسعى إلى المعنى ضمن الطيف الواسع والمعقد للتجربة الإنسانية، ويحث الأفراد على التعمق في طبيعة الوجود وآثاره. وتكشف تقاطعات فلسفاتهم عن نسيج غني من الفكر يدعو إلى الفحص والنظر المستمر في الساحات الفلسفية المعاصرة.
وعلى الرغم من المساهمات العميقة، التي قدمها كل فرد نحو التسخير الجماعي لإمكانات البشرية، إلا أن كلا الفيلسوفين عملا داخل مجتمع بدا فيه أن الإنسان الفردي لا يزال يمتلك القدرة الرائعة على التحكم في مصيره التكنولوجي. وفي تناقض صارخ مع هذا المنظور السابق، فإن فنون وعلوم التكنولوجيا اليوم لم توقظ سوى عدد قليل من النفوس المستنيرة على الأهمية الحاسمة للمشاكل الملحة، التي تطرحها، فضلًا عن الآثار الأوسع نطاقًا، التي تحملها هذه التطورات معهم. لذلك، فإن القلق الكبير، الذي يسدد “رؤية” الوجوديين في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بالإنسان هو أنه قد يكون الأمر بالفعل أن كل هذه التكنولوجيا المنتشرة والمتداخلة باستمرار قد تنقلب في نهاية المطاف ضد الإنسان نفسه، مما يؤدي إلى تجريده من إنسانيته وتآكل حقوقه الأساسية وبوصلته الأخلاقية، وتحرمه من كرامته المتأصلة، أو بعبارات مادية وعملية أكثر؛ إحباط غريزته للحفاظ على الذات وبقاء الأنواع، حتى وإن كانت هذه المشاريع التكنولوجية غير ضارة في عالمنا. وإذا كُنَّا نميل إلى الالتفات إلى آثارها، فقد يقودنا ذلك في نهاية المطاف إلى الوصول إلى نفس الاستنتاج المحبِط والمثير للقلق، إذ “إن مشكلة التعريف الشامل للحرية، التي ينطوي عليها استخدام الأسلحة الخارجة عن البشر تواجهنا في كل خطوة نتخذها. وفي كل بُعدٍ وشكلٍ يمكن تصوره، تقترح المشكلة أسئلة عميقة حول طبيعة الإنسان ووجوده”. ومع ذلك، فإن ما نشهده في عالم الفلسفة الحديثة ليس مجرد تأملات تخمينية، بل هو نتيجة مباشرة للتطورات المهمة، التي حدثت في فنون التكنولوجيا المتطورة باستمرار. وتساعد هذه المبادرات بسرعة في القضاء على البديلين المتبقيين اللذين ميزا بعمق الفلسفة الوجودية المركزية لأجيال. وبالتالي، بينما نتنقل عبر هذا المشهد التكنولوجي المعقد بشكل متزايد، يجب أن نفكر بعمق وتأمل نقدي في كيفية تشكيل هذه القوى وتأثيرها وتغييرها لفهمنا للوجود نفسه، بالإضافة إلى مسؤولياتنا الإنسانية والأخلاقية في ضوء هذه التغييرات السريعة.
الاغتراب التكنولوجي والسعي إلى الأصالة:
من بين السمات الأكثر إثارة للجدل للتكنولوجيا تحالفها المعقد والمتداخل مع مبدأ الإخراج، إذ تمثل هذه التكنولوجيا نفسها شبكة متقنة وواسعة من الهياكل والعمليات المختلفة، التي جلبها الإنسان الحديث عمدًا خارج نفسه. وهذه العناصر موجودة الآن بشكل مستقل عن نيته وسيطرته الأصلية، مما يخلق تأثيرًا عميقًا على كل من المجتمع والهوية الفردية. واليقين عندي أن الإنسان لم يخلق الثقافة ويُرسيها فحسب، بل إن الثقافة، لا سيما في شكل تكنولوجيا، خلقت الإنسان وأعادت تشكيله بطرق مهمة. فقد اتخذت البيئة، التي صنعها الإنسان بدقة من المواد الخام للطبيعة حياة خاصة بها، وهربت من فهمه الكامل وتحولت إلى قوة جبارة لا تؤثر عليه فقط، بل تشكله وتحكمه في نفس الوقت. وغالبًا ما يتجلى هذا التأثير بطرق لا يفهمها تمامًا، مما يؤدي إلى الانفصال عن نفس الإبداعات، التي كان القصد منها تعزيز وجوده. ولذك، فإن التحولات المستمرة للإنسان، المتراكمة عبر مرور الوقت، لا تحجب “رؤية” نواياه ورغباته الأصلية فحسب، بل تقوده إلى تصور غاياته وأهدافه النهائية، التي تكون ملامحها في الأساس تلك الخاصة بصرحه المتقن والمعقد. فخذ يوليسيس، على سبيل المثال، الذي يجد نفسه بعيدًا عن صخرته الأصلية، مفصولة بالمسافة الزمنية والمساحة المكانية، وفي هذه المسافة، لا يتعرف في الطريق على الصورة، التي كانت لديه ذات مرة عن منزله الحبيب، وكأنه يمضي مع شاعرنا العربي اللبناني إيليا أبو ماضي في حيرته “جِئتُ لا أَعلَمُ مِن أَين، وَلَكِنّي أَتَيتُ، وَلَقَد أَبصَرتُ قُدّامي طَريقاً فَمَشَيتُ، وَسَأَبقى ماشِياً إِن شِئتُ هَذا أَم أَبَيتُ”. وهذا الاغتراب العميق للإنسان عن نتاج أعماله ذاته جدير بالملاحظة بشكل خاص في سياق المجتمع المعاصر. ولذلك، فإن نمط الإنتاج، الذي يمكن القول بإنه أهم نشاط بشري، قد أفلت بشكل مأساوي من السيطرة والتأثير البشريين. يكتسب الاستخدام الميكانيكي وغير الشعوري في كثير من الأحيان للآلات قيمة معينة خاصة به، مما يؤدي إلى آثار كارثية على جوهر ما يعنيه أن تكون إنسانًا. وفي هذا العصر الحديث، يجد الإنسان نفسه بشكل متزايد تحت رحمة الأدوات، التي تم تصميمها في الأصل وتهدف إلى خدمته. وبالتالي، يصبح التمييز التقليدي والراسخ بين القيمة والموضوع غير واضح وغامض بشكل متزايد، مما يثير أسئلة عميقة حول الهوية والوكالة. ولذلك، فإن اغتراب الإنسان كمنتج هو مرحلة أساسية وحاسمة في السياق الأوسع لاغتراب الإنسان ككائن وحيد، كواقع إنساني محسوس وملموس. ما يعني أن تكون مغتربًا حقًا هو أن يكون المرء بعيدًا عن الذات، وأن يشعر بالانقسام على اثنين، وأن يتم تحويله باستمرار عن مصير المرء الحقيقي والأصلي كمخلوق عقلاني. ويهدف هذا الوجود إلى الازدهار في وئام مع بيئة معقدة وحيوية وتشاركية، حيث يُدرك كل فرد دوره ومكانه داخل نسيج الحياة الأكبر. وبالتالي، فإن القضية الرئيسة والأساسية المتعلقة بالاغتراب هي عدم التوازن، وتحديدًا الاهتمام المفرط بـ”الامتلاك” مع الحيازة والاستهلاك، مع إهمال الجانب الأساس لـ”الوجود”. ويتماشى هذا التفسير بشكل جيد مع الآثار الأخلاقية المتأصلة في الوجودية، وهو إطار فلسفي يهتم بشدة، كما أسلفنا، بطبيعة الوجود والوكالة الفردية. ويصبح الإنسان مهتمًا بشكل مفرط بـ”الامتلاك” إلى حد كبير بسبب الآثار المنتشرة لأسلوب حياته المدفوع بالتكنولوجيا والمبدأ الشامل للعقلانية التقنية، التي توجهها. ومع استمرار التكنولوجيا في الهيمنة على التجارب البشرية وتشكيلها، يصبح الاغتراب الناتج أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، مما يعزز الانفصال بين الأفراد والعلاقات الحقيقية، التي يمكن أن تكون لديهم مع أنفسهم والعالم من حولهم. ونظرًا للأهمية العميقة لآثاره على فلسفة مستقبلنا، سنلقي الآن نظرة ثاقبة ونفحص مشكلة الاغتراب متعددة الأوجه بمزيد من العمق والتفصيل، ونستكشف جذورها وآثارها ومساراتها المحتملة نحو إعادة الاتصال والفهم.
الرؤى الفلسفية المستقبلية والروايات الطوباوية:
أكثر من أية لحظة أخرى في الجدول الزمني الواسع للتاريخ البشري، فإن السؤال الملح حول ما ينتظرنا في المستقبل هو بلا شك الشاغل السائد لوجودنا الحالي الاعتبارات المتعلقة بما ينتظرنا في الأيام المقبلة قد انتقلت بشكل حاسم من المناطق الباطنية المرتبطة تقليديًا بالدين والأساطير والميتافيزيقيا، بدلًا من ذلك، وجدوا مكانهم الصحيح في طليعة الخطاب الفكري والسياسي المعاصر. ويبرز القرن العشرون، على وجه الخصوص، باعتباره مشهدًا غنيًا بشكل ملحوظ؛ مليء “برؤى” متنوعة للمستقبل، من اليوتوبيا المثالية، التي تضاءلت في الاعتقاد ولم تعد تعتبر ممكنة من الناحية العملية، إلى النماذج المعقدة، التي تسمح بحسابات غير محدودة، وتمتد إلى ما لا نهاية، إلى “الرؤى” الفوضوية، والمروعة في بعض الأحيان، لـ”الديستوبيا” الشاقة، التي تلوح في الأفق على حواف وعينا المجتمعي. وهذه “الرؤى”، التي لا تعد ولا تحصى للمستقبل هي دائمًا إسقاطات، وغالبًا ما تشتمل على قفزات وحدود معقدة ومتعددة الأوجه إلى عوالم الاحتمالات الخيالية، فيما يتعلق بما قد يحمله المستقبل للبشرية. وقد أشير بحق إلى أننا سجناء إلى الأبد في عصرنا، يُشَكِّلنا بعمق ومحصورين بمعاييره الخاصة وظروفه السائدة. ومع ذلك، يمكن القول، بنفس القدر من الصلاحية، إن المستقبل نفسه محجوب إلى الأبد، ويغيم عليه “رؤيتنا” المحدودة في كثير من الأحيان، وأحيانًا المنحرفة، وحتى المتحيزة لما يمكن أن ينطوي عليه. ولا تزال بعض الأنظمة الفلسفية الدائمة، التي تم إنشاؤها في الماضي تحتوي على ثروة من المعرفة القيمة للغاية و”الرؤى” العميقة، وهي مستعدة لتعليمنا عن نوع الخطاب الفلسفي، الذي قد يدعي المعرفة بالمستقبل بحق على أنه تراثه العزيز وأساسه التأسيسي. وفي حين أننا قد نتساءل عما إذا كنا نمتلك القدرة على معرفة ما يجب أن تكون عليه الأبعاد الفلسفية لمستقبلنا، إلا أنه يجب علينا مع ذلك أن نلزم أنفسنا بالتحقيق بجدية في الأبعاد الفلسفية للمستقبل، التي تم تصورها بعناية من خلال عدسة الماضي. وفي الفقرات التالية، قد نجد أنه من الضروري أن ننظر في سلسلة من الملاحظات المتعلقة بالطبيعة المعقدة لمفاهيم المستقبل، والأنظمة المتنوعة، التي تعرض هذه المفاهيم متعددة الأوجه وتعبر عنها، وأنواع الأفكار المعروضة سلفًا حول الإمكانية والضرورة، أو حتى التعريفات المحددة للوقت، التي قد تثير هذه المفاهيم الغنية، وتتولد في فهمنا الحالي للمستقبل الواسع والمعقد، الذي ينتظرنا.
أول هذه الملاحظات، هي أن المستقبل كموضوع اهتمام، والفكرة الحالية للمستقبل، والتكهن الفلسفي في المناقشات المعاصرة، يجعل المستقبل يقف كموضوع حاسم ذو اهتمام عميق. ويتصارع الفلاسفة والمفكرون وغيرهم كثيرون مع فكرتنا الحالية عن المستقبل، ولا يقتصر الأمر على إمكانياته فحسب، بل يقيمون أيضًا آثاره على البشرية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نستكشف التكهنات الفلسفية، التي تتعمق في كيفية تصورنا لإمكانيات النمو والتغيير والتحول بينما نمضي قدما.
وثانيها، هي مفهوم المستقبل كأنظمة فلسفية مختلفة عن إدراك المستقبل، الذي هو أكثر بكثير من مجرد فكرة. وذلك لأنه بمثابة أساس جذري لمختلف الأنظمة الفلسفية عبر التاريخ. وتتعامل المدارس الفكرية المختلفة مع فكرة المستقبل بطرق فريدة ومتنوعة، مما يثري فهمنا للوجود والواقع مع تشكيل الأطر، التي نتعامل من خلالها في الحياة.
وثالثها، هي التفاعل بين الوقت والقيمة والتماثل؛ أي أن النظرة على النفعية وآثارها على المستقبل يؤثر على تفاعل الوقت والقيمة والمثل بشكل كبير، وينعكس على الفكر الفلسفي. ويكشف فحص النفعية كيف يتفاعل هذا الإطار الأخلاقي مع جوانب الوقت والقيمة الإنسانية. ومن خلال تحليل القيمة النفعية، يمكننا أن نفهم بشكل أفضل آثارها على تشكيل مستقبلنا، لأنها تقترح معيارًا يتم فيه تحديد الإجراءات بناء على مساهماتها في السعادة العامة.
ورابعها، هي نوع معين من المستقبل؛ مثل استكشاف عالمية هيجل، الذي يقدم مفهومه للعالمية منظورًا رائعًا لنوع المستقبل، الذي قد نتخيله. ويدعونا هذا الإطار الفلسفي إلى النظر في تفاصيل التنمية البشرية وتقدمها. ومن خلال استكشاف أفكار هيجل، يمكننا الانخراط في نوع معين من المستقبل، الذي يؤكد على العملية الجدلية وإنسانيتنا المشتركة في السعي إلى فهم أكبر.
وخامس الملاحظات، ترتبط بالعلاقة بين “الرؤية” الفلسفية والمستقبلية والتاريخية، إذ توجد علاقة مقنعة بين الفلسفة والمستقبلية ومفهوم التاريخية. وتتشابك هذه المجالات، مما يجعل منها نسيجًا معقدًا يدعونا للتفكير في الأحداث الماضية والحقائق الحالية والمسارات المستقبلية. ويقدم تحليل هذا التفاعل الديناميكي “رؤى” حول كيف يمكن للنظريات الفلسفية أن تثري وجهات النظر المستقبلية وتلهمها، مع الحفاظ على إمكانية إرجاعها في السياق التاريخي.
والملاحة السادسة والأخيرة، هي ما بين المؤلف والفكرة، إذ نجد في فحص “الرؤى” البائسة في الأدب والفلسفة، أنهما غالبًا ما يتقاطعان في تصويرهما لهذه “الروى”، لأن كلا المؤلفين وأفكارهم يتقصدان إبراز هذا البؤس. وعند فحص هذه الروايات، نستطيع أن نكشف عن الموضوعات والمخاوف الأساسية المتعلقة بالمستقبل، مما يدفع إلى التفكير في التركيبات المجتمعية ومسار البشرية إلى الأمام. وهذه الإسقاطات البائسة بمثابة حكايات تحذيرية تتحدانا للتفكير في مسار مستقبلنا، وما يستلزمه للحياة كما نعرفها.
تَخَيُّل المستقبل والتأملات الفلسفية:
يبدو أنه من نواح كثيرة، ومن المفارقة الغريبة، أن تجلس وتكتب بعناية حول ما قد يخبئه المستقبل من دون أن تنتابك مشاعر أقرب إلى “هلوسات” ألان دونو بانحدار “عصر التفاهة”، الذي يغلف “الرؤية” في الحاضر. والمستقبل، في جوهره وطبيعته الأساسية، لم يحدث بعد، فكيف يمكننا بالضبط أن ندعي بمصداقية أننا نعرف كيف سيكون عليه بالفعل، ونحن أعجز عن إدراك القيمة الإيجابية في حاضرنا؟ بالتأكيد لا يمكننا معرفة كل التفاصيل على وجه اليقين المطلق، لكننا قد نتخيل بشكل معقول أن المستقبل سيحمل بعض أوجه التشابه مع أجزاء مختلفة من الماضي، أو حتى اللحظة الحالية، التي نعيش فيها حاليًا. وأولئك الذين يكرسون حياتهم المهنية ومساعيهم الفكرية لمجال علم المستقبل الرائع، والذي يعرف بأنه التخصص الأكاديمي، الذي ينطوي على التفكير والتحليل والتنظير المنهجي حول ما قد يحمله المستقبل وما ينطوي عليه، عادة ما يفعلون ذلك من خلال التفكير بعناية والقياس والتعميم على التفاصيل المعقدة للاتجاهات المعاصرة، التي يتم ملاحظتها في المؤسسات المجتمعية الأساسية مثل العلوم، والتعليم، والسياسة، والأخلاق، والدين. وتتطلب هذه العملية المعقدة والمتعددة الأوجه فهمًا عميقًا ودقيقًا للديناميات الحالية، بالإضافة إلى إمكانية التطور، أو التحول، أو التغيير بمرور الوقت. وبالطبع، فإن تَخَيُّل المستقبل، أو تصوره يُشبه المهمة الصعبة المتمثلة في التنبؤ بأنماط الطقس المعقدة، أو محاولة الفوز في مضمار السباق، الذي لا يمكن التنبؤ به. ونظرًا لأنه لا يمكن التكهن، أو التنبؤ بدقة بكل التفاصيل الدقيقة للمستقبل، فمن المحتم ومن المحتمل جدًا أن نجد أنفسنا؛ في بعض الأحيان، مندهشين بشكل غير متوقع بما يحدث بالفعل في رحلة الزمن، التي تتكشف أمامنا.
لهذا، فإن تَخَيُّل المستقبل ليس مجرد نشاط سلبي، بل هو مسعىً نِشِط يتطلب مشاركة وإبداعًا كبيرين، على غرار العمليات المعقدة، التي ينطوي عليها تصميم واتخاذ التدابير الأساسية لبناء بعض الهياكل الهندسية المبتكرة، أو الأجهزة الإلكترونية المتقدمة. وغالبًا ما تبدأ هذه العملية الإبداعية متعددة الأوجه بإنشاء رؤية محددة جيدًا، أو فكرة واضحة بشأن الهدف النهائي، الذي يسعى المرء إلى تحقيقه، مما يسهل تطوير مجموعة من البدائل الممكنة، التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك الهدف المنشود. وبعد هذه المرحلة الأولية، يتم النظر بعناية ودقة بين هذه البدائل، حيث يتم اختيار الخيارات الأكثر فاعلية بشكل انتقائي لتشكيل العناصر الأساسية للمشروع الشامل. ويطلق هذا الاختيار الاستراتيجي مرحلة البدء في عملية التصميم والبناء، التي يتم دفعها إلى الأمام من خلال خطة شاملة ومفصلة بدقة، وقد تم إعدادها بعناية لتوجيه العملية بأكملها من البداية إلى النهاية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا ينبغي النظر إلى هذه الخطة على أنها نص محدد مسبقًا في لوح محفوظ. بدلًا من ذلك، يمكن إعادة تقييمه وإعادة النظر فيه في أية لحظة طوال رحلة التشكيل. ويمكن بالفعل معالجة أي قيود قد تنشأ نتيجة للتعقيدات المتأصلة المحيطة بمختلف المكونات المعنية، بما في ذلك طبيعة وخصائص المواد المختلفة، أو القيود الناجمة عن الموارد المحدودة، من خلال نُهجٍ مبتكرة وجديدة. وبالنسبة للعديد من التحديات، التي تظهر خلال هذه العملية، إذا كان الحل يكمن على وجه التحديد على الفواصل بين تخصصين، أو أكثر من التخصصات المتميزة، فيمكن التغلب على هذا القيد بشكل فعال من خلال استعارة أدوات، أو تقنيات جديدة قوية من تلك المجالات المختلفة للدراسة، أو الممارسة. في النهاية، وفي سعينا للحصول على حلول، قد نجد أنفسنا منخرطين بطريقة تُشبه بشكل لافت النظر في سلسلة من ورش العمل لرفع الوعي. إذ إنه خلال هذه الجلسات التفاعلية، ينخرط الجميع في فحوصات نقدية لجميع آرائهم الجماعية، مما يسمح لوجهات نظر جديدة بالظهور والتطور وتحويل الاستراتيجيات، التي يستخدمونها بينما يسعون جاهدين لتشكيل مستقبل مبتكر وواعد. ويعزز مثل هذا التفاعل الديناميكي للأفكار والرؤى جوًا ناضجًا للاختراقات الإبداعية، مما يمكننا مثلهم من تجاوز الحدود والقيود التقليدية بينما نتنقل بشكل تعاوني في المياه المثيرة والمجهولة لما ينتظرنا.
ففي الماضي، جرت صياغة “اليوتوبيا” في المقام الأول في الأعمال الأدبية لمناشدة الرغبة العالمية في تهذيب وتحسين ظروف المعيشة. وقدمت هذه الأعمال الأدبية “رؤى” لمجتمع يمكن للناس أن يزدهروا فيه ويتقدموا ويحققوا ذلك الرقي المنشود. واليوم، ومع ذلك، يبدو أن مشهد الأدب تهيمن عليه بشكل كبير حكايات مقلقة ومرعبة، التي تصور في كثير من الأحيان آفاقًا مزعجة وحقائق مذهلة، فيما يُعرف بـ”الديستوبيا”. وهذه “الديستوبيا” مقنعة بشكل خاص وذات صلة بطلاب التخطيط الاجتماعي، لأنها توضح بجلاء الترياق الكلاسيكي للصراع الاجتماعي؛ بدءًا من الديكتاتورية الخيرية والاستبداد البيروقراطي إلى مذهب المتعة، فضلًا عن دور الأبويين السياديين، والشرطة السرية الأصلية، والمخبرين السريين. وغالبًا ما يحول تنفيذ هذه الأشكال من الحكم دون أي محاولة حقيقية لتعزيز توافق خيالي وغير متوقع في الآراء، فضلًا عن حل النزاعات من أجل مشروع تعاوني يتم اختياره بحرية. ويستخدم المؤلفون “البائسون” بمهارة رموزًا متقنة وتفاصيل غنية وملونة لخلق كثافة أدبية أكثر عمقًا بكثير من تلك، التي يعرضها المفكرون الاجتماعيون عادة. وغالبًا ما يطور هؤلاء أفكارهم وحججهم ضمن تقليد يرتكز على الملاحظة المجردة والتحليلية، التي قد تفتقر إلى المشاركة العاطفية الموجودة في الروايات البائسة. ونتيجة لذلك، يستحق النقد “البائس” للتخطيط الاجتماعي أن يؤخذ بجدية أكبر من النقد الاجتماعي لليوتوبيا التقليدية. وعلى الرغم من جاذبيتها الخيالية وصورها النابضة بالحياة، فإن “الديستوبيا” تتصارع على الأقل مع القيود والحدود المفروضة على ممارسة حرية الإنسان، بدلًا من التركيز فقط على موضوعات السعادة والراحة والحرية ومفاهيم العدالة. علاوة على ذلك، تثير هذه اليوتوبيا منطقيًا أسئلة حاسمة تتعلق بجوهر ورغبة “الجنة” الانتقالية الكاملة. ويمكن أن تختلف مثل هذه “الجنة” على نطاق واسع، وتشمل مفاهيم مثل “المدينة الفاضلة”، أو قارة أتلانتس المفقودة الأسطورية، أو حتى العصر الذهبي المثالي الموضح في روايات التقاليد اليهودية المسيحية والإسلامية، بالإضافة إلى الحلم الأمريكي الحديث، الذي يتميز بزيادة لا نهاية لها في الإنتاجية والاستهلاك والترفيه. وتجبر هذه التأملات القراء على فحص المزالق المحتملة والتوقعات غير الواقعية المرتبطة بمتابعة مثل هذه الحالات المثالية للوجود، والحث على تحقيق أعمق في عمليتها وأهميتها في الإطار المجتمعي المعقد اليوم.
الإبحار المطمئن في المجهول:
إن الطموح المركزي لإطار فلسفي شامل يمكن أن يكون مصمم خصيصًا لغرض التفكير ووضع الاستراتيجيات حول المستقبل هو تعزيز مهارة الفرد بشكل كبير في فن التفكير المستقبلي، مع الحكمة والفضيلة في “الرؤية” الفلسفية المستقبلية، التي يلهج بها جهد المفكرين الكبار. ويحمل هذا التعزيز الهدف الغائي المتمثل في تحقيق شعور أكبر بالرضا والإنجاز في الحياة. ويستلزم هذا المسعى العميق تعزيز تقدير أكثر ثراء ودقة للحظة الحالية، مقترنًا بنظرة مفعمة بالأمل وخطة جيدة التنظيم لمستقبل لا يحتضن الإمكانات الهائلة الكامنة في البشرية فحسب، بل يدركها بنشاط. وسيكون نهجنا كمنتدىً للفِكر العربي في هذه المهمة المعقدة والمتعددة الأبعاد والأوجه متنوعًا، ويتضمن وجهات نظر ومنهجيات متنوعة. وسنعمل دومًا للتأكيد على أن الاستفسارات المحيطة بما يأمله المرء ترتبط ارتباطًا وثيقًا ولا تنفصم بالأسئلة المتعلقة بما هو مرغوب فيه حقًا للأمل فيه، مع ملاحظة أن المساعي السابقة، التي تهدف إلى معالجة السؤال المحوري حول ما يشكل الأمل المرغوب فيه لا مثيل لها في عمقها وأهميتها، ويتردد صداها عبر عصور البحث الفلسفي. علاوة على ذلك، سنؤكد أن استكشاف رغبات المرء يرتبط ارتباطًا جوهريًا بهذه الأسئلة المحيطة بطبيعة الحياة الجيدة والكريمة، ويدعونا إلى فحص ما يشكل حقًا وجودًا ذا معنى. وفي هذا السياق الغني، نؤكد أن المحاولات التاريخية لتقييم، أو تصنيف السلع البشرية المختلفة، مثل السعادة والفضيلة والوفاء، لا تزال تحمل أهمية قصوى وتظل غير مسبوقة في بصيرتها، وغالبًا ما توجه الأفراد نحو فهم أعمق لأنظمة القيم الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، سنجعل نصب أعيننا الحجة، التي مفادها أن الإيمان ببعض المبادئ التأسيسية، والتي تحكم العمل البشري؛ سواء كانت تنطوي على الإيمان بالقدرة على التأثير بشكل إيجابي على الكون وحياة الأفراد، أو الإيمان بالمسار الحتمي للتقدم البشري نحو التحسين، أو الاقتناع بالقدرات غير المحدودة، التي توفرها تقدم التكنولوجيا، تُمارس تأثيرًا عميقًا وواسع الانتشار على شكل ومحتوى تطلعات الأفراد المستقبلية. وبالتالي، يشكل نظام المعتقدات هذا كيف يتصور الناس تحقيق أهدافهم، سواء من خلال الجهد المنضبط، أو العمل الهادف، أو التفكير الابتكاري. ومن خلال فهم هذه الروابط المعقدة وتحليلها بدقة، نأمل أن نقدم منظورًا غنيًا بالثراء حول العلاقة بين فهمنا الحالي، وتطلعاتنا للمستقبل، والأسس الفلسفية، التي توجه بقوة استكشافنا للإمكانات البشرية والمسارات، والتي قد نختار اجتيازها في سعينا لوجود ذي مغزى.
إن علينا أن نوضح حجة شاملة تفترض ما إذا كانت الطبيعة المتأصلة في الحالة البشرية هي السعي بلا تردد ليصبح الأفضل في شيء ما، وأن ينتصر المرء على فضائه الفريد وسط عدد كبير من المؤسسات، التي تصنع النجاح. وبالتالي، اعتبار أنفسنا الأكثر أهمية بين جميع المنافسين الأخرين، ثم تصبح المهمة الهائلة المتمثلة في التنقل بشكل صحيح عبر الاتساع اللانهائي وتعقيدات الواقع المحددة غير مهمة فحسب، بل ذات أهمية قصوى حقًا. وهذا التنقل محوري ليس فقط لتجنب براثن الشر الخبيثة، ولكن أيضًا لتحقيق الغايات السامية والنبيلة، التي تجسدها الحكمة والفضيلة معًا في أكثر أشكالها دقة. ومن المؤسف أن الكثير من جوانب هذه المهمة الحاسمة في واقعنا العربي والإسلامي والإنساني المضطرب لم تحظ باهتمام إلى حد كبير. وينشأ هذا الإهمال من ميل الفكر المستمر إلى السعي إلى فهم أكبر وأعمق للعالم مع تجاهل وقمع تلك الجوانب المعقدة للسلوك البشري، التي تحدد بشكل أساس واقعًا منفصلًا ومجتزءًا بشكل واضح عن العالم الأوسع نفسه، والذي يمر باستمرار في حالة تغير مستمر. بالإضافة إلى ذلك، تميل الفلسفة إلى عزل المفاهيم الحيوية للفضيلة والحكمة ضمن العوالم المفاهيمية الضيقة للأخلاق ونظرية المعرفة، وحصرها في التقاليد المحدودة لـ”كن صالحًا” و”اعرف الخير”. وهذه النظرة الاختزالية تقوض بشكل صارخ التعقيد المتأصل في التجربة الإنسانية، التي غالبًا ما تؤدي إلى نتائج متشائمة وغير مرغوب فيها. وقد نعاني من عواقب وخيمة وبعيدة المدى لاعتماد مثل هذا المنظور الضيق والغامض. وقد تظهر التداعيات على الأرجح من خلال الآلام والإخفاقات غير المرغوب فيها، التي تأتي في النهاية على حساب كثير من الرضا المستقبلي، وحتى من خلال الرفض الذاتي العميق للفرص المستقبلية المحتملة، التي قد تحمل وزنًا ومعنىً تاريخيًا كبيرين. وتتمثل خطتنا المدروسة والطموحة في الشروع في رحلة تحويلية لاستعادة ذلك التوازن الحاسم والأساس، الذي قد يتطور بمرور الوقت.
الخلاصة:
تكشف فلسفة المستقبل عن “رؤية” غنية بعمق لنوع جديد من الفكر، وفهم تحويلي يسعى إلى أن يكون عميقًا ومتاحًا لجميع الراغبين في التعامل معه، بما أنه يتمثل في احتضان اليقين والمسؤولية الأخلاقية في السعي لاستشراف هذا المستقبل. ولا يعتمد هذا المنظور على أسس نظرية معقدة، أو متناقضة، ولا يضع أعباء كبيرة من المعرفة الفلسفية الخاصة على أولئك الذين يرغبون في فهم أفكار مقنعة والتعامل معها. بدلًا من ذلك، فإنه يحاول أن يجعل حتى أكثر الآمال والأحلام غير المحتملة أقرب بكثير إلى التحقيق مما كان يُعتقد سابقًا، بخلق قناعات أنه ممكن من خلال مساحة جذابة للتأمل والمناقشة والحوار. علاوة على ذلك، يجتهد هذا النهج أن يسهم بعناية في رسم مسار المسؤولية الأخلاقية لأعضائه من المفكرين المعاصرين، ويشجعهم على المشاركة بشكل هادف في العالم من حولهم. ويجب عليهم أن يتبنوا بشجاعة اليقين كعنصر أساس في تحقيقاتهم، وأن يجري من يستطيع منهم بنشاط بحثًا في الأسئلة، التي تم تجاهلها، أو رفضها حتى هذه اللحظة باعتبارها منطقية بطبيعتها، أو ذات صلة، والعمل بجد لتطوير حلول مبتكرة للمشاكل الأخلاقية والاجتماعية الملحة، التي تستدعي بشكل عاجل الحل في عالمنا سريع التغير. لذلك، فإن وضع هذا الإحساس العميق بالمسؤولية في الاعتبار لا يتطلب من أي منا التخلي عن التزاماته الخاصة تجاه المجتمع. بعد كل شيء، حتى المفكرين يجب أن يهتموا بالاحتياجات الأساسية والجوانب العملية للحياة اليومية؛ مثلما يجب أن يأكلوا ويشربوا ويشاركوا في تفاصيل الحياة، التي لا تعد ولا تحصى، والتي تتطلب اهتمامهم. ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن ندرك أن المجتمع المثقف يشترك بشكل جماعي في هدف أوسع وأكثر جوهرية؛ وهو توفير حلول هادفة ومبتكرة للمشاكل الإنسانية تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد تلك القضايا المتأصلة في بنيتنا التحتية العلمية والتكنولوجية الحالية. وبهذه الطريقة، لا تثري “الرؤية” الفلسفية للمستقبل الفكر العربي فحسب، بل تسعى إلى التواصل العميق مع التجارب الحية للأفراد والمجتمعات على حد سواء. وتقدم هذه “الرؤية” إطارًا فكريًا جديدًا ومتماسكًا وشاملًا يحدد التغييرات الضرورية والحاسمة المطلوبة لإنشاء مجتمع مدني عربي قانوني خاضع للمساءلة السياسية والاجتماعية. ويوضح هذا العرض تمامًا أن الأفكار المطروحة في صفحاته لا تنبثق فقط من مبادئ مجردة، أو قيم متسامية منفصلة، بل إن هذه الأفكار مستوحاة من “رؤية” صاحب فكرة المنتدى؛ نقدمها في سرد مستمر ومتطور يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل المتشابك للوطن العربي والمجتمع البشري بأكمله. ففي الوقت الحالي، غالبًا ما تجري المناقشات المتعلقة بمستقبلنا ودور البشرية فيه في منتديات وساحات غير مناسبة تمامًا للدراسة الجادة والشاملة. وهذه المناقشات هي في الغالب مجال علماء المستقبل، الذين غالبًا ما تبدو تصريحاتهم وتنبؤاتهم جوفاء ولا أساس لها، خاصة من دون احتمال عمل اجتماعي وسياسي أوسع يمكن أن يوفر لهم مضمونًا ملموسًا. لذلك، يجب أن يتبنى المنتدى النهج الأكثر تفكيرًا وتجريبيًا، وبحسن الظن والحظ، وبالجهد الناجح ويعتنق بكل إخلاص الاعتراف بالفوائد المحتملة لتسخير التقاليد الفلسفية الغنية كمصدر حيوي للإلهام من أجل تغيير ثقافي وقانوني واجتماعي ذي مغزى. وحتى الآن، لم يفعل المفكرون أكثر من الاعتراف بوجود هذه الأسئلة والمخاوف الملحة، والاعتراف بها كمشاكل مجتمعية كبيرة. وفي حين أنه من المعقول أن نتخيل أنه لم يتم بعد اجتراح، أو اقتراح حل حقيقي وفعال حقًا في مجالات التحقيق الهامة هذه، لا يمكن التقليل من أهمية متابعة مثل هذه الحلول. ولذلك، وفقط من خلال المساهمة الأعمق والمشاركة النشطة في هذه المناقشات، يمكننا أن نأمل في تحديد خطوات قابلة للتنفيذ نحو مستقبل أكثر استنارة وأخلاقيًا.
_________
* الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، الأردن، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية، جامعة سكاريا، تركيا
الاثنين، 30 مارس 2025
القاهرة، جمهورية مصر العربية
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.