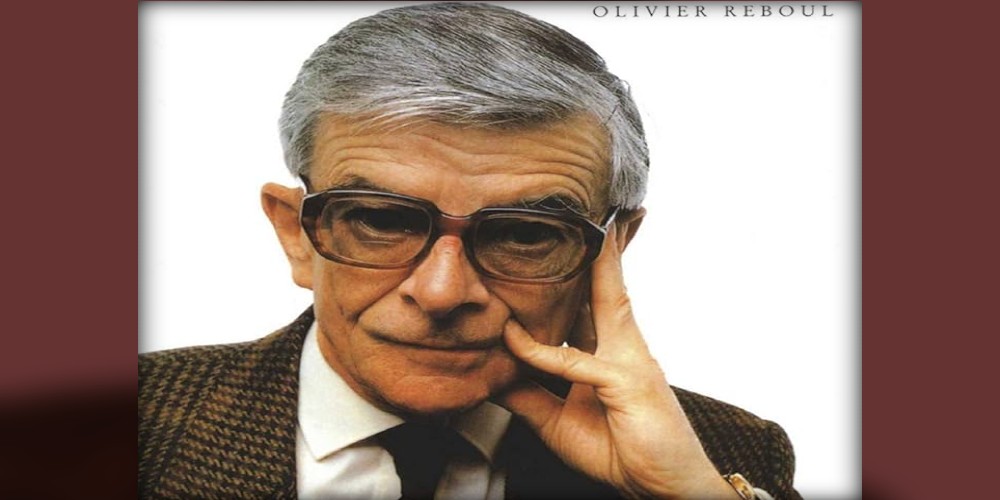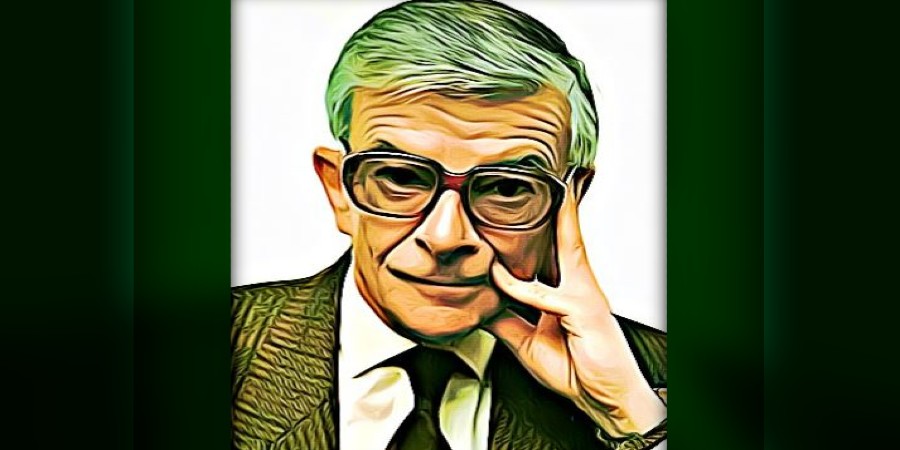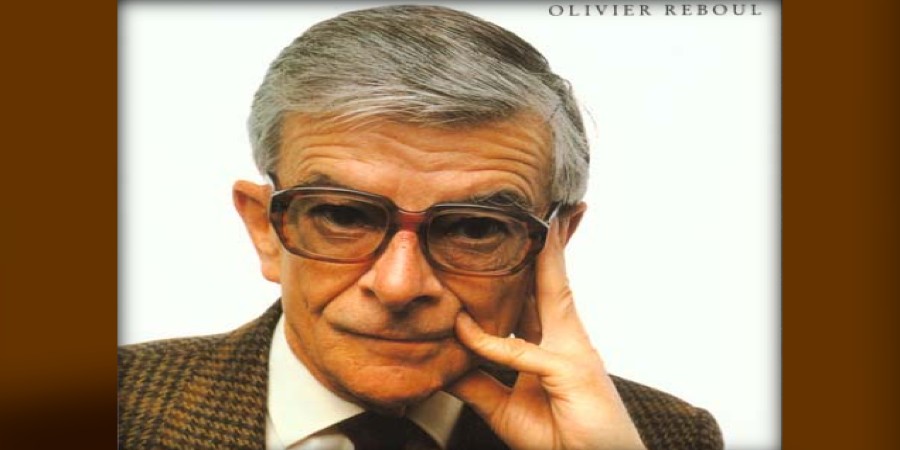تحوُّلات الخطاب في الإمبراطوريَّة الخطابيَّة لشايم بيرلمان

مهاد إشكالي:
حينما نتحدث عن مجمل التحولات التوترية للخطابة وتنقلاتها عبر التاريخ، لا بد لنا من النظر أيضاً أو مراعاة كذلك كل تلك التحولات التي سيشهدها الخطاب تاريخيا والذي يشير لدى اليونان إلى اللوغوس Λογότυπα بمعنى الكلام أو العقل، والذي سيعرف تحولا جذرياً لدلالته الإستعمالية في إمبراطورية Chaïm perelman الخطابية، وهذا التَّحَول transformer في الحقيقة هو موضوع مقالنا، ذلك أنه عندما نتحدث عن الخطابة فنحن نتحدث بالموازاة كذلك عن الخطاب والبلاغة والحجاج واللغة، فكل هذه الحقول المعرفية متداخلة بعضها البعض أو متكتلة تشكل أو تنتج لنا الخطاب كما نلمحه، لهذا يشير أوليفيي روبول في كتابه الشهير “مدخل إلى الخطابة” إلى تعريف دقيق جداً للخطاب بوصفه “مجموع متسق من الجمل متماسك، يملك وحدة المعنى ويتحدث عن الموضوع نفسه” [1]، بهذا يصبح الخطاب هو ذلك الكُلُّ المُرَكَّبُ من الجمل التي تتماسك بعضها البعض وتشكل تكتلا منطقيا أو اتساقا منطقيا صلباً لا يمكن هدم وحدته البتة، أو نقول عنه إنه خال من التناقض، فبما أن الحقيقة هي عدم التناقض، على الخطاب أن يكون بدوره خال من التناقض، فلا يعقل أن أقول كلاما وضده في نفس الجملة أو المساق اللغوي، آنذاك أكون أتناقض مع نفسي ومع متلقي الخطاب !
لهذا يضيف أوليفيي روبول في نفس الكتاب، ونفس الفقرة، ” إن وحدة الخطاب، إنما يخلقها مُؤَلِّفُهُ: هو من يُقرِّرُ ما يتَحَدَّثُ عنه، وهو من يقرر متى يبدأ خطابه ومتى ينتهي، وهو من يقرر أن يكتب مصنفاً، أو دراما، أو رسالة أو حكمة بسيطة ” [2]، ما يمكن الإشادة به هنا هو أن ما يميز الخطاب هو وحدة المعنى إضافة إلى تماسكه وتناظمه وتناسقه المنطقي، ولهذا كنا قد أشرنا فيما سلف أن الخطاب هو النظام، هذا الأخير يستدعي عدم التناقض، الذي يستدعي أيضاً التماسك المنطقي والوحدة Cohérence logique et unité.
والآن بعد تعرفنا على ماهية وحقيقة الخطاب الثابتة من خلال التعرف على أحد أهم عنصريه، ننتقل إلى شايم بيرلمان الذي لاحظ في إمبراطوريته الخطابية أن في السابق لم نكن نتحدث عن مصطلحي البلاغة والخطابة وما يفصل بينهما من خطاب، وهناك غياب ملحوظ لهما في المعجم النقدي والتقني الفلسفي الشهير لأندري لالاند، حيث << إن هذا التمييز [بين الحجاج والبلاغة والخطاب] لا يمكن أن يتم دون الرجوع إلى أحكام قيمة، كانت تبدو لي، وقتئذ، اعتباطية تماماً وغير مضبوطة منطقياً >> [3]، ومن هنا انطلقت أول ثورة كوبرنيكية عظيمة في حقل الخطابة والخطاب، ذلك أننا أصبحنا نتحدث عن الخطاب والبلاغة والحجاج انطلاقا من معيار حكم قيمي أو استنادا إلى حقل القيمة، لهذا سيعتبر أوليفيي روبول أن ما يميز شايم بيرلمان وعمله المشترك مع لوسي أولبرخت تيتيكا الموسوم ب “المصنف في الحجاج” هو أنه أعاد التفكير في الخطاب والخطابة والبلاغة والحجاج انطلاقا من منظور قيمي، لهذا << إن ما نشاهده حالياً من نهضة لصناعة الخطابة وإعادة إعتبار لها في الفكر [الفلسفي] المعاصر، لم يكن ممكنا إلا بعد إعادة النظر في العلاقات [القائمة] بينها وبين الجدل، بالشكل الذي أقامه أرسطو وعدله بيير دو لارامي Pierre de la Ramée بعمق، في إتجاه غير ملائم لها. إن إعادة نظر مُمَاثِلَةٍ [لما فعله كل من أرسطو و بيير دو لارامي] هي ما نَنْوِي القيام به: سوف تعلل [إعادة النظر هاته] أسباب إنحطاطها [أي الخطابة]، وتوضح علاقات صناعة الخطابة الجديدة بنظرية الحجاج >> [4]، ذلك أن ما يحسب لشايم بيرلمان في الحقيقة هو أنه حاول أن يعيد النظر في كل تلك المفاهيم الفلسفية التي تعلقت عبر التاريخ بالخطابة وقول الخطاب وعلاقة ذلك بالحجاج واستعمالات اللغة، من خلال إعادة النظر وإحياء التراث الأرسطي الذي هو إرث عريق سباق تاريخيا لعرض نظرية حول الخطابة أو الريطوريقا، ومحاولة الربط أو إعادة الصلة أو الوحدة التي ثم تقويضها وتقييدها والحد منها التي باءت بالفشل بين كل من الخطابة والحجاج.
هذا التحول لن يمر مرور الكرام، ذلك أن شايم بيرلمان هنا سيحاول أن يوجه نقودا شديدة إلى أصحاب النزعة الوضعية التي كانت تحاول ما أمكن الدفاع عن وصل أوكام القاضي بتخفيف أو التأفف في القول والإقتصاد في الكلام نظرا لحدود الكلام والخطاب، لكن << جواب الوضعانيين المتشكك لم يشف غليلي، فطفقت أبحث عن منطق لأحكام القيمة. فكتاب إدموند غوبلو [من كبار المنطقيين أنذاك] الصادر سنة 1927 تحت عنوان “منطق أحكام القيمة” لا يعالج بطريقة مرضية هذه الإشكالية >> [5]، ذلك أن بحث علماء المنطق والوضعيين في أحكام القيمة قد يكون إقبارا للخطاب واللغة البشرية بسبب الحافز الذي يشغلهم ولهم رغبة عمياء في وضع حدود لكل خطاب أو كلام موحد يعتبرونه ميتافيزيقا!
كل هذا سيجعل من شايم بيرلمان يقدم تعريفا خاصا به للخطابة، متعلق بالخطاب، هذا التعريف في الحقيقة، كان الغرض منه هو تمييز مفهوم الخطابة من التعريفات التي ألبست لها عبر التاريخ، لذلك << أعني بصناعة الخطابة، تلك الصناعة القديمة للإقناع (persuder) والتَّيْقِينِ (convaincre) >> [6]، فهذان العنصران الأخيرين يشكلان المقوم الجوهري للإمبراطورية البيرلمانية، بل ولنظرية الخطابة والحجاج لديه، فلا يمكن فهم أي خطاب إن لم يكن غرضه البائن هو الإقناع، بل وكذلك حدوث التيقين، وجدير بالذكر هنا أن بيرلمان يميز تمييز واضحا بينهما، كي لا يحدث الخلط في الذهن لدى المتلقي لهما حيث << إن التمييز بين الإقناع والتَّيْقِينِ يقوم، أساسا، على أن الإقناع من صنع الغير، في حين نُيَقِّنُ [نحدث التَّيْقِينَ] أنفسنا دائماً بِأَنْفُسِنَا >> [7] وبهذا يصبح الإقناع خارجيا والتيقين داخليا نحدثه بأنفسنا ونتحمل مسؤوليته.
لكن رغم كل ذلك نلحظ أن طموح بيرلمان هو طموح يهدف إلى البحث عن أسس ومقومات وركائز تبحث عن متلقي أو مستمع كوني عالمي وعولمي، وبهذا << إن الخطاب الموجه إلى مستمع خاص يهدف إلى الإقناع في حين يرمي الخطاب الموجه إلى المستمع الكوني إلى التَّيْقِينِ >> [8]، ليصبح للخطاب سمة أخرى تميزه عن غيره من الخطب وهو صفة الشمولية والكونية Holisme et universalité.
وبغض النظر عن خاصيتي الشمولية والكونية هناك خاصية أخرى ستنضاف إلى الخطاب أو الخطيب المعبر عن الخطاب هو خاصية التكيف ذلك أنه << على الخطيب إذا أراد التأثير بنجاعة بواسطة خطابه أن يَتَكَيَّفَ مع مُسْتَمِعِهِ >> [9] وعندما نقول بالتكيف الذي يشير إلى Adaptation أي الإنضباط والتلاؤم والانسجام وتقمص رؤى وتوجهات واتجاهات وإيديولوجيات المستمع، من خلال موافقته والتداخل والتكامل معه في أرائه ومعتقداته وميولاته وأهوائه، وكأننا نسقط هنا في الباتوس pathos الأرسطي.
أما عن الجدال والمساجلة التي انساق معها العديد من الفلاسفة عبر تاريخ الفلسفة أو إن صح القول تاريخ نظريات الحجاج والخطابة خاصة النقاش الذي دار حول كون هل كون الخطاب يعبر عن الحقيقة ؟ أو هل يمكننا بلوغ الحقيقة بغض النظر عن نظريات الحجاج يرد عليهم بيرلمان قائلا: << إن كل هؤلاء الذين يعتقدون أن باستطاعتهم إبراز الحقيقة بمعزل عن الحجاج، لا يُكِنُّونَ سوى الإحتقار لصناعة الخطابة [نفسها] التي تقوم على الآراء >> [10]، ومن هذا نفهم أن مجال الخطابة والحجاج هو مجال الرأي Doxa وليس مجال الحقيقة domaine de la vérité.
ويعود بنا شايم بيرلمان إلى الجذر اللاتيني اللغوي اليوناني للمصطلح الموافق ل << معنى كلمة << δεκτός >> التي تُرْجِمَت ب << مقبول بوجه عام >> أو << جدير بالقبول >> يتضمن مظهراً كيفياً الشيء الذي يقربنا من لفظ صائب raisonnable وليس من لفظ راجح probable >> [11]. وبهذا يصبح كل خطاب هو ما هو مقبول به أو جدير بالقبول، ومرحب به، أو معرض للتلقي والتقبل، وبهذا فالخطاب يقربنا من الصواب والصحة أو نقول عنه شبيه الحقيقة vraisemblable ولا نقول عنه بأنه عين الحقيقة !
لذلك فحديثنا عن الراجح أو المحتمل هو الذي سيشكل تحولاً آخر من تحولات الخطاب الذي نقف معه عند كل تمفصل من تمفصلات مقالنا، وذلك نظراً لأهميته حيث يشكل << الرُّجْحَانُ [الذي] لا يتعلق إلا بالوقائع Les faits أو بالأحداث الماضية أو المستقبلية، في حين أن الدَّعَاوَى موضوع النقاش يمكن أن تتعلق بأحكام لا زمنية. >> [12] هذا الفرق بين الوقائع التي يعبر عنها الرجحان وبين الحقائق التي قلنا لا تبت بصلة للخطاب، ذلك أن الدعاوى التي يحملها كل خطاب تحمل تأويلات قابلة للنقاش والتجاوز كذلك، نظراً لتعالقها بأحداث لا زمنية، وأن الخطاب لا تاريخ له ولا يحده زمان أو يشرطه مكان!
لأنه يتوجه إلى المتلقي << كيفما كان المستمع الذي يتوجه إليه وكيفما كانت المادة التي يستند إليها >> وهذا تدليل على أن الخطاب الموجه إلى المستمع الكوني لا يشرطه أي شرط يدعي أنه زمكاني. لكن لا ننسى أنه وعبر تاريخ نظريات الخطابة تعرض الخطاب ومهنة الخطيب للكثير من النقد والدحض والتفنيد وإعادة النظر، فمثلا في محاورة جورجياس الشهيرة لأفلاطون يصرح سقراط أن الخطابة صناعة مضحكة ، تشبه فن الطبخ، كما وجه إبكتيت نفس النقد لصناعة الخطاب حيث يقول << وصناعة القول وزخرفة لغتنا هاته، إن كان في ذلك من صناعة خاصة، ماذا تفعل حين تصادف أقوالنا موضوعاً مَا ؟ غير تزيين لغتنا وتصفيفها مثلما يزين الحلاق الشعر ويُصَفِّفُهُ >> [13]، لكن لنتوقف هنا بمعزل عن هذا النقد الهادم فقط، الذي لا يتغيا البناء ولننظر إلى << صناعة الخطابة، منظوراً إليها، وبشكل شمولي، هي فن التَّفْخِيمِ >> [14]، كما أن محاولات شايم بيرلمان كما قلنا منذ البداية كانت هي التقييم، ولا يفهم من التقييم هنا إضفاء قيمة، بل العكس هو تأسيس مجال الخطابة والحجاج على حقل القيم كما أشرنا سابقاً وبهذا أصبحنا نتحدث عن نوعين من القيم الأولى مثمنة والثانية لا قيمة لها ! لهذا << فما سَيُنْعَتُ بالجيِّد أو العادِل أو الجَمِيل أو الحقِيقِيُّ أو الواقعِيُّ مُثَمِّنٌ، وما وُصِفَ بالسَّيِّءِ أو الظَّالِمِ أو القبِيحِ أو الزائِفِ أو الظاهِرِيُّ ساقِطُ [أي بدون] القيمة. >> [15]، ومن هنا نستنتج لماذا فضل زينون الخطابة بوصفها قرينة الجدل، هذا الجمع يحسب في الحقيقة لأرسطو، الذي استقاه من زينون وفق شهادة كينتيليان الذي يعترف بأسبقية زينون الذي اعتبر الجدل أداة للحوار حيث << يُشَبِّهُ زينون Zénon الجدل، أي تقنية الحوار، بِجَمْعِ الكَفِّ، في حين كانت الخطابة تبدو له شبيهة بِيَدٍ مَفتوحة. >> [16]، لكننا دائما حينما نتحدث عن الخطاب أو ما نقوله من كلام يتم توجيهه إلى مستمع قلنا عنه سابقا أنه من الضروري أن يكون كونيا وشموليا حيث أن المستمع هنا لم يصبح شخصا مهمشا كما في السابق بل سيأخذ المركزية في نظرية الحجاج البيرلمانية ومن هنا نلحظ أن << المستمع بطريقة مُجْدِيَّةٍ لبلورة نظرية في الحجاج، فينبغي تصوره بوصفه مجموع من يريد الخطيب أن يؤثر فيهم بحجاجه. >> [17]، ومن هنا أصبحنا نتسائل عن غاية أو هدف الحجاج الذي ثم جعله في السابق يعتمد على طريقة استنباطية ينطلق من مقدمات معينة للوصول إلى نتائج جزئية معينة، لهذا ينتقد وبشدة بيرلمان هذا التصور ويعتبر أنه << ما دام أن هدف الحجاج ليس إستنباط النتائج من مقدمات معينة وإنما إحداث تصديق مُسْتَمَعٍ ما للدعاوى المعروضة عليه وتقويته >> [18]، هذا التحول من اعتبار الحجاج ينطلق من مقدمات ليصل إلى النتائج، إلى أن تصبح الغاية هي إحداث تصديق لدى المستمع الكوني أو استمالة الأذهان للدعوى التي تعرض عليه بغرض إحداث الإقناع لا التيقين يشكل ثورة عميقة في مجال الحجاج.
لهذا سيضيف أيضًا أنه << ما دام الحجاج يَتَغَيَّا التأثير في مُسْتَمَعٍ ما وتعديل قناعاته أو استعداداته بواسطة خطاب ما يوجه إليه ويسعى إلى كسب تصديق العقول بدل فرض الإرادة بالإكراه أو بالترويض >>.
على سبيل الختم:
شكل هذا المقال معالجة ومقاربة لإشكالية تحول الخطاب في الإمبراطورية الخطابية لشايم بيرلمان، هذا التحول يجب على كل قارئ مراعاته، ذلك أن عدم مراعاة هذا التحول/ التمفصل، قد يسقط القارئ في تأويل مغلوط أو فهم مخطوء لنظرية الحجاج البرلمانية، والتي تتأسس على أن الخطاب الغاية منه هو استمالة الأذهان وحدوث الإقناع، كما لا يريد الحقيقة بل يطلب شبيه الحقيقة الذي نأمل منه ثقة مفترضة لا ثقة مطلقة، ولعل هذا ما يعاب على كل من سقراط وأفلاطون اللذان نزعا نحو الحقيقة، حيث نلحظه يختم سقراط حديثه مع كاليكليس في محاورة “جورجياس” بالقول: << إن إتفاقنا إذن، يُثْبِتُ فعلاً أننا أدركنا الحقيقة >> [19]، وهذا ما يثير لنا إشكالاً آخر يبقى مفتوحاً هذه المرة، والمتمثل في هل يشكل اتفاق الخطيب مع المستمع تعبيراً عن الحقيقة ؟
_____
البيبليوغرافيا:
[1]-[2]أوليفيي روبول، مدخل إلى الخطابة، ترجمة رضوان العصبة، مراجعة: د. حسان الباهي، أفريقيا الشرق-المغرب، ص 227-230.
[3]- Chaïm perelman, L’empire rhétorique. Rhétorique et argumentation. Deuxième édition argumenté d’un indéx by Chaïm perelman. Librairie Philosophique. J.VRIN, Paris, 2002, p 48.
[4] -أنظر الترجمة العربية:
شاييم بيرلمان، الإمبراطوريَّة الخَطابِيَّة صناعة الخطابة والحجاج، ترجمة وتقديم وتعليق: د. الحسين بنوهاشم، دار الكتاب الجديد المتحدة 2022، الطبعة الأولى كانون الثاني/يناير 2022، ص 67.
[5]- Ibid, La même page.
[6]- Ibid, p 50.
[7] نفس المرجع السابق، ص 85.
[8] نفس المرجع السابق، ص 88.
[9] نفس المرجع السابق، ص 91.
[10] نفس المرجع السابق، ص 75.
[11] نفس المرجع السابق، ص 70.
[12] نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.
[13] Epictéte, Entretiens, L. II. XXII, 14, dans Les Stoïciens, traduction française, E. Bréhier, << La Pléiade >>, p 950.
[14] C. R. Weaver, << Language is sermonic >>, in R. Johannesen, Contemparary theories of Rhetorie, New York, Harper and Row, 1970, p. 173.
[15] نفس المرجع السابق، ص 97.
[16] Quintiline, De l’institution oratoire, vol, I , livre II, Chapitre. XX, p 489.
[17] نفس المرجع السابق، ص 84.
[18] نفس المرجع السابق، ص 79.
[19] Platon, Gorgias, partie 487 d – e, traduction française, Croiset et Bodin, ŒUVRES COMPLÈTES, Paris, Collection des Universités de France, 1923, t, III.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.