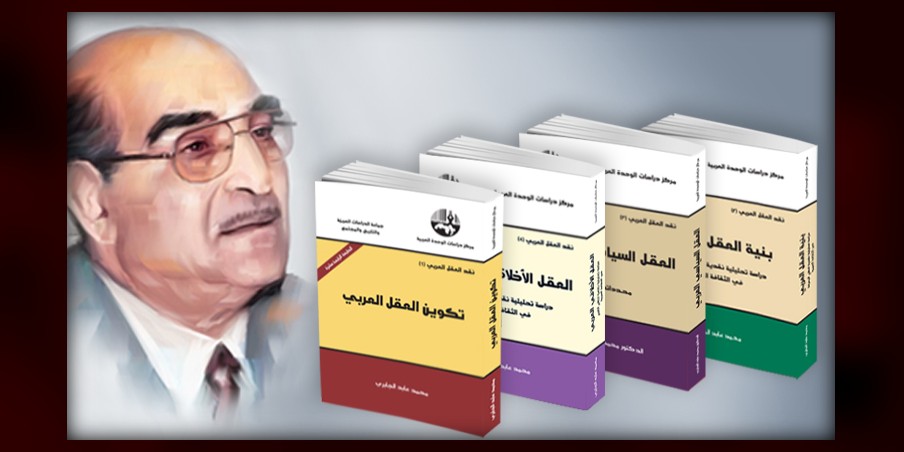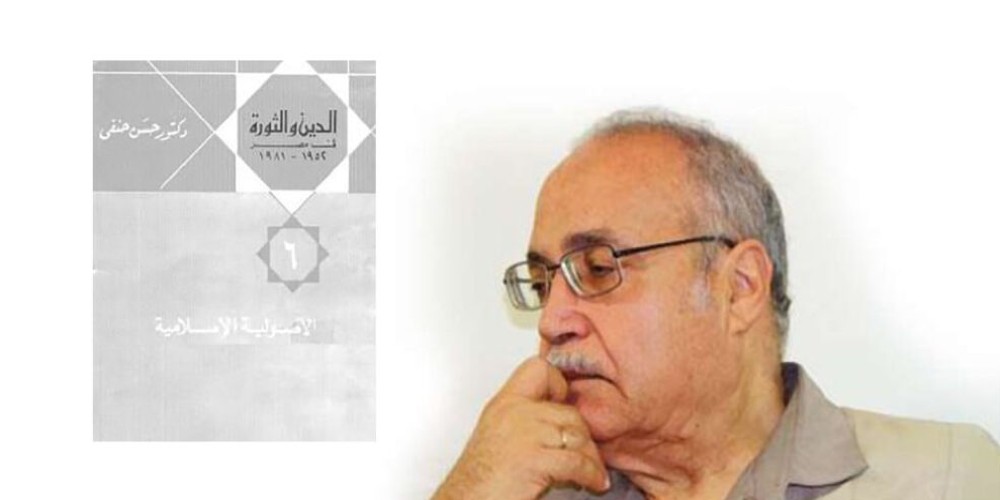محاولات في تجديد التفكير الديني: صراع التَّأويلات داخل التراث الديني

1. في البحث عن ملامح عقل معاصر داخل اللغة :
الإيمان من أجل الفهم أو الفهم من أجل الإيمان، تلك هي المعضلة التي أرقَّت الهرمنوتيقا الدينية في بحثها المتواصل من أجل الخروج من هذه الشرنقة. إنها دائرة تأويلية مغلقة، فالإيمان بالمعنى القديم أصبح شيئا غير مقبول في هذا العصر الذي شهد الزلزلة التي أحدثها فلاسفة الشك: ماركس ونيتشه وفرويد.
لقد أصبح التأويل يتيح لنا فهم كيفية الانتقال من حالة التدين الساذج إلى حالة الإلحاد، ثم من حالة الإلحاد إلى حالة الإيمان اليقظ والذكي، والحديث للكلمة. إننا نعثر في تراثنا على محاولات جنينية للخروج من الدائرة التأويلية المغلقة وذلك بالسعي إلى تأسيس الإيمان على المعرفة والنظر البداية كانت مع الجهم بن صفوان (ت 128 ه) الذي يعرف الإيمان بأنه معرفة، ثم جاء المعتزلة من بعده ليؤسسوا الإيمان على النظر فقد ورد في الجملة الأولى التي يبتدئ بها كتاب ” شرح الأصول الخمسة”: ” إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل: النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى، لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة، فيجب أن نعرفه بالتفكير والنظر ” (عبد الجبار بن أحمد الهمذاني – القاضي-، شرح الأصول الخمسة، تحقيق عبدالكريم عثمان، ط 1، القاهرة، 1965، ص 39).
إن تجسير العلاقة بين العقل والدين أو بين الحكمة والشّريعة لتجاوز تلك الثُنائيات ـ على ما في هذا التقسيم مىيتوس/ لوغوس أو عقل / نقل من مغالطات ـ سيجد دعامته الصلبة في اللغة بآعتبارها الرحم التّي ستنصهر فيها هذه الإشكاليات بحيث تصبح اللغة عامل تشبيك وتنافذ بينها. وهنا تكتسي نظريّة خلق القرآن أهميتها باعتبارها تكرّس النصّ القرآني وحيا قد أُلقي في لغة بشريّة قابلة للتعقّل والفهم. فالخلق المتّصل بالقرآن لا يمسّ مصدره الالهي ولا قداسته ولا يعني خضوعه للتغيير والتبديل. فالقرآن مدوّنة رسميّة مغلقة ومنفتح( 1)un corpus officielوclos et ouvert وإنّما الذي يصيب النص القرآني هو ما يستطيع العقل البشري استنباطه من مدلولات جديدة تقتضيها الشروط الحضارية للكائن البشري. فالقراءة ـ قراءة النصّ المؤسّس ـ هي إستنطاقأ واع باللحظة التاريخيّة لدلالة النصّ ومتمكّنة من مكوّناته ومستوياته الدلاليّة.
إنّ العقل الفلسفي ضمن تاريخه الطويل منذ اليونان إلى اليوم كانت له ثلاثة تجلّيات وذلك في محطّات تاريخيّة فارقة:التجلّي الأوّل كان للعقل – الجوهر وهو العقل اليوناني الذي امتدّ إلى القرون الوسطى وكان له تأثير كبير في لاهوت الأديان التوحيديّة الثلاثة. هو عقل لا يفكر بل يعقل ما هو كائن كما هو كائن ونوع الحقيقة الذي يقدّمه هو الحقيقة المطابقة،مطابقة الحكم للشيء.فما كان لليونان ولمن جاء بعدهم أن يعقلوا إلاّ داخل براديغم الكينونة وأفضل ما يفهمونه من ماهية شيء أو كائن ما، هو حدّ جوهره وصفته وأحواله. التجلّي الثّاني هو العقل – الذات وهو عقل له ماهية وعي هو العقل الحديث وهو لا يعقل بل يفكّر في ما هو متمثّل بوصفه متمثّلا ونوع الحقيقة الذي يثق به هو الحقيقة الموضوعيّة :تمثّل الكائن الخارجي بوصفه موضوعا للذهن.فما كان للمحدثين أن يتمثّلوا أيّ موضوع إلاّ داخل براديغم الذّات وأفضل ما يمكنهم تمثّله هو صورة موضوع ما في الذّهن البشري.
التجلي الثالث هو العقل- اللغة أو العقل الذي له ماهية علامة أو نصّ أو فعل كلامي وهو العقل المعاصر، وهو عقل لا يعقل ولا يفكّر بل يحلّل لغة الكائن الذي يدرسه أو يؤوّل لغة القائل الذي يخاطبه ونوع الحقيقة الذي يتبنّاه هو الحقيقة ـ الفعل القولي. فما كان للمعاصرين أن يتحقّقوا من معنى كائن ما أو وعي ما أو قول ما إلاّ متى تمّ تحليل أو تأويل اللغة أو الخطاب أو النصّ أو الفعل الكلامي الذي يصدر عنه أو في نطاقه(2)
إنّ هذا التجلّي الأخير للعقل يتيح لنا إمكانية البحث عن عقل يجد موقعه في اللغة وهو ما سيمكّننا من إعادة قراءة نصوصنا التأسيسيّة باعتبارها نتاج حضارة مارست المنعرج اللغوي،فقد ظللنا دوما في نطاق عقل لغوي عميق. فكلّ تفكير العرب في كلّ المجالات كان صادرا عن نوع مبكّر من الوعي بأهميّة اللغة ـ وإن كان وعيا كمونيّا غير مفكّر فيه ـ إنّه ذاك الذي يرفع الكلمة إلى رتبة الكينونة(3)
تتخّذ الكلمة في النصوص المؤسّسة للأديان الكبرى مثل البهاقفادا جيتا والتوراة والأناجيل والقرآن أهميّة خاصّة لأنّها- وهي المضمّخة بالبعد الأنطولوجي والمتعالي – تكتسح الوعي البشري بما لها من هيبة مستمدّة من علوية مصدرها ومن تمثّل المؤمنين لها على ذلك الأساس. والمفارقة في هذه النصوص هو التوسّل بآليات تحليل الخطاب البشري المدنّس للكشف عمّا في النصّ المقدس من وجوه مباينته وانقطاعه وفرادته(4.)
رغم تلك الهالة القدُسيّة التي تحيط بتلك النصوص وذاك التهيب الذي يصيب المقبل على دراستها، فإنّ اللّسانيات الحديثة بما تمتلكه من آليات ومناهج في قراءة النصوص استطاعت أن تحفر في ذلك التراث الضخم الذي كُتب حول النصوص المؤسسة – أي النصوص الثواني – وتخلع عليها قدسيّة مزيّفة اكتسبتها بفعل التقادم وتفكّكها لتكتشف مثلا أنّ الزّوج عقل – نصّ يؤدّي إلى تكريس الرؤية النصيّة التي تزعم أنّ الاستمداد من النصّ هو استمداد بريء لا يتدخّل فيه العقل الإنساني إلاّ بالتلقّي والفهم،و هو زعم لم يعد يصمد اليوم أمام الأبحاث اللسانية التي تؤكّد أنّ كلّ عمليّة فهم هي تأويل يتزاوج فيه تفكيك النصّ مع إعادة تركيبه للتمكّن من استيعابه.فالاستمداد من النصّ هو أيضا عمليّة عقليّة ينبغي أن تُبحث آلياتها حتّى لا تبقى متخفية تتستّر بشرعيّة النصّ.كما أنّ العكس صحيح أيضا،فكلّ تفكير عقلي لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن نصّ وخطاب ولغة.الأوّل يقدّم مادّة للتفكير (النصّ) والثاني يحدّد الاختيارات الإيديولوجية( الخطاب) والثالثة ترسم الأطر والقوالب الذهنيّة(اللغة(5).(
لقد كشفت اللسانيات الحديثة أنّ فعل القراءة بما هي تفكيك للنصّ وإعادة بنائه تتحكّم به ثلاثة مقوّمات: المقوّم الأوّل النصّ موضوع القراءة وقدرته على توليد المعنى واستنبات الدلالة بغنائه وثرائه، المقوّم الثّاني القارئ – فاعل القراءة -بما يحمله من خلفيّة فكريّة وزاد معرفيّ وما يمتلكه من جهاز مفاهيمي و إلمام بشتّى المناهج،المقوّم الثالث الظرفيّة التاريخيّة والاجتماعيّة التي يُقرأ في سياقها النصّ وهذه الظّرفية تحدّد توجّهات القراءة ومجالاتها وتضبط مسارها وأولوياتها.
2-دور اللغة في إضفاء المشروعية على تعدد التأويلات
لم يقتصر اهتمام اللسانيات بالنصوص الثواني وإنّما وجّهت مناهجها وآلياتها إلى النصوص الكبرى المؤسّسة نفسها وعملت على قراءتها متجاوزة فلسفة اللغة القديمة والتي ترى أنّ الأسماء تحيل مباشرة على الأشياء وأنّ كلّ جملة لها معنى واحد كما تعلن ذلك الفلولوجيا في القرن التاسع عشر حيث أنّ اللغة تشكّل نظاما مطابقا للمعرفة الحقيقيّة والصحيحة فيصبح الفكر محدودا باللغة ومقيّدا بها.
هذا التصوّر قوّضته اللسانيات الحديثة عندما أزاحت البعد التيولوجي لأصل اللغة من اهتماماتها واِعتبرت أنّ اللغة في منشئها في تعود إلى المواضعة يقول ابن جني ( ت 392 ه/1002 م) : ” أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع وإصطلاح لا وحي ولا توقيف ” ( كتاب الخصائص، ج 1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2010،ط 4، ص 43 ).
ثمّ إنّ اللسانيات الحديثة اِنتقدت اللسانيات الشكلية التي لا ترى في اللغة سوى الجانب الحسيّ إذ هي أصوات وحروف ماديّة وتتعامل معها على هذا الأساس. وآعتبرت أنّ النصّ شبكة معجميّة تخفي وراءها نسيجا من المعاني والدلالات تؤسّس لنمط من الوعي والتصوّر.لذلك عملت على الإمساك بالمعنى والدلالة لاسيما إذا كان النصّ المقروء ثريّا بالمجاز والإستعارة والرموز. وأدركت أنّ الدلالة تقع في مستوى العلاقات بين الوحدات المكوِّنة للنصّ في كلِّيته(6).
لقد كانت التفاسير فضاءا حرص فيه المفسِّرون على توجيه القراءة وِجهة معينة إلا أنّ ذلك لم يمنع من ظهورتأويلات des interprétations للنصّ تُسقط عليه مشاغل العصر ومفاهيمه وتتصارع مع بعضها بعضا،كلّ تأويل يسعى إلى أن تكون له المشروعيّة دون غيره.فكان دور المفسّرين العمل على إثبات اِستمراريّة القراءة وطمس الصراعات التأويليّة بإرجاعها إلى نظام الخطإ والصّواب المستند بدوره إلى تصنيف ثنائيّ :الأرثوذكسيّة / الهرطقات أو الفرقة الناجية / الفرق الضّالة7.
إنّ اِختلاف التفاسير وبالتالي تعدّدِ التأويلات،تدعِّم ما تذهب إليه اللّسانيات الحديثة من أنّ وراء كلّ تأويل لمؤوّل ما تقف خلفيات فكريّة واِنتماءات عقائديّة وكذلك ظرفيّة تاريخيّة واِجتماعيّة أحاطت بذلك التّأويل.
فالكتب المقدّسة بحكم اِزدواجيتها فهي من ناحية قابلة للتعظيم والتقديس وهي من ناحية أخرى أسفار تُباع وتُشترى وتُتبادل،تظلُّ دوما خاضعة لأشدّ القراءات اِختلافا عبر الزمان والمكان و حسب مستويات الثقافة واِهتمامات القُرّاء التاريخيّة أو الفنيّة أو الجماليّة أو المذهبية. (8)
تظلّ تلك الكتب دوما في نهم شديد إلى قراءات لا تستوفي كوامنها .إذ هي نصوص روحها الجوع على حدّ عبارة أديبنا محمود المسعدي. فرغم سعي القدماء إلى وضع مقاييس صارمة لتمييز القراءة الملائمة من غير الملائمة إلاّ أنّ ذلك لم يحُدّ من نُزوع القراءات إلى التنوّع والاِختلاف في تناول تلك النصوص ومقاربتها.وهناك يتعيّن الاِنتباه إلى التفاعل الجدلي بين العناصر الأربعة التي هي أطراف في القراءة: أي النصّ وle passé sémantique للقارئ والمجتمع والموروث الدلالي الذي يحمل أثر اللقاء بين أصالة رسالة الكتاب وكلّ ما يكوّن الإنسان في المجتمع: تطلّعاته الدينيّة وأحواله الاِجتماعيّة ومختلف السلط (9).
إنّ النصّ وفي تجلّيه المادي يظلّ موجودا بالقوّة والقراءة هي الوسيلة الوحيدة التي تنتقل به إلى الوجود بالفعل،فالنصّ لا وجود له مالم يقرأ. مماّ يعني أنّ كلّ قارئ يعيد كتابة النصّ بواسطة شبكة الإدراك وقواعد التّأويل. هذه الشبكة وتلك القواعد مرتبطة هي نفسُها،ليس فقط بالتقاليد الثقافيّة التي ينتمي اليها كلّ قارئ ولكن أيضا بالإكراهات الايديولوجيّة لجماعته ولزمنه وهذا يطرح مشكلة إسقاط الأفكار والمفاهيم والتمثّلات على النصّ. هكذا يمكن أن نفسر حجم التضخّم الدلالي والرمز ي والإيديولوجي الذي يُصيب النصّ القرآني أو التوراتي أو الإنجيلي عند اِلتحامه بالتاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي شديد التنوّع والتغيّر(10)
إنّ اللسانيات في مناهجها الباحثة على الإمساك بالدلالة والمعنى، قد أولت عناية فائقة للعناصر المعنيّة بفعل القراءة وذلك حتّى لا تسقط في القراءة الحرفيّة والبحث العبثيّ عن المعنى الأخير للنصّ ولا سيما تلك “القراءات” التي تتماهى مع النصّ المقروء حدّ التلبّس به.فتدّعي باطلا أحقّيتها في تملّك معانيه ثمّ تُعلي من شأن ذاك الفهم إلى مستوى الحقيقة المطلقة والوحيدة. وذاك ما فعله الخوارج – أوّل حزب سياسي في الإسلام – حين رفعوا شعار “لا حُكم إلاّ لله” المستمدّ من القرآن وتمسّكوا بقراءة حرفيّة له تتمثّل في أنّ الله وحده يحكم في المنازعات الدمويّة التي مزّقت الأمّة وليس البشر وفي نظرهم أنّ الله قد قضى في أمر معاوية فهو يُمثّل الفئة الباغية و بالتالي لا مناص من محاربتهم ولم يكن ينبغي وقف المعارك – أي حرب صفّين – فأصبح شعار” لا حُكم إلاّ لله” يعني أنّ الحُكم للسّيف. هذه القراءة المتشدّدة ستوغل بأصحابها شيئا فشيئا في أشدّ التوجهات عُنفا وأكثرها تطرّفا. فهم سيقطعون مع عليّ ابن أبي طالب كليّا ومع أتباعه من سُكّان الكوفة والبصرة وسيعُدّون خروجهم إلى حروراء شبيها بخروج الرسول صلّى الله عليه وسلّم من مكّة بآتّجاه المدينة وما سينجرّ عن ذلك من اِعتبار أنّهم الوحيدون الملمّون بالحقيقة فكأنّهم المسلمون الصحيحون الوحيدون ممّا سيؤول الامر بهم إلى توجيه تهمة الكفر إلى كلّ الآخرين ثمّ سيصبح رفض التحكيم – بالرّغم من أنّ اللّجوء إلى التحكيم لحلّ النزاعات يدلّ على قدرة الأمّة على اِستنفار كلّ كوامن ثقافتها الأنتربولجيّة والسياسيّة والدينيّة لكي تضُخّ لُبّا وعقلا في السياسة والحرب. (آنظر :د.هشام جعيّط، الفتنة جدليّة الدين والسياسة في الإسلام المُبكّر، دار الطليعة – بيروت،د.ت ص 222)- سيصبح عند الخوارج عقيدة تفصل المؤمنين الحقيقيين عن كلّ المسلمين الآخرين المطروحين الآن بوصفهم كُفّارا توجّبت عليهم التوبة.لقد حاول الخوارج فرض تصوّرهم ومُصادرة كلّ معنى الإسلام لصالحهم. إنّها دكتاتورية الأقليّة مغترّة بحقيقتها تعمل على فرض تفسيرها على الجميع.
ذاك نموذج من القراءات الحرفيّة التي صاحبت الإسلام في بداياته وما خلّفته من آثار سلبيّة على مستوى الوعي والتفكير مازالت تفعل فعلها إلى اليوم.لقد كبّلت الفكر وفرضت عليه كوابح تحُدّ من انطلاقته ففرضت هيمنة النّسق العقدي في صياغة المفاهيم وبناء التصوّرات. وهذا ما دفع باللسانيات إلى أن تأخُذ على عاتقها مهمّة تحرير الوعي البشري من كلّ ما يصادر حقّه في الحصول على معنًى يستجيب لمقتضيات المعقوليّة الحديثة بعيدا عن كلّ الإكراهات الإيديولوجية والتيولوجيّة التي تعمل دوما على تدجين المعنى وتجييره لصالحها.
________
الهوامش والتعليقات
1- Mohamed Arkoun،Lectures du Coran، ed maisonneuve et larose، Paris،1982،p43.
المدوّنة الرسميّة إشارة إلى أنّ جمع القرآن قد تمّ بإذن من الخليفة الثالث عثمان ابن عثمان رضي الله عنه وهي مغلقة أي لا يمكن أن نضيف إليها أيّة لفظة وهي منفتحة على كلّ السياقات التي تفترضها كلّ قراءة.
2-انظر د. فتحي المسكيني،”الهرمنوطيقا فلسفة عوّضت أسئلة التفكير بأسئلة الفهم “، مجلة قضايا إسلاميّة معاصرة،بغداد،السنة 18 العدد 57-58،شتاء-ربيع 2014 ص
3-ن.م ص20
4-حمّادي صمّود،من تجلّيات الخطاب البلاغي،تونس 1993،ص37
5-د.محمّد الحدّاد،‹تعقّل العقل في التراث الإسلامي› مجلّة دراسات عربية العدد5-6، السنة 34،بيروت،آذار-نيسان،مارس-أفريل1998،ص
6-Romdhane ben romdhane،Les apports de Mohamed Arkoun aux études islamiques d après son livre lectures du Coran،mémoire de master sous la direction de m.mohamed cherif ferjani faculté des Langues،université des Lumières lyon2،2001، thèse dactilgraphiée.
7-عبد المجيد الشرفي،لبنات،دار الجنوب،تونس 1994،ط1،ص107.
8-ن.م صص 102-103.
voir aussi، Gric،Ces écritures qui nous questionnent،Paris centurion،
1987،pp23-33.
9-عبد المجيد الشرفي، لبنات، ص110.
10-voir M ohamed Arkoun،Lectures du Coran،ed Alif،(Paris،1991 préface de la deuxième édition p.vi
___________
*رمضان بن رمضان: باحث في الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.