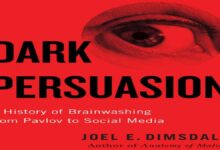في هذه السرديَّة التي فاجأت الكثيرين حول العالم نطالع مأساةً دراميَّةً؛ يُقتل فيها أربعة أشقاء في المجتمع الفرنسي؛ يُمثِّلون مَقولة “الآخر” لدى الضمير الثابت الراسخ داخل هذا المجتمع. قُتلوا مُرسلِين إرهاصات حرب أعظم، وربيع من الغضب سيحلُّ على فرنسا عن قريب؛ يتنبئ به صنَّاع الفيلم، ويحذرون منه مجتمعهم. هذا ما أثَّر في قلوب المشاهدين؛ أمَّا ما أسر عيونهم، فهُما الملحمتان البصرية والصوتية اللتان أتى بهما الفيلم، مؤكِّدًا على بلوغ التصوير درجةً من النضج، ترهص بتفوق مُذهل. ففيلمنا استطاع الجمع بين الإرهاص بالتأخر والحرب، والإرهاص بتقدُّم التصوير والفن البصريّ؛ وهكذا الحياة وبضدها تتمايز الأشياء!
فيلم “أثينا” (Athena) الذي شهد النور أوَّل مرة في مهرجان “البندقية” 2022؛ قد ألَّفه بالاشتراك وأخرجه منفردًا رومان جافراس. ومَن شاركه في التأليف هو لادج لي صاحب الفيلم القوي “البؤساء” الذي صدر في 2019 (كتبت عن الفيلم في حينه تحت عنوان “البؤساء .. هكذا يُصنع العنف في الأُمم”). والفيلمانِ يتناولانِ الموضوع نفسه وهي قضية المواجهة التي تتخذ منحى العنف بين طبقات كثيفة من المجتمع الفرنسي؛ الذي يَرفع شعار “الأنا”، وبين المسلمين الأفارقة والعرب القاطنين للأراضي الفرنسية؛ الذين يُرفع شعار “الآخر” حيالهم.
–قصة فيلم أثينا
يدور فيلم أثينا حول حادثة مقتل طفل يدعى “إدير”، على يد ثلاثة أفراد من الشرطة؛ كما بُثَّ في مقطع مُصوَّر. تم تقييد الطفل البالغ ثلاث عشرة سنة وضربه حتى الموت، وتصوير عملية الضرب من بعيد؛ بحيث تظهر وكأنها تصوير مُستتر مُسرَّب إلى وسائل الإعلام.
الطفل فرنسي من أصول عربية، وهو مسلم. يقطن مجتمعًا صغيرًا مُتخيَّلًا -أيْ ليس موجودًا في باريس الحقيقية- يدعى “أثنيا”، يعيش فيه المنبوذون من المجتمع، هؤلاء “البؤساء” -كما وصفهم الفيلم السابق- من المسلمين أفارقةً وعربًا. تحطم هذه الحادثة سدًّا لتتفجر أنهار من الغضب في وجه الجميع؛ ونعرف أنها لم تكن الحادثة الأولى بل هي الثالثة من الحوادث الوحشية التي تقوم بها الشرطة الفرنسية حيال المجتمع الأثيني في وقت قصير.
ويدور الفيلم فيما بعد الحادثة؛ راصدًا تداعياتها في إحداث ثورة من الشباب المُسلم ذوي الأصول المختلفة، في محاولة منهم لمعرفة الجُناة من الشرطة الذين أقدموا على هذا الفعل الشنيع. ومن ضمن هؤلاء الأشقاء الثلاثة للطفل الصغير: عبدل، وكريم، ومختار؛ كلٌّ في طريقه يمضي؛ صانعين اشتباكات درامية على خطوط الأحداث، كاشفين من خلالها الكثير من خبايا النفوس التي تعيش في هذا المجتمع، وصورة المجتمع الكبير لديهم وفي نظرهم.

–علامَ اعتمد بناء فيلم أثينا؟
اعتمد الفيلم في بنائه على الوحدة العُضويَّة للمَشاهد (أمر “شبيه” بوحدة الأبيات في الشعر)؛ ولا أقصد هنا إلا أنَّ كل مشهد صار مُحمَّلًا بمعنى عامّ كُليّ أو بعدد من المعاني، لا مُكملًا لأجزاء المعاني التي تعتمد على بقية المشاهد. وليس أدلَّ على هذا من أن أول ثلث ساعة في الفيلم ترسمها ثلاثة مشاهد؛ حيث حمل المشهد الأول ما يتعلق بالجانب الأول من الحرب “الثوار” ودوافعهم، ومشاعرهم، وسلوكهم الذي ينبئ عن كثير من خلفيات الأحداث بمجرد مطالعته. وحمل المشهد الثاني ما يتعلق بالجانب الآخر وهم الشرطة؛ في وجهتَيْن: الأولى وجهة القائد الشرطيّ الذي يتحدث بكل جدية وحسم، وهو صاحب توجُّه في المعركة، يريد حسمها في أقرب وقت، ويأمر بالاقتحام والالتحام في المساء، لإنهاء العملية، مُحذِّرًا الشرطيين من احتمال امتلاك الشباب الثائرين لأسلحة. وعلى الجانب الآخر نجد الشرطي -سيأتي ذكره منفردًا-.
وفي المشهد الثالث نطالع شخصية مختار وما يتعلق به. وإذا استمرَّ بحثنا نجد الرابع وهو من أبرز المشاهد، يدور في المسجد؛ حيث كثير من المسلمين يشاورون إمام المسجد في أمر ما يحدث، ويعرض علينا المشهد اختلاف الآراء وتنوُّعات الموجودين في وجهات نظرهم: من لائِم على الشباب ثورتهم رافض لها، وآخرون يحمِّلون “عبدل” مسئولية ما حدث… وهكذا نرى كلَّ مشهد أضاف وحده معنى كاملًا أو عدة معانٍ.
كما اعتمد بناء الفيلم على مركزية الشخصيات. وكان أبرزهم الأشقاء الأربعة: “إدير” وهو الطفل البريء الذي قامت على حادثته أعمدة الفيلم، والثاني هو “عبدل” ضابط الجيش الفرنسي، الذي يقوم بشخصية الأخ العاقل المُتفاهم المُتفاعل مع مجتمعه، والذي من صعيد آخر يُتَّهم من مجتمع المسلمين أنه حركيّ عميل، باع نفسه للجيش الفرنسي. والثالث “كريم” الثائر الغاضب الأصغر سنًّا الذي في طور براءته في رؤية الأمور، التي توحي له إيحاءً العُنف والتحرك الحاسم تجاه المُعتدين، وقد سئم كريم فكرة التبريرات المُجتمعية، وانتظار ردود الفعل المتأخرة وغير المُجدية التي لن تسفر عن أي تحرُّك سوى تجاهل آثار ما حدث. والرابع “مُختار” وهو الأكبر سنًّا، الشخص النفعيّ والأخ الفاسد؛ الذي عرف واستسلم لمبدأ تجاهل المجتمع له، فانصرف إلى نفعه الشخصي الذي رآه في تجارة المخدرات، بالتعاون مع بعض الفاسدين في الشرطة الفرنسية.
ونطالع أيضًا شخصية الشرطي الفرنسي الذي يمثل طوائف الشعب المعتدلة في نظرتهم للآخر؛ الذي يقف مدهوشًا ما الذي يحدث في بلده! ونراه يتفاجأ بالأحداث وتصرفات الثوار وكأنه يُسائلهم عن الدافع، وكأنه يُسائل نفسه عن سبب وجوده في قلب هذه المعركة، وهو يريد البقاء مع ابنته التي تصبغ أظافره بالطلاء وهو نائم مُلاعِبةً إيَّاه. ونراه هاربًا من المعركة التي لا يريدها، ونراه يذهل من قسوة زملائه وهُم يضربون الشباب الثائر بالعصي ويرشون عليهم رذاذ الفُلفل الحارق لعيونهم؛ وكأنه يستلهم منهم الشجاعة، ثم يضرب ضربة خائبة، ولا يجد له مبررًا فيهرع هاربًا مما يفعلون.
وأخيرًا نطالع شخصية سباستيان؛ وهي شخصية مُشكِلة (أيْ ذات إشكالات، وغير واضحة كبقية الشخصيات). سباستيان لا نعرف عنه الكثير، بل لا نعرف عنه شيئًا. تحذِّر منه نشرات الأخبار في المشهد الثاني بوصفه مطلوبًا من الشرطة، ونرى إمام المسجد يوصي بعزله لأنه تهديد. اسمه مسيحي، يتخفَّى في مجتمع أثينا الصغير، تكوينه فرنسي ذو ملامح وبشرة غربية صرفة. يلبس ملابس المسلمين (جلبابًا وطاقية)، ومُلتحٍ. يعرف الجميع بأمره، وواضح أنهم يتسترون عليه. وهو غير مُنشغل بشيء غير الحديقة الصغيرة. في أول ظهوره بدا؛ وكأنه معتوه سفيه مَسُوق من غيره، يطلب في وسط هذه المعمعة العارمة عصيرًا للأطفال.
لكنْ سرعان ما يتحوَّل إلى وحش حقيقيّ، وهو الذي يفجِّر المبنى في النهاية قاضيًا على آخر الأشقاء الأربعة. وفي مظهره الإسلامي، واسمه المسيحي رسالة من المخرج وصناع الفيلم أن الإرهاب الذي يريد النيل من الجميع لا دين له، ولا اسم له؛ بل قد يكون اسمه سباستيان، وقد يلبس جلباب المسلمين؛ لكنَّه مجنون هادم لكل كيان.
ولعلَّ المخرج اعتمد على حدث رئيس في التحوُّل الأكبر للفيلم؛ حيث البطل الرئيس للفيلم هو “عبدل”، ونقطة التحوُّل في الفيلم هي قتل الشرطة لـ”كريم”. وعندها نجد مسار الأحداث تغيَّر كُليَّةً؛ فقتل “عبدل” أخاه “مختار”، وتحوَّلَ من اللاعنف إلى العنف الصريح، ثم إلى العنف الشاكِّ في اختياره، وصراعه بين أصله الطيب وما يمكن أن تتحوَّل له الشخصيات تحت ضغط الواقع المرير. وهذا معنى رئيس يريد إيصاله الفيلم.

–سر تسمية الفيلم بأثينا
هنا قد يقف المُشاهد ليسأل: لماذا سُمِّي الفيلم بهذا الاسم المبتعد عن الواقع الباريسيّ؟ وهو سؤال منطقي تمامًا. وقد سبَّب المُخرج اختياره للفيلم بتأثُّره طوال حياته بالمأساة اليونانية، وطريقة سردها للأحداث. ولهذا أراد أن يُحاكيها صوريًّا في المشاهد الطويلة التي تعطي المشاهدين فرصة التفاعُل مع الشخصيات وما يحدث.
وعن نفسي ذكَّرتني أجواء الفيلم؛ خاصةً الأصوات الإنسانية التي تطلق الآهات بمسرحيات الكاتب التراجيدي العظيم “إيسخيلوس”، خاصةً مسرحيتَيْ: المُستجيرات، والفُرس. حيث نجد هذه الرُّوح النائحة على ما يحدث في الأولى، وفي الأخيرة يظهر الاستعداء بين جانبين متحاربين؛ أحدهما من الغرب (اليونان قديمًا، والضمير الغربي حديثًا) والآخر من الشرق (الفُرس قديمًا، والمسلمون من أصول مختلفة حديثًا). وكلا الأخيرَيْنِ يمثل تحديًّا حضاريًّا في الضمير الغربي.
ولعلي أرى أن هناك تشابهًا آخر في تسبيبي الشخصي للعنوان وهو طبيعة المجتمع الأثيني؛ حيث كان مجتمع أثينا طبقيًّا، يُفرِّق بين الناس ابتداءً؛ وهي الحال التي نراها بيِّنةً واضحةً كل الوضوح في هذا المجتمع الفرنسيّ. كما كان لدى المجتمع الأثيني (والضمير الغربيّ طوال العصور) فكرة “البرابرة” هؤلاء الهمج المتوحشين الذين يطمعون فينا، ويريدون أن يقضوا علينا؛ لذا يجب أن نقيم بيننا سورًا حتى نمنعهم من التوغُّل إلينا. والأمر واضح للعيان لا يحتاج لشرح.

–فلسفة التصوير في فيلم أثينا
من عناصر تفرُّد فيلم أثينا؛ اعتمادُه فلسفةً واضحةً لخصَّها المُخرج في مُحاكاة المأساة اليونانية القديمة في صناعة مشاهد طويلة ممتدة داخليًّا، ومتصلة مع المشاهد السابقة واللاحقة بها؛ وكأنك ترى مشهدًا مطوَّلًا للغاية. اختيار هذا النوع من “سيولة المشهد والتصوير فيه” يوفِّر للفيلم ظهيرًا معنويًّا بارزًا؛ وهو سرعة نفوذ التأثير إلى نفس المُشاهد، الذي يرى كل ما في الفيلم وكأنه دفعة واحدة تخترق نفسه وعقله. وبهذا يؤثر بشدة فيمَن يشاهد، ويضمن تفاعله مع ما يطرحه.
لكن هذه الفلسفة للتصوير ستكلِّف الفريق غاليًا؛ لتنفيذها كان عليهم اعتماد تقنية “اللقطة الواحدة” (One Shot)، وعدم اللجوء إلى القطع في الشريط إلا نادرًا وفي حال الضرورة القصوى. وقد تم الاستقرار على استخدام كاميرات ذات تقنية آيماكس IMAX)) في التصوير؛ حيث صُوِّر بها 80 % من الفيلم -كما صرَّح المخرج-. وهي كاميرات ذات تقنية متقدمة، وذات مُتحسِّسات عملاقة تمتاز برؤية أشدَّ اتساعًا من الكاميرات العادية وثبات ورسوخ أثناء الحركة؛ مما ساعده على إخراج الصورة التي يريدها وهو يصوِّر بين ممرات ضيقة وسلالم ومضائق؛ من حيث جودة الصورة واتساعها وثباتها.
كما أنه اعتمد في تقنية اللقطة الواحدة أسلوب التتبُّع لمحل التصوير؛ سواء في المشاهد الاعتياديَّة أو المشاهد الجماليَّة أو المشاهد الرمزية. فنرى الكاميرا دومًا مُتفاعلةً بالتتبُّع والملاحقة والمحاصرة والدوران والصعود لما تصوره؛ شخصًا أو حدثًا أو شيئًا ثابتًا. وهذا التتبع والملاحقة أفاد بشدة المُشاهد معنويًّا، ووضعه في الأحداث وكأنه مُشارك مع من يجري ويتشابك ويحتد في أثناء الحديث؛ جعل المشاهد جزءًا من الحدث السينمائي إنْ أردنا الدقة -رغم مجازيَّة التعبير-.
وهنا نسوق أهمَّ ما في تطبيق هذه الفلسفة الصعبة القاسية في الفيلم؛ وهو محل التصوير ومكانه. مكان التصوير هو مجتمع أثينا المكوَّن من فناء متسع، وبه أبراج عالية مليئة بممرات ضيقة متصلة، وسلالم دائرية. ولنتخيَّل هنا كم المشقة والمهارة التي تطلبها التصوير المستمرّ في هذه الأماكن. والمشهد يزيد اكتمالًا حينما نضيف محل التصوير؛ وهم عشرات وعشرات من الشباب المحتج من جانب، والشرطة الفرنسية من جانب. وهنا تصل الصعوبة إلى أقصاها؛ حيث احتمال الخطأ كبير، والتحكُّم في هذه الجموع بيِّنُ الصعوبة. وإذا أخطأ أي عنصر أثناء تصوير المشهد وجب على الجميع الإعادة من نقطة البدء أو من أقرب نقطة قطع تحريري (مونتاجي) خفي -والأخير فيه مغامرة أثناء تحرير الفيلم-.
ومن أُسس الفيلم تصويريًا عدم اعتماده على المؤثرات البصرية؛ بل أصرَّ المخرج على تصوير الواقع فقط، كما هو، دون أيَّة وسائل مُساعدة. وهذه نقطة ذكيَّة منه لسببين: حاجته للاقتراب من الواقع المعنوي الذي يصوره؛ ليصنع مُماسَّةً ومُماثلةً بين الشريط والواقع. والسبب الآخر هو أن الأحداث مليئة بقنابل الغاز، والألعاب النارية التي تصنع تلقائيًّا مردودًا بصريًّا مُثرِيًا لا يحتاج بعده إلى مؤثر؛ أيْ أن الفيلم يقدِّم مؤثرات بواقع ما يصوره. وهذا لا يعني عدم المعالجة اللونية في مراحل التحرير بالقطع.
وبالنسبة للظهير الصوتي؛ فقد اعتمد المخرج على جو مُحاكٍ لأجواء أصوات الجوقة (الفرقة المسرحية) التي كانت ذات دور أصيل وحاسم في المسرح القديم؛ بدءًا من اليونان. وهذا أتى تماشيًا مع رُوح المأساة اليونانية التي أراد إيداعها في الشريط كله. ونجد الاستخدام لهذه الأصوات في الأجزاء المفصليَّة في الفيلم. وقد أدخل المخرج أغاني يونانية بلحنها مع الترجمة للفرنسية. مع انضباط مُتماشٍ في مسألة الهندسة الصوتية، وإدخال المؤثرات الصوتية المصاحبة، بأسلوب واقعيّ غير مُبالغ فيه.

–كيف صور المشهد الافتتاحي؟
الكثيرون حول العالم انبهروا بشدة بالمشهد الافتتاحي لفيلم أثينا؛ وقد حقَّ لهم أن ينبهروا به، فهو مشهد خلَّاب آسِر. وتساءل الكثيرون كيف صُوِّر هذا المشهد البديع؟ .. المشهد يتكون من إحدى عشرة دقيقةً؛ فهو مشهد طويل. لكن ما أبهر الجميع هو امتداد المشهد، وعدم ظهور القطع التحريريّ (المُونتاجي) فيه. فكيف حدث هذا؟
المشهد يبدأ من الإظلام التام، بموسيقى دقات آلة البِيان متفرقة الدرجة، وموزعة المساحة الصوتية؛ للإشعار بجو التوتر والقلق وتسريبه إلى نفس المُشاهد؛ ثم دخول متصاعد للأصوات الإنسانية بآهات عميقة مطوَّلة مليئة بالشجن (المُكوِّنة لجو الفيلم الأساس) لتصعيد جو التوتر، ونقل مجرد “الإحساس بالتوتر” إلى النذير بالأهوال القادمة. فالفيلم اعتمد على الظهير الصوتي لبدء الشرارة الأولى، وكانت خطوة موفقة.
ثم يظهر “عبدل” بزيِّه العسكريّ الفرنسي، ومظهره المنكسر الذي يحاول الصمود. يسير طويلًا في ممرات، وصولًا إلى الجماهير. وفور انتهائه من كلمته البسيطة يبدأ الانتقال إلى جانب الثوار الذين حرص المخرج على أن يرتدوا لباسًا أسود ليعلن عن رؤيتهم لمجتمعهم الحاضن، ومدى خطورة ما سيحدث. ثم تبدأ معركة الكاميرا مع معارك الحضارة التي على الأرض.
وهنا يذهل المُشاهد؛ كيف تدخل الكاميرا إلى السيارة التي قادها الثوار، وتخرج منها دون قطع مرئي! الصورة متصلة أمامه بلا قطع فكيف يحدث هذا؟! .. قد تم القطع أكثر من مرة في المشهد؛ خاصة في زوايا الإظلام من الممرات، وأثناء وجود السواتر. لكنَّ تصويره اعتمد على الكاميرا الأساسية في الفيلم طوال المشهد، محمولةً بحامل مخصوص بها لتثبيتها أثناء الحركة العنيفة ولسهولة حملها من المصور الماهر الذي استطاع تجاوز الصعاب بمُعاونة اثنين آخرين، ومصور آخر مثبَّت على مُقدمة دراجة نارية. وأثناء انحراف سيارة الشرطة في منعطف الطريق قام المصورانِ بتبادل حمل الكاميرا؛ لتنتقل إلى الآخر راكب الدراجة.
ومن هنا ابتعدت الكاميرا بكل سلاسة، دون قطع مونتاجي عن السيارة بعيدًا، ثم اقتربت منها مرةً أخرى (وظهرت في زجاج السيارة بالخطأ)، ثم اقترب قائد الدراجة من السيارة المسرعة ليحملها المصور الموجود بالسيارة من قبل، ويتولى هو تتبع الحدث بعدها.
ثم جاء الدور الأخير لمصاحبة شخصية كريم عن طريق إبدال الكاميرا بأخرى محمولة على طائرة مُسيَّرة (درون) تسير بجواره حتى يصل إلى حافة الفناء، وتطير مُنهيةً المشهد الافتتاحي باسم الفيلم محصورًا بين عمودَيْ إضاءة؛ في حال تشبه حال الفريقين المُصطرعين في الفيلم.
صاحَبَ كلَّ هذا وقام على نجاحه قدرةُ الممثلين على التفاعل مع الحدث الثوري؛ صياحهم، وتحرُّكاتهم التشنجيَّة، إطلاقهم الألعاب النارية، إحساسهم الداخلي بالفرحة العارمة للظهور على الشرطة، والعديد منهم يطلق شعار “نحن الشرطة الآن”، استطاعتهم إشعار المُشاهد بلحظة التحقُّق الوجوديّ، بأنهم موجودون على قيد الحياة، ومؤثرون في عالَمهم، وقادرون على التغيير، رُوح الإصرار والتصميم على هدفهم بمعرفة الجُناة للحادثة. كلُّ هذه العوامل التمثيلية قد استطاعت إنجاح المشهد الشاقّ.

–المشاهد الرمزية في فيلم أثينا
هناك مشاهد رمزية أودعها المخرج في بنية فيلم أثينا. ولعل أهمها: لقطة الشباب وهُم في آخر المشهد الافتتاحي على الجسر؛ وللجسر دلالة في التحوُّل بين مصيرين؛ فإلى أيّهما سيمضي الأمر! وامتداد اللقطة بعده في حصر عنوان الفيلم بين عمودَيْ الإضاءة.
ثم الرمزية في تحرُّك الكاميرا؛ حيث تحرَّكت في المشهد الأول (مع الثوار) من الجسر إلى الجهة الأخرى، وفي المشهد الثاني (مع الشرطة) من الجهة الأخرى داخلةً تحت الجسر، وفيها رمزية المواجهة والحرب.
ولقطة سباستيان عندما فجَّر الخزنة مُستخدمًا بطارية لعبة الأطفال التي هشَّمها. والرمزية هنا أن: على حُطام الطفولة يتولَّد العنف والتفجير. وأخيرًا المشهد العبقري؛ بعدما لم تنجح الشرطة في اقتحامها ليلًا، وحُوصر الجنود في منتصف الفناء بشكل يشبه حصان طروادة، وعلى الجانب الآخر حيث دلَّى “كريم” شعره الطويل المربوط؛ فظهر في هيئة تشبه صورة سيدنا “عيسى” -عليه السلام- في المِخيال الغربيّ؛ وكأنه صار مُلهمًا رُوحيًّا للشباب الثائر، ورمزًا للطهارة والخُلُوص. وهو من أبرع المشاهد التي تنذر بالقادم القريب.
–هل كانت وجهة الفيلم محايدة
فيلم أثينا فيلم فرنسي خالص، عن همّ الداخل الفرنسي؛ فهو ليس فيلمًا عربيًّا وإنْ شارك فيه الكثير من العرب؛ وهو ليس فيلمًا عربيًّا وإن تناول أبطالَه العربَ وصدَّرَ بهم المشهدَ العام. إنه فيلم فرنسي مخلص يريد مناقشة خطر حضاريّ مُحدق بالمجتمع الفرنسي. ويحذر من بعض ممارسات الاضطهاد المُمارسة على المسلمين خاصةً في فرنسا، وعلى دور اليمين المتطرف الذي يكتسح أوربا منذ سنوات نجاحًا سياسيًّا.
ويا لها من كلمات أجهز بها مخرج الفيلم على كل ما قد يقال في الأمر؛ حيث يقول عن الفيلم والاتجاهات اليمينية في الغرب: “كان من الممكن أن تحدث أثينا في أي وقت في الماضي أو المستقبل. وراء كل حرب تلاعبٌ، كذبة أصلية. التاريخ يُعيد نفسه، من حرب طروادة إلى الحروب المعاصرة. هناك دائمًا قوى في الظل تغذي الصراع. تدرك هذه القوى أنه عندما يكون الألم الحميم أكبر من اللازم؛ فإن العنف يُعمي التفكير، وعندما تكون الأمة هشةً؛ فمن السهل دفعُها إلى الهاوية”.
________
*عبد المنعم أديب.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.