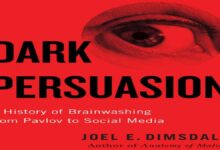ما كنتُ أحسبُ قبل دفنكَ في الثّرَى ** أنّ الكَـــــــــواكِبَ في التّرابِ تَغُورُ
ما كنتُ آمُلُ قَبلَ نَعشِــــــــكَ أن أرَى ** رَضْوَى على أيدي الرّجالِ تَسيرُ
خَرَجُوا بهِ ولكُلّ بـــــــــــاكٍ خَلْفَـــــــــــــهُ ** صَعَقــــاتُ مُوسَى يَوْمَ دُكَّ الطُّورُ
والشّمسُ في كَبِدِ السّماءِ مريضَةٌ ** والأرْضُ واجفَــــــــــةٌ تَكادُ تَمُـــــــورُ
الحديث عن الأحباب الذين فارقونا – رغم ما يمثله ذلك من وفاء وواجب تجاههم – مرهق ومؤلم للنفس جدا؛ ذلك أنه يثير فينا ذكريات لم تهدأ بعد، ويهيج حنينا لم يُطفَأ وما أظن أن جذوته تخبو أو تنطفئ مع مرور الوقت، خاصة إذا كان الراحلان اللذان نتحدث عنهما هما أسامة شفيع ومحمد متولي؛ هذان الشابان المفعمان بالحيوية والنشاط، والممتلئان أملا وإصرارا وسعيا جادا ومخلصا لتبوؤ ذُرَى المجد، حتى إذا أوشكا أن يتربعا على عرشه عن جدارة واستحقاق تخطَّفَهما الموت دون سابق إنذار، فكان الحزن على فقدهما بين الأصدقاء وفي الأوساط العلمية كبيرا وهائلا، وما أحسب إلا أن الله تعالى قد ضَنَّ بأمثالهما أن يعيشا في زمن لم يُخلَقا له؛ زمن طغى فيه الزيف والخداع والتلون وأثقله النفاق والفتن والتحولات، فأراد الله أن يقبضهما على نقائهما وفطرتهما السوية التي لم تُلَوَّثْ ولم تشُبها شائبة.
وهل أبالغ إذا قلت: إننا فقدنا برحيلهما السريع والمباغت نموذجا نادرا من أندر نماذج الإخاء والمحبة في هذا العصر؛ فلم يلبث متولي بعد رحيل صنوه وتوءمه أسامة سوى بضعة أشهر، زهد خلالها في كل شيء تقريبا، وفقد شهيته ورغبته في الحياة، وهو الذي كان يصول ويجول في كل الميادين وتملأ ضحكته الآفاق، فأحس بعد رحيل أسامة بألم الفقد وثقله وعدم قدرته على الاحتمال ومواصلة السير، وراح يتطلع إلى لقاء حبيبه هنالك في السماء؛ حيث أخبر النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أن المتحابين في الله ينعمون باللقاء في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله.
كتب متولي عقب رحيل أسامة على صفحته على الفيس بوك باستفاضة عن علاقته النادرة بصديقه الأثير، التي تشبه علاقة المريد بشيخه وعلاقة الحبيب بحبيبه، وفي هذه السلسلة أفرغ متولي كل ما لديه منذ التقى أسامة إلى أن وَدَّعَه إلى رحاب ربه، وكأنه بذلك أراد أن يبرئ ذمته أمام صديقه من التقصير ويعتذر له عن ضعفه وعجزه التام عن دفع غائلة الموت عنه، وما الذي يستطيع أن يفعله شخص مكلوم هَدَّهُ الوجع وأنهكه الفراق أمام هذا المارد الجبار، الذي يؤدِّب الله به العباد ويقهر كبرياءهم حتى لا تفتنهم الدنيا أو تغرهم قوتهم؟ وها هو ذا يخرج علينا بعد طول غياب ليكتب هذه الكلمات الحزينة التي تعكس أثر غياب أسامة شديد الوطأة على نفسه، كتب يقول: أيها الأعزاء، أيتها العزيزات: السلام عليكم، كيف أحوالكم؟! أرجو أن تكونوا جميعا بخير! أفتقدكم كثيرا، كثيرا والله! وأفتقد نفسي كثيرا أيضا.. تلك النفس التي كانت تحيا بكم، وطالما وجدت سعادتها بينكم! اشتقت أن أكتب هنا كتابة جادة، أو كتابة هزلية فكهة مرحة، وأن أحاوركم وأتلقى تعليقاتكم.. فقد كنت أجد في ذلك سعادة لا تعدلها سعادة.. ثمة شحوب تسلل إلى روحي؛ لأسباب كثيرة، تعلمون بعضا منها، ولا تعلمون بعضا آخر.. فتوقف القلم أو كاد! لكن حنينا جارفا يردني إلى ذلك العهد الجميل، حين أتلقى بعض الرسائل من وقت لآخر، تسأل عني وعن منشوراتي! أنا بخير .. لم أعد أكتب على الفيس، فقد فقدت قدرا كبيرا من الشغف بالكتابة، كما أنني لم أعد أضحك كثيرا، أو لم أعد أضحك على الإطلاق!! هل تعود الحياة كما كانت مرة أخرى أو لا تعود؟! لا أدري.. لكنني بخير والحمد لله.. كل ما في الأمر أنني لم أعد أضحك، ولم أعد أكتب!! دمتم سعداء مبتهجين.. وكل من تحبون! (نُشر هذا المنشور يوم 4 نوفمبر على صفحته قبيل وفاته بنحو شهرين رحمة الله عليه). فهل كان محمد متولي ينعى نفسه بهذه الكلمات دون أن ننتبه نحن لذلك، وهل كان يهيئ نفسه لهذا اللقاء الوشيك؟
وهل أبالغ إذا قلت أيضا: إننا بفقد هذين الشابين الواعدين قد فقدنا نموذجين نادرين في البحث العلمي والأدب والثقافة في مصر، وربما خفتت بعد رحيلهما تطلعاتُ جيل بأكمله كان ينتظر منهما مزيدا من الإنجاز والعطاء، لكن الموت باغتهما واختطفهما وهما في ريعان الشباب وأوج العطاء. لقد كان أسامة ومتولي قدوة لأبناء جيلهما – ليس بما امتازا به من تفوق ومثابرة في تحصيل العلم والمعرفة وحسب – وإنما من خلال سلوكهما وتحلّيهما بأخلاق العلماء وأمانة الباحث ودقته وسبره لأغوار المسائل العلمية، فضلا عما كانا يتحليان به من دماثة خلق وسماحة نفس وشجاعة في قول الحق، ولم يكن المرء ليخطئ هذه الصفات النبيلة فيهما بمجرد حديثه معهما واقترابه منهما رحمة الله عليهما، لست أدري لماذا استخدمتُ هنا صيغة المثنى في وصف جوهر واحد وإن انقسم إلى عنصرين متطابقين أو وجهين لصورة واحدة وأصل واحد، فيكفي أن نتحدث عن أحدهما إذا أردنا أن نصف الآخر، وكأن الحلاج قد عناهما بقوله:
أنا من أهوى ومـــــــــــن أهوى أنا ** نحن روحـان حللنا بدنا
نحن مذ كنا على عهد الهوى ** تُضرَب الأمثالُ للنــاس بنا
فإذا أبصـــــــــــــرتَني أبصــــــــــــــــرتَه ** وإذا أبصـــــــرتَه أبصرتَنا
أيها السائل عن قصـــــــــــــــــــــــــــــتنا ** لو ترانا لم تفــرِّق بيننا
روحُه روحي وروحي روحُــــــــه ** من رأى روحين حلَّت بدنا
لقد كان أسامة أمة وحده ونقطة مضيئة في أبناء جيله جميعا؛ فقد تنوعت مواهبه وتعددت تنوعا عجيبا حتى أنك لَتَحَارُ أين تضعه وكيف تصنِّفه؛ فهو شاعر مطبوع – وإن كان مقلا – يعبر عن مكنون نفسه ويترجم لأفراحه وأتراحه بأسلوب عذب وعفوي وبسيط وخال من التصنع شأنه شأن الشعراء المطبوعين، وهو مترجم فذ أتقن أدواته واستطاع في هذا العمر القصير أن يترجم عددا من الكتب المهمة في الفكر والتصوف والأدب، وقد شهد له بالنبوغ والتفرد في هذا الباب كبار الأساتذة والمترجمين، وتُوِّجت جهوده المباركة بحصوله على جائزة إقليمية كبيرة عن ترجمة كتاب المستشرق الفرنسي رينيه جينو أو عبد الواحد يحيى: الشرق والغرب، وقد قرأتُ له عددا من القصائد التي ترجمها عن الفرنسية غاية في الرقة والعذوبة والإتقان، فهو شاعر يترجم الشعر شعرا ويبث فيه من روحه وإحساسه ووجدانه حتى كأنه هو من نظم هذا الشعر. وهذه بعض نماذج من مقطوعاته الشعرية وترجماته الأخاذة، يقول رحمه الله:
حتَّامَ هجرك والديارُ قريبــةٌ ** والقلبُ من فرْطِ الصبابة دامـــي؟
يا منحةً قد أسفرت في محنةٍ ** يا مهجتي، يا لذتي وهُيامي
لا لا يغركِ أنني متجـــــــــــــلد ** فأنا الغريق تهدنـــــــــــــي آلامي
ويقول:
أفتــش في الأشـعار عن بيـت حـكمــــةٍ ** أُجـلِّـي بـــــــه هـذا الـجـمـال الــمُــدَثَّـرا
فيهتف بي من جانـب القلـــب هاتـفٌ: ** قصاراك في هذي المنازل أن تَرى!
وأعـــــــــــجب أمـري أنـنـــــي عند ذكرهـا ** أُعَــذَّبُ مــشـتـاقًـا، وأَنــــــــــــعـم ذاكــرا!
وهذه مقطوعة من أحب ترجماته إلى قلبه كما كتب على صفحته رحمه الله، وهي بعنوان: لا تقل شيئا، وهي تعبر عن شخصيته أتم ما يكون التعبير؛ فهو مُسلِّم ومنقاد لقلبه ودليله الذي لم يخذله قط تسليم المؤمن بالقضاء والقدر، وأظن أنها من شعر مولانا جلال الدين الرومي وفيها أنفاسه، يقول رحمة الله عليه:
انظر إلى وجهي الكسير، ولا تقل شيئا!
وارقب بعين الرفق آلامي العظامَ، ولا تقل شيئا!
وانظر إلى قلبي المخضب بالدما، وإلى العيون الهاملاتْ،
وإذا مررتَ بما رأيتَ فلا تقل:
لِمَ ذا وكيف، ولا تقل شيئا!
قد جاء أمسِ يزورني طيفكْ
وأقام يطرق باب قلبيَ، قائلا:
أقبلْ، ونَحِّ الباب، لكن..
لا تقل شيئا!
فكتمتُ آهاتٍ تنازعني وأشواقًا..
عضضتُ أناملي..
فأجابني: أمسكْ، ولا تَعْضُضْ يدك
فأنا وليُّك، لا تقل شيئا!
وَلَأَنت مِزماري، فلا تُرسل أنينَك مِن سوى شَفَتيْ
قيثارةٌ أنتَ..
هيهات أبسطُ بالأذى يومًا إليك يَدَيْ
وعن المقدَّر لا تقل شيئا!
قد قلتُ لهْ:
فعلام تأخذ في البلاد فؤادي؟
فأجاب: أين أخذتُه؟
هروِلْ إليَّ، ولا تقل شيئا!
فأجبته:
فإذا سكتُّ فقد أجبتُ دعاكا
وتصير نارًا، والنداءُ نداكا:
ادخل عليَّ، ولا تقل شيئا!
فأصابه ضحكٌ، كأن الزهرَ مَبسِمُه، وقالْ:
ادخل تَرَهْ!
وإذا رأيتَ النار أزهارًا وأوراقًا وزرعا
أمسك لسانك، لا تقل شيئا!
النار أضحت زهرةً تُزجي إليَّ حديثَها:
قالت: عليك برحمة المحبوب والألطاف جدد في النفوس رثيثها
فيما سواها لا تقل شيئا!
كما كان أسامة رحمة الله عليه دارسا متبحرا في التصوف يجيد السباحة بمهارة في هذا الخضم الخطير المترامي الأطراف، الذي قلما ينجو مَنْ أقدم على السباحة فيه بدون استعداد، فقد كان أسامة جاهزا تماما – لا للسباحة فحسب، بل لاستخراج الدر واللآلئ الثمينة – معتمدا في ذلك على عقيدة راسخة وإيمان ثابت، فهو لم يصدر في دراساته وآرائه عن هوى قط؛ بل عن اجتهاد وإعمال للعقل ورجوع دائم للأصلين الثابتين اللذين لا يأتيهما الباطل من بين أيديهما ولا من خلفهما: القرآن الكريم، وسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه الصحيحة، يُعضِّده في ذلك عقلٌ واعٍ مستنير، وفكر رشيد مبصر، قادر على التمييز بين السنة والبدعة، وبين السديد من القول والزائف منه، فهو لا يسير خلف أحدٍ معصوبَ العينين يردد ما يقوله دون مناقشة أو فهم، وكثيرا ما كنتُ أستشيره رحمة الله عليه في بعض المقولات الملبسة التي تنسب إلى أعلام التصوف كابن عربي والحلاج والسهروردي وابن الفارض وغيرهم، فكان يشرحها ويخرجها تخريجات عجيبة أقف أمامها مشدوها ومتعجبا من هذه الملكة العجيبة والقدرة المدهشة والغوص لاستخراج هذه المعاني الدقيقة والنورانية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده يزيد في الخلق ما يشاء!
سألته ذات مرة: مولانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال عجزتُ عن فهمه ولا ينبئك مثل خبير: كيف يمكن فهم هذا البيت المنسوب لابن عربي فهما صحيحا حيث يقول: (مقامُ النبوة في برزخٍ ** دُوَيْن الولي وفوق الرسول!) فجاءت إجابته لي على هذا النحو العجيب والمدهش: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ليست الفوقية هنا فوقية رتبة، ولكنها فوقية اتساع؛ فأوسعُ المقامات بإطلاقٍ مقام الولاية، لأن كل نبي ورسول من الأولياء ولا عكس، يليها في السعة مقام النبوة لأن كل رسول نبي ولا عكس، ثم يأتي مقام الرسالة وهو أعلاها وأضيقها من حيث عدد القائمين به، وليس مقصود الشيخ من الكلام تفضيل الأولياء على الأنبياء والمرسلين، والله تعالى أعلم. وكثيرا ما تأتي إجاباته على أسئلة الأصدقاء على هذا النحو المدهش، الذي يدل على تبحره وإتقانه وفهمه العميق لمسائل التصوف والفكر والأدب، وقد قدم رحمة الله عليه عدة حلقات عن الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي على صفحته على الفيس بوك، صال وجال في فكر الرجل وشرح غوامضه، وأرشد إلى الطريقة المثلى التي تعين الدارس على فهمه بصورة صحيحة بعيدة عن التشدد والمغالاة وبعيدة عن التفريط والفهم الساذج والسطحي.
أما تأملاته في كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والشعر العربي فهي تأملات فريدة حقا، لا يقع عليها إلا من أوتي علما وفقها وذكاء وصفاءَ نفسٍ وقربا من الله، وقد كنتُ حريصا على متابعة كل ما يكتبه، ولم ينقطع إعجابي به في كل مرة يعيد فيها نشر هذه الفرائد، وحسنا فعلتْ زوجُه حين أبقت على صفحته بعد رحيله لتنشر من خلالها هذه الدرر النفيسة والنورانية، فهي من العلم النافع الذي لا ينقطع أجر صاحبها كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، وإني لأرجو أن تُجمَع هذه المنشورات وتعليقاته على الأصدقاء بكاملها وتنشر في كتاب أو عدة كتب.
وإليك هذا المثال من بين مئات الأمثلة التي تدلك على منهج أسامة رحمة الله عليه في الاستنباط والتذوق والفهم؛ يقول رحمه الله متأملا قوله تعالى: “وبرًّا بوالدتي”: قالها المسيح عليه السلام بعد أن أشارت إليه أمُّه الصديقة المصطفاة عليها السلام، وكان أولُ بره بها تبرئةَ ساحتها، ثم اتخاذَه – في سبيل ذلك – طريقَ الاقتضاء دون المصارحة، فلم يقل: أمي بريئة مما تظنون ومما ترمونها به، فأجلَّها أن تقوم مقام المتهَم ولو في سبيل التبرئة، ولكن قال: “إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيًّا * وجعلني مباركًا” الآيات، فذكر النعم التي تقتضي البراءة ولا بد، ثم عزا جميع ذلك إلى الحق تنبيهًا على كمال البراءة من الحول والقوة، وهذا آكد في حقه عليه السلام، لِما سيُنسَب إليه بعد ذلك -زورًا- من دعوى الربوبية. فتأملْ كيف تكون مقاطع الحكمة عند المؤيَّد بنور الحق! وأنت تستطيع من خلال هذه الومضة القصيرة أن تقف على طبيعة فكره وعذوبة لغته ونقائها وفرادة أسلوبه رحمة الله عليه.
لقد كانت رحلة أسامة في طلب العلم حافلة وعامرة بالإنجازات رغم عمره القصير، وهذه هي البركة في العمر التي كان يدعو بها بعض الصالحين؛ حيث كان يطلب من الله حياة عريضة لا عمرا طويلا مديدا، وكم كنا نعقد الآمال عليه في إنجاز المزيد من الأعمال العظيمة، لكن الله الرحمن الرحيم اختاره إلى جواره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولا شك أن خسارتنا وخسارة الأمة بفقد مثله فادحة للغاية، لكن مثل أسامة لا يموت ذِكْرُه؛ فهو باق في وجدان أساتذته وزملائه وطلابه وكل العارفين بقدره، رحمات الله ورضوانه عليه في جنات الخلد مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ومن حسن الطالع وأنا أكتب هذه المقالة علمت بصدور دراسة الحبيب أسامة عن الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي وآرائه الفقهية وقد قَدَّم لها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله.
وأما محمد متولي رحمة الله عليه فقد كان مشروع ناقد كبير وروائي ممتاز، لو امتد به الأجل لأعاد للدار بعض أمجادها وتاريخها العريق، ولتبوأ مكانة سامقة في مجال النقد الأدبي والكتابة الروائية، خاصة أنه كان شديد الأناة والعناية بما يكتب، كما كان يتمتع بحس فكاهي ساخر وقدرة عجيبة على القص وسرد الأحداث، وتحويل الأحداث العادية والبسيطة إلى صور سردية مدهشة ومشوقة لا يشعر القارئ معها بالملل أبدا، ولد محمد متولي بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ في 21 نوفمبر عام 1982م، وحصل على درجة الماجستير في النقد الأدبي عن رسالة بعنوان: أثر مدرسة النقد الجديد في النقد العربي في مصر عام 2009م، وحصل على الدكتوراه من جامعة برلين الحرة بألمانيا عن رسالته: عتبات في الروايات العربية في مصر عام 2015م، وبعد عودته من ألمانيا عُيِّن مدرسا بقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وسافر في أواخر 2021م للعمل بجامعة الشرقية بسلطنة عمان، وهناك تعرض لحادث سير أليم قضى على أثره نحبه وفاضت روحه إلى بارئها ليلحق بصديقه وأخيه أسامة شفيع بعد نحو سبعة أشهر فقط، وعلى الرغم من حياته القصيرة فقد ترك متولي عددا لا بأس به من الدراسات النقدية والسردية المهمة؛ ومنها: أيامي في برلين – درعمي في بلاد الفرنجة، وهو سيرة ذاتية أدبية عن السنوات التي قضاها في ألمانيا، ودراسات في نقد الرواية والقصة القصيرة، ومحاضرات في علم الأسلوب، والأوكسيمورون في الرواية العربية، وسير الأزاهرة بين رعاية الأعراف وغواية الاعتراف، والحداثة الشعرية وأزمة البحث عن معنى، وصورة اليهود في الرواية العربية المعاصرة: رؤية سردية مغايرة، والمثقف والسلطة: استدعاء ابن المقفع في الأدب العربي المعاصر، وجسارة الكتابة الشذرية في «تأملات مسلم» لعبد الرحمن أبو ذكري، ورجاء جبر وجهوده في الأدب المقارن: بين التنظير والتطبيق. ولو جمعت تدويناته التي كان يكتبها على صفحته على الفيس بوك وتعليقاته لكانت سفرا كبيرا يفيد منه طلاب العلم والباحثون. (اعتمدت في هذا الجزء التوثيقي على ما كتبه الصديق عبد الفتاح جمال الدرعمي على صفحته على الفيس بوك بتاريخ 30 ديسمبر 2021م)
وبعد، فليس هذا كل ما في جعبتي عن الحبيبين أسامة ومتولي؛ فهما يستحقان وقفات أطول وأعمق، ولكنها كلمة مقتضبة أردت من خلالها أن أعبر عن مشاعري ومشاعر كثير من الأصدقاء تجاه الراحلين الكريمين، والتعريف بمنجزهما العلمي الثري في هذه العجالة، ولعلي أعود لهما لاحقا مستدركا ومستكملا ما بدأته، أسأل الله تعالى أن يرحمهما برحمته الواسعة وأن يسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة، وأختم مقالتي بهذه القصيدة الجميلة التي كتبها الصديق العزيز دكتور محروس بريك في رثائهما:
يودّعُنا الرفاقُ بلا إيابٍ ** متى من ودَّع الأيام آبَا
ونضحكُ للصديق وليس يدري ** بأن القلبَ يضطربُ اضطرابا
هي الدنيا تراودنا ولسنا ** كيوسفَ.. هَمَّ يدفعُها اجتنابا
وليس تُغلِّقُ الأبوابَ .. لكنْ ** تُفَتّحُ للأسى بابًا فبَابَا
نقُدُّ قميصَها ونهيمُ عشقًا ** فتَغْرِسُ في جدار القلب نابَا
ونعدو خلفَها بفؤادِ طفلٍ ** وكيف تطاردُ الشاةُ الذئابا؟!
لَعَمري كيف تخدعنا الليالي ** وهذي الأرضُ تنتحبُ انتحابَا
يسيلُ بجوفها دمعُ الثكالى ** وأبناءُ الترابِ غدَوا تُرابَا
على ظهر الرمال ضجيجُ موتٍ ** ونرفعُ كلَّ آونةٍ حِرابَا
ومن خلف الصخور أنينُ صمتٍ ** ولكنْ صمتُ من عرَف الصوابَا
مضى كلٌّ ليوم.. ليس يرجو ** لأمٍّ أو أبٍ فيه انتسابا
يقول الظالمون إذا رأَوهُ ** ألا يا ليتنا كنّا ترابَا
ووَدُّوا لو يعودُ العمرُ يومًا ** وكلُّ معاندٍ للحقّ ثابَا
وكيف يعودُ من عَبروا الليالي ** إذا ما أسدلَ القدَرُ الحجابَا
وما هذي الحياةُ سوى سرابٍ ** وأشقى الناسِ من طلبَ السرابا
أودّعُ كل يومٍ بعضَ قلبي ** وموجُ الموتِ يَصطخِبُ اصطخابَا
كأنيَ قارئٌ لكتابِ صَحْبٍ ** ويُغلِقُ دونيَ القدَرُ الكتابَا
أسامةُ/ محمدُ ..
يا رفيق الدربِ قُلْ لي ** أعانقتَ الصَّحابةَ والصِّحابَا
وكيف العُدْوَةُ القُصْوَى.. وقومٌ ** رأيتَ هناك قد وَطِئوا السحابا
وكيفَ حكيتَ للمختار عنَّا ** وكيف تضيءُ بسمتُهُ الرِّحابَا
وعن ضُرٍّ أصابك فاصطبرنا ** وكيف الموتُ يقترب اقترابَا
وأمٍّ خلف سِتر الليل تبكي ** وكيف أبوك يرتقبُ ارتقابَا
وكيف التَّرْجَمَاتُ .. حكيتَ عنها؟! ** وكيف مررتَ في الدنيا شِهابَا
وعن دار العلوم وعن بَنِيها ** وكلٌّ صار مُعْـتَـنِـقًا كِتابَا
وعنَّا إذ طوالَ الليلِ نحكي ** وعن ضَحِكَاتِنا.. والبدرُ غابَا
خطَطنا في شباب العمرِ حُلمًا ** وكفُّ الموتِ قد تَئِدُ الشبابَا
قضى الرحمن أن تغدو إليه ** بقلبٍ حاز في الحبِّ النِّصابَا
_______
*بقلم: أ.د. وجيه يعقوب السيد – كلية الألسن – جامعة عين شمس – قسم اللغة العربية.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.