ابن رشد؛ التوفيق بين الفلسفة والدين

تمسك ابن رشد الشديد بالعقلانية لم يحل دون اهتمامه بالدين، نظراً لعدة ظروف تاريخية تجسدت في السيطرة، التي بلغت ذروتها لعلماء الكلام والفقهاء على الحياة الفكرية والسياسية في عصر ابن رشد، وفي هجوم الغزالي على الفلسفة وعلى الفلاسفة
حظي ابن رشد، ومازال يحظى، باهتمام كبير من طرف الدارسين والباحثين والمؤرخين سواء في الشرق أو في الغرب، فدرست أعماله وتأثيراته في الفلسفة الوسيطة، خاصة منذ من منتصف القرن العشرين المنصرم، من قبل بعض المستشرقين، كان في مقدمتهم رينان في كتابه الشهير عن «ابن رشد والرشدية»، الذي وضع فيه الخطوط العريضة لسلسلة هائلة من الدراسات.
ثم توالت الدراسات من طرف مؤرخي فلسفة العصور الوسطى، الذين راحوا يهتمون بابن رشد وبأثره في فلسفة العصور الوسطى. وفي هذا السياق تتناول مؤلفة هذا الكتاب أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى، وتستند إلى ما قدمه رينان من جهد كبير، مسح من خلاله جل المخطوطات المتعلقة بالموضوع، وما قدم من لمحات عديدة حول الموضوع، فكانت تلك اللمحات سليمة حيناً، خاطئة أحياناً نتيجة لندرة المنشور والمحقق من المخطوطات في هذا المجال وقت ذاك. وتعتبر أن أبرز أخطاء رينان هو اعتباره المدرسة الفرنسيسكانية رشدية النزعة واعتبارها معقلاً من معاقل الرشدية اللاتينية في القرن الثالث عشر.
وتنظر المؤلفة إلى ابن رشد، بوصفه فيلسوفاً عقلانياً جريئاً، جعل رسالته تفسير الحقيقة العقلية الفلسفية التي توصل إليها المعلم الأول أرسطو. وترى أن تمسك ابن رشد الشديد بالعقلانية لم يحل دون اهتمامه بالدين، نظراً لعدة ظروف تاريخية، تجسدت في السيطرة، التي بلغت ذروتها لعلماء الكلام والفقهاء على الحياة الفكرية والسياسية في عصر ابن رشد، وفي هجوم الغزالي على الفلسفة وعلى الفلاسفة، الذي ما زال ماثلاً أمام الأذهان.
وبسبب هذين العاملين وضع ابن رشد ثلاثة مؤلفات توفيقية، هي «فصل المقال»، و«منهاج الأدلة»، و«تهافت التهافت»، حاول فيها التوفيق بين الفلسفة الأرسطية، وهي الحق العقلي في نظره، وبين ما جاء في الدين الإسلامي، متأوّلاً هذا الأخير في حالة تعارضه مع ما جاءت به الفلسفة بما يحقق الوفاق بينهما.
وبما أن أنه يعلم أن فلسفة أرسطو دخلت أوروبا مصطبغةً بصبغة عربية، أي متأثراً بالتأويل المادي للإسكندر الأفروديسي، لذلك أراد ألبرت الكبير من كتابه أن ينقي أرسطو قدر الإمكان من الفلسفة العربية، والرشدية على وجه الخصوص. وعليه يتضح أنه كانت هناك محاربة قوة ومتصاعدة للتيار الرشدي في الجامعات والثقافة الأوروبية، وتبلورت تلك المحاربة مع توما الإكويني عام 1269 في كتابه «في وحدة العقل رداً على الرشديين» الممثلين بسيجر برابانت.
وفي عام 1255 وضعت كلية الآداب بجامعة باريس تنظيماً لمناهج التدريس، ودخلت فلسفة أرسطو رسمياً في التعليم الجامعي، حيث وضع ألأبرت الكبير كتاب «في وحدة العقل ضد ابن رشد».
وتلك الفترة كانت تعدّ زمن أعظم المعارك الفكرية في القرون الوسطى، والتي دفعت بأسقف باريس تومبييه إلى إصدار قرار تحريم جديد عام 1270 ضد الرشدية والمشتغلين بها، ولكن فلسفة ابن رشد استمرت في كل أنحاء أوروبا حتى القرن السابع عشر، معلنة انتصار العلمانية كحتمية لا بد منها.
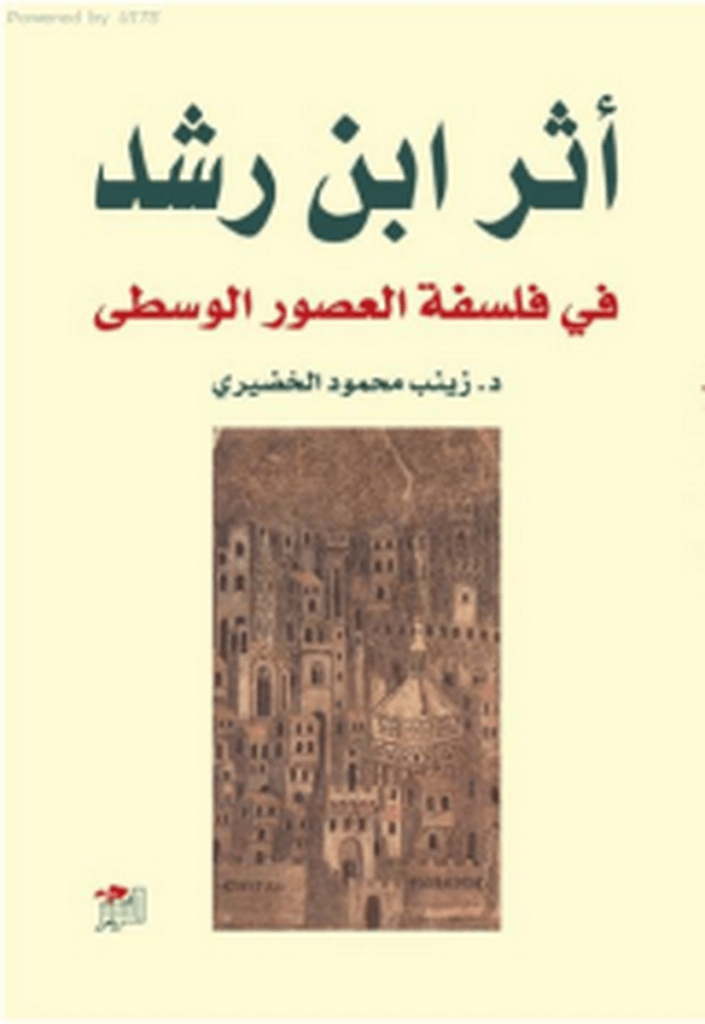
وتختار المؤلف من فلسفة ابن رشد ثلاث مشاكل فلسفية، هي مشكلة التوفيق بين الفلسفة والدين، ومشكلة العالم، ومشكلة النفس العاقلة، لتدرسها عند ابن رشد أولاً، ثم تدرس أثرها في فلسفة العصور الوسطى. ولا شك في أن دراسة هذه المشاكل الثلاث، تفضي إلى دراسة جانب كبير من فلسفة ابن رشد، وهو نفس الجانب الذي كان له أعظم الأثر فيمن تأثروا بالرشدية، كونها تشكل محور اهتمام كافة الفلاسفة المسيحية المهتمين بفلسفة ابن رشد، سواء كانوا مؤيدين له أم معارضين.
ويجري التركيز على الفلسفة الرشدية اللاتينية في القرن الثالث عشر في باريس وحدها، دون غيرها من المدن التي عرفت جامعاتها تلك الفلسفة. والسبب في هذا الاختيار يعود إلى أن القرن الثالث عشر يمثل ذروة ما وصل إليه الفكر في العصور الوسطى المسيحية، وإلى اعتبار باريس منارة هذا الفكر في ذلك الوقت، وما كان يحدث في جامعاتها وبأوساطها العلمية كان ينعكس بالضرورة على كل المراكز الفكرية الأخرى في أوروبا المسيحية.
إضافة إلى أن القرن الثالث عشر في باريس يعد أهم مرحلة في تاريخ الرشدية اللاتينية، حيث يمثل دخول هذه الفلسفة لأوروبا وبلوغها الذروة، كما أنه يمثل العصر الذي حدثت فيه ما يشبه الصدمة للفكر المسيحي، تلك الهزة التي ساهمت إلى حد كبير في خلق الفكر المسيحي الفلسفي المنفصل عن الفكر اللاهوتي.
وتحدد المؤلف عدة اعتبارات لاختيارها الفلاسفة المتأثرين بابن رشد، حيث ترجع اختيار القديس ألبرت الكبير، لأنه أول من أراد استيعاب أرسطو في علم اللاهوت المسيحي، وبالتالي لا بد وأنه تأثر بشارح أرسطو الأعظم وهو بصدد تحقيق هذا الغرض. ولا تنفصل فلسفة القديس توماس الأكويني عن «فلسفة» ألبرت الكبير، كونها مكملة لها إلى درجة أنه يُطلق على الفلسفتين معاً اسم «الفلسفة الألبرتو ـ توماوية».
لكن المؤلفة ترى أن القديس توماس لم يكن فيلسوفاً، حسب رأي بعض الباحثين، بل كان عالم لاهوت مخلصاً لدينه، رأى كنوز الأرسطية يقدمها له ابن رشد، فأخذ منها ما يخدم دينه ويفسره تفسيراً عقلياً، وهاجم ما يتعارض مع عقيدته.
وقد حددت المسيحية حدود فكره، حيث حددت له كل الحقائق التي كان عليه أن يثبتها عقلياً بواسطة الفلسفة. وبالرغم من اختلاف فكر فيلسوف قرطبة ومتفلسف المسيحية الأعظم، إلا أن العديد من الحلول الفلسفية الرشدية للمشاكل المختلفة تسلل إلى فكر الأكويني.
وبفضل تأثير ابن رشد تجاوزت فلسفة الأكويني، حسبما يؤكد ماكسيم جورس في كتابه «ذروة الفكر في العصور الوسطى»، النمط الفكري السائد وقت ذلك الوقت، أي ذلك النمط المتمثل في خلاصات الكسندر دي هالس والقديس بونافنتورا والقديس ألبرت وموسى بن ميمون، فحقق بذلك اتجاهاً تجريبياً مادياً أرسطياً رشدياً.
وبغية تفسيرها للتوفيق ما بين الدين والفلسفة الأرسطية، ترى المؤلفة أن أرسطو ذهب إلى مجموعة من الحقائق، التي كانت تؤلف نسقاً فلسفياً شامخاً، وهي تختلف مع هذه الحقائق الدينية الأساسية التي تتفق عليها الأديان السماوية، والمجسدة في اعتبار الله واحد، عليم بكل شيء، ويشمل بعنايته الكون الذي خلقه من عدم، والنفس الإنسانية خالدة وثمة ثواب وعقاب في الحياة الأخرى.
ونتيجة لهذا الاختلاف بين الأديان الثلاثة من جهة، والمذهب الأرسطي من جهة أخرى، كان على الفلاسفة، الذين عرفوا باسم المشائين، على اختلاف أديانهم التوفيق بين أرسطو وبين العقيدة، فقدم ابن رشد للإنسانية توفيقاً عبقرياً بين البناء الفلسفي الأرسطوي الشامخ وبين الدين الإسلامي، هو توفيق يصلح للمسلمين كما يصلح للمسيحيين ولليهود على السواء، لأن الأديان الثلاثة واحدة في جوهرها.
وإذا كان رجال الكنيسة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر قد حاربوا هذا التوفيق بضراوة، وحرّموا كتب ابن رشد، بل وذهبوا إلى حد قتل من يتمسك بقضاياه، فإن ذلك لم يكن إلا تعصباً من جانبهم، فالدين المسيحي لا يتعارض مع هذا التوفيق الفلسفي الذي يحترم حقائق الأديان الأساسية.
والدليل هو أن رجال الكنيسة أقحموا بعض قضايا القديس توماس في أحد التحريمات، ليعودوا بعدا ذلك بقليل فيجعلوا فكر القديس الأكويني هو فكر الكنيسة الرسمي.
ومعنى هذا أنه من الممكن أن تتغير وتتبدل تأويلات رجال الدين لدينهم بتغير الأزمنة والظروف لتبقى حقائق الدين المنزل خالدة ثابتة لا تتغير، وصالحة لأن تمثل الحق على مر العصور.
وبمعنى آخر من الممكن أن تطرأ تغييرات على كل من علم الكلام الإسلامي واليهودي وعلم اللاهوت المسيحي ـ وقد حدث هذا بالفعل! على مرّ العصور وباختلاف الأحوال، ولكن تبقى الأديان ثابتة خالدة.
المؤلفة في سطور
الأستاذة الدكتورة زينب محمود الخضيري، أكاديمية وكاتبة مصرية، رئيس قسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة. أصدرت العديد من الدراسات والمؤلفات، منها، «دراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية، 1986»، و«ابن سينا وتلاميذه اللاتين، 1999»، و» فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، 2006»، وترجمة بعض الكتب والدراسات عن الفرنسية، مثل:» في قلب الشرق : قراءة معاصرة لأعمال لويس ماسينيون».
المؤلفة في سطور
الأستاذة الدكتورة زينب محمود الخضيري، أكاديمية وكاتبة مصرية، رئيس قسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة. أصدرت العديد من الدراسات والمؤلفات، منها، «دراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية، 1986»، و«ابن سينا وتلاميذه اللاتين، 1999»، و» فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، 2006»، وترجمة بعض الكتب والدراسات عن الفرنسية، مثل:» في قلب الشرق : قراءة معاصرة لأعمال لويس ماسينيون».
الكتاب: أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى
تأليف: د. زينب محمود الخضيري
الناشر: دار التنوير للطباعة والنشر بيروت 2009
الصفحات: 426 صفحة
القطع: المتوسط
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.








