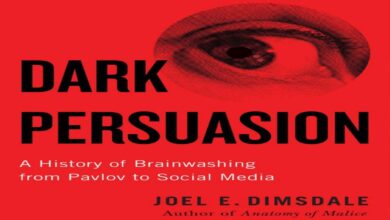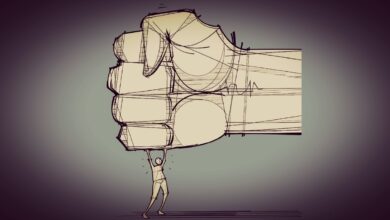ما زال المواطن الجزائري وحتى بعض الإطارات يعانون من استغلال بعض المسؤولين لنفوذهم الوظيفي في الكثير من المجالات، ففي زمن غابت فيه روح المسؤوليَّة انقلبت الموازين، وأصبح المسؤول الصغير يتحكَّم في المسؤول الكبير، زمن تمارس فيه كل أشكال الإقصاء والتهميش على خلفيَّة الإنتماء الشخصي أو السياسي، هي ظاهرة تحدث في البلاد الأخرى وما الجزائر إلا عيّنة، فإذا أردنا أن نكون موضوعيين علينا أن نقبل النقد الذاتي ونعترف بأنَّ الوعي ما زال غائباً لدى البعض في التعامل مع الآخر.
الشعب الذي تمرَّد على الحكم الإستعماري طيلة مائة وثلاثين سنة، والذي كان يشعر أنَّ الدولة دولته، وأنَّ الحكومة حكومته، وأنَّه هو السيد لأنَّ الاثنتين تخدمان مصالحه، وبالتالي فإنَّ احترامهما هو احترام لصالحه ونتيجة لهذا الوعي سارع الشعب في القيام بواجباته نحو الدولة، لكن بعد ثمان وخمسين سنة من الاستقلال وجد الشعب الجزائري نفسه يتخبَّط في مشاكل لم يكن هو صانعها، فعاش ثورات، بعضها كانت سلميَّة وأخرى دمويَّة، وهذا بفعل البيروقراطيَّة والنهب للثروات واختلاس المال العام على حساب التنمية، فكان الازدراء بينه وبين ممثّلي السلطة العامَّة، وكأنَّه يعيش التجربة الإستعماريَّة من جديد، فلم يعد يثق فيمن تولوا مسؤوليَّة السهر على هذه الدولة ونظامها.
السبب هو أنَّ بعض المسؤوليَّات أوكلت لغير أهلها ومن تسلَّموا زمام هذه المسؤوليَّة بطرق مختلفة تكبَّروا وتجبَّروا وتعجرفوا، وظنّوا أنهم هم الدولة ولهم الحقّ في أن يهينوا من هم متساوون معهم في الرتبة والدرجة بل قد يكونوا أرقى منهم وعيا ومسؤوليَّة، الفرق بينهم هو أن الظروف لم تسمح لهم بالحصول على هذه المناصب لتحمّل المسؤوليَّة، مسؤوليَّة خدمة المواطن والصالح العام، هناك فئة استغلَّت منصبها (رغم أنَّه منصب بسيط) لتتطاول على الآخر وتهينه بكل وقاحة ولا مسؤوليَّة، في محاولة التقليل من شأنهم، ولا تراعي للعشرة أو حتى لفارق السنّ، فكل من يتولَّى منصبا يقول: ” أنا ربكم الأعلى، وبدوني لا تستطيعون القيام بشيء، وتجده يعمل على تحريض من يحيطون به من الأعوان من أجل تهميش من يختلف معه أو أهواءه لا تلائم أهواءه هو لاختلاف الأفكار والمواقف، لدرجة أنه يسعى بكل الطرق والأساليب لإقصائه، وأحيانا من أجل التقليل من قيمته والاستهزاء به.
هي سلوكات وجب أن نضعها تحت المجهر لنكشف حقيقة من يعتقدون أنَّ الناس سذّجا لا يفهمون ولا يعون لما يدور حولهم، ولكنّهم ترفّعوا لتجاوز هذه الأوضاع لأنهم لا يجزمون إن كانت هذه الإهانة مزحة غير مقصودة أو محاولة للنيل من كرامتهم، وكان باستطاعتهم الردّ والكشف عن حقيقة البعض وإسقاط أقنعتهم، (هو الترَفُّعُ لا غير)، كما أن التربية تلعب دورا مهمّا في مثل هذه المواقف، وكما يقول علماء النفس إنَّ الإهانات لا تأتي دوماً بشكل يسمح للإنسان بالردّ عليها في اللحظة ذاتها، فهناك الإهانة المغلّفة بالمجاملات، التي تضعك في حيرة من أمرك بين الردّ عليها أو تجاهلها، كما أنَّ وقع الإهانة يختلف بحسب المكان والزمان، ومن هذا المنطلق وجب القول إنَّ بعض السلوكات قد تحدث في نفس الآخر شكوكا تجاه واقعه المعيش الذي يريد أن يغيّره نحو الأفضل، ولكن غالبا ما يقف الإنسان على مفترق الطرق وهو يرى أنَّ التغيير الذي ينشده يصطدم مع هذا الواقع الذي فرضه من تحدثنا عنهم بسلوكاتهم اللاواعية واللا أخلاقيَّة، أولئك الذين يحملون تفكيرا سلبيّا تجاه من لا يرضون عنه لسبب من الأسباب، وقد لا يطيقون وجوده بينهم، فيختلقون له العقبات لعرقلته، هي الأسباب التي جعلت المواطن يتمرَّد على حكومته وما الحراك الشعبي الذي عاشته الجزائر طيلة سنة كاملة، لدليل على أنَّ هؤلاء الذين أوكلت لهم المسؤوليَّة لم يكونوا في مستوى المسؤوليَّة ولم يكونوا جديرين بها وأنه وجب استئصالهم.
في زمن غابت فيه روح المسؤوليَّة انقلبت الموازين، وأصبح المسؤول الصغير يتحكَّم في المسؤول الكبير، وبطريقة غير مباشرة يسدي له الأوامر، يحدث هذا عادة مع بعض المسؤولين المحليين، أين يجد نفسه يسير وفق تعليماتهم في تفقّد مشاريع الولاية، حتى لا يقف هو على النقاط السوداء وكيف تدار الأمور في غيابه، هو زمن يختلف عن الزمن الماضي، يوم كان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب يخرج خفية لتفقّد أحوال رعيته (الأمَّة)، عكس اليوم لا يخرج المسؤولون الكبار ( الوزير أو الوالي) لتفقّد مشاريع قطاعهم إلا بعد إعلان عن موعد زيارتهم، فيقوم المسؤولون الصغار بتزيين المكان وتنظيف الشوارع وإخفاء العيوب كي يرى المسؤول الكبير أن كل شيء على ما يرام، وأنَّ الذين وضع فيهم ثقته أهل للمسؤوليَّة، ولولا الحركات الاحتجاجيَّة التي يقوم بها المواطنون الغاضبون لرفع مظالمهم للوالي أو للوزير والبيانات التي يرسلونها لوسائل الإعلام أو عن طريق النقابات لما تم الكشف عن هذه العيوب والنقائص.
كما ساهمت التكنولوجيا في الكشف عن تورّط بعض المسؤولين وما يرتكبونه من جرائم في حقّ الوطن والمواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أصبح الفيسوك مثلا الخيط الذي يربط المواطن بالمسؤول وبالرأي العام ككل، وبالتالي لم تعد “تغطية الشمس بالغربال” تجدي في زمن الرقمنة، التي جعلت العالم قرية صغيرة، وقرَّبت بين الشعوب، ما يمكن قوله هو أن تفاقم هذه الظاهرة وتضخّمها أصبحت تشكِّل بؤرة سرطانيَّة في جسد المؤسَّسات والمجتمع، وهذا لا يرجع إلى غياب النصوص القانونيَّة أو عدم كفايتها بل إلى غياب المحاسبة والمساءلة والشفافيَّة، وغياب الضمير المهني وتحمّل المسؤوليَّة، فإلى جانب البيروقراطيَّة والترهّل الإداري هل وجب القول إنَّ استغلال النفوذ والمحسوبيَّة جريمة يعاقب عليها القانون؟ كونها وصلت في بعض الأحيان إلى درجة المساس بشكلٍ مباشر بكافة حقوق المواطنين وأثَّرت سلبا على كل مناحي الحياة اليوميَّة.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.