الحقّ في الاختلاف وتَشكل مفهوم الفرد
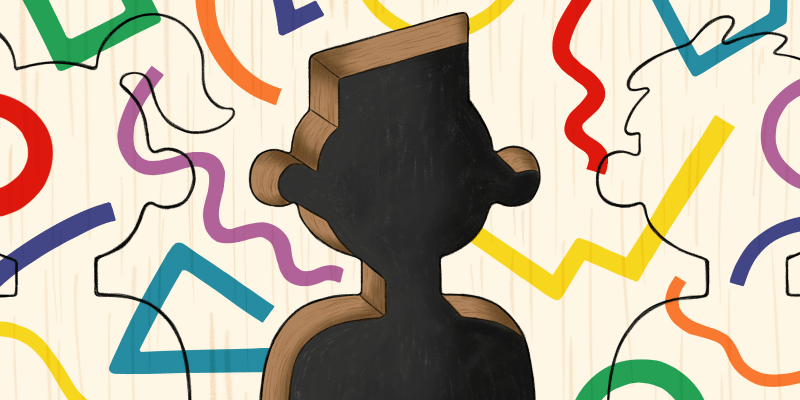
سألني أحد تلامذتي النابهين، ممن يريدون إحياء حزب شرقي، استنزَف أكثرُ قادته في السلطة ما كان يمتلكه لحظة تأسيسه، من روح وأخلاق وضمير وطني، وممن يجهلون وفريقهم المساعد أسس بناء الدولة الحديثة، ولا يَعرف عنهم المواطنُ إلا الحكم بمنطق القبيلة، والاستحواذ على ثروات الوطن بوصفها غنيمة.
هذا الحزب يوشك على الموت، بعد أن تَعذّر عليه مراجعة أدبياته ونقدُها، والتحولُ إلى رؤية بديلة للدولة تخلِّصه من المفاهيم المبسطة المحنطة في كتاباته التقليدية، والإصغاءُ إلى ما يفرضه عليه الواقع بكل ما فيه من وقائع جديدة -ومن مباغَتات أيضًا-، وبناءُ مفاهيم تتناغم والإيقاع السريع المتغير للواقع. فإكرامًا لتاريخه، ورحمةً بتضحيات صادقة لرجاله الأوائل؛ أَقترحُ إراحته بتهيئة الظروف المناسبة لإعلان وفاته قبل فوات الأوان. ولفرط حرص تلميذي، يريد إنقاذَ المحتضَر الذي صار فريسة، ويريد إعادته للحياة بكل وسيلة ممكنة. وأظن أنه لم تعد هناك وسيلة مُجْدية، إلى إنقاذ مصاب بأمراض مميتة وبعثِ الحياة فيه.
سأل تلميذي: “لماذا تتشظى أحزابُنا وتتفكك بالانشقاقات المتواصلة، وأحيانًا تسقط في سجن العائلة، كأنها منذ تأسيسها منقسمة على ذاتها، سواء أدينيةً كانت أم غير دينية كالأحزاب القومية واليسارية، وقلَّما نرى ظاهرة الانشقاقات المتواصلة في الأحزاب الديمقراطية الغربية، سواء أدينيةً كانت أم غير دينية، مع أن بعضها مضى على تأسيسه أكثر من قرن، ومع ذلك لم تسقط في إغواء السلطة ومغانمها، ولم تتآكل بالانقسامات المتوالية؟!”.
كان جوابي: كل حزب مِرآة لمجتمعه، وأحزابنا مِرآة لمجتمعنا، ترتسم فيها كل خصائص المجتمع ومعتقداته وقيمه وأعرافه وتقاليده وثقافته ومشكلاته وأمراضه المزمنة.
أعمقُ عوامل هذه الانقسامات المزمنة لأحزابنا، تنشأ من أن مجتمعاتنا فقيرة من منابع تغذية روافد التعدد والتنوع والتفكير الحرّ وترسيخها، والمتمثلة بالآتي:
– التربية على الحق في الاختلاف.
– التربية على الحق في الخطأ.
– التربية على الحق في الاعتراف والاعتذار.
– تحرير الفرد من الإذعان والخضوع والعبودية الطوعية.
هذه أسسٌ ينْبَنِي عليها كل قول بالتنوع والتعدّد والتفكير الحر. وكلُّ مجتمع لا يعرف معنى للاختلاف، لا يطيق التنوع أو التعدد بكل أشكاله، لأن أيَّ تفكير أو رأي أو موقف لا يكرِّر ما هو معروف ومفروض سلفًا، لا يكتسب أية مشروعية في مثل هذا المجتمع، بل غالبًا ما يُعَدُّ مارقًا.
كل تفكير أو رأي أو موقف، خارج ما تقوله الشعارات المتصلبة والأدبيات المغلقة للجماعات السياسية، يُعدُّ خروجًا عليها وخروجًا منها. الجماعاتُ السياسية في مجتمعنا تتحدث كثيرًا بالاختلاف والتنوّع والتعدّد، لكن كثير منها لا يطيق الإصغاء إلَّا إلى من يستمع لصدى شعاراته في صوته. وهو ينزعج وينفر عندما لا يرى صورته ماثلة بكل ملامحها، في آراء المختلِف ومواقفه وسلوكه في المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الأيديولوجي والسياسي.
لا معنى لمجتمع تعددي من دون بناء لمعنى الفرد، والحقُّ في الاختلاف هو الفضاء الطبيعي لتَشكّل مفهوم الفرد وتَطوره. وكل مجتمع يتأسّس على معتقدات وثقافة وتقاليد تتنكر للاختلافات الطبيعية بين البشر، يُجهَض فيه أيُّ مسعى لبناء مفهوم الفرد قبل أن يولد. البشر مختلفون في كثير من تكوينهم النفسي والتربوي والثقافي والاعتقادي والجسدي، إلى الحدّ الذي نرى فيه كل إنسان نسخة فريدة، ذاتَ بصمة خاصة لن تتكرّر أبدًا في العالَم، منذ أول إنسان إلى اليوم. ولو بقي الناس على تكوينهم الوراثي المعروف، ولم تتلاعب في هذا التكوين هندسة الجينات، لَظلَّ كل إنسان غير قابل للتطابق مع غيره -مهما كانت قرابةُ الدم بينهما-، حتى آخر فرد في هذا العالَم.
كل حزب سياسي يتأسّس على تقاليد تَغيب فيها المراجعات النقدية، تترسخ تقاليدُ استبدادٍ في بُنْيته اللاواعية. لذلك، يظل عُرضة لانقسامات لامتناهية، ريثما يتفكّك ويتلاشى، إلَّا إنْ كان ذلك الحزب يقع تحت وصاية مستبِد عنيف، كما في الاتحاد السوفيتي سابقًا، وفي الصين وكوريا الشمالية اليوم، وإن كان سرعان ما يتقوّض كل شيء لحظة هلاك المستبِد. ولكن، لم يتفكك أبدًا أي حزب يقع كل شيء فيه تحت سقف النقد، ويواصل تحديثَ خطابه ومفاهيمه وأساليب عمله في ضوء الواقع.
كل تعددية دينية أو ثقافية أو سياسية، لا بدّ أن تبدأ بتشكيل مفهوم الفرد، وتعمل على تجذيره تربويًّا ونفسيًّا وثقافيًّا. فبناء ثقافة تقوم على الحق في الاختلاف، هو الأساس الذي يولد في فضائه الفرد ويتشكّل مفهومه. فلا معنى لمجتمع تعددي متنوع من دون بناء مفهوم راسخ للفرد، ولا معنى لمفهوم الفرد من دون تبجيل الكرامة الإنسانية وتكريسها، بوصفها قيمةً مرجعية عُليا تعلو على كل قيمة.
______
*المصدر: تعدّديَّة.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




