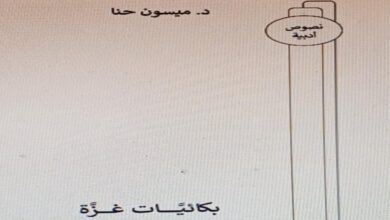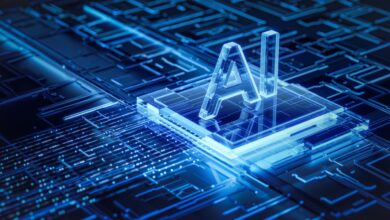مع أن هذه الحقيقة واضحة في كتاب الله وهدي الأنبياء، ولكنها لم تكن واضحة على الأرض في أي مرحلة من مراحل التاريخ كما هي اليوم، بعد ثورة المعلومات والاتصالات التي عززت فكرة القرية الكونية، وأكدت إخاء الإنسان للإنسان على الرغم من إرادة الحرب الباطشة التي تتناوب على إشعالها في الأرض قوى متقابلة في الشر من الشرق والغرب والشمال والجنوب، ولكن أدنى قدر من الثقافة صار يدعو الإنسان إلى معرفة أخيه الإنسان شريكاً لا بد منه لبناء الأرض وتسخير خيراتها في منافع العباد والبلاد.
جيران على كوكب واحد حقيقة أكدها القرآن الكريم: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)، وشرحها السيد المسيح بقوله الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره، ودلت لها حقائق العلم الحديث التي درست طبائع الإنسان وحاجاته ومقاصده وأكدت الأصل القرآني الكبير الذي دلت له عشرات الآيات: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وكل مولود يولد على الفطرة، أو كما تم التعبير عن هذه الحقيقة في مؤتمر الأديان الأخير بعنوان عريض: أسرة واحدة تحت الله!
الناس وفاقيون وفروقيون، منهم من يبحث عن المشترك ومنهم من يبحث عن المختلف، ومن عجائب القدر أن كلاً من الفريقين يجد بغيته وشواهده في العقل والنقل، ولا يخفي كاتب هذه السطور انحيازه إلى تيار الوفاقيين الذين يؤمنون بالإخاء الإنساني في الأرض، ويؤمنون بأن الله خلق العالم من أجل نهاية سعيدة، ويؤمنون بكلمة إقبال :
لم ألق في هذا الوجود سعادة كمحبة الإنسان للإنسان
لما سكرت بخمرها القدسي لم أحتج إلى تلك التي في الحان
وعلى الرغم من اختلاف الأعراق والأديان والثقافات ولكن الحقيقة التي تؤكدها تجارب التاريخ شرحها من قبل الشاعر العربي بقوله:
والناس للناس من عرب ومن عجم بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم
وهذه الحقيقة هي التي شرحها الصوفي العارف بقوله: الناس للناس والكل بالله.
الجميل كاسمه، والمعروف كرسمه، والخير كطعمه، وهي حقائق شرحها نص نبوي كريم رفعه الرسول إلى ربه: ليس كل مصل يصلي وإنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي وآوى الغريب ورحم المصاب وكسا العريان.
إن فعل الخير كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه، ولو أن تلقى الناس بوجه طلق، وغفر الله لبغي من بغايا بني إسرائيل رأت كلباً يلحس الثرى من العطش فنزلت بئراً فملأت خفها ماء فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها.
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
جيران على كوكب واحد حقيقة شرحها النبي الكريم بقوله: ما من مسلم يغرس غرساً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، وشرحتها نصوص القرآن الكبيرة الظاهرة فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.
وحين مضى التعصب إلى غايته في منع الخير عن المختلف في المذهب أو الدين أو السلوك راح النبي يضرب لهم أروع الأمثلة من الأفق الإنساني البعيد:
قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية!! فقال : اللهم لك الحمد على زانية!! لأتصدقن الليلة بصدقة، فوضعها في يد غني فاصبحوا يتحدثون: تصدق على غني!! قال : اللهم لك الحمد على غني!! لأتصدقن الليلة، فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق!! فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق.
وهنا أخبر النبي الكريم أن الرجل أتي (أي أوحي إليه) فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زنا، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته.
وهنا أختار لشرح هذه الحقيقة عند أهل الله كلام العارف الكبير أبي الحسن النوري حين سأله حيران بن الأضعف فقال: يا معلم: ما مراد الله من خلقه؟
أجاب فوراً: ما هم عليه!!
قال مندهشاً: أو يريد من الكفرة الكفر؟ قال أفيكفرون به وهو كاره؟
ثم قال: أخبرني ماذا أراد الله باختلاف الشيع وتفريق الملل؟
قال أراد إبلاغ قدرته وبيان حكمته وإيجاب لطفه وظهور عدله وإحسانه.
وكل قبيح إن نسبت لحسنه … أتتك معاني الحسن فيه تسارع
يكمل نقصان القبيح جماله …… فمـــا ثم نقصان ولا ثم باشع
إن إحساسي بإخاء الإنسان للإنسان لم يكن نتيجة قراءة سياسية، فأنا معك تماماً أن عصر الحروب الكولونيالية السابق والحروب الأمريكية اليوم لا تترك مجالاً لتفكير كهذا، ولكن ذلك في الحقيقة كان نتيجة التأمل في مشهد واحد لا يزال يرتسم في خاطري مذ عرفت الله، وهو يقيني بروحه سبحانه التي ينفحها كل يوم في روح الإنسان، ويمينه سبحانه التي مسحت جبين خلقه، ويوم حشد الملائكة في مشهد عظيم، وقدم للجمهور الكبير في الملأ الأعلى مشروعه في الأرض المسمَّى آدم، سراً من سره، ونوراً من نوره، وأمر الملائكة جميعاً أن يخرّوا له ساجدين، لم يكن آنذاك نبي ولا كتاب، ولا وحي ولا شريعة، ولكن الإنسان كان محلاً للتكريم، وعلى الإنسان أن يكتشف سره في ذاته، تماما كما عبر إقبال على لسان آدم:
إن سري.. يوم نــادى مهرجـــــــانـه
أمر الكل فخروا… فحباني صولجانه!
وحين يعتز الإنسان بماضيه المجيد في حضن الملأ الأعلى، لا يرى في هبوطه من السماء إلا استمراراً لرسالة شريفة خلق من أجلها، وهي أن يملأ العالم بالعبادة والحب، فيسأل في تمرد:
ما الذي تفعله العباد في قصر السماء؟
بين سجاد وريحــــان وبخور ومــاء؟
هم من الخلد سكــارى وأنا أحفر لحدي
أحمل الدنيا شريداً أعصر الصخر لوحدي
أنــــــــــا لما أعبد الله بحرماني وجوعي
لن ترى في الملأ الأعلى كمثلي في خصوعي
قل لمن يسـأل عني أنا شيخ الحضرتيــــــــن
إن عبداً لوعته الأرض عبد مرتيــــــــــــــــن
إن فكرة الجوار الإنساني على الكوكب ليست فكرة بلهاء تعفينا من التزام الحقوق، وتحولنا إلى مجرد دراويش على طرف الكوكب نرقص في الغسق، ونهز الرؤوس في الضحى كعنزة الزمخشري لإرادة المستبد، بل هو تشارك ومسؤولية، وكفاح وجراح، ودمعة وابتسامة، وحين نتخلَّى عن مسؤوليتنا في القرية الكونية فنحن إذن من يخرق وثيقة الجوار، وربما كان أوضح شرح لمسؤولية الجوار ما عبر عنه الرسول الكريم: مثل القائم في حدود الله والراتع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقاً فلم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
جيران في كوكب الأرض، عنوان كبير لحقائق في الأرض تتعزَّز كل يوم، ويكتشف الإنسان كل يوم أنه أحوج لأخيه الإنسان من ذي قبل، وأن فكرة صبغ البشرية بلون واحد، وأن الناس على دين ملوكهم هي فكرة استبداد وقهر تنتمي إلى عصر الأباطرة والقياصرة، وليس إلى عصر الأنبياء الذين بشروا في الأرض بقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً، ونادوا في العالم بحقيقة عميقة بعيدة الغور: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ).
________
*عن موقع مركز الدراسات الإسلاميَّة/ الراصد التنويري (العدد 2) أيلول/ سبتمبر 2008.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.