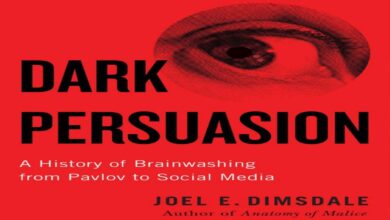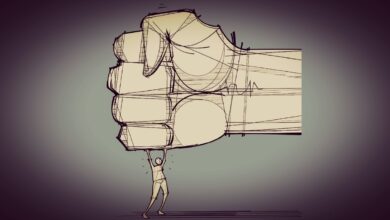ثقافة القبيلة وأثرها في العنف الديني والسياسي

“العنف مرتبط بالتقديس، والتقديس مرتبط بالعنف وكلاهما مرتبطان بالحقيقة أو بما يعتقد أنّه الحقيقة، والحقيقة مقدّسة وتستحقّ أن يسفك من أجلها الدم! هذا هو المنطق الذي ساد الوجود البشري في كلّ المجتمعات والأديان والعصور” / محمد أركون.
يبدو أنَّ علاقة التأثير المتبادل بين الفرد والمجتمع ومن منهما أكثر تأثيراً في الآخر علاقة في غاية التعقيد، فيمكن لفرد بقامة عيسى المسيح أو محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلّم من أن يغيِّر موازين مجتمع بكامله وينجح في تغيير نمط تفكيره وسلوكه بشكلٍ إيجابي بنّاء، كما يمكن لأفراد آخرين أن يحيلوا مجتمعاً كاملاً إلى جيش من القتلة والسفّاحين المتعطّشين للدماء، كما فعل الحجّاج وجنكيز خان وهتلر وأمثالهم. ومع ذلك تبقّى للمجتمع، بأنساقه وعقائده وقيمه وتقاليده، سلطته وسطوته في صناعة وعي الأفراد وتنمية سلوكياتهم سلباً أو إيجاباً .. ولن يكون الحديث عن ظاهرة العنف مجدياً ما لم نشخّص الجذور الاجتماعيَّة المسبّبة لها كون الشخص العنيف يحمل مرضاً اجتماعيّاً معيّناً يدفعه لممارسة العنف بالقول وحتى بالسلوك. وما يجري في بلداننا العربيَّة خصوصاً بعد حركة الربيع السلفي يُظهر للعيان حجم العنف الذي ينذر بمستقبلٍ مرعب ومصير مجهول.
يبدأ العنف في مجتمعاتنا من الأسرة متمثّلاً بعلاقة الرجل بزوجته من جهة وبأولاده من جهةٍ أخرى، تلك العلاقة القائمة، في الغالب، على التفرّد بالقرار ومصادرة الرأي المخالف، فضلاً عن عدم احترام خصوصيَّة كل فرد في التفكير والاعتقاد والممارسة، وليس للناس في بلداننا إلّا أن يكونوا على دين آبائهم وسّنَّة أسلافهم وعلى طريقتهم في الحياة.
يأتي بعد ذلك دور المؤسّسات التربويَّة والتعليميَّة، بدءاً بالمدارس وانتهاءً بكوادرها ومناهجها في إضفاء الطابع المنهجي لثقافة وممارسة العنف وبجرعات أكثر تركيزاً .. وقلما تختلف علاقة المعلم أو الأستاذ في الجامعة بالطالب عن علاقة معظم الآباء بأبنائهم فهي غالباً ما تكون علاقة السيد الذي لا يسأل عمّا يفعل بعبده المسؤول حتى عما لم يفعل.. أو كعلاقة الضابط بجنوده، حيث لا مجال سوى تنفيذ الأوامر وأداء الواجبات من دون نقاش. أمّا المناهج التربويَّة فهي في جانبها التربوي والثقافي لا تخرج كثيراً عمّا يتبنّاه الحاكم المطلق وما يشرّعه فقهاء البلاط، والأدهى من كل ذلك والأخطر هو دور المسجد الذي تحوّل من بيت يفترض به أن يكون لله وحده إلى معسكر للمفتي وجنده يتدرَّب فيه المريدون على شتّى أساليب كراهية الآخر المختلف وإقصائه في مجتمع يتفنّن بصناعة العنف وتصديره.
في مثل هذا المجتمع ينشأ الأفراد عاطلين عن التفكير الإيجابي، فضلاً عن العمل الصالح، وكثيراً ما ينجح الإسلاميّون في استغلال حالة التذمّر المجتمعي والغضب الشعبي الناتجة عن غياب العدالة الاجتماعيَّة المتمثّلة بتفشّي البطالة والفقر والفساد الإداري والمالي والتشريعي، والناتجة عن عدم وجود مفهوم واضح للسلطة لدى ذلك المجتمع أولا، وانعدام الضوابط والقواعد والرقابة الشعبيَّة على من يصلون إلى الحكم ثانيا.
فليست السلطة في بلداننا للشعب، حتى حين يمارس الديمقراطيَّة بنسختها العربيَّة المشوّهة، بل هي سلطة الحزب الحاكم الذي يُفصِّل الأنظمة والقوانين على مقاسه في نزعة للبقاء في السلطة إلى يوم يبعثون.
وحين نعود إلى الوراء قليلاً نجد أنَّ مصادر صناعة وعي الإنسان العربي بشكلٍ عامّ، حتى يومنا هذا، تعود بجذورها لأعراف وقيم عرب الصحراء التي تقدّس القوّة وتمجّد العنف وتؤمن بالشيخ أو الزعيم والقائد الرمز تلك الشخصيَّة المتوثّبة والمستفزّة على الدوام خوفاً من المجهول القادم من عمق الصحراء الشاسعة الحبلى بالمفاجآت، فضلاً عن قساوة تلك البيئة ووعورة تضاريسها وقلة فرص العيش فيها، الأمر الذي جعل تفكيره قائماً على الغارة والغزو سعياً وراء الغنيمة التي تصل حدّ سبي النساء والزواج بهن قسراً، ويعد أدب تلك الفترة خير دليل على ما نقول، ويكفي قول شاعرهم:
وكم ذات بعلٍ أنكحتها رماحنا حلالاً لمن يبني بها لم تُطلّقِ!!
حتى إذا لم يجدوا من ينهبونه لن يتردّدوا في الغارة على إخوانهم ومقرّبيهم، كما يسجّل ذلك عمر بن كلثوم في معلّقته الشهيرة، قائلاً:
وأحياناً على بكرٍ أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا !!
ورغم قتامة المشهد وظلاميّته، لم تخلُ ثقافة عرب الجاهليَّة من نفحات الروح الفيّاضة بالرحمة والحنان وخفقات القلب المفعم بالحبّ والضمير المعبّأ بقيم الخير والعدل والجمال متمثِّلة بالهاشميّين ومن كان على شاكلتهم، كما يؤكِّد الأستاذ العقّاد في كتابه “أبو الشهداء”، غير أنّ روح البداوة والتصحّر كانت هي الغالبة دائما، وقد تجد العربي في كثير من الأحيان خليطاً غريباً من المشهدين وحتى يومنا هذا، كما يثبت الدكتور علي الوردي في معظم كتاباته. فتراه رقيقاً كالطفل تسيل دمعته لأبسط موقف يرتبط بالحزن، لكنّه في ذات الوقت قاتل محترف لا يعرف الرحمة حين ينشب الخلاف بين أقاربه والآخرين، وبغض النظر عن أحقيَّة هذا الطرف أو ذاك، فهو يسير على سنَّة أسلافه من عرب الجاهلية الذين كانوا يقولون: انصر أحاك ظالماً أو مظلوما! بل كانوا يفتخرون بكونهم:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا
ولقد عمل الإسلام كل ما بوسعه على أن يحدث انقلابا هائلا في منظومة القيم، وأن ينتقل بعرب الجاهليَّة وأعراب الصحراء إلى واحة التحضّر والمدنيَّة، وتُعدّ إنجازاته في هذا المجال فتحاً عظيماً خصوصاً في تلك الفترة الحالكة من تاريخ العرب، لكنّه لم ينجح في إكمال مشروعه بعد أن تمكّنت قيم القبيلة بزعامة بني أمية من تحييد قيم الدين الجديد تمهيداً لتشويهها ومن ثمّ القضاء عليها، ولقد كان لها ما أرادت.
وممّا لا شكّ فيه أنّ نسخة الدين التي تحكم وعينا العربي حتى هذه اللحظة هي ليست سوى تلك النسخة التي زورها كهنة بني أمية وسلاطينهم، وهي ذاتها، بكل ما فيها من روح التحجّر والبداوة والتصحّر، من تحرّك مشاعر الملايين من المسلمين وتشحذ حماسهم في معظم مواقفهم الحياتيَّة، في الوقت الحاضر، ومهما بلغ مستوى المدنيَّة لديهم، فالمدنيَّة شيء والتحضّر شيء آخر تماما، ولعلّ موقف شرائح واسعة من العرب والمسلمين المؤيّد لحركات الإرهاب والعنف الديني دليل على أن الروح الطائفيَّة هي تجلٍّ للروح القبليَّة التي تحكم وعي العربي ولكن بغطاء ديني.
ولعل عاملاً اجتماعيّاً مهمّاً هو الذي مكَّن للكاهن والسلطان، وبغض النظر عن قوميّتهما وانتمائها، أن يحكما معادلة السلطة على طول الخط، وتمثّل ذلك العامل بسذاجة وبساطة الوعي المجتمعي وضحالته واختلاله وعدم قدرته على إحداث التغيير النوعي الحقيقي.
إنّ دلائل الواقع كلّها تثبت أن هناك أزمة حقيقيَّة في الوعي لدى المسلمين والسبب الكامن وراء ذلك هو وجود التناقض والتضارب في الكثير من المفاهيم وغياب الرؤية المعرفيَّة الواضحة حتى لدى الكثير ممّن يتصدّون لصناعة الوعي من النخب الثقافيَّة والدينيَّة، والدليل أنك قد تجد مثقّفاً عربيّاً ذا توجّه ماركسي يصبح بلمح البصر طائفيّاً بامتياز، كما تجد داعية إسلاميّاً ينادي بالتقريب بين المذاهب لسنين يتحوّل مفتياً تكفيريّاً بشكلٍ مفزع. كل ذلك يدل على أنّ قيم التحضّر والمدنيَّة لم تتأصّل بعد في الوعي العربي بشكلٍ عامّ، بل هي مجرد قشرة خارجيَّة كما يؤكِّد الشاعر نزار القباني بقوله:
لبسنا قشرة الحضارة والروح وجاهليَّة
ومن بين تلك الدلائل أنّ معظم الشباب المسلم المشحون بالحماس الديني غير المنضبط يسمع الكثير عن الجهاد أو المقاومة أو ما شابه من العناوين التي يختفي وراءها أصحابها ربما لغاية لا تمتّ لها بصلة على الإطلاق، غير أنّ أولئك الشباب لم يسمعوا مقابل ذلك شيئاً عن ضوابط الجهاد وموانعه، ولم يسمعوا عن الحدود التي يجب وقف القتال فيها ومنعه، كذلك لم يسمعوا كيف يكون الامتناع عن القتال أحب إلى الله وأقرب إلى الدين وأفضل للمسلمين، كما يؤكِّد ذلك القرآن بقوله ” وادخلوا في السلم كافة…” وكذلك فهم لا يعرفون شيئا عن قيمة التسامح والتعايش السلمي وحقوق الإنسان ومفهومي المواطن والوطن، لهذا استفاد المنقلبون على الدين الجديد من هذا العامل مضافاً لعدّة عوامل أخرى أسهمت بمجملها في تطويع المجتمع وترويضه على التعاطي مع ما يريدون، من أهمّها أن نصوص القرآن والحديث النبوي لم يتمّ تدوينها في عصر النبي الرائد، بل تمّ ذلك على مراحل لاحقة اعتماداً على النقل الشفوي للأتباع، وتتمثَّل خطورة هذا الأمر في المساحة المتاحة للبشري في التلاعب بالسماوي.
يقول محمد أركون: ” إنَّ النصوص الدينيَّة كلها (قد) دوّنت بعد فترة طويلة نسبيّاً من تاريخ النبوَّة، وبناء على الذاكرة الشفهيَّة للصحابة أو الحواريين، بمعنى أنها لم تكتب في زمن النبوّة ذاتها. وفي أثناء عمليَّة الانتقال من التراث الشفهي/ إلى التراث الكتابي تضيع أشياء، أو تحوّر أشياء، أو تضاف بعض الأشياء لأن كل ذلك يعتمد على الذاكرة البشريَّة، وهي ليست معصومة…”.
وبناء على ما سبق أسهم الكهنة مع السلاطين في الترويج للتفسير الأيدولوجي والقبلي للنصوص المقدّسة مستفيدين من ضبابيَّة الفهم للدين والخلط بين الإسلام وبين تجارب وممارسات زعامات المسلمين كون الحسّ الاجتماعي كان ولا يزال يدور في فلك الأشخاص أكثر ممّا يتأثّر بالأفكار، لهذا تمكّن المتآمرون من تغيير المعادلة التي جاء بها الإسلام حين جعل الفكر والسلوك معياراً للتمييز بين الناس، فجعلوها تتمحور حول الشخص الذي تحوّل إلى مبرر لإضفاء القداسة على الفكر؛ فالمعيار عند معظم العرب والمسلمين هو من يتكلَّم وليس ماذا يتكلَّم وكيف، ولهذا فهم يقيسون الحقّ بالرجال وليس العكس في تراجع وانتكاس للمقاييس ليس له مثيل، ذلك أنهم لا يستطيعون العيش دون إعلاء شأن هبل، أكان ذلك الصنم من الحجر أو من البشر.. لهذا نجد أنّ فتوى واحدة لأحد (نجوم) فقه الكراهية والقتل كافية لتسابق مئات الشباب للتطوّع في صفوف الحركات الظلاميَّة التي أغرقت شوارع المسلمين قبل غيرهم بلون الدم ورائحة الموت.
وتتجلى أزمة الوعي المجتمعي وسطحيّته بشكلٍ فاضح حين ندرك الطريقة التي استثمر بها المتسلطون مضافاً لاستفادتهم القصوى من عدم تدوين النصّ المقدّس، فقد وظّفوا مسألة “الناسخ والمنسوخ” في إكمال مشروعهم السلطوي في أكبر عمليَّة تزوير في التاريخ. ومن اللافت للنظر أنّ أصحاب القراءة المتطرّفة للنصوص الدينيَّة يركّزون على مسألة النسخ وأنّه قد طال الكثير من الآيات الكريمة التي تحثّ على التعاطي مع الآخر من خلال الحوار والجدال بالتي هي أحسن، حيث تتجلّى الحكمة والموعظة الحسنة، ويدّعون أنّه تمّ نسخها بآيات القتل والقتال وجهاد الكفّار، ومن يتمعّن بالنسخة السلفيَّة للإسلام، والتي تشكِّل امتداداً لإسلام بني أميَّة، يجد أنّه ديناً يتّسم بالتوحّش والهمجيَّة والظلاميَّة والتخلّف بكل المقاييس لا يعرف غير لغة القهر والغلبة من خلل القتل والإبادة الجماعيَّة.
لقد عمد كهنتهم إلى تعميم النسخ لكثير من الآيات القرآنيَّة، ولم تبق من آيات المودَّة والرحمة والتعامل مع الآخر بالحسنى سوى الآيات الأمرة بقتال الكفّار والمشركين، مثال ذلك أنّ ابن حزم الأندلسي في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم يرى أنّ آية ((فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ…)) قد نسخت (47) مورداً من آيات الكتاب التي فيها إشارة إلى الرحمة والمودّة والعفو والتسامح وعدم الإكراه، فلا غرابة حينئذ أن ترتكز فتاوى التكفير وخطب التحريض على هذا القسم من الآيات في الوقت الذي تتجاهل فيه الآيات الأخرى، ولهذا بعده النفسي المرتبط بالجذر الاجتماعي المشار إليه في ما سبق من سطور.
وحين يحاول الباحث ان يجتهد في تشخيص الأسباب التي كانت وراء توفّر الموروث الديني الروائي الذي يتبنّاه عرابو المشروع القبلي السلطوي من الساسة ورجال الدين، على ذلك الكمّ الهائل مما يمكن أن نطلق عليه فقه الكراهية والعدوان، يجد أن وراء ذلك مشروعاً سلطانيّاً عمل على تكريس الحروب والقتال، حيث أن أغلب الآيات التي طالها النسخ تمثّل روح الدين وجوهره وحقيقته وخطابه الإنساني المفعم بالحبّ والرحمة والمودّة.
يقول الباحث ماجد الغرباوي إنّ النسخ بهذه الكثافة ” لا يعدو أن يكون أسلوباً استبداديّاً أريد به تبرير حروب الخلفاء والملوك والسلاطين أو يمكن أن يكون مبرّراً لحثّ المسلمين على القتال لتوسيع رقعة الحرب من أجل ملء الفراغ وزج الجنود بما يشغلهم وتحصيل الثروات وتكريس المكاسب والامتيازات لمصالح فئويَّة وشخصيَّة، ثمّ تحوّل بعد ذلك إلى حقيقة معرفيَّة وأحكام شرعيَّة يتناقلها الرواة والفقهاء” ثمّ تغلغلت في ثقافة المجتمع وأصبحت من مقدّساته وأعرافه التي لا جدال فيها.
كما تأتي مسألة التلاعب والخلط في دائرة المقدّس من حقيقة أن قيم المجتمع المترسّخة قبل مجيء أية رسالة سماويَّة لها جذورها العميقة في اللاوعي الشعبي إلى الدرجة التي لا يمكن القول إنّ الدين الجديد قد تمكّن أن يستبدل تلك القيم أو يهذّبها بشكلٍ كامل، بل إنّ التراث والتقاليد المحليَّة التي كانت سائدة قبل ظهور الإسلام والتي استمرّت في العيش بعده، لم تمت كليّا كما يتوهّم الكثيرون، بل لقد استمرّت في العيش والتعبير عن نفسها بأشكال متفاوتة. ولقد ظهرت بوادر قيم الجاهليَّة الرابضة في لا وعي الصحابة منذ اللحظات الأولى للخلاف الذي نشب بينهم بعد وفاة النبي مباشرة، ولهذا حل منطق القبيلة بديلاً عن منطق العقيدة وحكمت لغة الأمر الواقع بدل لغة التفاهم والحوار.
ورغم أن لظاهرة العنف وعلاقته بمقدّسات المجتمع جذراً نفسيّاً يرتب بطبيعة التكوين البشري حيث المصالح الذاتيَّة مقدّمة على المصلحة العامّة، وأن الأنوية هي الأساس والجماعيَّة تحتاج إلى تربية وترويض للنفس، كذلك ترتبط تلك النزعة بجذر ديني يتمثّل في التفسير الأيدولوجيا لذرائعي للكثير من النصوص الدينيَّة، بل ابتداع الكثير من النصوص التي لم تصدر عن النبي ولا عن صحابته المخلصين لفكره مطلقا. ومن المؤكَّد أن نزعة احتكار التأويل قد ظهرت في بدايات الدعوة الإسلاميَّة وبالتحديد على يد الخوارج الذين آمنوا أنهم الجهة الوحيدة التي تمتلك حقّ التأويل وإنّ ما عداهم لا يمتلك هذا الحقّ حتى لو كان بمنزلة الإمام علي بما له من مكانة دينيَّة وعلميَّة معروفة لدى جميع المسلمين، بل عليه هو أيضا أن ينصاع إلى آرائهم رغم سذاجة الكثير منها. ولعلّ من سخريات القدر وسوء طالع العرب والمسلمين أن يصبح منهج الخوارج وفكرهم الظلامي المتخلّف هو السائد في حياة معظم المسلمين حتى يومنا هذا.. في حين يعيش فكر ابن أبي طالب بإنسانيّته الرحبة رحابة السماء حبيس الرفوف حتى لدى معظم المتشيِّعين له.
علاوة على ذلك، لعبت ظاهرة الاستبداد الفكري لدى النخبة الثقافيَّة والدينيَّة، دوراً كبيراً في تأجيج ظاهرة العنف نتيجة لشعور الأفراد والجماعات أنهم لا يستطيعون حتى التفكير بحريَّة كونهم محكومون بالعديد من السلطات القمعيَّة بما في ذلك سلطة النخبة، وتكمن خطورة الاستبداد الفكري كونه يفضي بلا شك للاستبداد السياسي، خصوصا حينما يتبنّى الحاكم قراءة هذه الفئة أو تلك للدين وللحياة.
مما نجّم الفكر تقسيم المجتمعات إلى ثنائيّات تعيش حالة من الاحتراب الدائم (موحّد/ مشرك) أو (مسلم/ ذمّي) الأمر الذي أدّى إلى شيوع ثقافة التجزئة بدلاً من ثقافة التوحّد التي أراد الإسلام لها أن تكون أساساً في حركته على مرّ الزمن. لذا فإنّ مسألة التعاطي مع النصّ الديني تعدّ من أخر منابع التطرّف والعنف في الكثير من الأحيان، خصوصاً حين يكون المفتي أو المفسِّر أو المثقّف بشكلٍ عامّ يفكِّر بعقليَّة شيخ القبيلة ويتحرّك في معظم سلوكيّاته وفقاً لأعرافها وتقاليدها.. ورحم الله الدكتور الوردي حين وصف حالة الفصام في شخصيَّة الفرد العربي، مؤكِّدا أنّ “التناقض الاجتماعي كامن في أعماق الشخص العربي، فهو يقلد الشاب الغربي في أفانين الغرام، ولكنّه في الزواج يريد تقليد أبيه وأعمامه وأخواله. أنّه في غراميّاته (دون جوان) وفي زواجه (حاج عليوي).
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.