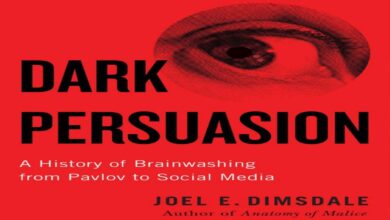ما بعد التنوير العربيّ: الإسلامويّة والعلمانيّة الرجعيّة ورسْمنة الإسلام

تنوير فوقيّ
لا شكّ أنّ علاقتنا نحن المُحدثين بما يُسمّى تارةً بـ«التنوير العربيّ»، وأخرى بالحداثة العربيّة1 ليست بتلك العلاقة اللائقة، ولا المُستحسنة. إنّها علاقة تشاكليّة، وكانت دائمًا صداميّة، لا سيّما وأنّ هذا التنوير العربيّ -بكلّ تنوّعه من لطفي السيّد إلى أركون والجابريّ، بنسخه المُحافِظة والتقدميّة- كان دائمًا فوقيًّا، ولم ينشأ من النّاس تحديدًا. ورغم أنّ هناك حركات اتخذت التنوير رايةً لها وفي الوقت نفسه انحازت لأصوات النّاس، في منتصف القرن العشرين، إلّا أنّ أغلب تلك الحركات انتهت إلى ما يمكن أن نسميّه بـ«الفوقيّة المطلقيّة». وأعني بالفوقيّة المطلقيّة تلك النّزعة التي لا تجدُ في تحقّقها، لا نفسها، إلّا شكلًا فوقيًّا محتومًا بالدّولة. وبما أنّ الدوّلة هي شرطٌ بنيويّ يهيكلُ الشّرط الحديث بمجمله، حتى إنّ ما هو دينيّ بهويّاته وحركاته وهو يسعى للإفلات منها، يدخلُ في اشتباكٍ معها تهيكله هو أيضًا2، فإنّ التنوير العربيّ دائمًا ما انتهى لنهاية بسيطة وواضحة: إمّا محض التأليف، أو إنشاء «علمانيّة رجعيّة».
كانت الفكرة التنويريّة بسيطةً في حجّتها. فهي تقوم على فرضيّة مسبقة بانحدار حاصلٍ فيما تسمّيه «الثقافة الإسلاميّة»، ولا بدّ من تجاوز هذا الانحدار إمّا عبر إحياء أصوات وسمها التنويرُ العربيّ بـ«العقلانيّة»، كالاعتزال في مقابل الأشاعرة، وكابن رشد في مقابل الغزاليّ3؛ وإمّا عبر اكتشاف خلل ما في «التقليد» بكامله، ومن ثمّ الارتماء في تقاليد أوروبيّة أخرى، وإعلان القطيعة مع التقليد الإسلاميّ المُنتِج (العرويّ رائدًا ههنا). أي، كان تنويرنا ثقافيًّا، يقوم على اعتقادٍ بتغيير الثقافة لتغيير الواقع، وذلك التغيير لا يتأتّى إلّا بعمل المفكّر الذي يقفُ ضدّ خرافات التقليد (ما أسماه الجابريّ بالبيانيّة) مناصرًا العقلَ البرهانيّ في ذلك التقليد؛ أو بالقطيعة بأكملها والاعتراف بأنّ أوروبّا هي اكتمال العقل والعقلانيّة.
في السياق ذاته، اقتصرت مساءلة هذا الإرث التنويريّ غالبًا على أبعاده الفكريّة، دون اختباره سياسيًّا. ولمّا كان السياسيّ، كحقلٍ متمايز، أو كقارّة بتعبير ألتوسير، فإنّه وفّر دائمًا مساحات للتمظهر وللعرْض وللتبدّي الأنواريّ العربيّ. وأثبتَ، في أحيانٍ كثيرة، أنّ التنويريّ العربيّ لربّما كان رجعيًّا في سبيل تحقيق تقدميّته الفوقيّة-الفكريّة. وتلك هي العلمانيّة الرجعيّة. وقد تمثّلت هذه العلمانية في التاريخ العربيّ الحديث على مراحل عدّة. لكنّي مشغولٌ ههنا بتمثّّلها الأكثر جدّة، ذلك التمثّل المرتبط بـ«الإسلام الرّسميّ» الذي تسعى الدّول العربيّة حاليًا بعد فشل الرّبيع العربيّ على العمل عليه. فقد كانت الهبّات العربيّة الشعبيّة منذ أواخر 2010 بمثابة امتحان لكافّة القوى المتنازَعة، وللأجندات الفكريّة والسياسيّة المطروحة، والتي، في كثيرٍ منها، بدا أنّها لا يمكن لها بحالٍ أن تكون إلّا من فوق، لا من تحت، وأنّ الرّجعيّة هي المآل.
العلمنة عربيًّا وتعريف الدين الرّسميّ
أيّة علاقة تلك بين الإسلام الرّسميّ والعلمانيّة الرجعيّة؟ وكيف يلتقي زواجان مفهوميّان -الإسلام، العلمانيّة- كانا دائمًا ما يُقدّمان كنقيضين؟
لا شكّ أنّ العلمنة، كما بيّن غيرما واحدٍ، هي مأسسة الدين وقوننته، أي إفراده إلى الخاصّ، وترك «العامّ» للعقل الذي يُوضَع كرديف للإرادة في مقابل الدّين الرّديف للخصوصيّة والطقوسيّة ووللإراديّة تبعًا. بيد أنّني أدافعُ عن شيء آخر في العلمنة عربيًّا، ألا وهي أنّها لم تسع فحسب إلى خصخصة الدين، وإنّما، في بلدٍ كمصر مثلًا، إلى تعميمه عبر إنتاج نسخة رسميّة منه، كان الأزهر حاملها في أغلب تاريخنا المعاصر. هذه النّسخة الرّسميّة ليست بالضرورة -كما لا أُريد أن يُفَهَم كلامي خطأً- نسخة خاطئة من تأويل الإسلام، أو ليست من «الإسلام» في شيء. فالإسلام، كتشكّل خطابيّ، وكتقليد حيّ، تتنازعهُ الجدالات المحمومة، ولا يبقى مستقرًّا وحيًّا إلّا في اللحظة التي يمارسه فيه المسلمون على أنماط شتّى وفق تمثّلهم لمفهوم الإسلام. والتعريفُ فوقانيّ وسلطويّ كما نعلم. ولذا كانت الممارسة هي التعريف، لأنّها من التقليدُ، وإليه ترتكز، وفيه تطوّر.
لقد نُظرَ إلى العلمنة، عربيًّا في العادة، باعتباره سيرورة من التنكيل بالدّين، أي من إبقائه في حيّز الفرديّ، وإخلاء حيّز العموميّ للعقل والتدبير. لكنّ ذلك ليس سوى بلاغة. فكما بيّن طلال أسد، إنّ العلمانيّ والدينيّ متشابكان لدرجة يصعبُ فيها فصل أحدهما عن آخر. وفي العالم العربيّ، كان السعيُ دؤوبًا نحو علمنة تامّة، وإقناع للجماهير بخصوصيّة دينهم. لكن، وعندما كان التنويرُ العربيّ في سعيه هذا، فإنّه كان ينتجُ دينًا برعاية الدّولة، دينًا عموميًّا مروّضًا ومحجّمًا. وقد أبان ما يُسمّى الربيع العربيّ وصعود الإسلامويّة -غير المفاجئ حقيقةً- عن ذلك. حيث طالبت القوى العلمانيّة التنويريّة العربيّة الدولة (ممثّلةً في أجهزتها الأمنيّة والعسكريّة بالأساس)، بصراحةٍ وجلاء، بالتدخّل في الشأن الدينيّ، أي بحماية الدّين من الإسلامويّة التي ينظرون إليها كأيديولوجيا دخيلة، ستعصفُ بالدين في زمن التغيير، حسب رضوان السيّد، والذي سأعود في نهاية المطاف للدخول معه في نقاش حول أفكاره الأخيرة.
إذًا، تاريخيًّا، لم يكن الدينُ شأنًا عامًّا، وإنّما معنى محدّد له هو المسموح بالتعامل معه، ونبذ جميع «الإسلامات» الأخرى المعروضة في المجال العامّ باعتبارها ليست الإسلام الصحيح. أي إنّ تحديد الدين وتعريفه هو جوهر سيرورة العلمنة. وقد أوضحت صبا محمود في كتابها «الاختلاف الدّينيّ في عصرٍ علمانيّ» كيف أنّ الدّولة الحديثة التي تزعمُ الحياديّة في الشأن الدينيّ إنّما هي متورّطة بما تسمّيه محمود بـ«تناقض توليديّ»: فلا يمكنها السّماح بالدّين هكذا دون تحديد ماهيته ودوره وفاعليه الاجتماعيين حتّى، وفي الوقت ذاته تزعمُ الحياد تجاهه. وعليه، فالدّين هو شغلُ العلمانويّة السياسيّة. وههنا، ليست المشكلة في أنّ الدين لا يمكن إنشاء تعريف كونيّ له، وإنّما في التعريف الذي تقوم به سلطات فوقانيّة سياسيّة.
من البيوسياسة إلى الدين-سياسة
لقد طرحَ فوكو في سبعينيّات القرن المنصرم فكرة البيوسياسة (Bio-politics) كنمط اشتغال للدّولة، باعتبار أنّ الدّولة تتدخّل في الإنتاج الحيويّ للذّوات الانضباطيّة. لكن من تقليدٍ آخر، وعربيًّا تحديدًا، يمكن القول أيضًا إنّ الدّولة العربيّة أصبحت «دين-سياسيّة»، بما أنّها تقوم بضبط المجال الدينيّ، والخطب، وطبيعة ما يُعرَض من الدين، ومَن المسلم من غير المسلِم، وما هو الدّين ماهيةً وجوهرًا. هذا الدّين الرّسميّ كان دائمًا محلّ ترحيب ممّا قمت بتسميتها بالأعلى بـ«العلمانيّة الرجعيّة». وفي الحقيقة، إنّ الدين الرّسميّ دائمًا كان محطّ ترحيب من كلّ العلمانات؛ فالعلمانويّة السياسيّة، تحديدًا، هي تعريفُ الدين من قبل الدّولة بشكلٍ لا يسمح بنشوء «سيادات منافسة» في المجال العامّ. وإذا كانت الدّولة لها السيادة فلا يمكن لسيادة منافسة أن تطرح نفسها.
لقد حاولت الدّولة العربيّة إنتاج هذا الإسلام الرّسميّ على أشكال عدّة، في مصر كان الأزهر، وفي السعوديّة كانت المؤسّسة الوهابيّة. وترافقت سيرورة إنتاج هذا الإسلام الرّسميّ مع تعريف إسلامات بديلة. إسلام سياسيّ تحديدًا. أقصدُ أنّ الدّولة ليست سلطويّة فقط، وليست بيو-سياسيّة فقط، بل أيضًا، كما ذكرت عاليه، دين-سياسيّة بهذا المعنى. أي بمعنى أنّها تحدّد الإسلامَ من اللاإسلام، أو لنقل، تُحدّد الإسلام الصحيح، من آخره «غير الصحيح». ولما كان التنوير العربيّ مشروعه السياسيّ هو «العلمانيّة الرجعيّة» فعلًا، فلم يكن له كبير همّ في العلن مع هذا التحديد الدولتيّ للدين، بل سعى إليه دومًا؛ خوفًا من الاستثمار الماديّ والخطابيّ للإسلام من قبل الإسلامويين، وتأثيرهم. (لا يمكن أن تجد علمانيًّا محافظًا سيدافع عن عدم تحديد الدوّلة للدين، وتركه للممارسة، وللنّاس الذين جاء الدين لأجلهم. فلأنّه سلطويّ، لن يسمح لسيادات منافسة ببساطةٍ).
صحيحٌ أنّ التنويريّ لديه مشكلة فكريّة مع هذا الإسلام -أحيانًا في قراءته للإسلام، أو في أشعريّته تحديدًا. لكنّهما سياسيًّا متحدان. لذا، لن يجد أصحاب أطروحات علمنة المجتمع العربيّ عبر تقديم قراءة للإسلام هي، برأيهم، جديدة، مشكلة مع هذا الإسلام، ولا المؤمنون بالإسلام الرّسميّ سيجدون مشكلة مع علمانيّة رجعيّة. وتلك هي نسخةُ العالم العربيّ الدينيّة ما بعد الرّبيع العربيّ. عالمٌ فوبيائيّ من الإسلامويّة لدرجة حكمت التنقاضات الحالية بصورة فجة. ولدرجةٍ أيضًا جعلت الاصطفاف من شتّى السُّبل في سبيل تهديم هذا العدّو الخطير، الأصوليّ، اللعين.
لكن، وبما أنّ التنوير عربيًّا تناقضيّ، فالإسلامويّة كذلك. هي صراعٌ على الإسلام أيضًا وتحديده. إنّها ليست إحيائيّة. إنّ الإسلامويّة ضدّ التقليد، مثلها مثل الأنواريّة العربيّة. وهذا ما قاله طلال أسد من أمد، ويقوله هذه الأيّام الدكتور رضوان السيّد الذي أودّ الوقوف عنده في الختام.
أزمنة التغيير، ومعادة التقليد، والإسلامويّة
يعملُ رضوان السيّد على طرْح شديد البساطة، لكنّه مستمدّ من مجمل أبحاثه السابقة عن الجماعة في الإسلام والفكر السياسيّ الإسلاميّ. هذا الطرْح خلاصته هو التالي: كلّ تيارات الفكر العربيّ الحديث، إسلّاميًّا وعلمانيًا، من حسن البنّا إلى محمد أركون، تقطعُ مع التراث، وتلعن هذا التراث، وترى أنّ مشكلة الإسلام في «قروسطيّته» التي ما زالت ممتدّة من اليوم. لا يختلفُ في ذلك سلفيّ مع حداثيّ، ولا إسلامٌ سياسيّ -من مصر إلى إيران- أو اشتراكيّون ثوريّون، إلخ. كلّهم خارجون عن التقليد، بل «يلعنونه»، ويؤسّسون -أو لنقُل يدعون إلى- فكرًا إسلاميًّا جديدًا.
مَن أفلتَ من هذه «القطيعة المعمّمة»، برأي رضوان السيّد، هي المؤسّسة الدينيّة «الرسميّة»؛ أي الأزهر والزيتونة إلخ، ومن ثمّ كانت كلّ الحركات السابق ذكرها تقطع مع هذه المؤسّسات ولا ترى حاجةً لها أصلًا، بعضها من موقفٍ علمانيّ مثلًا، وبعض منها من موقف إسلاميّ يرى أنّه لا «مؤسّسة» في الإسلام.
وفي ضوء «أزمنة التغيير»، كما هي عبارة رضوان السيد، تضاعفَ الهجومُ على المؤسّسات الرسميّة إضافةً إلى الدولة الوطنيّة، ومن ثمّ يحدثُ عصفٌ بالأمّة. وبالتالي، يقترحُ علينا السيّد أنّه لا بدّ من «صون الدين في زمن التغيير»، كما هي عبارته، لكنّ ذلك عن طريق أمرين:
أولًا، عن طريق التخلّص من كلّ الإصلاح الدينيّ «القطائعيّ»، والتخلّص من الإسلام السياسيّ عبر تقوية المؤسّسات الدينيّة الرسميّة ضدًّا للجماعات السابقة التي ستعصفُ بـ«الأمّة». لأنّ المؤسّسة الرسميّة هي مَن تحفظُ التقليد السّنيّ، وهي من تجمع على النّاس أمر دينها الذي تبدّد في أزمنة التغيير. ثانيًا، عبر تقوية الدولة الوطنيّة في مواجهة المشاريع الأخرى المطروحة حول الدولة. ودعوني أجازف فأقل المشاريع «الديمقراطيّة»، لأنّه في حقيقة الأمر، الأنظمة الوطنيّة بعد الاستقلال (في مصر مثلًا) لم تكن ديمقراطيّة.
تبدو، لأوّل وهلة، كلمات السيد ذات وجاهةٍ، لكن عند تفحّصها نجد أنّها أصلًا لا تفعل شيئًا سوى إبقاء للوضع على ما هو عليه، وأنّ هذا الكلام، في نهاية المطاف، هو تخلّص من رجّة الثورات العربيّة تحت أجندات «علميّة». لأنّ مساءلة بسيطة لهذه الأفكار تُظهر عدّة مشاكل: أولًا، الدولة الوطنيّة التي يريد السيّد تقويتها هي أصلًا مَن خرجت الثورات ضدّها بالأساس، هذه الدّول التي انبنت على أجساد وعظام النّاس العاديين. كما إنّ الأزهر، والمؤسّسة الرسميّة عمومًاَ، كانت ولا تزال كيانًا متحالفًا مع هذه الدّولة، أيًّا كان أو يكن شكل هذا التحالف، ومن ثمّ فهي كانت جزءًا لا يتجزّأ من تدعيم هذه الدّول الوطنيّة، وبالتالي جزءًا من أجندة الاستبداد. ثالثًا، هناك جمعٌ حداثويّ عند السّيد بين الدين والأمّة والدّولة، وهو يشارك التنويرَ العربيّ موقفَه السياسيّ تحديدًا بتحجيم الدّين من قبل دولة وطنيّة عبر إنشاء إسلام رسميّ. يعني، في الوقت الذي يرى السيّد أن يحرّر الدين من الإسلامويّة، فإنّه يسلمه إلى السّيادة، إلى السياسيّ بمعنى كارل شيمت لما هو سياسيّ، الذي سينتجُ إسلامًا رسميًّا. أي إنّ موقف السيّد ههنا ليس دفاعًا عن التقليد، وصونًا له، بل مأسسته ورسمنته من قبل السياسيّ.
لذا، لا يمكن بحال قراءة إحيائيّة رضوان السيّد فكريًّا فحسب، بل لا بدّ من تسييسها لفهمها، لأنّها، والحال كذلك، نشأت في سياقٍ سياسيّ متغيّر، في أزمنة التغيير -بتعبير السيّد نفسه-، وهي لا تدعو إلى إصلاحٍ فكريّ لإسلامٍ سنيّ قائم، بل إلى تعزيز أنظمة سياسيّة رجعيّة من الخليج إلى مصر تعملُ بداخلها هذه المؤسّسات.
لذلك، يتخيّل السيّد الجميع أعداء له وللمؤسّسة الرّسميّة، ويُحاول أن يجانس بينهم بطريقة ما: فالإسلامويّ الإخوانيّ يتجانس مع الأركونيّ والجابريّ في كونهما يرفضان التقليدَ. وفي حين أنّ رفض الإسلامويّ للتقليد لا يمكن ترجمته لـ«صيغة رفض» تمامًا، وإنّما، برأيي، لـ«صيغة اصطناع وتخيّل»، فإنّ الآخرين يرفضونه من منطلق حداثويّ كما هو معلوم. فأنا لا أرى أنّ الإسلامويين والأزاهرة، مثلًا، يتنافسون على مرجعيّة واحدة، حتى وإنْ جمعتهم هذه المرجعيّة. فالإسلام السياسيّ لا يتنافس على تحقيق الماضي (وإنْ ادّعى الخلافةَ شعارًا له) وإنّما يجابه الحاضر بأسلحة ملفّقة. فهو عندما ينادي بـ«تطبيق الشريعة» إنّما يدّعي تراثيّة دعوته، في حين أنّها نداءٌ حديث، ولا يمكن فهم فكرة تطبيق الشريعة إلّا في السياق الحديث نفسه.
وعليه، فالسيّد لا يسيء فهم الإسلامويّة فحسب من حيث هي بناءٌ أيديولوجيّ حداثيّ، وإنّما أيضًا ينحازُ لمشروع الدّولة-الأمّة بصبغته الأزهريّة، والمؤسّساتيّة الدينيّة عمومًا، خوفًا على الإسلام من شطط الحَركيين والحداثيين. والمؤسّسة، التي بدا أنّها عادت الانتفاضات منذ البداية، تعود اليوم إلينا عبر رضوان السيّد (بل وعبر خطابات الدّولة الوطنيّة) كحارسة للإسلام السنيّ من تهديدات بنيه الداخليين.
خاتمة
لا شكّ أن التناقضات التي تحكمُ العالم العربيّ بشأن مسألة الدين والعلمانيّة تقعُ في صلب مسألة كوننا نقف فيما بعد هذا التنوير وفيما بعد هذه الإسلامويّة. وإذا كان من خطرٍ ما، فإنّه النظر إلى التيارات الفكريّة والأيديولوجيّة العربيّة عبر طرح هذه التيارات لنفسها بما هي كذلك وبما تقدّمه، وإنّما يجب اختبار التقاطعات بينها، التي تصفها هي كتناقضات، عبر عدسة السياسيّ التي تؤلّف تلك التيارات المتلبّسة بلبوس التناقضِ ظاهريًّا، وهي واحدة في العمق، ربّما. ولا يمكن بحال فصل ذلك كلّه عن الشّرط التناقضيّ الذي نعيشه، ونسائله. أي هذا الشّرط المحكوم بنقائض إمّا، وإمّا، ويكأنّ التناقض قدرٌ لا مفرّ منه.
_________
الهوامش:
1) يرى كثيرون أنّ هذه الحداثة العربية عاجزةٌ عن التّمام بسبب أبعاد دينيّة عند العرب، أو بسبب عوائق إبستمولوجيّة متعلّقة بطبيعة النّقل عن الغرب، والتي يرى، أيضًا، فريق أنّها تمّت أدبيًّا، وفشلت فلسفيًّا -كالمرحوم جابر الأنصاريّ، وأدونيس.
2) أي إنّ الدينيّ الحديث محكوم بالدّولة بنيويًّا.
3) لا شكّ أنّ أبا الوليد ابن رشد احتلّ
مكانةً ربّما لم يحتلّها أحدٌ غيرها في الفكر الأنواريّ العربيّ، حتى إنّه يجوز لنا
القول برشديّة هذا الضرب من التنوير.
______
*المصدر: حبر.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.