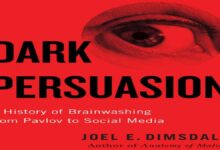حيويَّة تكامل المعرفة في التعليم

تخلّف التعليم أصبح واضحاً اليوم في واقع المجتمعات الإسلاميَّة، وليس ثمَّة عذر
لدينا مع شيوع الأمثلة الجيّدة في تاريخ المسلمين في مجّانيَّة التعليم وانتشار
المكتبات العامّة ومراكز العلم، مع سهولة الوصول إليها، فضلاً عن الجهود المنظّمة
لحركة الترجمة وتوفّر الكثير من العلوم المتراكمة في العالم.
في 17 حزيران (يونيو) 1744 تفاوض المسؤولون في ولاية ماريلاند وفرجينيا، مع الهنود من الأقوام الستة في لانكستر بولاية بنسلفانيا بغرض إقرار معاهدة، دعي فيها الأمريكان الهنود إلى إرسال أولادهم إلى كليَّة وليام وماري لتعليمهم اعتماداً على أساس العالم الحديث. في اليوم التالي رفض الهنود العرض:
” نحن نعرف إجلالكم الكبير لنوع التعليم الذي يدرس في تلك الكليّات، وأن إعالة والحفاظ على شبابنا معكم، سيكون مكلفاً جداً. نحن مقتنعون بأن ما تقصدون فعله لنا جيد، ونشكركم من صميم القلب.. ولكنكم، وأنتم أهل الحكمة، تعرفون أن الدول المختلفة لديها مفاهيم مختلفة للأمور، وسوف لا تشعرون تالياً بالنقص عندما نقول بأن التعليم عندنا يختلف عما عندكم. لدينا بعض الخبرة في ذلك، فالعديد من شبابنا تمّت تنشئتهم في كليّات المحافظات الشماليَّة. وتعلّموا جميع العلوم الخاصَّة بكم. ولكن عندما جاؤوا إلينا، كانوا عدائيّين سيئين، يجهلون كل وسائل العيش في الغابة، لا يصلحون للصيد، أو أن يكونوا مستشارين، كانوا تماما جيدين في لا شيء”.
في دراسته للرؤية الكونيَّة لدى سكّان أمريكا الأصليّين، الهنود الحمر، يقول الفيزيائي “ديفيد أف بيت” إنّ الثقافة الغربيَّة لها ميل طبيعي نحو التحذير، المساعدة، التعليم، الإرشاد والتحسين، بدلاً من السماح للناس في التعلّم من تجاربهم، ويروي قصّة جو كوتور، الأخصّائي في العلاج والعلاج التقليدي، الذي يستكشف فيها الآثار المترتّبة على هاتين الطريقتين للمعرفة والصدام بين التعليم الغربي وذلك الذي للهنود الحمر. وتظهر القصَّة كيف أن تعليم الناس التقليدي الذين يرون قصصاً متجذّرة في التجارب الملموسة الخاصّة بدلاً من إضفاء حقائق أو تطبيق تفكير منطقي مجرّد. في هذه الحالة الهندي الأكبر سنّاً من سكّان أمريكا الأصليين، واصفاً تجربة حفيده في مدرسة محلّيَّة، رأى أن لا حاجّة لتحليل الفلسفة التربويَّة في المدرسة، ولا مناقشة القيمة النسبيَّة لاختلاف وجهات النظر العالميَّة.
أرى أنّ الأمم المختلفة لها مفاهيم مختلفة للأمور. خلال التعليم تنقل أية أمّة، أو مجتمع، أو حضارة، بوعي المهارات المتراكمة والمعرفة والحكمة من الماضي للأجيال المقبلة. التعليم ليس فقط للحفاظ على الهويّة الثقافيَّة والإرث التاريخي للمجتمع، ولكن يضمن لها البقاء كهويّة مميزة. أنها تقدّم النظرة التي من خلالها يسعى المجتمع لحل مشاكله، ويحدِّد بذلك العلاقات الاجتماعيَّة والنشاط الاقتصادي، والتعبير عن منطق ذاتها. ودفع آفاق المعرفة إلى أقصى حدودها، وتستمرّ في العيش ككائن حي، وقد أدرك الهنود أنّ التعليم المقدّم لهم من قبل حكومة الولاية لم يتجهّز الشباب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها من أجل البقاء، الأسوأ أنّها تهدِّد بقاء ثقافتهم ومجتمعهم.
حكاية الأقوام الستّة تشير أيضاً إلى مأزق، إذ أنهم كانوا على حقّ في الحكم على الطرق الجديدة للمعرفة بأنها ليست مناسبة لمجتمعهم في ذلك الوقت، لكن هذا الاختيار كان للحفاظ على ثقافاتهم أو إنقاذهم من التدهور الكارثي.
المفارقة الكامنة التي تشكّل جوهر المشكلة أمامنا، وليس فقط في مجال معيّن من التعليم، ولكن أيضاً في مجال أوسع للتغيير هو في المنظومة المعرفيَّة وأثرها على ارتقاء وسقوط الحضارات.
الهنود، أقرب إلى المسلمين الذين اتبعوا مساراً مماثلاً في وقتٍ لاحق، ولم يقدّموا لأنفسهم أية خدمة من خلال تمسّكهم بجهلهم في تفاوت القوّة المعزّزة من قبل الاستعمار الذي قاد الهنود للانقراض، ثمّ المسلمين لاحقاً على الخضوع من أجل مواجهة هذه المفارقة الأساسيَّة.
نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن ومواجهة حقيقة أن قيمنا الروحيَّة والأخلاقيَّة لا يمكنها البقاء على قيد الحياة مع زوال القوّة لحماية المجتمعات من القهر. وثمّة استنتاج لا مفرّ منه هو أن واجب المجتمعات الإسلاميَّة إدراك تقدير وتحقيق درجة من التميّز في المعرفة المعاصرة.
التوحيد من البديهيّات الأساسيَّة في الإسلام، بدءاً من توحيد الله، والمبدأ الأوّل للإسلام في خطّة العمل يقودنا بشكل منهجيّ إلى وحدة الخلق (النظام الكوني) ووحدة المعرفة، ووحدة الحياة (الوجود الإنساني كأمانة مقدّسة، أمانة من الله، والإنسان بوصفه وصيّاً وخليفة، في رحلتنا الأرضيَّة) وحدة الإنسانيَّة، وأخيراً الطبيعة التكامليَّة في الوحي والعقل. هذه البديهيّات جميعها تقدّم لنا إطاراً ممتازاً لكل من يسعى وراء المعرفة وإصلاح التعليم الإسلامي.
الطريق إلى الإمام ضمن إطار شامل للوحدة هو “التجديد” أو إعادة اكتشاف” هذه المهمَّة، مع الأخذ بها إلى الأمام من أسلمة إلى تكامل المعرفة. أزعم بإيجاز في نقد سابق للأسلمة، حيث غرست بالفعل مع الميتافيزيقيا المادّيّة والغربيَّة، والأخلاق العلمانيَّة في تطوّر مستحضرات التجميل المعرفيَّة لشدّ الوجه لا أكثر ولا أقل، وفي أفضل الأحوال سيكون إدامة الانقسام بين المعرفة العلمانيَّة والإسلاميَّة، المشروع يحرص على تجنّبه.
أرى أن الفردانيَّة لا يمكن أن تفهم بشكلٍ صحيح في حدود الحداثة، وما بعد الحداثة والعلمانيَّة والاختزاليَّة والشكليَّة والطبيعيَّة، والعديد من العقائد الأخرى المنتهية التي أوصلتنا إلى حافّة الفوضى في المقام الأوّل. ولعل إنشاء المؤسّسات الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة والثقافيَّة ليس فقط لتلبية احتياجات محدّدة وتحقيق أهداف معينة، ولكن لتحقيق قيم معيّنة. إذ نسعى وراء المعرفة ليس فقط للحصول على قدر أكبر من التفاهم واتّخاذ إجراءات أكثر فاعليَّة في العالم الحقيقي، ولتعزيز بعض المبادئ التي تدمج المعرفة مع قيمنا، والتأكيد على الترابط بين الخلق وتضافر البشريَّة في تعزيز المساواة والعدالة وصون الحياة.
على أيَّة حال هناك الكثير من الأسباب لهذه الأزمة، أوّلها الأسباب الداخليَّة الخاصَّة بالمسلمين فيما يتعلَّق بغياب المعرفة الحديثة، وهيمنة منظومة وإطار مفاهيمي قديم، وتبجيل الحفظ الشفهي للقرآن، ونفرح لأنَّ فتية صغار حفظوا كتاب الله عن ظهر قلب من الغلاف إلى الغلاف. لكن هذا ليس بتعليم حقيقي، التلقين والحفظ بدأ مع القرآن وأصبح المنهج الرسمي المعتمد للتعليم الديني، أصبح اليوم العائق نحو تطوير الحسّ والوعي اللذين يركّز عليهما القرآن. تعلّم القراءة والكتابة ليس بهدف القرآن فحسب، وإنما لولادة ثقافة، وإنتاج معرفة جديدة ليست مكتسبة وبناء حضارة فاعلة ومزدهرة. وهي الأدوات الأساسيَّة التي علّمها الله لنا لتسهيل التواصل، وغرس الأفكار في البشر.
لا بدّ من القول إنَّ هناك العديد من الأسباب المتعلّقة بنكوص المجتمعات الإسلاميَّة أهمها قلّة الاستثمار في التعليم وتعليم التلقين والحفظ والتشنّج بين التراث والعصرنة والدفاع عن الاستقلاليَّة الثقافيَّة، إلى جانب تبعات التاريخ والتخلّف وميراث الاستعمار. ولعلّ مواجهة الأمّيَّة في المجتمعات الإسلاميَّة اليوم تعتبر من المهام الضروريَّة، ومن واجبات المؤمن والمؤمنة الحثّ على التعليم باعتباره مسؤوليَّة دينيَّة ودنيويَّة.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.