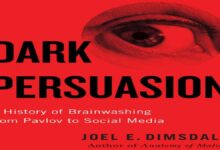يتحرّك العالم الإسلامي، والعربي على وجه الخصوص، بخطى بطيئة، مخلِّفة جماعات متناحرة ومتنافرة تمضي إلى هاوية التدمير الذاتي، وبعكس حرّيَّة العالم السائر باتّجاه التطوّر والتقدُّم والانفتاح والتكامل ضمن كيانات كبيرة.
وتمثِّل العولمة في القرن الحادي والعشرين ظاهرة ومتطوّرة تعكس إحدى مواصفات مجتمع شديد التعقيد، وتحمل بين طيّاتها السلبيّات والإيجابيّات معاً، وهي ظاهرة تغور في عمق الفاعليَّة الإنسانيَّة ولا يمكن عكسها بسبب تطوّر القواعد والأنظمة الاقتصاديَّة، فضلاً عن الترتيبات الماليَّة المرتبطة بالسوق.
وجوهر سلبيّات العولمة يكمن في سيطرة اقتصادّيّات البلدان المتقدّمة على الشعوب النامية، فضلاً عن الحدّ من تطوّر اقتصادّيّات وأسواق وإنتاج الشعوب الفقيرة والضعيفة، ممّا يجعلها في منافسة غير منصفة مع القوى المتطوّرة خلال عمليَّة تفاعلات العولمة.
لكن يصعب حقّاً تفهّم الشكّ المبالغ من قبل المسلمين للعولمة باعتبارها المنعطف الأهمّ في تاريخ البشريَّة المعاصر، وتكمن أسباب الشكّ في عدم قدرتهم على دراسة إيجابيّاتها وما يمكن الاستفادة منها، خاصَّة في الدول التي هي بحاجة إلى توطين التكنولوجيا وريادتها لاقتصاد فاعل لإنسان المجتمع المعاصر، والتدفّق الحرّ للمعلومات لتوسيع الآفاق والمدارك والتجارب في حرّيَّة التعبير والنقد، ولن تستطيع أيّة أمَّة من الأمم الإسلاميَّة الانعزال في عصر العولمة حتى لو أرادت ذلك، كما أنّها لا تتمكّن من فعل أي شيء، وإن رغبت بذلك وما يهمّ المسلمين في عمليَّة العولمة هو مشاركتهم الفاعلة، الأمر الذي يزيد من مساهمة المنظّمات أو المؤسّسات غير الحكوميَّة لتركيز دورها، خاصَّة العاملة ضمن قضايا أساسيَّة تهمّ الإنسان كالبيئة والمناخ والصحَّة العامَّة وغيرها.
وتناسب العولمة النظر العالميَّة للقرآن وإمكانيَّة نشر قيمه بوجود الوسائل والأدوات المناسبة بين أبناء البشر والمساهمة في تعزيز النظام الأخلاقي العالمي المرتبك.
ولا تمثِّل العولمة ثقافة أو فكراً واحداً، كما يعتقد الكثير من المسلمين، إنما تقدّم ثقافة كونيَّة مشتركة يتكوَّن إطارها من الثقافات الذاتيَّة لشعوب الأرض، وتدعو كذلك للتعدّديَّة والتنوّع في الأديان والثقافات واختلافهما كظاهرة أو سنَّة طبيعيَّة في الحياة لا يجوز تجاوزها.
رفض المسلمين الواضح للعولمة وتهويل سلبيّاتها ناتج عن ثقافة ذهنيَّة مهيمنة تعتبر أن كل ما يأتيها من خارج ثقافاتها، غزواً وتحدّياً يجب مقاومته ومحاربته، لذا لا يمكن التمييز بين التقليد الذي يعني النقل غير الواعي والمكتمل، والتأثير الذي يحوي بين طيّاته مضموناً يستطيع أن ينمو ويكبر ليصبح إبداعاً جديداً لواقع متجسّد في فجوة أفكار وفراغ وقيادات وانحسار مفاهيم.
كما يمكن القول إنَّ المسلمين لم يستطيعوا تطوير القيم القرآنيَّة المنسجمة مع نظرة الإنسان أو ذات علاقة بعالميَّة التوجّه، كما في مفهوم الأمَّة، على سبيل المثال لا الحصر، حيث لم يخرج المفهوم من بعده الفكري التاريخي القائم على دار الحرب ودار الإسلام إلى بعده الاجتماعي الحضاري لاستيعاب ضمن إطاره العلاقات الاجتماعيَّة بين أبناء البشر من مسلمين وآخرين.
ويعكس الاستحواذ في ذهنيَّة الفرد والمجتمع على الداخل (المتشابه) عن الآخر (المختلف) الداخلي أو الخارجي، ممّا يعزِّز الانكفاء على الذات والعزلة والشعور بالهزيمة والإحباط والإذلال ومحاولة التعويض عنها بالحقد والكراهية كنوع من إعادة الثقة المفقودة بالنفس ومحاولة التغطية على حالة الضعف، وهذا ما يشتِّت المسلمين إلى طوائف صغيرة في البلد الواحد، ودفعهم إلى عصر ما قبل القبيلة عكس ما تقوم به عمليَّة العولمة وتجمّعاتها الكبيرة.
وهنا تأتي الدعوة للحكومات والمجتمعات والمؤسّسات والأفراد المسلمين في العمل حثيثاً لإفراز نظم معرفيَّة وتربويَّة وتعليميَّة قائمة على العقل والتفكير الموضوعي والإبداع والتطوّر والبناء والتداخل مع أبناء البشر، بعيداً عن التلقين وظاهرة الصوت والحقد والكراهية وقيم الموت والانتحار، إضافة إلى إنشاء مؤسّسات عصريَّة تعمل على تطوير خبرات الإنسان وأدواتها المنسجمة مع روح وحركة المجتمع المعاصر، وإطلاق العقل للمباشرة في تأسيس علوم جديدة كأصول العقل أو مبادئ المعرفة أو علم كلام جديد قائم على المحبَّة والتسامح وغيرها من القيم الإنسانيَّة، عندئذٍ نكون قد بدأنا المسيرة الطويلة في طريق الانفتاح والتطوّر والتكامل.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.