تلاعبُ الهويّة المُغلقَة بالمعرفة

لكلِّ مجتمع ديانتُه ولغتُه وثقافتُه وتاريخُه وجغرافيتُه، لكن ليس لكلِّ مجتمعٍ قوانين تطوره الخاصة التي ينفردُ بها. قوانينُ تطور المجتمعات كليةٌ لا يختصُ بها مجتمعٌ دون سواه. المجتمعاتُ تشتركُ جميعاً في أنها تنمو وتراكم تجاربَها وتتطور لو توافرت عواملُ نهوضها، كما أنها تتخلفُ وتتدهور وتنهار لو لم تتخلص من عوامل انهيارها. المجتمعاتُ كلها تسري عليها قوانينُ البناء والتطور ذاتها، وتشتركُ في العناصر الأساسية التي يُنتجُ النهوضَ توافرُها والانهيارَ غيابُها.
منطقُ التاريخ وقوانينُه شاملة، لكن هناك شعوراً كامناً في لاوعي كثير من الناس في مجتمعنا بأنه استثناءٌ في حضارته وهويته ومعتقده وثقافته وتاريخه، وكأن تاريخَه لا يخضع لما يخضع له تاريخُ المجتمعات من قوانين، وثقافتُه تتفوقُ على كلّ الثقافات، وتراثُه يختلفُ عن كلّ تراث، وهويتُه تنفرد بخصوصيات استثنائية. وظلّ الشعورُ بالخصوصية والاستثناء يغذّي الهويةَ باستمرار حتى تصلّبتْ وانغلقتْ على نفسها، حتى بلغت حالةً تتخيّل فيها أنها مكتفيةٌ بذاتها، لأن كلَّ ما تحتاجه في حاضرها ومستقبلها يمدّها به ماضيها. تراثُها منجمٌ زاخرٌ بكلّ ما هو ضروروي لكلّ عملية بناء ونهوض، وعلومُها ومعارفُها الموروثةُ تغنيها عن كلّ علم ومعرفة تبتكرها المجتمعاتُ الأخرى، وهي ليست بحاجة إلى استيراد ما أبدعه غيرُها، لأنه منتجٌ لمجتمع غربي ينتهك خصوصيتَها ويهدّد هويتَها وتتغرّب به. وكانت أكثرُ أدبيات الجماعات القومية والدينية تغذّي هذا الشعور، وتلحّ على الإعلاءِ من مكانة التراث، والايحاءِ بأن بعثَه كما هو يكفل نهوضَ مجتمعنا، ولا حاجةَ للإفادة من علوم ومعارف وثقافات غريبة عنه. وقد بالغت هذه الجماعاتُ في التشديد على ثقافة الخصوصية والاستثناء، حتى انتهى ذلك إلى موقفٍ خائفٍ من كلّ ما ينتمي للآخر ومنجزاته.
في هذا الفضاء ولد موقفٌ هجائي للفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع، تبناه جماعةٌ من الخطباء والكتّاب، فولّد هذا الموقفُ كراهيةً وحذراً شديداً منها، وتعزّزت حالةُ الكراهية هذه حتى صارت من المسلّمات في كثيرٍ من أدبيات الجماعات الدينية. فمثلاً يصنف سيدُ قطب علوم ومعارف البشرية وثقافاتها اليوم بقوله: “نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلامُ أو أظلم.كلّ ما حولنا جاهلية. تصورات الناس وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم وآدابهم، شرائعهم وقوانينهم. حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية، ومراجع إسلامية، وفلسفة إسلامية، وتفكيراً إسلامياً، هو كذلك من صنع هذه الجاهلية!”[1]. أما الفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع فيحكم عليها بجملتها بالجاهلية أيضاً، ويشدد على ذلك بقوله: “إن اتجاهات الفلسفة بجملتها، واتجاهات تفسير التاريخ الإنساني بجملتها، واتجاهات علم النفس بجملتها – عدا الملاحظات والمشاهدات دون التفسيرات العامة لها – ومباحث الأخلاق بجملتها، واتجاهات التفسيرات والمذاهب الاجتماعية بجملتها – فيما عدا المشاهدات والإحصائيات والمعلومات المباشرة، لا النتائج العامة المستخلصة منها ولا التوجيهات الكلية الناشئة عنها – .. إن هذه الاتجاهات كلها في الفكر الجاهلي – أي غير الإسلامي- قديماً وحديثاً، متأثرة تأثراً مباشراً بتصورات اعتقادية جاهلية، وقائمة على هذه التصورات، ومعظمها -إن لم يكن كلها- يتضمن في أصوله المنهجية عداءً ظاهراً او خفياً للتصور الديني جملة، وللتصور الإسلامي على وجه خاص!”[2]. ويبلغ موقف سيد قطب أقصى مديات الرفض، إذ يقول: “وهذه الجاهلية خبثت قديماً وخبثت حديثاً… يختلف خبثها في مظهره وشكله، ولكنه واحد في مغرسه وأصله”[3]. وكلامُه هذا نموذجٌ لطريقةِ تفكيرٍ استلهمتها وتشبّعت بها أكثرُ أدبيات الجماعات الدينية سنية وشيعية، حتى أضحى هذا الفهمُ مرجعيةً استقى منها تفكيرُ ومواقفُ ومشاعرُ عدة أجيال من أتباع هذه الجماعات أمس واليوم.
إن أكثرَ دعاة البحث عن هوية دينية للعلوم والمعارف الحديثة في بلادنا هم ممن تأثرتْ مواقفُهم بفكرة “جاهلية” هذه العلوم والمعارف. وتعد جماعةُ “إسلامية المعرفة” أبرزَ مصداق لذلك في المجال العربي الإسلامي[4]. لذلك كانت دعوتُهم تجد تبريرَها في التشديد على غواية العلوم والمعارف الحديثة وضلالها.
في فضاء هذا اللون من التفكير، المعادي للفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع، وقعَ تفكيرُ المسلم في حيرة، فهو حائرٌ بين أن يدع َكلَّ المكاسب الحديثة لهذه العلوم، وهو موقف يتعذّر اتخاذُه على من يريد أن يحضر في العالم اليوم ، وبين أن يلجأ إلى خيار يحسب أنه يخرجه من المأزق، ويتمثل بالعملِ على إثراءِ رصيدِه من هذه المكاسب من خلال خلع غطاء من النصوص الدينية عليها، وليرضي ضميره بتوهم أن هذه العلومَ دينيةٌ، لأنه استحوذ عليها من خلال هذا الغطاء، فأصبح يتملّكه شعورٌ بأنه هو من أبدعها، وكأن النصوصَ الدينيةَ اكسيرٌ تتبدّل به طبيعةُ الأشياء، فبمجرد أن نسقيها إلى أيّ علم ومعرفة تتبدّل فجأة من دنيوية إلى دينية. من الواضح أن هذه العمليةَ شكليةٌ فارغةٌ من دون مضمون حقيقي.
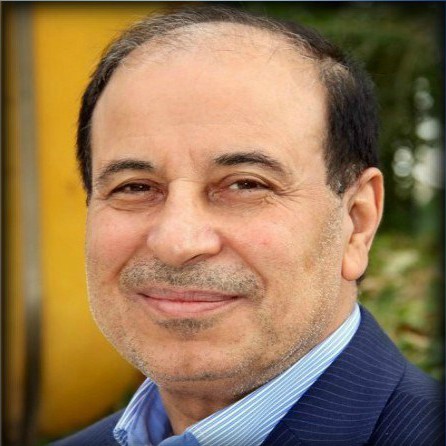
حقلُ العلم غيرُ حقل الدين، وحقلُ المعرفة غيرُ حقل الايمان. وظيفةُ العلم غيرُ وظيفة الدين، ووظيفةُ المعرفة غيرُ وظيفة الايمان. مهمةُ رجل العلم في الحياة غيرُ مهمة رجل الدين. مهمةُ رجل الايمان في الحياة غيرُ مهمة رجل المعرفة. العلومُ كونيّةٌ لا هويةَ دينية واعتقادية وأيديولوجية لها، وإلّا لو حاول كلُّ مجتمع أن يبتكر هذه العلومَ من جديد، ويشتقّها في فضاء دينه ومعتقده وميراثه، بدعوى أن العلومَ تأسرها بيئاتُ وثقافاتُ ودياناتُ من ينتجها، فإن ذلك، فضلاً عن أنه مُتعذَّر لأن البشريةَ احتاجت لآلاف السنين حتى وصلت العلومُ إلى هذه المرتبة، يفضي أيضاً إلى تعدّد العلوم والمعارف بعدد الأديان والمعتقدات والثقافات في المجتمعات البشرية، وهذا ما يكذبه الحضورُ المكثّف للعلوم والمعارف ذاتها في العالَم كلّه. إذ نجدها هي ذاتها ماثلةً في مراكز الأبحاث والتربية والتعليم والتكنولوجيا ومختلف مجالات الحياة، سواء كانت في الولايات المتحدة الأمريكية أو استراليا أو بريطانيا أو روسيا أو فرنسا أو الهند أو الصين أو اليابان أو ماليزيا أو ايران أو تركيا أو مصر.
إن تاريخَ العلم هو تاريخُ تفنيد الأخطاء. تطوّرُ العلم تراكمي، لا يبدأ العلمُ من الصفر في كلّ مرة، ولا تعمد المجتمعاتُ لإعادةِ اكتشاف ما اكتشفه غيرُها، أو البحثِ من جديد عمّا هو ناجزٌ من معطيات العلم. حقلُ العلوم الطبيعية وقوانينُها يختصان بعالم المادة، ويمكن اكتشافُ الطبيعة من خلال التعاطي مع هذا العالم بشكل مباشر، بأدوات ووسائل مادية في المختبرات وغيرها. فقد اكتشف الفلكيون في العالم الحديث الفلكَ بالتلسكوبات والمناظير الحديثة. وهكذا اكتشف نيوتن الجاذبية، وأديسون الكهرباء… وغيرُهم. المكتشفون والمخترعون المسيحيون واليهود في الغرب الحديث تعاملوا مباشرةً مع الطبيعة، ولم يعتمدوا الانجيلَ والتوراةَ في اكتشاف عالم الطبيعة والتعرّف عليه. وعلماءُ الطبيعة في تراثنا العلمي مثل ابن الهيثم والبيروني والرازي والخوارزمي وغيرِهم تعاملوا مباشرةً مع الطبيعة، ولم يعتمدوا القرآنَ في اكتشاف قوانين الطبيعة والتعرّف عليها. وإن كان حثُّ القرآن الكريم على التفكّر والنظر والتدبّر والتبصّر ذا تأثيرٍ ملموسٍ في تحريرِ عقل المسلمين من الأغلال، وتحريضِهم على تأمل الطبيعة، والتفكيرِ العميق في آفاقها، والسعي لاكتشاف قوانينها.
وعندما ندرس الفلسفةَ الحديثةَ وعلومَ الإنسان والمجتمع في السياق الغربي لم نجد نظرياتِها مستنبطةً أو منبثقةً من نصوص الكتاب المقدّس، إذ ولدت كلُّ تلك النظريات من خارج نصوصه، ولم يتحدث هذا الكتابُ عنها تصريحاً أو تلويحاً، بل كان الكثيرُ ممن أبدعوا تلك النظريات لا يؤمنون بهذا الكتاب أو يعتقدون بقدسيته. وإن كانت الأسئلةُ المتنوعة والجدلُ حوله ذاتَ أثرٍ واضح في تطور هذه العلوم واتساعِ مدياتها. فقد ظلت الأسئلةُ الكبيرةُ تتوالد على التوالي عن كيفيةِ تشكّل الكتاب المقدس وتاريخِ تدوينه، وما تشتمل عليه نصوصُه من ميتافيزيقا ومعتقدات وقيم روحية وأخلاقية وقصص وأحداث. وعن قراءاته المتجدّدة والمختلفة باختلاف الأزمنة.
لقد قادَ الموقفُ الأعمى من العلم والمعرفة الحديثة للتلاعب بها، فكما يتلاعب المعتقدُ، تتلاعب الهويةُ المغلقةُ أيضاً بالعلم والمعرفة. إن كلّاً من الهوية والمُعتقَد متفاعلان لكن تأثيرَ كلٍّ منهما على شاكلته وبطريقته الخاصة. الطريقةُ التي تلاعب بها المعتقدُ تشاكلُ شباكَ المعتقد وتشعّبه، والطريقةُ التي تلاعبت بها الهويةُ تشاكلُ شباكَ الهوية وتشعّبها.
لكلّ جماعةٍ بشرية شغفٌ بإنتاج هوية خاصة مُصطفاة، عل وفق ما ترسمه احتياجاتُها وأحلامُها وآفاقُ انتظارها، وما تتعرض له من إخفاقات وإكراهات. وكل ذلك يسهم في كيفية بناء معتقدها، ويحدد ألوان رسمها لصوره المتنوعة وتعبيراته في الزمان والمكان، ثم تدمج صور المعتقد لتدخل عنصراً في مكونات هذه الهوية، بجوار العناصر الأثنية والثقافية واللغوية والرمزية وغيرها، بالشكل الذي يجعل المعتقد عنصراً فاعلاً ومنفعلاً داخل الهوية. كذلك تدخل الهوية في مكونات المعتقد، إذ تتغذى منه الهوية ويتغذى منها، فإن كان المعتقد مغلقاً يؤدي ذلك إلى انغلاق الهوية، وإن كانت الهوية مغلقةً يؤدي ذلك إلى انغلاق المعتقد. ويتشكل مفهوم الحقيقة وفقاً لهما. ذلك ان المعتقد والهوية ينشدان إنتاج الحقيقة حسب رهاناتهما ومطامحها ومعاييرهما، سواء كانت تلك الحقيقة دينية أو غير دينية.
وكما يتلاعبُ المعتقدُ والهويةُ المغلقان بالمعرفة يتلاعبان بالذاكرة أيضاً. إذ تعمل الهوية المغلقة على اعادة خلق ذاكرة موازية لها، تنتقي فيها من كل شيء، في تاريخها وتراثها، ما هو الأجمل والأكمل، ولا تكتفي بذلك، بل تسلب ما يمكنها من الأجمل والأكمل في تاريخ وتراث ما حولها، فتستولي على شيء مما هو مضيء فيه.
ويجري كل ذلك في ضوء اصطفاء الهوية لذاتها، لذلك تعمد لحذف كل خسارات الماضي واخفاقاته من ذاكرة الجماعة، ولا تتوقف عند ذلك، بل تسعى لتشويه ماضي جماعات مجاورة لها، والتكتم على مكاسبها ومنجزاتها عبر التاريخ.
في الهوية المغلقة يعيد متخيل الجماعة كتابة تاريخها، في أفق يتحول فيه الماضي إلى سردية رومانسية فاتنة، ويصبح العجز عن بناء الحاضر استعادة استيهامية مهووسة بالأمجاد العتيقة، ويجري ضخ الذاكرة الجمعية بتاريخ متخيل يضمحل فيه حضور التاريخ الأرضي، وتخلع على الأحداث والشخصيات والرموز والأفكار والمعتقدات والآداب والفنون هالة أسطورية، تتحدث عنها وكأنها خارج الزمان والمكان والواقع الذي ظهرت وتكونت وعاشت فيه.
سيد قطب. معالم في الطريق. القاهرة: الحدود للنشر والتوزيع، 2012، ص 39 – 40. وقد سبق أبو الحسن الندوي سيد قطب في موقفه المناهض لتعليم العلم والمعرفة الحديثة، فقد كتب مطلع الخمسينيات من القرن الماضي محذراً من التورط في تعليمه: “وأولى للبلاد الإسلامية أن تتجرد منه وتحرم من ثمراته المادية، فالأمية خير لها من هذا التعليم الذي يرزأها في طبيعتها وعقيدتها وروحها”. وتمثل كتابات هذا المفكر الهندي المسلم أحد منابع الإلهام الأساسية لتفكير بعض الجماعات الدينية في البلاد العربية. لاحظ: أبو الحسن الندوي. كيف توجه المعارف في الأقطار الإسلامية؟.
___________
بغداد: المطبعة الاسلامية، ط4، 1956، ص 6. [1]
كان معظم الفريق الذي يقود “المعهد العالمي للفكر الاسلامي” قد تشبعت ثقافته ورؤيته للعالَم بأدبيات جماعة الاخوان المسلمين، خاصة كتابات سيد قطب، في مرحلة التكوين الأساسية من حياته. [4]
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.




