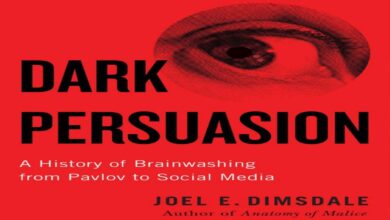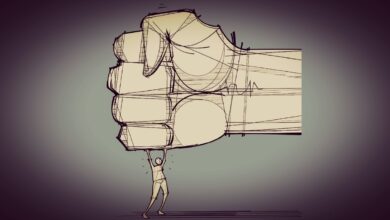الحوار مع الله يمر عبر الحوار مع الإنسان – حوار مع د.عدنان المقراني

حوار مع د.عدنان المقراني
أجراه: يامن نوح
- اسمح لنا أن نبدأ بداية تقليدية ونطلب منك بطاقة تعريف للدكتور عدنان المقراني
- أنا عدنان المقراني أستاذ الدراسات الإسلامية والعلاقات الإسلامية المسيحية في الجامعات البابوية في روما، أدرس في معهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية، وأيضا في الجامعة البابوية الجريجورية. في السابق درست في جامعة الزيتونة بتونس. تخصصي هو أصول الدين والأديان المقارنة. أنا من أصل تونسي أعيش في إيطاليا منذ حوالي عشرين سنة. وأؤمن بالحوار لا كمنهج معرفي ولكن كطريق للعيش وللحياة.
- بمناسبة مسألة الحوار دكتور، قرأت سابقا لك مقالا تعتبر فيه أن الحوار “نشاط روحي”، كيف تنظر إلى مسألة الحوار التي اعتيد الحديث حولها باعتبارها نشاط معرفي، وصلتها بالنشاط الروحي.
- هناك أكثر من مستوي للحوار، فالحوار بين الأديان قد يكون حوارا دبلوماسيا، وقد يكون حوارا للتعارف، وقد يكون حوارا من أجل حل الخلافات والمشاكل ومن أجل عيش مشترك أو تخفيف للأزمات، مثلا أثناء الحروب أو بعد الحروب…وأشياء من هذا القبيل. ولكن أيضا الحوار يمكن أن يكون طريقة روحية من أجل تطهير النفس من التراكمات السلبية، التي من شأنها أن تعيق الطريق نحو الله. الحوار مع الله يمر عبر الحوار مع الإنسان. وهذا شيء أساسي، فالعلاقة مع الله تختبر وتمتحن بشكل فعلي من خلال التعامل مع الناس. فرؤيتنا للآخر بالتأكيد من شأنها أن تطهر ما في نفوسنا من حسد أو غيرة. فنحن يكون لدينا عادة عواطف سلبية بسبب التنافس والرغبة في الهيمنة والإقصاء والانتصار “للأنا” و “النحن” بمعني الجماعة أو الجماعة الدينية. فالحوار بين الأديان في هذا السياق هو مدخل لتطهير التدين من القبلية والعنصرية، والتدين الذي يحمل معني الهوية الخائفة والمنغلقة أو الهوية المتسلطة. وكل هذه الأمراض يمكن التغلب عليها والشفاء منها عبر الحوار بين الأديان. ولكن كما قلت فإن الحوار أيضا نمط حياة علي مستوي الأسرة، وعلى مستوي إدارة العمل، وفي المدرسة، وفي تسيير شئون الاقتصاد والسياسة…الخ. فلا يمكن تجزئة الفعل الحواري لأنه فعل يشمل كل مناحي الحياة اليومية والإنسانية.
- ممتاز، لكن دكتور اسمح لي، إدارة حوار من هذا النوع لها متطلبات مسبقة، وأولها المرونة والقدرة على التخلي عما اعتبر من الثوابت والمسلمات، بحيث يتحول الحوار من كونه “نشاطا تفاوضيا” إلى كونه نشاط إنساني وروحي عميق بهذا الشكل. فهل تتفق مع ذلك مبدئيا؟
- السؤال هو ما هي المسلمات والثوابت التي تمتحن بالحوار؟ هل هي مسلمات حقيقية أم مجرد فرضيات تحولت بالعادة إلى مسلمات؟ هذا هو السؤال الأساسي. بالتأكيد هناك أشخاص وجماعات إسلامية ومسيحية ومن أديان مختلفة لديها مواقف سلبية من الحوار، لأنه ينظر إليه كمدخل للنسبية الدينية أو “لتعليق الأحكام” أو “للشك في الدين” أو أشياء من هذا القبيل، ولكن هذا خطأ منهجي وخطأ في رؤية الحوار. فيفترض أن الشخص صاحب الخبرة والتجربة الدينية، وصاحب الآثار و”السلوك” إلي الله يكون واثقا من رؤاه الدينية ولا يشعر بالتهديد، والدين في نهاية المطاف ليس هدفا في حد ذاته، فالدين يفترض أن تكون له رسالة، وهي رسالة “أنسنة الإنسان” بمعني إخراج كل طاقات الإنسانية في الإنسان، وجعله أكثر انفتاحا علي الله والآخر، وتفعيل مقومات الإنسانية في الإنسان. فالدين هو التدريب والتمرين على هذا الفعل. والهدف هو “الله”. الدين هو الطريق، ولذلك نحن لا نعبد الطريق، بمعني أننا لا نعبد ديننا، ولكن نعبد الله. ويجب التأكيد كذلك على القابلية للإضافة والتعلم وتغيير الأفكار والانفتاح علي النور مهما كان مصدره. فالإنسان لا يمكن مسبقا أن يرفض ما لا يعرف، عندما يتمتع بالفضول والرغبة في المعرفة يمكنه أن ينفتح على أي فكرة أو رأي أو خبرة إنسانية، أولا عن طريق التعرف على المعتقد المطروح كفكرة ثم التعرف عليه كخبرة إنسانية مطروحة أمامه، وبعد ذلك يمكن أن يتعلم إذا وجد في هذه الخبرة ما يمكن أن يفيد حياته.
- لكن دكتور يحتاج الإنسان أولا أن يطمئن، وأن يزول الخوف، حتى يستطيع الانفتاح على الجديد، أليس كذلك؟
- بالتأكيد، الخوف موجود خاصة في حالات انعدام الثقة. فالإنسان لا يمكن أن يبوح بأفكاره العميقة أو قناعاته العميقة بدون توفر أجواء الثقة والحرية والسماحة. ففي أجواء الأزمات وأجواء الشحن الطائفي يكون صعبا، ويتحدث الناس حينها في كل شيء ويتحاشون الموضوعات الدينية لأن الأجواء لا تكون مناسبة، حيث يظن البعض أنها ستكون مدخل للخصومة والخلاف. لكن إذا تعمقت الصداقة يكون هناك ثقة متبادلة بين الأشخاص. فعملية بناء الثقة خطوة هامة جدا، وفي هذه الحالة يتخلى الانسان عن الحذر وعن التفكير مرتين، وبالتالي يمكن للإنسان التعبير بحرية عن خبرته الحميمة مع الله، وأفكاره الدينية.
- إذن بالنظر إلى واقع المسلمين اليوم، كيف تري قابلية انفتاح المسلمين على هكذا حوار، وكذلك انفتاح باقي العالم على هكذا حوار مع المسلمين. كيف تقيم إمكانات هذا الوضع اليوم؟
- موضوع الحوار هام جدا، وهو ليس موضوع نخبة، وليس موضوع مختصين دون غيرهم، ولكن له أبعاد كبيرة جدا. البعد الأول عند الحديث عن موضوع الإصلاح الديني. فاليوم أي رسالة دينية لكي تكون عالمية بالفعل يجب أن تكون منفتحة على كل الخبرات والأفكار، لا أظن أن إصلاح الفكر الديني ممكن بدون الحوار بين الأديان، وبدون التعاون الأكاديمي والعلمي بين الثقافات والأديان المختلفة. وأن نعتبر هذه التعددية الدينية في إنتاج الفكر الديني. وعلى المستوي السياسي لا يمكن إنشاء مجتمع ديمقراطي حر يقبل بالتعددية ويقبل بالتنوع من دون الحوار بين الأديان. وبالتالي الحوار بين الأديان داخل الشعب الواحد وداخل الأمة الواحدة، على نطاق وطني أو إقليمي أو نطاق أوسع خطوة اساسية في سبيل الديمقراطية، والقبول ليس فقط بالتنوع بين الأديان، ولكن التنوع داخل كل دين، بدون أن يثير ذلك أي حساسيات أو تنافر أو أي مشاعر سلبية. للأسف في بعض الدول بنيت الهوية الوطنية بشكل أحادي على أساس الطائفة الأكبر أو المهيمنة والتي بيدها السلطة، ويتم اغفال باقي العناصر الاجتماعية سواء في كتب التاريخ أو الاعلام أو السينما وفي كل المجالات. وتبقي كحقائق هامشية لا تذكر إلا عرضا عند حدوث مشكلة بشكل صارخ فيضطر الناس للحديث عن الموضوع بشكل مباشر. ولكن في الظروف العادية ترفض الثقافة المهيمنة الحديث عما يسمي الأقليات الثقافية والدينية كأنه “تابو” أو كأنه أمر يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي، وكأن التنوع والتعدد يمثل تهديدا للوحدة الوطنية. وهذا تفكير خاطئ وهو أساس التفكير الديكتاتوري. ولذلك الحوار بين الأديان هو خطوة أساسية من أجل إصلاح الفكر الديني الإسلامي والفكر الديني عموما، وكذلك بناء مجتمع ديمقراطي حر يقبل بالتعددية.
- ممتاز. لكن دعنا نحاول النظر إلى الوجه الآخر لمسألة الحوار، فالقدرة على التعبير عن النفس بانفتاح ومشاركة التجربة الحميمة مع الله لا تنفصل من الناحية الأخرى عن القدرة علي نقد الذات. كيف تري قدرة المسلمين اليوم في ظل ثقافة هشة تعاني من مشكلات بنيوية كبيرة على تناول الذات بهذا الشكل النقدي؟
- النقد ذو وجهان، فهو لا يعني فقط إظهار النقائص والسلبيات، ولكن يعني أيضا تثمين الإيجابيات. فالنقد الأعرج الذي يري فقط السلبيات يسمي “جدال”، وهو نزعة لرؤية فقط الجانب السلبي في الآخر وأحيانا تضخيم أو اختراع هذه السلبيات وتكوين نظرة كاريكاتورية أو تشويهية للآخر. النقد يفترض الاتزان والجمع بين الأمرين: عدم انكار مواطن الحق والخير والجمال في الآخر، مع تنسيب التجربة التاريخية، وأيضا نقد الذات على ضوء العلاقة مع الآخر، ونقد الآخر على ضوء العلاقة مع الذات. على سبيل المثال عندما ندرس لاهوت الأديان المسيحي وتطوره، نجد تجربة غنية جدا يمكن أن نستفيد منها، وهي تجعل المتأمل فيها يعيش توتر إيجابي يدفعه للتساؤل حول كيف يمكن لهذا الفكر اللاهوتي المتطور أن يغني فكره الديني! أيضا على سبيل المثال دراسات الكتاب المقدس بكافة أنواعها سواء النقد التاريخي أو الدراسات الأدبية أو المنهج السردي وغيرها، فيها أيضا ثراء واسع جدا، وهذا يجعل المتأمل لها يفكر في علوم القرآن والدراسات القرآنية وكيف يمكن أن تكون في حوار مع العلوم الإنسانية. فبالتالي ليس مطلوبا من الشخص أن يحاكي فقط الآخر أو يبحث عن التغيير بأي ثمن، ولكن فتح مجالات للتفكير في “مناطق الصمت”، فأحيانا الحوار يطرح أسئلة لم يكن من الممكن التفكير فيها بدون الحوار. وهذا هو معني الانفتاح على العالمية، وعلى التحديات الكبرى التي تواجه الإنسانية. الأديان كلها ولدت في عصر ما قبل الحداثة، والحداثة أحدثت قطيعة على المستوي الفكري والاقتصادي والسياسي مع كل النماذج السابقة، وكل الأديان حاولت أن تجيب على هذا التحدي بطرق مختلفة. وعندما ننظر إلى كيف واجه الفكر المسيحي أو اليهودي هذه التحديات، نجد تقاطعات وتشابهات واختلافات، وهذا بإمكانه أن يعطينا رؤية أوسع للمشاكل والتحديات، ويعطينا أيضا وسائل نقدية فاعلة لمواجهة هذه التحديات.
- ذكرت حضرتك أن النقد يتطلب الاتزان حتى لا يخرج عن مضمونه، فهل هذا الاتزان متحقق في العالم الإسلامي اليوم؟ وإن لم يكن متحققا فكيف تري المدخل إلى تحقيقه؟
- طبعا هناك خلل كبير في العالم الإسلامي، فمازالت الأدبيات الجدالية هي الأدبيات المهيمنة، وهي لا تصنع معرفة مباشرة بالآخر إلا عبر القنوات الجدالية المليئة بعقد النقص التي تتحول إلي عقد عظمة. فالشعور بالنقص يولد نزعة نحو ما يمكن تسميته “إمبريالية بدون امبراطور”. النزعات الإمبريالية في الغرب مفهومة بسبب وجود بالفعل قوي عظمي لها نزعات توسعية، لكن عند بعض المسلمين هناك نوع من الإمبريالية الوهمية بدون قوي حقيقية كتعويض عن عقدة نقص، من أجل تضخيم الذات وتصويرها بصورة مثالية مبالغ فيها. هناك جانب آخر من جوانب الخلل والنقص، وهو ضعف المؤسسات، سواء كانت المؤسسات جامعية حكومية أو خاصة، أو مؤسسات دينية، وهذا يربك الوضع. وللدقة أعني ضعف طريقة العمل المؤسساتي، فنحن مازلنا معتادين على طريقة العمل الفردي وليس العمل الجماعي وهذا نقص كبير في طريقة العمل.
- وما هو تحليلك لهذا النقص في القدرة على العمل الجماعي في بيئة المسلمين، ولماذا تجاوز المجتمع الغربي هذه الأزمة بينما لم يستطع مجتمع المسلمين تجاوزها حتى اليوم؟
- أولا لرسوخ التقاليد الديمقراطية في الغرب، فالديمقراطية ليست فقط عملية سياسية، ولكنها عملية فكرية، أي طريقة في العيش والحركة على جميع المستويات. حتى في مجال تسيير الجامعات وأيضا تسيير المؤسسة الدينية، وإن كانت بالفعل هناك مقاومات حتى في المجتمع الغربي، فالكنيسة الكاثوليكية شهدت إصلاحات وإن لم تتحول إلى مؤسسة ديمقراطية بمعني الكلمة، ولكن عموما على مستوي القاعدة والتسيير العمل الجماعي موجود عن طريق مجالس ومجموعات للتفكير. بينما نحن في العالم العربي والإسلامي بشكل عام بسبب تراكم عقود إن لم يكن قرون من الديكتاتورية ومركزية القرار في يد شخص واحد أو عائلة واحدة أو مجموعة محدودة من الناس، حول ذلك المواطن العادي إلي شخص مهمش. حتى في العقلية الدينية نفسها تجد مثلا ظاهرة الفتاوي “أونلاين” وهو ما يعكس حاجة الإنسان المستمرة إلى من يفكر ويقرر في مكانه، وعدم القدرة على اتخاذ القرار حتى علي المستوي الشخصي. أيضا نظام التعليم نفسه إذا كان مبنيا على التلقين الذي يؤدي إلى تقزيم الشخصية وعدم القدرة على التحليل، كل هذه مشاكل تربوية اجتماعية نفسية سياسية أدت إلى انعدام أو قلة “الشورى” الفعلية، وهي موجودة عندنا كمسلمين كمبدأ أو مثال ولكن على مستوي الفعل هي تقريبا غائبة تماما.
- إذن كيف تري طرف الخيط؟ من أين نبدأ؟
- لعل الوقت الحالي قد يمثل فرصة إيجابية. نحن نفتقد إلى مفكرين كبار يمثلون زعامات فكرية، ونعيش في عصر انعدام الزعامات، حتى علي المستوي السياسي. والربيع العربي هو ربيع بدون زعامات، وحتى بدون أحزاب سياسية، وليس هناك تمثيل سياسي حقيقي للشباب. وهذا ينظر إليه على أنه سلبية، لأن الشعوب تعودت على زعامات كاريزمية تجذب الناس نحو التغيير، وهذا الآن غير موجود. فما هو البديل؟ البديل أن يصبح كل منا زعيم بمعني العمل المشترك، أي تكوين شبكات وربط العلاقات بين أشخاص يشعرون بنفس الألم والعطش والحاجة. أنا في كل مرة أتحدث عن هذه الأفكار في أوساط عربية أشعر بصدي إيجابي فوري. نحن لدينا فكرة خاطئة أحيانا عن الناس والشعب، فنقول مثلا “الشعب متخلف، أو تسيطر عليه الأفكار الأصولية والتطرف وعدم قبول الآخر، وهو نوع من التعالي على الناس. ولكن في نفس الوقت عندما نملك الجرأة الكافية للتعبير عن أفكار جديدة ومختلفة نجد أذنا صاغية، ونجد عطشا وانتظارا، فالناس تنتظر سماع أشياء مختلفة وجديدة. ومن ناحية أخري، وأخشى ما أخشاه أن يسبب فشل الربيع العربي وفشل مشاريع التغيير في المنطقة العربية السقوط في اليأس والإحباط وجلد الذات وانغلاق الأفق. فهذا أمر سلبي جدا ومعدي بالمناسبة. لدي كثير من الأصدقاء في مختلف الدول العربية أسمع منهم هذا الخطاب اليائس، وهو أسوأ ما يمكن أن يحصل. أتصور أن المنطقة العربية هي أكثر مناطق العالم تضررا في الأزمة العالمية الحالية بسبب الحروب. ربما لم يشهد العالم العربي عددا من الحروب مثلما هو موجود حاليا، وأيضا أزمات اقتصادية خانقة جدا، لكن لابد أن نتذكر شيء أساسي، وهو أن العرب هم فقط جزء صغير جدا من العالم الإسلامي والأمة الإسلامية. فالعرب ربما 20 بالمائة أو أقل من مجموع المسلمين في العالم، وخارج الإطار العربي توجد حيوية، وأتصور أن انفتاح العرب علي المسلمين غير العرب وهم الأغلبية سواء في اندونيسيا والهند او باكستان وإيران وتركيا أو أمريكا او أوروبا هو الشيء الناقص، الحوار الإسلامي، والحوار الثقافي بين المسلمين، والانفتاح على تجارب إسلامية إيجابية ممكن أن تعطي أمل وأفكار جديدة، وعدم التمحور حول ذات عربية متأزمة ومتألمة ويائسة، وهذا لا يؤدي إلا إلي موت بطيء وهو خطير جدا. فنحتاج إلى إشاعة جو من “التفاؤل العلمي” وليس فقط تفاؤل عاطفي أو مجرد أحلام. فيمكن لجماعات فكرية أن تتحول إلى العمل الاجتماعي والمجتمع المدني. التطرف الشديد هو أحيانا رد على اليأس، فانعدام الحلم يدفع الناس إلى الانتحار المعنوي عن طريق التطرف المجنون. الشاب عنده طاقة ضخمة يحتاج إلى تفعيلها وتشغيلها والتعبير عنها، وإن لم يجد القناة المناسبة يعبر عنها في أساليب منحرفة.
- إذن كيف تري دور للتعليم في هذا الإطار؟
- في السابق أشرت إلى موضوع التلقين. عدم الثقة في قدرات الطالب علي التحليل وعدم أعطائه الفرصة لذلك من خلال أجواء المناقشة ومن خلال أجواء تسمح لكل طالب بالتعبير عن رأيه بحرية، فما زالت المحاضرات في شكل أستاذ يتكلم وحده طول الوقت وكأنه يعرف كل شيء أو كأنه ديكتاتور صغير داخل قاعة المحاضرات، وفي المقابل طلبة صامتين طيلة الوقت يستمعون إلي الأستاذ “الملهم”! هذا إعادة انتاج للديكتاتورية في جميع المجالات، حتى في مجال الخطاب الديني. خطبة الجمعة على سبيل المثال هي مجال تربوي، وهناك الخطيب أو الإمام يكتب الخطبة وحده جالسا في مكتبه ثم يخرج على الناس بهذه الخطبة -المملة في كثير من الأحيان-، والسؤال هنا لماذا لا تكون الخطبة عمل جماعي؟ ولماذا لا يكون المسجد ملتقي اسبوعي بين أبناء الحي والمثقفين وتكون خطبة الجمعة هي نتيجة حوار بين الناس؟ في بعض المساجد في أمريكا قاموا بهذه التجربة، فخطيب الجمعة ليس بالضرورة أن يكون شخصا واحدا فممكن يحدث التناوب وممكن أن يكون رجلا أو امرأة. وبغض النظر عن ذلك المهم هو ألا تكون الخطبة مركزية لإنتاج شخص واحد يفكر مكان الجميع، ولكن هي نتيجة تفكير جماعي، وهذا علي سبيل المثال. هذه المسائل تدخل ضمن “اللامفكر فيه” في مجتمعات المسلمين، فنحن لا نفكر في هذه الاحتمالات الممكنة لأننا تعودنا على طريقة في العمل والعيش والتفكير مبنية على الفردانية، وعلى المبادرة الفردية بمعناها السلبي. وهذا أيضا تربية، فما نحتاجه هو التربية على الحوار وعلى حس مرهف بالعدالة، وحساسية من كل أشكال الظلم. فنحن نعيش في الوقت الحالي ما يمكن أن نسميه “طائفية الألم” بمعني أني أشعر فقط بألم من يشبهني، ومن أفكاره تطابق أفكاري، وجماعتي. وإذا حدث ظلم أو اضطهاد لطائفة أخري أو لدين آخر أصاب بنوع من التبلد في العواطف والمشاعر. أي يصبح مقياس العدل عندي المطابقة العقائدية والفكرية والدينية. بينما يغيب مفهوم التضامن الذي يجب أن يتجاوز كل حدود الانتماءات القبلية واللغوية والعرقية، ويغيب الإحساس بالمظلمة وبألم الانسان في كل مكان. كيف يمكن للمربي أن ينمي هذا الإحساس بالعدل، والرغبة في العدل والخير للجميع ولكل الناس؟ وكذلك الانخراط في كل معارك الإنسانية بدون حواجز، وهذا أمر فيه نقص كبير في المجال التربوي. وأظن أن الحوار أيضا تربية، فممارسة الحوار كتدريب يومي من أهم الوسائل للدمقرطة والتربية على السلام والعدالة وقبول الآخر وقبول التعددية. على سبيل المثال سبق لي أن عملت في لبنان في التسعينات بعد الحرب الأهلية، ووجدت كثير من المراكز التي كانت تجمع شباب مسلم ومسيحي لم يلتقوا من قبل، لأنه كان هناك فرز سكاني، ولم يكن هناك فضاءات مشتركة. في الأيام الأولي كان يمكن ملاحظة حالة الخصومة والجدال وصعوبة التعامل، ولكن في الأيام التالية بدأت تتكون صداقات وبدأ الأفراد يكتشفوا انسانيتهم، وأنهم يشبهوا بعضهم في نهاية الأمر، فكلهم شباب، وكلهم ينتمون إلى ثقافة واحدة ووطن واحد. وهذا نموذج على أن الحوار وسيلة أساسية لتكسير العزلة النفسية بين الناس وتكسير الحواجز والأحكام المسبقة. الحوار هو وسيلة تربوية أساسية وناجعة.
- إذن الحوار هو وسيلة تربوية بقدر ما هو منتج نهائي للتربية أيضا..
- نعم بالتأكيد، فالتعليم بالتعلم، ولا يمكن أن ننتظر أن نجد أنفسنا في يوم ما ديمقراطيين فجأة هكذا بدون محاولات، والبدايات عادة تكون صعبة ومتأزمة ومؤلمة، وفيها تقدم وتراجع وتردد. ولكن لا يعني ذلك أن نخاف من هذه البدايات، فهذا جزء من العملية التربوية، وكثيرا ما كنت أقابل أشخاص غير مؤمنين بجدوى الحوار ولكن من خلال الحوار نفسه يحدث لهم تحول جذري.
- إذن التعليم أوسع من المؤسسة الرسمية…
- نعم بكل تأكيد. هناك صحفي فرنسي كان أسيرا لدي داعش وقد كتب كتابا عن تجربته بعد تحريره، وكان يتحدث عن “صداقة” نشأت بينه وبين سجانه الذي هو شاب مثله في نهاية الأمر، ونشأ بينهما حوار عن الأفلام التي شاهدها كل منهما وعن ألعاب الفيديو التي تعرضوا لها، وكان يتحدث عن العنف الحاضر في السينما وألعاب الفيديو كعنصر أساسي في الثقافة الحديثة، فأجيال كاملة تقضي ساعات طويلة أمام هذه المواد الدموية، وهذا يعد نظاما تربويا مفتوح وعابر للثقافات ومشكل لها أيضا.
- لكن دكتور كأنك تحيل دائما إلى أسباب سياقية للتطرف الديني ولا تري بأن هناك أسباب بنيوية في ثقافتنا وفي تراثنا الديني تؤدي إلى انفجار هذا النوع من العنف والتطرف! حتى في مثال الصحفي الفرنسي الذي استخدمته ربما نتسائل: لماذا صنعت نفس لعبة الفيديو من الشاب الداعشي قاتلا متطرفا بينما صنعت من الشاب الفرنسي شخصا مؤمنا بالحوار؟
- بالتأكيد العناصر الدينية حاضرة في هذا المخيال، فمثلا المنشور الأساسي لداعش اسمه “دابق”، ودابق هو اسم مكان موجود في الحديث النبوي مرتبط بمعركة نهائية بين “الخير” و “الشر” في نهاية العالم، وهو أمر له بعد مسيحاني أخروي، وهذا النص موجود بالفعل في التراث وكتب الحديث، ولكن السؤال كيف هذا النص الموجود في الرفوف والكتب يتحول إلى مشروع سياسي وفعل! صحيح أن خطاب الأفكار الدينية المتطرفة يلجأ إلى انتقاء ما يلائمه في تحفيز الطاقات القصوى للجندي إلى حد الموت، ولكن هناك سياق تاريخي وسياق اجتماعي وسياق سياسي يسمح بذلك. أتصور أن الأفكار التراثية والتاريخية المتطرفة موجودة ولكن غير كافية لوحدها أن تنتج تطرفا فعليا.
- تعني أنه حتى مع وجود العوامل البنيوية يحتاج الأمر إلى “صانع الخطاب” الذي يحولها إلى أيديولوجيا ومشروع سياسي فعلي؟
- نعم، وصانع الخطاب هذا يمكن أن يكون شخص مقتنع بالفعل بهذه الأشياء، ولكن في أحيان أخري يكون شخص له غاية، لأنه هذا النوع من الأفكار يسمح بتفعيل “قوي الموت” في الإنسان، بمعني تحويل الجندي إلي قنبلة وسلاح متفجر، وهذا الشخص لابد أن يقتنع بأن موته مفيد وله معني، فيتم تغليف وتركيب أيديولوجيا تسمح بهذا وتدفع إليه، ولكن لاحظ: أنا شخصيا أري على مستوي المخيال أن الفكر المتطرف ليس وليد مشوه للتراث فقط، ولكن هو أيضا وليد مشوه لحداثة مأزومة بمشاكل اجتماعية وأيضا لمخيال حديث تماما. مثلا قصة دابق والصراع بين الخير والشر هذه ممزوجة بعشرات الأفلام التي صدرت مؤخرا عن انقاذ العالم من خلال معركة أخيرة بين الخير والشر، وهذا مشهد سينمائي متكرر، وأيضا ارتباط هذا بمخيال ألعاب الفيديو التي تتحول كثيرا إلى أفلام والعكس، وكلا الجانبين مكون أساسي في انتاج مخيال حرب وصراع. وهذا المخيال الحديث المتأزم يكون ممزوج بنصوص تراثية. وليس فقط الشاب المسلم هو الذي من الممكن أن يسقط في هذا الفخ، ولكن كثير من الذين يتبنون التطرف هم أشخاص من أديان أخري أو حتى لا دينيين، لأن ذلك أصبح في السوق الرائجة اليوم هو ما يوفر أكبر قدر ممكن من العدمية والرفض ونسف كل شيء. كان هناك مؤخرا حوار بين فلاسفة فرنسيين من بينهم أوليفيروا وكان يتحدث عن “أسلمة الراديكالية”، بمعني أن الراديكالية كانت في عقود سابقة تأخذ أشكالا علمانية ويسارية، اليوم تأخذ أشكالا دينية. هناك جانب من الشباب يعاني من إحباط ويأس ورغبة في بديل مستحيل غير واقعي، فيلجأ إلى هذه الأشكال الراديكالية العنيفة التي تتخذ شكل ديني. ولذلك فأؤكد على أن المسألة مركبة من عدة عناصر والتراث فقط هو أحد هذه العناصر.
- إذن العوامل البنيوية غير كافية وحدها لصناعة التطرف وتحتاج إلى عوامل سياقية لصناعتها كما هو واضح في رأيك، لكن السؤال الآن يصبح: هل يمكن صناعة الحل بمعزل عن معالجة أزمة التراث الديني والعوامل الكامنة فيه؟ بمعني فتح باب النقد لطبيعة التفكير الديني للمسلمين وعلاقتنا بالتراث؟
- مؤخرا كنت أقرأ مقالا جيدا لأستاذ مصري اسمه محمد فاضل وكان يتساءل حول: هل الديمقراطية تتطلب بالضرورة إقصاء غير الديمقراطيين؟ وهل التعددية هي إقصائية للإقصاءيين؟ بمعني هل التعددية تهمش كل من لا يقبل التعددية؟ هناك تناقض في هذا الموضوع، فيوجد لدينا جماعات تكتفي بتكرار التاريخ والنظر إلى الوفاء للأشكال القديمة باعتبار ذلك وفاءا للدين نفسه وللتراث والأجداد، والتعامل مع هؤلاء يمثل إشكالية أساسية. هناك من الفلاسفة والمفكرين من أمثال رضا شاه كاظمي الذي كان يقول “التعددية الحقيقية هي التي تقبل أيضا بالإقصائيين”، فوجود أشخاص سلفيين ومحافظين هذا موجود في كل الأديان، لكن يكمن الخلل عندما تتحول هذه النزعة إلى نزعة مهيمنة وعنيفة وهذه هي المشكلة. فإصلاح الفكر الديني هو أمر ضروري بالتأكيد، ولكن لابد أن نظل فطنين لمزالق ديكتاتورية المجددين وحتى أدعياء التجدد، لأني أري أيضا محاولات لإعادة انتاج الإقصاء والتشدد ولكن بثوب تجديدي وحداثي، فالإنسان ممكن أن يكون حداثي وديكتاتوري واقصائي وعنيف أيضا في نفس الوقت، فبذلك نعيد انتاج المشكلة في نهاية الأمر. أضيف أيضا أن التصوف من الممكن أن يكون له دور هام في مسألة الإصلاح الديني، فالدين عندما يتحول إلى مجموعة من الأوامر والواجبات والأفعال بدون روح ومنهج ورسالة وقلب، هذا يجعل الدين يتحول إلى جسد ميت، وإلى آداه لإضعاف روح المواطنة. فعندما يصبح المواطن غير قادر علي الاختيار وغير ناضج كشخصية يمكن أن تختار وتنتقد وتنتخب، يجعل هذا النمط من التدين خاضعين لقيادات ومشايخ وغير ذلك. صحيح أن التصوف عاش مراحل انحطاط وأصيب بأمراض أخري متعلقة بمسألة القيادات والخضوع للمشايخ وغير ذلك في التصوف الطرقي، ولكن يمكن اختيار عناصر إيجابية في التجربة الصوفية وفي التراث الصوفي تحدث توازن في الفكر الديني. فالفكر الديني لا يمكن أن يكون فقط فكر نظري أو فكر عملي مجرد ولكن روح تجمع بين النظر والعمل.
- سؤال أخير إذن دكتور: هل أنت متفائل بشأن احداث تغيير حقيقي في ثقافة العالم الإسلامي على المدي المنظور؟ هل تري ذلك ممكن التحقق؟
- نعم. هناك كاتب سوري اسمه ياسين الحاج صالح أصدر كتابا بعنوان “الثورة المستحيلة”، وقد أثار عنوان الكتاب ردة فعل سلبية لما فهم من أنه يطرح استحالة الثورة، بينما كان هو يقصد أن المستحيل قد حدث بالفعل متمثلا في استفاقة الشعوب التي تظاهرت بطريقة سلمية وأطاحت بالحكام، حتى لو أنه على المدي البعيد والمتوسط لم ينتج تغيير جذري أو مأمول، لكن المستحيل قد حدث بالفعل، بمعني أن الحدث التأسيسي قد انطلق. لأول مرة نسمع شباب عربي يتحدث عن الحاجات الأساسية والمشاكل الحقيقية والأولويات والتحديات…الخ. وقد نتج عن ذلك شبكات وتضامن وطني عابر للانتماءات السياسية، وهي حالة فريدة في التاريخ العربي. صحيح أننا نعيش الآن في ظرف من الهشاشة والضعف والشك، ولكن يكمن الاستثمار في استحضار اللحظة الثورية أو لحظة النور التي جمعت ولم تفرق، فهؤلاء الشباب الذين عاشوا تلك اللحظة مازالوا على قيد الحياة، ومازالوا في بداية الحياة، ومازالوا قادرين على الفعل ربما بأساليب أخري أكثر تنظيما ووعيا وعقلانية وقدرة علي نقد التجارب السابقة، وقدرة على استثمار وسائل التواصل الاجتماعي. ولاحظ أن الأزمة ليست فقط في العالم العربي، ولكن أوروبا كذلك تعيش الأزمة بشكل آخر، فالمجتمع منقسم في أوروبا بحدة، والديمقراطية الأوروبية تعيش لحظة فارقة في تاريخها، فتجد خطاب موجات اليمين المتطرف والانغلاق والخروج من أوروبا وغرق الحدود وطرد الأجانب والخطاب العنصري وعودة الفاشية وكل هذه الأشياء التي كنا نظن أنها مرت بلا عودة، ولكن الأشباح القديمة تعود بسبب الخوف وعدم الثقة في الآخر، وهذا له انعكاسات سياسية ثقافية اجتماعية ضخمة، وهناك على الجانب الآخر أوروبا التي تقاوم هذه القوة، أوروبا التي تؤمن بالعالمية والأخوة الإنسانية والتضامن والديمقراطية. فهذا نفس الصراع ولكن بأشكال مختلفة في أوروبا.
- إذن دكتور هل لديك كلمة ختامية في نهاية الحوار؟
- أشكركم شكرا جزيلا
_______________د.عدنان المقراني/سيرة ذاتيّة معرفيّة:
___________________________من مواليد تونس سنة 1966، أستاذ في الدراسات الإسلاميّة والعلاقات الإسلاميّة المسيحيَّة، لدى الجامعة البابويّة الغريغوريَّة في روما، ولدى المعهد البابوي للدراسات العربيَّة والإسلاميَّة في روما (إيطاليا)، حيث يقيم منذ حوالي خمسة عشر عاما.
حائز على الدكتوراه في أصول الدين من جامعة الزيتونة في تونس، والدكتوراه في العلاقات الإسلاميَّة المسيحيَّة من المعهد البابوي للدراسات العربيَّة والإسلاميَّة.
من مؤلفاته: تأملات مريميَّة (2001)، نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي (2008)، نظرات المسيحيّين اللبنانيّين للعلاقات الإسلاميَّة المسيحيَّة (2009)، قراءة القرآن في روما (2010).
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.