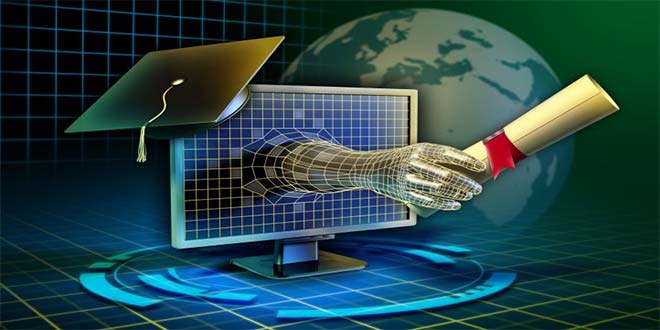“المعلم” منطلق إصلاح التعليم بالوطن العربي

يفترض بأي نظام تعليمي أن يهيئ الأجيال القادمة ويعدها أحسن إعداد لتكون بذلك من يقود أممها نحو الرقي والازدهار، باعتبار التعليم أحد البنى الأساسية لتحقيق هذه الغاية. لكن ماذا لو استحال ذلك؟ ماذا لو كان الفاعل الأساسي المنوط به تحقيق هذا الهدف ليس بمقدوره ذلك ؟ ماذا لو كان المعلم عاجزا عن إعداد هذه الأجيال ؟ هل من سبيل لتجاوز هذا الوضع ؟
إن إدراك عمق أزمة المنظومة التعليمية بالدول العربية لا يتطلب كثيراً من البحث أو الاستدلال فهو واضح للجميع، وهو ما تثبته التقارير والمؤشرات العالمية حول التعليم وجودته. والحقيقة أن مشكلة التعليم بالوطن العربي متعددة ومتشابكة ومتداخلة، بين ما هو سياسي، وما هو اجتماعي، وما هو ثقافي، وما هو متعلق بالإمكانيات والوسائل، وفيها ما هو متعلق بالمناهج، وفيها ما هو بشري متعلق بالأستاذ أو المعلم.
المعلم أحد أهم مشكلات المنظومة التعليمية في الوطن العربي، وتتلخص في أن الذين منحت لهم مهمة تعليم المواطن ومحو أميته هم أنفسهم ضحايا أمية من نوع أخر، حيث أن أغلب المعلمين والأساتذة – في كل المستويات التعليمية بدءاً بالأساسي، والإعدادي، والثانوي، ثم الجامعي – في معظم هذه البلدان غارقون هم أنفسهم في أمية معرفية خطيرة، فيكفي أن تجري نقاشاً قصيراً معهم، أو تتفقد حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتكتشف حجم الانحرافات الفكرية و فداحة التصورات الاجتماعية التي يحملها – وينشرها بالتالي – هؤلاء الفاعلون المراد منهم تخريج الأجيال اللاحقة. كما يفتقد هؤلاء أخلاقيات العلم، فالمعلم عندنا يتحول إلى “ماكينة” للإلقاء، بل حتى لا يقوم بتحديث معلوماته ومتابعة ما يجدّ في حقول المعرفة، بل عن تخصصه الأكاديمي، فهو لا يتطور، وكما قال أحدهم ساخراً من خبرة رجل التعليم عندنا أن كل خبرته سنة مكررة عدد السنين التي مارس فيها وظيفة التعليم، فكل ما يقدمه مجموعة معطيات ومعلومات مغرقة في الحشو والحفظ، لأن مساحة إعمال العقل وصقل قدرات التلميذ النقدية وتحرير مهاراته الإبداعية غير متاحة، فتصير بذلك وظيفة المدرس أشبه بعملية ميكانيكية تتم إعادتها مع كل فصل دراسي وفي كل سنة، والنتيجة أن العلم يتطور بينما المدرس والتلميذ لا يراوحان مكانهما.
مشكلة المنظومات التعليمية بالوطن العربي أنها لا تقدم الحل، بل هي جزء من المشكل، فالأستاذ غير الكفء نتاج منظومة تعليمية تربوية مهترئة. فما تقدمه المدارس والمنظومة التربوية في المنطقة العربية عاجز عن تخريج معلم فاعل وقادر على إنتاج أجيال متنورة لأن المنظومة التعليمية بشكل عام وشامل تعيش أزمة بنيوية، بدءا من السياسات التعليمية نفسها، حيث تعتبره ملفا يستنزف ميزانيتها ولا يقدم لها أي أرباح آنية (ليس قطاعاً منتجاً). كما يظهر أن ملف التعليم يتم التعاطي معه بارتجالية حيث تغيب الرؤية الإستراتيجية على المدى البعيد، فالمصير غامض، كما أن مناهج التعليم جلها مستورد من تجارب لدول أجنبية. كما ظل ملف التعليم ولسنوات مجال صراع بين القوى السياسية المختلفة، فكل حكومة جديدة تدخل فيه تعديلات حسب ما يتلوه عليها مزاجها وتقديرها السياسي، ما يجعل المنظومة التعليمية هي المتضرر من الوضع.
يكفي أن نقارن تكوين المعلم العربي بالمعلم الأجنبي لنكتشف الفرق بينها، فلا يخضع المعلم العربي للتكوين إلا مرة واحدة في مساره كمعلم، بينما الأجنبي يخضع للتقييم المستمر، ما يجعله دائم الاطلاع على النظريات والدراسات العلمية في ميدانه، ومؤهلا بالتالي ليعطي أفضل ما لديه. زد على ذلك أن السياسات العامة في مجال التعليم بالغرب تتم بلورتها في علاقتها بباقي القطاعات الأخرى وبمشاركة المعلم، باعتباره أحد أطراف العملية التعليمية، لكن في الوطن العربي دور المعلم ما يزال هامشيا، كما أن تكوينه الذي يتلقاه لا يؤهله لأداء المهمة المنوطة به. وبالتالي وجب البحث عن بدائل جديدة لإعادة دور المعلم المحوري في العملية التعليمية .
داخل حقل العلوم السياسية وعلم السياسات العامة هناك نظرية تسمى نظرية النخبة (Elite Theory)، يمكن اعتمادها كإطار نظري لما ننطلق منه كأهم مدخل لصناعة معلم مؤهل لتولي شرف تكوين الأجيال اللاحقة. فحسب هذه النظرية يمكن العمل على تكوين نخبة صغيرة من الناس، تكويناً خاصاً ونوعياً، بحيث يمكن لهذه النخبة المكونة تكوينا جيدا أن تصنع أجيالا جديدة، ومختلفة، تستطيع تغيير المجتمع مستقبلا.
ونقتبس هنا مثلاً للتدليل على هذه النظرية، النموذج الياباني الرائد في التعليم، حيث نجد أن البعثات الطلابية التي أرسلتها اليابان إلى أوروبا في عهد الإمبراطور “ميجي” كانت سبباً في نهضة اليابان، إذ استفاد منها في التأسيس لما يسمى بالنموذج الياباني، فتسلم أفراد هذه البعثات الطلابية بعد عودتهم أعلى المراتب في الجهاز التعليمي والإداري، وقاموا بتطويره وفق المناهج الحديثة. وعندما سُئل الإمبراطور الياباني الميجي عن أهم أسباب تقدم دولته في ظرف زمني قصير، قال: “بدأنا من حيث انتهى الآخرون وتعلمنا من أخطائهم، وأعطينا للمعلم حصانة الدبلوماسي وراتب الوزير”. وهو مثال واضح يبين مدى محورية التعليم في تحقيق النهضة اليابانية.
نفس الشيء كاد أن يحصل مع دول أخرى تعيش وضعا مختلفا اليوم، مثل المغرب، حيث أرسل الملك الحسن الأول في نفس الفترة بعثات طلابية لأوروبا، لكنها رجعت بعد وفاته ولم يتم استخدام الخريجين في مجالاتهم، بل في وظائف بعيدة وهامشية، وبذلك تم تضييع فرصة الإقلاع الحضاري، وبقي المغرب بلداً متخلفاً تعليمياً وصناعياً وإدارياً.
هكذا فتكوين هذه النخبة أو المجموعة، سيكون له دور مهم في إنقاذ التعليم من أزمته الحالية، بالتوجه إلى تكوين خبراء في مجال التربية والتكوين، ما سينعكس إيجابا على المنظومة التعليمية ككل، حيث تتحول المؤسسات التعليمية من فضاء تلقين الدروس والمعلومات، إلى مركز لصناعة الأفكار والتأسيس للفكر النقدي عبر تحرير القدرات الإبداعية للتلميذ، ما سينعكس على الثقافة المجتمعية بالضرورة.
إجمالا، فإنه لا تنمية ولا نهضة بدون تعليم متقدم ففي الدول المتقدمة نجد أن أحد أهم ركائز تقدمها هو موقع التعليم داخل اهتماماتها وسياساتها العامة ومكانته في سلم أولوياتها. ومنه فإن استقامة العملية التعليمية ستؤدي إلى استقامة الدولة ككل وتفضي إلى تقدمها والعكس صحيح، ففشل المنظومة التعليمية ستكون له أضرار على باقي المؤسسات السياسية و الاقتصادية… إلخ، فالسياسي والطبيب والمهندس … بل حتى المعلم كذلك، كل هؤلاء تخرجوا من هذه المدرسة وكلهم تلقوا تعليمهم من نفس المعلم، وبالتالي فالمعلم هو نقطة البدء في أي تنمية ونهضة. لكن وجب التنبيه أن ما تقدم ذكره ليس الوصفة المثالية والسحرية لتحقيق التنمية والنهضة المنشودة، حيث أنه جزء من الحل، وبالتالي لابد من توفير وسائل وموارد ومناهج مساعدة.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.