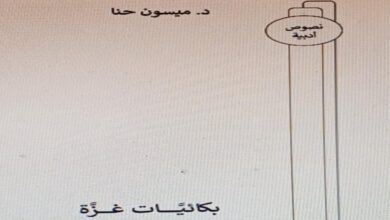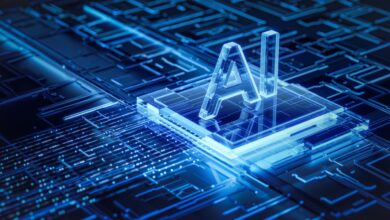سمات المعلِّم الناجح؛ التدريب على صياغة السؤال وتشجيع الحوار والتفكُّر المتعدِّد الأبعاد

أجريت قبل كتابة المقال مسحًا سريعًا لموقع البحث “غوغل” باللغة الإنجليزية لمعرفة أفضل مميزات المعلِّم الناجح، وتمحورت أغلب النتائج حول:
المعلمون المتميزون هم من يجعلون توقعات طلابهم عالية، ويتسمون بالوضوح تجاه ما يريدونه من الطلبة. كما أن المعلِّم الناجح يجعل تلامذته منظمين وبإعداد جيد ويحملهم على النظر للقضايا بطرق مختلفة، والكفؤين منهم يعملون على تشكيل علاقات قوية مع الطلبة، مع بالغ الاحترام والاهتمام والعناية بهم، ويشعرونهم بالانتماء لمجموعة متراصّة وفخورة بذاتها، والأهم القدرة على التواصل الفعال مع أولياء الطلبة. وحريّ ذكره أن المعلِّم الجيد سيد موضوعه ويمتلك صفات القائد الماهر ويحافظ على مهنيته طوال الوقت، ويكون مرنًا لتغيير مقاربته في التعليم عندما يجد طريقته غير فاعلة.. وغيرها من النقاط الأخرى المهمة والعملية.
ولكن تبقى منطقة فراغ واسعة جدًا لم ألحظها في المسح وهي عدم الحديث عن أهمية تدريب الطلبة على صياغة السؤال ونوعيته والنقاش الناقد والتأمل وغيرها. لديّ زميل وكاتب معروف في كتاباته العميقة عن الإسلام دُعِيَ ذات مرّة إلى مدرسة بنات ذات غالبية مسلمة تتراوح أعمار الطالبات في حدود 16 عامًا في مدينة برادفورد (شمال بريطانيا) للحديث في درس التربية الدينية. قال للطالبات، كما ذكرها لي فيما بعد بأساريره المبهجة، لنبدأ بالأسئلة، فجاء السؤال الأول من طالبة محجبة وهو: “كيف يمكننا تحديد إرادة الله؟” ولم يكن يتوقع مثل هذا السؤال الصعب، بل صعقه حقا، ثم جاء السؤال التالي: “هل الإسلام منسجم مع مرحلة ما بعد المعاصرة؟” وتوالت بعدها الأسئلة الباحثة والجدليّة لفترة استغرقت أربع ساعات، وشعر كما أخبرني، بالإعياء والاستجواب، وكأنما حُقِقَ معه في محكمة جنائية.. وعند استفساره من المعلِّمة عن الذي ألهم كل هذه الاستفسارات عند الطالبات لأنه اعتقد أن المعلِّمة والمدرسة كان لهما دور في الأمر.. أخبرته المعلِّمة عن التركيز على مادة “الفلسفة للأطفال” في حصة الدين، وهذا لا يعني تعليم مبادىء أفلاطون وسقراط، وإنما تعليم النماذج الفلسفية التي تحث على التعلم والبحث، وفي طرح السؤال أثناء النقاش والحوار. وتواصل المعلِّمة بأنها تشجع الطالبات على القراءة الواسعة وتأمل ما يقرأ. وعكست جلسة الأسئلة والحوار مع الطالبات كما أبلغني صاحبي “أنهن يعرفن كيف يسألن ليس من أجل السؤال، وإنما كان التساؤل قائمًا على التفكّر والتأمل بشكل نقدي”. وهذا ما ينسجم مع الخطاب التساؤلي للقرآن وإثارته للتحريّ والتأمل، بل التعقل، وإذا كان القرآن يتمحور حول الإنسان باعتباره خليفة الله على الأرض، فالأحرى بالإنسان إذاً تقليد الله في هذا الشأن وتجسيد خطابه في الواقع العملي، والتدرّب على قراءة القرآن بعمق، ولو كان القرآن ذا بعد واحد، قاحل أو كاسد ولا يملك البعد الأخلاقي فكيف كانت مهمته في تحفيز المؤمنين، كما حدث سابقًا، لتطوير العلوم والتعلّم، وتعزيز العقل والمنهج التجريبي، وإنشاء الجامعات والمستشفيات والدراسات الفلكية وغيرها، المعتمدة على البحوث وتطوير الفكر الفلسفي والحوار والنقد.
واحدة من القدرات المتميزة للمعلِّم الناجح هي حيويته في التعليم والتدريب لتمكين طلابه من مقاومة التلقين من أي نوع، والمثال العملي كما تنقلها لنا فصلية “المسلم الناقد” الصادرة في لندن باللغة الانكليزية، أنه في مدرسة ثانوية ولطلبة تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً كشفت نسبة 1:4 رغبة الطلبة في فائدة الدروس الدينية، حيث أبدى كثيرون منهم رغبتهم بذلك كونها تمنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم، وتطوير مهارات التواصل، واحتذاء المعرفة للأديان الأخرى، وتطوير الوعي باتجاه الثقافات المختلفة في البلد لتطوير المهارات والتأمل والتحري الفلسفي، والتفكُّر مليًّا لهدف ومعنى الحياة.
ولعل الخطوة الأولى التي أتَّبعُها في مسار تدريب طلبتي في المرحلة الجامعية هي “كيفية التفكير” وليس “لماذا التفكير”؛ فعند إتقان الأولى يتمكن الطالب من القدرة على صياغة السؤال ونوعية السؤال والتعاطي مع المشاكل عمليًّا بأخلاقية عالية، فضلاً عن دوام الاستمرار في تدريب الذهن على القدرة الذاتية، وتنمية الثقة بالنفس والمبادرة، وهي إحدى مهارات القيادة الفاعلة. بينما الثانية للأسف تجعل الطالب مقلِّدًا ويحاكي التكرار الممل.
وفي هذا الإطار يتساءل البروفيسور ضياء الدين سردار، الكاتب والناقد البريطاني المعروف عن أزمة التعليم في عالمنا الإسلامي، ويعتقد “أن الأسباب الداخلية الخاصة بالمسلمين فيما يتعلق بغياب المعرفة الحديثة، وهيمنة منظومة وإطار مفاهيمي قديم، وتبجيل المسلمين للحفظ الشفهي للقرآن، وفرحهم لأن فتية صغارًا حفظوا كتاب الله عن ظهر قلب من الغلاف إلى الغلاف. لكن هذا ليس بتعليم حقيقي، بل أصبح اليوم العائق نحو تطوير الحس والوعي الذي يركز عليهما القرآن. تعلُّم القراءة والكتابة ليس بهدف القرآن في المجتمع فحسب، وإنما لولادة ثقافة، وإنتاج معرفة جديدة ليست مكتسبة، وبناء حضارة فاعلة ومزدهرة.. وهي الأدوات الأساسية التي علمها الله لنا لتسهيل التواصل كما في القرآن (سورة الرحمن:آية 4) وغرس الأفكار في البشر”.
وثمة مشكلة تتمحور حول دور المعلم وتعاني منها حتى البلدان المتطورة، حيث التربية السائدة في الولايات المتحدة قائمة على تحدّث المعلمين واستماع الطلبة لهم، وتتخللها أحيانًا المناقشة الموجهة من قبل المعلِّم! وليس من ذات الطلبة عبر أسئلتهم. كما كشفت دراسة استقصائية واسعة النطاق عن المدارس الثانوية البريطانية بأن أقل من 10 في المئة من كلام المعلِّم في قاعة الدرس يكون موجهاً نحو تطوير نظام مهارات التفكير العليا، بينما يتم توجيه الغالبية العظمى من ذلك الوقت في المراقبة والسيطرة والإدارة، بما في ذلك حفظ النظام وإعطاء التعليمات، لهذا تنتقل الحقائق والمعلومات على مستوى منخفض.
ويكمن هدف معظم الاستجوابات والأسئلة الموجهة للطلبة في السعي للحصول على “الإجابات الصحيحة” فيما يتعلق بالمحتوى المحدد، كما هو مطلوب من قبل نظام اختبار وتقييم، بدلاً من تعزيز المناقشة من خلال وجهات نظر بديلة أو غيرها من الإجراءات العليا للتحقيق أو عمليات استكشاف واستطلاع التأمل.
وتؤكد الفيلسوفة الاجتماعية حنة أرندت (1906 – 1975) أن “الهدف من التعليم الاستبدادي أو الشمولي ليس أبدا لغرس القناعات، ولكن لتدمير القدرة على تشكيل أية منها”.
التعليم المتمحور حول المعلِّم لا يمكنه تدريب العقل ونقل المعرفة لأنه يتم على حساب التنشئة الأوسع (تربية) ويساوم على سلامة وتكامل التجربة والخبرة ويجعل من الطلبة عناصر خاملة. لتعددية المعتقد والتنوع، والأهم كرامة الإنسان بشكل جوهري وليس كرامة المسلم فقط. ودور أهمية المفاهيم ذات الصلة بالتعددية والتنوع والتبادل الثقافي، والعلاقة مع الآخر، وتوسيع آفاق المعرفة بسبب وجود صلة واضحة بين كل ذلك ودور الحديث، والخطاب والنقاش والحوار والجدل كمرتكز لأي تحوّل مقتدر في العملية التعليمية. سألني صديق ذات مرة: لماذا أطلقنا على منظمتنا تسمية “المنبر الدولي للحوار الإسلامي” وكان جوابي مختصرًا وهو أن الحوار هو جوهر القرآن، والحوار مع الآخر المختلف داخليًا (أبناء الجلدة) وخارجيًا هو أساس التعلم والخبرة في الحياة.
ولا بد من القول إن اقتلاع التحيّزات (التحامل أو التطرف أو التعصب) ومقاومة التلقين، وتحدي الحفاظ على ميكانيكية تفكير البعد الواحد، والنصوص الخلافية، يجب أن تكون واحدة من أهم وظائف المعلّمين والمدربين والباحثين من الأكاديميين المرموقين، مع ترسيخ ممارسة النقد الثقافي الساعي إلى البحث عن الحقيقة والتنظيم والتقييم النقدي للأدلة. إضافة إلى الاشتباك الفكري الحاسم والصريح مع وجهات نظر بديلة، والتنافس في النقاش أو الجدل بقصد الوصول إلى أدلة متناقضة لخدمة الصقل التراكمي للمعرفة الإنسانية. وقد أثبتت العملية الجدلية الفلسفية من أفلاطون ولغاية اليوم أنها متميزة تمامًا ومتفوقة بما لا يقاس عن علم البلاغة وفن الخطاب كوسيلة للإقناع، فضلاً عن ولادة الأفكار وتبلور المفاهيم.
إحدى الأقوال المأثورة التي تنسب إلى الفيلسوف ورجل الدولة الإنكليزي في القرن السابع عشر فرانسيس بيكون أن: “المعرفة قوة”، كتبها باللاتينية عام 1597 موضحًا إياّها بأن المعرفة تساوي القوة، ويستمر بالقول إن المعرفة “ليست مجرد حجّة أو زخرفة” وقالها بسبب استيائه من المنهج المدرسي التقليدي آنذاك، محاولًا ربط المعرفة مع الفعل أو العمل، لإنتاج المعرفة العملية على أساس المبادئ التجريبية “لفائدة الإنسان”.
أيّد بيكون مهمة تطهير العقل من التعصب والتكييف والمفاهيم الخاطئة، أو ما أسماه “أصنام العقل البشري” التي تشوّه الطبيعة الحقيقية للأشياء واستخدام- بدلاً من ذلك- الفعل والخبرة المباشرة والرصد والإدراك والاستقراء كوسائل لكسب المعرفة العميقة. ويطلق بالمقابل على عوائق التفكّر والفهم السليم تسمية “أصنام” التي تحاول البحث عن أدلة لدعم الأفكار المسبقة، ورؤية ما يتوقع المرء أن يرى، واعتقاد ما يريد المرء أن يصدقه، والتعميم، وتفضيل نظرة أو وجهة نظر على الأخرى، كذلك عدم الوعي أن للكلمة قد يكون هناك أكثر من معنى.
هذه القائمة المتألقة التي لها صدى في عالم اليوم، تؤكد ما جاءت به النتائج الرئيسة من علم النفس الإدراكي (العقلي) والتخصصات ذات العلاقة حول طبيعة التلقين والتكييف والتحيّز والعوائق الأخرى للتعلم. وشكلت أفكاره في التركيز على الفعل والتجريب والجانب العملي للأمور، الأثر البالغ لعصر النهضة الأوروبية، وهو من الذين قرأوا وربما تأثروا بأفكار ابن طفيل، العالم الأندلسي، وقصته الشهيرة “حي بن يقظان”. والجدير ذكره أن فيلسوف الحسّ البريطاني الكبير، جون لوك، عقد جلسات ومناظرات عامة مع أكاديميين بريطانيين في دراسة قصة ابن طفيل في التفصيل واستنباط العبر والاستنتاجات لتطبيقها على الواقع الانكليزي.
المعلِّم الكفء هو الذي يحث طلابه على الانفتاح وحب المعرفة والاستطلاع ويقدح القوة فيهم للتعرف على كتلة معارف البشرية والتحلي بالتفكير المتعدد الأبعاد للتمكن من حشد الأدلة والبراهين والأهم مقاومة التلقين والتكيف والانحياز.
أهم ميزات معلم الدين هي إدراك الطاقات والإمكانيات البشرية مستخدمًا، ليس العقل فحسب، وإنما جميع الحواس، فضلاً عن الجوانب الأخلاقية والروحية في عمليات التعليم والتعلم. يقول جيرمي هانزل توماس خبير التعليم “أعتبر بديهية إن التعليم النوعي (جودة التعليم) حقاً لا يمكن إلا أن يستند إلى فهم ناضج من مجموعة كاملة من القوى والملكات البشرية – المادية والحسية والمعرفية، والإدراك، والخيال، والوجدانية والأخلاقية والروحية – وإذ تضع في الاعتبار أن المنظور الروحي لكل هذه القوى والملكات هي أوقاف إلهية” و”ليس هناك سلطة ولا قوة إلا بالله وحده”.
مفهوم وممارسة التعليم الشمولي وربما بتعبير أدق الكلي أو المتكامل هو أيضاً جزء لا يتجزأ من الرؤية الشاملة لملكات الإنسان في الإسلام. هناك النصائح المتكررة في القرآن لاستخدام الملكات التي أتيحت لنا لتحقيق المعرفة وإدراك الحقيقة. وتشمل هذه الحواس، والتي تمكننا من التعلم عن طريق الملاحظة المباشرة والخبرة، وكذلك من خلال التعليمات، وعلى أساس اللغة التداولية أو عقلانية الملكة (عقل) والتي تدفعنا إلى التفكير والاستفسار والتحليل والتعريف والتمييز، والانخراط في عملية جدلية. في هذا المضمار تمكننا الملكات الأخلاقية الرأسية في المعيار (الفرقان) من التمييز بين الصواب والخطأ، وتحمّل المسؤولية الشخصية والمساءلة في نهاية المطاف لأعمالنا. وفوق كل ذلك، الوعي واليقظة في الله (التقوى) والرغبة في إجراء حياة المرء على ضوء هذا الوعي. ليستنتج توماس تالياً أن “التعليم يجب أن يمنح القدرة على التعرف على المدى الكامل لقدرات وملكات الإنسان لأجل أن نتمكن من السيطرة الواعية في تطورها داخل ذواتنا”. وهذا يعبر عن رؤية متكاملة للملكات الإنسانية في التعليم الديني التي يجب أن لا تفصل بين القوى العقلانية من الخبرة المباشرة، والتقييم الأخلاقي والوعي الروحي وربطها وتقييمها باستمرار مع الواقع المعاش.
المعلِّم الجيّد في عمليات التعليم هو ليس المعلِّم الناقل للمعلومات والصاقل للمعرفة والثقافة فحسب، وإنما المربي للنفوس والمطور للأخلاق والنافع لشخصية المسلم.
ضرورة المعلِّم الكفء تكمن في قدح عناصر الإبداع والأخلاقية الكامنة عند الطلبة والساكنة في ذواتهم وعدم مقدرتهم لتفعيلها إما بسبب عدم امتلاكهم لمفاتيح تحرير هذه القدرات والمواهب أو عدم وجود البيئة الخصبة لتوفير عناصر الانطلاق للطاقات المبتكرة، أو عجز أساليب وطرق ومحتوى العملية التعليمية وغيرها من العوامل الأخرى. وحيوية وعي أن التدريب على الإبداع وتصميم الأمثلة / التمارين العملية وغير ذلك لا يستبدل الأسس والمفاهيم الأولية، وغالباً ما تكون عمليات الإبداع حول «كيف» وليس «ماذا» يعلّم.. وتنبع أهمية عملية التصميم في عملية التعلّم والتدريب للربط بين الإبداع والأخلاقية للوصول إلى ابداعات جديدة تلامس حياة الطلبة.
المعلّمون المبدعون عمليًا هم القادرون على إحداث وزرع (التغيير) عند الطلبة؛ أي تحويل الفكرة إلى مفهوم ملموس يمكن استثمارها في التطبيق كتصميم برنامج أو فكرة تلامس حياة الطلبة وتصميم أمثلة/تمارين/مشاريع تقرب المفهوم (النظري) من الواقع، وتستخدم كذلك دورات التعليم والتدريب أدوات وتقنيات مجرَّبة وناجحة أو طرق تحليل المجتمع/السوق أو ممارسة العصف الذهني واستخدام بيانات/استطلاعات وورشات العمل المتخصصة، فضلاً عن عمليات القياس أو نقاط الارتكاز Benchmarking، ولو أن الأخيرة هي تفصيل من استراتيجية العملية التعليمية، غير أن بإمكان المعلم إيجاد نقاط ارتكاز قاعدية خاصة به. شخصياً كنت على الدوام أقارن بين معدل النجاح في المادة من قبل الطلبة، وبين نسبة استيعاب المبادئ والمفاهيم في المادة المعنية من خلال تدرج صعوبة التمارين والأسئلة والمشاريع.
التحوّل في التعليم/التدريب مرتبط بفهمنا الجديد في كيفية إحداث عملية التعلّم عند المتلقين من الطلبة وتشخيص أن التعلم/التدرب هو عملية تغيير عضوية تحدث في الدماغ ومن المحتمل كل الجسد. التعلم، كما يقول علماء النفس، يرتبط بالضرورة في إعادة اتصال مسارات الأعصاب (يمتلكها الطلبة)عند وصولهم صفوف التعليم/التدريب، وتزداد هذه العملية عمقًا عندما يتفاعل المتلقين/المتعلمين جسدياً مع بيئاتهم فيما يتعلق بالمعلم والمادة ووسائل الإيضاح وغيرها. فقد ترى بناية، مثلاً، تعتقد أنها تجارية لتكتشف بعدها أنها سكنية.. هذا لا يعني أنك لم تتعلَّم شيئًا، وإنما أكمل الدماغ دورته للتعلُّم. دورة الدماغ تبدأ مع خبرات صلدة وملاحظات بسيطة وتستمر بالتأمّلات التي تربطها مع الأشياء المعروفة سلفًا، لذا يجب أخذ أعلاه وعادات العقل وغيرها في الاعتبار في برامج التعليم/التدريب. والمعلِّم الناجح يعي تماماً أن التعليم والتعلم يعتمد على إحداث روابط/علاقات بين الأشياء قبل تقديم المعرفة.. وتوعية الطلبة على التفكّر وتعلم رؤية الصورة الأشمل Big Picture للأمور.
وجزء من عملية التعلم الحديثة توفير المعلومات على شكل صور والتعلم عبر الرسوم التخطيطية؛ أي التفكير الصوري/تحقيق الأفكار عبر الصور.
والمعلِّم الناجح يضع أسئلة أساسية له في نهاية العام الدراسي أو الدورة التعليمية:
ماذا سيتذكر الطلبة عند الانتهاء من الدورة التدريبية أو العام الدراسي؟
هل أحدثت الدورة/الدراسة تغييرًا في الطالب/المتلقي حتى يترجم أثره في محيطه الصغير/الكبير؟
هل كانت هناك إضافة مهمة للحياة العملية في التعامل مع (أو صياغة) مشكلة الذين لا يتواصلون مع الدورة/التعليم؟ هل الطلبة بعد التعليم قادرون على جمع المعلومات وتحليلها، واختبار الأفكار، وتقديم الافتراضات والحلول، وتمييز الدليل عن الاستنتاج ، والأهم كيفية النقاش بمنطق؟
والجوهر في غرس عناصر الإبداع أن يكون الطالب واعيًا للمسألة الأخلاقية وأن يكون هناك ترابط بين الإبداع وأي مفهوم أعلى من شخصية وأخلاق الإنسان. فالإبداع جانب من جوانب الامتياز والنجاح والتفوق البشري، وأن لا يكون تصوره مجرد براعة أو شطارة من دون أي اعتبار للجانب الأخلاقي للأغراض التي يتم استخدامها. كلنا نتذكر الهزة المالية للبنوك والمؤسسات الغربية عام 2008 التي كادت تطيح بالاقتصاد العالمي، ومُنِيَ الكثير من المواطنين العاديين والأبرياء بخسارة أموالهم ووظائفهم بسبب الطمع والغش. العمليات التي تمت بها هذه السرقة كانت “متميزة” وحتى “مبدعة” إن صح تسميتها، لكنها ماكرة وفاقدة للعنصر الأخلاقي. وكلنا نتذكر فيلم “وول ستريت” عندما يردد كوردن كيغو (أحد أبطال الفيلم): “الطمع جيد…” أليس ما طبقه الإسلام السياسي في العراق وفي بلدان عربية أخرى من فساد مالي وبطرق عجيبة وجديدة تفوق مرات عديدة ما ردده “كوردن كيغو” لدرجة وصول تلك البلدان إلى حافة الانهيار.
لذا يوجد فارق مهم بين الاحتراف والامتياز.. المافيا فيها رجال باحتراف كامل للقتل والغش، هل بالإمكان القول إنهم محترفون جيدون أو ما يسمونه بـ “الشطارة”. الفرق هو أن قلب الامتياز ليس مجرد الإتقان الشخصي للمهارة أو الفاعلية في إنجاز مهمة، بل يشمل تميّز شخصية الإنسان، المتسمة ببعد أخلاقي، وفي نهاية المطاف البعد الروحي. ونلحظ كم الكلمات دقيقة وجميلة بهذا الشأن في القرآن كالإحسان وغيرها كما في أسماء الله الحسنى، سمات الله المقدسة، وانعكاسها على روحية الإنسان المؤمن بها، لإحداث الربط الجميل وإفرازات كل ذلك على الصقل الروحي والأخلاق الفاضلة التي يجب أن تكون جزءًا وافرًا من عمليات التعلُّم.
فلسفة الرؤية المتكاملة لملكات الإنسان في التعليم الديني يجب أن لا تفصل بين قوى العقلانية من الخبرة المباشرة أو العملية والتقييم الروحي، وهذا لا يتم إن لم يكن المعلِّم قادرًا على منح القوة والوعي والمعرفة للوصول إلى رؤية عالمية في الامتياز تشمل الحقيقة والمعنى والهدف والغرض عن ماذا يعني بأن يكون المرء إنساناً متكاملاً في الذات والآخر. لذا تكمن قيمته عند امتلاء ذاته وقدرته على الاختيار، وأن يكون متمكِّنًا من تدريب طلبته على عمق واتساع البصيرة التي تمكنهم من إدراك وحدة المعرفة وتقدم المعرفة البشرية، كما نرى في التاريخ ليس في اتجاه واحد. والرقي لا يحدث من استيعاب ثقافة واحدة أو النظر إلى الآخر من خلال عدسات التغرب، أو أسلمة المدارس والجامعات والمعرفة، بل تكامل المعرفة لأفضل ما هو موجود في كل ثقافة وحضارة لبلوغ هدف القرآن، الوحدة في التنوع.
المعلِّم الجيد هو الذي يدرك كيفية منح طلبته القدرة للوصول إلى رؤية عالمية في الامتياز والشاملة للحقيقة، المعنى، والهدف والغرض عن ماذا يعني وكيف أن يكون إنسانًا متكاملًا.
وتنبع أهمية مسح واستطلاع الطرق الجديدة والمبدعة للتعليم والتدريب عند المسلمين في نهاية المطاف حول كيفية بناء القدرات عند الشباب وتسليحهم ذهنيًا وعمليًا في كيفية الارتباط والتعامل مع المشاكل المعقدة في البلدان الإسلامية كتلك التي يتمتع بها المنبر الدولي للحوار الإسلامي. فالمسح والاستطلاع للمنظمات ونوعية برامجها التعليمية، على قلتها، تمكن من التواصل والمقارنة وتعلم الخبرات للارتقاء بوعي ومعرفة ما يجعل المعلِّم والمدرِّب ناجحًا وكفؤًا في عمليات تعليمه وتواصله مع الطلبة.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.