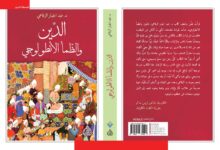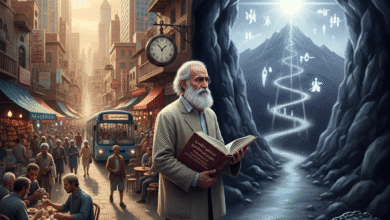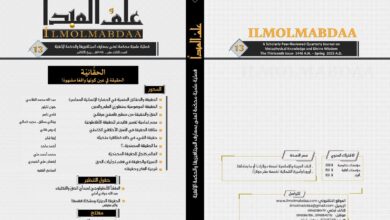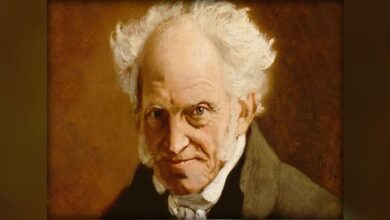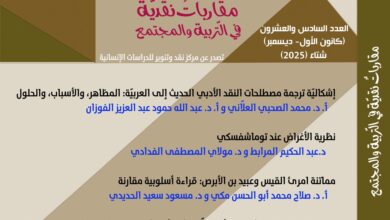حقّانية المثنّى كمبدأ أنطولوجي
في مواجهة الثنائيات الفلسفية: بحث في الواحد الذي يجمع الكثرة والأضداد
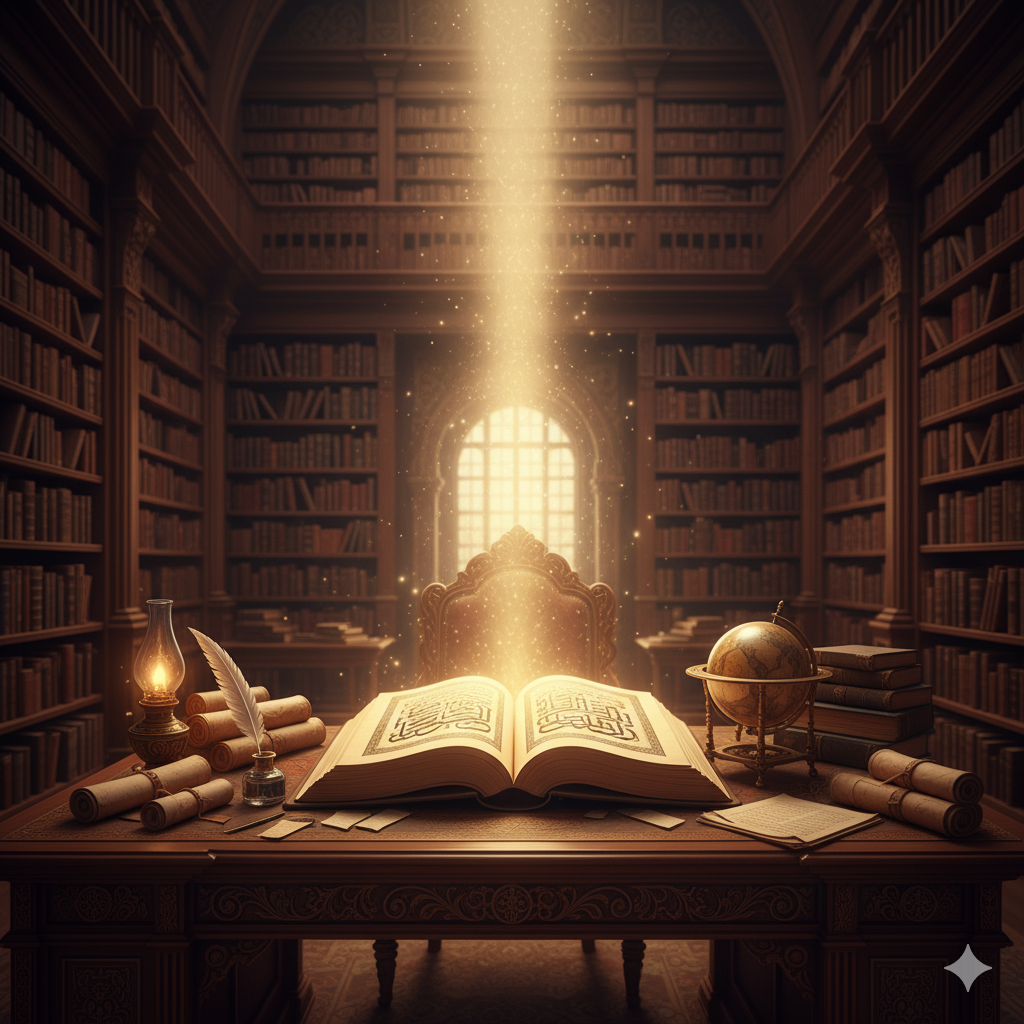
لدى الكلام على حقَّانيَّة الموجود الأول – بما هو المبدأ الذي منه كانت وتبدَّت سائر الموجودات- ينبسطُ منفسحٌ مُفارقٌ لا تبقى فيه المكابدة الميتافيزيقيَّة على سيرتها الأولى. فلئن رأينا إلى هذا الموجود بوصفه مبدأً مؤسِّسًا لسلسلة الموجودات كلِّها، نكون رسمنا أفقًا للتعرُّف على مَشكلٍ أنطولوجيٍّ أفضى إلى اعتلالاتٍ تكوينيَّةٍ عميقةٍ ومديدة في عالم الميتافيزيقا.
لقد ابتنينا مسعانا التنظيري إلى هذه الغاية، على تصوُّرٍ لموجودٍ بَدئيٍّ، منه كانت الموجودات كلُّها، وفيه انطوت مبادئها وعِلَلُها الكلّيَّة، وبه ظهرت أجناسُها، وأنواعُها، وفصولُها، وأسماؤها التي سُمِّيت بها. ولقد افترضنا أنَّ هذا الموجود البَدئيَّ، هو الحقيقة الواقعيَّة الأولى؛ كان ذلك في استتارها من قبل أن تؤمر بالظهور، وكذلك كان الحقيقة إيَّاها من بعد إظهارها. حتى أنَّه لَيُنظَرُ إليه كأمرٍ واقع مشهودٍ بالعين والعقل، فلا تشاكُل واقعيَّته حالئذٍ شاكلة. هو كائنٌ غير مسبوق بكائنٍ كان على شاكلته، فما سَبَقه كائنٌ من قبل، ولا كان له من قبلُ نظير. خاصِّيتُه أنَّه يجمع إلى فرادته البساطة والتركيب، ويختزن في كينونته الواحدة كثرةً لا يعتريها تباينٌ ولا يصيبُها اعتلال. ولقد ارتأينا نعتُه بـ”المثنَّى” لكونه يفيد بالإثنينيَّة غير القابلة للإنفصال، وتلك خاصِّية لا يتوقَّف فهمها على إبداء لفظيٍّ أو نعتٍ دلاليٍّ، وإنَّما على ما يتفرَّد به ذاك الكائن من مفارقات وأسرار وحقائق. فالتفرُّد في المثنَّى ليس مجرَّد صفة عارضة عليه، إنَّما هي عين حقَّانيّته التي استحقَّها لفظًا ونعتًا ومقصدًا أنطولوجيًّا. ومتى أدركنا أنَّ حقَّانيَّة هذا المنفرد في ذاته، هي حقيقته في عين كونها واقعًا مشهودًا عليه، سينفتح لنا السبيل حالئذٍ إلى إدراك ماهيَّة هذا المبدأ والتعرُّف على غاية مُبدئِه من إبدائه.
ماهيَّة المبدأ المنعوت بـ”المثنَّى”
كنا ألْمَحنا في ما تقدَّم، إلى المفارقة الوجوديَّة الثاوية في ماهيَّة المثنَّى. فهو من حيث كونه “الشيء في ذاته” أو ـ “النومين” بحسب الإصطلاح اليونانيِّ ـ لا يستقيم فهمه إلَّا بضدِّه. أي بـ “الشيء الذي يظهر على مرأى العين، ويُستدلُّ عليه برياضات العقل. من مفارقاته: قيامُه على واحديَّة الظهور والخفاء. فهو ظاهرٌ بكثرته، مستترٌ بواحديته، وهو في الآن عينه، غامضٌ حتى ليخالُه العقل الأدنى قضيَّة ظنَّيَّة لا تفيد اليقين بشيء. وسنرى بمقتضى هذه المفارقات وسواها، كيف استعصت ماهيَّتُه على الفهم؛ ذلك إلى الحدِّ الذي أنكرته الفلسفة الأولى، وجَحِدَ به أكثر فلاسفتها من المتقدِّمين والمتأخِّرين.
يحظى المثنَّى – في مكانته الأنطولوجيَّة – بالقدرة على حواية الموجودات أنَّى كان اختلافُها وتضادُّها ومفارقاتُها. ولأنَّ حقيقة المبدأ – هي إيَّاها حقَّانيَّة “المثنَّى”- وتتَّصف بصفاته، فإنَّ خاصّيَّة المفارقة والتضادِّ التي ينطوي عليها، هي بحدِّ نفسها رابطة تماثُل وتكامُل وانسجام. وعلى ما يقرِّر المناطقة، فالحالتان المتضادَّتان إذا تتالتا، أو اجتمعتا معًا في نفس المدرِك، كان شعوره بهما أتمَّ وأوضح؛ وهذا لا يَصدُق فحسب، على الإحساسات والإدراكات والصور العقليَّة، بل كذلك على جميع حالات الشعور كالَّلذَّة والحبِّ والخوف والألم. فإنَّ الأشيــاء تتميَّز بأضدادها، وقانــون التضادِّ هـو أحـد قوانين التقابل (opposition) الذي يدلُّ على علاقة بين شيئين أحدُهمــا مواجِهٌ للآخر، أو علاقــة بين متحرِّكين يقتربان سويَّة من نقطة واحدة، أو يبتعدان عنها. ولصلته المنطقيَّة بالمثنَّى نحوًا واصطلاحًا يتَّخذ التقابل وجهين: أحدهما، “تقابل الحدود”، وثانيهما، تقابل القضايا. المتقابلان في تقابل الحدود هما الَّلذان لا يجتمعان في شيء واحد، وفي زمان واحد. ومن هنا نستطيع أن نستظهر التمايز الجوهريَّ بين وجهَيْ التقابل المذكورين ومنطق المثنَّى، حيث يستوي الأخير على نصاب مفارق يعربُ فيه عن الواحديَّة الحاوية للتعدُّد، وبالتالي كنقيض للإثنينيَّة كما سيتبيَّن في ما بعد..
ثمَّة إذًا، فارقٌ أصليٌّ بين ماهيَّة المثنَّى المتأسِّسة على التناغم والانسجام الذاتيِّ، والإثنينيَّة المُنبَنِية على الاختصام وجدل التناقض. بيان المقتضى، أنَّ كلَّ تناظرٍ بين متقابلين في الإثنينيَّة آيلٌ إلى التنابذ والفِرقة، بينما كلُّ الأشياء – على اختلافها وتضادِّها وتناقضها – محمولة على الانسجام والجمع في حضرة المثنَّى. الداعي إلى هذا الفهم، هو أنَّ زوجيَّة المثنَّى لا تعمل إلَّا وفقًا لقانون التكامل؛ ولأنَّها كذلك فإنَّ سعيها نحو الوحدة يجري طبقًا لمبدأ الامتداد الجوهريِّ في الواحديَّة الجامعة للكثرة والتنوُّع. وعلى أساس هذا المبدأ الساري بالانسجام والتناسب بين أضداد المثنَّى، لا يعود ثمَّة قطيعةٌ في ما بينها، بل تكاملٌ لا تباين فيه. واتِّساقًا مع نظائر المثنَّى ومتشابهاته، نرانا أيضًا بإزاء مفهوم القطبيَّة الذي يعني وجود ثنائيَّة أصليَّة لها قطبان متعارضان، في كلِّ شيء، ولكنَّهما يتعاونان بالضرورة، ولا قيام لأحدهما من دون الآخر. ومن تضادِّهما وتعاونهما تنشأ مظاهر الوجود وتستمرّ. في النفس البشريَّة تجتمع ثنائيَّات خلَّاقة كامنة في أغوار النفس الإنسانيَّة. فالحياة وكذلك الموت غريزة بيِّنة الحضور في أصل وجودنا، بل إنَّ ظواهر الوجود كلِّها هي حاصل التجاذب بين قطبَي هذه الثنائيَّة.
المفيد ممَّا ذكرنا، أنَّ التحامًا جوهريًّا بين الأزواج قد حلَّ في حضرة المثنَّى. فلا يستطيع أيٌّ من عناصره أن ينفكَّ عن نظيره انفكاكًا تامًّا. هما من نفس واحدة، لكنْ لكلِّ فردٍ في الكثرة الأصليَّة نفسٌ فرعيَّة تدبِّر له أمره ويتدبَّر بها شأنه، إلَّا أنَّه لا يقدر على أن يبرح عالم الزوجيَّة والقوانين الكلِّيَّة التي تنتظمه. أمَّا الوجود الأوحد لذاته بذاته في ذاته، فهو الذي لا ضدَّ له، بسبب أحديَّته، وتعاليه على الثنويَّة، وتنزُّهه عن مخالطة المثنَّى في آن، هو ما يُسمَّى أحيانًا الحقيقة الغائيَّة، أو المبدأ الإلهيّ. في حين أنَّ العمليَّة الخَلقيَّة، أو فعل إيجاد العالم، يستلزم التضادَّ بطبيعته. حتى في النظام الإلهيِّ هنالك توسُّطات تدبيريّة – أو حسب التعبير العرفانيِّ أسماء وصفات إلهيَّة – يمكن عن طريقها معاينة الكثرة، ونظام الضدِّية الذي تحتكم إليه. ويجوز القول تبعًا لمبدأ التوسُّطات المشار إليها، أنَّ دائرة الأسماء والصفات الإلهيَّة هذه، هي التي تنطلق منها مساحات النسبيَّة. ولذا، فإنَّ ظهور أشياء هذا العالم كافَّة، وهي الصادرة عن الأمر الإلهيِّ، إنَّما يتمُّ عن طريق أضدادها. وبهذا، فالحياة في عالم الظهورات، أو في مرتبة التجلِّي، حياة سارية في عالم أضداد لا ترتفع إلَّا في الوجود الجامع للأضداد (Coincidentiaoppositorum). وعليه، فالأضداد في مرتبتها الوجوديَّة تتعارض في الغالب، وتفتقر إلى التحمُّل والتسامح بعضها حيال البعض الآخر. ولهذا، لم يكن التسامح أو عدم التسامح مجرَّد أمور أخلاقيَّــة، بل هي ذات بُعدٍ آفاقيٍّ، وهذه نقطة جرى التشديد عليها في التعاليم التراثيَّة الشرقيَّة التي أكَّدت أنَّ القوانين البشريَّة والقواعد الأخلاقيَّة ليست منفصلة عن بعضها. وعلى ذلك لا ينبغي النَّظر إليها على أنَّها مجرَّد خيار أخلاقيٍّ أو قيميٍّ، بل ينبغي اعتبارها حقيقة أنطولوجيَّة أيضًا. أي أنَّها ذات أصل وجوديٍّ حيث تتموضع الحقيقة الأخلاقيَّة في الحقيقة الأساسيَّة لنظام الخلق. إلَّا أنَّ الكثرات الموجودة في نشأة الظهور والتجلِّي، رغم توفُّرها على وجودات متلائمة ومتكاملة بعضها مع بعض، فإنَّ بُعدها الصراعيَّ يمكن ملاحظته في المتضادَّات السلوكيَّة، كالتضادِّ بين الصدق والكذب، والجمال والقبح، والخير والشرّ.
قلنا، إن المبدأ المنعوت بـ “المثنَّى”، هو محدَثٌ قديم الوجود دلَّ عليه الحكماء بالموجود الأوَّل. وهذا الموجود المفطور على الزوجيَّة مؤلَّف من زوجين متَّحدين في واحدٍ كلِّيّ. هو في طبيعته التكوينيَّة قائمٌ على وحدة أضداد ينتظمُها تدافعٌ وتضادٌّ أبديَّان في ما بينهما؛ وتلك سَيْريَّة جوهريَّة تحفظ تنامي المخلوقات وتجدُّدَها المستدام.
ماهيَّة المثنَّى كما عرَّفته الفلسفة الأولى
لا ينأى ما تقصده العلوم الإلهيَّة في الزوجيَّة المؤسِّسة لعالم الخلق، عمَّا ذهبت إليه بعض مذاهب الحكمة القديمة باعتبار الزوجيَّة مبدأ تفسير الكون وفهم أسراره. من ذلك يمكن أن نستذكر على سبيل المثال، ثنائيَّة الأضداد وتعاقبها عند اليونان القدماء، أو ثنائيَّة الواحد وغير المتناهي عند الفيثاغوريين، أو عالم المُثُل عند أفلاطون… إلخ. لكن من المفيد الإشارة إلى أنَّ الثنويَّة التي قالت بوجود أصلين للوجود، ولكلٍّ منهما وجودٌ مستقلٌّ في ذاته، ومن غير هذين الأصلين لا يمكن فهم طبيعة الكون.. إنَّما هي ثنويَّة تختلف جوهريًّا عن المثنَّى كمخلوق حاوٍ للمخلوقات ذات النشأة الواحدة.
لم تنجُ الفلسفة من تاريخها الإشكاليِّ بصدد التعرُّف على المبدأ الأول لظهور الكون. فإنَّها غالبًا ما مزجت في تقاليدها ومواريثها السارية بين الله والنشأة البدئيَّة للعالم. من ذلك راحت تتشكَّل معضلة المكوث المُستدام في كهف السؤال عن ماهيَّة هذا الكائن المختفي في ذاته، ثمَّ صار كونًا لامتناهيَ السِّعة والعظَمة. العقل الفلسفيُّ [القبل- وحياني] ظلَّ على حيرةٍ من أمره، فلم يفلح علمًا لا بالغاية من إيجاده، ولا بموجِده. وهذا هو السبب الذي جعل كلَّ مسألة ذات طبيعة فوق ميتافيزيقيَّة تستعصي على الانكشاف. على ذلك، كانت المعثرة الكبرى في مشاغل الميتافيزيقا الكلاسيكيَّة في انزياحها عن مهمَّتها الأصليَّة؛ أي عن فهم العالم كوجود متَّصل، والنظر إليه كامتدادٍ جوهريٍّ متواصل بين مراتبه المرئيَّة والَّلامرئيَّة. ولئن كانت هذي هي مهمَّة الميتافيزيقا الأصليَّة فذلك تذكير بما هو فيها ومنها من بداهة. أي استكشاف ما يحتجب عن ملكات العقل وتجاربه، وهذا إقرار لها بوصف كونها علمًا حيًّا، يحيي نفسه ويحيي سواه من العلوم والمعارف في الآن عينه. إنَّه أيضًا عرفان لها بالجميل وهي تقيم علاقة شديدة الخصوصيَّة بالوجود لجهة رسالتها الأصليَّة، حتى وهي تعتني بعالم الممكنات وعوارضه من خلال الاهتمام بأسئلة الممكنات المتناهية وعوارضها. وهذا مألوف في سيرتها التاريخيَّة ومدوَّناتها، حيث إنَّ الخاصّيَّة الملحوظة لكلِّ التعاليم الميتافيزيقيَّة هي التقاؤها على ضرورة البحث عن السبب الأوَّل لكلِّ ما هو موجود. ذاك الذي سُمِّي المادَّة الأولى مع ديمقريطس، والخير مع أفلاطون، والفكر الذي يفكِّر بذاته مع أرسطو، والواحد مع أفلوطين، والوجود مع كلِّ الفلاسفة المسيحيين، والقانون الأخلاقيَّ مع كانط، والإرادة مع شوبنهاور، والفكرة المطلقة عند هيغل، والديمومة الخلَّاقة عند برغسون، و”المونادا” أو الواحد البسيط لدى ليبنتز…
لنا في ما يأتي أن نبدي باقتضاب طائفة من نظائر “المبدأ / المثنَّى” كما وردت مسمَّياته في مدوَّنات الفلسفة الأولى ومذاهبها:
المسمَّى الأول: “المائيَّة” أو المبدأ الذي هو أصل كلِّ الأشياء
يوجز طاليس(Thales 624- 546 ق.م) وهو أوَّل الحكماء السبعة، يوجز نظامه الفلسفيَّ بالاعتقاد أنَّ الماء أصل الأشياء جميعًا، وأنَّ الكون مليءٌ بالآلهة، وأنَّ الاختلافات بين الموجودات ليست إلَّا نتائج استحالات عرضت للماء فغيَّرت مظاهره الخارجيَّة التي كانت ترافقه وهو ماء، وأحلَّت معها خاصّيَّات أخرى تتلاءم مع المصدر الجديد الذي استحال إليه الماء؛ فكلُّ شيء راجع إلى الماء، ومن الماء وُجِدَ كلُّ شيء.
قول طاليس «إنَّ الماء أصل كلِّ الأشياء» أوَّلهُ بعضهم بأنَّه يشي بما لم يعلن، رائيًا إلى الماء الإله الموجِد لكلِّ شيء، لأنَّه المبثوث في ثنايا كلِّ شيء. في المقابل رأى آخرون أنَّ قولًا كهذا قد يفيد اعتقاده بالتوحيد، عبر الإقرار بإله متجلٍّ بالماء. حيث هو الموجود في كلِّ شيء، وموجِد كلَّ شيء. إلَّا أنَّ كثيرين وجدوا أنَّ هذه الأقوال ليست سوى تأويلات أُلبِسَت طاليس إلباسًا ولا تعكس مقصده البتَّة.
المسمَّى الثاني: “الأبيرون” أو الَّلامتناهي الكونيّ
أحد أبرز فلاسفة ملطية أنكسميندر (Anaximander 611-547 ق.م)، ينكر فكرة معلِّمه طاليس أنَّ «الماء أصل الأشياء جميعًا»؛ ودليله أنَّ الماء جزءٌ كغيره من الأجزاء، والجزء لا يكون أصلًا للكلِّ المركَّب من أجزاء يخالف بعضها البعض في خواصِّه، وبالتالي في جوهره. لكنَّ المفارقة أنَّه سيوافقه الرأي حيال فكرة المادَّة الواحدة التي سمَّاها (الَّلامتناهي) أو الأبيرون Apeiron. و”الأبيرون” مزيجٌ من الأضداد كالحارِّ والبارد واليابس والرَّطب، لكنه – في الأصل – كلٌّ متجانسٌ لا يوصف بكمٍّ نهائيٍّ ولا بكيف محدَّد، ويمتاز بالسرمديَّة، وهو جامع لخواصِّ وصفاتِ كلِّ شيء، وعنه تكون الأشياء فترتدُّ إلى العنصر الذي نشأت منه، كما جرى بذلك القضاء والقدر. فأشياء الكون تنشأ من هذا «الَّلامتناهي» بعمليَّة الانفصال. وبحركة المادَّة تنفصل الأشياء بعضها عن بعض وتجتمع بعضها إلى بعض. ثمَّ تظهر لنا صور الانفصال؛ وبفضل هذه الحركة الانفصاليَّة الخالدة تحدث الكائنات.[جعفر آل ياسين، فلاسفة يونانيون- العصر الأول، بغداد، مطبعة الإرشاد، 1971، ص 30.].
المسمَّى الثالث: الألوهيَّة الملتبسة بالوثنيَّة
بين القرنين السادس والخامس قبل الميلاد، سنجد انعطافًا قليلًا في الَّلاهوت والكوزمولوجيا اليونانيَّة نحو ضربٍ ملتبس من التوحيد. سوف يرفض إكسينوفان (Xenophones 570-480 ق.م) وتلميذه بارمنيدس(Parrmenides 515-440 ق.م) الطابع الخرافيَّ للديانة اليونانيَّة، فأنكرا التعدُّديَّة وعقيدة التناسخ الفيثاغوريَّة، وقالا بإله واحد، غير أنَّ هذه الوحدانيَّة ظلَّت مشوبة بالتباسات وثنيَّة بيِّنة.
حسب أكسينوفان أنَّ ما هو إلهيٌّ لا يمكن إلَّا أن يكون واحدًا، ولا يمكن إلَّا أنَّ يوجد واحد هو أفضلها، لهذا رأى أنَّ الإله يجب تصوُّره على أنَّه واحد، وهذا الإله لا يشبه البشر الفانين، فهو كلَّه بصرٌ وكلَّه سمعٌ وكلَّه فكر». وهو الذي يحكم الأشياء جميعًا من دون مشقَّة. ومع أنَّ توحيد إكسينوفان لم يكن كتوحيد الأديان الوحيانيَّة، لكنَّه آمن بإله أعظم يتفوَّق على باقي الآلهة والبشر. الدربة نفسها سيأخذ بها بارمنيدس Parmenides الذي آمن مثل أستاذه إكسينوفان بوحدة الوجود، وجعل الوجود أساس الَّلاوجود، فالوجود موجود ولا يمكن إلَّا أن يكون موجودًا. والوجود والواحد متكافئان، ملاء لا خلاء، ثابت لا حركة فيه. ثم أيَّده تلميذه زينون الإيلي(zenon 490 -430 ق.م) مثبتًا الوحدة، منكرًا الكثرة، مؤيِّدًا الثبات ضدَّ الحركة، وله في ذلك حجج مشهورة في تاريخ الفلسفة. [حسن حنفي، تطوُّر الفكر الدينيِّ الغربيِّ (الإنسان والله)، مجلَّة الجمعيَّة الفلسفيَّة المصريَّة، السنة السابعة- العدد السابع، 1998، ص 131].
المسمَّى الرَّابع: الواحد عند هيراقليطس
على الوجهة إيَّاها – وإن بصياغة أخرى – سيمضي هيراقليطس (Heraclitus 540- 475 ق.م) ليرفض فكرة تجسيد الإله مع قبوله فكرة التشبيه. لكنَّ فكرته في تنزيه الإله كانت هي الإضافة الحقيقيَّة له؛ حيث أعلن أنَّ الإله واحد، وأنَّ عالم الآلهة المزعوم وهمٌ وخرافة، وأنَّ الأسرار الشائعة بين الناس ليست سوى حكايات مائعة لا قدسيَّة فيها. ربما يكون هيراقليطس قد تأثَّر بأورفيوس والديانة الهندوسيَّة، خصوصًا لجهة اعتقاده بخلود الروح وتناسخها وخضوعها لقانون الكارما. وبذلك اختلف المؤرِّخون حول صفات الإله الواحد عند الفلاسفة الموحِّدين وحول صلته بالعالم وأزليَّته، لكنهم لم يتوصَّلوا إلى فكرة الإله الواحد الذي ليس كمثله شيء، وهذا ما دعاهم إلى النأي عن عقيدة التوحيد على نهج ما هو معروف في الديانات الوحيانيَّة.
المسمَّى الخامس: العقل كمبدأ يعادل الإله الأرضيّ
العقل هو الموجود الأوَّل أو الشيء في ذاته لدى أناكسجوراس. وإذا كانت جميع الأشياء فيها جزءٌ من كلِّ شيء، فإنَّ العقل لا نهائيٌّ، ويحكم نفسه بنفسه، ولا يمتزج بشيء، ولكنه يوجد ككيان قائم بذاته… “ذلك أنَّ العقل هو ألطف الأشياء جميعًا وأنقاها، عالم بكلِّ شيء، عظيم القدرة، يحكم جميع الكائنات الحيَّة كبيرها وصغيرها، والعقل هو الذي حرَّك الحركة الكليَّة فتحرَّكت، وهو الذي يدرك جميع الأشياء التي امتزجت وانفصلت وانقسمت، وهو الذي بثَّ النظام في جميع الأشياء التي كانت، والتي توجد الآن والتي سوف تكون”. هذا يعني أنَّ أنكساجوراس قد ألَّه العقل وجعل منه المحرِّك الأوَّل، إلَّا أنَّه لم يتحدَّث عن أيِّ تدابير إلهيَّة في فلسفته عن الوجود.
المسمَّى السَّادس: المبدأ الأفلاطونيّ أو عالم المُثُل
في طورٍ تالٍ من التفلسُف سنشهد على انعطافات كبرى في ميتافيزيقا الوجود شكل التجريد العقليِّ سمة بيِّنة لها. سيعلن أفلاطون أنَّ الطريق إلى معرفة المبدأ لا بدَّ من أن يمرَّ عبر الفلسفة بما هي العلم بالحقائق المطلقة المستترة وراء ظواهر الأشياء”. وكان بهذا يصدق النيَّة في الدعوة إلى تأسيس فلسفة ما ورائيّة تتغيّا الكشف عن حقيقة الوجود. ولمَّا جاء أرسطو ليعرِّف الفلسفة بأنّها “العلم بالأسباب القصوى للموجودات، أو هي علم الموجود بما هو موجود”، كان توَّاقًا إلى الانعطاف بمهمَّتها من أجل أن يجاوز التعالي الميتافيزيقيَّ للمُثُل الأفلاطونيّة ويحسم الجدل حول تعريفاتها. كانت هندسة العقل بالمقولات العشر ثمرة هذا الانعطاف. وهو لم ينفِ ما أعلنه القدماء من أنَّ الفلسفة تبقى العلم الأشرف من المعرفة العلميَّة، وأنَّ إدراك الحقيقة ومعرفة جوهر الأشياء يحتاجان إلى إلهام وحدسٍ عقليٍّ يمضي إلى ما وراء طور العقل. إلَّا أنّه – مع ذلك – سيبقى أوَّل من افتتح باب السؤال المتشكِّك عمّا إذا كان بمستطاع العقل البشريِّ إدراك الحقائق الجوهريَّة للأشياء.
المسمَّى السَّابع: المحرِّك الذي لا يتحرَّك
سيبدو أرسطو في مدوَّناته “ما بعد الطبيعة” كما لو أنَّه يعلن الميقات الذي نضج فيه العقل البشريُّ ليسأل عمَّا يتعدَّى فيزياء العالم ومظاهره. لكنَّ السؤال الأرسطيَّ – على سموِّ شأنه في ترتيب بيت العقل – سيتحوَّل بعد برهة من زمن، إلى علّةٍ سالبة لفعاليَّات العقل وقابليَّته للامتداد. وما هذا إلَّا لحَيْرة حلّت على صاحبه ثمَّ صارت من بعده قلقًا مريبًا. والذي فعله ليخرج من قلقه المريب، أنَّه أمسك عن مواصلة السؤال الذي تعذَّر الجواب عليه في حساب المنطق، ثمَّ مضى شوطًا أبعد ليُعرِضَ عن مصادقة السؤال الأصل الذي أطلَّ منه الموجود على ساحة الوجود. والحاصل أنَّ الفيلسوف الطموح “ما بعد الطبيعة” مكث في الطبيعة وآَنَسَ لها فكانت له سلواه العظمى. رضي بما تحت مرمى النظر ليؤدّي وظيفته كمعلِّم أوَّل لحركة العقل. ومع أنَّه أقرَّ بالمحرِّك الأول، لكنَّ شَغَفَه بعالم الإمكان أبقاه سجين المقولات العشر. ثمَّ لمَّا تأمَّل مقولة الجوهر، وسأل عمَّن أصدرها، عاد إلى حَيْرته الأولى. لكنَّ استيطانه في عالم الممكنات سيفضي به إلى الجحود بما لم يستطع نَيْلًه بركوب دابَّة العقل. حَيْرتُه الزائدة عن حدِّها أثقلت عليه فلم يجد معها مخرجًا. حتى لقد بدت أحواله وقتئذٍ كمن دخل المتاهة ولن يبرحها أبدًا. مثل هذا التوصيف يصل إلى مرتبة الضرورة المنهجيَّة ونحن نعاين الحادث الأرسطيّ. لو مضينا في استقراء مآلاته لظهر لنا بوضوح كيف اختُزلت الميتافيزيقا إلى علم أرضيٍّ محض. من أبرز معطيات هذا السياق الاختزاليِّ في جانبه الأنطولوجيِّ أنَّ أرسطو لم يولِ معرفة الله عناية خاصَّة، ولم يعتبرها غرضًا رئيسيًّا لفلسفته، ولم يدخلها بالتالي في قوانينه الأخلاقيَّة ولا في نظمه السياسيَّة. الأولويَّة عنده كانت النظر إلى العالم الحسّيِّ وبيان أسبابه وعلله من دون أن يفكِّر في قوَّة خفيَّة تدبِّره. مؤدَّى منهجه أنَّ الطبيعة، بعدما استكملت وسائلها وانتظمت الأفلاك في سيرها، انتهى بها المطاف إلى محرِّك أوَّل أخصُّ خصائصه أنَّه يحرِّك غيره ولا يتحرَّك هو. هذا المحرِّك الساكن أو المحرِّك الصُوَريُّ هو عنده الإله الذي لا يذكر من صفاته إلَّا أنَّه عقل دائم التفكير، وتفكيره منصبٌّ على ذاته. يتحرَّج أرسطو عن الكلام في المسائل الدينيَّة، ويعدُّها فوق مقدور البشر، ويصرِّح بأنَّ الكائنات الأزليَّة الباقية، وإن تكن رفيعة مقدَّسة، فهي ليست معروفة إلَّا بقدرٍ ضئيل. لكنَّ هذا الفيلسوف الذي لم يفكِّر مبدئيًّا إلَّا في الطبيعة وعللها والأفلاك ومحرِّكاتها سيق في آخر الأمر إلى إثبات محرِّك أكبر تتَّجه نحوه القوى وتشتاق إليه. [إبراهيم مدكور- فلاسفة الإسلام والتوفيق بين الفلسفة والدين – في إطار كتاب “قضيّة الفلسفة” تحرير وتقديم: محمّد كامل الخطيب – دار الطليعة الجديدة – دمشق – 1998- ص: 165].
المسمَّى الثَّامن: “النومين” أو الشيء في ذاته
حين وقفت المدارس الفينومينولوجيّة الحديثة بانذهال أمام “النومين”، كباعث خفيٍّ لـ “الفينومين”، دأبت على تعريفه بالَّلا مشعور به، أو بالشيء المصموت عنه والمغفول عن سيرته. غير أنَّ هذا “التسقيط المفهوميِّ” لـ”الشيء في ذاته” لم يكن بداعي النّظر إليه كأمرٍ بديهيٍ، وإنَّما لكونه السرَّ الذي اسْتَتَر عن النّظر، وعزَّ فهمُه على طبائع العقول المشغولة بدنيا المظاهر.
منشأ المعضلة في ظاهراتيَّات الحداثة، يعود إلى الفهم الميتافيزيقيِّ لأوّل ظاهرةٍ وجوديَّة. أي إلى ظاهرة نشوء الكون الذي اتَّفقت الفينومينولوجيا اليونانيّة والحديثة معًا على أنّه هو الشَّيء الذي يظهر من تلقاء ذاته. وبالتالي، هو نفسه الشَّيء الممتنع ذاتًا عن المعرفة، والذي ينبغي تعليق الحكم عليه. النتيجة التي ترتَّبت على هذه “المسلَّمة” جاءت على خلاف ما تقتضيه البراءة العلميَّة. والنتيجة، تقييد العقل وتعطيل إمكاناته إلى حدِّ إنكار العلَّة المظهِّرة لهذا الشيء. وما ذاك إلَّا لأنَّ العقل الفينومينولوجيَّ الغربيَّ منذ بداياته التأسيسيَّة قرَّر النَّظر إلى”النومين” كعلَّة تامَّة نشأت من ذاتها بذاتها ولذاتها، ولا حاجة لها إلى علَّةٍ خارجيّةٍ تدفعها إلى الظهور. وبالتالي، سيضطرُّ الناظر إليها لأن يتَّخذ هذه المسلَّمة دربةً له، كقاعدة ضروريَّة لوصف ما هي عليه ظواهر الموجودات في الواقع.
في الميتافيزيقا الحديثة، دارت الأفهام حول النومين مدارات شتَّى من الجدل، إلَّا أنَّها في خواتيمها لم تفارق ما تداوله حكماء اليونان وفلاسفتهم. هو حينًا نفس الأمر المكمون في الشيء، وهو عصيٌّ على الإدراك، ولا يُعرف إلَّا حين يبدو لنا في الواقع العينيِّ.. ذلك ما كان أشار إليه هايدغر لمَّا بيَّن أنَّ الحداثة أخفقت في ابتكار تعريف للكليَّات يوازي أو يجاوز ما وضعه الإغريق. وإنَّ فلاسفة اليونان مذ حدَّدوا المعالم الأساسيَّة لمبادئ فهم الوجود لم تتحقَّق خطوةٌ جديدةٌ من خارج الحقل الذي ولجوه أوَّل مرَّة.
من أجل ذلك، ينبِّه علم النومين (النومينولوجيا) إلى وجوب تصويب خللٍ تكوينيٍّ في الاسم الأنطولوجيِّ للميتافيزيقا. فإذا كانت كلمة الما بعد (ميتا) دالَّةً على ما هو تالٍ للطبيعة أو ما فوقها، فذلك معناه أنَّ عالم ما بعد الطبيعة هو امتداد للطبيعة وموصول بها بعروةٍ وثقى. ما يعني أيضًا أنَّ كلَّ ما بعد الطبيعة هو واقعٌ حقيقيٌّ بمرتبةٍ وجوديَّةٍ مفارقة، وإن تعدَّدت ظهوراته كمًّا وكيفًا. مثل هذا الخلل في الاسم الأنطولوجيِّ للميتافيزيقا سوف يؤدّي إلى صدعٍ في المبدأ المؤسِّس للعقل، والاستفهام عن حقيقته. وهذا ما سيكشف عن أمرٍ بديهيٍّ سها عنه القول الفلسفيُّ الإغريقيُّ ولواحقُه. فإذا كانت مهمَّة الميتافيزيقا البحث في الوجود بما هو موجود، فإنَّ مبتدأها ومنتهاها تمثَّل بحصر معرفتها بالموجود في ظهوره العيانيِّ، وعدم الاكتراث لما هو عليه في خفائه وكمونِه.
يعتني علم “النومين” بالظاهرة الوجوديَّة بوصف كونها ظهورًا لأصل وجودها، ومتَّصلة به اتِّصال الجزئيِّ بالكلّيِّ، فإذا كانت الفينومينولوجيا تدلُّ على الشيء كما يتبدَّى في العلن، فإنَّ هذا المتبدِّي ما كان له أن يبدو لولا اتِّصاله بمصدره الأوَّل. الذي هو ماهيَّته وحقيقته الواقعيَّة. نعني بذلك الجوهر بذاته الذي ظهر وتوسَّع ليكون ظهور الموجودات امتدادًا لظهوره وتوسُّعاته.
ولكونه علمًا ينشد التعرُّف على الموجود الأوّل وسرِّ ظهوره، والكيفيَّة التي ظهرت منه الكثرة، تُعيد النومينولوجيا الاعتبار لكلام متجدِّد حول فينومينولوجيا الوجود المتعيّن على نحو يجاوز الثنائيَّات المؤسِّسة للمعضلة الميتافيزيقيَّة في ثقافة الغرب. ولذا، فإنَّ المهمَّة التأسيسيَّة لعلم “النومينولوجيا” هي إذًا، استكشاف حقيقة موجودٍ فُطِرَت موجوديَّته على وحدة البساطة والتركيب. وبالتالي، إدراك حقيقة هذا الجوهر الوجوديِّ الذي حظيت ذاته بفرادة جمع الوحدة إلى الكثرة، هو الشيء الوحيد الذي تقوم طبيعته على الثراء والفقر في آن. أي بين الاحتياج إلى موجده وبين كونه مبدأ مؤسِّسًا لعالم الممكنات.
كفَّت الميتافيزيقا التي عهدناها مع قدماء الإغريق عن أن تكون العلم بإلهيَّات ما بعد الطبيعة. جرى هذا من بعد أنسها المتمادي بالمفاهيم، حتى لقد أخلدت إلى دنيا الطبيعة، ودارت مدارها، ولم تكن في مجمل أحوالها ومشاغلها سوى مكوثٍ مديدٍ على ضفاف الكون المرئيّ. لقد انسحرت الفلسفة الأولى بالبادي الأوَّل حتى أشركته مُبديه وبارئه، ثمَّ راحت تخلع عليه ما لا حصر له من ظنون الأسماء: المحرِّك الأوَّل غير المتحرِّك، “النومين أو الشيء في ذاته”، “العلَّة الأولى” و”المادَّة الأولى أو الهيولى”، وأخيرًا وليس آخرًا “القديم والأزليّ”.. وجريًا على هذه الحكاية ستنتهي إلى نعته بالموجود الذي أوجد ذاته بذاته من عدم، ولمَّا أن وُجدَ لم يكن له من حاجة إلى تلقّي الرعاية من سواه. هو بحسب “ميتافيزيقاهم” كائنٌ مكتفٍ بذاته، ناشطٌ من تلقاء ذاته، ومتروكٌ لأمر ذاته.
الفلسفة الحديثة – حتى وهي في ذروة دهشتها بذاتها – لم تَبرح هذه المعضلة الموروثة عن السّلَف الإغريقيّ. مبدأُها المنبسطُ على ثنائيَّة “النومين” و”الفينومين” ظلَّ ملازمًا لها كما هو في نشأته الأولى. وبسبب من هذا التلازم تجدَّدت ألوان المعضلة وتكثَّرت أنواعها، واستدام الاختصام والفرقة بين جناحَيْ الثنائيَّة. ولمَّا لم يكن لهذا المبدأ أن يبلغ مقام الجمع بين الجناحين، أفضت الإثنينيَّة في غُلُوِّها الإنشطاريِّ إلى وثنيَّةٍ صارخةٍ حلَّت ورسخت في قلب الميتافيزيقا، قديمِها ومستحدثِها. من هذا النحو، لم يُفلح النِّظام الفلسفيُّ الكلاسيكيُّ في مُجاوزة معضلته الكبرى المتمثِّلة بالقطيعة الأنطولوجيَّة بين الله والعالم. وهو حين تصدَّى لمقولة الوجود بذاته، أخفق في إدراك حقيقته. ثمَّ أعرض عنها وأخلد إلى الاستدلال المنطقيِّ والتجربة الحسِّيَّة. لهذا ظلَّ الموجود الأوَّل في هندسة العقل المقيَّد بالمقولات العشر لغزًا يدور مدار الظنِّ، ولمَّا يبلغ اليقين. وبسببٍ من قيديَّته سَرَت ظنونُهُ إلى سائر الموجودات ليصير الشكُّ سيّدَ التفلسُف منذ اليونان إلى ما بعد الحداثة. من أجل ذلك، سنرى كيف سيُخفقُ التاريخُ الغربيُّ رغم احتمائه بهندسات العقل الذكيِّ، في إحداث مسيرة حضاريَّة مظفَّرة نحو النور والسعادة. فلقد تخلَّل ذلك التاريخ انحدارٌ عميقٌ إلى دوَّامة المفاهيم والاستغراق مليًّا في أعراض المرئيَّات الفانية. النتيجة أنَّه كلَّما ازدادت محاولة الإنسان فهم دنياه، وعالمه الواقعيِّ ازداد نسيانه ما هو جوهريّ. والنُّظَّار الذين قالوا بهذا لا يحصرون أحكامهم بتاريخ الحداثة، بل يُرجعِونها إلى مؤثِّرات الإغريق، حيث وُلِدتَ الإرهاصاتُ الأولى لتأوُّلات العقل الأدنى. وهو العقل إيَّاه الذي سترثه الفلسفات الَّلاحقة، لتصبح العقلانيَّة العلميَّة معها حَكَمًا لا ينازِعُه منازعٌ في فهم الوجود وحقائقه المستترة. وكحصيلة لمسارات العقل الأدنى ستأخذ الثورة التقنيَّة صورتها الجليَّة، لِتَفْتتِحَ أفقًا تفكيريًّا سيعمِّق القطيعة مع أصل التكوين وحقيقة الوجود.
المسمَّى التَّاسع:”المونادا” أو الواحد البسيط الذي لا يتمدَّد
كتب لايبنتز “المونادولوجيا” أو علم المونادا (الواحد – البسيط) عام 1714م. وقد بدت كتكثيف لكلِّ نسقه الفلسفيِّ، رغم أنَّها لا تتجاوز الصفحات العشرين. لقد ابتكر هذا المصطلح من كلمة يونانيَّة معناها “الوحدة”، ليؤكِّد أنَّ همَّه الأوَّل هو التوصُّل إلى الواحد البسيط الذي لا يحوي شيئًا آخر. وهذا الواحد هو نفسه الجوهر الفرد الذي لا يتمدَّد لئلَّا يصير قابلًا للقسمة، ولا يحوي شيئًا آخر لئلَّا يصبح مركَّبًا. رأى ليبنتز أنَّ كلَّ مركَّب هو عبارة عن مجموعة وحدات بسيطة، ليس له شكل، وهذا الجوهر هي “المونادا”، التي هي ذرَّات الطبيعة أو عناصر الأشياء. هذه المونادات لا يمكن أن توجد إلَّا بالخلق، ولا يمكن أن تنتهي إلَّا بأمر إلهيٍّ بإفنائها، بمعنى آخر، لا يمكن أن تُنتج أو أن تُدمَّر، وكلُّ مونادا هي فرديَّة وحيدة بمعنى أنَّه ليس هناك مونادا مطابقة لمونادا ثانية، وكلُّ واحدة منها مستقلَّة استقلالًا تامًّا عن نظيرتها. إنها حسب ليبنتز “بلا نوافذ يستطيع أي شيء أن يدخل أو يخرج منها… غير أنَّ هذه المونادات لا بدَّ لها من أن تحوي بعض الصفات وإلَّا لما أصبحت موجودات”: أول هذه الصفات هي أنَّ كلَّ مونادا مختلفة تمامًّا عن الأخرى، تحوي قوَّة للتطوُّر وللتغيُّر من حالة إلى أخرى، وهي خارجيَّة، وغير بيِّنة، ولا تكسب كلَّ وضوحها إلَّا حين تتلاشى في الميل الداخليِّ للقيام بإدراك جديد أكثر تميُّزًا ووضوحًا من الإدراك السابق. ومن ثمَّ فإنَّ القوَّة التي تضعها مع العالم الخارجيِّ لا تأخذ كلَّ معناها إلَّا بعمليَّة الإدراك، حين تنهض المونادا من سُباتها، وذلك حين يصبح لها ذاكرة يمكن أن ندعوها نفسًا. والبشر يخلق عندهم عادة فيفكِّرون بطريقة تجريبيَّة، أي حسب ما صادفهم سابقًا.[جورج زيناتي- الفلسفة في مسارها – دار الكتاب الجديد المتَّحدة – بيروت – 2013 – ص 156.]
قصارى غاية ليبنتز من المونادا هو ما يستظهره كتابه التأسيسيُّ “مقالة في الميتافيزيقا” التي يفارق فيها جلَّ معاصريه من فلاسفة الغرب. عنينا بذلك مسألة الخلق كفعلٍ إلهيّ. بصدد هذه المسألة يقرِّر ما يلي: قبل أن توجد الأشياء في هذا العالم بالفعل، وجدت بما هي ممكنات ضمن عالم من العوالم الَّلامتناهية التي تزخر بها ملكة فهم الله. فالله لا يخلق إلَّا ما كان ممكنًا. يوجد الممكن أوّلًا على شكل أفكار. ولله فكرة عمَّا يمكنه أن يخلق، كما أنَّ له فكرة عمَّا لن يخلقه. هذا التنوُّع في أفكار الله ضروريٌّ، لأنَّ ملكة فهمه تتضمَّن كلَّ الأفكار الممكنة، ولكن ما الذي يحمل الله على تحويل ممكنات من دون أخرى من طور الإمكان إلى طور الوجود الفعليّ؟
يقارن الله بين الأفكار التي في ملكة فهمه، ويتبيَّن قيمة كلِّ واحدة منها، ويقرِّر أن يخلق أو يمنح الوجود لما يرى أنَّه خير بذاته. فالله لا يخلق الخير المترتِّب على وجود الأشياء، بل يخلق الأشياء التي يرى أنَّها خيّرة بذاتها. ولذا، فالممكن، إذًا، بالنسبة إلى ليبنتز ليس شيئًا نظريًّا يتحدَّد من خلال التركيبات الخياليَّة، بل قل إنَّ للممكن عنده شيئًا من الكينونة، غير أنَّه يبقى كائنًا منقوصًا. وبيان ذلك ما يلي:
“لا يحوز الممكن كيانًا كاملًا بل يتضمَّن ميلًا للوجود، وهو يبقى، بحسب تعريف ليبنتز، يطالب بالوجود Exigentia Existers. بسببٍ من ذلك يظلُّ كيان الممكن كائنًا منقوصًا، وهذا، لا يعني أنَّ وجود الممكن، من جهة إمكانه، أن يتحوَّل بالضرورة إلى واقع؛ إذ لو تحوَّل كلُّ ممكن إلى واقع، لكان كلُّ ما في العالم ضروريًّا، ويفقد الخلق بذلك دلالاته، إذ يستحيل وقتها أن نتحدَّث عن إرادة خلق تميّز فعل الله.
[Wilhelm Leibniz, Discours de métaphysique et correspondance avec Arnauld, introduction,texte et commentaire par Georges Le Roy (Paris: J. Vrin, 1957, p. 121].
المبدأ المثنَّى في مدارج الميتافيزيقا البَعديَّة
للاقتراب من حقَّانيَّة المبدأ، لزم عبور حقلٍ خصيبٍ من الأسماء والصفات والنعوت لم تنتهِ عند تقريرات الفلسفة الأولى، بل مضت بعيدًا في آفاق الميتافيزيقا والمعارف الإلهيَّة. ولنا في ما يلي نسوق شطراً مما ورد من مكابدات بغية الاقتراب من حقيقة المبدأ وهوّيَّته:
أوَّلًا: المبدأ في قانون العلِّيَّة
يتَّخذ المبدأ من قانون العلِّيَّة سبيلًا لتدبير العالم. وطبقًا لقاعدة أنَّ “كلَّ معلول هو مركَّب في طبعه من جهتين: جهة بها يشابه الفاعل ويحاكيه، وجهة بها يباينه وينافيه. فإنَّ هذا المبدأ يكون مطلقًا ونسبيًّا في آن. الكلام عن معلوليَّة المبدأ رغم فرادته وخصوصيَّة تركيبه، ينطبق على كلِّ فرد في عالم الكثرة. ودليل أصحاب هذه القاعدة هو التالي: إذا كان الموجود يشبه فاعله من جميع الجهات، يلزم إلَّا يكون هناك أيُّ اختلاف بين العلَّة والمعلول، وحينذاك لا معنى لمسألة الصدور. ولو خالف الموجود فاعله من جميع الجهات، يلزم أن تتناقض العلَّة مع المعلول، في حين لا يقع نقيض الشيء معلولًا له، لوجود تمانع بين الموجودين المتناقضين. وإذن، فالموجود المعلول – بحسب هؤلاء – ذو جهتين دائمًا: جهة متعلِّقة بالفاعل وتشير إليه، وجهة متعلِّقة به. وعليه فهو يُعدُّ “وجودًا” من حيث جهة الفاعل، ويُعدُّ “ماهيَّة” من حيث جهته، وفي حين تسمَّى جهة وجود الموجود بالجهة النورانيَّة، تُسمَّى جهة الماهيَّة بالظلمانيَّة. وهكذا، فإنَّ نسبة المعلول إلى فاعله كنسبة الظلِّ إلى الضياء. فالظلُّ من حيث هو مضيءٌ يكشف عن الضياء، ومن حيث هو مزيجٌ بنوع من الظلمة، متناقضٌ مع الضياء ويحكي عن الظلام. فمثلما لا يمكن أن ننسب الجهة الظلمانيَّة للظلِّ إلى وجود الضوء، كذلك لا يمكن أن تُنسب جهة الماهيَّة إلى الفاعل. وعليه، يمكن القول بأنَّ الجعل والإيجاد لا يتعلَّقان بالماهيَّة أبدًا، وإنَّما يتعلَّقان بالوجود فقط. أي لا بدَّ من أن يُعدَّ الجعلُ والإيجادُ والإفاضة والإشراق، خصوصيَّة خاصَّة بالوجود. ودور الماهيَّة على صعيد الموجودات البسيطة والمجرَّدة كدور المادَّة على صعيد الموجودات الماديَّة والمركَّبة. وكما أنَّ مقتضى الكثرة في الموجودات المادّيَّة والمركَّبة هو وجود المادَّة الأولى أو الهيولى، كذلك مقتضى الكثرة في الموجودات البسيطة والمجرَّدة هو الماهيَّة. ولذا يمكن القول أنَّ الكثرة في عالم البسائط والمجرَّدات، ناشئة من الماهيَّات فقط. الشيخ الرئيس ابن سينا يأخذ بهذه الفكرة أيضًا، ويعتبر الماهيَّات مصدر كلِّ تركيب وتعدُّد في عالم البسائط. وفي كتاب “الإلهيَّات” بحث القاعدة المعروفة “كلُّ ممكن زوج تركيبيّ”. حيث تكشف هذه القاعدة جيّدًا عن ضرورة البحث عن أيِّ تركيب وتعدُّد، في الماهيَّات. ولذلك تُعدُّ الماهيَّات مثار الكثرة ومنشأها [الديناني، غلام حسين الإبراهيمي- القواعد الفلسفيَّة العامَّة في الفلسفة الإسلاميَّة – الجزء الثاني- تعريب: عبد الرحمن العلوي – دار الهادي- بيروت- 2007 – ص 355].
النتيجة أنَّه بالإمكان القول أنَّ أثر الفاعل ليس سوى مثال الفاعل، ولهذا السبب يكشف الفعل عن الفاعل دائمًا. أي أنَّه يمكن معرفة الفاعل عن طريق الفعل. وقد تناول صدر الدين الشيرازي هذه المسألة في كتاب “الأسفار”، وصاغها على الوجه التالي: “إنَّ كلَّ منفعل عن فاعل، فإنَّما ينفعل بتوسَّط مثال واقع من الفاعل فيه. وكلُّ فاعل يفعل المنفعل بتوسُّط مثال يقع منه فيه. وذلك بيِّنٌ بالاستقراء. فإنَّ الحرارة الناريَّة تفعل في جرم من الأجرام بأن تضع فيه مثالها وهو السخونة. وكذلك سائر القوى من الكيفيَّات. والنفس الناطقة إنَّما تفعل في نفس أخرى مثلها”.[الشيرازي، صدر الدين- الأسفار العقليَّة الأربعة في الحكمة المتعالية – الجزء الأول- مصدر سابق- ص 419] .
ثانيًا: المثنَّى أو “المطلق المحدود” في الحكمة التراثية
يجري في عالم الميتافيزيقا تمييزٌ دقيقٌ بين المطلَق بوصفه الواحد بالوحدة الحقيقيَّة أي الله تعالى، وبين المطلَق بما هو الواحد بالوحدة الحقيقيَّة الظلِّيَّة، أي الموجود بغيره؛ وهو ما يُنعت بالمطلق المحدود. فالمطلق بمعناه الأوَّل هو التامُّ والكامل والمتحرِّر من كلِّ قيد، وهو واجب الوجـود المتجـاوز للزمان والمكـان، ولذا فهو يتَّســم بالثبات والكلِّيَّة. أمَّا بمعناه الثاني فهو النسبيُّ الذي يُنسَب إلى غيره ويتوقَّف وجوده عليه، ولا يتعيَّن إلَّا مقرونًا به. وهذا النسبيُّ مُقيَّد وناقصٌ ومحدودٌ، وهو مرتبط بالزمان والمكان، ويتلوَّن بهما ويتغيَّر بتغيِّرهما، ولذا فهو ليس بكلِّيّ. في الفلسفات الحديثة، يُعدُّ هذا التعريف للمطلق والنسبيِّ تعريفًا عامًّا ولا يؤدّي غايته المثلى. ولذا يرى أحد فلاسفة مدرسة الحكمة الخالدة المعاصرين السويسري فريذوف شوان (1907-1998) أنَّ الَّلانهائيَّة والكمال من الأبعاد الكامنة في المطلق، وتبرهن على ذاتها “في اتِّجاه هابط” حسب النشأة الكونيَّة للتجلِّيات. حتى ليتسنَّى لنا القول أنَّ الكمال هو صورة المطلق في انعكاساته في الوجود، وهوما يُؤلِّف الَّلانهائيَّة، وهنا تتدخَّل العناية الربَّانيَّة حيث ينبثق من المطلق لانهائيَّة فاعلة تتجلَّى في الخير، وترسم بالتالي بنية أقنوميَّة في اتِّجاه “خالقٍ” حتى نهاية التجلّيات.
وقد تعمَّق شوان في تحديد ماهيَّة المطلق متجاوزًا التحليل الُّلغويَّ المعجميَّ، وهو يقدِّم مجموعة من التساؤلات حوله. يقول: “لو سُئلنا عمَّا هو المطلق، لقلنا أوَّلًا إنَّه الجوهريُّ واجب الوجود، وليس العرضيَّ ممكنَ الوجود فحسب، وبالتالي فهو لانهائيٌّ وكاملٌ، ولقلنا ثانيًا إنَّه كلُّ ما انعكس في الوجود، كوجود الأشياء بحسب مستوى السؤال، ولا وجود بغير المطلق، ويتجلَّى وجه المطلقيَّة في وجود شيء ما يُميِّز الموجود من الَّلاموجود، فحبَّة الرمل الموجودة معجزة بالقياس إلى الفضاء الفارغ.. ولو نحن سُئلنا عمَّا هو الَّلانهائيُّ لقلنا إنَّه المنطق شبه التجريبيِّ الذي يطلبه السؤال نفسه، ويتبدَّي في الوجود كصيغ للمدِّ والجزر، شأنَّه شأن المكان والزمن والشكل والعدد والتكاثُر والمادَّة، وحتى نكون أكثر دقَّة نقول بطريقة أخرى: إنَّ هناك صيغة حافظة هي المكان وصيغة مُحَولةً هي الزمن، والذي يعني لانهائيَّة اطِّراد التحوُّلات، لا تحديد الدوام فحسب، وصيغة كميَّة هي العدد الذي يعني لانهائيَّة العدد ذاته لا تحديد الكمِّ فحسب، وصيغة ماديَّة هي المادَّة، وهي الأخرى لا حدود لها كتجلّي النجوم في السماء، ولكلٍّ من هذه الصيغ امتدادٌ في الحال الحيويِّ وما وراءه، فهي أعمدة الوجود الكونيّ. وأخيرًا، لو سُئِلنا عن الكمال أو الخير الأسمى، لقلنا إنَّه الله سبحانه، والخير هو ما يتجلَّى في الوجود على شكل فضائل، أو بالحريِّ ظواهر كيفيَّة تتبدَّى في كمال الأشياء لا في وجودها فحسب، والمطلق والَّلانهائي والخير، لا تناظر الوجود والأنواع الموجودة وما يتعلق بكيفيات وجودها فحسب، بل هذه العوامل معًا في آن، لتبيّن معنى الأوجه الربَّانيَّة في ما وراء العالم لو جاز القول”.
ولأجل تفادي ما وقعت فيه بعض تيَّارات وحدة الوجود من جمع حلوليٍّ بين الله والعالم، ثمَّة – وفق الرؤية الآنفة الإشارة – تمييز بين نوعين من الوجود من حيث الإطلاق وهما: الوجود المطلق والوجود المحض. أمَّا الوجود المطلق فيمثِّل انعكاس المطلق المحض الذي يتجلَّى في النسبيَّة، ولا يمكن أن يتحوَّل إلى الوجود المحض كما يدَّعي فلاسفة النسبيَّة المعاصرة، ولو حدث التحوُّل، وهذا مستحيل، لتنزَّهت الثنويَّات والثالوث عن مخالطة البشر أو محادثتهم، لأنَّ التنزيه من صفات المطلق المحض، وهكذا يقول شوان “لا يتطابق الوجود المُطلق مع المطلق المحض الصمديّ، فهو تابع للنظام الربَّانيِّ بقدر ما هو انعكاس للمطلق في عالم النسبيَّة، ومن ثمَّ يمكن تسميته مطلقًا نسبيًّا رغم ما تحمله التسميَّة من تناقض، ولذا فهو أقنوم ربَّانيّ. وإذا كانت الأقانيم الربَّانيَّة هي المطلق بما هو لتنزَّهت عن مخاطبة الإنسان [” FrithjofSchuon: the play of masks، world Wisdom Books INC، 1992، p45]. والوجود المُطلق هو المطلق النسبيُّ أو المطلق المحدود، أو هو الربُّ مطلقًا نسبيًّا قادرًا على الخلق، فالمطلق المحض الصمديُّ أي “غيب الغيب” يتعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا.
ويشتمل المطلق أو الجوهر على الَّلانهائيَّة التي تشعُّ بنوره، فالنور الإلهيُّ يعكس الجوهر على “الفراغ” من دون أن “يخرج” إليه بأيِّ شكل كان، إذ إنَّ المبدأ معصوم لا ينقسم، ولا يمكن أن يُغتصب منه شيءٌ، فانعكاسه على الَّلاشيء يتجلَّى بصيغة “أشكال” بادية و”أفعال” حادثة، و”حياة” الَّلانهائيّ ليست فعَّالة بقوَّة مركزيَّة centrifugal فحسب، ولكن أيضًا ببنية مركزيَّة centripetal، وبشكل تبادليٍّ أو متزامن بدءًا بالإشعاع وعودًا إلى المبدأ، والمبدأ الأخير يعني نشورًا وعودة الأشكال والحوادث إلى الجوهر، ومن دون أن يزيد أو يُنقص من الجوهر شيئًا، فهو النعمة والكمال مطلقًا، وهو خصيصة من خصائص المطلق كما لو كان حياته الباطنة، أو حبَّه الذي يفيض ليخلق العالم.
[FrithjofSchuon: Sufism Veil and Quintessence، Translated from French by William Stoddart، world Wisdom Books INC،1981، p165.]
منزلة المثنَّى /المبدأ في المعرفة العرفانيَّة
ماهيَّة المبدأ كما تُستقرأ في الإلهيَّات والعرفان النظريِّ، تستوي على نصاب معرفيٍّ يفارق ما ابتدأه الإغريق، فضلًا عن المتأخّرين من بعدهم. لقد اتَّخذ الكلام على الموجود الأول في الميتافيزيقا الوحيانيَّة مسالك شتَّى؛ إلَّا أنَّ جامعًا مشتركًا حول ماهيَّته ظلّ ينتظم دائرة واسعة من تلك المسالك. وفي المجمل كان يُنظر إلى هذا الموجود على أنَّه مطلقٌ من حيث كونه أوَّل موجود في مشيئة الإيجاد الإلهيِّ، ونسبيٌّ من حيث كونه محتاجًا لموجِدِه ومركَّبًا على الزوجيَّة والكثرة. ويمكن لنا أن نتبيَّن في ما يلي، سِمَتين أساسيَّتين لمبدأ الضدِّيَّة:
السِّمة الأولى: أنَّ لمعرفة المبدأ في مفارقاته علاقةً وثيقةً بمفهوم الأضداد: فمشاهدة الحقيقة الإلهيَّة الحاضرة والقريبة والموجودة في كلِّ شيء – فالأضداد كامنة في الأضداد: إذ العلوَّ كامن في الدنوِّ، والعزُّ كامن في الذلِّ، إلى غير ذلك من الأوصاف العلويَّة مع الأوصاف السفليَّة…”. فـ”الأشياء كامنة في أضدادها ولولا الأضداد لما ظهر المضادُّ كما يقول العارفون”.
السِّمة الثانية: أنَّ الوعي بالأضداد في منزلة كونه وعيًا فائقًا، مقتضاه الشعور بالدهشة عند الوقوف على الحقيقة، أو الوقوف عند مرحلة التحقيق: وكلَّما كان الضدَّان متباعدين كان الالتقاء بينهما مصحوبًا بدهشة قويَّة من طرف العارف أو المتأمِّل”. وهنا سنلاحظ أنَّ من العرفاء من ذهب بعيدًا في التمثيل بالدهشة الناتجة من التقاء الأضداد في تجربة الانتقال من الكفر إلى الإيمان. فالمشاهدة – كما يبيِّن العارف بالله ابن عجيبة الحسني – تتقوَّى لدى أهل الكفر الذين تابوا من كفرهم ورجعوا إلى مشاهدة الحقيقة الإلهيَّة أكثر من أهل الإيمان”[المصدر نفسه، ص 37]. وهكذا، فإنَّ هذه الدهشة هي صيرورة دائمة تتواصل بتواصل المعرفة: فإذا كانت الدهشة هي بداية الفلسفة أو التفكير كما قيل، فإنَّ الدهشة في الفكر مصاحِبة للمعرفة منذ بدايتها وخصوصًا في غايتها.
علم “كان” و”علم البَدء”
في العرفان النظريِّ يتوسَّع أفق التنظير والاستشعار، حتى لنجدُنا تلقاء مساعٍ فريدة ومفارقة بغية الخروج من العثرات التي تحول دون الأجوبة الآمنة. ولأجل الوقوف على أهمِّ هذه المساعي نلقي الضوء بداية على قاعدتين تؤلّفان أبرز التنظيرات التي عَنِيَت بنظام معرفة الموجود البَدْئيّ، وقد ذكرهما ابن عربي في ردِّه على أسئلة الحكيم الترمذيِّ، وهما: علم “كان” و”علم البدء”[ابن عربي- أجوبة ابن عربي على أسئلة الحكم الترمذي- إعداد وتحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبي – مكتبة الثقافة الدينيَّة – ط 1- القاهرة – 2006 – ص 41-42].
– القاعدة الأولى- علم “كان”: ولهذه القاعدة صلة نَسَبٍ وطيدة بعلم المبدأ. فالمقصود من علم “كان” هو تنزيه الله تعالى عن كلِّ ما سواه من أشياء الكون. وتأسيسًا على قوله تعالى: Nلَيسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌM[الشورى- 11]. يقرّر علم “كان” أنَّه سبحانه لا تصحبُه الشّيئيَّة، ولا تنطلق عليه.. فقد سَلَب الشيئيَّة عنه، وسَلَب مَعيّة الشيئيَّة. إنَّه مع الأشياء، وليست الأشياء معه. لأنَّ المَعيَّة تابعة للعلم: إنَّه يعلمُنا فهو معنا، ونحن لا نعلمُه فلسنا معه.. وأمَّا لفظة (كان) فليس المراد منها التّقييد الزمانيَّ، وإنما المراد الكون الذي هو (الوجود). فتحقيق “كان” أنَّه حرف وجوديٌّ، لا فعل يطلُب الزمان. ولهذا لم يَرد ما يقوله علماء الرُّسوم، من المتكلّمين، وهو قولهم “وهو الآن على ما عليه كان”، فهذه زيادة مُدرجة في الحديث ممَّن لا علم له بعلم (كان)، ولا سيَّما في هذا الموضع كما يبيِّن ابن عربي.. ويضيف: ولئن تصرَّفت “كان” تصرُّف الأفعال، فليس من أشْبَه شيئًا من وجه ما يُشبهه من جميع الوجوه، بخلاف الزيادة، بقولهم “وهو الآن”، فإنَّ “الآن” تدلُّ على الزمان. وأصل وضعه أنها لفظة تدلُّ على الزمان الفاصل بين الزمانين (الماضي والمستقبل).. فلمَّا كان مدلولها “الزمان الوجودي”، لم يُطلقه الشارع في وجود الحقِّ، وأطلق (كان) لأنَّه “حرف وجوديّ”، وتخيَّل فيه الزمان لوجود التصرُّف: من كان ويكون فهو كائن ومُكوَّن.. فلما رأوا في “الكون” هذا التصرُّف، الذي يلحق الأفعال الزمانيَّة. تخيّلوا أنَّ حكمها حكم الزمان، فأدرجوا “الآن” تتمَّة للخبر وليس منه.. وعليه كان تقرير الشيخ ابن عربي حول علم “كان” أنَّ الله موجود، ولا شيء معه. أي ما ثمَّ من وجوده واجب لذاته غير الحقّ. والممكن واجب الوجود به لأنَّه مظهره، وهو ظاهر به. والعَيْن الممكنة مستورة بهذا الظاهر فيها.. فانْدَرج الممكن في واجب الوجود لذاته “عَيْنًا”، واندرج الواجب الوجود لذاته في الممكن “حُكمًا”..[م. ن- ص 50]..
– القاعدة الثانية: علم البَدء: لا ينأى هذا العلم عن علم “كان” في منظومة ابن عربي، بل هو الحلقة التالية في علم التوحيد. فإذا كان علم “كان” هو علم الإقرار بالذات الأحديَّة وتنزيهها عن الفقر والإمكان، فإنَّ علم البَدء هو علم الإقرار بحاصل الكلمة الإلهيَّة “كن”. أي بالموجود البَدْئي كأول تجلٍّ إلهيٍّ في دنيا الخلق. على هذا الأساس يعرِّفه ابن عربي بأنَّه علم الفصل بين الوجودين، القديم والمُحدث. وهو علم عزيز وغير مقيَّد. كما يصرِّح ويضيف: إنَّ أقرب ما تكون العبارة عنه، أن يُقال: البَدْء افتتاح وجود الممكنات على التّتالي والتّتابُع، لكون الذات الموجدة له اقتضت ذلك من غير تقييد بزمان. فالزمان من جملة الممكنات الجسمانيَّة، وهو لا يُعقل إلَّا إرتباط ممكن بواجب لذاته. فكان في مقابلة وجود الحقِّ، أعيان ثابتة، موصوفة بالعدم أزلًا، وهو الكون، الذي لا شيء مع الله فيه، إلَّا أن وجوده أفاض على هذه الأعيان، على حسب ما اقتضته استعداداتها، فتكوَّنت لأعيانها، لا لهُ، من غير بينيَّة تُعقَل أو تتوهَّم. فوقعت في تصوُّرها “الحَيْرة” من طريقين: طريق “الكشف”، وطريق “الدليل الفكريّ”. والنُّطق عمَّا يقتضيه الكشف، بإيضاح معناه، يتعذَّر: فإنَّ الأمر غير مُتخيَّل، فلا يُقال، ولا يدخُل في قوالب الألفاظ. وسبب عزَّة ذلك، كما يبيّن الشيخ الأكبر، يعود إلى الجهل بالسبب الأوَّل وهو “ذات الحقّ”. ولما كانت سببًا، كانت إلهًا لمألوه لها، حيث لا يعلم المألوه أنَّه مألوه. بعضهم قال: “إنَّ البدء كان عن نسبة القهر”، وقال غيرهم. “بل كان عن نسبة القدرة”.. والذي وصل إليه علمُنا من ذلك – وَوَافَقنا الأنبياء عليه – كما يضيف ابن عربي- أنَّ “البدء عن نسبة أمْر، فيه رائحة جَبْر”. إذ الخطاب لا يَقَع إلَّا على عَيْن ثابتة، معدومة، عاقلة سميعة، عالمة بما تسمع: بسَمْع ما هو سمع وجود، لا عقل وجود، ولا علم وجود. فالْتَبست، عند هذا الخطاب بوجوده. فكانت “مَظْهرًا له” من إسمه (الأول-الظاهر). وانسحبت هذه الحقيقة، على هذه الطريقة، على كلِّ عَيْن إلى ما لا يتناهى.. فإنَّ مُعطي الوجود لا يُقيّده ترتيب الممكنات، إذ النسبة منه واحدة. فالبَدْء ما زال، ولا يزال. وكلُّ شيء من الممكنات له عين الأوَّليَّة في البدء. ثُمّ إذا نُسبت الممكنات، بعضها إلى بعض، تعيَّن التقدُّم والتأخُّر، لا بالنسبة إليه سبحانه.. فوقف “علماء النَّظر” مع ترتيب الممكنات، حيث وَقَفنا نحن مع نسبتها إليه تعالى[م.ن- ص 52]..
ثمَّ ينتقل ابن عربي إلى طور متقدِّم في تعريف هذا الموجود فيقول: “إنَّ أوليَّة الحقِّ هي أوليَّة (العالم)، إذ لا أوليّة للحقِّ بغير العالم، ولا يَصحُّ نسبتها ولا نَعْته بها، وهكذا جميع النّسب الأسمائيَّة كلِّها.. فعَيْن الممكن لم تَزل، ولا تزال، على حالها من الإمكان.. والأمور لا تتغيَّر عن حقائقها، باختلاف الحكم عليها، لاختلاف النّسب. ألا ترى إلى قوله تعالى Nوَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔاM[سورة مريم، الآية 5]، وقوله تعالى Nإِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُM[سورة النحل، الآية 40]، فنَفى الشّيئيَّة عنه وأثْبَتها له، والعين هي العين، لا غيرها…[ابن عربي – أجوبة ابن عربي على أسئلة الحكيم الترمذي- المصدر نفسه- ص 44].
سيكون لهاتين القاعدتين حضورٌ بيِّنٌ في مقتربات العرفان النظريِّ للمبدأ كمخلوق أوَّل. وعليه سوف نحاول في ما يلي استظهار طائفة من المقتربات تدور على الإجمال مدار التعريف بطبيعة الموجود الأوَّل، وخصوصيَّته وكيفيَّة صدوره، والمهمَّة الإلهيَّة التي أوكلت اليه. ويمكن القول أنَّ هذه المقاربات، وإن تباينت في سرديَّاتها حول ماهيَّة وهويَّة هذا المخلوق، فإنَّها تتقاطع على الجملة حول منزلته الفريدة ومكانته المفارقة في عالم الوجود.
سنورد في ما يلي أبرز ما أطلق عليه من نعوت وأوصاف في هذا الخصوص:
الأوَّل: الموجود المنفرد بذاته
يستهل الإلهيّون سَفَرهم لمعرفة المخلوق الأوَّل من خلال السعي لإثباته بالدليل العقليّ. ومؤدَّى قولهم في هذا المسعى أنَّ مقتضى القوانين العقليَّة تثبت وجود موجود في الخارج قائمٍ بنفسه غيرِ ذي وضع، ومشتملٍ بالفعل على جميع المعقولات، التي يمكن أن تخرج إلى الفعل، بحيث يستحيل عليه وعليها التغيُّر والاستحالة والتجديد والزوال، ويكون هو وهي بهذه الصِّفات أزلًا وأبدًا. من الإلهيّين من ذهب إلى تسميته حينًا بالعقل الكلِّيّ، وحينًا آخر بـ “الَّلوح المحفوظ”. ويقول المحقِّق والفيلسوف صائن الدين ابن تركة عن هذا الموجود إنَّه يعادل “نفس الأمر” الذي هو عبارة عن حقائق الأشياء بحسب ذواتها، وبقطع النظر عن الأمور الخارجة عنها. ويضيف: “أن نفس الأمر هو أيضًا كناية عمّا ثُبتت فيه الصور والمعاني الحقَّة، وهو العالَم الأعلى الذي هو عالم المجرَّدات، كما يُطلق عالم الأمر على هذا العالم؛ ذلك لأنَّ كلَّ ما هو حقٌّ وصدق من المعاني والصور، لا بُدَّ وأن يكون له مطابَق في ذلك. فالعالم الأعلى هو الحيُّ التامُّ الذي فيه جميع الأشياء، وأنَّ فعل الحقِّ هو العقل الأوّل؛ فلذلك صار له من القوَّة ما ليس لغيره، وأنَّه ليس هناك جوهر من الجواهر التي بعد العقل الأوَّل إلّا وهو من فعل العقل الأوّل؛ وعليه فإنَّ الأشياء كلّها هي العقل، والعقلَ هي الأشياء، وإنَّما صار العقل جميعَ الأشياء، لأنَّ فيه جميعَ كلّيَّات الأشياء وصفاتِها وصورِها، وجميعُ الأشياء – التي كانت وتكون – مطابِقةٌ لما في العقل الأوّل. ثمَّ يمضي ابن تركة إلى إنشاء علاقة وطيدة بين هذا الموجود ومنشأ المعرفة البشريَّة ليرى أنَّ معارفنا -التي في نفوسنا – مطابقة للأعيان التي في الوجود، ولو جوَّزنا غير ذلك – أعني أن يكون بين تلك الصُّور التي في نفوسنا وبين الصور التي في الوجود تباين أو اختلاف – لما عرفنا تلك الصور، ولا أدركنا حقائقها؛ لأنَّ حقيقة الشيء ما هو به هو، وإذا لم يكن، فلا محالة غيره، وغير الشيء نقيضه؛ فإذن، جميع ما تدركه النفس وتتصوَّره من أعيان الموجودات، هو تلك الموجودات، إلّا أنَّه تنوَّع بنوع ونوع. [ابن تركة، صائن الدين – تمهيد القواعد – تقديم وتصحيح وتعليق: سيد جلال الدين آشتياني- مركز النشر الإسلامي في الحوزة العلميَّة – قمّ- إيران 1381 هـ – ص 182].
كلام ابن تركة حول ماهيَّة الموجود الأول يحيلنا إلى الفضاء الذي اشتغل عليه العرفاء. فالمقطوع به أنَّ ما تداوله جلُّ هؤلاء عن هذا الموجود ليس هو نفسه الكون الذي عرَّفه الإغريق بادئ الأمر، ثمَّ أخذه عنهم كثرة من المتأخّرين من الفلاسفة وعلماء الكلام. فهو عندهم الكائن المنعتق من كلِّ علاقة بالزمان الفيزيائيّ.. إلَّا أنَّه مع ذلك هو الحاضن لكلِّ موجوديَّة، لكونه يؤلِّف صيغة الظهور الذي به تظهر الأشياء من دون أن تلزمه أن يمتلئ بها ليحقِّق هذا الظهور…
الثاني: عالم الإمكان وعالم الأمر
المبدأ هو عالم الإمكان أو عالم الأمر. بل هو عالم الوجود المطلق، وهو أنَّ الموجودات موجودة فيه على وجه الإطلاق، غير مقيَّدة بهيئة. أي أنَّ المخلوقات موجودة فيه ذكرًا لا عينًا. مادَّتها واحدة، لا يمكن تمييزها بعضها عن بعض، يعني أنَّ زيدًا موجود في عالم الإمكان، لكنَّه موجودٌ بالذكر، لا بالعين، يعني: مادَّة ليست متعيّنة، ولا متخصِّصة. ويُسمَّى أيضًا بعالم الأمر، وهو مأخوذٌ من قوله تعالى: Nأَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَM. [الأعراف- 54] ويقابل الوجود المطلق الوجود المقيَّد، وفيه المخلوقات موجودة وجودًا مقيّدًا بصورة، وموجودة فيه ذكرًا وعينًا. ويكون تقييدها بالحدود الستَّة، وهي: الكم، والكيف، والجهة، والرتبة، والزمان، والمكان، ويُسمَّى هذا بعالم التكوين، يعني زيد في هذا العالم موجود بالذكر والعين، مادَّته تعيَّنت وتخصَّصت بالحدود المذكورة. ويسمَّى أيضًا بعالم الخلق. فالمخلوقات لمَّا كانت في عالم الإمكان لم تكن متمايزة، ولما أُلقِيَ عليها التكليف، وقَبِلت حِصَصها، كلٌّ حسب قدره ظهرت وتميَّزت في عالم التكوين.
الثالث: المُمِدُّ الأوَّل أو العرش
يذهب العارفون إلى وصف الموجود البَدئيّ بما وصفه به الخالق وأفاضه عليه من حُسن التدبير. فقد منحه من صفاته وأسمائه الحسنى الإمداد والرعاية. وعليه فقد أعطاه حقَّه من التنظير المخصوص على نحو يجعل منه مخلوقًا وخلَّاقًا في الآن عينه. يُشار في هذا الموضع، إلى أن ما أطلَقَ عليه بعض المحقّقين من أهل المعاني المادَّة الأولى، كان الأولى بهم أن يطلقوا عليه المُمِدّ الأوَّل في المحدثات؛ لكنهم سمَّوه بالصفة التي أوجده الله تعالى لها. وليس بمستبعد أن يسمَّى الشيء بما قام به من الصفات. يضيف: “وإنَّما عُبِّر عنه بالمادَّة الأولى فلأنَّ الله تعالى خلق الأشياء على ضربين: منها ما خلق من غير واسطة وسبب، وجعله سببًا لخلق شيء آخر. ومنها وهو الاعتقاد الصحيح أنَّه تعالى أوجَدَ الأشياء عند الأسباب لا بالأسباب، خلافًا لمخالفي أهل الحقّ. والذي يصحُّ أنَّ أوَّل موجود مخلوق من غير سبب متقدِّم ثمَّ صار سببًا لغيره ومادَّة له ومتوقّفًا ذلك الغير عليه على العقد الذي تقدَّم، كتوقُّف الشبع على الأكل، والريِّ على الشرب عادة؛ وكتوقُّف العالم على العلم، والحيّ على الحياة عقلًا وأمثال هذا؛ وكذلك كتوقُّف الثواب على فعل الطاعة والعقاب على المعصية شرعًا. فلمَّا لحظوا هذا المعنى سمَّوه المادَّة الأولى وهو حَسَنٌ، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا لا عقلًا [ابن عربي، محيي الدين – التدبيرات الإلهيَّة في إصلاح المملكة الإنسانيَّة- تحقيق: عاصم ابراهيم الكيالي الحسيني- الطبعة الثانية- دار الكتب العلميَّة- 2003- ص 22].
لكن الشيخ الأكبر يكتفي بما عَرَضه قدماء الإغريق وسواهم في تعريف الموجود الأوَّل، لذا سينتقل إلى أرض العرفاء حيث عبَّر عنه بعضهم بالعرش. والذي حملهم على ذلك أنَّه لما كان العرش محيطًا بالعالم في قول، أو هو جملة العالم في قول آخر، وهو منبع إيجاد الأمر والنهي، ووجدوا هذا الموجود المذكور آنفًا يشبه العرش من هذا الوجه، أعني الإيجاد والإحاطة. فكما أنَّ العرش محيط بالعالم وهو الفلك التاسع [في مذهب قوم]، كذلك هذا الخليفة محيط بعالم الإنسان. ثمَّ يومئ إلى قوله تعالى: Nالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىM [سورة طه، الآية 5]. على أنَّه في معرض التمدُّح لهذا المخلوق. فلو كان في المخلوقات أعظم منه لم يكن تمدُّحًا. فالعرش المذكور في هذه الآية هو مستوى الرَّحمن، وهو محلُّ الصفة؛ والخليفة الذي سمَّيناه عرشًا حملًا على هذا مستوى الله جل جلاله؛ فبين العرشين ما بين الله والرحمن، وإنَّه كان، فلا خفاء عند أهل الأسرار فيما ذكرناه [التدبيرات الإلهيَّة، ص 22]. وحدُّ الاستواء من هذا العرش المرموز قوله (ص): “إنَّ الله تعالى خلق آدم على صورته”؛ فالعرش الحامل للذات والمحمول عليه للصفة، فتحقَّق أيُّها العارف وتنبَّه أيها الواقف، وأمعن أيها الوارث، (والله يقول الحقّ وهو يهدي السبيل)[سورة الأحزاب، الآية 4].
الرَّابع: المعلِّم الأوَّل والإمام المبيّن
من صفات الموجود البَدئيِّ ما عبَّر عنه بعضهم بالمعلِّم الأول. والذي حملهم على ذلك أنَّه لمَّا تحقَّق عندهم خلافته، وأنَّه حامل الأمانة الإلهيَّة، ونسبته من العالم الأصغر نسبة آدم من العالم الأكبر. وفي ما يعتبره سرًّا من أسرار الخواصِّ في فهم المخلوق الأوَّل، يرى ابن عربي أنَّ سرَّ السجود هنا لا يمكن إيضاحه، وقد عبَّر عنه بعضهم بمرآة الحقِّ والحقيقة، ذلك أنَّهم لمَّا رأوه موضع تجلّي الحقائق والعلوم الإلهيَّة والحكم الربانيَّة، وأنَّ الباطل لا سبيل له إليها، إذ الباطل هو العدم المحض، ولا يصحُّ في العدم تجلٍّ ولا ظهور كشف، فالحقُّ كلُّ ظهر. والسبب الموجب هو لكونه مرآة الحقِّ قوله (ص): “المؤمن مرآة أخيه”. والأخوَّة هنا عبارة عن المثليَّة الُّلغويَّة في قوله تعالى: Nلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌM[سورة الشورى، الآية 11] ؛ وذلك عند بروز هذا الموجود في أصفى ما يمكن وأجلى ممكن ظهر فيه الحقُّ بذاته وصفاته المعنويَّة لا النفسيَّة، وتجلَّى له من حضرة الوجود.
الشيخ العارف أبو الحكيم بن برّجان الأشبيليُّ (ت 727 ) وصف الموجود البَدْئيَّ بالإمام المبين، وهو الَّلوح المحفوظ [المعبَّر عنه بكلِّ شيء في قوله تعالى: Nوَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍM[الأعراف- 145] وهو الَّلوح المحفوظ. والذي حمله على ذلك قوله تعالى: Nوَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍM[يس- 12]، ووجدنا العالم كلَّه أسفله وأعلاه مُحصى في الإنسان فسمَّيناه الإمام المبين، وأخذناه تنبيهًا من الإمام المبين الذي هو عند الله تعالى، فهذا حظنا منه.
الخامس: المُفيض ومركز الدائرة
من العرفاء من نعَتَ الموجود البَدئيَّ بالمُفيض. ومنهم من اعتبره “مركز الدائرة”. والذي حمل هؤلاء على مثل هذا الاعتبار أنَّهم لمَّا نظروا إلى عدل هذا الخليفة في ملكه واستقامة طريقته في هيئاته وأحكامه وقضاياه، سمَّوه مركز دائرة الكون لوجود العدل به، وإنَّما حملوه على مركز الكرة نظرًا منهم إلى أنَّ كلَّ خطٍّ يخرج من النقطة إلى المحيط مساويًا لصاحبه رأوا ذلك غاية العدل فسمُّوه مركز الدائرة لهذا المعنى. وأمَّا تأويل ذلك فإنَّ نقطة الدائرة هي أصل في وجود المحيط، ومهما قدَّرتَ كرة وجودًا أو تقديرًا فلا بدَّ من أن تقدِّر لها نقطة هي مركزها؛ فلا يلزم من وجود النقطة ووجود المحيط ووجود الفاعل من هذه الدائرة ورأس الضابط ولا دائرة في الوجود كان الله ولا شيء معه، وفخذاه يداه المبسوطتان جودًا أو إيجادًا؛ والفخذ المختصَّة بالنقطة يد المغيب والملكوت الأعلى، والفخذ المختصَّة بالمحيط يد عالم الملك والشهادة: فالواحدة للأمر والأخرى للخلق.
السادس: العينُ الثابتة وظهوُرها بالكلمة “كن”
استنادًا إلى كونه معادلًا للأعيان الثابتة بما هي الوجود الكامن في مقام الألوهيَّة. فقد صحَّ القول أنَّ المبدأ لا يكون من بل إنَّ فعل كونه وإيجاده متَّصل بكمونه وقابليَّته للظهور حالما يجيئه الأمر الإلهيّ. على هذا الأساس لم يكن ابن عربي ليصرِّح بما وصف به هذا المخلوق، لولا أنَّه استشعر منزلته المؤسِّسة لعلم البدء. من أجل ذلك سيطلق على متعلِّق هذا العلم اسم الأعيان الثابتة. والأعيان الثابتة – على ما نتبيَّن من أعمال العرفاء – هي مفتاح الكثير من المعضلات التي واجهت النظريَّات الوجوديَّة. أمَّا فهمها فيقوم على أنَّ عمل الخلقة لا يعني ظهور موجودات مستقلَّة إلى جانب الله تعالى. وإنّما هو عبارة عن تجلّي الحقِّ وتَشَؤُّنهِ في صور الأشياء. وعليه، فإنَّ صورة الأشياء لا تُخلق بواسطة الله، ما لم تكن موجودة فيه. فكلُّ شيء يظهر، إنَّما يظهر من شيء شبيه به. يعتقد ابن عربي في هذا الخصوص أنَّ إنشاء الخلق يقتضي توفُّر طرفين: الأوَّل هو الفاعل والذي عبارة عن أسماء الله. والثاني هو القابل والذي عبارة عن الأعيان الثابتة. والاثنان – أي الفاعل والقابل – موجودان في مقام الألوهيَّة، أي أنَّ الفاعل والقابل مجتمعان معًا: فإنَّه أعلى ما يكون من النسب الإلهيَّة أن يكون الحقُّ تعالى هو عين الوجود الذي استفادته الممكنات فما ثمَّ إلَّا وجود عين الحقِّ لا غيره؛ والتغييرات الظاهرة في هذه العين هي أحكام أعيان الممكنات، فلولا العين لما ظهر الحكم، ولولا الممكن لما ظهر التغيير، فلا بدَّ من الأفعال من حقٍّ وخلق [الفتوحات المكيَّة، ج 3- مرجع سبق الرجوع إليه في فصول سابقة- ص 211]. ويرى ابن عربي أنَّ هذه الأعيان موجودة بوجود الله من جانب، ومعدومة من جانب آخر لأنَّها تقبل الوجود. إذن، فالخلق من العدم يعني الخلق من الأعيان الثابتة. وههُنا تظهر مفارقة الوجود والعدم. والأعيان الثابتة أشياء لا وجود لها في الخارج. صحيحٌ أنَّها تحظى بالشيئيَّة لكنَّها لا تتمتَّع بالوجود كوجودٍ عينيٍّ وظهور في عالم الشهادة حتى يفيض عليها الله بأمر الإيجاد. وهنا بالذات يبطل ابن عربي وسائر العرفاء الإلهيّون نظريَّة الخلق من عدم. وفي هذا الشأن يضيف الشيخ الأكبر “لأنَّ أعيان الموجودات معدومة، وإن اتَّصفت بالثبوت، إلَّا أنَّها لم تتَّصف بالوجود [المصدر نفسه، ج1، ص 76]… لأنَّ العدم الثابتة فيه ما شمَّت رائحة من الموجود فهي على حالها مع تعداد الصور في الموجودات[المصدر نفسه، ج1، ص 76]. أمَّا الأعيان الظاهرة فهي مظهر تلك الأعيان الثابتة. ويمكن القول على ضوء وحدة الظاهر والمظهر- أنَّها نفسها، أي أنَّها الأعيان الثابتة الظاهرة التي ما زالت في البطون أيضًا. بتعبير آخر: إنَّ وحدة الحقِّ والخلق لا يكون لها معنى إلَّا إذا كان أحد الطرفين معدومًا. والمخلوقات ليست سوى هذه الأعيان الثابتة التي قلنا إنَّها معدومة إلَّا أنَّها تتَّحد مع وجود الحقِّ في عالم الشهادة. وحسب ابن عربي، أنَّ الحقَّ يقول ما ثمَّ شيء أظهر اليه لأنّي عين كلِّ شيء، فما أظهر إلَّا لمن ليست له شيئيَّة الوجود فلا تراني إلَّا الممكنات في شيئيَّة ثبوتها، فما ظهرتُ إليها لأنَّها لم تزل معدومة، وأنا لم أزل موجودًا فوجودي عين ظهوري، ولا ينبغي أن يكون الأمر إلَّا هكذا.[الفتوحات المكيَّة، ج 4، سبق ذكره- ص 8-9].
يسوِّغ القائلون بالأعيان الثابتة مدَّعاهم الآنف الذكر بما أسَّس له الكتاب الإلهيُّ عن علم الله الأزليّ. فالله عالم مطلق، وعلمه غير محدود، وأزليٌّ، ولا يتغيَّر. ولديه علم بكلِّ شيء قبل ظهوره. كما أنَّ ماهيَّة العلم تكشف عن حقيقة المعلوم. إذن، لا بدَّ قبل ظهور الخلقة، من وجود معلوم أزليٍّ لا يتغيَّر. ويعتقد الشيخ الأكبر بأنَّ الأعيان الثابتة هي هذا المعلوم، وأنَّها أيضًا علم الله الأزليّ الذي لا يتغيَّر طبقًا لوحدة العلم والمعلوم. وقد سمّيت بالثابتة لأنَّها لا تتغيَّر.
وفي تأويله لقوله تعالى:Nإِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُM[سورة النحل – الآية 40]، يلاحظ ابن عربي أنَّ ذلك الشيء الذي يستمع أمر “كن” ويطيعه، ويظهر إلى الوجود بعد أن كان معدومًا، هو العين الثابتة، وهو ذاك الذي قصدنا به المثنَّى أو الموجود البَدئيَّ والحقَّ المخلوق به حسب وصفه. والعين الثابتة التي تدلُّ على مجمل الأوصاف التي مرَّت معنا هي في حقيقة أمرها ذاتٌ وجوديَّة مهديَّةٌ وهادية في الآن عينه.
وعلى نحو ما تفصح عنه هذه المقاربة التأويليَّة ينوجد المبدأ الأوَّل كعين ثابتة ثمَّ يظهر في عالم الإمكان كحاصل للمشيئة الخالقة من خلال تلازم ثلاثة أفعال إلهيَّة هي: الأمر والإرادة والكلمة. وهو ما نستدلُّ عليه من الآية التي وردت في سورة “يس” وأدَّت قصد الآية السابقة نفسه Nإنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُM [سورة يس- الآية 82]. فالآية هنا تشير إلى نظام مثلَّث الأضلاع ينتظم الفعل الإلهيُّ في إيجاد الموجودات. فالأمر فعل الإرادة، ولا إرادة لمجهول. والنتيجة أنَّ الشيء سابق في إيجاده على إيجاده الأمريِّ، تمامًا كما يسبق الوجود الذهنيُّ الوجود الواقعيَّ في الصقع الربوبيّ. أمَّا الكلمة “كن” فهي الواسطة الإلهيَّة التي ظهر بها عالم الوجود الإمكانيّ. بذلك يكون فعل الكلمة انكشَفَ الله عن أمره وإرادته ليظهر المخلوق الأول كتجلِّ للأمر والإرادة معًا. ولعلَّ السرَّ في جعل متعلّق إرادته سبحانه في “كن” هو استبعاد دخولها تحت توصيف “ما بالقوَّة – ما بالفعل” التي زخرت بها البحوث الميتافزيقيَّة في عالم الممكنات. أمَّا في بحوث العرفان فسنجد قراءة مفارقة مؤدَّاها: أن يكون ما بالفعل هو عين ما بالقوَّة تجاوزًا. لكن تحت حيطة ارادته المطلقة وبصورة الرسم انمحاء الواو في “كن” “تعبير” عن ذلك. فليس شيء بحاجة إلى كون ما دام في مخطوطة علمه للذي هو في الوقت ذاته إرادته. وبهذا يتبيَّن لنا أنَّ الحاصل الأنطولوجيَّ للعلم والإرادة هو التجلِّي البَدئيٌّ الذي سمَّاه الحقُّ تعالى “كن”. ولذا فإنَّ هذه الكلمة الايجاديَّة هي الطريق بين الكون (ما دون الصقع الربوبيِّ) وبين العلم في تعلُّق الإرادة. وبهذا المعنى تصير الإرادة وسيط العلم إلى الكينونة.
السابع: المبدأ بما هو الحادث القديم
يميّز ابن عربي بين مرتبتين للوجود: مرتبة الوجود المطلق، وهو وجود الذات، ومرتبة الوجود المقيَّد، وهو الوجود العينيُّ الحسّيُّ للعالم. فالوجود المطلق هو الوجود الحقُّ منبع كلِّ موجود، وهو النور الذي يسطع على الممكنات، فيخرجها من حيّز الإمكان إلى حيّز الوجود الفعليّ [الطيب، محمد بن- عقيدة التوحيد الوجودي عند ابن عربي – بحث في إطار كتاب جماعيّ بعنوان: الإيمان في الفلسفة والتصوُّف الإسلاميين- إشراف: نادر الحمامي- منشورات: مؤمنون بلا حدود – الرَّباط- المغرب- 2016- ص 252]. إلَّا أنَّ التمييز الذي يجريه بين المرتبتين له تكملة جوهريَّة في منظومته العرفانيَّة.
وإنَّما كان الممكن قابلًا للوجود من دون العدم؛ لأنَّ له مرتبة الوجود في العلم الإلهيِّ، ومن ثمَّ ترجح جانب الوجود فيه على جانب العدم؛ لأنَّ له وجهًا إلى الحقِّ، ونسبة تغلب على جانب العدم، فلذلك قبل الظهور بالوجود، وصار وجوده وجودًا إضافيًّا نسبيًّا، وفي هذا المعنى يتنزَّل قوله: “علمنا قطعًا أنَّ كلَّ ما سوى الحقِّ عَرَضٌ زائل، وغَرَضٌ ماثل، وأنَّه، وإن اتَّصف بالوجود، وهو بهذه المثابة في نفسه، في حكم المعدوم، فلا بدَّ من حافظٍ يحفظ عليه الوجود، وليس إلَّا الله تعالى.
وبناءً على ذلك، يصحُّ وصف العالم بالقِدم إذا نظرت إلى مرتبة الوجود العلميِّ، ويصحُّ وصفك إيَّاه بالحدوث إذا نظرت إلى مرتبة الوجود الحسّيِّ، وكلتاهما مرتبتان، ونسبتان إلى حقيقة وجوديَّة واحدة. ومن ثمَّ، تكون الألوهيَّة مفهومًا ذهنيًّا معقولًا يتوسَّط بين الذات الإلهيَّة والعالم، أو بين الوجود الحقِّ المطلق والوجود المقيَّد المضاف، ويصعب أن توصف بالوجود أو العدم بمعناهما الحسّيِّ، بل الألوهة فاصلة واصلة في آن، إنَّها أمر ثالث بين الوجود المطلق والوجود المقيّد “لا يتَّصف لا بالوجود، ولا بالعدم، ولا بالحدوث، ولا بالقِدم، وهو مقارن للأزليِّ الحقِّ أزلًا، فيستحيل عليه، أيضًا، التقدُّم الزمانيُّ على العالم والتأخُّر، كما استحال على الحقِّ وزيادة؛ لأنَّه ليس بموجود، فإنَّ الحدوث والعدم أمرٌ إضافيٌّ يوصل إلى العقل حقيقة ما، وذلك أنَّه لو زال العالم لما أطلقنا على الواجب الوجود قديمًا، وإن كان الشرع لم يجىء بهذا الاسم – أعني: القديم – وإنَّما جاء بالاسم الأوَّل والآخر؛ إذ الوسط العاقد للأوليَّة والآخريَّة ليس ثمَّ، فلا أول ولا آخر، وهكذا الظاهر، والباطن، والأسماء، والإضافات كلُّها، فيكون موجودًا مطلقًا من غير تقييد بأوليَّة، أو آخريَّة” [المصدر نفسه- ص 253]. وهكذا يستبين لنا أنَّ الأسماء الإلهيَّة ليس لها وجود إضافة كالعالم، وإنَّما هي مجموعة من التعلُّقات التي تصل بين كينونتين؛ الأولى هي الذات الإلهيَّة بوجودها المطلق حتى عن الإطلاق، والثانية هي العالم بوجوده العينيِّ المضاف لا بوجوده العلميِّ الأزليّ [المصدر نفسه، الصفحة نفسها]. وتلك النسب، والإضافات، والتعلُّقات هي التي تقيّد إطلاق الذات الإلهيَّة، ومن ثم تجمع بينها وبين العالم، وبذلك يكون الله مُتعاليًا ومُحايثًا في آن، والتعالي والمُحايثة مظهران للحقِّ، فالتعالي للحقِّ باعتباره ذاتًا إلهيَّة مجهولة العين، والمُحايثة باعتبار العالم مجلى لألوهيَّتها؛ أي: مظهرًا لأسمائها، وانعكاسًا لصفاتها.
فالله هو الحقُّ الوحيد، أمَّا العالم فلا وجود له من ذاته، وإنما وجوده موقوف على إيجاد الله إيَّاه، وحفظه الوجود عليه، فلا مجال للحديث عن وحدة وجود مادّيَّة محايثة ترجع الله إلى العالم، وتجعله ماثلًا فيه، ولا عن وحدة وجود فيضيَّة تعدُّ العالم سيلانًا، واندفاقًا من الذات، وإنَّما هي وحدة عمادها الإيمان بالله الواحد الحقِّ الفرد الصمد الذي لا يتبدَّل، فهو نفسه في حقيقته الغيبيَّة المتعالية، وهو نفسه في المظاهر المتعلِّقة بالكون المخلوق.
الثامن: المبدأ بوصفه الحقَّ المخلوقَ به
السؤال الإشكاليُّ الذي يطرحه قرَّاء ابن عربي بإزاء الصِّلة بين الله والعالم، أو بين الحقِّ والخلق، هو التالي: كيف للوجود الحقِّ أن يظهر في مراتب وظهورات مختلفة؟
في جوابهم، يسعى هؤلاء لمتاخمة ركن بارز في أركان التنظير عند ابن عربي، عنينا به مفهوم التجلِّي، والوظيفة المعرفيَّة المُسندة إليه في التوحيد الوجوديّ: يرى هؤلاء أنَّ مفهوم التجلّي هو بمثابة الأداة الإجرائيَّة؛ التي بفضلها يفسِّر ابن عربي تعدُّد المراتب الوجوديَّة، مع أنَّ عين الوجود واحدة، وبفضل هذا المفهوم المفتاح يؤسِّس ميتافيزيقا التجلّي، وهي ميتافيزيقا وحدويَّة تصل بين الله والعالم، فتجعل من العالم مرتبة من مراتب التجلّي الإلهيّ الدائم، ويُعتاض بها عن ميتافيزيقا الفيض، كما نظّر لها الفلاسفة، وعن ميتافيزيقا الخلق من عدم كما نظّر لها المتكلِّمون. تلك التي تتأسَّس على مبدأ الإله المفارق المتعالي، والعالم المنفصل عنه؛ ولذلك أتيح له أن يحقِّق مقصوده من تمييز نسق تفكيره الخاصِّ من الفلاسفة والمتكلِّمين معًا بفضل استصفاء هذا المصطلح.(…) ثمَّ إنَّ ميتافيزيقا التجلّي تجعل المفارق محايثًا من غير أن يفقد مفارقته، وتعاليه، فهو مُتعالٍ من جهة ذاته، مُحايث من جهة أسمائه، وهذا التجلّي له جانبان: جانب وجوديٌّ وجانب معرفيٌّ؛ لأنَّه نوعان: “تجلٍّ عامٌّ إحاطيٌّ، وتجلٍّ خاصٌّ شخصيٌّ، فالتجلّي العامُّ تجلٍّ رحمانيٌّ، وهو قوله تعالى Nالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىM[سورة طه، الآية 5]، والتجلِّي الخاصُّ هو ما لكلِّ شخص من العلم بالله، وهو ما يسمَّى (التجلِّي الوجوديُّ) و(التجلِّي الشهوديُّ)، فضلًا عن أنَّ الأسماء الإلهيَّة، على تعدُّدها، وتنوُّع حضراتها، وفاعليَّتها في الأكوان كلِّها، يمكن إرجاع الأفعال المتَّصلة بها إلى نوعين من التجلّي هما: تجلّي الجمال، وتجلّي الجلال[الطيب، محمد بن- مصدر سابق].
وهكذا سنرى أنَّ الخلق في – منظومة ابن عربي العرفانيَّة – ليس إيجادًا لشيء لا وجود له، فذلك مستحيل عقلًا وفعلًا، ولا هو فعل قام به الحقُّ في زمن مضى، دفعة واحدة، ثمَّ فرغ منه، كلَّا، فليس الخالق عنده بمعنى الموجِد من عدم، أو المبدِع على غير مثال سابق، وإنَّما الخالق ذاتٌ أزليَّة أبديَّة تظهر في كلِّ آن في صور ما لا يُحصى من الموجودات كثرة، فإذا ما اختفت فيه صورة تجلّى في غيرها في الَّلحظة التي تليها، فعمليَّة الخلق هي حركة التجلّي المتجدِّد، والمخلوق هو تلك الصور المتغيّرة الفانية التي لا قوام لها في ذاتها، وإنَّما قوامها بالحقِّ الذي يوجدها بمقتضى علمه، ويحفظ عليها وجودها على النحو الذي يشاء، بمقتضى قدرته، وإرادته. فـ: “إذا قلت القديم فَنِيَ المحدث، وإذا قلت الله فَنِيَ العالم، وإذا أخليت العالم من حفظ الله، لم يكن للعالم وجودٌ وفنيٌ، وإذا سرى حفظ الله في العالم بقي العالم موجودًا، فبظهور وتجلّيه يكون العالم باقيًا… وبهذا يصحُّ افتقار العالم إلى الله في بقائه في كلِّ نفس، ولا يزال الله خلَّاقًا على الدوام [ابن عربي – الفتوحات المكيَّة، الجزء الأول مصدر سبق ذكره – ص 454].
إنَّ الخلق عند ابن عربي هو التجلّي؛ أي: إخراج ما له وجود في حضرة من حضرات الوجود إلى حضرة أخرى، بمعنى إخراجه من الوجود في العلم الإلهيِّ الى الوجود في العالم الخارجيِّ، أو هو إظهار الشيء في صورة غير الصورة التي كان عليها من قبل، فالعالم، من حيث بطونه في العلم الإلهيِّ، حقيقة أزليَّة دائمة لا تفنى، ولا تتبدَّل، ولا تتغيَّر إلَّا من حيث صورها، أمَّا حقيقة ذاتها وجوهرها فلا تخضع للكون والفساد، وإنَّما تخضع لهما صورها المتكثِّرة، ومظاهرها المتعدِّدة [العفيفي، أبو العلا- التعليقات على فصوص الحكم – الجزء الثاني- مصدر سبق ذكره – ص 213].
يكتشف العارف خلال معراجه المعرفيِّ واختباراته المعنويَّة سرَّ الوجود في ذاته. وهو في هذا يتفادى الجدل الذي يشهده فقه الفلسفة لجهة التعارض بين الخلق من العدم والخلق من شيء، وهو تعارض لا نعرف معه الخاصّيَّة التي يتمتَّع بها الحقُّ المخلوق به فلا يشاركه فيها أيُّ مخلوق. فهو مخلوق متفرِّد بذاته، فاعل بالخلق منفعل بالحقِّ الأعلى، ولذلك حظي بمنزلة الخلق الأول والتجلّي للكلمة الإلهيَّة البدئيَّة “كن”. فهذه الكلمة يمثِّلها ابن عربي بـ “النفس الإلهيّ. وهي تعني الانبلاج كما ينبلج الفجر. وأمَّا الخلق هنا فهو أساس كشف الذات الإلهيَّة لنفسها، ولذا فلا مجال هنا للخلق من عدم لفتح هوَّة لا يمكن لأيِّ فكر عقلانيٍّ أن يمدَّ فوقها جسرًا، لأنَّ تلك الهوَّة نفسها وبطابعها التمييزيِّ تقوم بالمعارضة والإبعاد بين الأشياء. فالتنفُّس الإلهيُّ يخرج ما يسمّيه ابن عربي نَفَسًا رحمانيًّا، وهذا النَفَسُ هو الذي يمنح الوجود والحياة لكلِّ الأجسام “الَّلطيفة” التي تشكِّل الوجود الأوليَّ والتي تحمل اسم العماء [المصدر نفسه].. في هذا المجال يشير المفكِّر الفرنسيُّ هنري كوربان إلى الحديث المنسوب إلى النبيِّ(ص) لمَّا سُئل: أين كان ربُّنا قبل أن يخلق خلقه؟ فأجاب: كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء.
يرى كوربان أنَّ هذا العماء الذي يصدر عنه والذي فيه يوجد أزلًا الكيانُ الإلهيُّ، هو نفسه الذي يقوم في الآن ذاته بتلقّي الأشكال كلِّها، ويمنح للمخلوقات أشكالها: إنَّه نشطٌ وسكونيٌّ، متلقٍّ ومحقِّق، وبه يتمُّ التمييز داخل حقيقة الوجود باعتبارها الحقَّ في ذاته. إنَّه من حيث هو كذلك الخيال المطلق والَّلامشروط. وعمليَّة التجلّي الإلهيِّ الأصليَّة التي من خلالها “يظهر” الوجود لنفسه بالتميُّز في وجوده الخفيّ، أي بإظهاره لذاته ممكنات أسمائه وصفاته والأعيان الثابتة، هذه العمليَّة تُعدُّ خيالًا فاعلًا وخلَّاقًا وتجلّيًا. العماء بهذه الدلالة هو الخيال المطلق أو التجلّي الإلهيُّ أو الرَّحمة الموجِدة، تلكمُ هي بعض المفاهيم المترادفة التي تعبِّر عن الواقع الأصل نفسه، أي الحقَّ المخلوق به كلُّ شيء، وهو ما يعني أيضًا “الخالق المخلوق”. فالعماء هو الخالق، بما أنَّه النفيس الذي يصدر عنه لأنَّه مخبوء فيه: وهو من حيث هو كذلك اللَّامرئيُّ و”الباطن”. والعماء هو المخلوق باعتباره ظرفًا ظاهرًا. فالخالق المخلوق يعني أنَّ الوجود الإلهيَّ هو المحجوب والمكشوف أو أنَّه هو الأول والآخر [ابن عربي – فصوص الحكم – الجزء الثاني – ص 313].
تتضمَّن كلمة “كن” التي كان بها الحقُّ المخلوق به كلُّ شيء، إيحاءً غيبيًّا من خالقه مؤدَّاه: “لست أنت الذي يخلق حين تخلق، ولهذا فخلقك حقيقيّ. وهو حقيقيٌّ لأنَّ كلَّ مخلوق له بعد مزدوج: فالخالق المخلوق يُنمْذِج وحدة الأضداد. ومنذ الأزل وهذه المصادفة متأصِّلة في الخلق لأنَّ الخلق ليس من عدم وإنَّما هو تجلٍّ، ومن حيث هو كذلك فهو خيال. فالخيال الخلَّاق هو خيال شهوديٌّ، والخالق مرتبط بالمخلوق المتخيّل، لأنَّ كلَّ خيال خلَّاق هو تجلٍّ وتجدُّد للخلق. وعلم النفس لا ينفصل عن علم الكون: وخيال التجلّي يصرفهما في سيكوكسمولوجيا. وبالحفاظ على هذه الفكرة حاضرة في الذهن يلزمنا مساءلة ما يكون عضوها في الكائن الإنسانيِّ، أي عضو الرؤى والتنقيل، وتحويل كلِّ الأشياء إلى إشارات ورموز. [كوربان، هنري- المصدر نفسه – ص 184].
التاسع: “المبدأ/ المثنَّى بما هو الوجود المنبسط
ظهرت قاعدة “الواحد لا يصدر عنه إلَّا واحد” كواحدة من أبرز القضايا الإشكاليَّة في تاريخ الميتافيزيقا والعلوم الإلهيَّة. وبناءً على أنَّ الواحد لا يصدر عنه إلَّا واحد، كَثُر التساؤل عن ماهيَّة وطبيعة وصفة ذلك الواحد الصادر أوَّلًا من المبدأ الأعلى.
في تعريفات مدرسة الحكمة المتعالية أنَّ الصادر الأوّل ممكن لا يحتاج إلى غيره من الممكنات، بل يجب أن يكون هو واسطة في وجودها، وينحصر احتياجه إلى الواجب نفسه وحسب. وهي ترى إليه على أنَّه الممكن الأشرف، والوجود المطلق المنبسط، وأوّل ما ينشأ من الوجود الحقّ. ويجمع صدر الدين الشيرازي بين القولين أي الممكن الأشرف والعقل الأوّل باعتبار هذا الأخير صادرًا أوَّل بالقياس إلى الموجودات المتعيّنة المتباينة المتخالفة الآثار. فالأوّليَّة ههُنا بالقياس إلى سائر الصوادر المتباينة الذوات والوجودات، وإلَّا فعند تحليل الذهن العقل الأوّل إلى وجود مطلق وماهيَّة خاصَّة ونقص وإمكان، حكمنا بأنَّ أوّل ما ينشأ هو الوجود المطلق المنبسط ويلزمه بحسب كلِّ مرتبة ماهيَّة خاصَّة، وتنزُّلٌ خاصٌّ يلحقه إمكان خاصّْ”.[ملَّا صدرا- الأسفار- ج2- ص 270].
الإنسان الكامل كتجلٍّ لحقيقة المبدأ
لم ترِد لفظة المبدأ في الأدب العرفانيِّ على نحو صريح؛ إلَّا أنَّنا سنلقاها مطويَّة في تأويليَّات العُرفاء لمَّا تحدَّثوا عن البعد المزدوج للموجودات. فالمبدأ معادل لتجلّي الواحد في العالم الكثير، وهو مصداق هذا التجلّي في الآن نفسه، أمَّا أصالته فمأخوذة من الواحد ومرعيَّة باعتنائه. وتلك مسألة لا يدركها العقل الحسير مهما دأب على اختبارها بالاستدلال، إذ كلَّما مضى هذا العقل إلى مقايستها والبرهنة عليها وفق قاعدة المقدِّمات والنتائج عادت خائبة إلى سيرتها الأولى. والعارف الذي يقطع جسور الاستدلال يعرف أنَّ مسألة كهذه ممتنعةٌ على الفهم، فلا يجد حالئذٍ سوى التأويل سبيلًا إلى التعرُّف. والمقصود به العقل الاستدلاليُّ الذي يدور مدار عالم الممكنات ولا يغادره أبدًا، وهو عقل غير قادر على الامتداد إلى ما فوق أطواره الدنيويَّة. وبذلك فإنَّه كلَّما قطع شوطًا باتِّجاه معرفة الحقائق عاد إلى نشأته الأولى فحلَّت بصاحبه الحسرة. وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى: Nالَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ*ثمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌM [سورة الملك، الآية 3-4].
للمبدأ في المنظومة العرفانيَّة حقيقته المفارقة. هو واحد وكثير في الآن عينه. وحين يصل العارف إلى هذا المقام يكون قد تمثَّل ماهيَّته وصار هو عين المثنَّى وحقيقته. ولذا سنرى كيف ابتنى سيرَه وسلوكَه على الغيريَّة الخلَّاقة حيال سائر الموجودات وفي مقدَّمها النوع الآدميّ. ذلك بأنَّه الآن في مقام معرفيٍّ مبنيٍّ على حاضريَّة الله في عالم الاختلاف والكثرة. وما ذاك إلَّا لأنَّ هذه الحاضريَّة المتعالية المعتَنِية في الآن نفسه، تجعل العارف كائنًا راعيًا للمجتمع الإنسانيّ، وليس مجرَّد كائن اعتياديٍّ شأنه شأن سائر البشر. فهو مهاجر إلى الجود الإلهيِّ ليكسب عظمة الإيثار والإنفاق. وما غايته من متاخمة الألوهيَّة إلَّا لتمنحه صفاتها في العطاء والجود والُّلطف. ولذا جاءت حاضريَّة الله في هجرة النظير، حاضريَّة تدبير ولطف، حيث يستوي فيها النوع الآدميُّ بالعدل على نشأة النفس الواحدة.
المبدأ بوصفه عين الحقيقة المحمديَّة
تتَّخذ الحقيقة المحمديَّة سيريَّتها المعرفيَّة إلى مقام كونها نظيرًا للمبدأ. ودلالتها الأنطولوجيَّة أنَّها فعلُ الله الذي فعل به الأشياء كلَّها. وقد سُمّي هذا الجوهر الذي هو الفعل بأسماء مختلفة لا عداد لها، فهو مشيئة الله، وإرادة الله وقدرة الله، ويد الله، وروح الله.
لا يشكِّل البُعد الُّلغويُّ أهمّيَّة كبيرة في معالجة مفهوم الحقيقة المحمديَّة، فهو يأخذنا إلى القول بأنَّه مركَّب من مفردتين: الأولى: الحقيقة وهي تعني استعمال الَّلفظ بما وُضع له، لذلك قال ابن منظور الحقيقة: [ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 1414، الجزء 10، الصفحة 52]. “ما أُقرّ في الاستعمال على أصل وضعه، والمجاز ما كان بضدِّ ذلك”. والثانية دالةٌ على النبيِّ الخاتم محمَّد(ص)، وذلك ما يجعل الُّلغة تحمل دلالة التعرُّف على حقيقة النبيِّ، وهي تشير إلى محتوى المعالجة وأهدافها، التي لا تتَّضح بشكل جليٍّ إلَّا من خلال الكتب الاصطلاحيَّة، التي عملت على تفسير المقصود منه، حيث عرَّفها الجرجانيُّ بقوله: “الحقيقة المحمديَّة: هي الذات مع التعيُّن الأول، وهو الاسم الأعظم”. ويُظهر معنى هذا المفهوم بشكل أوضح حين ذهب إلى تعريف الروح الأعظم، الذي اعتبره: “الروح الإنسانيَّ مظهر الذات الإلهيَّة من حيث ربوبيَّتها، ولذلك لا يمكن أن يحوم حولها حائمٌ، ولا يروم وصلها رائمٌ، ولا يعلم كنهَها إلَّا الله تعالى، ولا ينال هذه البغيةَ سواه، وهو العقل الأول، والحقيقة المحمديَّة، والنفس الواحدة، والحقيقة الأسمائيَّة، وهو أوَّل موجود خلقه الله على صورته، وهو الخليفة الأكبر، وهو الجوهر النورانيُّ، جوهريَّته مظهر الذات، ونورانيَّته مظهر علمها، ويُسمَّى باعتبار الجوهريَّة: نفسًا واحدة، وباعتبار النورانيَّة: عقلًا أوَّل”. وهذا المعنى قريب ممَّا أشار إليه الكاشانيُّ بقوله: “إنَّ محمَّدًا هو أوَّل التعيُّنات التي عيَّنت بها الذات الأحديَّة قبل كلِّ تعيُّن، فظهر به ما لا نهاية من التعيُّنات، فهو يشمل جميع التعيُّنات، فهو فردٌ واحد في الوجود، ولا نظير له، إذ لا يتعيَّن من يساويه في المرتبة، وليس فوقه إلَّا الذات الأحديَّة المطلقة”[سعاد الحكيم، المعجم الصوفي – الحكمة في حدود الكلمة، بيروت، دار دندرة، 1981، الصفحة 347]. إنَّ الحقيقة المحمديَّة “هي أكمل مجلى خلقيٍّ ظهر فيه الحقُّ، بل هي الإنسان الكامل بأخصِّ معانيه. وإذا كان كلُّ موجود هو مجلى خاصًّا لإسم إلهيٍّ، فإنَّ محمَّدًا قد انفرد بأنّه مجلى للإسم الجامع وهو الإسم الأعظم [الله]، ولذلك كانت له مرتبة الجمعيَّة المطلقة”.
المثنَّى بما هو الرَّاعي الرَّحمانيُّ للموجودات
لمّا كان المثنَّى حاويًا للاختلاف وراعيًا للمتغايرات، فما ذاك إلَّا لجامعيَّته الداخلة في أصل تكوينه وإظهاره. ما يعني أنَّ حاضريَّته في الوجود لا تقوم على قانون نفي النَّفي، ولا كذلك على قانون التناقض، وإنَّما على ما نسمّيه بـ “زوجيَّة التكامل بين جناحيه. فلو أوَّلنا المثنَّى في توليده للتناظر الخلَّاق بين الكثرات الوجوديَّة، سيظهر لنا ما نعتبره مجازًا بـ”ديالكتيك التوحيد”، بحيث لا يعود النظير نقيضًا لنظيره، وإنَّما تآخٍ محفوظ بسيرية التواصل الجوهري بين النظائر والتساند الحميم في ما بينها.
على هذا النصاب من التآخي في الواحديَّة سيُكتبُ لعالم الموجودات أن يجتاز التناقض ليرى ذواته كنفس واحدة في محراب المثنَّى. وفي هذه الحال يصير كلُّ شيء بالنسبة إلى هذا العالم قابلًا لسَرَيان الزوجيَّة واختلافاتها في الوجود. لقد صار الأمر بينًّا لمن رأى ضدَّه حاضرًا في ذاته. ففي هذه الحال لا حاجةٍ لأحدٍ من طرفَي الزوجيَّة إلى البحث عن صاحبه في غير ذات زوجه، لأنَّ كلًّا من الزوجين الضدَّين قائمٌ في ذات الآخر، وكلٌّ منهما يحسُّ بزوجه، ولولا رؤية كلٍّ من الباطن والظاهر قائمًا في الآخر لما استطاع الإنسان أن يتلاءم مع صروف الدهر، فيحيا النقيض في نقيضه، ليُعدَّ لكلِّ حال عدّته مزوَّدًا من غناه لفقره، ومن صحَّته لمرضه، ومن راحته لتعبه ومن شبابه لهرمه. ولهذا كان علمُنا بباطن الشيء يجعلنا نعلم ظاهره ضرورة وبداهة والعكس بالعكس. ولنا في هذا مثال: فلو علمتَ أنّ الحركة في كلّ من الزوجين النقيضين من كلِّ شيء، تنتهي وتبدأ في الزوج الآخر في وقتٍ واحدٍ، لوجدت أنَّ السبب في ذلك إنَّما هو من أجل أن تظلَّ مستمرّة دائمًا وأبدًا. فالشيء المتحرّك الذي تنتهي حركته في أحد الزوجين وتبدأ في الزوج الآخر في وقتٍ واحدٍ، إنَّما هي حركةٌ مستمرَّةُ لا تتوقَّف، وفيها تتمثّل الصلة بين الخالق والمخلوق،- وبين النظير ونظيره-، وذلك في صورة رحمته التي وسعت كلَّ شيء[المصدر نفسه، ص 19]. وفي استمرار هذه الصلة المتبادلة على السواء والتعادل المتبادل، يتجلَّى سرُّ هذا الوجود في صورة قيام النهاية في البداية والبداية في النهاية في كلِّ شيء. فإذا نظرت مثلًا إلى معنى التزاوج الذي يتَّجه إلى الاتصال مستقلًّا عن معنى التجاوز الذي يتَّجه إلى تعدّي الشيء الذي تتجاوزه منفصلًا عنه، وجدت أنَّه ليس إلى تعرُّف أيٍّ منهما من سبيل إلَّا من خلال الآخر. [محمد عنبر – مقدِّمة لديوان العارف بالله العلَّامة الشيخ أحمد محمد حيدر “النغم القدسي” – دار الشمال – طرابلس – لبنان – 1997 – ص 18].
* * *
مقتضى التعرُّف على المثنى كمبدأ أنطو – ميتافيزيقيّ، هو قبل أيِّ شيء الإقرار بواقعيَّته وحقَّانيَّة وجوده. ومقتضى الإقرار، أن يُقام مقام الوجوب والضرورة. فإنَّه في مقام الوجوب من أمر الموجب ومشيئة المُبدِئ وإرادته؛ في مقام الضرورة لا انفلات له قيد لمحة من نظام الغائيَّة الإلهيَّة. فالمبدأ / المثنَّى هو من أمر الألوهيَّة وفعلها، والعلم بفعل الألوهيَّة إنَّما هو عين العلم بالمبدأ من حيث كونه كونًا تام القوام وعالّمًا متقن الصنع.
د. محمود حيدر
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.