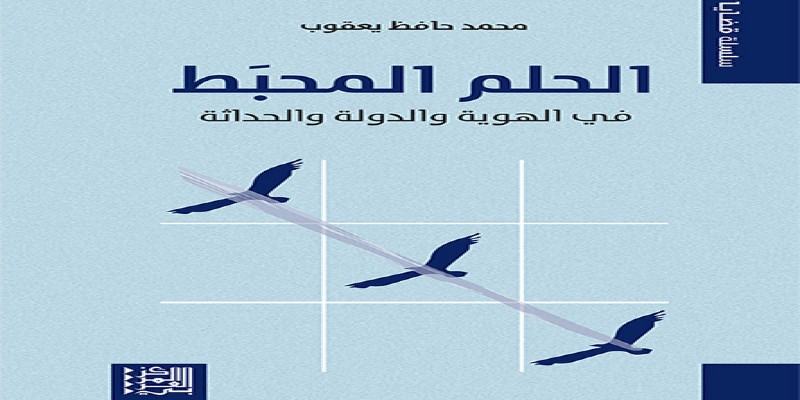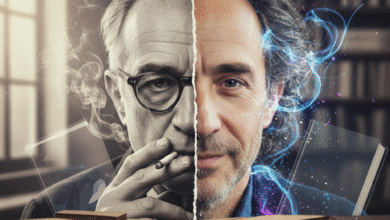الـحــريـَّـة بـــوصــفـــها مشروعـًا مستـمـرًّا

يولـد الإنسان حُـرّا، ولكن الأغلال تُقـيّـده أينما كان)[1](؛ ذلك قول قائله فيلسوف الحرية «جـ. روسو» J.Rousseau [1712-1778]. قد يُقال إنه قول غير مُجانب للصواب على اعتبار أن الحرية مِـنْحـة وهِـبَة يولد بـهـا الإنسان. وكـأن ماهية الإنسان مُحددة سلفا؛ أي إن الإنسان كائن حُـرّ. ولهذا، يقال عادة، إن أبلغ ترجمة لكون الإنسان حرا، هو تلك الدقائق أو اللحظات الأولى التي خرج فيها إلـى الوجود؛ بدون تحيُّزات أو انتماءات أو مواقف دوغمائية أو مختلف المُلصقات… ولكن، لا ينبغي أن نغتـرّ ونُــخــدع بهذه الصورة “البليغة”، ونذهب إلـى القول: إن الحرية هي غياب لضرورات بمختلف أشكالها. بَـيْـد أن الأقرب إلـى الصواب هو إن الحرية مُبناة لا معطاة؛ ولا تُبنى إلا ارتباطا بالضرورة. نريد أن نقول: لا يُولد الإنسان حرا، وإنما يصير كذلك. وسنحاول إبراز ذلك بِمبْضَعَي التحليل والنقد. ويمكن التعبير عن الإشكالية بالاستفهامات الآتية: كيف يمكن فهم الحرية؟ ما علاقتها بالضرورة؟ إذا سلّمنا بأن الحرية مشروع دائم فما أساسها؟
1ـ الحرية وعلاقتها بالثورة العلمية/الفلكية:
يذهب البعض إلى أن فهم ثمار ومنجزات العصر الحديث يرتبط أساسا بالوقوف عند الثورة الفلكية الكوبيرنيكية)[2](. فمن بين دروس هذه الأخيرة، مثلا، أن الحقيقة مبنية؛ فالشمس التي تطلع وتغرب علينا يوميا، ليست هي التي تدور حولنا، وإنما نحن من يدور حولها. إلى هذه الدرجة لم تعد حقيقة الموضوع ماثلة أمامنا، بل هي بناء وتشييد. إن هذه العودة إلى الذات لبناء الموضوع)[3]( ستنعكس على عدة مجالات؛ ليصبح «المجتمع صناعة»)[4](؛ فالمجتمع لاحق لـ«حال الطبيعة»، وتصبح النظرية العلمية مبنية أيضا؛ منهج الفرض الاستنباطي، والحرية كذلك. أصبحنا في عصر لا يقبل الجاهز، بل عصر ثقافته الشكـ. لذلك، أصبح يُصنعُ كل شيء؛ الجمال، العلم، الأوهام، الإيديولوجيا، التربية (صناعة الطفل الحر)، الحرية، وهي ما يهمنا في هذا المقام. ليست جاهزة، لا يولد بها الإنسان؛ إنما هي صناعة؛ خلق، بناء، مشروع مستمر.
الملاحظ، إذن، هو أن الصناعة هي سمة بَـلْـه ثقافة العصر الحديث، لذلك كانت الحرية من جنس المصنوعات. ثم إن انهيار العالم الأرسطي الثنائي، ساهم في سيادة الحرية بشكل قوي. فإذا كان العالم قبل كوبيرنيك، عموما، عالمين؛ عالم ما فوق القمر وعالم ما تحته، وأن الأرض هي مركز العالم. فإن مشكلات علمية، تحيُّر الكواكب إلخ، ستُسقط نظرية مركزية الأرض ومن ثم سيُصبح العالم واحدا؛ لا عالمين، فليس ثمة فرق بين ما يتجاوز القمر ولا ما بينه وبين الأرض، العالم كله واحد، يتغير، يخضع للكون والفساد. ونتيجة ذلك هي: لم يعد هناك فوق ولا تحت إلا بالمقارنة والنسبة، ولأن المركز غير معروف. ويسمى هذا انهيار الهرمية الكونية، ولنقل بشيء من التجاوز (المساواة الكونية). وهو ما سينعكس على عدة مجالات، مثل السياسة؛ سيصعد الشعب للحُكم، سيصبح الإنسان على صلة مباشرة مع الله (انهيار الوساطة)، سيصبح الإنسان مشرّعـا لذاته (الأخلاق الكانطية نموذجا)، ستصبح المرأة تطالب بحقوقها لأنها إنسان كالرجل)[5](، ستطلب الشعوب استقلالها… وهذا وغيره دليل على وجود صرخة كبرى هي صرخة الحرية. لا نُنكر أن الحرية لم يكن لها وجود حتى العصر الحديث، وإنما ستُصبح ثقافة للشعوب وللخاصة والعامة. ولنُلاحظ أن الحرية قبل العصر الحديث قد كانت مرتبطة بتحديدات قبلية، فأفلاطون Platon وأرسطوAristote ، مثلا، قد أقرّا بأنه بأنه ليس ثمة مشكلة في نظام العبودية)[6] (أي من الطبيعي أن يوجد عبيد وأسياد/أحرار. لكنها بعد هذا العصر، العصر الحديث، ستُصبح الحرية مطلب الكل؛ فمثلما أن العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس)[7](، كذلك أصبحت الحرية أعدل ما يمكن أن يتمتع بها كل إنسان. فهل نـفـهـم من ذلك أن الرؤية الكونية، المتعلقة بالعلم كعنصر أساسي فيها، تُغير العلاقات بين البشر؟ يبدو الأمر كذلك. فنحن في نسق كبير متغير، أبسط شيء يؤثر على كل الأجزاء، وَعَيْنا ذلك أو لم نفعل.
2ـ الحرية والضرورة أو الحرية والتحديات العلمية:
لو سلمنا ـ جدلا ـ أن ما قيل سابقا مجرد اجتهاد مجانب للصواب، فإنه لا يمكن إنكار أن الحرية بناء مستمر، ومواجهة للضرورات والعراقيل بشكل دائم، وإلا لم يعد هناك شيء اسمه الحرية)[8]( كما قال فيلسوف ألمانيا «كـ . ياسبرز»K. jaspers 1883-1969)]. ويعني ذلك، أننا لا نكون أحرار، إلا من خلال الدخول في علاقة جدلية مع الضرورة بمختلف ألوانها وأشكالها. فلا يمكن الإبداع من الفراغ، وإنما من مواد وموضوعات موجودة سلفا؛ هذا شأن الحرية، لا تظهر إلا عبر الضرورة بوصفها مرآة للفاعلية الإنسانية.
1ـ1ـ الضرورة السيكولوجية: حين أعلن «سـ . فرويد» S.Freud [1856-1939] خضوع الشخصية لـ«اللاّوعي»)[9](، فهذا تحدّي جديد لحريتنا، ولذلك كان لزاما علينا بناؤها من جديد من خلال معرفة أغوار الذات البشرية والبواعث التي تدفعنا للفعل. عندما نفهم الأسباب العميقة لـ: الزلات والفلتات وضروب من الأحلام… فإن هذا عينه هو بداية التحرر من سلطان اللاوعي. ولذلك كان الأساس الصلب الحرية إنـمـا هو المعرفة والعلم؛ أعني مختلف المعارف والعلوم.
لقد اشتهر «فـ . بيكون» [1561-1626] F.Bacon بقوله إن العلم قوة، ولكن ينبغي أن نُضيف: إنه حرية أيضا. فالسّفينة الشراعية التي تريد أن تتفادى التيار، تتحايل على الرياح المضادة فتتقدم في اتجاه لولبي مستخدمة قوى الرياح من أجل السير في اتجاه مضاد لتلك الرياح. إذن، فالبحّار ليس بحاجة إلى معجزة لتغيير اتجاه الرياح، ولكن يمكنه أن يستغل القوانين الطبيعية([10]) بوعي وتبصُّر)[11](. وكمثال ثان عن ارتباط الحرية بالمعرفة، نقول: إن السائق الذي يعرف خريطة المدينة أكثر حرية من الذي لا يعرف إلا طريقا أو طريقين نحو مكان بعينه. وعليه، فإن طبيعة حريتنا من طبيعة معرفتنا. إننا حين نعرف دروب وطبقات شخصيتنا نستطيع أن نتحرر من أوهامنا، فكثيرا ما نُخذَع ونُوهِم أنفسنا بأننا نختار وفقا لقناعات معينة، بيْد أن حقيقة الأمر هي أن دافع الخوف أو الانتقام أو الأنانية… هو المحرك، ومن ثم نسقط في وهم الحرية. إذن، عندما نعرف خفايا النفس ودوافعها اللاواعية، كما نعرف بواطن الطبيعة، فبإمكاننا أن نبدأ في طريق الحرية؛ من جهة التحرر مما يفرض نفسه علينا بحيث لا يكون بوسعنا فعل شيء.
هذا على المستوى الذاتي، فما طبيعة الحرية علائقيا؟
1ـ2ـ الضرورة الاجتماعية: يرى البعض أن الخلايا العصبية المرآوية، التي تتواجد في الفص الجبهي في مقدمة الدماغ، لها دور في التعليم بالمحاكاة، وهو ما ساعد على قيام الحضارات، وإلا لاستغرق ذلك أضعاف الوقت الذي بالفعل. فقط، من حوالي 75ـ100 ألف سنة حصل تطور وانتشار مفاجئ وسريع لعدد من المهارات الإنسانية، كاللغة، واستعمال الأدوات، وإشعال النار، واستخدام الملاجئ، والقدرة على التواصل مع الآخر عبر فهم وتفسير تصرفاته، وذلك رغم أن الدماغ قد وصل إلى حجمه الحالي منذ حوالي 300ـ400 ألف سنة خلت، ويرى «راما شاندران» أن ذلك حصل بسبب الظهور المفاجئ للخلايا المرآوية، التي سمحت بتقليد ومحاكاة أفعال الآخرين)[12](. ولكن، المشكلة تكمن في أن هذا التقليد نفسه كثيرا ما يسلب حريتنا، من حيث محاكاة الجماعة ورؤية ما يرون ولو كان موضوع الرؤية خاطئا أو وهميا. وهذا ما أكدته تجارب علمية مثل «تجربة سولومون أش » Solomon Asch الشهيرة ونسختها الثانية عام 2005. فما هي هذه التجربة؟
تجربة «سولومون أش» (1907ـ1996) عالم النفس الاجتماعي؛ هي تجربة تعود إلى عام 1952. وهي كالتالي: لدينا بطاقتان كبيرتان على إحداهما امتد خط رأسي واحد، والثانية عليها خطوط ثلاثة مشابهة لهذا الخط، وكان على المتطوعين أن يحددوا ـ بعد النظر إلى كل من البطاقتين ـ أي الخطوط الثلاثة على البطاقة الثانية هو المماثل للخط المفرد الذي على البطاقة الأولى، وكان «أش» قد جعل أحد الخطوط الثلاثة مماثلا لذلك الخط المفرد بينما جعل الخطين الآخرين على درجة كافية من الاختلاف عنه، وأثناء إجراء التجربة أوْعَز «أش» لبعض الأفراد ـ الذين تواطأ معهم مسبقا ـ بأن يجهروا بإجابتهم ـ والتي كانت خاطئة ـ قبل أن يشرع المتطوعون الحقيقيون بالإجابة. وقد كانت النتيجة ما يلي: حين كان المتطوعون يجيبون فُرادى، كانت إجاباتهم صحيحة، ولكن بعدما سمعوا المتواطئين يعلنون كلهم الإجابة الخاطئة، تحولت الأغلبية إلى مسايرة المتواطئين بالإدلاء بالإجابة الخطأ. الملاحظ إذن هو أن ثمة نزعة قوية إلى المطابقة)[13](.
ثمة نسخة جديدة من هذه التجربة، عام 2005. قام فريق من الباحثين بتجربة مشابهة استخدمت فيها «تقنية MRI» (التصوير بالرنين المغناطيسي)، وطُلب من المشتركين النظر إلى صور فوتوغرافية لأشكال ثلاثية الأبعاد مختلفة في الظاهر، ثم تقرير ما إذا كانت مختلفة حقا أم أنها لشيء واحد أخذت له صور من زوايا مختلفة؟ وقد تم التواطؤ مع بعض الأشخاص ليقدموا إجابات خاطئة، وكانت النتيجة أن المتطوعين الأصليين قدموا إجابات صحيحة حين كانوا مستقلين بأنفسهم، ولكن كلما تدخل المتواطئون انصاع المتطوعون الأصليون، فتنازلوا عن قناعاتهم لصالح الأغلبية وذلك بنسبة 100/40 من مرات إجراء التجربة. الجديد هو أن الصور المأخوذة بتقنية MRI أكدت أن المتطوعين لم يكونوا يُسايرون الجماعة فقط، بل كانوا بالفعل يرون الأشياء على ذلك النحو الخاطئ الذي ألهمته الأغلبية، وبتعبير مصححي التجربة فإن: «التركيبة الاجتماعية تُبدّل في إدراك العالم»، ذلك أن نشاط المخ لديهم قد بلغ أقصاه في التلافيف بين الجداريات في الجانب الأيمن، حيث يجري تكريس الوعي بالمكان، ولم يبلغ أقصاه كما هو متوقع في الحيّز الأمامي وهو الحيز المتخصص في التخطيط وحل المشاكل)[14](.
بناء على ما سبق، إن زيادة المعرفة بكيفية اشتغال الوعي الفردي داخل الجماعة، يحررنا نسبيا. ما دُمنا نضع وضعنا موضع سؤال واستشكال. وإن نشر هذا اللون من المعارف العلمية قد يحرر من التعصب والدوغمائية. ومن مقتضيات تحرر الفرد تحرر الجماعة. أي إن معرفة الإنسان لنفسه ونوعه قد يساعد على تحرره وتحرير جماعته، من كل أشكال العنف والسلبية. الحرية، بهذا المعنى، تؤدي إلى الانفتاح والتقليل من التعصب، والولاء والوفاء للبشرية وللإله أيضا؛ ما دام العالم يُوحّدنا بوصفه بيتا للإنسان وأمانة عنده. وكلما تحررنا تحرر العالم، وأصبح الجنس البشري في أحسن أحواله، ولأن المعرفة ليست كافية لإحداث التحرر، فلا بد من العمل والشغل وتفعيل تلكم المعرفة.
وعن قيمة الحرية وعلاقتها بالتقليد، يمكن استحضار طُرفة فلسفية، فهذا «ديوجين الكلبي الذي دحض حجج زينون على نفي الحركة؛ [دحضها] بأن قام ومشى ذهابا وإيابا، ضرب تلميذه الذي اكتفى بهذه الطريقة في الدحض، وصاح قائلا بأنه لا ينبغي للمتعلم أن يتقبل الأسباب التي قبلها هو [أي الأستاذ] من غير أن يضيف إليها أسبابه الخاصة»)[15](.
لا ينبغي، إذن، تقليد المعلِّم أو غيره في كل ما يقول، بل يجب التفكير معه وضده، معه بإضافة أسباب أو حجج أخرى مؤيدة، أو معارضة. فالذي يتفق معنا، بنفس حججنا، كأنه عطّل مَلَكة التفكير عنده.
إن «قابيل» بفعله، الممارس على «هابيل»، كأنه سنّ للبشرية «قانون العنف»، وإذا سلّمنا أننا أبناؤه)[16](، أبناء قابيل، فإن هذا الفعل سيُصبح مرتبطا بنا؛ كإمكانية لا كطبيعة، وهو ما ينطبق على الحرية، أيضا؛ فـكُلّما علّمنا الفرد كيف يكون حرا، كلما ساهمنا في تحرير وإحياء أبناء جنسنا. وبتعبير واضح، من أحيا وحرر نفسا فكأنما أحيا وحرر الناس جميعا.
1ـ3ـ الحرية والعلم التجريبي/علم الأعصاب: لقد أكدنا أن الحرية بناء وكسب ومهمة يجب الاشتغال عليها، لوعينا بأن الحرية هي تلك العذراء والقديسة التي سالت من أجلها الدماء حتى على عتبات المعابد. ولأن الحرية شاقة وصعبة، ينبغي أن نعلم أن الإنسان مطالب بالعمل؛ النظري والتطبيقي، من أجلها، فالعلم التجريبي قد وصف أمرا في غاية الاستشكال، يخص الدماغ والإرادة الحرة، فهذا عالم النفس الألماني «بنيامين ليبيت» B.Libet[1916-2007] يقوم بتجربة خلاصتها هي: استخدم «ليبيت» أقطابا كهربائية وصلها باللحاء المخي cerebral cortex للمتطوعين الذين طلب منهم القيام بأفعال سهلة كضغط زر، وكان عليهم أن يرصدوا اللحظة التي يشعرون فيها تحديدا بالدافع للقيام بهذا الفعل وهو الضغط عل الزر، وكانت النتيجة هي أن المتطوعين كانوا يضغطون الزر بعد زهاء خُمس الثانية من اتخاذ قرار الضغط، لكن التسجيلات الكهربائية بينت أن انطلاق النشاط العصبي المخي يحصل قبل ذلك بنحو نصف ثانية بما يزيد عن 300 مللي/ثانية قبل أي إدراك لدافع ضغط الزر)[17](([18](. ولكن، أليس «جُهد الاستعداد» كما ورد في التجربة دليل على أنه مجرد تهيُّؤ واستعداد، وليس هو ما يتحكم في قراراتنا؛ بدليل إمكانية رفض/تغيير ما كنا سنفعل؟ كيف ننفي حرية الإرادة في الوقت الذي نحاول فيه إقناع أحد ما بتغيير وجهة نظره؟ أليس هذا تناقضا؟
3ـ الحرية كمشروع دائم:
إذا كانت العبودية سهلة، كما يقول نيقولاي برديائف Nicolas Berdiaev (1874ـ1948)، فإن الحرية صعبة؛ لأنها صناعة، مُبناة، مكسب، في عمقها مهمة ينبغي الاضطلاع بها. ويبدو أن «حب الحرية والتطلع إلى التحرر هما، بالفعل، مؤشر على مستوى عال، ويظهران أن الإنسان داخليا لم يعد عبدا»)[19](. أجل، إن «لاوعينا» يمارس سلطته علينا، وجماعتنا تؤثر علينا وعلى تفكيرنا ورؤيتنا لذاتنا وللعالم، والعلوم التجريبية والإنسانية (مثلا علوم الأعصاب والنفس والاجتماع) تؤكد أن حريتنا ليست بذلك الحجم الذي نتصوره… والطبيعة كما نؤثر فيها تؤثر علينا. وهذه العلاقة بين الإنسان وباقي الأغيار (الغير والطبيعة والإله) علاقة مركبة جدا، تقتضي من الإنسان أن يُجاهد باستمرار لنيل الحرية ولو نسبيا؛ ولا يكون ذلك إلا بالمعرفة وتوظيف القوانين الطبيعية والإنسانية التي لولاها لما قامت للحرية قائمة، فهذه الجوهرة لا تقدم نفسها لأي أحد، وإنما للخبير الذي لا يعرف الاستسلامُ طريقا إليه. وبعبارة موجزة: لو خلا الكون والطبيعة من القوانين، ولو كان هذا العالم مسرحا «لسلسلة مستمرة من المعجزات، لما وجد الفعل البشري نقطة ارتكاز يقوم عليها أو يستند إليها، ولَكُـنّا نحن البشر مجرد عبيد تحت رحمة تقلبات الكون ونزواته»)[20](.
غير كاف أن نعرف أن انهيار «التراتبية الكونية» [فوق – تحت] كفيل بأن نُصبح أحرارا، أي أن الحرية بِنْتُ الثورات العلمية، وإنما الذي يجب علينا، أيضا، هو العمل لنستحق أن نكون أحرارا بالفعل. إن الحرية أعظم ما يمكن أن يتصف به الإنسان؛ هذا الكائن الذي يُعد عملة نادرة في الوجود، وإذا سلمنا بأن الإنسان يُساوي الحرية، كما ذهب فلاسفة الوجودية، فإنه يجب أن نحترمه ونُقدّره تقديرا. فــ«على هذا الكوكب الصغير يوجد الناس، ونحن نوع نادر ومُعرّض للخطر، وإذا ما اختلف معك إنسان؛ دَعْـهُ يَـعِـش، لأنكـ لن تجد إنسانا آخر في مائة مليار مجرة»)[21](. إنها دعوة إلى خدمة «الجنس البشري» والدفاع عنه، أجل إنها دعوة إلى الكونية، وهي دعوة حالمة، ولكن «المثال» هو الذي يُحرك الإنسان، وهو الذي يعطي القيمة لحياته. أليس هو الكائن الذي يُراوح بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون؟ أليست الحضارة حصاد وثمرة الانتقال من الواقع إلى المثال؟
لا يخفى أن جزءا من خطاب ما بـعد الحداثة الفلسفي قد شيّد صورة جديدة عن الإنسان بوصفه أسطورة العصر الحديث، فالإنسان ـ في هذا الخطاب ـ إن هو إلا «زهرة فانية على الجذع المشترك للطبيعة»، وأن العالم قد بدأ بدونه وسينتهي بدونه)[22](. إنه إعلان صريح عن «موت الإنسان»؛ فليس الإنسان ذاتا حرة وفاعلة ومستقلة… بل ذات مفعول بها، لا حيلة لها… وما تلك الخصائص إلا أوهام خلعها الإنسان على نفسه كأحلام وضروب من العزاء الوهمي؛ فلا صوت يعلو عن صوت المادة والطبيعة واللاوعي واللاشعور الجمعي والنسق… ولكن مهلا، هل اكتشافنا لبعض ما يحكم الإنسان هو قضاء على الإنسان ونهايته أم هو قضاء على تصورات عن الإنسان؟ فإذا كُنّا نعتقد أن المادة ليست إلا شيئا صلبا، لنكتشف لاحقا أنها طاقة، فهل يجوز القول أن المادة قد تلاشت أم أن تصوراتنا عنها هي التي ذهبت واندثرت؟ لـم يـمُـت الإنسان، بل اتسعت معرفته بنفسه عن نفسه)[23](، وازداد حرية حين تبيّن له أنه ليس حرا بإطلاق وأن ثمة حتميات أو ضرورات يعيش في ظلها، وبإمكانه الاتّـكـاء عليها ليزداد حرية واستقلالية وفرادة في مـمـلــكــة الطبيعة التي لا تنفصل عنها مـمـلـكة الـحـريـة.
لو صحّ أن الإنسان أسطورة، لكان من تبعات ذلك ليس التخلّي عنه ككائن ميتافيزيقي فحسب، بل التخلي عن البشر الواقعيين الذين يوجدون اليوم في حالة حرمان من العدالـة ومن الحرية ومن القدرة على تقرير المصير)[24](. وهو ما يعني، كذلك، أن حقوق الإنسان والحياة الكريمة عبث لا معنى له. ثم إن مسيرة ومغامرة البشرية عبر آلاف السنين لا يُعقل أن تنتهي بفلاسفة وعلماء يقرون بموت الإنسان والتاريخ ونهاية “السرديات الكبرى”؛ وهي أطاريح غير علمية وغير صائبة؛ إنها، فيما يبدو، دعاوى لمفكرين لم يعد لديهم ما يمكن قوله وإضافته. إنهم أشبه بـ أنصار «الفلسفة العلمية» (المتطرفين)؛ وهي ـ كما يقول الفيلسوف الروسي برديائف، مرة أخرى ـ من «اختراع مفكرين محرومين من أي موهبة فلسفية صادقة، أو الشعور بأن لهم رسالة معينة، هم هؤلاء الذين لا يضيفون شيئا إلى الفلسفة»)[25](.
_________
خلاصة:
صفوة القول، سيبقى الإنسان ذلك الموجود الميتافيزيـقي الذي يتغيّا الحرية. إنه لم يـمُـت، ولم تـفْـنَ الحرية، وإنما الذي شبع موتا هو بعض التصورات عنه. وليس الإنسان إنسانا إلا بقدر ما يقاوم ويُـثـابـر ليكون حرا وفاعلا في «عالـم الضرورة والعلل». وما الطبيعة إلا مرآة شاهدة عن قدرته على التجاوز والتعالي والتحرر. فــ«أسطورة نَركِيسُوس»([26]( مثال قوي عن كون الإنسان يُوثِر الخـلود من خلال ترك الأثـــر؛ وما أثر الإنسان على الطبيعة والغير إلا إثبات وتوكيد لِسَعْيه المستمر نحو قدْر أكبر من الحرية. وإنما الإنسان يكون حُـرّا بقدر ما يتعالى على الجاهز والمُعطى، ويُعيد رسم لوحة العالم والوجود على نحو جديد. وبتعبير مكثف عن قيمة الحرية، يمكن القول: إذا كانت «متعة الإنسان لا تنحصر في امتلاكه للحقيقة، وإنما تنحصر في الجهد الذي يبذله من أجل العمل على بلوغها… ولا تنمو ملكات الإنسان بامتلاكه الحقيقة، بل بالبحث عنها، كما أن كماله المتزايد لا يتمثل إلا في هذا المظهر وحده»([27])، فكذلك شأن الحرية؛ فمثلما تُصنع الحقيقة باستمرار، كذلك الحرية هي مشروع دائم؛ والإنسان إنما يُبنى ويُشيَّد هو أيضا في الوقت الذي يبني فيه حريته.
__________
الــمــــراجــــع :
مراجع باللغة العربية:
ـ الطاهر وعزيز، المناهج الفلسفية، المركز الثقافي العربي، ط1، 1990.
ـ جان جاك روسو، في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي، ترجمة عبد العزيز لبيب، المنظمة العربية للترجمة، ط1، بيروت، 2011.
ـ جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب، تونس، ط5، 2016.
ـ روبرت اغروس وجورج ستانسيو، العلم في منظوره الجديد، ترجمة كمال خلايلي، عالم المعرفة، 1989.
ـ زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، مكتبة مصر، ط2، 1963.
ـ زكريا إبراهيم، مشكلة الحياة، مكتبة مصر، بدون تاريخ.
ـ سيغموند فرويد، تفسير الأحلام، ترجمة مصطفى صفوان، دار المعارف، مصر، بدون تاريخ.
ـ عبد الرزاق الدواي، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، كتابك للنشر والتوزيع، ط1، 1992.
ـ عبد المجيد باعكريم، في المنهج: منطق الكشف النظري العلمي والفلسفي، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1، 2024.
ـ عدنان إبراهيم، حرية الاعتقاد في الإسلام ومعارضاتها، جامعة فيينا (رسالة لنيل الدكتوراه تحت إشراف روديجر لولكر)، 2014.
ـ علي شريعتي، الإنسان والإسلام، ترجمة عباس الترجمان، دار الأمير، ط2، 2007.
ـ كارل ساغان، الكون، ترجمة: نافع أيوب لبّس، عالم المعرفة (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب)، الكويت، 1993.
ـ محسن المحمدي، الحداثة ومركزية الرؤية العلمية، دار أدب، المملكة العربية السعودية، الرياض، ط1، 2022.
ـ نيقولاي برديائف، العزلة والمجتمع، ترجمة فؤاد كامل عبد العزيز، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1960.
ـ ولتر ستيس، تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة، القاهرة، 1984.
مراجع باللغة الفرنسية:
ـNicolas Berdiaeff, De l’esclavage et de la liberté de l’homme, Traduit du Russe par Samuel Jankelevitch, Paris : Aubier, Les Éditions Montaigne, 1963.
ـRené Descartes, Discours de la méthode(1637), Édition électronique (ePub) v.: 1,0 : Les Échos du Maquis, 2011.
[1] جان جاك روسو، في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي، ترجمة عبد العزيز لبيب، المنظمة العربية للترجمة، ط1، بيروت، 2011، ص 78.
[2] أنظر كتاب: محسن المحمدي، الحداثة ومركزية الرؤية العلمية، دار أدب، المملكة العربية السعودية، الرياض، ط1، 2022.
[3] عبد المجيد باعكريم، في المنهج: منطق الكشف النظري العلمي والفلسفي، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1، 2024، ص 208.
[4] محسن المحمدي، الحداثة ومركزية الرؤية العلمية، ص 263ـ275.
[5] راجع كتاب: محسن المحمدي، الحداثة ومركزية الرؤية العلمية، فيه تفصيل لنتائج الثورة العلمية على رؤية الإنسان لذاته وللعالم.
[6] ولتر ستيس، تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة، القاهرة، 1984، ص 262.
[7] René Descartes, Discours de la méthode(1637) , Édition électronique (ePub) v.: 1,0 : Les Échos du Maquis, 2011, p: 6.
[8] جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب، تونس، ط5، 2016، ص 146.
[9] سيغموند فرويد، تفسير الأحلام، ترجمة مصطفى صفوان، دار المعارف، مصر، بدون تاريخ، ص 595.
[10] المُلاحظ أن “قوانين الطبيعة تصفُ ولا تُلزِم“، ومن ثم لا تُرغم أحدا على شيء، فمثلا قوانين الحركة تصف كيف تتحرك الأشياء، لكنها لا تُجبرها على الحركة… إذن، فمع كوننا نتصرف تصرفا حرا، فإن أفعالنا تندرج تحت القوانين الطبيعية ذات الطابع الوصفي. عدنان إبراهيم، حرية الاعتقاد في الإسلام ومعارضاتها، جامعة فيينا (رسالة لنيل الدكتوراه تحت إشراف روديجر لولكر)، 2014، ص 79.
[11] زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، مكتبة مصر، ط2، 1963، ص 83.
[12] عدنان إبراهيم، حرية الاعتقاد في الإسلام ومعارضاتها، ص 111.
[13] نفسه، ص 111.
[14] نفسه، ص 111.
[15] الطاهر وعزيز، المناهج الفلسفية، المركز الثقافي العربي، ط1، 1990، ص 13.
[16] علي شريعتي، الإنسان والإسلام، ترجمة عباس الترجمان، دار الأمير، ط2، 2007، ص ص 60ـ61.
[17] عدنان إبراهيم، حرية الاعتقاد في الإسلام ومعترضاتها، ص 110.
[18] ولكن، ويلدر بنفيلد Wilder Penfieldوهو عالم أعصاب كندي صاحب كتاب «لغز العقل The Mystery of the Mind الذي سعى طوال حياته العلمية كغيره من العلماء إلى إثبات أن الدماغ يفسر العقل، انتهى إلى نتيجة مختلفة تماما. ولعل من أشهر تجاربه على المرضى ما يلي: يقول «عندما جعلت أحد المرضى يحركـ يده بوضع “الالكترود” [قطب كهربائي] على القشرة الحركية في أحد نصفي كرة دماغه كنتُ أسأله مرارا عن ذلك. وكان جوابه على الدوام: “أنا لم أحرّكـ يدي، ولكنكـ أنت الذي حرّكتها”. وعندما أنطقته قال: “أنا لم أخرج هذا الصوت، أنت سحبته مني”». ويعني ذلك أن المريض الذي يراقب مثل هذا لابد من أن يكون شيئا آخر يختلف كليا عن فعل الأعصاب اللاإرادي. إن مضمون الوعي – كما يقول بنفيلد – يتوقف إلى حد كبير على النشاط العصبي، ولكن الإدراك نفسه لا يتوقف على ذلك. إن الالكترود يستطيع أن يجعل جسم المريض يتحرك، ولكنه لا يستطيع أن يجعله يريد تحريكه. إنه لا يستطيع أن يُكره الإرادة. بمعنى أنه ليس في قشرة دماغ المريض أي مكان يستطيع التنبيه الكهربائي أن يجعل المريض يعتقد أو يقرر شيئا. من هنا فـ«العقل والإرادة البشرية ليس لهما أعضاء جسدية. ورُبّما الدرس المستفاد من هذه التجارب، هو أن الحرية ممكنة، وليس الإنسان مُجبرا وإن كان في عالم العلل والضرورات. روبرت اغروس وجورج ستانسيو، العلم في منظوره الجديد، ترجمة كمال خلايلي، عالم المعرفة، ص ص 36ـ37. فضلا عن أن الفيزياء الكمية قد بينت أن الاحتمال هو ما يحكم العالم الميكروسكوبي وليس الحتمية.
[19] Nicolas Berdiaeff, De l’esclavage et de la liberté de l’homme, Traduit du Russe par Samuel Jankelevitch, Paris : Aubier, Les Éditions Montaigne, 1963, p:255.
[20] زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، ص 83.
[21] كارل ساغان، الكون، ترجمة: نافع أيوب لبّس، عالم المعرفة (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب) ــ الكويت، 1993، ص 274.
[22] عبد الرزاق الدواي، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، كتابك للنشر والتوزيع، ط1، 1992، ص 183.
[23] نفسه، ص 184ـ185.
[24] نفسه، ص 186.
[25] نيقولاي برديائف، العزلة والمجتمع، ترجمة فؤاد كامل عبد العزيز، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1960، ص 19.
[26] هي أسطورة من الأساطير اليونانية القديمة المعروفة.
[27] زكريا إبراهيم، مشكلة الحياة، مكتبة مصر، بدون تاريخ، ص 47.
_________
*رحـو اليوسفي: باحث مغربي وأستاذ للفلسفة بسلك التعـليم الثانوي التأهيلي.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.