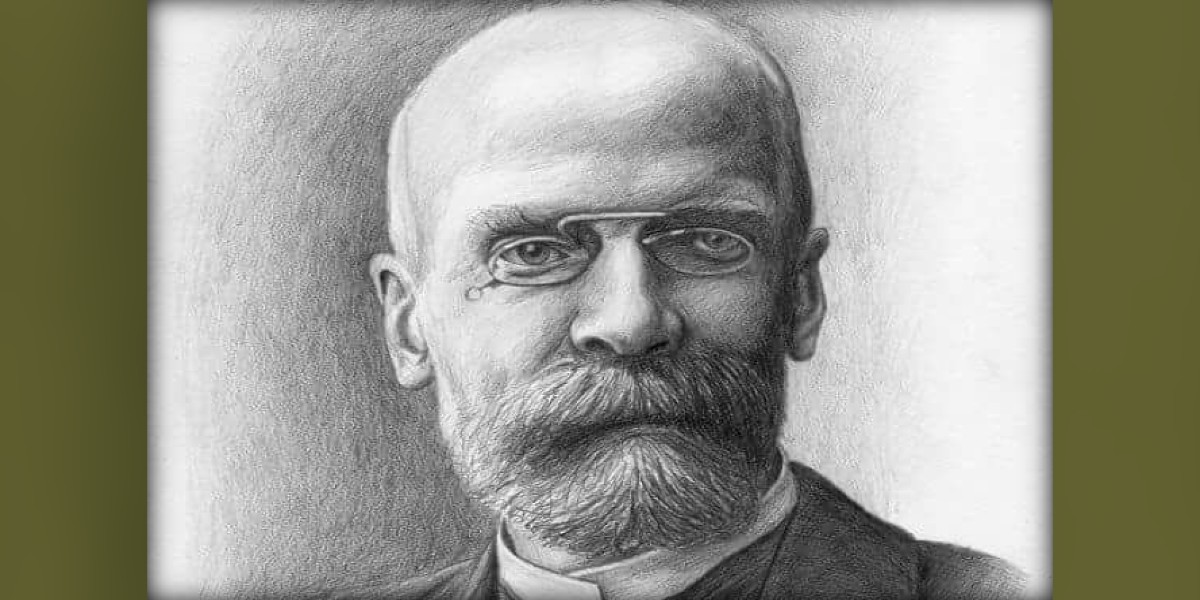ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقيا بعديَّة

ما بعد فلسفة الدين…ميتافيزيقا بَعديَّة..[1]
د. محمود حيدر
تحمل كلمة «ما بعد» في كلِّ حالٍ من أحوالها، على التساؤل عمَّا إذا كان «الماقبل» قد انطوى وفات أوانُه. لكنَّ دلالة الكلمة لا تتوقَّف على معنى أحاديٍّ أو على وجهٍ واحد؛ فإنَّما هي حمَّالةٌ لغير معنىً ووجه. لقد مرَّ معنا أنَّ من «المابعد» ما يشير إلى استئناف أمرٍ بُغية استكماله.. ومنه ما يدلُّ على اضمحلالِ قديمٍ وولادةِ جديد.. ومنه كذلك، ما يعني وصولَ علمٍ ما إلى خاتمة مبانيه ومناهجه ومنظوراته، حتى فَقَدَ القدرة على الإتيان بخبر جليل.
ما نحن بصدده، في هذه المطارحة، تنظيرُ «المابعد» في فلسفة الدين قصْدَ متاخمتها على إنشاءٍ آخر. وهذا يوجب دربًا مفارقًا في المكابدة المعرفيَّة غايتُه أمران:
لمُّ الشمل بين عالَمَين [الفلسفة والدين] طال بينهما أمدُ الاختصام.
ب- نقد أو تقويض ما اقترفته فلسفة الدين من معاثر وأعطالٍ في مناهجها ونظريَّاتها ومسلَّماتها.
* * *
إذا عَنَت فلسفة الدين – كما صنَّعتها مقالة الحداثة – النظر إلى الدين كظهور سوسيو- تاريخيٍّ يُقرأ من خارجِهِ، أو كمعرفة محايدة تعلِّق الأحكام كما تقرِّر الَّلاأدريَّة، أو حتى كتقويض لمبانيه الوحيانيَّة كما فعلت العلمانية الملحدة… فسيكون من غير الجائز منطقيًّا أن يستوي نظرُها على صواب الرؤية. إذ كيف لفلسفة تنتسب إلى عالمٍ ليس من عالمها، ولا هي من طبيعته، ويصير اسمها حذو اسمه، أن تصدر أحكامها الصارمة عليه؟ ثم كيف لها من بعد ذلك، أن تجعل الدين حقلًا لاختباراتها، في ما هي تنكر عليه ماهيَّته التوحيديَّة ومسلَّماته الوحيانيَّة؟..
ذاك كان من أعقد مُعضلات الفلسفة لمَّا أقبلت على الدين إقبالَ المُقبِلِ على غريب، ثمَّ مضت ترتِّبُ أحكامها عليه، وترسم له معالمه وسِماته، حتى من قبل أن تتعرَّف إلى هوّيَّته الحقيقيَّة، ومنزلته العميقة الغور في النفس البشريَّة.
لقد سبق لهذه المعضلة بالذات، أن تشيعَ بقوَّة في سياق الجدل المفتوح بين التيَّارين الفلسفيِّ والَّلاهوتي في أوروبا القرن الثالث عشر. وقتذاك توجَّه القدِّيس توما الأكوينيُّ إلى أساتذة الَّلاهوت وطلب إليهم أن يجتنبوا الاستدلال على أصلٍ إيمانيٍ بالبرهان المنطقيّ، لأنَّ الإيمان لا يرتكز على المنطق بل على كلمة الله. وعلى التوازي راح ينبِّه أساتذة الفلسفة ألَّا يستدلَّوا على حقيقة فلسفيَّة باللُّجوء إلى كلمة الله، لأنَّ الفلسفة لا ترتكز على الوحي بل على العقل ومقولاته. ومع أنَّ الأكوينيَّ كان أرسطيًّا متشدِّدًا، فقد حرِصَ على التمييز بين الفلسفة والوحي؛ وهَدَفُه حفظ قدرة كلٍّ منهما على إنتاج المعرفة الصحيحة، وبما يتناسب وطبيعة كلٍّ منهما. فإذا كان الَّلاهوت هو العلم بالأشياء عن طريق تلقِّيها من الوحي الإلهيِّ، فالفلسفةَ هي المعرفة بالأشياء التي تفيض من مبادئ العقل الطبيعيّ. ولأنَّ المصدر المشترك للفلسفة والَّلاهوت هو الله خالق العقل والوحي، فإنَّ هذين العلمين يسيران باتِّجاه نقطة نهاية واحدة»…
ذاك يفيد بضرورة تمييز المعرفة الفلسفيَّة المبنيَّة على مبادئ العقل، عن المعرفة الدينيَّة الآخذة بمسلَّمات الوحي. وهذا التمييز لا يرمي في الواقع، إلى الفصل والتفريق الموصل إلى القطيعة، وإنَّما يقصد التأليف بين معرفتين قامتا على تباين واختلاف في المنهج، إلَّا أنَّهما تختزنان مَيْلاً أصلياً نحو التناغم والانسجام.. وتأسيساً على مبدأ التأليف بين المعرفتين، تنهض فرضيتنا على تصور لأطروحة ذات أفقين متعاونين: الأول، يفتتح سَيْرًا مرنًا باتجاه مستحدثٍ معرفيٍّ مُفارق، من سماته الأساسيَّة، أنَّ «مابعديَّته» لا تُسقِط ما قبلها ولا تحكم عليه بالبطلان، بل تقيم له مطرحًا يناسب نظامه المعرفيّ.. أما الأفق الثاني ففيه تُعرب الأطروحة «المابعديَّة» عن رغبة بالمجاوزة، من خلال التنظير لمقترح يجمع العقل إلى الوحي على نصاب الواحديَّة، حتى يغدوا معاً دربة ومنهاجًا لفهم العالم بوجهيه المرئي والوحياني.
نجدنا هنا تلقاء تفكير جديد، هو أقرب إلى هجرة معرفيَّة تتغيَّا من وجهٍ أول، نقد المبدأ المؤسِّس الذي منه نمت وتطوَّرت فلسفة الدين، ومن وجهٍ ثانٍ، تقويض ما يُفترض تقويضُه مما فَسُدَ من نظريَّاتها وأعرافها وأبنيتها المنطقيَّة والإبستمولوجيَّة. ما يحملنا إلى هذه الهجرة المعرفية المركبة هي ضرورة تبديد طائفة الأحكام رافقت اهتمام الفلسفة الغربية بالدين؛ لعل أبرزها هذه الأحكام: إقصاء معرفة الله والدين النظري من حقل المعرفة التي يمكن تحصيلها عن طريق العقل، مع ما يستتبع ذلك من نفيٍ لكل ما لا يقع تحت أمرة العقل القياسي تجربة واستدلالًا. هذا هو الداعي إلى وجوب مراجعةٍ جوهريَّةٍ تقيم التفكُّر الفلسفيَّ في الشأن الدينيِّ على نصاب يتعدَّى ما انصرفت إليه الحكاية الفلسفيَّة الكلاسيكيَّة حين أوقفت رؤيتها إلى الدين على مفترضات العقل القياسي وما يستولده من أحكام.
I
في صدد ماهيَّة فلسفة الدين وطبائع فلاسفتها
لم تنجُ فلسفة الدين – كما سوَّغتها الحداثة الوضعانية- من معثرة تكوينيَّة في نظامها المعرفيِّ تنتهي إلى جعل الدين مجرَّد موضوعٍ للاختبار والتدارس كأيٍ من موضوعات العلوم الإنسانية الأخرى. بيد أنَّ لهذه المعثرة التكوينية نتائج فادحة. فهي لم تكتفِ بإجراء مقاربات سوسيو ـ تاريخية للدين، أو التعامل معه كمعطى فينومينولوجي، بل ستقطع مسافة أبعد يغدو فيه الفلسفيٌ سيِّداً على الدينيِّ وحاكماً عليه. ومع أن فلسفة الدين علمٌ مستحدث ينتمي إلى سلسلة الفلسفات المضافة، فقد سلكت مسلكاً جاوز صفتها الإضافية، لتمسّ حقلاً أنطولوجياً لا تملك لمعضلاته الكبرى مخرجاً. فلو اتَّفقنا على كون فلسفة الدين: فلسفة مضافة إلى الدين، أو انها أضيفت إلى الدين رغبة في درسه وتظهيراً له كموضوع للبحث العلمي، فمن غير المنطقيِّ أن يُصدِرَ الفرعُ حكمًا على صحَّة أو بطلان ما يقوم عليه المضاف إليه. فلو فعلت «الفلسفة المضافة» ذلك، لحَكَمَت على نفسها بمثل ما حَكَمَت على أصلها، أي إبطال المبادئ الناظمة لمشروعها المعرفيِّ وتقويض مرتكزاته ومبانيه الأصليَّة. فالعلمُ المضاف – كونه مضافًا – يبقى تحت ظل مصدره الأول، ولا يملك أهليَّة حلِّ المعضلات الميتافيزيقيَّة الكبرى. وإذا كان هذا هو واقع الحال فماذا سيكون عليه الحال التالي حين يتصدَّى علمٌ وضعانيٌّ لأمرٍ وحيانيٍّ غيبيٍّ بعقلٍ حسابيٍّ مقيَّدٍ بمعياريَّة المفاهيم وصرامتها؟.. سوف يتوضَّح محلُّ النزاع لو تنبَّهنا إلى أنّ الموضوع المحوريَّ في التنظير الحداثيِّ لفلسفة الدين كامنٌ في النظر إلى المسائل الاعتقاديَّة كظواهر لا تكتسب حقَّانيَّتها وواقعيَّتها إلَّا بمدى تطابقها ومبادئ العقل الاحتسابيِّ ومقولاته. بهذا التعيُّن تتحوَّل الرؤية الفلسفيَّة الوضعيَّة للدين إلى علم مقطوع الآصرة عن الماوراء؛ شأنها في ذلك شأن سائر موضوعيَّات العلوم الإنسانيَّة. فإذا كانت الميتافيزيقا نظام معرفة وتعرُّفٍ على المبدأ الأول والأسباب الأولى للأشياء، فما تبديه فلسفة الدين هو الانشغال بالشأن الدينيِّ كمُعطى «محض» فينومنيولوجيّ. وسيرد في تنظيرات فلسفة ما بعد الحداثة ما يسوِّغ النظر إلى الدين كظاهرة سوسيو- تاريخيَّة، وعلى الفلسفة أن تتعاطى حيالها كحقل معرفيٍّ منزوع الصلة عن بُعدِهِ الغيبيّ. الفرضيَّة المؤسِّسة لفكرة كهذه تقرِّر أنَّ الفينومينولوجيا ليست علمًا تمهيديًّا للفلسفة بل هي الفلسفة نفسها، ما يعني أنَّ مهمَّة الفلسفة بتعريفها المذكور، باتت خارج موطنها الأصليِّ أي العلم بمبدأ الأشياء ومعرفة الشيء في ذاته. ومع أنَّ هذه الفكرة سيحملها عدد من كبار مجدِّدي الفينومينولوجيا الحديثة أمثال هوسرل وهايدغر وسواهما، إلَّا أنَّها لم تفارق النطاق العامَّ للتفكير الوضعانيِّ حيال الدين. الشاهد هنا، ما دعا إليه هؤلاء وفي مقدَّمهم هايدغر من أنَّ على فلسفة الدين في أفقها التاريخيِّ أن تفهم الحاضر وتحدِّد مسبقًا التطوُّر المستقبليَّ للدين، ثمَّ عليها أن تقرِّر ما إذا كان سيكون هناك دينٌ عامٌّ للعقل يجري إنشاؤه بطريقة توفيقيَّة من الكاثوليكيَّة والبرتستانتيَّة، أو ما إذا كانت إحدى الديانات الوثوقيَّة (Positive) مثل (المسيحيَّة – البوذيَّة – الإسلام) ستسود وحدها في المستقبل. [هايدغر – فينومينولوجيا الحياة الدينيَّة – ص 39].
على منقلبٍ آخر، وفي مقام شغفها الأقصى بالهمِّ الدينيِّ، تتدرَّج فلسفة الدين لتصير أكثر تماهيًا مع مشاغل الَّلاهوت وعلم الكلام، وخصوصًا لجهة عنايتها بأسئلة الوجود: نظير: «هل الله موجود؟»، و«ما معنى الحياة؟»، و«ما هي السعادة؟»، و«هل ستتحقَّق الحياة الخالدة؟»، وسواها من الأسئلة. لكنَّ الفارق بين فلسفة الدين وما يناظرها كلاميًّا أو لاهوتيًّا، يكمنُ في أنَّ العِلمَيْنِ الأخيرين يستندان إلى الوحي، في حين تستند الفلسفة إلى سنَّة العقل وحسب.. لهذا، قد يبدو للنُّظَّار كما لو أنَّ فلسفة الدين تنشط في منطقة حياديَّة، حين تمارس نقدها للمنظومة الدينيَّة. وإذ نستكشف مسالكها يظهر لنا كيف ستعمل بصورة حثيثة لنقد- أو تقويض- مختلف المعتقدات من دون أن تخشى تهمة الانحياز والحياد غير الإيجابيّ. قد يكون في مثل هذا المسلك شيءٌ من الصواب في أحيانٍ خاصَّة، إلَّا أنَّ اجراءاتها النقديَّة الإقصائية، في عصور الحداثة، تبطل مدَّعى الحياد المعرفيِّ، لا سيَّما في تعاملها مع المسائل الكبرى لعلم الوجود، نظير الوحي والروح والتوحيد الإلهيّ…
وأنَّى ما يُقال من مسميَّات وأفعال وتعاريف حول فلسفة الدين، فستكشف العمليات الاستقرائيَّة عن طائفة من العناصر تفيد الوقوف على ماهيَّتها والأحيان التي تعكس فيها هوّيَّتها الفعليَّة:
الأول– حين يُدرَس الدين وفقًا للمقولات الفلسفيَّة، أنطولوجيًّا ومعرفيًّا وتاريخيًّا.
الثاني– حين يُرى إلى الدين كموضوع يتناوله الفلاسفة كلٌّ على طريقته.
الثالث– حين يُقرأ الدين فلسفيًّا على أرض المقولات الدينيَّة.
الرابع– حين يتكلَّم الفيلسوف، عن الدين كموضوع، ويستند إلى مقدِّمات فلسفيَّة من خارج الدين للبحث في القضايا الدينيَّة.
الخامس– حين يتوجَّه فيلسوف الدين إلى البحث في الدين بوصفه ظاهرة بشريَّة منزوعة الصِّلة من بُعدها الغيبيّ.
السادس– حين يتعامل فيلسوف الدين مع دينٍ معيَّنٍ قصد إجراء بحوث مقارنة مع أديان أخرى.
السابع– حين يؤثرُ فيلسوف الدين العمل وفق المنهج «الخارج دينيِّ» ليدخل دائرة البحث الدينيّ.
إلى العناصر المذكورة، يُحتمل أن تنبسط نوازع فيلسوف الدين وميوله على أنحاء شتَّى: إمَّا أن يكون مُنكرًا لله، أو مؤمنًا به، أو لا أدريًّا. إلى هذا ليس بالضرورة أن يكون ملتزمًا بدينٍ معيَّنٍ حتى يمارس مهمَّته الفلسفيَّة، ذلك أنَّ كلمة الدين في فلسفة الدين، كلمة مطلقة وغير مقيّدة بدينٍ معيَّن من دون سواه، أي أنَّها غير مقيَّدة لا بالإسلام ولا بالمسيحيَّة ولا باليهوديَّة، ولا بسوى ذلك من الديانات غير الوحيانيَّة. لهذا الداعي وسواه، غالبًا ما يكون فيلسوف الدين مأخوذًا، بأسئلة قلقة لا تسفر إلَّا عن إجابات قلقة، لكنَّه يبقى مسكونًا برغبة التوصُّل إلى جوابٍ ما، من أجل أن يمنح نفسه قِسطًا من يقينها المفقود. ولأنَّه كثيرًا ما يخذله السؤال عن تحصيل الجواب الآمن، نجده مستيئسًا من أيِّ بارقة أمل. لذا أكبَّ على اقتفاء أثر عالم الممكنات قصد تحرِّي عِللِهَا وأسبابها والنتائج المترتِّبة عليها. وفي هذا السبيل سيلتجئ إلى عالم السؤال من أجل أن يستفهم عن الوجود بما هو موجود مرئيٍّ ومتعيِّن. غير أنَّ استيطانه كهف الممكنات سيؤدّي به عمومًا إلى التشكيك أو إنكار ما لم يستطع نَيْلًه عبر دابَّة العقل. بذلك يكون فيلسوف الدين المعاصر قد اقتفى أثر الأوَّلين من دون أن يلتفت سوادهم الأعظم إلى المشكلات المعرفيَّة الناجمة عنه. من البيِّن أنَّ الفلسفة في تطلُّعِها إلى الأمر الدينيِّ لم تتخلَّص من تاريخها الإشكاليِّ منذ اليونان إلى أزمنة الحداثة الفائضة. وهذا هو الداعي الذي جعل كلَّ مسألة ذات طبيعة فوق ميتافيزيقيَّة (غيبيَّة) تستعصي على الحلّ. المعثرة الكبرى في مكابدات الميتافيزيقا القبْليَّة كامنة أساسًا في انزياحها عن مهمَّتها العظمى، وهي فهم العالم كوجود متصل، بين مراتبه الطبيعية وفوق الطبيعيَّة. ولئن كانت هذه هي مهمّتها الأصليَّة- وهذا ما يميّزها عن العلم- فذلك تذكير بما هو بديهيٌّ فيها، أي استكشاف قدرتها – وما تنطوي عليه من مَلَكَات العقل النظريِّ – على الإحاطة بالمستتر في الوجود. وهذا إقرار لها كعلمٍ حيٍّ يُحيي نفسه ويُحيي سواه من العلوم في الآن عينه. ولا مناص من الإلتفات إلى أنَّ من أحسن حسنات الفلسفة، أنَّها لا تكفُّ عن إعلان رسالتها الأصليَّة، حتى وهي تستغرق في دنيا الممكنات وعوارضها. فالخاصّيَّة الملحوظة لكلِّ التعاليم الميتافيزيقيَّة، هي التقاؤها على ضرورة البحث عن ذلك الأصل في كل موجود. وفي تاريخ الفلسفة – الكلاسيكيَّة والحديثة – كثُر الحديث عن هذا المبدأ الذي يُسمِّي المادَّة الأولى مع ديمقريطس، والخير مع أفلاطون، والفكر الذي يفكِّر بذاته مع أرسطو، والواحد مع أفلوطين، والوجود مع كلِّ الفلاسفة المسيحيين. في أزمنة الحداثة تبدَّلت الأسماء والأوصاف، إلَّا أنَّ المقصد إلى الأصل بقي هو نفسه. فقد اتَّخذ المبدأ الأول صفة القانون الأخلاقيِّ مع كانط، والإرادة مع شوبنهاور، والفكرة المطلقة حسب هيغل، والديمومة الخلّاقة عند برغسون. وفي جميع الأحوال، فإنَّ الميتافيزيقيَّ القاصد إلى الأصل هو ذاك الذي يبحث في ما وراء وبعد التجربة عن مصدر مطلق لكلِّ تجربة حقيقيَّة وممكنة. وتبعًا لهذه الرؤية ما عاد يصحُّ اعتبار الإنسان حيوانًا ناطقًا كما قرَّر أرسطو، بل هو كائنٌ ميتافيزيقيٌّ بالطبع والغريزة، أي أنَّ ماهيَّته ميتافيزيقيَّة، عكس كلِّ الماهيَّات التي تنطوي في خِلقتها الأولى على عاقل يعقلها ويرعاها ويدبِّر لها أمرها. فالقانون – على سبيل المثال – الذي هو مخصوصٌ بالكائن الإنسانيِّ لا يكتفي بتقرير الحقيقة، بل يشير إلى سببها. وبما أنَّ الإنسان عاقلٌ بماهيَّته، فقد وَجَبَ تفسيره والبحث عن ماهيَّته في بنية العقل نفسها. بكلام آخر؛ ينبغي أن يكون السبب في أنَّ الإنسان حيوان ميتافيزيقيٌّ كامنًا في مكان ما من طبيعته العقلانيَّة. ولقد لَفَتَ الفلاسفة إلى حقيقة تفيد بأنَّ في المعرفة العقليَّة من الصوابيَّة المنطقيَّة ما هو أكثر ممَّا في التجربة الحسّيَّة. وهم سوَّغوا ذلك بأنَّ الخصائص النموذجيَّة للمعرفة العلميَّة، مثل «الكليَّة والضرورة»، لا يمكن إيجادها في الحقيقة الحسّيَّة، في حين أنَّ التفاسير الأكثر عموميَّة تؤكِّد أنَّ المعرفة العلميَّة تأتي إلينا من قدرتنا أصلًا على المعرفة. لذا يقال إن لا شيء يحلُّ في العقل ويتمُّ تعقُّله ما لم يمرّ من قبل في الحواسِّ ما عدا العقل ذاته. ومثلما كان كانط أول من فقد الثقة بالميتافيزيقا وتمسَّك بها باعتبارها أمرًا لا مفرَّ منه، كان هو نفسه أوّل من نبَّه إلى قدرة العقل البشريِّ الملحوظة في تجاوز كلِّ تجربة حسّيَّة. وهو ما سمَّاه بـ «الاستعمال المتعالي للعقل». غير أنَّ المفارقة في تنظير «ناقد العقل الخالص»، إعراضُه عن تحويل فكرة الاستعمال المتعالي للعقل إلى منفتح لمبدأ يؤسِّس الحداثة وفلسفتها على منشأ جديد. ولقد وجدناه يعزف عن مشروعه في تعاليه، لينعطف رجوعًا ويتَّهم الميتافيزيقا بأنَّها المصدر الدائم لأوهامنا الميتافيزيقيَّة. [إيتان جلسون- وحدة التجربة الفلسفيَّة، ص 226].
II
معضلة الجحود بالألوهة
لا تنأى مباني فلسفة الدين وفرضيَّاتها من مشاغل الوضعانيَّة على اختلاف تيَّاراتها الإلحاديَّة ومذاهبها الفلسفيَّة ونزعاتها الإيديولوجيَّة. وعلى ما يظهر، فقد تلاقت هذه جميعًا على جملة قواعد أبرزها: أنَّ الكون نشأ من تلقاء نفسه ومن دون الحاجة إلى صانع، وأنَّ الحياة ظهرت ذاتيًّا من المادَّة عن طريق قوانين الطبيعة، وأنَّ الفرق بين الحياة والموت هو فرق فيزيائيٌّ بحت، وأنَّ الإنسان ليس غير جسد مادّيٍّ، يفنى تمامًا بالموت.
هذه القواعد المذكورة – التي باتت لدى أصحابها مثابة نظريَّة معرفة – ستدخل دخولًا بيِّنًا في الهندسة المعرفيَّة الأصليَّة لفلسفة الدين. كما ستجد منفسحًا تنظيريًّا خصبًا لرواجها في القرن التاسع عشر من تاريخ أوروبا الحديثة. ففي العام 1841، وبعد مرور عشر سنوات على وفاة هيغل، نشر الألمانيُّ لودفيغ فويرباخ Ludwig Feuerbach كتابه المشهور «جوهر المسيحيَّة» ثمَّ ما لبث أن ألحقه بكتاب «جوهر الدين». ومع أنَّ السجال لم يتوقَّف حول ما إذا كان فيورباخ ملحدًا أم لا، إلَّا أن النتائج العامة المترتبة على نظرياته أسهمت في رفد الإلحاد، وعزَّزت من شيوع ثقافة الدين الطبيعي. الذين استقرأوا السيرة الشخصيَّة لفيورباخ قرَّروا غير ذلك. فهو عندهم لم يكن منكراً للدين ولو من زاوية النظر إليه كضرورة ملازمة للطبيعة البشرية والدليل على هذا قولُه إنَّ الإنسان حيوان متديِّنٌ بماهيَّته، وإنَّ الدين هو الأساس في الفصل الماهويِّ بين الإنسان والحيوان.
يُستنتج من قول كهذا أنَّ هدف فويرباخ في المطاف الأخير هو تدمير كلِّ المعارف المعتبرة «فوق الطبيعيَّة» supernaturalism. ولقد سعى لتحقيق هذا الهدف من خلال إقناع الإنسان بأنَّه هو الحقيقة السامية، وعليه ألَّا يبحث عن السعادة خارج ذاته، بل في نفسه، لأنَّه عندما يكون هو المطلق بالنسبة إلى نفسه، فسوف يفقد كلَّ الرغبات فوق الطبيعيَّة، والذي لا يبقى لديه رغبات فوق طبيعيَّة لا يكون لديه كائن فوق طبيعيٍّ كذلك. ورغم موقفــه الحـادِّ من الدين ظلَّ فيورباخ شغوفًـا بدراسته بعمق، إلى الحدِّ الذي مضى فيه إلى صريح التعبــير بأنَّ العناية المعرفيَّة بالدين هو أوجب واجبات الفلسفة.
[L. Feuerbach, The Essence of Christianity, trans, by M vans, New York, 1855; Chap. I, pp. 21- 22].
هذا هو الشيء الذي التَفَتَ إليه الفيلسوف الفرنسي من أصل روسي نيقولا بريائيف (N. Berdyaev) ليبيِّن أنَّ الفلسفة الحديثة عامَّة والفلسفة الألمانيَّة على وجه الخصوص، هي أشدُّ مسيحيَّة في جوهرها من فلسفة العصر الوسيط، وذلك بسبب موضوعاتها الرئيسيَّة وطبيعة تفكيرها، الأمر الذي يشي بوضوح أنَّ المسيحيَّة نفذت إلى ماهيَّة الفكر نفسه منذ فجر العصور الحديثة.
لكن الوضعانيَّة التي قدّستها الحداثة، سوف تطوي فلسفة الدين تحت أجنحتها لتوظِّف أنساقها المعرفية في تقويض الإيمان المسيحي. لأجل ذلك راحت تنتج من خلالها شبكة معقدة من النظريَّات المتداخلة مؤدَّاها: أنَّ العالم الدينيَّ القائم على الخوارق هو عالم وهميٌّ لأنَّه يسلب الجوهر الإنسانيَّ من الإنسان لأجل الله. وأنَّ فكرة الإله مجرَّد إسقاطٍ أجراه العقل البشريُّ على نفسه من أجل أن يعثر على حلٍّ آمن لسرِّ وجوده. حتى إذا جاءت أطروحة فيورباخ مضت إلى اختزال القضيَّة بعبارات وافية، هي أنَّ الفهم الأساسيَّ والأولي للدين يتلخَّص في كون «الأنثروبولوجيّ هو سرُّ الَّلاهوت»، وأنَّ جوهر وحقيقة الدين ومعناه الباطنيَّ العميق هو الجوهر الإنسانيّ. فالدين عنده له مضمون خاصٌّ في ذاته، أي أنَّ معرفة الله هي معرفة الإنسان بذاته التي لم تعِ ذاتها بعد. والوعي بالدين هو الوعي الأول وغير المباشر للإنسان، وهو الوسيلة التي يتَّخذها الموجود البشريُّ في البحث عن نفسه. والنتيجة التي ينتهي إليها، أنَّ كلَّ صفات الجوهر الإلهيّ هي صفات لجوهر الإنسان في أقصى درجات كمالها، وأنَّ الروح الإلهيَّة التي ندركها أو نعتقد بها هي نفسها الروح المدرِكة.
[L. Feuerbach, Ipid. P. 24].
على التأسيس الذي مرَّ معنا، ستنشأ حقولٌ معرفيَّة تفرَّعت من فلسفة الدين، وقامت على منطقها، أهمُّها اثنان شكَّلا سحابة قرن ويزيد، مساحة احتدام لم تهدأ ضوضاؤها بين التيَّارين العلمانيِّ والَّلاهوتيِّ وهما حقل «التجربة الدينيَّة» وحقل «التعدُّديَّة الدينيَّة».
حقل التجربة الدينيَّة
لدى الحديث عن التجربة الدينيَّة، ترِدُ إلى الأذهان سلسلة من الاستفهامات حول طبيعة المشاعر والأحاسيس والأحوال الروحيَّة التي يختبرها المتديّن. جلُّ الإجابات على تلك السلسلة المفترضة من الاستفهامات تُظهِرُ على نحو البداهة، أنَّ الاعتقاد بوحدانيَّة الله هي الوجهة القصوى التي يتطلَّع إليها المتديِّن والتي تشكِّل جوهر تجربته الدينيَّة. فلكي يُفهم الإيمان بالأمر الغيبيِّ على ما هو عليه في حقيقته، لا بدَّ من أن يُعاش. ومقتضى عيشه أن تكونَه. كأنْ تنظر إلى قداسته بالرضا والتسليم، ثمَّ أن تتعقَّل ما أنت فيه ليكون فهمك له حاصل نظر وعمل. أما «الميثاق الروحيّ» الذي ينبغي أن يُبرم مع المقدَّس فإنه يوجب عليك الاستعداد للقاءٍ لم تعهده من قبل. فسيكون على الداخل في الاختبار أن يتهيَّأ لحوار لا يدور إلَّا على نحو شخصيّ. فلا تقبل الحضرة القدسيَّة حوارًا مع المقبل إليها، إلا أن يأتيها فردًا رغم كثرة المقبلين. فلكلِّ فردٍ سبيل إليها، ولا ينالها – إلَّا من وقف – وقوفًا ما – على سرِّها. فمن خَلُصت نيَّتُه انفتح له باب السرّ، ودخل الحضرة بيُسْر. حتى إذا دنا من مقصوده راح يتوسَّلُه بلطف المحاورة. أمَّا علامة القبول، فشعورٌ بالأمان وإحساس باليقين. في هذه الَّلحظة التي عُرفت عند الصوفية بـ «لحظة التجلِّي» يحدثُ ضربٌ من انخطافٍ روحيٍّ لا يتوفَّر عليها سوى الذي يعيشها بالفعل. فقد تواصل سرُّ الفرد مع سرِّ الألوهيَّة، حتى ليُمسِيا على صراط واحد. ومثل هذا التجلّي لا يُحصَّل إلَّا في الفضاء الرحب للإيمان الأعلى، الذي منه يولد المقدَّس وفي لحظته تشرق شمس الألوهيَّة.
كان عالم الأنتروبولوجيا ومؤرِّخ الأديان ميرسيا إلياد، ينفي أن يكون المقدَّس مجرَّد مرحلة من مراحل الوعي البشريِّ، بل يعتبره عنصرًا مكوِّنًا لبنية هذا الوعي. وأكثر من هذا فإنَّه يعتبر وجود العالم حصيلة جدليَّة لتجلّي المقدَّس وظهوره. وكان يلاحظ أنَّ أقدم صورة لعلاقة الإنسان بعالمه هي تلك العلاقة المشبعة بالمقدَّس حيث يفيض هذا المقدَّس بمعانيه على مكان الإنسان، وحيث تكون ممارسته له في حدِّ ذاته عملًا دينيًّا.
[M. Eliade La Nostalgie des origins: Méthodologie et histoire des religions, ed Gallimard, Paris 1971. P 7].
يبيِّن هذا التأصيل الجوهريُّ لمكانة المقدَّس في الحياة البشريَّة، أنَّ الإنسان – بوصفه إنسانًا – هو كائن دينيّ. فإذا كان الإنسان العادي لا يستطيع العيش إلَّا في عالم ذي معنى، فالإنسان المتديِّن على وجه الخصوص، هو الأكثر توقًا إلى العيش في محاريب القدسيِّ، أو إلى الهجرة نحوها بلا كلل. وما ذاك إلَّا لأنَّ هذا العالم المتسامي، الذي يستمدُّ جاذبيَّته من الغيب، هو بالنسبة إلى المتديِّن عالمه الواقعيٌّ والحقيقيّ، وهو الذي يمنحه الأمل بالآتي، وبالسعادة التي لم تأتِه بعد. ولأنَّه لا يجد نفسه إلَّا في محلٍّ ممتلئ بجلال المقدَّس، فقد شاء أن يفتتح سبيلًا إلى السكن في رحاب الألوهيَّة الفائضة بالُّلطف والأمان ولذَّة القرب. ذلك بأنه يرجو لنفسه مستقراً في المكان الأعلى طهرًا وتقدُّسًا. في السياق يلاحظ علماء اجتماع الأديان أنَّ تجربة الإحساس بالقداسة لدى الأفراد والجماعات تأسَّست على عدم انفصال الرُّموز لديهم عن الحقيقة التي تدلُّ عليها تلك الرموز. من أجل ذلك توفَّرت للرمز الدينيِّ القدرة على إدخال العابدين في مختبر القداسة.. ولم يكن من أحد على مرِّ التاريخ، يستطيع أن يُخبرَ عن كشوفات هذا المطرح المدهش بصورة مباشرة، الَّلهم إلَّا عدد بالغ الضآلة من الأفذاذ، لذا كان على الإنسان أن يدركها من خلال شيء آخر، من خلال إنسانٍ ما على سبيل المثال، أو عبر أرضٍ مقدَّسة، حيث يعدُّ المكان رمز القداسة الأولى وأكثرها انتشارًا. ويشير هؤلاء إلى أنَّ الطقوس التي يؤدّيها الناس في المكان المقدَّس، إنَّما هي صورة أخرى من صور محاكاة الألوهيَّة والدخول إلى عالم الوجود الأكمل. وهذه الصورة تكتسب أهميَّة أساسيَّة لفهم قداسة المزار أو أيِّ مدينة مقدَّسة، لأنَّه ينظر إليهما كنظير لأصل سماويٍّ؛ فإذا قام الإنسان بمحاكاة الصورة السماويَّة القديمة للمعبد فلربما استطاع أن يحيل المعبد بيتًا للربِّ هنا على الأرض. [كارين آرمسترونغ – القدس مدينة واحدة – نقلًا عن موقع قصة الإسلام- ص 30-31].
في الجغرافيا الثقافيَّة الدينيَّة لحداثة الغرب، كانت ثنائيَّة المقدَّس والدنيويِّ تُعرَّف بأنَّها السمة الأساسيَّة للأديان، وأنَّ «الأديان نسقٌ موحَّدٌ من المعتقدات والممارسات ذات الصلة بأشياء مقدَّسة أو بأشياءٍ حُرم أو محرَّمة». وإذا رجعنا إلى اللسان العربي سنجد أنَّ القداسة تعني الطهر والبركة، وإذا نسبت إلى الله فهي الكمال الإلهيُّ الكلّيُّ والتنزُّه عن الموجودات، والانفصال عن عالم الطبيعة والمادَّة. ومن هنا مقابلتها بالدنيويِّ والدهريِّ والفاني، فيقال إنَّ المقدَّس هو من الحرام الذي لا يمكن انتهاكه أو الخروج عليه، فالشيء المقدّس يكتسب قداسته من ارتباطه او صلته بمصدر القداسة، كما أنَّ درجة قداسته تتحدَّد بمدى القرب أو البعد عن المصدر القدسيّ. فالله هو المقدَّس الصمديُّ والمطلق، وهناك مقدَّسات نسبيَّة تكتسب قداستها من صلتها به وليس من ذاتها. ومن المفيد عند هذا الموضع، الإلفات إلى جملة دواعٍ تؤلِّف معًا خطوطًا هادية للتعرُّف إلى حقل التجربة الدينية: أولها، ما يفترضه المنشأ الجيو- حضاريِّ الغربيِّ الذي ولدت فيه.. ثانيها: نظريَّة المعرفة التي اعتُمدت من أجل مقاربة التديُّن كموضوع للبحث،.. ثالثها، الالتباسات الكثيفة التي ظلَّلت المفهوم، وما ترتَّب على تلك الأضلّة من سوء.. أمَّا رابعها، فمفاده أنَّ التجربة الدينيَّة غالبًا ما أُخِذت في مجتمعاتنا العلميَّة والثقافيَّة كمقولة معياريَّة محايدة، تمامًا كما يحصل في العادة من إسقاطات مفاهيميَّة في معرض الانشغال بفلسفة الدين أو بعلم اجتماع التديُّن. بناءً على هذا، لا تنفصل نظريَّات التجربة الدينيَّة عن حزمة المفاهيم التي اكتظَّ بها تاريخ الحداثة على مدى ستة قرون متَّصلة. فلاسفة الغرب الذي اشتغلوا عليها، لم يفارقوا فضاء النظر إلى الدين باعتباره ظاهرة «أرضانيَّة» منحكِمةً إلى ظروف المكان ومقتضيات الأوان. عند هؤلاء – كما سَلَفَت الإشارة – أن لا شيء يعوَّل عليه إلَّا ما ينالُه المنطق الوضعيُّ والعلوم التجريبيَّة بالإحاطة والفهم. من هذا النحو سنرى كيف انبسطت التجربة الدينيَّة على هَدْيِ تفكير يكتفي بمعاينتها وتنظيرها بما هي ظاهرة فرديَّة – أو جماعاتيَّة لا تُستقرأ إلَّا بمنهجية سوسيو- تاريخيَّة.
هذه الدربة من التفكير سوف تختزِلُ ميراث الحداثة كلَّه. وسنرى كيف أنَّ وقائعها الأولى سَرَتْ في تاريخ فلسفة الدين منذ الَّلحظة التي انقلب فيها “التنوير” على مسيحيَّة القرون الوسطى. وقتذاك طفق التنويريون يشتغلون على منفسح آخر من التفكير لن يكون النظر في أثنائه إلى الإيمان الدينيِّ غير تهيُّؤات نفسانيَّة لأفراد متفرِّقين. وهكذا جرى التعامل مع الدين واختباراته تبعًا لمعايير الأنسنة المطلقة الأمر الذي سيفضي إلى تنظير التجربة الدينيَّة بوصفها قضيَّة شخصيَّة متحوِّلة وغير مستقرَّة. وسيتبيَّن لنا كيف ستؤول مقولة التجربة الدينيَّة كمصطلح ومفهوم الى أصلها الذي جاءت منه. فلقد ألقى هذا الأصل بظلِّه الثقيل عليها ليُسقِطَ قِيَمَه ومعاييره الكبرى، وعلى الأخصِّ منها تاريخانيَّة الدين وفينومينولوجيَّته، وما نجم عن هذين المعيارين من نظريَّات معرفة لا تفسِّر الدين إلَّا بوصفه فعلًا افترضته الحاجة إلى الخلاص الشخصيِّ سواء لدى الأفراد أم ما يخصُّ العصب الدينيَّ للجماعات.
أول ما يطالعنا من تداعيات هذه المعضلة أنَّ التنظيرات التي دارت في رحاب فلسفة الدين، لم تفلح في فهم الماهيَّة «المابعد- تاريخيَّة» للدين، ولذا تعذَّر عليها إدراك جوهره المتعالي. وإذ استشعرت عجزها عن استكشاف ما تنطوي عليه المعارف الوحيانيَّة، فقد حرصت على معاملتها كقضيَّة خادمة للوضعانيَّة بأشكالها ومذاهبها كافَّة. من هذا المنظر على وجه الخصوص، لم تكن فكرة التجربة الدينيَّة لدى الحداثات المتتالية سوى ثمرة تأويليَّة لما تنطوي عليه الخبرة الدينيَّة للأفراد والجماعات. فالخبرة بناء على هذا التفكير، إمَّا أنَّها وُلدَت من تلقاء نفسها، أي بسبب ظروف نفسانيَّة- مجتمعيَّة معيّنة، وبذلك تكون فاقدة لبعدها الوحيانيِّ، وإمَّا أن يُرى إليها كظهور تاريخيٍّ لعادات وطقوس وأعراف ذات جذور أسطوريَّة أو اعتقادات وثنيَّة. وفي الحالتين تظلُّ النتيجة هي هي. فرغم إيلائها مكانة استثنائيَّة من البحث العلميِّ، ظلَّت التجارب والاختبارات الدينيَّة أسيرة الأحكام الكليَّة للعقل الوضعانيّ. من أظهر السمات التي نجمت عن دراسات التجربة الدينيَّة في الغرب، أنَّ هذه الأخيرة اتَّخذت سياقات متناقضة. فقد توسَّعت دائرة الاشتغال عليها إلى دوائر الهرمنيوطيقا والَّلاهوت. فرغم ما فعله التكيُّف المديد الذي أجرته الكاثوليكيَّة لصالح العلمنة، وكذلك ما فعله الإصلاح البروتستانتيُّ لجهة ما سُمّي بـ «الدين المدنيّ»، كان ثمَّة مطارحات جادَّة تنقض المقاربات العَلمانيَّة للدين. ولقد بدت الصورة على الوجه التالي: تلقاء الرؤية الوضعانيَّة التي ملأت الحقل المعرفيَّ الأوروبيَّ بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كان ثمَّة في الوسطين الفلسفيِّ والَّلاهوتيِّ من أقام التجربة الدينيَّة على وجهين متلازمين: وجهٌ متصلٌ بسوسيولوجيا الحياة وتحيُّزاتها الثقافيَّة والحضاريَّة، ووجهٌ منوطٌ بالتطلُّع إلى معرفة الخالق المعتني بالإنسان والكون. فالتجربة بما هي تجربة تحتمل الصواب والخطأ أنَّى كان الحقل الذي تقع فيه. ومن البيِّن أنَّ فلاسفة الدين الذين اتَّخذوا لأعمالهم نسقًا مغايرًا للظواهريَّة، خاضوا سجالًا لم ينتهِ ضدَّ الذين يزعمون أنَّ «الحقَّ» غير معروف، ويبتنون على هذا الزعم بأنَّ الحقَّ غير موجود. ولقد تبيَّن أنَّ هذه البيئة المفارقة لم تتعدَّ نطاقاتها المحدودة الأثر، ولم تستطع – وبسبب من محدوديَّة تأثيرها – أن تُحدث خرقًا في الجدار السميك للوضعانيَّة وسلطانها العنيد. ومهما يكن من أمر، ثمَّة من فلاسفة الَّلاهوت في الغرب من ميَّز بين نموذجين في ميدان التجربة الدينيَّة:
أولهما: النموذج الكوزمولوجيّ، وينسبه إلى توما الأكوينيِّ، الذي يرى أنَّ الله موجود «هناك»، ولا يكون الوصول إليه إلَّا بعد عمليَّة استدلال خطيرة، أمَّا العثور عليه فشبيه بلقاء شخص غريب.
ثانيهما: النموذج الأنطولوجيُّ، ومفادُه أنَّ الله بالأصل حاضرٌ لنا من حيث هو أساس وجودنا، ولكنَّه في الآن عينه مفارق لنا إلى حدٍّ لا متناهٍ، وأنَّ وجودنا المتناهي هو حلقة متَّصلة ومستمرَّة للوجود الَّلامتناهي؛ وبالتالي فإنَّ معرفة الله تعني التغلُّب على اغترابنا عن أصل وجودنا. العقل الطبيعي بطبيعته العائدة إلى أصل نشأته يستطيع أن ينتقل من الغربة الى الحضرة. ذلك بأنه يسلِّم بما يؤمن به حتى لو لم يكن ثمَّة كتاب مقدَّس. وما ذاك إلَّا لأنَّ البشر يجدون هذا المعتقد مكتوبًا في قلوبهم، ويعترفون به أنَّه قائم بالبرهان، حتى من دون رغبة منهم في ذلك.
حقل التعدُّديَّة الدينيَّة
كما هو الحال في التجربة الدينيَّة، كذلك هو في ما عُرِفَ بالتعدُّديَّة الدينيَّة. لقد أوضحت الاختبارات التنظيريَّة المتأخرة التي خاضها فيلسوف الدين البريطانيُّ جون هيغ(1922…) أنَّ أطروحة التعدُّديَّة الدينيَّة لم تكن خارج البيئة الفكريَّة المهيمنة على تفكير الغرب حيال الدين. فما أخرجه من تنظيراتٍ سيُدرج ضمن المسار الكلِّيِّ للعقلانيَّة الوضعانيَّة التي أنشأتها الحداثة، وحكمت على أساسها مناهج العلوم الإنسانيَّة كافَّة. ورغم التفسيرات المتعدِّدة والمتناقضة لأطروحاته، تبقى فكرة التعدُّديَّة الدينيَّة وليدة مناخٍ ثقافيٍّ وضعانيٍّ شديد الصرامة. ولهذا الدّاعي بدت الفكرة إيَّاها غير قادرة على الإحاطة أو التكيُّف مع ما هو مقدَّس أو فوق تاريخانيّ. ومع أنَّ الرجل زعم استظهار نظريَّته بمنهجيَّة التفكير المحايد، إلَّا أنَّ رؤيته للأمر القدسيِّ ظلَّت أسيرة حقلٍ معرفيٍّ أنثرو- فينومينولوجيٍّ ألقى بأعبائه على مجمل المعارف المتَّصلة بفلسفة الدين وعلم الاجتماع الدينيّ.
أخذ التيَّار التعدُّديُّ أخذ اليقين بما أسَّست له الحداثة من نظريَّات فلسفيَّة وسوسيولوجيَّة حيال الدين. سنجد أنَّ رائد هذا التيَّار، فضلًا عن أنَّه كان مسكونًا بنظريَّات فيورباخ الإقصائيَّة للجانب الوحيانيِّ للدين، كان من قبل ذلك مسحورًا بالنظريَّة الكانطيَّة في تقسيم الوجود إلى «نومين» (الشيء في ذاته حيث لا تبصره الأعين ولا تدركه الحواسّ)، و«فينومين» (الشيء كما يبدو لنا في الأعيان). ومثلما انصرف فلاسفة الحداثة إلى الإعراض عن الشيء في ذاته بذريعة استحالة إدراك ماهيَّته الذاتيَّة والبرهان عليه، جاءت النظريَّة التعدُّديَّة لتبني مجمل منظومتها على هذه الدربة، ثمَّ مضت إلى تقسيم الدين تبعًا لمنهج القطيعة بين بُعدَيه الوحيانيِّ والتاريخيِّ فيه.
كثيرون ممَّن تناولوا أطروحات هيغ وأتباعه بالنقد، ذهبوا إلى أنَّ فرضيَّاته ليست محايدة ولا تخلو من بواعث إيديولوجيَّة شاع أمرها تحت رعاية سلطة ثقافيَّة وضعانية منكرة للدين. ولأنَّ المبدأ المؤسِّس لهذه الأخيرة قام على التعدُّد الانفصاليِّ في بنية الوجود، فمن البديهيِّ أن تفضي الأطروحة في منزلتها الأنطولوجيَّة إلى القول بتعدُّد منازل الحقّ. حتى لقد بدت الصورة كما لو أنَّ لكلِّ دينٍ إلهَه المخصوص به. أمَّا الحجَّة التي يرفعها أصحاب هذه النظريَّة فهي متأتِّية أصلًا من تعريفهم لماهيَّة الدين، حيث اعتبروه إطارًا إيديولوجيًّا، أو طريقة لفهم الكون بطريقةٍ ملائمة للعيش فيه. وعلى زعمهم، أنَّ الديانات السائدة في العالم، إنْ هي إلَّا معبِّرات عن تنوُّع النماذج الإنسانيَّة وتعدُّدها، وعن أنماط التفكير والطبائع والتقاليد الثّقافيَّة والأشكال الفنيَّة والسياسيَّة والُّلغويَّة والاجتماعيَّة. أمَّا حاصل هذه الرؤية فهو صيرورة الأديان مظهريات وضعانية مناقضة للتوحيد وللحقيقة الإلهيَّة الواحدة. [محمود حيدر- التعدُّديَّة الدينيَّة كوريث لوثنيَّة الحداثة – فصلية الاستغراب – العدد 25- 2021].
ولبيان ما نقصد إليه، سنبيِّن الوجه الإيديولوجيَّ لأطروحة التعدُّديَّة الدينيَّة بمجموعة شواهد:
أوَّلًا: حين نظر أصحاب التعدُّديَّة إلى نظريَّتهم بوصف كونها الحقيقة الكلية الحاكمة على عالم الأديان، ثمَّ أقاموا حقيقتهم المدَّعاة فوق حقائق الأديان جميعًا…
ثانيًا: حين قدَّمت الأطروحة نفسها باعتبارها سلطةً معرفيَّةً تفرض الحقيقة، وتعبِّر بالتالي عن مركزيَّة الحضارة الغربيَّة وهيمنتها.
ثالثًا: لمَّا نظَّر أصحابها لفرادة نظريَّتهم باعتبارها إحدى أبرز ابتكارات الحداثة الغربيَّة في مجال الَّلاهوت الطبيعيِّ وفلسفة الدين.
رابعًا: لمَّا استخدم رائدها جون هيغ العموميَّات الَّلفظيَّة في صياغة أطروحته مثل «التاريخ المشترك»، و«المجتمع العالميّ»، و«الَّلاهوت العولميّ»، وسوى ذلك ممَّا يشير إلى الرَّغبة ببناء منظومةٍ كونيَّةٍ تجعل الثقافات الدينيَّة غير الغربيَّة موادَّ ثانويَّة وفضاءات حضاريَّة تابعة.
البيِّن أنَّ نظريَّة التعدُّديَّة الدينيَّة غير بريئةٍ من التّوظيف الإيديولوجيِّ في مشروع الحداثة، أمّا استعاداتها الراهنة من جانب نيوليبراليَّة ما بعد الحداثة فإنَّما هي استئنافٌ إيديولوجيٌّ يجري معه تحويل الأديان العالميَّة غير الغربيَّة إلى منفسحاتٍ وظائفيَّة تبغي إعادة تشكيل العالم الآخر على نشأة الهيمنة والاحتواء.
III
مغايَرة الفلسفة الدينيَّة لفلسفة الدين
اكتظَّت القرون الوسطى في الغرب بمحاولات شغوفة لتأسيس الفلسفة على قواعد لاهوتيَّة. كانت الغاية آنذاك احتواء القول الفلسفيِّ وتوظيف قواعده المنطقيَّة ومبانيه العقليَّة، حتى تتمكَّن المقالة الَّلاهوتيَّة من الاستحواذ على ديناميَّات الوعي وطرائق التفكير.
جمعٌ من علماء الَّلاهوت ممَّن جاوزوا الرؤية التاريخانيَّة الوضعايَّة للدين، لاحظوا هذه الصِلاتية العميقة بين الإيمان والعقل، إلَّا أنَّهم سيوضحون مسألة مهمَّة غالبًا ما تخلَّلها الَّلبس والغموض. فعلى الرغم من يقينهم بملازمة الإيمان للعقل في جميع أطواره، فقد لاحظوا أطوارًا فوق مرئية تمتنع فيها التجارب على التفسير العقليّ. أما السبب فيعود إلى تساميها فوق المفاهيم التي تنتمي إلى منحوتات العقل الأدنى. ذلك بأن سبب عجز الفهم البشريِّ عن وعي اختبارات الشأن القدسيِّ، هو أنَّ القوانين المنطقيَّة الحاكمة على مجال الفهم الإنسانيِّ لا استخدام لها في نطاق هذه الاختبارات.
سوى أنَّ فهم الاختبارات الروحيَّة – تبعًا للفلسفة الدينيَّة ذات الأفق الوحيانيّ- عائدٌ إلى أنَّ وعي الشأن القدسيِّ وإدراك أسراره يمكث في المنطقة العليا من الإيمان. لكنَّ هذه المنطقة الفائقة من الوعي ما كانت لتتشكَّل في وجدان الفيلسوف الإلهيِّ لولا عنايته بالوجهين العقلانيِّ وغير العقلانيِّ للدين. يدرك الفيلسوف الدينيُّ أنَّ المرء غالباً ما يؤمن بموضوع لا يستطيع أن يراه، لكنَّه يدرك في المقابل أنَّ للإيمان حضورًا في الحياة الواقعيَّة للأفراد والجماعات، كما يرتِّب عليهم أعمالًا ومسالك ومواقف تتوقَّف عليها مصائرهم في الحياة. لهذا، فإنَّ إيمان المؤمن بما يؤمن لا يمكن وصفه وتحديده عقلياً إلَّا في إطار ما هو مشترك مع الجماعة المؤمنة. فالإيمان ليس مجرَّد ظاهرةٍ تُماثلُ الظاهرات الطبيعيَّة الأخرى، وإنَّما هو الظاهرة المركزيَّة في حياة الإنسان الشخصيَّة الجليَّة والخفيَّة في الوقت نفسه. هو إمكانيَّة جوهريَّة للإنسان، ولذلك فوجوده ضروريٌّ وكليٌّ، وهو ممكن أيضًا في كلِّ زمان ومكان. ولأنَّ للإيمان أصلًا تكوينيًّا خلقيًّا في ماهيَّة الكائن الإنسانيّ، فلا يمكن إذّاك أن يضارعه العلم الحديث ولا عدميَّات الوضعانيَّة. أمَّا الذين يرفضون واقعيَّة الإيمان وحضوره الفعليَّ في حَيَوَاتِ المؤمنين، فإنَّما هم في الواقع يعبِّرون عن إيمانٍ ما، أو لنقَلُ عن اعتقاد معيَّن ولو كان هذا الاعتقاد متأتيًّا من أيديولوجيَّة إلحاديَّة، أو كان مرتبطًا بقضايا تنتسب إلى دنيا المحسوسات وعالم الأفكار المجرَّدة. ها هنا قد يصحُّ الكلام على وحدة فعليَّة بين الحقيقة الفلسفيَّة وحقيقة الإيمان. بيد أنَّ هذه الوحدة ليست مفتعلة، بل هي مقروءة وحاضرة بصورة فعليَّة في كلِّ نظام فلسفيّ. لهذا السبب تحظى مثل هذه الوحدة بين الحقيقتين بأهميَّة استثنائيَّة في عمل فيلسوف الدين، وكذلك في عمل المؤرِّخ وعالم الاجتماع على السواء. بل أكثر من ذلك، فإنَّ الفيلسوف الدينيَّ على وجه التخصيص سيرى إلى هذه الوحدة باعتبارها أصلًا ذا قيمة تكوينية في نظامه الميتافيزيقيّ.
هنالك إذًا، حقيقة إيمان في الحقيقة الفلسفيَّة، وحقيقة فلسفيَّة في حقيقة الإيمان. لكنَّ الإفصاح عن هذه المعادلة يفترض التعامل مع الحقيقة الفلسفيَّة من خلال المفاهيم وما تفضي إليه من دلالات.. كما يفترض التعاطي مع الحقيقة الإيمانيَّة من خلال التعبير الرمزيِّ عمَّا تختزنه من عناصر غير مرئيَّة. ولو كان من تأصيل أكثر عمقًا في هذا المنفسح، فلسوف نجد أنَّ ثمة فلسفة تسري بعمق في كلِّ رمز إيمانيّ. وفي الآن عينه، ليس بالضرورة أن يكون الإيمان عاملًا مقرِّرًا في توجيه حركة الفكر الفلسفيّ. الشيء نفسه يسري على الفلسفة التي لا تستطيع تحديد ماهيَّة الإيمان ومستوى حضوره في قلب المؤمن. وعليه، يمكن لرموز الإيمان أن تفتح عيني الفيلسوف على خواصّ في الكون التي لا يمكن له أن يتعرَّف عليها من دونها. غير أنَّ الإيمان لا يأمر باتِّباع فلسفة بعينها، وإن كانت الحركات الَّلاهوتيَّة استخدمت الفلسفات الأفلاطونيَّة أو الأرسطيَّة أو الكانطيَّة أو الهيوميَّة. والحاصل، أنَّ بالإمكان تطوير المضامين الفلسفيَّة لرموز الإيمان بطرقٍ متعدِّدة، لكن ليس لأيٍّ من حقيقة الإيمان وحقيقة الفلسفة أيُّ سلطة على الأخرى [تيلش- بواعث الإيمان- ص 108].
تستحثُّ جدليَّة الاتِّصال والانفصال بين الحقيقتين الدينيَّة والفلسفيَّة على البحث عن نظريَّة معرفة يستوي فيها الدينيُّ والفلسفيُّ معًا على نصاب التكافؤ والعطاء المتبادل. السؤال الذي يُطرح من تلقائه في هذا الخصوص هو في إمكان تحقُّق مثل هذا الاستواء. إلى القول أنَّ نظريَّة المعرفة الدينيَّة تفارق نظريَّة المعرفة الفلسفيَّة في ترجيح الإيمان على المعرفة. في حين أنَّ المعرفة الفلسفيَّة تشترط اليقين بالاستدلال العقليِّ والتجربة الحسّيَّة. لكن، لا بدَّ من التذكير بأنَّ الإيمان بما هو إيمان هو معرفة كامنة في المشاعر وإن لم يفصح عنها صاحبُها بالكلمات. هذا يعني أنَّ المعرفة الاكتسابيَّة التي ينتجها العقل الاستدلاليُّ يستحيل أن تصبح علَّة تامَّة للإيمان. بيان الأمر أنَّ الإيمان يتأبَّى على المفاهيم ويعمل خارج قيودها المنطقيَّة. قد لا يؤمن الإنسان رغم حصوله على المعرفة، وقد يؤمن ويبلغ إيمانه درجة عالية من سكينة الفؤاد وانشراح الصدر من دون أن يحوز على معرفة مكتسبة. فالإيمانُ معرفة صدريَّة فؤاديَّة تنتمي إلى ما نسمّيه “اليقين الرضيِّ”. ولأنَّه بهذه المنزلة، فلا يشترط عليه بالضرورة أن يكون تحقُّقه مشروطًا بتحقُّق المعرفة المنطقية الصوريَّة. مع أن هذه الأخيرة تبقى تمثِّل شرطًا لازمًا لتحقُّق الإيمان المتلازم مع اليقين العقلي. بعبارة محدَّدة، يمكن القول أنَّ المعرفة هي الشرط الَّلازم للإيمان ولكنَّها ليست شرطًا كافيًا؛ ذلك لأنَّ الإيمان خبرة عمليَّة تقوم على الإرادة والاختيار. والدليل، أنَّ كثيرين من الذين عرفوا أصول الدين ومقاصده النظريَّة لم يؤمنوا، أو أنَّهم لم يفلحوا بالإيمان ولو سعوا إليه أو رغبوا فيه. وهذا عائد إلى أنَّ معرفتهم بالدين وقفت عند تخوم التحصيل وجدران المفاهيم، إلا أنها لم تتحوَّل إلى واقعة شعوريَّة إحساسيَّة تصل بصاحبها إلى علمٍ حضوري ويقين راسخ. في هذه الحال لا يعود للاعتقاد حاجة إلى المعرفة الاكتسابيَّة إلَّا إذا شاء المرء أن يرقى بإيمانه إلى الحدِّ الذي تصير فيه معرفته علَّة تامَّة لإيمانه. فإذا صارت المعرفة علَّة تامة للإيمان، نكون قد انتقلنا إلى طور أرقى جاز أن يُطلق عليه المعرفة في مقام الرحمانيَّة. تأسيسًا على هذا الفهم يصير الإيمان معرفة عليا بالوجود، وإن لم تُعرب عن نفسها بالعبارات والمفاهيم. فهو الطاقة الوحيدة التي تستطيع الإحاطة معرفيًّا بالحقائق الإلهيَّة، ذلك أنَّها على خلاف محدوديَّة الإدراكات الطبيعيَّة الموقوفة على مقولات العقل الأدنى ومفاهيمه. فالإيمان نظير الاستبصار الداخليِّ الذي يسدِّده الروح القدس، ويفضي إلى انشراح الصدر وسكينة الفؤاد، وتلك تعبيرات تفوق قدرات العقل القياسيِّ، رغم أنَّها مخبوءة فيه.
في طور كهذا من الفهم، سنكون مع فيلسوف دينيٍّ حوى من المعارف ما يتعدَّى حصريَّة ما وقفت الفلسفة الأولى. فمن أخصِّ سماته تأبِّيه على الانحصار في أحاديَّة المنهج. من أجل ذلك، نراه جامعًا إلى العلوم الإلهيَّة والمعارف الدينيَّة، الفلسفة وعلم الأخلاق وعلم الكلام، ناهيك بالعرفان بجناحيه النظريِّ والمسلكيّ. غير أنَّ منجزه المعرفيَّ على تنوُّعِه وتعدُّد منفسحاته يظلُّ موصولًا برباط وطيد بعلم الوحي كمبدأ مؤسِّسٍ وراعٍ للحقول جميعًا. وتلك خاصِّيَّة ذات أثر بيِّن في نظم نَسَقِه الميتافيزيقيّ. لذا يؤثِرُ الفيلسوف الدينيُّ التعرُّف على حكمة الوجود بآفاقها ودروبها المتعدِّدة، فلا يكتفي مثلًا بما جاء به العقل القياسيِّ من قواعد البرهان ومبادئ الاستدلال، بل يتطلَّع إلى طور أعلى من التعقُّل تنطلق فيه إمكانات العقل نحو فتوحات لا قِبَل له بها. ثمَّ إنَّه على ريب مقيم من ذكاء العقل القياسيِّ لجهة ادِّعائه الإحاطة بماهيَّة الموجودات. فهو ينظر ببصيرة المتدبِّر لفهم الموجود كما هو في ذاته. يفعل ذلك خلافًا للذين أعرضوا عن المبدأ، فما بلغوا فهم الشيء في ذاته، ولا أدركوا علم البَدء، ولا انتهى بهم علمُهم إلى إدراك ما وراء الحواسِّ ومقولاتها العشر. وسيظهر له أنَّ الفكر المستغرقَ في الأعراضِ العارضِة لا يقوى على إبرام ميثاق مع الأصل. وما دام العقلُ مفصولًا عن جاعله، نائيًا منه، لن يتيسَّر له أن يمسَّ الحقيقة الخافية أو أن يُقِرَّ لها بالحضور. ثمَّ له أن يعلم أنَّ السؤال الساكنَ في العالم الفاني لا يقدر أن يطلبَ الإجابةَ من عالَمٍ لا يدنو منه الفناءُ قيدَ لمحة. فالذي حالُه الفناء، لن يفلح في التعرُّف على الذي شأنُه الحياة والديمومة.
IV
إله فلسفة الدين والله الموحي في الفلسفة الدينيَّة
تلحظ الميتافيزيقا البَعدية مائزًا جوهريًّا بين إله الفلسفة والله الموحي كما يعبّر عنه في الدين. من ذلك، سيعكف الآخذ بدربتها على التفريق بعمق بين وثنيَّة “الُّلوغوس” والتوحيد الوحيانيّ. ومن هذه المنزلة بالذات، تبتدئ إرهاصات هجرة عقليَّة مشرَّعة الآفاق ستحمله على الإنتقال من ضيق الفلسفة كعقلٍ أدنى إلى سِعة الوحي. كمعرفة عليا. بعبارة أبيَن: يصبح قادرًا على التمييز بين توحيد الله وتوحيد الوجود المخلوق كنتيجة لتوحيد الله وتنزيهه عن الخلق. وذلك من أخصِّ المسائل التي تواجه الحكم الإلهي في مساعيه لحلِّ أعقد المعضلات الوجوديَّة وأكثرها دقَّة في المعارف الإلهيَّة. نعني بذلك التمييز بين الله الخالق المدبِّر، والمخلوق المعتنىَ به من خالِقِه والخاضع لقوانينه وسُنَنِهِ. فما دام اشتغال الفكر يدور مدار فضاءٍ ميتافيزيقيٍّ مسكونٍ بطغيان المفاهيم، ومحكومٍ لمقتضياتها المنطقيَّة، سيتعذَّر الوصول إلى حقيقة التوحيد. لهذا، يتنبَّه الحكم بما هو فيلسوف ديني إلى هذه الفاصلة الدقيقة من المعرفة، ليوضح أنَّ الله ليس مقولة من مقولات الفلسفة، ولا مفهومًا كسائر المفاهيم. ثمَّ إنَّ إحاطته بحكاية الفلسفة بيَّنت له حقيقة أنَّ الإغريق استغرقوا بلعبة المفاهيم حتى صار كلُّ قول في الإله مجرَّد تصوُّر محض من تصوُّرات الذِّهن البشريّ. ومع أنه يقطع مسافات موصوفة في مباحث الاستدلال، ويأخذ بما تمليه مقتضيات العقل النظريِّ ومبادئ المنطق من أجل التعرُّف على الكون، فقد شاء ذلك كوساطة ضروريَّة لفهم الإخبار الإلهيِّ عن سببيَّة وجود الموجودات. لأجل هذا تنأى الميتافيزيقا البَعديَّة، بما هي فلسفة دينيَّة، من التعقيد لتتَّخذ من البساطة دربة لها ومنهجًا.
تلقاءَ ذلك، ثمَّة من العلماء من يجتهد ليقترح بناء شبكة معرفيَّة على أساس العقل الفلسفيِّ قبل الوصول إلى مُسلَّمة الوحي. ويذهب إلى الاعتقاد بأنَّ كلَّ تحليل أو تفسير للوحي يجب أن يقوم على أساسٍ من هذه المنظومة المعرفيَّة بشكل مستقلّ. وخلاصة ما يتوصَّل إليه هؤلاء أنَّ العقل والفسفة متماهيان ومستقلَّان عن الوحي، وهما حاكمان بالمطلق على مطلق الوحي. وأنَّ مساحة الإدراكات العقليَّة ليست محدودة بحدٍّ، فهي تشمل جميع أسُس المعرفة الدينيَّة، وإنَّما تحتاج إلى الرجوع إلى الوحي في تفاصيل الأحكام فحسب، وعلى هذا الأساس، فإنَّ أسُس الدين تكون قابلة للإدراك بوساطة العقل الفلسفيّ. والنتيجة هي أنَّ العقل في ضوء بعض المقدِّمات حاكمٌ على المعرفة الدينيَّة، ومتقدِّمٌ عليها. بل مضى إلى أبعد من ذلك ليقول بنظريَّة بـ “كفاية العقل” باعتبارها الأصل الذي ينبغي أن يعتمدها الرَّاسخون في العلم.
مع ذلك، فإنَّ غاية ما يتطلَّع إليه “المابَعد” في فلسفة الدين، هي تظهير ميتافيزيقا متطلِّعة إلى التعرُّف على حقائق الوجود بالاستناد إلى مبادئ العقل ومسلَّمات الوحي. وليس من ريبٍ في أنَّ ما يُسمَّى أنواع البديهيَّات الستِّ ما خلا الفطريَّات – أي الأوليَّات والمشاهدات والتجريبيَّات والحدسيَّات والمتواترات – كلّها تُبنى على القياس. أمَّا الفطريَّات فهي قضايا قياساتها معها، في حين أنَّ الحدسيَّات والتجريبيَّات تستبطن قياسًا مخفيًّا فيها. ومع أنَّ جميع هذه القضايا تُعدُّ من البديهيَّات، ويمكن اعتبارها جميعًا أساسًا لمعرفة سائر القضايا، إلَّا أنَّ مجموعتين منها – في الحقيقة – لا تستند إلى دليل آخر؛ وهي الأوليَّات والمشاهدات. فالأوليَّات تنفرد بكونها الأساس الوحيد للفلسفة. وسيكون من البيّن أن بإمكان الفلسفة أن تصل بفضل الشهود إلى فوائد عديدة، خصوصًا أنَّ الفلسفة الأولى تبتني على أساسين هما: العقل والشهود.
[يد الله يزدن بناه- تأمُّلات في فلسفة الفلسفة الإسلاميَّة – ترجمة: أحمد وهبة – مراجعة: محمد الربيعي- دار المعارف الحِكْميَّة – بيروت – 2021- ص 135].
ومن خلال مواصلة عمليَّة الاستعانة بالقضايا اليقينيَّة في القياس نستطيع الوصول إلى نتائج يقينيَّة أخرى. وهذا الطريق شائع ومعروف في النشاط الفلسفيِّ العامّ. لكن إلى جانب هذا الطريق يمكن الاستفادة من “الشهود” أيضًا في تجديد وتطوير القول الفلسفيّ. من أجل ذلك يذهب علماء الإلهيَّات المعاصرون إلى أنَّ الشهود لا ينحصر بالشهود الحسّيِّ، سواء الحسّ الظاهر أم الحسّ الباطن، بل ثمَّة “الشهود العقليُّ” وفوقه الشهود القلبيُّ أيضًا. والجدير بالالتفات أنَّ “الشهود القلبيّ”، يُطلق على كلِّ شهودٍ يرتفع فوق حدود العقل. هنا، يمكن الإشارة إلى ثلاثة أنواع من الشهود هي: الحسّيّ، والعقليّ، والقلبيّ. وبقبول هذه النقطة ينفتح الباب أمام دخول الشهود إلى عالم الفلسفة وبيان حجِّيَّته وقيمته المعرفيَّة.
V
الميتافيزيقا البَعديَّة من حيث أنَّها فلسفة دينيَّة
تريد أطروحة «ما بعد فلسفة الدين»، الإلفات إلى أنَّ الفلسفة – بما هي بالأصل سؤال وجود وموجود وما وراء الكون الظاهر- يمكن أن تنال حظَّها من علم الوحي لو هي توفَّرت على شروط الارتقاء إلى ميتافيزيقا ناظرة بالخلق الأول ومتبصِّرة فيه. فالمعرفة التي سدَّدها الإيمان، واستتبَّ شأنُها به، لا تقطع الصِّلة بعالم المفاهيم، بل هي تتوسَّط هذا العالم (من واسطة) بغية الوصول إلى المعرفة العالية بالمبدأ. ما كان للمفاهيم لها أن تولد إلَّا لأنَّ العقل المدرِك استخرجها من عوالم الإمكان والواقع التي هي محل عناية التدبير الإلهيّ. في مقام إدراك كهذا، قد يُفتح للمعرفة المسددة بالإيمان أن ترى بوعي المتدبِّر تاريخيَّة الدين ووحيانيَّته سواءً بسواء. لذا جاء تسييل هذا الطور من الميتافيزيقا قصد تصويب خللٍ تكوينيٍّ غَشِيَ الفلسفةَ الأولى، ثمَّ سرى من بعدها إلى سائر الفلسفات الَّلاحقة. ولأنَّ التصويب الذي نحسبه ليس مجرَّد إصلاح لخللٍ أنطولوجيٍّ عارضٍ، فإنَّه في مهمَّته الجوهريَّة فعلٌ معرفيٌّ عزيزٌ له صلة وطيدة بالغاية الأصليَّة للفلسفة. الأمر الذي يفترض فحصًا استرجاعيًّا لمجمل الاختلالات التي عصفت بالهيكل الأنطولوجيِّ للوعي الفلسفي على امتداد عشرات القرون. نرانا هنا، بإزاء فهم مخصوصٍ لفكرة «المابعد» جَاَزَ أن نقدِّمها بـ «المعرفة البَعديَّة الفائقة». من سمات هذه المعرفة – ذات الصفة المتفوِّقة- تساميها على مفاهيم الَّلحظة العابرة، وتراحمها في الوقت نفسه مع هذه المفاهيم تبعًا لشروط ظهورها وظروف إقامتها في ساحة المعرفة. ولكونها «بَعديَّة» ساعية إلى إنبات زرعٍ جديد في أرض الميتافيزيقا، فإنَّها لا تكتفي بالسؤال حين تسأل، وإذا أجابت أتى جوابها على غير عَجَلة، ولو طلبت المعرفة كانت على دراية من أنَّ الأشياء والأفكار تُعرف بأضدادها. وفوق ذلك، انها «بَعديَّة» مدرِكة أنَّ السير باتِّجاه مستحدثٍ معرفيٍّ مجاوزٍ لفلسفة الدين بصيغتها الحداثية هو سيرٌ غير موقوف على النقد وبيان العيوب وحسب، بل هو أيضًا حفرٌ معرفيٌّ يقوِّضُ ما تراكم من أعطال كانت سببًا في تشيُّوء الفكر الفلسفيِّ. من أجل ذلك، تأبى البعديَّة الفائقة مفارقة مفاهيم العقل الأدنى ومقولاته، بل تحتويها لتغدو مرتبة فهم دنيا ضمن هرمها المتعدِّد المراتب. مع السياق الانتقاديُّ التقويضيُّ ذاك، وبالتلازم معه، تشقُ العمليَّة المعرفيَّة سبيلها نحو رؤية توحيديَّة جامعة بين الغيب والواقع. ما يومئ إلى ولادة دربة مستحدثة للتفكير لا تُدركُ آليَّات عملها إلَّا بمنهج جاوز المألوف وقام على لقاء الأضداد وتناغمها. لكن هو كيف للفاعل الفلسفيِّ والناظر الدينيِّ أن يستويا على أرض واحدة ونصاب مشترك؟
نحن إذًا، في محضرٍ من الضدِّيَّة الخلَّاقة التي سيكون بإمكانها المؤالفة بين الفاعل والناظر بوصف كونهما ضدِّيَّة تكامل وانسجام لا ضدِّيَّة نزاع وتناقض. فقد يطلق على الشيء أنَّه ضدُّ شيءٍ إذا كان مباينًا له، أمَّا التناقض فيدلُّ على أنَّ الشيء لا يمكن أن يكون حقًّا وباطلًا في الحال نفسه. وقد تتعدَّد أضداد الشيء إلَّا أنَّ نقيضه يبقى واحدًا. أما الضدَّانيَّة بصيغتها الخلَّاقة فهي أقرب حالًا إلى زوجيَّة المثنَّى التي لا تقبل الانفصال. تلك الزوجيَّة التي يعمل كلُّ شيء فيها وفقًا لقانون التكامل والوحدة. وبهذا المعنى تصبح الضدَّانيَّة بما هي «زوجيَّة المثنَّى»، عروة وثقى توصلُ ظواهر تبدو للعيان أنَّها منفصلة، إلَّا أنَّها -على الحقيقة- موصولة بين طرفيها بحبل متين. لذا سنرى لاحقًا كيف يتماهى منطق الميتافيزيقا البَعديَّة في التعامل مع المتناقضات والضدِّيَّات، مع ما نجده في إخبارات الوحي، وهذا المنطق إذا أخذ على ظاهره سوف يتبدَّى للناظر على غير انسجام مع القوانين والقوالب المتداولة في التفكير، بل وينقض قواعد المنطق التقليديِّ بشكل صريح.
ولمَّا أن كان همُّ الحكمة معرفة المبدأ، والتعرُّف إلى العلل الأولى ومساءلتها عن موجِبِها الأول، كان السؤال المتأتِّي من حَيْرتها العظمى بحقيقة الوجود هو أوجَبَ واجباتها لمعرفة الوجود الأشرف. من أجل ذلك، وبناءً على مقتضيات المعرفة المبدئيَّة يتَّخذ الفيلسوف الدينيُّ دربة منهاجيَّة مركّبة على طيف من المقتضيات:
المقتضى الأوَّل: أنَّ الفلسفة ضرورة، كوساطة إدراك عقليَّة لفهم ظواهر الوجود، وما انبسطت عليه من سُنَنٍ وقوانين. إلَّا أنَّها في الآن عينه علمٌ وسائطيٌّ يترصَّد الوجود بالاستدلال والبرهان.
المقتضى الثَّاني: الوحي – بوصف كونه أساسًا للمعرفة «المابعديَّة»- يأتينا بالخبر اليقين.
المقتضى الثَّالث: الطريق إلى معرفة المبدأ والمآل، هو سيرورة مركَّبة يتضافر فيها العقل والوحي والفطرة، لينتج السير في هذا الطريق علمًا حضوريًّا مسدَّدًا بالكشف والشهود.
المقتضى الرَّابع: الوحي تمامُ العقل ونقيض الجاهليَّة، والدين الخاتم هو ثمرة الحكمة البالغة وبيانها الجَليِّ. وبناءً عليه، يصير التعرُّف على هذه الحقيقة وسيرورتها في تاريخ الإنسان، مبتدأ كمال العقل وصيرورة الإنسان الكامل.
ولتوسيع مساحة النظر في الميتافيزيقا البَعديَّة نقول إنَّها فلسفة دينيَّة تتعالى عن تشييء الدين، وترى إلى الشأن الدينيِّ كحقيقة أصيلة في الواقع التاريخيّ. فإذا كانت فلسفة الدين قد عيَّنت غايتها بالنظر إلى الدين كظاهرة أنثروبولوجيَّة، فإنَّ الفلسفة الدينيَّة تنظر إلى الدين لا مجرَّد حضور في الزمان والمكان وحسب، وإنَّما أيضًا كحضور حيٍّ في المجالين العينيِّ والغيبيِّ، ومثل هذا النظر لا يدلُّ على تناقض واستحالة، بقدر ما يحيل إلى فهم يفارق الفيزيائيَّة الصلبة للفلسفة الباحثة عن الموجود بما هو موجود. بمعنى أنَّ الفلسفة الدينيَّة كميتافيزيقا بَعديَّة لا تجد حرجًا من الأخذ بنظريَّة معرفة تقوم على الإقرار بالصِّلة الذاتيَّة بين البادي للعيان من الموجودات، والحقيقة الكامنة وراء هذا البادي. بذلك يكون العلم بالدين فلسفيًّا لدى الميتافيزيقا البَعديَّة هو دراسة الوجود بتناهيه ولا تناهيه انطلاقًا من مدارك العقل ومباني الوحي بمراتبهما المتعدِّدة.
استنادًا إلى المسائل المذكورة، يصير بإمكان الفيلسوف الدينيِّ حيازة وعيٍ إشرافيٍّ يمكِّنُه من تظهير هندسة معرفيَّة توحيديَّة لعِلمَيْ الواقع والغيب بوصفهما علمًا واحدًا. ولأجل هذا المقصد يروح الفيلسوف التوحيدي يتَّخذ منهجًا يتَّسع لمنازل المعرفة ودروبها ويعمل بحسبها وفق سعتها ومقاديرها. لذا تبدو الفلسفة في مساعيه كما لو أنَّها عقلٌ ناشطٌ اتَّخذ حَبْوتِهِ الأولى إلى الحقيقة. مع ذلك، فهو لا ينظر إلى الميتافيزيقا على أنَّها مجرَّد سؤال واستفهام، وإنَّما في كونها إمكانًا رحبًا لتحصيل اليقين. كذلك لا يرى إلى الفلسفة على نحو ما استألفه النُّظَّار وآنسوا إليه، من حيث أنَّها استعادة شارحة للمنجز اليونانيّ. على أساس هذا سوف يسلك دربًا يخشاه العقل الحسابيُّ، لأنَّه مسلك يوجب الشجاعة للإتيان بما هو غير اعتياديٍّ وهو يخوض لجّة المعرفة. ما يعني أن الوعي الفائق بالفائق من الوجود لزومه شجاعة الفاعل في تبديد الأوثان المهيمنة على عالم الأفكار. فإذا كانت الفلسفة الأولى قد أسَّست للانشطار المعرفيِّ لمّا ألْزَمت نفسها بالتوقُّف عند تخوم الاستفهام القلق عن الوجود بذاته والموجود بغيره، فقد تتَّخذ الميتافيزيقا البَعديَّة مسارها المفارق من أجل تشكيل نظامها المعرفيّ الخاصّ. فلو كان لنا أن نجد نعتًا مناسبًا لهذا النظام الخاصِّ، لأقمناه تحت عنوان مجمل هو “الميتافيزيقا البَعديَّة”. والمُراد من مصطلح كهذا هو تبيين مقصده الأقصى لجهة الانتقال بالعقل إلى الضفَّة الأخرى من نهر الوجود حتى يقف على سرِّه المضمر والانفتاح على آفاقه الَّلامتناهية. فإنَّ ما ستفعله الميتافيزيقا البعدية، انها تفتتحُ سبيلًا انعطافيًّا يحرّر القول الفلسفي من دنيا المقولات وصرامتها، ليعرج به إلى آفاق الميتافيزيقا وعوالمها الرحبة.
وفق هذه السيريَّة الجوهريَّة من الواحديَّة بين العقليِّ والشهوديِّ تنهض المعادلة التالية: “المعرفة الوحيانيَّة” تقع على خطٍّ امتداديٍّ صاعد من “المعرفة العقليَّة”. وإذا اتّفق أنَّ هذه الأخيرة، أي “المعرفة العقليَّة”، تتعامل مع الاستدلال والمفاهيم والتصوُّرات والألفاظ، فإنَّ المعرفة في أفقها “المابعديِّ” مبنيَّة على الكشف والشهود وعلم الفطرة. على هذا الأساس تصبح “الفلسفة”- وهي العلم الذي تتمُّ دراسته بواسطة النظام العقليّ – على أفق مشترك مع الميتافيزيقا البَعديَّة بوصفها فلسفة حاضنة للوحي والعقل معًا. صحيح أنَّ مهمَّة الفلسفة معرفة الحقائق، لكن الأداة التي تستخدمها لهذا الغرض وتثبت بها مسائلها، هي “العقل” و”المفاهيم الذهنيَّة”. ولهذا يُتوقَّع فقط من العقل والفلسفة إثبات وجود الله تعالى، في حين يستحيل أنَّ نتوقَّع منهما إيصالنا إلى معرفة ذات الله. ذلك أنَّنا بالعقل والفلسفة يمكننا معرفة الله، إلَّا أنَّهما بعد ذلك، لا يوفِّران لنا رؤيته والحضور في ساحته المقدَّسة؛ وهذا طورٌ من التصعيد تصل فيه همَّة التفلسف إلى القبول الرضيِّ بما توفِّره الميتافيزيقا البَعديَّة من طرائق تفضي إلى التحرُّر من أسر المفاهيم، وصولًا إلى ما يمكن أن تكتسبه من نعوت غير معهودة في مقام كونها العلم الذي يُتعرَّفُ فيه على الفائق والمتعالي في الوجود. صحيح أنَّ طريق الفلسفة يختلف عن طريق الميتافيزيقا البَعديَّة وماهيَّتها، إلَّا أنَّهما يستطيعان معًا وبالرضى المشترك أن يملآ منطقة فراغ ميتافيزيقيَّة أخفقت الفلسفة الكلاسيكيَّة في ملئها على مدى أحقاب طويلة.
[1]*– رئيس التحرير.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.