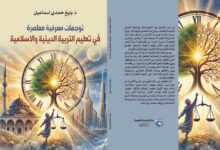موجز تطوّر فن الخطابة: من الإدانة الأفلاطونيَّة إلى البلاغة الجديدة لبيرلمان

مقدمة
إذا كان من المخجل ألا يتمكن الإنسان من الدفاع عن نفسه بالقوة العضلية. فإنه من العبث ألا يتمكن من الدفاع عن نفسه بالكلمة، إذ بها، لا بالقوة العضلية، يتميز الإنسان[1]. إن هذه الكلمة هي ما جعلت الإنسان يتميز عن سائر الكائنات الأخرى، بل جلت له السيادة داخل العالم. إن الكلمة أي اللغة الطبيعية، تعد أعظم ابتكار بشري وكانت بمثابة العش الذي نشأت فيه الابتكارات اللاحقة. إنها، أي اللغة، بمثابة السلاح آو الأداة الفعالة لتحكم في الكائنات ولامتلاك الوجود.
إن صفة التحكم أو التأثير التي تخولها اللغة للإنسان ليست مقتصرة على الكائنات الأخرى فقط، بل تمتد لتشمل التأثير على الإنسان الأخر أيضا. إن محاولة التأثير في الإنسان من خلال اللغة هو ما يدعى بالحجاج.
يلاحظ أن الحجاج، كما يعبر عنه ذ.محمد الولي: “…هو توجيه الخطاب إلى متلق ما لأجل تعديل رأيه أو سلوكه أو هما معا. وهو لا يقوم إلا بالكلام المتآلف من معجم اللغة الطبيعية”[2].
إن التأثير على آراء الآخرين ودفعهم لتغيير سلوكهم، يلزم الإنسان من استخدام كل الأدوات والوسائل المتاحة له لتعزيز فعالية خطابه في علاقاته مع الآخرين. ومن المؤكد أن
مجال الحجاج يرتبط بمجال المحتمل، أي انه ــ الحجاج ــ يتدخل في كل المجالات التي تستدعي اختيار شيء ما من بين خيارات متعددة؛ أي تبني فكرة دون الأخرى. إذا فهو يرتبط بكل ما يتعلق بالإنسان في مختلف جوانب الإقناع والتأثير، إن من يمتلك الحجاج يمتلك السلطة، والشرط الأساسي لامتلاك هذه السلطة هو إتقان شفرة القول أو اللغة، باعتبارها الأداة التي من خلالها يمكن للإنسان الدفاع عن نفسه وعن الآخرين، والتأثير فيهم.
إن الحجاج يشغل مكانة مركزية في مختلف نظريات الخطابة، وقد أصبح بُعدًا أساسيًا في الخطاب الإنساني. حاول العديد من الباحثين تناول هذا المفهوم من وجهات نظرهم المختلفة، مما ساهم في جعله في حالة دائمة من التجدد والتطور. ومن بين هؤلاء الباحثين الذين تركوا بصمة واضحة في مجال الحجاج، برلمان وتيتيكا، من خلال كتابهما مصنف في الحجاج: الخطابة الجديدة.”Traité de l’argumentation: La nouvelle rhétorique”، الذي أحدث ثورة كبيرة في البلاغة الحديثة. في هذا السياق، سنحاول من خلال هذه المقالة الوقوف على إشكال جوهري نصوغه كالتالي: ما هي الممهدات اليونانية لخطابة شاييم بيرلمان؟ وما هي مساهماته في هذا المجال (الخطابة)؟
إن الحديث عن الخطابة والحجاج هو حديث يتعلق أساسا باللغة في حالة فعل، أي أن نتكلم لأجل أن نختار شيء ما من بين الاختيارات التي تكون معروضة أمامنا، واختيار شيء واحد يقتضي القيام بعملية حجاجية، إما مع الذات أو مع المتلقي. إذا الأمر يتعلق بالأمور التي ينبغي أن تحدث. أي أن الأمر يتعلق بالمجالات الاحتمالية لا العلوم الدقيقة التي لا احتمال فيها. لكن قبل الغوص في كل هده التعقيدات، تجدر الإشارة إلى شروط انبثاق مفهوم الخطابة، وهي شروط اجتماعية، سياسية وقانونية.
إن الجذور الأولى للخطابة، يمكن إرجاعها إلى صقلية اليونانية، حيث يعد كوراكس وتلميذه تيزياس من أوائل من وضعوا أسس فن الخطابة. في القرن الخامس ق.م شهدت صقلية تحولات سياسية بعد الإطاحة بالطغاة، “فالمواطنون الذين نهبهم الطغاة، طالبوا بثرواتهم، ثم أعقبت الحرب المدنية العديد من النزاعات القضائية. وقد وجب في عصر حيث لا يوجد محامون أن يمنح المترافعون وسيلة الدفاع عن قضيتهم. وقد نشر كوراكس تلميذ الفيلسوف أنبادوقليس، وتلميذه الخاص، تيزياس، فنا خطيبا، هو جمع من التعاليم العملية، مرفق بأمثلة، مخصصا للمتقاضين وقد أعطى كوراكس الخطابة أيضاً أول تعريف لما هو قال: إنها صانعة مقانعة”[3] .
ونظرًا للعلاقات الوثيقة بين أثينا وصقلية، سواء على الصعيد التجاري أو السياسي، بالإضافة إلى القضايا المشتركة بينهما، تبنت أثينا بسرعة فن الخطابة. وأصبح لها مجال أوسع، يتعلق بعملية التحكم في الناس وغلبتهم والسيطرة عليهم بالكلام في إطار الحاضرة، وهذا تجلى بالتحديد في تجربة السفسطائيين. كان هؤلاء في الأصل معلمي الخطابة، فبالإضافة إلى الدفاع عن الناس في المحاكم، كانوا يعلمون هذا الفن للراغبين في ذلك مقابل أجر، حتى أن كبار السفسطائيين كانوا يتقاضون أجورا كبيرة مقابل جهدهم[4].
لقد تميزت اليونان بكونها منبع توثيق مؤلفات فن الخطابة، كما أنها شكلت نموذج فريد في تاريخ البشرية، وهذا يتجلى في نظامها الديمقراطي الذي قام على حرية ممارسة الخطابة، مما أتاح لجميع المواطنين حق المشاركة في النقاشات العامة. في هذا السياق يمكن القول أن هذه الحرية الخطابية في المجال السياسي هي ما ألهبت مشاعر الغضب عند سقراط وأفلاطون.
أفلاطون
إن التحول التاريخي والثقافي الذي شهده الفكر اليوناني، في انتقاله من الأسطورة إلى اللوغوس، ساهم في ازدهار أنماط تفكير مثل المنطق الصوري والجدل والخطابة، كانت الفلسفة في هذا السياق هي التأمل العقلي الحر والمستقل عن صخب الجمهور ومعتقدات العامة، تماما عكس الخطابة. هذا ما جعل من الفلسفة والخطابة تتنافسان على السيطرة في مجال قيادة الشعب وتدبير شؤون الحاضرة.
وفي صدد القول أن أفلاطون يعد من اشد أنصار الفلسفة التأملية، واحد ابرز المهتمين بتدبير شؤون الحياة السياسية. فقد كان يكن العداوة للخطابة باعتبارها تقوم على الرأي والأهواء وليس على الحقيقة، في حين انه اعتبر أن الانخراط في السياسة يتطلب إحكام تسييج المؤسسة السياسية ضد تأثير المشاركة العامة.
ومن هذا المنطلق، بلور أرسطو عقيدته التي تشترط أن يكون الملك فيلسوفا منفصلا عن أراء العامة ليحكم بعقلانية تأملية[5]، وغير هذا يجب إبعاده عن الحاضرة وخاصة الخطابة التي كان يرى أنها تستخدم استخدامات سيئة وخطيرة، وتبرز خطورتها في أن الخطيب يمكن أن يتكلم في كل شيء، بل ويمكن أن يكون أكثر إقناعا من أي متخصص في مجال ما (مثال الطبيب)، فقط لأنه يعرف كيف يتلاعب بعقول العامة، وهذا ما أكده جرجياس في قوله: “… وليذهب طبيب وخطيب معا إلى أي مدينة تشاء، فإذا ما لزم أن فتح باب المناقشة في جمعية الشعب… ليقرر أيهما يختار كطبيب، فاني أؤكد انه لن يكون للطبيب وجود، وان الخطيب هو الذي سيفضل إذا أراد هو ذلك”[6]. ومن هنا حذر أفلاطون من الاحتكام إلى العامة، والاستقواء بها.
لكن في محاورة فيدر نرى أن أفلاطون يقلل من هجومه على الخطابة ويجعلها أداة فلسفية ترتقي بالمعرفة من المستوى العام المشترك إلى المستوى الفلسفي التأملي. أي ممارسة الجدل، “ولكي تصير يا فايدروس خطيبا مفوها لا بد من أن تتوافر لك بعض الشروط الضرورية كما هو الحال في جميع الفنون الأخرى. فإن كان لك بالطبيعة استعداد للخطابة فستكون خطيبا ممتازا إن أضفت إليها العلم والمران…[7].
يميز أفلاطون بين الخطابة السطحية التي تهدف لإرضاء الجماهير (محاورة جورجياس)، والخطابة القائمة على الجدل، التي تسعى للوصول إلى الحقائق من خلال الحوار المنطقي (محاورة فيدر). ويرى أن الحشود، بسبب افتقارها للتكوين الفلسفي، ليست مؤهلة للانخراط في هذا النوع من الجدل العميق، هكذا “يبعدها]الخطابة[عن الحشود بقدر ما يقربها من الجدل والفلسفة”[8]. إذا كانت المسالة هكذا بالنسبة للأستاذ (أفلاطون)، فما الأمر بالنسبة للتلميذ (أرسطو)؟
أرسطو
إذا كان منطلق أفلاطون في إدانة الخطابة وإخراجها من الحاضرة هو انتصاره للفلسفة الأولى، فأرسطو كان منطلقه في مسألة تدبير شؤون الحاضرة هو إقامة فلسفة عملية (صناعة التطبيقية)، هذه الفلسفة العملية تتضمن السياسة، ومهمتها حسب أرسطو هي تحقيق السعادة لكل المواطنين. ولتحقيق هذا الهدف ينبغ أن تستعين بالأعوان،” فان الخطابة هي من الأعوان الأساسين لخدمة السياسة، تماما كما أن الإستراتيجية العسكرية علم مهم…”[9].
إذا فأرسطو لم يسر على خطى معلمه في إدانته للخطابة، بل أعلى من شانها ليضعها في مقام أعوان السياسة. كما انه لم يطابق بين الخطابة والجدل كما فعل أفلاطون. أرسطو يعتبر الخطابة فنًا عمليًا يهدف إلى الإقناع في أي موضوع عبر استثمار الوسائل الممكنة[10]. لكنه يربطها بثلاثة أجناس خطابية رئيسية:
الخطاب التشاوري (Deliberative): موجه لإقناع الناس باتخاذ قرارات عملية حول المستقبل (مثل السياسة أو الحرب).
الخطاب القضائي (Judicial): يركز على الماضي ويهدف إلى إثبات البراءة أو الإدانة في القضايا القانونية.
الخطاب الاحتفالي (Epideictic): يركز على الحاضر ويهدف إلى مدح أو ذم الأشخاص أو الأفعال (مثل الخطابات في الاحتفالات أو التأبين).
أما الجدل بأنه أعم من الخطابة؛ أي أنه ليس مقيدًا بأجناس محددة أو غرض مباشر مثل الإقناع في الخطابة. بل إن الجدل يشمل الإحاطة بجميع الأمور التي تُفضي إلى الإقناع بغض النظر عن الموضوع أو السياق. فهو يعبر عن أسلوب منطقي وفكري عام لفهم وإقناع الآخرين، وليس فقط للإقناع في مواضع محددة مثل الخطابة. “الجدل إذا هو مجال أوسع من الخطابة التي هي لصيقة بالمقامات السياسة الثلاثة: المحاكم، والتجمع الشعبي، والمحافل العمومية. وهذه مقامات مخاطبة الجموع مخاطية شفوية بغاية الإقناع”[11].
من خلال هذا يمكن القول أن أرسطو يرى أن الخطابة والجدل ممارستان متناظرتان تهدفان إلى الإقناع، لكنهما تختلفان في الأسلوب والطبيعة. الجدل موجه إلى مستمع كوني حيادي، ويعتمد على العقل والمنطق فقط للوصول إلى الحقيقة. أما الخطابة، فترتبط بالمقام الملموس وتتأثر بالعواطف (الباتوس) ومصداقية الخطيب (الإيثوس)، مما يجعلها أداة للتفاعل مع جمهور محدد. ومع ذلك، عندما تعتمد الخطابة على الحقائق والبراهين، تقترب من الجدل وخطاب الفلاسفة، لكنها تقترب من جوهرها كلما زادت استعانتها بالعواطف والظروف الواقعية.
إذا استنادا على ما تم ذكره، فان العناصر الأساسية ومقومات الخطابة تتجلى في ثلاث ركائز؛
1. اللوغوس: يتعلق بالحجج العقلية والمنطقية في الخطاب، ويشمل أنواعًا مختلفة من الحجج مثل القياس الإضماري في الخطابة القضائية، والشاهد في الخطابة الاستشارية، والتفخيم في الخطابة الاحتفالية. كما يهتم ببناء الخطبة وصياغتها.
2. الإيتوس: يرتبط بشخصية الخطيب وأخلاقه، حيث يجب أن يظهر بمظهر جدير بالثقة لزيادة فعالية الإقناع.
3. الباتوس: يتعلق بالمشاعر والنوازع النفسية للمستمع، حيث يتم تحفيز مشاعر الجمهور أو تهدئتها حسب الحاجة الإقناعية.
يجمع أرسطو بين العقل والمنطق (اللوغوس)، والأخلاق والشخصية (الإيتوس)، والعواطف (الباتوس) لتشكيل خطاب مؤثر. ويؤكد على أهمية الحجاج باعتباره العنصر الأكثر تأثيرًا في الخطابة، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجدل والمنطق، ويعمل على تعزيز قوة الخطاب وإقناع الجمهور. وبالتالي، يرى أرسطو أن الخطابة الناجحة يجب أن تعتمد على الاستهلال تم تقديم عرض موضوعي مدعوم بالحجج القوية ثم خاتمة، مع التأكيد على دور الحجاج في التأثير على المستمعين بشكل فعال. ” يُمثل الحجاج الذي يستقطب المضمر والشاهد والمواضع قلب الخطابة. إنه النواة العقلية التي تربط الخطابة بالجدل والمنطق والفلسفة هذه النواة هي التي تؤمن وحدة وتماسك المجرة الخطابي”[12].
يتناول أرسطو أيضًا مسألة الأسلوب في الخطابة، مشيرًا إلى أنه يجب تجنب الأسلوب الذي يثير مشاعر مثل الألم أو الابتهاج، لأنه قد يُضيع الرسالة الحجاجية. ومع ذلك، يعترف بأهمية الأسلوب في جذب انتباه الجمهور، ويشير إلى أن الأسلوب يمكن أن يكون أداة معرفية إذا تم استخدامه بشكل معتدل. كما يناقش مسألة الأداء ويعتبره عنصرًا فطريًا، غير مرتبط بالصنعة. يقول محمد الولي: “ يقول أرسطو في مستهل الكتاب الثالث من الخطابة: علينا أن نهتم بمسألة الأسلوب، لا باعتبارها سليمة، بل لأنها ضرورية، لأنه من حيث الصواب ينبغي على المرء أن يهدف في خطبته إلى تجنّب إثارة الألم أو الإبهاج إذ العدالة تقتضي ألا تُعالج القضية إلا بالوقائع وحدها”[13].
إذا يمكن القول في النهاية أن أرسطو قدم مراحل يجب أن تمر منها الخطابة الجيدة، من كونها مادة خام إلى أن تصل إلي المستمع. هذه المراحل تشمل، الاجاد، الترتيب، الأسلوب، الأداء (عنصر فطري) وأهمها حسب أرسطو هي الاجاد (الحجاج)، تم يليه الترتيب، تم الأسلوب.
بيرلمان
لكن في العصر اللاتيني، سنجد أن هذه المراحل التي قدمها أرسطو ستنقلب. بعد انهيار الديمقراطية اللاتينية انتهى الحول وانتهت معه الخطابة؛ بمعناها الأرسطي، حيث تحوّلت الخطابة من فن إقناعي يعتمد على الحجة إلى أسلوب يعمد إلى التأثير الانفعالي المباغت، هذا ما سيجعل الأسلوب يتضخم ليصبح بهذا في المرتبة الأولى بعد أن كان في المرتبة الأخيرة مع أرسطو. وهذا ما يتجلى في كتابات شيشرون ومن بعده في وقت لاحق راموس الذي لعب دور مركزي في تقليص مجال الخطابة، وعمل على استبدال فن الحجاج القديم ببلاغة المحسنات البديعية.
إذا في ذلك العصر أصبح الأمر يتعلق بكيفية تسخير اللغة في الخطابة، الأمر الذي جعل منها ممارسة تزيينية وجوفاء، وبالتالي فقدانها للجوهر الذي كانت تحمله في العصور السابقة.
هذا الإهمال الذي عرفه مبحث الحجاج، يمكن إرجاعه إلى انهيار الديمقراطية والسبب الثاني هو ذاك التضييق الفلسفي لفكرة العقل وحصره في منظور نظري محض.
في هذا الإطار جاء شاييم برلمان لرد الاعتبار إلى للحجاج، وذلك بتبرئته من جهة من تهمة المناورة والمغالطـة والتلاعب بعواطف الجمهور وعقله أيضا، وتخليصه من جهة ثانية من صرامة الاستدلال الذي يجعل المخاطب به فـي وضع ضرورة وخضوع واستلاب. “فالحجاج عند برلمان هو حوار يسعى إلى إحداث اتفاق بين الأطراف المتحاورة في جو من الحرية والمعقولية: أي أن التسليم برأي الآخر يكون بعيدا عن الاعتباطية واللامعقول اللذين يطبعان الخطابـة الكلاسيكية وبعيدا عن الإلزام والاضطرار اللذين يطبعان الجدل”[14].
إن مشروع شاييم برلمان هو ثورة سعى من خلاله هدم الهوة التي تفصل بين الخطابة الكلاسيكية واصلها الأرسطي، وسعى أيضا إلى توسيع موضوعها لتغطي كل الخطابات الموجهة إلي كل أنواع المستمعين، سواء تعلق الأمر بجمهور أو بجماعة مختصين أو بالفرد مع نفسه. ” هذه البلاغة البرلمانية تكاد تغطي كل المساحة التي تمتد من الخطاب اليومي إلى الأدب والفلسفة والعلوم القانونية والعلوم الإنسانية”[15]. كما انه حاول أن
يبرئ الخطابة من ذلك التصور التقليدي الذي ينظر إليها كأداة استدلالية أدنى مرتبة من المنطق أو كفن للإقناع غير الموثوق. يرى بيرلمان أن البلاغة تحتوي على أنماط حجاج ضرورية في مجالات لا يمكن للمنطق الصوري أن يفي بها، مثل القضايا التربوية، الأخلاقية، الدينية،…
من جهة أخرى، يرى بيرلمان أن البلاغة الأفلاطونية، التي تتمحور حول الحوار العقلاني بين الفلاسفة (محاورة فايدر)، والنموذج الأرسطي، الذي يركز على الإقناع الجماهيري، يمكن دمجهما في صياغة موحدة. هذه الصياغة تدمج بين الحوار الجدلي الخاص والنقاش الجماهيري العام لتكوين رؤية جديدة للبلاغة، سماها “البلاغة الجديدة”. هذه البلاغة لا تقتصر على الخطاب الجماهيري التقليدي، بل تشمل كل أشكال الخطاب التي تهدف إلى تفعيل المخاطب وتحفيزه، سواء كان ذلك في المجال الشخصي أو الجماعي أو حتى في الحوار اليومي.
. من خلال هذا تطهر أهم سمة من سمات بلاغة بيرلمان التأكيد على أهمية المتلقي الذي لم يعد سلبيا كما كـان فـي البلاغـة القديمة، بل أصبح متلقيا إيجابيا يتلقى الخطاب الحجاجي ويفكر فيه ويقلبه على أوجهه المختلفة، ليكتشف زيفه أو صدقه، ثم ينتقل إلى فعل الإرسال مفندا أو مدعما؛ ليرتقي بذلك إلى منزلة المرسل وهكذا يتزايد الخطاب. وهذا هو حجر الزاوية في بلاغة برلمان والذي يتعلق بهدف الحجاج؛ وهو إحداث الاقتناع.
الخاتمة
إن الخطابة، بما تحمله من تاريخ طويل يمتد من جذورها اليونانية إلى تطوراتها الحديثة، تعد مرآة عاكسة لتحولات الفكر الإنساني، فقد شكَّلت محاورات أفلاطون مثل جورجياس وفيدروس منعطفًا مهمًا في النظر إلى الخطابة، حيث أدانها أفلاطون بوصفها وسيلة بعيدة عن الحقيقة، حصرها في مجال الانفعالات والتلاعب بالعقول، وأبعدها عن الساحة السياسية والعامة. ومع ذلك، في فيدروس، نجد بذرة مختلفة، حيث أعاد أفلاطون للخطابة بعض الاعتبار عبر حصرها في حوارات النخبة، لكنها ظلت بعيدة عن الجمهور والواقع السياسي.
أما أرسطو، فقد أعاد الاعتبار الكامل للخطابة، ودمجها في صلب الحياة السياسية والاجتماعية، معتبرًا إياها أداة أساسية للإقناع والحوار الديمقراطي. وبوضعه لأنواع الخطابة الثلاثة – التشاورية، القضائية، والاحتفالية – أرسى أرسطو قواعد جديدة جعلت من الخطابة فنًا يخدم المجتمع، وليس مجرد أداة للانفعال.
غير أن انهيار الديمقراطية في العصور اللاتينية قاد إلى تراجع دور الخطابة كفن إقناعي يعتمد على الحجاج، وحولها إلى مجرد ممارسة شكلية تهتم بالمحسنات البديعية والبلاغة الزائفة التي تخاطب العاطفة. لكن هذا التراجع لم يكن إلا مرحلة عابرة، حيث جاء شاييم بيرلمان في العصر الحديث ليعيد الاعتبار للحجاج عبر مشروعه البلاغة الجديدة.
لقد وسَّع بيرلمان مفهوم الحجاج، وربطه بالخطابة والجدل، ليصبح أداة تواصل شاملة، تجمع بين الحوار الفلسفي الراقي والتواصل اليومي العملي. بذلك، أعاد بيرلمان للحجاج مكانته كجسر بين الفكر والواقع، وبين العقل والعاطفة، وبين الخاص والعام، مؤكدًا دوره الأساسي في بناء حوار إنساني يقوم على الاقتناع، وليس الهيمنة أو الخداع.
وهكذا، تظهر الخطابة كفن حيّ ومتجدد، يتطور مع تطور الفكر الإنساني ويواكب حاجاته المتغيرة، مما يجعلها ليست مجرد وسيلة تواصل، بل أداة لتحقيق العدالة والحوار في شتى مناحي الحياة.
قائمة المراجع:
- شاييم برلمان وتيتكا، مصنف في الحجاج: الخطابة الجديدة، ت محمد الولي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط 1، ليبيا 2023.
- ارسطو. الخطابة. الترجمة العربية القديمة، تتحقيق عبد الرحمان بدوي.
- محمد الولي، مدخل الى الحجاج افلاطون وارسطو وشايم بيرلمان، عالم الفكر، العدد2، المجلد40، اكتوبر- ديسنبر 2011م.
- افلاطون، محاورة جورجياس، ت محمد حسن ظاظا، م علي سامي النشار، الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر.
- افلاطون، محاورة فايدروس، ت اميرة حلمى مطر، دار غريب،2000.
- اوليفي روبل، مدخل الى الخطابة، ت رضوان العصبة، افريقيا الشرق2017.
[1]. ارسطو. الخطابة. الترجمة العربية القديمة، تتحقيق عبد الرحمان بدوي، ص.8. (بتصرف)
[2] . محمد الولي، مدخل الى الحجاج افلاطون وارسطو وشايم بيرلمان، عالم الفكر، العدد2، المجلد40، اكتوبر- ديسنبر 2011م، ص11.
[3] . اوليفي روبل، مدخل الى الخطابة، ت رضوان العصبة، افريقيا الشرق2017، ،ص30.
[4] . محمد الولي، مدخل الى الحجاج افلاطون وارسطو وشايم بيرلمان، مرجع سابق،ص،20-21.
[5] . شايم برلمان وتيتكا، مصنف في الحجاج: الخطابة الجديدة، ت محمد الولي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط 1، ليبيا 2023، ص14.
[6] . افلاطون، محاورة جورجياس، ت محمد حسن ظاظا، م علي سامي النشار، الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر، ص46.
[7] . افلاطون، محاورة فايدروس، ت اميرة حلمى مطر، دار غريب،2000، ص101.
[8]. شايم برلمان وتيتكا، مصنف في الحجاج: الخطابة الجديدة، مصدر سابق، ص،16
[9]. المصدر نفسه، ص،ن.
[10]. ارسطو، الخطابة، ص، 29
[11] . محمد الوالي، افلاطون ارسطو برلمان، مصدر سابق،ص،25.
[12]. شايم برلمان وتيتكا، مصنف في الحجاج: الخطابة الجديدة، مصدر سابق، ص،21ـ22.
[13]. المصدر نفسه،ص، 23.
[14]. عبد العزيز لحويدق، مقال ضمن كتاب: الحجاج مفهومه ومجالاته، عالم الكتاب الحديث، الطبعة لأولى،2010م، الجزء الثالث،ص 344.
[15]. محمد الوالي، افلاطون ارسطو برلمان، مصدر سابق،ص، 34.
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.