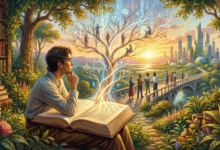هدف السلام:”الطرف الثالث” ورؤية منتدى الفكر العربي للخيارات المتاحة

بُعْدٌ جديد:
تأخذنا القرائن الماثلة، إضافة إلى ما قدمنا من عرض في المقالين السابقين، إلى أن يد “الطرف الثالث” ما تزال متغلغلة وفاعلة في صناعة الكثير من الأحداث، بل وترتيب نتائجها في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وأن الفاعلين منهم ما يزالون يمدون أعينهم إلى ما متع الله به دول المنطقة من خيرات وثروات. وتتفاقم بين دول المنطقة غير قليل من الخلافات، التي تخلق قابليات للتدخلات الخارجية، وتمهد لها الطريق للتأثير على صناعة قرارها الوطني والجمعي. لذلك، فإن السلام بمعناه الشامل هو هدفٌ ينبغي أن يكون في أعلى قائمة الفكر السياسي، وفي مقدمة أدوات التخطيط الاستراتيجي، لهذه الدول، التي عاشت أجيالًا من حياتها تكافح كل يوم لمجرد تأمين حياضها، بل هو حتمية المرحلة؛ مثلما كان ضرورة وجودية في كل مرحلة سبقت. وذلك لأن العديد من الصراعات العنيدة، التي تُلَبِّدُ آفاق هذا السلام، تستشري في الوطن العربي، نتيجة للفشل في إدارة التنوع الداخلي، وما يرتبط به من تاريخ طويل ومأساوي من الصراعات المحفزة للتدخلات الخارجية. ورغم وجوب الاعتراف بأن هذه الصراعات لم تولد من فراغ، بل هي ذات أسباب اليوم، التي مكنت لها بالأمس، وجب أيضًا محاسبة الذات على استمرارها. والسؤال الحارق هو: إذا كانت المنطقة متنازع عليها من قبل القوى الاستعمارية حتى قبل اتفاقية سايكس بيكو، خاصة بين الإمبراطوريات البريطانية، والفرنسية، والعثمانية، والصفوية، فأين التدبير الوطني، الذي كان عليه أن يفعل الكثير لاستقرارها؟ وبالتالي، نستطيع نفي أن ما نشهده اليوم من هذه الصراعات في المنطقة ما هو إلا ميراث لقرون من محاولات الهيمنة المنهجية، التي تستهدف المجتمعات العربية والإسلامية، وكأنه قدر مقدور، بل كثيره من صنع أيدينا.
والاستدراك، الذي لا يعفي من المسؤولية، هو أن شعوب المنطقة نفسها قد جرى استعمارها وتهجير بعضها، أو نزحت من ديارها، أحيانًا نتيجة لما كان من ترتيبات القوى الاستعمارية؛ إما لحكم أراضٍ طَمِعُوا في ثرواتها، أو لاختراق حدودٍ معينة وضمها إلى غيرها من الدول المجاورة، وفي غالب الأحيان من دون أن يطلب منها الانضمام إليها، وما حدث ويحدث في غزة وفلسطين ما هو إلا نموذج مصغر للصور الأكبر من مخططات لا تنتهي. وإذا كان من فرقٍ يُحْسَب؛ يمكننا القول إنه تاريخيًا، كان للصراعات في المنطقة بعض الصلة بمصالح القوى الخارجية المباشرة، وقد أخذتها عُنوة ومن دون مواربة كـ”طرف أول”، وتوعز بما يمكن لها من أخذها الآن خِفيَةً. لذلك، من المؤسف حقًا أن العديد من الصراعات اليوم لا تزال تخدم مصالح الأطراف الخارجية، فهي من تشجع عليها، إن لم تكن في الحقيقة مخترعة لها كـ”طرف ثالث”. ولذلك، فإن التعاون بين الدول العربية نفسها، ليس من أجل تشجيع الحرب والتوسع، ولكن على أساس التفاهم الصادق وعلى حسن النية في القرارات العربية، هو فقط ما الذي يمكن أن يكون أساسيًا للسلام القادم. الأمر الذي يحتم وجود “رؤية سلام عربية” شاملة، تأخذ بالخيارات المتاحة، مع ضرورة أن تضع في الاعتبار أن واقعنا الإقليمي لا يعتمد فقط على صياغتنا الخاصة لأهمية السلام، بل هي نتاج حقبٍ تاريخية عززت تطوير نماذج لخيارات السلام الناشئة عن مختلف التجارب الإنسانية. وهكذا، قد يتوجب علينا، ونحن نسعى للسلام، أن نقوم بإلقاء نظرة عامة على بعض المواقف النظرية والأمثلة العملية، لِتَخَيُّر ما يناسب واقعنا العربي والإسلامي.
الخلفية التاريخية:
في أعقاب إنهاء الاستعمار، ظهرت حركات وطنية تتدثر بالحِْفَة أيديولوجية مختلفة في جميع أنحاء الوطن العربي، مما أدى في كثير من الأحيان إلى توحيد مختلف التركيبات العرقية والدينية والطائفية في دولة واحدة، قادت إلى تسوية النزاعات الإقليمية داخلها في بعض الأحيان. وعكست حدود هذه الدول الوطنية الجديدة إلى حد كبير تلك الخطوط، التي رسمتها القوى الاستعمارية خلال أوائل القرن العشرين، في محاولة لتقسيم الشرق العربي وتوزيعه فيما بينها. ونتيجة لذلك، تدخلت العديد منها، منذ ذلك الحين، مرارًا وتكرارًا في النزاعات الداخلية، وأججت الحروب الأهلية والبينية في هذه الدول. وفي حين أن بعض هذه البلدان، التي كافحت طويلًا من أجل استقلالها قد شهدت نجاحات أنهت عقودًا من الصراعات والأعمال العدائية في السنوات القليلة الماضية، بينما لا يزال البعض الآخر يكافح تحديات تشكيل هوية دولة موحدة وحكم مستقر ومركزي. وبالإضافة لتجارب الاستعمار المباشر، تَشَكَّل الوطن العربي أيضًا من خلال التداعيات المعقدة والمستمرة لمأساة فلسطين، حيث تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين العرب على يد عصابات المستوطنين والجماعات شبه العسكرية؛ بعد وعد بلفور في 1917، إبان فترة الانتداب، وما تلاه من خطة تقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين؛ عربية ويهودية.
وتحفظ الذاكرة العربية أن العلاقات بين الكيان الصهيوني، أو الدولة الإسرائيلية الجديدة، منذ إنشائها في عام 1948، قد تميزت بالعداء للفلسطينيين والعرب، ومرت بفترات متعددة من الصراع المسلح، وما تزال، على الرغم من أن توقيع الاتفاقيات في نهاية كل حرب كان يجلب شيئًا من الاعتراف المتبادل والهدوء النسبي. ومع ذلك، منذ الطلقات الأولى للانتفاضة في عام 1990، تخللت هذه العلاقات مرارًا وتكرارًا أعمال عنف غير مسبوقة، وأسواها ما نشهده في غزة الآن. ولا شك أن الصراع العربي- الإسرائيلي قد تحول من فلسطين إلى أجزاء أخرى من المنطقة، ويتفاقم كل مرة بسبب اندلاع الحروب الأهلية في العراق وسورية ولبنان وليبيا واليمن والسودان، التي جلبت عددًا لا يحصى من الجهات الفاعلة غير النظامية المحلية والدولية إلى الصراعات الإقليمية. ويوفر هذا التحالف والتاريخ المشحون بالنزاعات في كثير من الأحيان عدسة مفيدة يمكن من خلالها رؤية ومناقشة الجهود المختلفة، التي يبذلها مفكرو الدول العربية لإيجاد رؤىً مُثْلّى للسلام تهيئ لأمتهم ولأنفسهم مكانًا آمنًا في منطقتهم، ويوجدون بيئة جيوسياسية أكثر ملاءمة للانتماء والإنماء، ومستقبل يمكن التنبؤ به، على خلفية ما كانت تتمتع به المنطقة في ماضيها بشكل عام.
ومعلوم أن الخط السياسي، الذي انبثق من الإرث الاستعماري وبعض التجارب الوطنية، بدوره، يوجه الأنساب المعرفية والأيديولوجية نحو التأريخ، من قبل الكثير من المفكرين والمثقفين، الذين يطمحون أيضًا إلى اقتحام حقبة ما بعد الاستعمار. لذلك، فإن تاريخ هذه الفترة مركب ومعقد جدًا، إذ يتكون من تدخلات عرضية وظرفية على ما يبدو، بينما تتقلب الدوافع وتحتل السياقات الإقليمية مكانة مهمة في مبادرة هذه التدخلات، التي خضعت لمحاولات مختلفة، وأثرت بشكل عميق على التطورات الوطنية المتعاقبة. وعند التركيز بهذه الطريقة على القوى الاستعمارية، لا تُفهم هذه العوامل الاستعمارية والقدرات الإبداعية وإعادة التشكيل للممارسات السياسية من خلال الجلوس في أبراج عاجية، وإنما من بالتفاعل المباشر مع أصحاب المصلحة. وفي هذا الجانب، يفهم المفكر والمثقف، وحتى المؤرخ، ظواهر التكوين الوطني لقادة ومنظري هذه التمثيلات، ثم يثبت بدقة شديدة المصدَرَين الاستراتيجيين لأعطاب بيئتهم السياسية والاجتماعية. فمنذ بداية غزوهم للأراضي العربية، كان وجود القوى الاستعمارية مصدر استياءٍ شديد من قبل المحكومين، وخاصة أصحاب الفكر والرأي منهم. وقد تطور الاستياء وتعمم نتيجة للوعي المتقدم، الذي بَثَّتهُ مراكز الفكر ومنتدياته، وهو ما كشف أن خطر “الطرف الثالث” لا يرجع إلى الوحشية، التي تستخدمها السلطات الاستعمارية فحسب، بقدر ما يرجع إلى الضرر العقلي، الذي يدمر طموحات الرجال والنساء، بسبب التَعَمُّد الاستعماري لخلخلة التطور الطبيعي للأشياء.
في الختام، تجدر الإشارة إلى إن كل من يتحدث عن “العامل الاستعماري” من خلال تسليط الضوء على الاستمرارية التاريخية للقومية العربية والاستعمار، فإنه يصنع استمرارية بين مجتمعات ما قبل الاستعمار والتطور الاستعماري، ويبني فترة اجتماعية وسياسية، وحتى معرفية لنتائج التدخل الاستعماري. وهكذا يؤدى هذا التدخل “الواعي” إلى ولادة قيادات مستنيرة فعليًا بتأثيرات “الطرف الثالث” في مجتمعات وشعوب نابضة بالحياة، مما يدفع إلى تطوير جزء ثابت من أعمالها؛ إما من أجل التحرر من نير المستعمر، أو لاستدامة نضالها لأطول فترة ممكنة من بعض القيادات الوطنية، أو الرضاء بواقع لا يقبله غيرها. وتؤكد بعض الثورات، التي تضم أسماء الممثلين الأوائل لـ”النهج الاستقلالي”، أن الأمور إذا أخذت على عجل، تكون فيها شبهة يُثيرها الاستعمار من خلال التشكيك في ظروف ولادتها وتكوينها. لذلك، فإنهم يُظهرون مقاومة هذه التشكيلات الوطنية فيما يتعلق بالتاريخ الاستعماري، ويُبرِزُون معارضة هؤلاء القادة وزعمائهم الأيديولوجيين، الذين أصبحوا أحيانًا أسرى ومنفيين في الدول المستعمرة، أو تعرضوا للاغتيالات السياسية، التي كان سرعان ما يتم ختمها، أو التغطية عليها، بعد حدوثها في المنطقة.
الأطر النظرية لبناء السلام:
لقد تَرَسَّخَ لدى منتدى الفكر العربي، منذ انطلاقته الأولى في عام 1981، أنه يمكن للأطر النظرية المتعددة أن توجه مبادرات وجهود بناء السلام. لذلك، اجتهد منظروه في الدعوة للسلام، وكان على رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، رئيس المنتدى وراعيه، الذي ابتدر الدعوة بضرورة سن “قانون عالمي للسلام”، وسعى في تبيان حقيقة أن حل النزاعات ممكن من خلال إعمال العديد من التوجهات النظرية والمفاهيم والأدوات، التي يمكن أن تكون مفيدة في بناء السلام في المنطقة العربية. وعلى الرغم من أن الأعمال الكلاسيكية حول الطرق البديلة لحل النزاعات تختلف في التفاصيل والأسماء، إلا أنها تشترك في بعض القيم والأساليب الأساسية، التي ظل ينادي بها المنتدى. ولذلك، يحاول دائمًا فهم وتقديم حلول للصدامات والصراعات من خلال استخدام وتطبيق الحوار والتفاوض والوساطة بدلًا من العنف. وتطبيقًا للمستوى النظري للعلاقات الدولية، كان هناك تحول تقديري من أساليب الحوار القديم إلى إبداعات النقاش الأحدث حول طريقة البحث العلمي، إلى إعادة التفكير في كيفية تفاعل الوكلاء؛ أي الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركات وغيرها، وكيف يشكل هذا التفاعل ويتكون من قبل مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية، وكذلك الجهات الفاعلة الحكومية، ليبلغ الجميع مظان الغايات المتوخاة.
ولذلك، فإن توصيف، أو تصنيف، أو حتى تصفيف، مثل هذه الخطوات ومقاربتها مع الفكر النظري والعملي مليء بالصعوبات إذا لم تكن الرؤية الكلية حاضرة؛ مثل تلك التي تجلت في رؤية القانون العالمي للسلام. ومع ذلك، لا يمكن اشتقاق تمييز، أو اختلاف واضح وآثار عملية إلا إذا بذلت بعض المحاولات للتفكير في صياغة السياسات وتنفيذها، وفق ما ورد هذه الرؤية الكلية، وما يمكن تحصيله من ضوابط موضوعية في آراء اللغويين والفلاسفة وعلماء الاجتماع. ويُعتقد، في هذا الصدد، أن الفرق بين النظرية والفلسفة هو الممارسة، التي تضع كليهما موضع التنفيذ على أرض الواقع، وما كان لقيادة المنتدى إلى أن تضع هذه الحقيقة نِصب عينيها، لأن الأمير الحسن لا يفتأ يردد أهمية استصحاب هذا الواقع في حساب الصالح العام. وفقط عندما يكون هناك فرق بين ما يجب القيام به وما يجب التفكير فيه، هناك مجال لمعرفة ما يمكن القيام به اليوم، وما يمكن التفكير فيه غدًا؛ ومن ثم، فإن هذا وحده سيوجه قصد الغد، ويتجلى على أنه مفيد وثاقب اليوم.
نظريات حل النزاعات:
لقد طور العلماء نظريات مختلفة لحل النزاعات، وكلها تحاول تقديم آليات وأدوات لحل هذه النزاعات. ومع ذلك، لا يمكن دعم أي من هذه النظريات، أو الطعن فيها ما لم يتم تطبيقها على مقاييس، أو موضوعات، أو أماكن محددة. ويمكن أن تكون بمثابة بيئة عامة ملائمة، أو ظروف تنص على أنه من أجل معالجة مثل هذا النوع من الصراع، تتوفر الحلول التالية، ومن ثم يجب القيام بشيء ناجع؛ كاتباع كذا وكذا من الخطوات. وبشكل عام، هناك أنواع مختلفة من نظريات حل النزاعات، تتعامل مع ماهية القضية، بما في ذلك النظريات القائمة على المصالح والنظريات القائمة على الحقوق. ويهدف النهج القائم على المصالح إلى تحديد هذه المصالح الأساسية، التي يتم التعبير عنها كمواقف، ويركز على إيجاد طريقة لتلبية مصالح كل طرف، فيما يمكن إجماله تحت رؤية “الصالح العام”. ونعلم أن النهج القائم على الحقوق قد تطور ببطء من خلال جملة من عمليات حل النزاعات وخلق السلام. وقد أسفرت حركة حقوق الإنسان عن تطوير نهج أكثر شرعية قائم على الحقوق، حيث يُنظر إلى الأطراف المتنازعة على أنها تتمتع بحقوق أكثر أهمية من مصالحها، ويجب الاعتراف بها واحترامها. ويُشير الباحثون إلى أن هذا النهج يمكن أن يكون مناسبًا للبيئة العربية. وتستند مناهجه الآلية إلى حل النزاعات من خلال الاتصال، الذي يهدف إلى فهم المصالح الأساسية للطرف الآخر. ويمكن أن يكون هذا إما العلاج بالحوار المباشر، أو المساعي الحميدة، أو مزيج من الاثنين معًا. وتتمثل الروح الأساسية لهذه الآليات الأربع في تسهيل فهم المتنازعين لبعضهم البعض، وزيادة العزم والإرادة، وعدد الطرق الممكنة والمتداخلة لحل المشكلة.
لهذا، ولكي تكون قواعد الأدلة أكثر قابلية للتطبيق على المستوى المحلي، أو الوطني، ينبغي أن تتضمن أمثلة من العالم الحقيقي على الاستخدام الناجح للآليات وعددًا محتملًا من هذه الأمثلة، التي لم تصل أبدًا إلى مستوى المعالجة الإعلامية. ومع ذلك، هناك القدرة على الإشارة إلى عدد من الأماكن في بيئة الصراع العربي في الشرق الأوسط حيث يمكن أن تكون هذه الآليات ذات قيمة نظريًا، وربما عملية في خاتمة المطاف. ومن وجهة نظر أخرى، وفي حين أن الذكاء العاطفي مهم في الصراعات بين الثقافات والمؤسسات بشكل عام، فإن تطبيقه على الصراعات المستعصية يمكن أن يكون مهمة قيمة، ولكن يصعب تحقيقها في كل الحالات. ويعد تحويل الناس من التركيز على حلول الجانبين وتوقع الخسارة هدفًا مهمًا في أي صراع مستعصي، لكن تحويل هذا إلى مفهوم الفوز في الحالتين قد يكون طوباويًا. وأخيرًا، فإن نظريات حل النزاعات جيدة جدًا بالفعل، لكن تطبيقها يمكن أن يغرق في تحديات الحياة الواقعية. وتشمل بعض هذه الأمثلة تصوير الرجال والنساء ليس كأفراد، بل كممثلين لثقافاتهم. وكما أنه قد تفشل هذه النظريات في إدراك احتمال أن يكون العنف، أو النزاع قد جاء قبل التجارب العاطفية للغضب. ومن أجل تمهيد الطريق نحو سلام دائم، قد يكون تطبيق جميع النظريات، أو تجريب فاعليتها، خيارًا صحيًا.
وجهات نظر العلاقات الدولية:
يجري تناول مجموعة من المقاربات النظرية، التي تهدف إلى شرح تطبيق مبادرات عملية السلام، ويمكن تفصيل نظرة ثاقبة حول أنماط واتجاهات السلوك العربي نحو السلام وفقًا لها، أو بمعزل عنها. وفي ظل المنظور الواقعي، تميل مقترحات السلام إلى أن تقرأ على أنها نتيجة لاصطفاف أيديولوجي، أو أمني سابق. وقد لعبت المبادئ الهيكلية الليبرالية دورًا في تبرير فك الارتباط العسكري الوطني بالواقع؛ وما تجارب الولايات المتحدة في فيتنام والعراق وأفغانستان إلا نماذج قاد فيها استبعاد المؤسسات العسكرية الوطنية عن الحل إلى مزيد من التعقيدات، التي أطالت من عمر الصراع. ومن المنظور البنائي، عادة ما تُناقش الصراعات وفرص السلام من حيث التعلم والتغيير، والتي تدفعها أيضًا الأفكار. وفي السياق، تميل قصص عملية السلام إلى أن تُروى على أنها سردية عن التوافق القيم والتواصل، والتعاون والمواجهة هما استنتاجان محتملان. لذلك، تهدف نظريات العلاقات الدولية إلى السعي لتحقيق السلام، إذ غالبًا ما تتأثر الصراعات المحلية بشدة بتكوين القوة على المستوى الدولي.
وغالبًا ما يتم قيادة التدخلات الخارجية على أساس تعريف النظام العالمي، بشكل عام كانتقام من العدوان، أو كأداة للحفاظ على الاستقرار. فيما يُنظر إلى التحالفات العسكرية، أو المنظمات الإقليمية كوسطاء محتملين يدخلون لمنع الحروب، أو إنهائها. ولذلك، فإن الأمم المتحدة، وفقًا لميثاقها، تتعهد بإيمانها بالحقوق الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والأمم كبيرها وصغيرها، وبشكل أدق، فهي تتبنى صون السلم والأمن الدوليين وإزالة التهديد للسلام، وقمع أعمال الصراع. ولا يتردد صدى المظالم الإقليمية والوطنية بشكل صحيح في مؤسسة تعترف بمبدأ واحد فقط من مبادئ التنشئة الاجتماعية، وهو الحرية الفردية. وبالتالي، فإن ردود الفعل العربية الجماعية لها ما يبررها في المقام الأول من حيث تأثيرها التراكمي، أو من حيث التداخل العميق بين المحلي والدولي، حيث تتشابك التطورات المحلية بعمق مع التدخلات الإقليمية، وربما العالمية. وبالتالي، فإن التجريدات المختلفة ضرورية، وتتضمن تلك الموجودة في العلاقات الدولية. وتشمل الأسس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للسلام آليات الدولة، ولكنها تتجاوزها. ومن ثم هناك حاجة إلى نهج شبه متعدد التخصصات بين التحليلات الداخلية والإقليمية والدولية.
الديناميات الإقليمية:
ومن هنا، ولفهم تعقيدات السعي العربي الموحد للسلام كجزء من دينامية اجتماعية وسياسية واقتصادية متماسكة، يُصبِحُ من الضروري تقدير الإمكانيات المتنوعة، التي توجه بها المشهد السياسي والأمني العربي. وهذه الإنجازات متجذرة في العلاقات العربية المستمرة، التي تتجاوز مستويات التعاون الحالية وتلقي الضوء على التنافس الكامن بين مختلف الدول العربية. وبما أن المظالم التاريخية تثري على إعادة الترتيب المستمر لتفاعل القوى العالمية في بلاد الشام والخليج العربي وشمال أفريقيا، وما وراءها، فإن المرحلة المقبلة ستلقي الضوء على طبيعة هذه النزاعات وعيارها واستمراريتها. باختصار، مع ظهور دول عربية مختلفة، وتشكل ديناميات مختلفة من الإجماع وسط مصالح وطنية مميزة، يجب على المرء أن يكون مستعدًا لإلقاء نظرة فاحصة على التطورات الثورية، التي ستشكل مسار تحالفات الدول الوطنية العربية. وإذا كانت هذه صراعات تشمل دولًا عربية فقط، فهناك ديناميات إضافية تلعب دورًا أوسع من مجرد وصفها بأنها حالات إقليمية.
بيد إنه إذا حدثت هذه الانتهاكات داخليًا داخل الدول العربية والإسلامية، فمن المعقول فقط النظر في ضرورة التضامن ضد مجموعات معينة، مع ارتباط ضئيل، أو معدوم بعمليات بناء الأمة العربية الإسلامية الأكبر. إنه سيناريو مماثل للفضاء العالمي، حيث هناك أيضًا حاجة إلى جبهة مشتركة إنسانية ضد الاستراتيجيين الأقوياء، لأنه مع انتقال سياسات الشرق الأوسط من مراكز عملية السلام إلى مراكز حل النزاعات، تغيرت النقاط المرجعية الإقليمية أيضًا لتعكس علاقات محددة مع الدول العربية، التي غَذَّت الوهم بوجود سياسة خارجية موحدة. وعلى هذا النحو، تبددت النوايا الحسنة المطلقة، التي كانت تربط بعض الدول العربية ببعضها البعض بهدف واحد، مما أدى إلى تبخر رؤية كلاسيكية موحدة للسلام العربي. ومثل هذه الدول وتحالفاتها الجيوسياسية ستواجه دائمًا بعضها البعض على أرضيات الدبلوماسية الدولية. ومن الواضح أن كل الطامحين ينجرفون ويتحركون إلى محاور مختلفة من التحالفات والنفوذ، ويقسمون على عدم التوقف عند أي شيء في حماية مصالحهم الوطنية وسط ألعاب القوة الإقليمية المستمرة.
العلاقات العربية:
تاريخيًا، وصفت المعاملات والعلاقات المنطقة العربية بأنها شديدة التقلب، ولم يقابلها من الصراعات والمواجهات بين الدول سوى تحالفات سياسية وتجارية واستراتيجية متغيرة. وتستمر شبكة المعاملات والعلاقات هذه في تشكيل الاستراتيجيات العربية والتحالفات الخارجية. وفي الوقت نفسه، أدى التاريخ الطويل للصراعات إلى بذل جهود تعاونية ومنسقة واسعة النطاق لرأب الصدع وصياغة حلول سلمية مقبولة. ويعلق جميع العرب تقريبًا دائمًا أحر ترحيب رسمي وشعبي على محاولات المصالحة وحل النزاعات بمواقف عاطفية أكثر منها عقلانية واقعية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تخلق وجهات النظر المختلفة قدرًا معينًا من المقاومة والمعارضة السياسية، أو تدخلات “الطرف الثالث”، لا سيما للاصطفاف مع الدول العربية المهيمنة أقدار جيرانها بسبب اختلاف المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية.
لقد طور نظام الدول العربية الإقليمي العديد من “الترتيبات” في محاولة لتعزيز الوحدة العربية والسلام في المنطقة. وكدليل على فعاليتها النسبية، تمكنت هذه “الترتيبات” من تحديد والعمل من أجل مبادرات ووضع حدود ومعالجات معينة للقطيعة بين العرب. ومع ذلك، فقد أثبتت هذه المنظمات المترابطة أوجه القصور فيها، خاصة أجهزة الجامعة العربية. ولا تؤثر النجاحات والإخفاقات على تطور المواجهات المسلحة الحالية وحلها السلمي فحسب، بل تؤثر أيضًا على كيفية مواجهة الصراعات المحتملة في منطقة ذات اتجاه تراجعي بموارد محدودة ودعم سياسي غير مُؤسس على قاعدة تراضٍ عام، ونفوذ خارجي يخترق كل الجدران. وتزداد المهمة تعقيدًا بسبب الاهتمام المفرط ببقاء العرب، وإنشاء نظام سياسي يمكن أن يضمن الديمقراطية والحرية، ولكنه في الوقت نفسه يقلقه السؤال عما إذا كان بالإمكان أن يكون بمقدوره خلق الاستقرار والأمن في المنطقة؟! وهنا علينا، قبل محاولة التفكير في الإجابة، أن ندرس كيف تعاملت الدول العربية مع نظام التعاون وطورته، مما أثر على المصالح المشتركة، وخلق دراسات حالة مختلفة لتوضيح انتكاسات التعاون العربي في المواجهة مع مشكلاتها الداخلية والخارجية. وقد لا تحدد المنظمات غير الحكومية التعاون العربي الدولي كهدف محدد، ولا توجد قضية السلام في المنطقة صراحة كهدف معلن في بيانات مهمة لمعظم هذه المنظمات غير الحكومية والمنظمات المدنية المحلية. ومع ذلك، فإن معظمهم شركاء في الجهود التعاونية، وهي وسيلة لتحقيق النوايا الواردة في بيانات مهمتهم، أو كوسيلة لإرضاء الذات. ورغم ذلك، ينبغي الاعتراف بأنه يوجد شكل من أشكال التعاون العربي بين الجمعيات المدنية العربية، الذي يمكن أن يوفر، وفق رؤية المنتدى، إطارًا جنينيًا تستطيع من خلاله بناء هيكل قوي للسلام والتنمية.
إن السعي لتحقيق السلام في الوطن العربي، أو الشرق الأوسط الكبير، هو عملية معقدة تهدف إلى تقليص عدد الصراعات بين الدول العربية وجوارها، والاهتمام المتبادل بالنفط والموارد الأخرى، وزيادة الضغط على مصادر النفوذ الخارجي من أجل السلام. ولكن هذه وغيرها تعقدها أكثر إمكانيات الجغرافيا السياسية والاقتصادية العربية بسبب اعتماد الوطن العربي على استيراد المعدات العسكرية والتكنولوجيا المتطورة، وحتى غذائه من الخارج. وتشكل هذه التطورات الأخيرة في المنطقة البيئة السياسية الملائمة لاستدامة تدخلات “الطرف الثالث”. والسلام، بوصفه فرصة، يقوم على شبكة من الاستجابات المتبادلة بين الدول العربية؛ فيما يحفظ لها مصالحها الجمعية كوطن وأمة واحدة، والتركيز على قضيتها المركزية فلسطين باعتبارها “ورم خبيث” قام باستنباته هذا “الطرف الثالث” للإبقاء على نفوذه. لذلك، فإن مُدركات الأزمة العربية – الإسرائيلية ينبغي أن تظل محفورة في أذهان الرأي العام العالمي المهتم، مع درجة المرونة، التي تمتد إلى قُدرات التعاطي مع الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. ورغم أن السلام هنا بعيد المنال بسبب التنافس بين القوى العظمى، وتعارض مصالحها مع المصالح العربية. لذلك يجب التعامل مع المواجهة العربية ضد الدول الموالية لإسرائيل، مثل تلك الموجودة في إفريقيا، بشكل مختلف عن تلك الموجودة في أوروبا ودولة مثل الولايات المتحدة. أما البلدان الفقيرة، كما هو الحال في أفريقيا، فهي لها خيارات ومشاكل أكثر مرونة من القوى الغربية، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية. وتميل الدول العربية إلى حشد الضغوط والتأثيرات الدبلوماسية في وكالات إطارية إضافية، مثل منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز والأمم المتحدة ووكالات إقليمية أخرى، متحدة في تهم مختلفة تتراوح من الحياد والموقف العدواني إلى العداء المتشدد. وللأسف، لا تظهر الدول العربية تجانسًا في المواقف، لأن كل دولة عربية لديها مجموعة مختلفة من المعاهدات والاتفاقيات والأيديولوجيات الفلسفية والسياسية، التي تحكم بها الدولة وعلاقاتها الخارجية. وباختصار، أصبحت الالتزامات العالمية بالسلام مسألة سياسة واقعية وأخلاق براغماتية دولية، إلى جانب الأخذ في الاعتبار قوة ومصلحة أولئك الذين يمارسونها.
دور الجهات الفاعلة الخارجية:
لقد حددت الجهات الفاعلة الخارجية، أو “الطرف الثالث”، بشكل كبير خطوات السعي لتحقيق السلام في الوطن العربي، وقيدت نجاحاته. لذلك، يحمل دور القوى العالمية وزنًا كبيرًا في السياسة الإقليمية، كما هو موضح في السياق العراقي، والليبي، واليمني، والسوري. ويصبح الموقف، الذي يتخذونه فيما يتعلق بالسلام هو التوازن الكياني والاستراتيجي للقوى الإقليمية وتلك التي هي خارج المنطقة. وسواء كانت هذه إيجابية، أو سلبية، فهي قطعًا تنعكس على المصالح الاستراتيجية للقوى العالمية في مشاركتها، أو غير ذلك، في هذه الصراعات الآن وفي الماضي والمستقبل. ومن دون معالجة هذه الاعتبارات، فإن السلام الإقليمي يبدو في ظاهره مستحيلًا، إذا لم يستطع العرب التفكير الجدي في تقرير مصيرهم بأنفسهم من نفوذ لا يفتأ يتمدد ويتجذر. لذلك، فإن هذه الأبعاد الخارجية تعقد بالتأكيد الديناميات الداخلية للصراع وتجعل السلام مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالقضايا الإقليمية والعالمية ذات المصالح المتعارضة. وينطبق نفس المبدأ على المنظمات الدولية، الذين يمكنهم تسهيل السلام من خلال مفاوضات السلام والمساعدات الإنسانية وما إلى ذلك، ولكن يمكنهم أيضًا إعاقة السلام إما عن قصد، أو غير ذلك.
وفي السعي لتحقيق السلام الإقليمي، يعد دور الجهات الفاعلة الإقليمية والجيران أمرًا بالغ الأهمية؛ مع ضرورة الانتباه لمقتضيات الربح والخسارة فيه. فالدول المجاورة تشترك في روابط ثقافية وتجارية واجتماعية وطائفية وسياسية عميقة مع الدول العربية، ولكن هذا لا يعني تطابقًا في قيمة المصالح. وهذا أمر إيجابي وسلبي معًا من حيث أنه يمكن أن يعزز العلاقات الاقتصادية والتبادل الاجتماعي، سواء في مجال التكنولوجيا الفكرية، أو السيبرانية، ولكنه من ناحية أخرى يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات والتهديد المتبادل للأمن، مما يؤدي إلى تحالفات بين هذه القوى الخارجية وبعض المناطق المحيطة بها، أو القوى الخارجية المعادية. وفي حالات كثيرة، فقد أدى ذلك إلى معارضة داخلية من صانعي القرار، مما عزز جهود السلام وأدى في كثير من الأحيان إلى الفشل في وقت واحد.
ويتسم عالم اليوم بصراع على السلطة وإعادة اصطفاف القوى، وتغذيه التوترات الإقليمية والخارجية الإقليمية، عبر هذه المداخل المختلفة. وعلى الرغم من أن الجهات الفاعلة غير الحكومية لا تملك سلطة رسمية على المستوى الحكومي، إلا أنه لا يمكن الاستهانة بدورها في عملية السلام، إذا أُحسِنَ استيعاب جهودها في المشروع الوطني. إذ إن هذه الجهات الفاعلة ومجموعات الضغط تعمل باستمرار للتأثير على الأجندة الوطنية والموقف التفاوضي للوفد الرسمي والرأي العام للمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين. وفي العديد من عمليات السلام، كان من الصعب على “أطراف ثالثة” إشراك أطراف متعددة في نفس الصراع مثل المعتدين والأطراف المتضررة. ولذلك، لكي تنجح استراتيجيات السلام، يجب تكييفها مع هذه السياقات المختلفة. وللقيام بذلك، يجب على الأطراف الدولية أن تكون على دراية تامة بالعوامل، التي تحفز هذه الجهات الفاعلة المختلفة على الانخراط في استراتيجيات فك الاشتباك وزيادة التأييد إلى أقصى حد في كل مرحلة من مراحل العملية السلمية.
الآليات المؤسسية للسلام:
بالإضافة إلى الآليات غير الرسمية للسلام، جرى تشكيل العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية بحيث يمكن تحسين مختلف العوامل، التي تمنع، أو تؤخر وصول السلام في العديد من البلدان والمناطق، غير أنها أشغلت جهدها بإدارة الصراع وليس منع حدوثه. وتعد جامعة الدول العربية، على ضعف مردوداتها، واحدة من أكثر المنظمات الإقليمية شهرة في هذا الجانب. رغم أن الأهداف الأساسية للجامعة، التي يتبناها منتدى الفكر العربي، تشمل تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتنسيق سياساتها، وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي من أجل إقامة تعاون دولي فيما بينها. وكوسيلة لحوار أعمق، تحاول الجامعة العربية أيضًا تنظيم القضايا بين الأطراف المتعاقدة قبل ظهورها. وتتوافق الأهداف الأخرى لجامعة الدول العربية مع الأهداف الأوسع للأمم المتحدة للسلام والتقدم العالميين، لأن الغرض من الجامعة هو السعي للحصول على السلطة التقديرية والسلطة الدولية للمجتمع من شكوى مباشرة من دولة عربية إلى مجلس الأمن، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومع ذلك، فإن جامعة الدول العربية، كمؤسسة قائمة على إجماع أعضائها، كانت غير فعالة تمامًا في نظر الرأي العام العربي. وفي حين تم تمرير العديد من اتفاقيات السلام عبر آلية جامعة الدول العربية، إلا أن هذا يحدث غالبًا من خلال التدخل الخارجي “الطرف الثالث” حيث تفشل الجامعة العربية نفسها بسبب تصرفات الدول الأعضاء، التي يمكن أن تمنع بسرعة تمرير اتفاق في هذه الاتفاقيات. ولا تزال أنشطة الجامعة العربية رهينة للعلاقات العربية البينية المليئة بالتوترات والتناقضات، التي أصبحت جزءًا من التقاليد العربية، ولأن السبب الرئيس للصراعات يكمن داخل الدول المعنية. وبهذا المعنى، فإن موقف الجامعة يتماشى مع الأمم المتحدة، وأن بناء السلام لا يمكن تحقيقه من دون مشاركة الحكومات، التي تمسك بمستقبل السيادة. وهذا ما تؤكده الصعوبات، التي تواجه إقامة عملية سلام في الضفة الغربية وغزة، لأنه بدأ جليًا أن الدول العربية ذاتها لا يمكن أن تتفق على تصور موحد لهذا السلام. ومن ثم، فإن المأزق قد استمر بالفعل لسنوات بعد التوصل إلى حل متفاوض عليه بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
المخاوف الأمنية:
ومن أهم العوائق، التي تعترض النهوض بمسألة السلام في البحث عن السمات المشتركة على المستويات المختلفة لهرم السلام الشواغل الأمنية. وتختلف هذه عن العنف المرتبط بالنزاع والإجراءات المسببة لهذا السلام بشكل عام لأنها أسباب معقدة لتصورات التهديد. ويتم تأطير هذه التصورات في نهاية المطاف ضمن منظور أمني وطني، أو إقليمي، أو دولي. ومن ثم، ينبغي التمييز بوضوح ذي مغزى بين الصراع والعنف لتأثيرهما على المواقف تجاه السلام والعناصر، التي تشكل الأهمية الأمنية. لذلك، فإن تقديم تعريفات مختلفة لماهية الأمن يمكن أن يشكل بمستوى كبير المواقف تجاه السلام. وبحكم هذا التعريف، فإن المخاوف مثل تدفق الأسلحة، والمنظمة الإرهابية الداخلية، أو الخارجية، والخوف من امتداد صراع قائم، أو صراع جديد بين الدول يفسح المجال لمفاهيم مختلفة للسلام. ويمكن لكل قضية لا تجد حلً ناجزًا أن تعيق السلام وتخلق الخوف وتعمل كمصدر جديد للعنف.
ولا تؤثر هذه العوامل على المواقف تجاه ما تخشاه الأطراف فحسب، بل إنها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستراتيجيات المضادة والمعايير الدولية. على سبيل المثال، في ظل ظروف السلام، أو الحرب، تتفاعل الثقة مع الأمن. ويمكن أن يؤدي المستوى العالي من الثقة إلى تهدئة مخاوف المتلقي من خلال ضمان أن المانح في حال انهيار التعاون لن يستخدم هذا التعاون الفاشل لصالحه. وهناك أيضًا أدلة تُشير إلى أن القلق بشأن هذه القضايا، وغيرها، يُترجم إلى نفاد صبر كبير فيما يتعلق بمعالجة القضايا طويلة الأمد مثل المياه واللاجئين والحدود والمشاركة، وغيرها من المجالات الصعبة. ومثل هذا الوضع يعمل على دفع تفشي أعمال العنف، ولا يمكن أن يكون من المستغرب أن يتعلق عدد لا يحصى من حوادث العنف به. وفي مثل هذا المناخ من انعدام الأمن، هناك ميل للأطراف إلى أن تصبح قدرية، وأكثر ميلًا إلى افتراض العنف، أو الموافقة عليه باعتباره “السبيل الوحيد”. ومن ثم، تتجه الأطراف لإنفاق مبالغ مهولة من الأموال على البنادق وغيرها من الخصائص والأدوات الأمنية المماثلة. ولكل ذلك، فإن التحديات القديمة معقدة، والتحالفات الجديدة تتعرض الآن للخطر الحقيقي بسبب هذه العملية المركبة من الحسابات بمجرد انتهاء الإضرابات المستمرة.
التنمية الاقتصادية:
لقد اتخذ منتدى الفكر العربي “الانتماء والإنماء” شعارًا واصفًا لتوجهاته، لأن البحث عن جوهر الهوية العربية والتعايش السلمي، أو العيش المشترك، متأصل في الواقع وينجذب الناس نحوه في الحاضر، ويتطلعون لتحقيق مثالاته وكمالاته في المستقبل. والرؤية الحاكة تقول بإنه يجب ربطه بما هو موجود على الصعيدين الوطني ودون الوطني، والبناء عليه، والتحرك نحو ما ينظر إليه على أنه سلام مرغوب فيه. ويستكشف هذا السلام كمجموعة من الظروف، التي تشكل تحديًا وفرصة في نفس الوقت. رغم أننا نعلم جميعًا أن الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، التي لم يتم حلها قد تؤدي إلى تأجيج المزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وزيادة التوترات الاجتماعية. وقد تستخدم المجتمعات الأكثر ثراءً تكنولوجيات أكثر تقدمًا، وتستغل المزيد من الموارد العربية، مما يزيد من خطر حدوث المزيد من الصراعات مع المجتمعات المحلية الفقيرة. وإذا تركت هذه المجتمعات بعيدًا عن الركب، فقد لا تشعر بالمسؤولية عن الحفاظ على النظام، وربما تشعر بالتهميش وتوافق على الوضع الراهن بنزاعاته وصراعاته، ولا تحفل كثيرًا بضرورات تثبيت عُرى السلام. وفي الوقت نفسه، يوفر تطوير البنية التحتية والوصول إلى مصادر المياه أمثلة قابلة للتكرار لتعزيز التوترات والعلاقات المستقرة بين المجموعات المتنافسة. وقد يؤدي المزيد من المركزية، أو اللامركزية المفرطة في إدارة المياه؛ مثل استثمارات البنية التحتية الأخرى، إلى تفاقم التوترات. وقد توفر الإدارة المشتركة للموارد، بدورها، حوافز اقتصادية لعلاقات الجوار المستقرة، بل وقد تقلل من خطر نشوب صراعات وتمارس ضغوطًا لحل النزاعات بين البلدان، أو في جميع أنحاء المنطقة.
ومن جانب آخر، فقد يؤدي الاستثمار في البنية التحتية والخدمات البيئية؛ سواء عبر الحدود، أو داخل المنطقة، أو المحلية، ورأس المال البشري ذي الصلة إلى تعزيز رفاهية المجتمعات المحلية وتلبية الاحتياجات البشرية وتعزيز نظام بيئي اجتماعي مستقر ومستدام. والفرص المتوازنة للتفاعل الاقتصادي لها علاقة تجريبية واضحة مع انخفاض احتمال اندلاع الأزمات السياسية؛ وفي المجتمعات، التي شهدت أزمة سياسية، وجد أن وجود فرص اقتصادية يقلل من مستوى العنف. وتكاد تكون الرغبة في الاتصال الاقتصادي عبر الحدود شرطًا مسبقًا للحوار حول السياسات والاتفاق بين القادة السياسيين الذين قد يساومون على تنازلات في هذا المجال. وقد أحدثت المساعدات الدولية تأثيرًا أكثر غموضًا، لأنها قد تنطوي على استراتيجيات التنمية المستدامة، التي تهدف إلى بناء مجتمع متكامل ومستدام ومنصف قائم على التماسك الاجتماعي، إلا أنها لا تخلو من مخاطر. ومن خلال التمييز والتوجيه المناسبين، ومن خلال الدعم والقيادة والترتيبات المناسبة، يمكن للتعاون الاقتصادي والتنمية أن يسهما في بناء السلام، والمساعدة على استقرار المجتمع، واستغلال إمكاناته الإنمائية، وخلق مستفيدين أقوياء، وتجنب الصراع الاجتماعي السياسي.
التحديات والفرص:
يرى منتدى الفكر العربي أن أية استراتيجية إقليمية وعالمية قوية للصمود على مبدأ السلام في الوطن العربي يجب أن تركز على مواجهة التحديات واغتنام الفرص؛ وما أكثرها في الاتجاهين. إذ إن التحديات، التي تواجه السلام والقدرة على الصمود في المنطقة العربية متعددة الأوجه وكبيرة. إذ إن انتشار الأسلحة وانتشار الصراعات يهددان أمن واستقرار كل الدول العربية. ويشكل المهاجرون واللاجئون الفارون من النزاعات المسلحة عاملًا مزعزعًا للاستقرار بالنسبة للبلدان المجاورة، وكذلك بالنسبة للأعضاء البعيدين في المجتمع الدولي. وينتشر التطرف العنيف، بكل مكوناته البغيضة، كالنار في الهشيم، ويغذي الحروب الأهلية في العراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، ولبنان، والسودان. وتؤدي الانقسامات الداخلية على مستوى المنطقة إلى تفاقم الصراعات في جوارها القريب والبعيد. وتسهل الطائفية والانقسامات العرقية والتشرذم السياسي والتنافس على تقاسم السلطة وتوزيع الموارد انتشار الآراء المتطرفة والراديكالية، التي ترفض الآخر، والمختلف، والضعيف، والمحروم. لذلك، فإن إرث الديكتاتورية والظلم الاجتماعي وتهميش المواطنين يؤدي إلى عدم المساواة والبطالة والفقر، مما يخلق بيئة خصبة للتطرف والتطرف. كما أنها تحد من الإمكانيات الاجتماعية والاقتصادية وفرص بناء السلام، كما تمثل التنمية الاقتصادية تحديًا جديًا للسلام؛ وطريقًا إلى السلام في آن واحد.
لهذا، فإن تحقيق التنمية المستدامة فرصة لبناء السلام في المنطقة، مثلما يفضي التكامل والتعاون وعمليات بناء الدوائر الاقتصادية والاجتماعية إلى القدرة على الصمود وتطوير بناء هذا السلام. ويمكن أن يكون هذا التكامل الاقتصادي بمثابة حافز، حيث يجمع مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص معًا لتطوير مبادرات ومشاريع مشتركة وتوافقية مستدامة وذات شرعية شعبية، التي يمكن أن تكمل وتعزز مبادرات السلام المحلية والوطنية والإقليمية. كما أنها وسيلة ممتازة لتقريب بناة السلام من الأعضاء العرب في المجتمع المدني، الذين غالبًا ما يعملون على مستوى القاعدة الشعبية، والذين عادة ما يكونون رجالًا ونساء لا يمتلكون سلطة سياسية، أو اقتصادية، لكنهم في الخطوط الأمامية في النضال من أجل السلام والعدالة. ويعد إدراج هذه المكونات أمرًا بالغ الأهمية لضمان تكييف مبادرات الصمود والسلام مع الاحتياجات الحقيقية، وأن متوافقة مع حقوق الأقليات من حيث النوع، والعمر، والدين، والمذهب، والعرق.
الخلاصة:
إن التصعيد الحالي للحروب غير المتكافئة من الأسفل، والتصعيد التدريجي للصراعات بين دول الشرق الأوسط، والبيئة الإقليمية ككل، يستلزم صياغة “سعي واسع النطاق من أجل السلام” من قبل الجماعات المُحارِبَة والدول العربية. ومن الأهمية بمكان أن يكون هذا المبدأ الموحد مدمجًا في إطار سياسي وطني وإقليمي أكبر؛ استراتيجيًا وتنمويًا، وسياسيًا موسعًا. وبتأكيدنا على فلسفة السلام المتسقة، لا نرغب في منتدى الفكر العربي إثارة جو من المثالية الرومانسية، ولكننا سعينا ونسعى إلى التحفيز على شق طريق نحو اتخاذ مبادرات وطنية ومبادرة قومية شاملة من شأنها أن تمكن وتعزز التعايش الحي الفاعل والمتفاعل والرخاء المشترك بالتكافؤ المتكافل. كما أن التعبير عن جهد عربي وإسلامي متكامل، أو مشترك من أجل الأمن والسلام يلجم تدخلات “الطرف الثالث”، ويلقي باللوم على خصومنا باعتبارهم لعنة على السلام. بل ويجعلهم عندما ينددون بتأكيدنا على الذات، ومطالبتنا بالكرامة الإنسانية والأمن، فإن دوافعهم الخاصة وميلهم المتصاعد إلى نفيها عَنَّا من خلال تحميل المسلمين المسؤولية عن العنف والإرهاب وزعزعة الاستقرار العالمي، ويجهض جميع حساباتهم، ويمكننا من تقديم مبادرات التفاوض العقلانية، التي يجب أن تظهر دائمًا في مقدمة مطالبنا للسلام والعيش المشترك.
بالإضافة إلى كل ذلك، وجدنا في المنتدى أن هناك عدة طرق، تاريخية ونظرية وعملية، يمكن أن تشكل جزءًا من السعي إلى السلام. وبعض المبادرات هي مبادرات شبه حكومية ومدنية، مثل تعزيز وإدماج ثقافة السلام والتعايش السلمي من الأسفل، التي تنفذ كمبادرة تراكمية للمجتمع المدني كمختبر لمزيد من الانتشار. ونأتي معًا للدفاع عن سلام مخطط له مع الحد الأدنى من التعايش التعاوني، من دون أن يكون لدينا بالضرورة اعتراف قانوني بخصوم أمتنا في “الطرف الثالث”. ومن هنا، نؤكد مرة أخرى على فكرة أن هناك حاجة ماسة إلى مناقشة هذه الروحانية المنسقة فيما يتعلق ببدائل السلام بين الأغلبية الساحقة من المواطنين العرب والاتفاق عليها كحاجة في مأسسة أمنية وتشريعية رسمية عربية ومنتديات فكرية عربية متجددة. ويجب أن يشمل الحوار المستمر في هذا السعي الأثيري الطبيعي من أجل السلام جدول أعمال واستراتيجيات واسعة. ومن الضروري وضع مخطط لمشروعات تكيفية لم يكتمل بناؤها أبدًا، لأنه يتوقف على الديناميات الإقليمية. وبعض الاتجاهات العلمية والاجتهادات الممكنة والسرديات المحتملة لصياغة عددٍ من البدائل، هي: أولًا، الانتقال من السعي إلى الرؤية، وهيكل إقليمي مشترك للسلام من أجل المشاركة المستقبلية؛ أي “عصر ما بعد المعاهدات”. وثانيًا، الإسهام في إعادة تشكيل الأخلاقيات والتآخي الروحي للعلوم الإنسانية الجديدة لإعادة التأكيد على الوحدة بين الدين وقيم الخير وأزمة الانقسام الناجمة عن الصراع القائم بين دراسات الاجتماعية والإنسانية والبحوث التطبيقية. وثالثًا، التشجيع على اجتثاث نوازع الأنانية من النفوس، والدعوة إلى خيرية التعاون والتكافل المتعدي للحد المحلي والوطني بإيجاد “صندوق عالمي للزكاة”، يعضد أدوار مؤسسات الزكاة الوطنية، ولا يلغيها. ورابعًا، التأكيد على الحاجة الملحة للتوعية الإعلامية المشتركة لتحفيز الأمة في الاستجابة لمبادرات السلام. وخامسًا، الاستمرار في الدعوة لـ”قانون عالمي للسلام” باعتباره ذروة سنام جهد المنتدى، وعروة مقاصده الوثقى.
* الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، المملكة الأردنية الهاشمية، أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية، جامعة سكاريا، تركيا
الأربعاء، 19 مارس 2025
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.