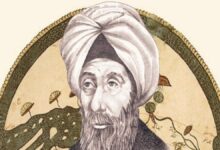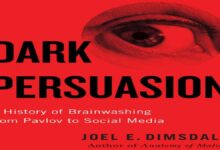الطرف الثالث:قراءة جديدة في إشكاليَّات العلاقات الدوليَّة
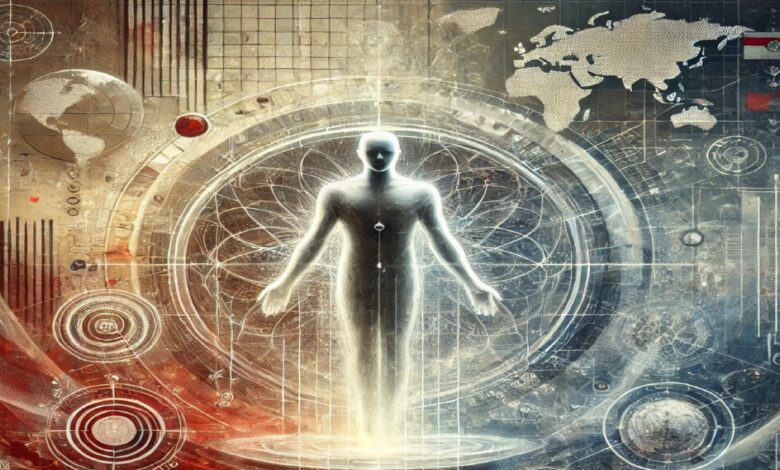
استهلال:
أحسن صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي وراعيه؛ كالعهد به، بإشارته الفَطِنَة لمسألة “الطرف الثالث”، كمحرك للأحداث الكبرى في المنطقة والعالم. وذلك عند اختتامه لمحاضرته الثرة، يوم الأربعاء 26 شباط/فبراير 2025، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، التي كانت بعنوان: “قراءة استشرافية للواقع الجيوسياسي المعرفي والعلمي العالمي الجديد”، والتي قدم فيها رؤيته لأهمية تدعيم الجهد العربي المشترك، في ظل التطورات العالمية المتسارعة. وقال أن هذا الدعم لا بد أن يمر عبر الصناديق الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع أدوارها لتصبح منصات إقليمية رائدة على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. داعيًا إلى إنشاء مبادرات إقليمية تمثل هياكل مصغرة وعابرة للحدود في منطقة المشرق والجزيرة، مثل مجلس المواطنين لبلاد الشام، ليكون مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات المنطقة، تقوده وتنظمه المنطقة نفسها، للمساهمة في النهوض بالمشتركات الإبداعية الإقليمية.
إن هذا المقال ليس تقريرًا عن المحاضرة، وليس القصد منه إيراد تفصيلاتها الكثيرة، ولكنه معنِيٌّ بأهم إشارة وردت على لسان سموه، ولم يقف عندها الحضور كثيرًا؛ وفقًا لما أبانته مداخلات وأسئلة المشاركين؛ والتي هي، في تقديري، عبارة “الطرف الثالث”، والتي تكررت أكثر من مرة في حديثه موحية إلى أن كثيرًا مما ننفعل به، وننخرط فيه، وننفق عليه الكثير من مواردنا وغير قليل من إرادتنا؛ من “حِلف بغداد”، إلى “حِلف المعاهدة المركزية- السنتو”، الذي كان تحالفًا ضد الشيوعية، وحتى “التحالف الدولي ضد الإرهاب”، فما هو إلا بعض صنيع “الطرف الثالث”. لذلك، ثارت الشبهات حول كل ما تواضعنا عليه من ترتيبات جمعية، بما في ذلك “جامعة الدول العربية”، لتتحكم “نظرية المؤامرة” في رؤيتنا لأنفسنا كـ”مُسْتَتبَع” والآخر “الفاعل”، الذي يؤكد ثبات حقيقة تدخلات القوى المهيمنة الخارجية، التي ظلت “تُجَمِّع وتُفَرِّق” في خصوصيات شأننا، وتعبث بمكونات ودول الإقليم تِبْعًا لمقتضيات مصالحها.
وخزة وعي:
لقد كانت إشارة سمو الأمير الحسن إلى حقيقة “الطرف الثالث” من دون أن يُسْهِب في تفصيلاتها، عبارة عن “وخزة” في وعينا العام، وتنبيه مقصود للدراسين للعلوم الاستراتيجية في كلية عسكرية مرموقة أن “خُذوا التاريخ مع الحاضر لاستشراف المستقبل”، مع كل اليقظة المطلوبة. إذ أن شبكة العلاقات المعقدة والمركبة، التي تتداخل بشكل محير أحيانًا بين حياة وأفعال قوى عظمى على رأس المجتمع الدولي تدعو إلى استكشاف مثير للاهتمام للديناميات المتعددة الأوجه، والتي تشمل مختلف الجهات الفاعلة الدولية. وتوجه الأحداث الهامة، التي تولدها، أو تؤثر فيها، بل والخطاب العام، الذي يحيط بهذه الأحداث المؤثرة للغاية. ويدفع هذا التعقيد الإشكالي إلى تفكير عميق، وربما مثير للحيرة، حول حقيقة التاريخ السياسي للعالم، وطبيعة وجاذبية نظريات المؤامرة كظاهرة. فنحن نعلم أن نظرية المؤامرة؛ في أكثر حالاتها طموحًا واستفزازًا للعقل التحليلي، تفترض أن الحدث المرصود ليس مجرد حدث، أو مصادفة عشوائية، بل هو نتيجة لأفعال منسقة جيدًا نابعة من اتفاق سري، أو غامض، تم التوصل إليه بدقة بين عدد من الجهات الفاعلة الدولية، التي تم إخفاء وجودها ونواياها ودوافعها عن أعين الرأي العام إلى حد كبير، أو هي هذا “الطرف الثالث” الحقيقي والمُتَخَيَّل. وتجبرنا مثل هذه النظريات المقنعة على التشكيك في الروايات التقليدية المقدمة لنا من خلال وسائط مختلفة والنظر في الديناميات الأساسية، التي تلعب دورًا خارج السطح. ولكن، يجب أن يجري فحص هذه الأسئلة الحارقة والمقنعة بدقة في إطار منظم للملاحظة من الدرجة الثانية، التي تؤكد على أن هذا الفحص النقدي والتحليل التفصيلي، هو لازم لفهم هذه التفاعلات المعقدة بشكل كامل. وينصب التركيز، الذي بُنِيَت عليه تفاصيل محاضرة سموه ومقاصدها، بشكل خاص على ضرورة بناء بيئة مفصلة قادرة على قراءة “تقديرات وسلوكيات” الجهات الفاعلة الدولية المؤثرة، وما تقوم به من الترويج لتعزيز حدث منظم جيدًا؛ تم ترتيبه والاتفاق عليه مسبقًا، ووُظِّفَت له مختلف الاستراتيجيات المعقدة، التي يمكن استخدامها ببراعة لضمان أن تتمكن جميع الأطراف المعنية من إنكار أي ادعاءات بالتآمر علنًا، أو الحفاظ على إمكانية الإنكار المعقولة في مواجهة التدقيق. ويتضح هذا النظر الفكري والمفاهيمي بوضوح من خلال الكثير من دراسات الحالة المستمدة من الرصد التاريخي الغني للقرنين التاسع عشر والعشرين، والتي تكشف كيف تجلت هذه الديناميات المعقدة تاريخيًا، وما هي المعرفة والآثار، التي تحملها على الفهم المعاصر لعالمنا اليوم.
تنشيط الذاكرة:
لقد ورد ذِكر “حِلف بغداد” و”حِلف المعاهدة المركزية”، وهما صنيعة “الطرف الثالث” بامتياز، كهدف متقدم في استراتيجية التصدي للمد الشيوعي. إذ إنه في أعقاب الحرب العالمية الثانية، برزت قوتان عالميتان رئيسيتان هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وشكل الصراع بينهما إطارًا للحرب الباردة، حيث سعت كلتا القوتين إلى توسيع نفوذهما السياسي والعسكري في أنحاء العالم. وبينما كان السوفييت يواصلون توسيع مناطق نفوذهم في أوروبا الشرقية، كانت إحدى المناطق، التي يتطلعون للوصول إليها هي الشرق الأوسط. وقد اعتبرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا الشرق الأوسط منطقة حيوية لمصالحهما الأمنية، وكانت بريطانيا على وجه الخصوص مرتبطة بالمنطقة، فقد كانت دائماً الدولة الأكثر نفوذاً فيها، وبعد الحرب العالمية الثانية، تعاملت بريطانيا مع أمن المنطقة باعتباره شديد الأهمية بالنسبة لها، ولكن تراجع قوة بريطانيا مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي كان يُثير تساؤلات متزايدة حول قدرتها على حماية ما تبقى من مصالحها في الشرق الأوسط. لذلك، أعربت حكومة الولايات المتحدة في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي عن اهتمامها بتشكيل حلف عسكري في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد التمدد الشيوعي السوفييتي إلى مناطق إنتاج النفط الحيوية. ولذلك، سعت واشنطن إلى إنشاء تحالفات إقليمية تهدف إلى احتواء الشيوعية، فجاء “حِلف بغداد” و”حِلف المعاهدة المركزية” كجزء من هذه الاستراتيجية، حيث كان الهدف بناء جدار من الدول المتحالفة يمتد من تركيا إلى باكستان.
وبالعودة إلى أضابير التأريخ نَجِدُ أن بداية هذين الحلفين ترجع إلى فبراير عام 1955، وذلك عندما عقدت تركيا والعراق ميثاقًا دفاعيًا بينهما، ثم انضمت إليهما بريطانيا “الطرف الثالث” في أبريل عام 1955، والباكستان في يوليو عام 1955، وادخِلَت إيران في نوفمبر عام 1955. وكانت بريطانيا تأمل في انضمام الأردن إليه، لكنها في 14 يناير/ كانون الثاني من عام 1956، أعلنت رفضها الانضمام. وقد فشلت محاولات نوري السعيد، رئيس الحكومة العراقية وقتها، في إقناع بعض الدول العربية للانضمام إلى هذا الحلف، بل إن جمال عبد الناصر قاوم إنشاء هذا الحلف وقتها، وكان عقبة أمام انضمام أية دولة من الدول العربية. ويمكن ملاحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية؛ “الطرف الثالث” الأهم، لم تنضم إلى هذا الحلف، رغم دورها الرئيس في التحريض على قيامه، إلا في مارس/ آذار عام 1959، بعد انسحاب العراق في عام 1958. وفي عام 1979 انسحبت إيران بعد الثورة الإسلامية وسقوط الشاه من “حلف المعاهدة المركزية”، ليتم حله في نفس العام. من هنا، فإن وقائع التاريخ تُحدِثنا أن “الطرف الثالث” هو الذي حرض وأملى على الدول المشاركة الانضمام، لأن هذا يرتبط بالقيمة الاستراتيجية الهائلة لمنطقة الشرق الأوسط من الناحية العسكرية، باعتباره متاخمًا للاتحاد السوفيتي مصدر خطر المد الشيوعي، ثم القيمة الاقتصادية لهذه المنطقة باعتبارها مركز أكبر احتياطي للبترول في العالم. وقد تشكل حلف بغداد في نفس الوقت الذي تأسس فيه كل من حلف “حلف شمال الأطلسي- الناتو”، و”منظمة معاهدة جنوب شرق آسيا”، إذ حاولت تلك التحالفات محاصرة الاتحاد السوفييتي من خلال سلسلة من المنظمات العسكرية الموالية للغرب. وقد ظهرت فكرة التحالفات الثلاثة بعد أن عاد وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس إلى واشنطن من جولته في الشرق الأوسط في مايو/ أيار من عام 1953 حيث اقترح تشكيلًا دفاعيًا لدول تمتد عبر أوراسيا لاحتواء الشيوعية. ومثل دالاس، تختزن الأضابير “معلومة” أن أول من تحدث، بصورة رسمية، حول ضرورة وجود كيان سياسي يجمع الدول العربية في عام 1941، هو أنتونى إيدن، وزير الخارجية البريطاني الأسبق.
الأطر النظرية:
تُعتبر الأطر النظرية التقليدية مكونات أساسية لتخصص العلاقات الدولية، وتوفر نهجًا منظمًا لتحليل سلوك الدول والتفاعلات العالمية؛ من بين أبرز النماذج الواقعية والليبرالية والبنائية التقليدية، رغم ما نشهده الآن من “توتر واضطراب” في كل المعايير تحت القيادة الجديدة للبيت الأبيض. فقد كانت كل من هذه النظريات، قبل مجيء الرئيس دونالد ترامب، تقدم توضيحًا للدوافع الكامنة وراء السلوك الدولي، وتؤكد على إمكانية “التوقع” لضرورة التأثير الدولي. وكانت المنافسة على الهيمنة العالمية تشجع الدول على البناء على مواردها والتصرف بطريقة المصلحة الذاتية، وفقًا للتوازنات المتاحة. لكن في هذا الوقت، علينا أن نفهم شكل وطبيعة السياسة الدولية على أنها فوضوية، مما يمنع ظهور نظام عالمي مستقر. وبالتالي، تهدف كل الدول الآن إلى تعظيم قوتها مع حماية نفسها من التهديدات، لأن حتى النظرية الليبرالية، التي كانت تنظر إلى التبعية والثقة باعتبارهما المحفزين الأساسيين لإنشاء تفاعلات عالمية، تستند إلى الاقتصادات والمعايير، لم تعد صالحة لاختلال هذه المعايير. وقد كان يُعتقدُ أن الترابط يقلل من خطر الصراع، ويعزز الرخاء العالمي، ويساهم في تحقيق فوائد القيم المتبادلة بشكل أكبر. في المقابل، صار يُنظرُ إلى الاتفاقيات على أنها لا تدعم التفاهم بين الدول، ولا تضمن حوكمة عالمية موثوقة. وبصفة عامة، يعتقد الآن أن الدعم بين الدول والجهات الفاعلة ذات المنظور الموحد “الطرف الثالث” قد يزيد من فوضى العولمة، ولا يحد من العداء حتى بين حلفاء الأمس.
لهذا، فإن الحديث عن “الطرف الثالث” اعتمد على تقرير “الحال”، أو استصحاب التاريخي والراهن ضمن “الرؤية” الكونية الكلية لمسألة النظر الاستراتيجي؛ بفرصه وتحدياته، ومنطلقات هذه الرؤيا الاستشرافية، وفقًا لسياقاتها المتعددة؛ بمآلاتها وإكراهاتها الديمغرافية والجغرافية. وما مشاكل العلاقات الدولية ونظرية المؤامرة إلا مقدمات تتكئ على الفرضية الأساسية المتمثلة في أن المبادرات بعيدة المدى، التي تهدف إلى تغيير العالم تقع في الغالب ضمن الاختصاص المهيمن للشركات متعددة الجنسيات، والائتلافات الحكومية والمنظمات الدولية الربحية وغير الربحية، التي توسط الإشارة إليها حديث سمو الأمير الحسن. وحتى الآن، تتعلق معظم الموضوعات، التي وردت في الحديث بشبكات إمدادات الطاقة الصناعية الضخمة، ومشاريع النقل الواسعة؛ القديمة والمستحدثة، على نطاق عالمي. ويمكن بالفعل توسيع هذا المنظور وتفصيله؛ فرؤية سموه الأوسع تفتح مساحة كبيرة للعديد من السياقات الإضافية للفهم والتفسير في دراسة الطبيعة المعقدة لـ”الطرف الثالث”. ففي حين أن المؤسسات العالمية غالبًا ما تصنف على أنها أهم اللاعبين إلى جانب حكومات بلدان معينة، إلا أنها شكلت فعليًا نوعًا من قوة “الطرف الثالث”، بمعنى فهمنا وتصوراتنا العامة لهذا المفهوم المعقد. ونعلم يقينًا أن التجارة والسياسة الدولية في العصر الحديث، تزداد تعقيدًا، وأولئك الذين يعملون بإخلاص من أجل غايات مرغوبة في هذه المجالات لديهم مجموعة أدوات واسعة النطاق، لكن لا يملكون كل أسرار التحكم في غاياتها.
ولهذا، يمكننا القول إن هذا ربما يكون سيفًا ذو حدين، مما يعني أنه كلما زادت الإجراءات المحتملة في هذا المشهد المربك، زادت الطرق، التي يمكن لأولئك الذين يقفون ضد مثل هذه الإجراءات من خلالها اتخاذ مواقف المضادة لمعارضة مخططاتهم وخططهم. ويمكن للمرء بعد ذلك المضي قدمًا بالإشارة إلى أنه بصرف النظر عن الإمكانيات الهائلة، التي تم فتحها بفضل التجارة المعولمة، والأنظمة المصرفية الدولية، والاستثمارات المتعددة المستويات، وتلك العوائد المختلفة الناشئة بشكل غير مباشر عن كل من المؤشرات الاقتصادية السابقة، والمشاركة السياسية للهياكل فوق الوطنية، لا يزال المجال معقدًا بشكل لا يصدق، ومليئًا بعدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بالعديد من العملاء السِرِّيين الذين يعملون خلف الظل. وبإدراكنا لكل أشكال الخطط وأنواع آليات القوة، التي يوظفها “الطرف الثالث”، نكون بهذه الطريقة، مستعدين لتصور مناقشة جادة للتوجهات وفحص لمظان الاحتمالات بعقل وقلب يقظين. ومن الأهمية بمكان إيلاء اهتمام دقيق لكامل السلوكيات والإجراءات المنحرفة المحتملة، التي يتخذها من يدخلون ضمن تصنيفات “الطرف الثالث” من النجوم الجدد الناشئة في كل من القدرات الاقتصادية والعسكرية على المسرح العالمي؛ كالصين والهند وغيرهما. وهذا يشمل الموضوعات، التي تعتبر عادة عرضية للغاية؛ مثل التأثير اللاشعوري على المواجهة والعدوان من قبل الجهات الفاعلة، التي تتباهى ببراعة تكنولوجية تتجاوز بكثير المعرفة الحديثة الحالية. وحتى وجود مركبات يتم التحكم فيها خارجيًا، ويفترض أنها مصممة هندسيًا مما يمكن أن ينظر إليه على أنه ساحة معركة أخرى للقوى العالمية، التي تتنافس على السيطرة.
خاتمة:
إجمالًا لكل ما مضى، فإن تصورنا لخاتمة هذا المقال لا بد أن تُقِرُّ أن محاضرة صاحب السمو الأمير الحسن بُنِيَت على أسس فكرية، قد تبرر الرؤيا فيها كل شروط الواقعية السياسية والحصافة الدبلوماسية، لأنها أدركت واقعًا تمضي أحداثه بيننا، وإن تجذرت بعض جوانبها في الماضي. وقطعًا لا يدخل أي قول فيها ضمن نطاق نظرية المؤامرة العالمية، خاصة إذا اقتنعنا وفقًا للحيثيات أن هذه المؤامرة كانت على الدوام فعلًا مقصودًا، بتخطيط وتنفيذ “الطرف الثالث”. وتوفر الحالات المذكورة في هذا المقال، وغيرها مما هو طارئ ومزدوج الأبعاد، حتى لو تمثل فيه أعلى قدرٍ من ضبط النفس من قبل “طرف ثالث”، فرص الموافقة المحتملة من قبل جمهور عالمي، وتُعّدُّ نقطة انطلاق للحوار بين كلا الطرفين والتقائهما. وفي تقديرنا، لا يمكن استبعاد هذه القضية، التي تبدو خيالية تمامًا في أعقاب العديد من المشكلات التعاقدية الخبيثة في الماضي، بين هذا “الطرف الثالث” والجمهور العالمي، أو فيما نواجهه من معضلات بسبب النفوذ المتزايد للشركات العملاقة، التي تتعامل مع الصناعات المتطورة والتقنيات المبتكرة، والتي أصبحت نقطة محورية للعديد من المناقشات الأخلاقية. فقد دعتنا المحاضرة للانتقال إلى الوعي الأعلى في تحليلنا، عند النظر إلى الكيانات متعددة الأوجه، التي غالبًا ما تعتبر مشبوهة بشكل شامل، جنبًا إلى جنب مع المحددات النفسية والاجتماعية، التي تؤثر على قبول نظريات المؤامرة بين مجموعات سكانية متنوعة. من ناحية، فإن التحيز المعرفي، والحاجة الفطرية إلى اليقين، ومجموعة من العوامل النفسية الأخرى تدفع الأفراد نحو أنماط التفكير المشوهة بشكل عام حول التاريخ والوضع الحالي لعالمنا، التي جرى تفصيلها. ومن ناحية أخرى، تناقش عوامل مثل ديناميات المجموعات وقضايا الثقة المجتمعية العامة المقترنة بارتفاع مستوى الوعي، مع التركيز بشكل خاص على الحالة الخاصة في فلسطين كدراسة حالة. فقد تعمدت المحاضرة توضيح كيفية ارتباط هذين المستويين من التفكير وتأثيرهما على بعضهما البعض، مع تسليط الضوء على خصائصهما وروابطهما المشتركة. ويسمح هذا التحليل متعدد المستويات برؤية أكثر دقة حول سبب إعجاب بعض شرائح الجمهور بنظريات المؤامرة أكثر من غيرها، مما يكشف عن طبقات الإدراك والتفسير، التي تشكل أنظمة المعتقدات الجماعية، بينما ركزت المحاضرة على وقائع كانت، وتَمَثُّلاتها حاضرة، وحثت الحضور على استشراف المستقبل.
* الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، الأردن
الاثنين، 4 مارس/آذار 2025
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.