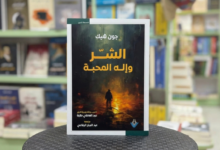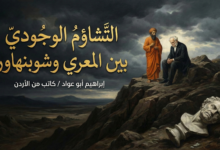دبلوماسيَّة الإكراه: وسائل قاسية وإجراءات قسريَّة لأهداف غير عادلة

مقدمة:
حظي مفهوم الدبلوماسية القسرية باهتمام كبير في الأدبيات الأكاديمية، مما سلط الضوء على تعقيداته وآثاره بعيدة المدى في مجال العلاقات الدولية. لذلك، فإن الفحص الشامل للإكراه في مجال القانون الدولي يعبر ببراعة عن رؤى العديد من العلماء، الذين يشددون بقوة على أهمية فهم القيود المتأصلة في الإكراه والضرورة الملحة لاستخدام استراتيجيات بديلة. وتتمثل إحدى الحجج الرئيسة المطروحة في أن الإكراه غالبًا ما يستغل نقاط الضعف المتأصلة في الأطراف الأضعف، التي قد تفتقر إلى الوعي الحاسم بخياراتها المختلفة. وهذا يطرح حجة مقنعة للدعوة إلى الإقناع كنهج بناء وإيجابي أكثر للتأثير على السلوك وتسوية النزاعات. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هذا المبحث على الدور المحوري للتفاوض على المكاسب المتبادلة ويشدد على أهمية تبادل المعلومات في تعزيز عمليات حل المشكلات الفعالة. كما ينبه إلى خطورة احتمال تحول الإقناع إلى الإكراه، وهو تحول يمكن أن يعرض في نهاية المطاف حياد الوسطاء المشاركين في عملية التفاوض للخطر ويؤثر على النتائج الإجمالية للجهود الدبلوماسية، كما أوضحت ذلك أمليا إسبين (إسبين، 2009).
وبناء على هذه الحجة، تتحدى ساندرا رابوني (رابوني، 2015) فكرة أن الإنفاذ القسري هو شرط أساس للقانون، لا سيما في السياق الدولي. ومن خلال دحض الشكوك المحيطة بشرعية القانون الدولي، تفترض رابوني أنه في حين أن الإكراه قد يعزز الامتثال محليًا، إلا أنه أقل فعالية على المستوى الدولي. ويجادل المبحث بضرورة القبول العام للقواعد القانونية الدولية ودور المؤسسات الرسمية في تفسير هذه القواعد، وبالتالي تأطير مناقشة الإكراه في سياق قانوني وأخلاقي أوسع. ويدرس جيمس باتيسون (باتيسون، 2015) كذلك الأبعاد الأخلاقية للدبلوماسية القسرية، لا سيما من خلال عدسة النقد الدبلوماسي. ويقدم حجة مقنعة لاستخدام الوسائل الدبلوماسية كبديل مفضل للتكتيكات الأكثر قسرًا. ومن خلال التأكيد على أهمية المخاوف المتعلقة بالسمعة، يوضح باتيسون كيف يمكن للدول أن ترد على الانتقادات الدبلوماسية للتخفيف من التهديدات لشرعيتها. ويضيف هذا المنظور طبقة دقيقة لفهم الدبلوماسية القسرية، مما يشير إلى أن التدابير غير القسرية يمكن أن تسفر عن نتائج سياسية مهمة.
لهذا، يتم استكشاف العلاقة المعقدة بين الشرعية والإكراه في بناء السلام من قبل جوليا جيبرت (جيبرت، 2017)، التي تجادل بأن الإكراه يجب أن تمارسه المؤسسات الشرعية ليكون فعالًا. وبالاعتماد على أمثلة تجريبية من بعثات الاتحاد الأوروبي، وتسلط جيبرت الضوء على التوازن الدقيق بين ممارسة القوة القسرية والحفاظ على الشرعية بين السكان المحليين. وهذا التفاعل حاسم لفهم كيفية إدماج الإكراه في جهود بناء السلام دون تقويض الأهداف ذاتها، التي يسعى إلى تحقيقها. ويحول هايتامي بيترا (بيترا، 2019) التركيز إلى أمثلة معاصرة للدبلوماسية القسرية، لا سيما استراتيجيات الصين في بحر الصين الجنوبي. ويحدد المبحث مناهج مختلفة للدبلوماسية القسرية، وتوضح كيف تستخدم الدول التهديدات والوجود العسكري للتأثير على سلوك الآخرين. ويؤكد بيترا تحليل الآثار الضارة لمثل هذه الممارسات على العلاقات الدولية، لا سيما في سياق الإجراءات الصينية الحازمة وآثارها على الاستقرار الإقليمي.
ولهذا، فإن كاتبًا مثل آرثر ميشلينو، (ميشلينو، 2022) يضع الدبلوماسية القسرية في الإطار الأوسع للتنافس بين القوى العظمى، موضحًا دورها الاستراتيجي في السياسة الدولية. ويوضح المبحث كيف تعمل الدبلوماسية القسرية كحل وسط بين التفاوض السلمي والنزاع المسلح، بالاعتماد على استراتيجيات الردع لإجبار الامتثال. ومن خلال التفكير في دراسات الحالة التاريخية، مثل أزمة الصواريخ الكوبية، ويوضح ميشلينو إمكانية الدبلوماسية القسرية لحل التوترات دون التصعيد إلى حرب. وتسلط الأدبيات الضوء بشكل جماعي على الطبيعة المتعددة الأوجه للدبلوماسية القسرية، وتكشف عن أبعادها الأخلاقية والقانونية والاستراتيجية، مع الحث على التفكير النقدي حول فعاليتها وعواقبها في العلاقات الدولية.
مراجعة الأدبيات:
في مقالتها “استخدام تسوية المنازعات الدولية لمعالجة مسألة الامتثال في القانون الدولي”، تُقدِّم أمليا إسبين (إسبين، 2009) فحصًا شاملًا للديناميات بين الدبلوماسية القسرية وتسوية المنازعات الدولية (IDR). وتفترض الأطروحة المركزية للمبحث أن الإكراه غالبًا ما يستغل افتقار الطرف الأضعف إلى المعرفة فيما يتعلق بالتكتيكات والخيارات المتاحة. ومن خلال تمكين الأطراف من خلال IDR، يمكن لأصحاب المصلحة التعرف بشكل أفضل على التكتيكات القسرية ومحاسبة المشاركين الآخرين، مما يساهم في النهاية في الحد من الممارسات القسرية. وتشدد إسبين على أهمية فهم أوجه القصور في الإكراه وتدعو إلى إيجاد بدائل، ولا سيما الإقناع. وتُعَرِّف الإقناع بأنه طريقة لتغيير السلوك تعمل من خلال نشر المعلومات والحوافز والأعراف الاجتماعية. ويسلط هذا المنظور الضوء على جانب حاسم من حل النزاعات؛ أي إمكانية نظرية التفاوض المتبادلة لتسهيل التعاون بين الأطراف. ومن خلال تعزيز تبادل المعلومات وتعزيز العلاقات الجيدة، يمكن لـIDR تعزيز فعالية حل المشكلات.
ومع ذلك، تُحذر إسبين من الخط الرفيع بين الإقناع والإكراه. يجب على الوسطاء توخي الحذر للحفاظ على حيادهم، لأن أي تحول من التكتيكات الإقناعية إلى التدابير القسرية يمكن أن يعرض عملية الوساطة للخطر. وهذه البصيرة مهمة بشكل خاص في السياقات، التي تكون فيها المخاطر عالية، وميزان القوى غير متساو. ويوضح المبحث أيضًا تعقيدات الدبلوماسية القسرية من خلال مثال صراع أيرلندا الشمالية. وتلاحظ إسبين أن محاولات إجبار الجماعات شبه العسكرية على إيقاف تشغيل أسلحتها باءت بالفشل إلى حد كبير. وتؤكد هذه القضية على ضرورة إنشاء عمليات تسمح لأصحاب المصلحة بالسعي وراء مصالحهم بشكل تعاوني، بدلًا من تكتيكات الضغط. وتُقدم مفهوم التثاقف، مما يشير إلى أن منظمات حقوق الإنسان الدولية يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تشكيل عمليات صنع القرار للأطراف المشاركة في النزاعات. ومن خلال تشجيع الأطراف على النظر في القانون الدولي والأعراف الدولية، يمكن لهذه المنظمات أن تهيئ بيئة أكثر ملاءمة للامتثال والتعاون. وفي مقالها، “هل الإكراه ضروري للقانون؟ ودور الإكراه في القانون الدولي والمحلي” تنخرط ساندرا رابوني (رابوني، 2015) في نقاش نقدي حول طبيعة القانون الدولي وفعاليته، لا سيما فيما يتعلق بآليات الإنفاذ القسري. والادعاء الأساس، الذي تناولته رابوني هو الشكوك المحيطة بشرعية القانون الدولي بسبب افتقاره الملحوظ إلى نظام مركزي للعقوبات القسرية، وهي وجهة نظر غالبًا ما يعبر عنها النقاد الذين يجادلون بأن هذا الغياب يقوض مكانة القانون كقانون “حقيقي”.
لهذا، تتحدى رابوني هذه الشكوك من خلال افتراض أن الإنفاذ القسري ليس شرطًا ضروريًا لوجود قانون، أو التزامات قانونية. وتشدد على أنه في حين أن الإكراه يمكن أن يعزز الامتثال ضمن الأطر القانونية المحلية، فإن تطبيقه على المجال الدولي محفوف بالتعقيدات وغالبًا ما يثبت أنه أقل فعالية. ويدعو هذا التأكيد إلى إعادة تقييم الافتراضات الأساسية حول العلاقة بين الإكراه والقانون، مما يشير إلى أن جوهر القانون يتجاوز مجرد الإنفاذ القسري. كما تقرر المادة عنصرين حاسمين يحددان طبيعة القانون الدولي: ضرورة القبول العام للالتزامات القانونية بين الدول وأهمية التفسير الرسمي للقواعد القانونية وتطبيقها من قبل المؤسسات المعترف بها. وتؤكد رابوني حجة القانون الدولي على أن شرعية القانون الدولي تنبع من قبوله والتزامه من قبل المجتمع الدولي وليس من الآليات القسرية. ويتماشى هذا المنظور مع فهم أكثر دقة لكيفية عمل القانون الدولي، مع الاعتراف بدور المعايير والاتفاقيات والموافقة المتبادلة في تعزيز الامتثال. لذلك، فإن عمل رابوني مهم بشكل خاص في سياق الدبلوماسية القسرية، حيث يسلط الضوء على قيود وتحديات استخدام الإكراه كأداة لإنفاذ الالتزامات القانونية الدولية. ومن خلال توضيح أن الإكراه قد لا يكون الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق الامتثال، يدعو المبحث العلماء والممارسين إلى النظر في مناهج بديلة تعطي الأولوية للحوار والتفاوض وبناء الإجماع.
وفي “أخلاقيات النقد الدبلوماسي: مسؤولية الحماية ونظرية الحرب العادلة والملاذ الأخير الافتراضي” يتعمق جيمس باتيسون (باتيسون، 2015) في الدور الدقيق للنقد الدبلوماسي، لا سيما في سياق دبلوماسية الإكراه القسرية وآثارها الأخلاقية. ويدرس المبحث بشكل نقدي كيفية استخدام الدول لأشكال العقوبات السياسية، وتحديدًا من خلال آلية “التسمية والعار”، للتأثير على سلوك العملاء المخالفين. ويجادل باتيسون بأن هذا الشكل من الدبلوماسية القسرية يمكن أن يكون بديلًا قابلًا للتطبيق لأشكال التدخل الأكثر عدوانية، بما يتماشى مع مبادئ نظرية الحرب العادلة، ولا سيما مفاهيم الملاذ الأخير والضرورة. ويتمحور تحليل الفرضية القائلة بأن النقد الدبلوماسي لا يعمل فقط كإجراء عقابي، ولكن كأداة بناءة محتملة لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية. ويفترض باتيسون أن الدول مدفوعة بكل من “منطق العواقب” و”منطق الملاءمة”. ويشير الأول إلى الحسابات الاستراتيجية، التي تقوم بها الدول لحماية مصالحها، بينما يتعلق الأخير بالالتزام بالتوقعات المعيارية داخل النظام الدولي. ويؤكد هذا الإطار المزدوج على تعقيد سلوك الدولة ردًا على الانتقادات، مما يشير إلى أن التهديد بإلحاق الضرر بالسمعة يمكن أن يجبر الدول على تعديل أفعالها.
تتمثل إحدى المساهمات المهمة في عمل باتيسون في استكشاف الأبعاد الأخلاقية المحيطة بواجب النقد. ويوضح أن هناك التزامًا أخلاقيًا للدول بالانخراط في النقد الدبلوماسي، خاصة في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو الأفعال غير المشروعة. ويرتكز هذا الواجب على الاعتقاد بأن النقد يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، حيث قد تسعى الدول المخالفة إلى التخفيف من الضرر، الذي يلحق بسمعتها من خلال معالجة القضايا المثارة. وبالتالي، لا يتم تأطير النقد الدبلوماسي على أنه إجراء عقابي فحسب، بل كخطوة ضرورية نحو تعزيز المساءلة وتعزيز المعايير الدولية للسلوك. ومع ذلك، في حين أن باتيسون يحدد بشكل فعال الفوائد المحتملة للنقد الدبلوماسي، فإن المبحث تدعو أيضا إلى التفكير النقدي في حدوده. يمكن أن تختلف فعالية التسمية والعار كاستراتيجية اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على السياق والجهات الفاعلة المحددة المعنية. على سبيل المثال، قد تظل الدول، التي لا تولي اهتمامًا للشرعية الدولية سوى عدم الاستجابة للنقد الدبلوماسي، مما يثير تساؤلات حول الفعالية الإجمالية لهذا النهج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يستفيد المبحث من استكشاف أعمق لعواقب مثل هذا الانتقاد، لا سيما في الحالات، التي قد تؤدي فيها إلى تفاقم التوترات، أو تؤدي إلى تدابير انتقامية.
وفي “الشرعية والإكراه في بناء السلام: عمل متوازن” تُقدم جوليا جيبرت (جيبرت، 2017) يقدم فحصًا دقيقًا للتفاعل بين الإكراه والشرعية في سياق عمليات بناء السلام، مع التركيز بشكل خاص على بعثات الاتحاد الأوروبي في كوسوفو والبوسنة والهرسك. وتفترض في مبحثها أنه لكي يتم استخدام الإكراه بشكل فعال دون الانحدار إلى الاستبداد، يجب أن تمارسه مؤسسة شرعية. وهذا التأكيد أمر بالغ الأهمية، لأنه يسلط الضوء على الشرط المزدوج لأية هيئة إدارية لامتلاك سلطة فرض الامتثال والاعتراف بتلك السلطة على أنها شرعية من قبل المحكومين. ويُؤكد تحليل جيبرت أن احتكار العنف، المرتبط تقليديًا بسلطة الحاكم، غير كاف في حد ذاته. بدلًا من ذلك، تلعب الشرعية دورًا محوريًا في تحديد فعالية التدابير القسرية. ويجادل المبحث بأنه في حين أن القوة العسكرية يمكن أن تعمل على تعزيز شرعية جهة فاعلة معينة، فإن القوة القسرية المفرطة، أو غير المقيدة يمكن أن تقوض هذه الشرعية في النهاية، مما يؤدي إلى مزيد من الصراع. وتبرز هذه العلاقة بشكل خاص في سياقات بناء السلام، حيث يعد دعم السكان المحليين والنخب أمرًا ضروريًا لنجاح مبادرات الإصلاح.
من خلال البيانات التجريبية المستمدة من استطلاعات الشرعية والمقابلات شبه المنظمة مع أفراد الشرطة والعدالة المحليين، تُقدِّم جوليا جيبرت تقييمًا أساسيًا لكيفية تأثير تصورات الشرعية على فعالية مهام بناء السلام. وتشير النتائج إلى أنه في حين أن القوة القسرية يمكن أن تكون أداة للإنفاذ، فإن تطبيقها الناجح يتوقف على المشاركة التعاونية للجهات الفاعلة المحلية. وهذا النهج التعاوني أمر بالغ الأهمية، لأنه يؤكد على الحاجة إلى الامتثال الطوعي بدلًا من مجرد الإكراه. وعلاوة على ذلك، يكشف فحص جيبرت لبعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو وبعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك عن التعقيدات، التي تواجهها البعثات الدولية في تحقيق التوازن بين القوة القسرية والحاجة إلى الشرعية. ويوضح المبحث بشكل فعال أن بناء السلام هو مسعى دقيق حيث يمكن أن يؤدي سوء إدارة الأدوات القسرية إلى تدهور الثقة والتعاون بين أصحاب المصلحة المحليين.
ومن منظور آخر، يقدم مقال “الدبلوماسية القسرية الصينية من خلال صراع بحر الصين الجنوبي ومبادرات الحزام والطريق” بقلم هايتامي بيترا (بيترا، 2019) فحصًا شاملًا للدبلوماسية القسرية، التي تستخدمها الصين في سياق نزاعات بحر الصين الجنوبي ومبادرة الحزام والطريق الأوسع. ويُعَرِّف بيترا الدبلوماسية القسرية بأنها نهج استراتيجي يستخدم أشكالًا مختلفة من الضغط – بما في ذلك القوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية والاتفاقيات غير المتكافئة – للتأثير على سلوك الدول الأخرى. وهذا التعريف مهم لأنه يضع إطارًا لفهم التكتيكات المحددة، التي تستخدمها الصين في ارتباطاتها الإقليمية. يحدد المبحث أربعة أشكال مختلفة من الدبلوماسية القسرية: نهج “جرب وانظر”، ونهج “الدوران التدريجي للبراغي”، ونهج “الإنذار النهائي الكلاسيكي”، ونهج “الإنذار الضمني”. ويقدم كل متغير نظرة ثاقبة حول الحسابات الاستراتيجية وراء تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي. على سبيل المثال، قد يتجلى نهج “الإنذار الكلاسيكي” في المطالبات الإقليمية الحازمة للصين، لا سيما من خلال الخط المثير للجدل المكون من تسع متقطعات، والذي يجادل فيه بيترا بأنه ممارسة دبلوماسية غير قانونية. وهذا الادعاء مهم لأنه يعكس محاولة الصين إضفاء الشرعية على تأكيداتها الإقليمية التوسعية في منطقة محفوفة بالمصالح المتنافسة.
ويسلط تحليل بيترا الضوء على الآثار الضارة للتكتيكات القسرية للصين على الدول المجاورة، لا سيما من خلال تصعيد الوجود العسكري وتكتيكات الترهيب. لذلك، فإن نشر السفن الحربية، وخاصة الحادث، الذي تورطت فيه 95 سفينة صينية حول جزيرة ثيتو لردع أنشطة البناء الفلبينية، يجسد الموقف العدواني، الذي يميز استراتيجية الصين. وهذا لا يقوض الاستقرار الإقليمي فحسب، بل يشكل تحديات للمعايير الدولية فيما يتعلق بالحقوق البحرية والسيادة الإقليمية. وعلاوة على ذلك، ينتقد المبحث الأبعاد الاقتصادية للدبلوماسية القسرية الصينية، لا سيما من خلال مبادرة الحزام والطريق، التي ينظر إليها على أنها وسيلة لممارسة التأثير على الدول النامية. وهنا يجادل بيترا بأنه في حين أن هذه المبادرة تقدم فرصا لتطوير البنية التحتية، إلا أنها تضع هذه البلدان في الوقت نفسه في مواقف محفوفة بالمخاطر، مما قد يؤدي إلى التبعية الاقتصادية والسيادة المعرضة للخطر. ومن حيث التقييم النقدي، يوضح المبحث بشكل فعال آليات وآثار الدبلوماسية القسرية للصين، ويوفر فهمًا دقيقًا لطموحاتها الإقليمية. ومع ذلك، يمكن أن تستفيد من استكشاف أكثر تعمقًا للاستجابات من الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى، مثل الولايات المتحدة ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا، لاستراتيجيات الصين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لإطار نظري أوسع حول الدبلوماسية القسرية أن يعزز التحليل، مما يسمح بالمقارنة مع الجهات الفاعلة الحكومية الأخرى المنخرطة في ممارسات مماثلة.
وبنهج أعم، يُقَدِّم آرثر ميشيلينو في “تنافس القوى العظمى وسياسات القوة والإكراه في القرن الحادي والعشرين” (ميشيلينو، 2022) تحليلًا شاملًا للدبلوماسية القسرية وآثارها في العلاقات الدولية المعاصرة. ويفترض المبحث أن نجاح الدبلوماسية القسرية يتأثر بشكل كبير بالدعم الدولي والانسجام السياسي المحلي. ويجادل ميشيلينو بأنه عندما تحصل دولة بادئة على دعم دولي، فإنها تزيد من ضغوطها على الدولة المستهدفة، وتعزز شرعيتها وتوفر أدوات دبلوماسية إضافية. ويسلط هذا المنظور الضوء على أهمية التضامن العالمي في فعالية التدابير القسرية، مما يشير إلى أن غياب مثل هذا الدعم يمكن أن يقوض مصداقية التهديدات ويضعف موقف الدولة البادئة. ويستكشف المبحث أيضًا البعد المحلي للدبلوماسية القسرية، مؤكدًا أن المعارضة الوطنية القوية يمكن أن تحد من قدرة الحكومة على التصرف بشكل حاسم. ويلاحظ ميشيلينو أن الإجماع داخل الدولة البادئة يعزز عزيمتها ويعزز فعالية الاستراتيجيات القسرية. ويقدم هذا التركيز المزدوج على العوامل الدولية والمحلية فهما دقيقا لكيفية عمل الدبلوماسية القسرية في الممارسة العملية، مما يكشف عن التوازن المعقد المطلوب للتنفيذ الناجح.
ويضع ميشيلينو الدبلوماسية القسرية ضمن مجموعة أوسع من الاستراتيجيات الدبلوماسية، ويحددها كحل وسط بين التفاوض السلمي والصراع العسكري. يؤكد هذا التصور على الطبيعة الاستراتيجية للدبلوماسية القسرية، التي تعتمد على التهديد باستخدام القوة لإجبار الدولة المستهدفة على الامتثال. الجانب النفسي للتلاعب بتصور الخصم بارز بشكل خاص، لأنه يلعب دورا مهما في التأثير على القرارات وتوجيه الهدف نحو النتائج المرجوة. لذلك، فإن دراسة المبحث للحالات التاريخية، ولا سيما أزمة الصواريخ الكوبية، بمثابة توضيح مقنع لمبادئ الدبلوماسية القسرية في العمل. ويشير ميشيلينو إلى تحليل ألكسندر جورج للتأكيد على كيف كانت تكتيكات الرئيس كينيدي محورية في حل وضع شديد التقلب دون التصعيد إلى نزاع مسلح. ولا تعزز دراسة الحالة هذه الحجج الرئيسية للمقال فحسب، بل تقدم أيضًا دروسًا قيمة للتطبيقات المستقبلية للدبلوماسية القسرية.
الخلاصة:
تكشف الأدبيات المتعلقة بدبلوماسية الإكراه، أو الدبلوماسية القسرية، عن تفاعل معقد بين الأبعاد الأخلاقية والقانونية والاستراتيجية، وتؤكد على ضرورة فهم دقيق لآثارها في العلاقات الدولية. ويبدأ الاستكشاف بالاعتراف بقيود الإكراه وإمكانية وجود استراتيجيات بديلة، مثل الإقناع، لتعزيز التعاون بين الأطراف المتنازعة أميليا (إسبين، 2009). وتتحدى الحجة، التي قدمتها (رابوني، 2015) الاعتقاد التقليدي بأن الإكراه ضروري للقانون، بافتراض أن شرعية القواعد القانونية الدولية متجذرة في قبولها بدلًا من الإنفاذ القسري. وقد تم التأكيد على الأبعاد الأخلاقية للدبلوماسية القسرية من قبل جيمس باتيسون (باتيسون، 2015)، الذي يدعو إلى النقد الدبلوماسي كبديل للتكتيكات القسرية، مما يشير إلى أن المخاوف المتعلقة بالسمعة يمكن أن تحفز الدول على تغيير سلوكها. وتُكمل هذا المنظور جوليا جيبرت (جيبرت، 2017)، التي تسلط الضوء على التوازن الحاسم بين الإكراه والشرعية في جهود بناء السلام، مؤكدة أن المؤسسات الشرعية تمارس السلطة القسرية بشكل أكثر فعالية. وتوضح الأمثلة المعاصرة، مثل الدبلوماسية القسرية الصينية في بحر الصين الجنوبي، الآثار العملية للاستراتيجيات القسرية، كما عرضها هابيتاني بيترا (بيترا، 2019). ويؤكد هذا التحليل على الآثار الضارة للتكتيكات القسرية على الاستقرار الإقليمي، مما يثير مخاوف بشأن الآثار الأوسع نطاقا لمثل هذه الممارسات على العلاقات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يضع آرثر ميشيلينو (ميشيلينو، 2022) الدبلوماسية القسرية في سياق التنافس بين القوى العظمى، ويدعو إلى فهم استراتيجي لدورها بين التفاوض والصراع. ومن هنا نستطيع القول إن هذه الأدبيات تؤكد بشكل جماعي على الطبيعة متعددة الأوجه للدبلوماسية القسرية، وتكشف عن ضرورة الموازنة بين التدابير القسرية والاعتبارات الأخلاقية والشرعية. وتسلط الرؤى المستمدة من هذه المقالات الضوء على أهمية الحوار والتفاوض والتفاهم المتبادل في تعزيز العلاقات الدولية الفعالة مع التحذير من المخاطر المحتملة للإكراه.
_________
مراجع:
إسبين، أ. “استخدام تسوية المنازعات الدولية لمعالجة مسألة الامتثال في القانون الدولي”. (2009). [PDF]
رابوني، س. “هل الإكراه ضروري للقانون؟ دور الإكراه في القانون الدولي والمحلي”. (2015). [PDF]
باتيسون، ج. “أخلاقيات النقد الدبلوماسي: مسؤولية الحماية ونظرية الحرب العادلة والملاذ الأخير الافتراضي”. (2015). ncbi.nlm.nih.gov
جوليا جيبرت، ب. “الشرعية والإكراه في بناء السلام: عمل متوازن”. (2017). [PDF]
بيترا، ح. “الدبلوماسية القسرية الصينية من خلال صراع بحر الصين الجنوبي ومبادرات الحزام والطريق”. (2019). [PDF]
ميشيلينو، أ. “تنافس القوى العظمى وسياسات القوة والإكراه في القرن الحادي والعشرين”. (2022). osf.io
** أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسية، جامعة صقاريا، تركيا، الأمين العام لمنتدى الفكر العربي، الأردن
السبت، 01 شباط، 2025
عمان، المملكة الأردنية الهاشمية
اكتشاف المزيد من التنويري
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.